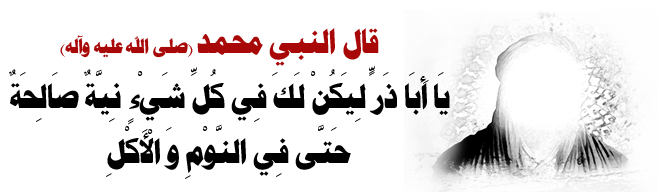
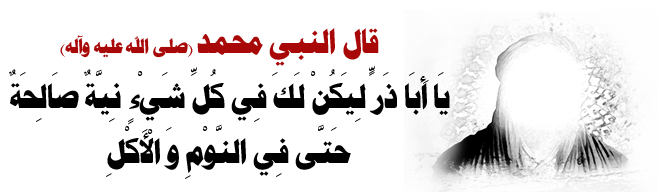

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-2-2017
التاريخ: 10-2-2017
التاريخ: 24-2-2017
التاريخ: 3-2-2017
|
قال تعالى : {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32] .
لما بين سبحانه حكم الميراث وفضل بعضهم على بعض في ذلك ذكر تحريم التمني الذي هو سبب التباغض فقال: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾ : أي لا يقل أحدكم : ليت ما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان لي فإن ذلك يكون حسدا ، ولكن يجوز أن يقول : اللهم أعطني مثله عن ابن عباس وهو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) . وقيل : إن المعنى لا يجوز للرجل أن يتمنى إن لو كان امرأة ولا للمرأة أن تتمنى إن لو كانت رجلا لأن الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح فيكون قد تمنى ما ليس بأصلح أو ما يكون مفسدة عن البلخي . ويمكن أن يقال في ذلك : أنه يجوز ذلك بشرط أن لا يكون مفسدة كما يقوله في حسن السؤال سواء ﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾ قيل فيه وجوه :
(أحدها) : إن المعنى : لكل حظ من الثواب على حسب ما كلفه الله من الطاعات بحسن تدبيره فلا تتمنوا خلاف هذا التدبير لما فيه من حرمان الحظ الجزيل عن قتادة (وثانيها) : إن لكل فريق من الرجال والنساء نصيبا مما اكتسب من نعيم الدنيا بالتجارات والزراعات وغير ذلك من أنواع المكاسب فينبغي أن يقنع كل منهم ويرضى بما قسم الله له . (وثالثها) : إن لكل منهما نصيبا من الميراث على ما قسمه الله عن ابن عباس فالاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة والإحراز ﴿وسألوا الله من فضله﴾ معناه إن احتجتم إلى ما لغيركم وأعجبكم أن يكون لكم مثل ما له فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله بشرط أن لا يكون فيه مفسدة لكم ولا لغيركم لأن المسألة لا تحسبن إلا كذلك وجاء في الحديث عن ابن مسعود عن النبي قال سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج وقال سفيان بن عيينة لم يأمرنا بالمسالة إلا ليعطي . ﴿إن الله كان بكل شيء عليما﴾ : معناه أن الله عليم بكل شيء ولم يزل كذلك فيعلم ما تظهرونه وما تضمرونه من الحسد ويقسم الأرزاق بين العباد على ما يعلم فيه من الصلاح والرشاد فلا يتمنى أحدكم ما قسم لغيره فإنه لا يحصل من تمنيه إلا الغم والإثم.
__________________
1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 74 .
{ولا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ} . ظاهر النهي ان الإنسان لا يجوز له أن يتمنى لنفسه ما يستحسنه عند غيره من النعمة والفضل ، سواء أتمنى مع ذلك زوال النعمة عن الغير ، وهو الحسد المذموم ، أم لم يفكر في ذلك إطلاقا ، بل تمنى أن يكون له مثل ما لغيره ، وهذه هي الغبطة .
ولكن ظاهر الآية على إطلاقه غير مراد ، لأن الغبطة لا بأس بها ، ولا ضرر منها ، أما الحسد فمحرم إذا بغى صاحبه على المحسود ، أو تضمن الاعتراض على اللَّه وحكمته ، قال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) : « إذا حسدت فلا تبغ » أي إذا شعرت من نفسك الرغبة في زوال النعمة عن غيرك فتمالك واكبت هذا الشعور ، وجاهده كي لا يظهر له أثر إلى الخارج في قول أو فعل . . فان تمالكت فأنت غير مسؤول أمام اللَّه ، وان اندفعت وراء شعورك تدس وتفتري على صاحب النعمة فإنك معتد أثيم .
وعلى هذه الحال وحدها يحمل النهي في الآية ، لأن قول الرسول (صلى الله عليه وآله) :
« إذا حسدت فلا تبغ » بيان وتفسير لها ، وإذا جاز للإنسان أن يتمنى لنفسه مثل ما لغيره من دون بغي فبالأولى أن يجوز له أن يتمنى ما يشاء من الخير ، دون أن ينظر إلى ما فضل اللَّه به غيره عليه . . قال تعالى في معرض المدح :
{ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنا عَذابَ النَّارِ - 201 البقرة } .
{لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} . في تفسير مجمع البيان : « جاءت وافدة النساء إلى رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) فقالت : يا رسول اللَّه أليس اللَّه رب الرجال والنساء وأنت رسول اللَّه إليهم جميعا ؟ فما بالنا يذكر اللَّه الرجال ، ولا يذكرنا ؟ نخشى أن لا يكون فينا خير ، ولا للَّه فينا حاجة .
فنزلت هذه الآية . »
والمعنى الظاهر منها ان لكل إنسان نتيجة عمله ، فلا ينبغي له ان يشغل نفسه بالحسد المذموم ، لأنه يعود على صاحبه بالوبال دنيا وآخرة ، قال الإمام علي (عليه السلام) : لا تحاسدوا ، فان الحسد يأكل الإيمان ، كما تأكل النار الحطب » وقال :
« صحة الجسد من قلة الحسد » . وذكر اللَّه سبحانه النساء للتنبيه على ان الرجل والمرأة سواء في ان لكل منهما ما سعى : { أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ - 195 آل عمران} .
يدعو اللَّه ويعمى عن سبيله :
{وسْئَلُوا اللَّهً مِنْ فَضْلِهِ}. فإن خزائنه لا تنفد ، ونعمه لا تحصى ، قال الإمام زين العابدين (عليه السلام) في بعض مناجاته : « علمت - يا إلهي - ان كثير ما أسألك يسير في وجدك ، وان خطير ما أستوهبك حقير في وسعك ، وان كرمك لا يضيق عن سؤال أحد ، وان يدك في عطاياك أعلى من كل يد » .
وفي الحديث : « سلوا اللَّه من فضله ، فاللَّه يحب أن يسأل » .
وتقول : ان الأمر بالسؤال يستدعي الإجابة ، مع العلم بأن كل الناس ، أو جلهم يسألون ويلحون في السؤال والدعاء ، ولا يستجيب اللَّه لهم ؟
الجواب : ان اللَّه سبحانه كما أمر بالدعاء فقد أمر أيضا بالسعي والجد ، وقال : { وأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى - 40 النجم } . ومعنى هذا ان اللَّه سبحانه ضمن إجابة الداعي عن طريق السعي والعمل ، ولم يضمن الإجابة عن
كل ما يمر بخاطر الإنسان بمجرد ان يطلب ويسأل . . كيف ؟ ولو فعل لخرب الكون . . ثم هل اللَّه جل وعز آمر ، أو مأمور ؟ وما ذا يفعل إذا تلقى دعوتين متناقضتين في آن واحد ؟ وما قولك بمن يدعو اللَّه ، ويعمى عن سبيله ؟ .
وبالتالي ، ان أمره تعالى بالسؤال من فضله تعبير ثان عن أمره بالجد والعمل ، وان على الإنسان ان يتجه إلى كسبه متوكلا على اللَّه وحده ، ولا ينظر إلى كسب الغير ، وما آتاه اللَّه من فضله . . وما من أحد شغل نفسه بغيره إلا تنغص عيشه ، وتاه عقله ، وارتبك في جميع أموره . . وقد عرفت ، وأنا طالب في النجف الأشرف زملاء لا ينقصهم الاستعداد والذكاء ، وأمضوا في النجف سنوات طوالا ، ومع ذلك كانوا من الفاشلين ، لا لشيء إلا لأنهم اشتغلوا بالناس عن أنفسهم ودروسهم . . وللَّه من قال : « من راقب الناس مات غما » . وتكلمنا مفصلا عن الدعاء والإجابة في تفسير الآية 186 من سورة البقرة .
_________________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص310-312 .
قوله تعالى : { وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ } التمني قول الإنسان : ليت كذا كان كذا ، والظاهر أن التسمية القول بذلك من باب توصيف اللفظ بصفة المعنى ، وإنما التمني إنشاء نحو تعلق من النفس نظير تعلق الحب بما تراه متعذرا أو كالمتعذر سواء أظهر ذلك بلفظ أو لم يظهر.
وظاهر الآية أنها مسوقة للنهي عن تمني فضل وزيادة موجودة ثابتة بين الناس ، وأنه ناش عن تلبس بعض طائفتي الرجال والنساء بهذا الفضل ، وأنه ينبغي الإعراض عن التعلق بمن له الفضل ، والتعلق بالله بالسؤال من الفضل الذي عنده تعالى ، وبهذا يتعين أن المراد بالفضل هو المزية التي رزقها الله تعالى كلا من طائفتي الرجال والنساء بتشريع الأحكام التي شرعت في خصوص ما يتعلق بالطائفتين كلتيهما كمزية الرجال على النساء في عدد الزوجات ، وزيادة السهم في الميراث ، ومزية النساء على الرجال في وجوب جعل المهر لهن ، ووجوب نفقتهن على الرجال .
فالنهي عن تمني هذه المزية التي اختص بها صاحبها إنما هو لقطع شجرة الشر والفساد من أصلها فإن هذه المزايا مما تتعلق به النفس الإنسانية لما أودعه الله في النفوس من حبها والسعي لها لعمارة هذه الدار ، فيظهر الأمر أولا في صورة التمني فإذا تكرر تبدل حسدا مستبطنا فإذا أديم عليه فاستقر في القلب سرى إلى مقام العمل والفعل الخارجي ثم إذا انضمت بعض هذه النفوس إلى بعض كان ذلك بلوى يفسد الأرض ، ويهلك الحرث والنسل.
ومن هنا يظهر أن النهي عن التمني نهي إرشادي يعود مصلحته إلى مصلحة حفظ الأحكام المشرعة المذكورة ، وليس بنهي مولوي .
وفي نسبة الفضل إلى فعل الله سبحانه ، والتعبير بقوله : { بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ } إيقاظ لصفة الخضوع لأمر الله بإيمانهم به ، وغريزة الحب المثارة بالتنبه حتى يتنبه المفضل عليه أن المفضل بعض منه غير مبان .
قوله تعالى : { لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ } ذكر الراغب : أن الاكتساب إنما يستعمل فيما استفاده الإنسان لنفسه ، والكسب أعم مما كان لنفسه أو لغيره ، والبيان المتقدم ينتج أن يكون هذه الجملة مبينة للنهي السابق عن التمني وبمنزلة التعليل له أي لا تتمنوا ذلك فإن هذه المزية إنما وجدت عند من يختص بها لأنه اكتسبها بالنفسية التي له أو بعمل بدنه فإن الرجال إنما اختصوا بجواز اتخاذ أربع نسوة مثلا وحرم ذلك على النساء لأن موقعهم في المجتمع الإنساني موقع يستدعي ذلك دون موقع النساء ، وخصوا في الميراث بمثل حظ الأنثيين لذلك أيضا ، وكذلك النساء خصصن بنصف سهم الرجال وجعل نفقتهن على الرجال وخصصن بالمهر لاستدعاء موقعهن ذلك ، وكذلك ما اكتسبته إحدى الطائفتين من المال بتجارة أو طريق آخر هو الموجب للاختصاص ، وما الله يريد ظلما للعباد .
ومن هنا يظهر أن المراد بالاكتساب هو نوع من الحيازة والاختصاص أعم من أن يكون بعمل اختياري كالاكتساب بصنعة أو حرفة أو لا يكون بذلك لكنه ينتهي إلى تلبس صاحب الفضل بصفة توجب له ذلك كتلبس الإنسان بذكورية أو أنوثية توجب له سهما ونصيبا كذا.
وأئمة اللغة وإن ذكروا في الكسب والاكتساب أنهما يختصان بما يحوزه الإنسان بعمل اختياري كالطلب ونحوه لكنهم ذكروا أن الأصل في معنى الكسب هو الجمع ، وربما جاز أن يقال : اكتسب فلان بجماله الشهرة ونحو ذلك ، وفسر الاكتساب في الآية بذلك بعض المفسرين ، وليس من البعيد أن يكون الاكتساب في الآية مستعملا فيما ذكر من المعنى على سبيل التشبيه والاستعارة.
وأما كون المراد من الاكتساب في الآية ما يتحراه الإنسان بعمله ، ويكون المعنى : للرجال نصيب مما استفادوه لأنفسهم من المال بعملهم وكذا النساء ويكون النهي عن التمني نهيا عن تمني ما بيد الناس من المال الذي استفادوه بصنعة أو حرفة فهو وإن كان معنى صحيحا في نفسه لكنه يوجب تضييق دائرة معنى الآية ، وانقطاع رابطتها مع ما تقدم من آيات الإرث والنكاح .
وكيف كان فمعنى الآية على ما تقدم من المعنى : ولا تتمنوا الفضل والمزية المالي وغير المالي الذي خص الله تعالى به أحد القبيلين من الرجال والنساء ففضل به بعضكم على بعض فإن ذلك الفضل أمر خص به من خص به لأنه أحرزه بنفسيته في المجتمع الإنساني أو بعمل يده بتجارة ونحوها ، وله منه نصيب ، وإنما ينال كل نصيبه مما اكتسبه .
قوله تعالى : { وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ } ، الإنعام على الغير بشيء مما عند المنعم لما كان غالبا بما هو زائد لا حاجة للمنعم إليه سمي فضلا ، ولما صرف الله تعالى وجوه الناس عن العناية بما أوتي أرباب الفضل من الفضل والرغبة فيه ، وكان حب المزايا الحيوية بل التفرد بها والتقدم فيها والاستعلاء من فطريات الإنسان لا يسلب عنه حينا صرفهم تعالى إلى نفسه ، ووجه وجوههم نحو فضله ، وأمرهم أن يعرضوا عما في أيدي الناس ، ويقبلوا إلى جنابه ، ويسألوا من فضله فإن الفضل بيد الله ، وهو الذي أعطى كل ذي فضل فضله فله أن يعطيكم ما تزيدون به وتفضلون بذلك على غيركم ممن ترغبون فيما عنده ، وتتمنون ما أعطيه .
وقد أبهم هذا الفضل الذي يجب أن يسأل منه بدخول لفظة « مِنْ » عليه ، وفيه من الفائدة أولا التعليم بأدب الدعاء والمسألة من جنابه تعالى فإن الأليق بالإنسان المبني على الجهل بما ينفعه ويضره بحسب الواقع إذا سأل ربه العالم بحقيقة ما ينفع خلقه وما يضرهم ، القادر على كل شيء أن يسأله الخير فيما تتوق نفسه إليه ، ولا يطنب في تشخيص ما يسأله منه وتعيين الطريق إلى وصوله ، فكثيرا ما رأينا من كانت تتوق نفسه إلى حاجة من الحوائج الخاصة كمال أو ولد أو جاه ومنزلة أو صحة وعافية وكان يلح في الدعاء والمسألة لأجلها لا يريد سواها ثم لما استجيب دعاؤه ، وأعطي مسألته كان في ذلك هلاكه وخيبة سعيه في الحياة.
وثانيا : الإشارة إلى أن يكون المسئول ما لا يبطل به الحكمة الإلهية في هذا الفضل الذي قرره الله تعالى بتشريع أو تكوين ، فمن الواجب أن يسألوا شيئا من فضل الله الذي اختص به غيرهم فلو سأل الرجال ما للنساء من الفضل أو بالعكس ثم أعطاهم الله ذلك بطلت الحكمة وفسدت الأحكام والقوانين المشرعة فافهم.
فينبغي للإنسان إذا دعا الله سبحانه عند ما ضاقت نفسه لحاجة أن لا يسأله ما في أيدي الناس مما يرفع حاجته بل يسأله مما عنده وإذا سأله مما عنده أن لا يعلم لربه الخبير بحاله طريق الوصول إلى حاجته بل يسأله أن يرفع حاجته بما يعلمه خيرا من عنده.
وأما قوله تعالى : { إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً } فتعليل للنهي في صدر الآية أي لا تتمنوا ما أعطاه الله من فضله من أعطاه الله إن الله بكل شيء عليم لا يجهل طريق المصلحة ولا يخطئ في حكمه .
____________________________
1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 285-287 .
لقد أوجب التفاوت في سهم الرجال والنساء من الإِرث ـ كما قرأت في سبب النزول ـ تساؤلا لدى البعض ، ويبدو أنّهم لم يلتفتوا إِلى أنّ هذا التفاوت إِنّما هو لأجل أن النفقة بكاملها على الرجل ، وليس على النساء شيء من نفقات العائلة ، بل نفقة المرأة هي الاُخرى مفروضة على الرجل ، ولهذا يكون ما تصيبه المرأة ضعف ما يصيبه الرجل من الثروة، ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية : {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} ، لأنّ لكل نوع من أنواع هذا التفضيل والتفاوت أسرار خفيّة عنكم غير ظاهرة لكم ، سواء كان التفاوت من جهة الخلقة والجنسية وبقية الصفات الجسمية والروحية التي تشكل أساس النظام الإِجتماعي فيكم ، أو التفاوت من الناحية الحقوقية بسبب اختلاف الموقع والمكانة كالتفاوت في سهم الإِرث ، إِنّ جميع أنواع هذا التفاوت قائم على أساس العدل والقانون الإِلهي الحكيم ، ولو كانت مصلحتكم في غير ذلك لسنّه وبيّنه لكم .
وعلى هذا فإِن تمنّى تغيير هذا الوضع نوع من المخالفة للمشيئة الرّبانية التي هي عين الحق والعدالة .
على أنّه يجب أن لا نتصور خطأً أنّ الآية الحاضرة تشير إِلى التفاوت المصطنع الذي برز نتيجة الإِستعمار والإِستغلال الطبقي ، بل تشير إِلى الفروق الطبيعية الواقعية ، لأنّ الفروق المصطنعة لا هي من المشيئة الإِلهية في شيء ، ولا أن تمني تغييرها مرفوض وغير صحيح ، بل هي فروق ظالمة وغير منطقية يجب السعي في رفعها وإزالتها وتفنيدها ، فللمثال : لا يمكن للنساء أن يتمنين أن يكُنّ رجالا ، كما لا يمكن للرجال أن يتمنوا أن يكونوا نساء ، لأنّ وجود هذين الجنسين أمر ضروري للنظام الإِجتماعي الإِنساني ، ولكن هذا التفاوت الجنسي يجب أن لا يتّخذ ذريعة، لأن يسحق أحد الجنسين حقوق الجنس الآخر ، ومن هنا فإنّ الذين اتّخذوا هذه الآية ذريعة لإِثبات التمييز الإِجتماعي الظالم أو يتصوروها حجّة على هذا التمييز قد أخطأوا خطأً كبيراً.
ولذا عقب الله سبحانه على الجملة السابقة فوراً بقوله : {للرّجال نصيب ممّا اكتسبوا وللنساء نصيب ممّا اكتسبن} أي لكلّ من الرجال والنساء نصيب من سعيه وجهده ومكانته سواء كانت مكانة طبيعية (كالتفاوت والفرق بين جنسي الرجل والمرأة) أو غير طبيعية ناشئة عن التفاوت بسبب الجهود الإِختيارية .
إنّ الجدير بالإِلتفات هنا هو : إنّ لكلمة «الإكتساب» التي هي بمعنى التحصيل مفهوماً واسعاً يشمل الجهود الإِختيارية ، كما يشمل ما يحصل عليه الإِنسان بواسطة بنيانه الطبيعي .
ثمّ يقول : {واسألوا الله من فضله} أي بدل أن تتمنوا هذا التفضيل والتفاوت اطلبوا من فضل الله واسألوا من لطفه وكرمه أن يتفضل عليكم من نعمه المتنوعة وتوفيقاته ومثوباته الطيبة ، لتكونوا ـ بنتيجة ذلك ـ سعداء رجالا ونساء ، ومن أي عنصر كنتم ، وعلى كل حال اطلبوا واسألوا ما هو خيركم وسعادتكم واقعاً، ولا تتمنوا ما هو خيال أو ما تتخيلونه (ولعلّ التعبير بلفظة «من فضله» إِشارة إِلى المعنى الأخير).
على أنّه من الواضح جدّاً أن طلب الفضل والعناية الرّبانية ليس بمعنى أن لا يسعى الإِنسان في الأخذ بأسباب كلّ شيء وعوامله، بل لابدّ من البحث عن فضل اللّه ورحمته من خلال الأسباب التي قرّرها وأرساها في الكون .
{إِنّ الله كان بكل شيء عليماً} أي يعلم ما يحتاج إِليه نظام المجتمع وما يلزمه من الفروق سواء من الناحية الطبيعية أو الحقوقية، ولهذا لا وجود للظلم والحيف ولا لأي شيء من التفاوت الظالم والتمييز غير العادل في أفعاله ، كما أنّه تعالى خبير بما في بواطن الناس من الأسرار والخفايا والنوايا ويعلم من الذي يتمنى الأماني الخاطئة في قلبه، ومن يتمنى الأماني الإِيجابية الصحيحة البناءة .
___________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص111-113 .
مني وأنا صنعته .



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|