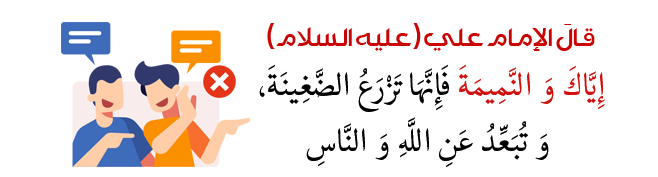
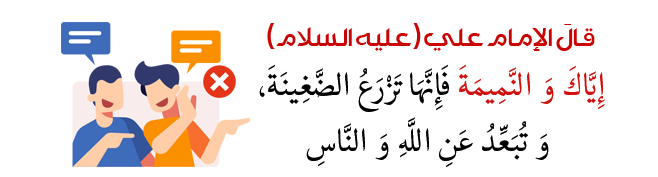

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
|
تحرير النزاع: كل عاقل يجد من نفسه إنه إذا وجب عليه شيء وكان حصوله يتوقف على مقدمات، فإنه لا بد له من تحصيل تلك المقدمات ليتوصل إلى فعل ذلك الشيء بها. وهذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشك والنزاع، وإنما الذي وقع موضعا للشك وجرى فيه النزاع عند الأصوليين هو إن هذه الابدية العقلية للمقدمة التي لا يتم الواجب الا بها هل يستكشف منها اللابدية شرعا أيضا؟
يعني إن الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه الشرعي وجوب مقدمته شرعا؟ أو فقل على نحو العموم: كل فعل واجب عند مولى من الموالي هل يلزم منه عقلا وجوب مقدمته أيضا عند ذلك المولى. وبعبارة رابعة أكثر وضوحا: إن العقل - لا شك - يحكم بوجوب مقدمة الواجب (أي يدرك لزومها) ولكن هل يحكم أيضا بأنها واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها؟
وعلى هذا البيان، فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي موضع البحث في هذه المسألة.
مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية؟
وإذا اتضح ما تقدم في تحرير النزاع نستطيع إن نفهم إنه في أي قسم من أقسام المباحث الأصولية ينبغي إن تدخل هذه المسألة. وتوضيح ذلك: إن هذه الملازمة - على تقدير القول بها - تكون على إنحاء ثلاثة: أما ملازمة غير بينة. أو بينة بالمعنى الأعم، أو بينة بالمعنى الأخص(1). فإن كانت هذه الملازمة - في نظر القائل بها - غير بينة أو بينة بالمعنى الأعم، فإثبات اللازم وهو وجوب المقدمة شرعا لا يرجع إلى دلالة اللفظ أبدا بل إثباته إنما يتوقف على حجية هذا الحكم العقلي بالملازمة، وإذا تحققت هناك دلالة فهي من نوع دلالة الإشارة (2). وعلى هذا فيجب إن تدخل المسألة في بحث الملازمات العقلية غير المستقلة، ولا يصح إدراجها في مباحث الألفاظ.
وإن كانت هذه الملازمة - في نظر القائل بها - ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية وهي الدلالة الإلتزامية خاصة.
والدلالة الإلتزامية من الظواهر التي هي حجة. ولعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ وجعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص. وهم على حق في ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها الا لكونها ملازمة بينة بالمعنى الأخص، ولكن الأمر ليس كذلك. أذن، يمكننا إن نقول: إن هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها: يمكن إن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال، ويمكن إن تدخل في الملازمات العقلية على البعض الآخر. ولكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقلية - كما صنعنا - لأن البحث فيها على كل حال في ثبوت الملازمة، غاية الأمر إنه على أحد الأقوال تدخل صغرى لحجية الظهور كما تدخل صغرى لحجية العقل. وعلى القول الآخر تتمحض في الدخول صغرى لحجية العقل. والجامع بينهما هو جعلها صغرى لحجية العقل. ثمرة النزاع: إن ثمرة النزاع المتصورة - أولا وبالذات - لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقلي الثابت. وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصولية، لأن المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلتها. ولكن هذه ثمرة غير عملية، باعتبار إن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي ولا بدية الإتيان بها لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها، إذ لا مجال للمكلف إن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال ذي المقدمة. وعليه، فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليا مفيدا، بل يبدو لأول وهلة إنه لغو من القول لا طائل تحته، مع إن هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم وأدقها وأكثرها بحثا.
ومن أجل هذا أخذ بعض الأصوليين المتأخرين يفتشون عن فوائد عملية لهذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب. وفي الحقيقة إن كل ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع. (راجع عنها المطولات إن شئت).
فيا ترى هل كان البحث عنها كله لغوا؟
وهل من الأصح إن نترك البحث عنها؟
- نقول: لا! إن للمسألة فوائد علمية كثيرة إن لم تكن لها فوائد عملية، ولا يستهان بتلك الفوائد كما سترى، ثم هي ترتبط، بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الفقه، كالبحث عن الشرط المتأخر والمقدمات المفوتة وعبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث مما لا يسع الأصولي إن يتجاهلها ويغفلها. وهذا كله ليس بالشيء القليل وإن لم تكن هي من المسائل الأصولية. ولذا تجد إن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المنوه عنها وأمثالها. أما نفس البحث عن أصل الملازمة فيكاد يكون بحثا على الهامش، بل آخر ما يشغل بال الأصوليين. هذا، ونحن أتباعا لطريقتهم نضع التمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة:
1 - الواجب النفسي والغيري تقدم في المجلد الأول ص 72 معنى الواجب النفسي والغيري، ويجب توضيحهما الآن فإنه هنا موضع الحاجة لبحثهما، لأن الوجوب الغيري هو نفس وجوب المقدمة - على تقدير القول بوجوبها - وعليه، فنقول في تعريفهما: (الواجب النفسي): ما وجب لنفسه، لا لواجب آخر. (الواجب الغيري): ما وجب.. لواجب آخر. وهذان التعريفان أسد التعريفات لهما وأحسنها، ولكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح: فإن قولنا: (ما وجب لنفسه) قد يتوهم منه المتوهم لأول نظرة إن العبارة تعطي إن معناها إن يكون وجوب الشيء علة لنفسه في الواجب النفسي، وذلك بمقتضى المقابلة لتعريف الواجب الغيري، إذ يستفاد منه إن وجوب الغير علة لوجوبه كما عليه المشهور. ولا شك في إن هذا محال في الواجب النفسي، إذ كيف يكون الشيء علة لنفسه؟ ويندفع هذا التوهم بأدنى تأمل، فإن ذلك التعبير عن الواجب النفسي صحيح لا غبار عليه، وهو نظير تعبيرهم عن الله تعالى بأنه (واجب الوجود لذاته)، فإن غرضهم منه إن وجوده ليس مستفادا من الغير ولا لأجل الغير كالممكن، لا إن معناه إنه معلول لذاته. وكذلك هنا نقول في الواجب النفسي فإن معنى (ما وجب لنفسه) إن وجوبه غير مستفاد من الغير ولا لأجل الغير في قبال الواجب الغيري الذي وجوبه لأجل الغير، لا إن وجوبه مستفاد من نفسه. وبهذا يتضح معنى تعريف الواجب الغيري (ما وجب لواجب آخر) فإن معناه إن وجوبه لأجل الغير وتابع للغير، لكونه مقدمة لذلك الغير الواجب. وسيأتي في البحث الآتي توضيح معنى التبعية هذه ليتجلى لنا المقصود من الوجوب الغيري في الباب.
2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم: (إن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره)، ولكن هذا التعبير مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن إن تتصور لها معاني أربعة، فلا بد من بيانها وبيان المعنى المقصود منها هنا، فنقول:
1 - إن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض. ومعنى ذلك إنه ليس في الواقع الا وجوب واحد حقيقي - وهو الوجوب النفسي - ينسب إلى ذي المقدمة أولا وبالذات والى المقدمة ثانيا وبالعرض. وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى حينما يقال: المعنى موجود باللفظ، فإن المقصود بذلك إن هناك وجودا واحدا حقيقيا ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات والى المعنى ثانيا وبالعرض. ولكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي إن يكون هو المقصود من التبعية هنا، لأن المقصود من الوجوب الغيري وجوب حقيقي آخر يثبت للمقدمة غير وجوب ذيها النفسي، بأن يكون لكل من المقدمة وذيها وجوب قائم به حقيقة. ومعنى التبعية في هذا الوجه إن الوجوب الحقيقي واحد ويكون الوجوب الثاني وجوبا مجازيا. على إن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة حتى يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عمليا.
2 - إن يكون معنى التبعية صرف التأخر في الوجود، فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر، بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلا ولكنه بعد البعث نحو ذيها مرتب عليه في الوجود، فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعة ومن قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت. ولكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي إن يكون هو المقصود هنا، فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة - في الحقيقة - وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب ذي المقدمة وإنما يكون وجوب ذي المقدمة له السبق في الوجود فقط. وهذا ينافي حقيقة المقدمية فإنها لا تكون الا موصلة إلى ذي المقدمة في وجوبها معا.
3 - إن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لذي المقدمة على وجه يكون معلولا له ومنبعثا منه انبعاث الأثر من مؤثره التكويني كانبعاث الحرارة من النار. وكان هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقوم، ولذا قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا لمكان هذه المعلولية، لأن المعلول لا يتحقق الا حيث تتحقق علته وإذا تحققت العلة لا بد من تحققه بصورة لا يتخلف عنها. وأيضا عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علته. ولكن هذا الوجه لا ينبغي إن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيري وإن اشتهر على الالسنة، لأن الوجوب النفسي لو كان علة للوجوب الغيري فلا يصح فرضه الا علة فاعلية تكوينية دون غيرها من العلل فإنه لا معنى لفرضه علة صورية أو مادية أو غائية. ولكن فرضه علة فاعلية أيضا باطل جزما، لوضوح إن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب هو الأمر، لأن الأمر فعل الأمر. والظاهر إن السبب في اشتهار معلولية الوجوب الغيري هو إن شوق الأمر للمقدمة هو الذي يكون منبعثا من الشوق إلى ذي المقدمة، لأن الإنسان إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق بالتبع إلى فعل كل ما يتوقف عليه. ولكن الشوق إلى فعل الشيء من الغير ليس هو الوجوب وإنما الشوق إلى فعل الغير يدفع الأمر إلى الأمر به إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به فإذا صدر منه الأمر وهو أهل له أنتزع منه الوجوب. والحاصل ليس الوجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي في ذي المقدمة ولا ينتهي إليه في سلسلة العلل، وإنما ينتهي الوجوب الغيري في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة إذا لم يكن هناك مانع لدى الأمر من الأمر بالمقدمة، لأن الشوق - على كل حال - ليس علة تامة إلى فعل ما يشتاق إليه. فتذكر هذا فإنه سينفعك في وجوب المقدمة المفوتة وفي أصل وجوب المقدمة، فإنه بهذا البيان سيتضح كيف يمكن فرض وجوب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها، وبهذا البيان سيتضح أيضا كيف إن المقدمة مطلقا ليست واجبة بالوجوب المولوي.
4 - إن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي ولكن لا بمعنى إنه معلول له، بل بمعنى إن الباعث للوجوب الغيري - على تقدير القول به - هو الواجب النفسي باعتبار إن الأمر بالمقدمة والبعث نحوها إنما هو لغاية التوصل إلى ذيها الواجب وتحصيله، فيكون وجوبها وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها ولولا إن ذيها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدمة. ويشير إلى هذا المعنى من التبعية تعريفهم للواجب الغيري بأنه (ما وجب لواجب آخر)، أي لغاية واجب آخر ولغرض تحصيله والتوصل إليه، فيكون الغرض من وجوب المقدمة على تقدير القول به هو تحصيل ذيها الواجب. وهذا المعنى هو الذي ينبغي إن يكون معنى التبعية المقصودة في الوجوب الغيري. ويلزمها إن يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوبها إطلاقا واشتراطا. وعليه، فالوجوب الغيري وجوب حقيقي ولكنه وجوب تبعي توصلي آلي، وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة. فكما إن المقدمة بما هي مقدمة لا يقصد فاعلها الا التوصل إلى ذيها كذلك وجوبها إنما هو للتوصل إلى تحصيل ذيها، كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة والاستقلال. وسر هذا واضح، فإن المولى - بناء على القول بوجوب المقدمة - إذا أمر بذي المقدمة فإنه لابد له لغرض تحصيله من المكلف إن يدفعه ويبعثه نحو مقدماته فيأمره بها توصلا إلى غرضه. فيكون البعث نحو المقدمة - على هذا - بعثا حقيقيا، لا إنه يتبع البعث إلى ذيها على وجه ينسب إليها بالعرض كما في (الوجه الأول)، ولا إنه يبعثه مستقل لنفس المقدمة ولغرض فيها بعد البعث نحو ذيها كما في (الوجه الثاني)، ولا إن البعث نحو المقدمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلولا له كما في (الوجه الثالث). وسيأتي تتمة للبحث في المقدمات المفوتة.
3 - خصائص الوجوب الغيري بعد ما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي، وهي أمور:
1 - إن الواجب الغيري كما لا بعث استقلالي له - كما تقدم - لا إطاعة استقلالية له، وإنما أطاعته كوجوبه لغرض التوصل إلى ذي المقدمة، بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه.
2 - إنه بعد إن قلنا إنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري وإنما أطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة فلا بد ألا يكون له ثواب على أطاعته (3) غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة، كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة. ولذا نجد إن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، لا إنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة. وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين (عليه السلام) وإنه في كل خطوة كذا من الثواب فينبغي - على هذا - إن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته باعتبار إن أفضل الأعمال أحمزها وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعرض، باعتبار إنها السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل، فتكون السبب في زيادة الثواب، لا إن الثواب على نفس المقدمة. ومن أجل إنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث الظاهر منه إن الثواب على نفس المقدمة بما هي. وسيأتي حله إن شاء الله تعالى.
3 - إن الوجوب الغيري لا يكون الا توصليا، أي لا يكون في حقيقته عباديا ولا يقتضي في نفسه عبادية المقدمة إذ لا يتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال كما قلنا في الخاصة الأولى إنه لا إطاعة استقلالية له، بل إنما يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذيها وإطاعة أمر ذيها فالمقصود بالامتثال به نفس أمر ذيها. ومن هنا استشكلوا في عبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث. وسيأتي حله إن شاء الله تعالى.
4 - إن الوجوب الغيري تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة، قضاء لحق التبعية، كما تقدم. ومعنى ذلك إنه كل ما هو شرط في وجوب ذي المقدمة فهو شرط في وجوب المقدمة، وما ليس بشرط لا يكون شرطا لوجوبها، كما إنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمة تحقق معه وجوب المقدمة. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذيها لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعة، أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته بناء على إن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها. ومن هنا استشكلوا في وجوب المقدمة قبل زمان ذيها في المقدمات المفوتة كوجوب الغسل - مثلا - قبل الفجر لإدراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر، فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب في وقته، ولهذا سميت مقدمة مفوتة باعتبار إن تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب في وقته فقالوا بوجوبها قبل الوقت مع إن الصوم لا يجب قبل وقته فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمته؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال في بحث المقدمات المفوتة.
4 - مقدمة الوجوب قسموا المقدمة إلى قسمين مشهورين:
1 - (مقدمة الواجب)، وتسمى المقدمة الوجوبية. وهي ما يتوقف عليها نفس الوجوب، بأن تكون شرطا للوجوب على قول مشهور. وقيل إنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقق والوجود على قول آخر، ومع ذلك تسمى مقدمة الوجوب. ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، وكالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات. ويسمى الواجب بالنسبة إليها (الواجب المشروط).
2 - (مقدمة الواجب)، وتسمى المقدمة الوجودية. وهى ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها، بل يكون الوجوب بالنسبة إليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والسفر بالنسبة إلى الحج ونحو ذلك. ويسمى الواجب بالنسبة إليها (الواجب المطلق). (راجع عن الواجب المشروط والمطلق المجلد الأول ص 81). والمقصود من ذكر هذا التقسيم بيان إن محل النزاع في مقدمة الواجب هو خصوص القسم الثاني أعني المقدمة الوجودية، دون المقدمة الوجوبية. والسر واضح لأنه إذا كانت المقدمة الوجودية مأخوذة على إنها مفروضة الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها، فإنه خلف، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج، بل إن انفق حصول الاستطاعة وجب الحج عندها. وذلك نظير الفوت في قوله (عليه السلام): (اقض ما فات)، فإنه لا يجب تحصيله لأجل امتثال الأمر بالقضاء، بل إن اتفق الفوت وجب القضاء.
5 - المقدمة الداخلية تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين: داخلية وخارجية.
1 - (المقدمة الداخلية): هي جزء الواجب المركب، كالصلاة. وإنما اعتبروا الجزء مقدمة فباعتبار إن المركب متوقف في وجوده على أجزائه فكل جزء في نفسه هو مقدمة لوجود المركب، كتقدم الواحد على الاثنين. وإنما سميت (داخلية) فلأجل إن الجزء داخل في قوأم المركب، وليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الإجزاء.
2 - (المقدمة الخارجية): وهي كل ما يتوقف عليه الواجب وله وجود مستقل خارج عن وجود الواجب. والغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان إن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل المقدمة الداخلية أو إن ذلك يختص بالخارجية؟ ولقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخلية. وسندهم في هذا الإنكار أحد أمرين:
(الأول) إنكار المقدمية للجزء رأسا، باعتبار إن المركب نفس الإجزاء بالأسر فكيف يفرض توقف الشيء على نفسه.
(الثاني) بعد تسليم إن الجزء مقدمة، ولكن يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري ما دام إنه واجب بالوجوب النفسي، لأن المفروض إنه جزء الواجب بالوجوب النفسي، وليس المركب الا إجزاءه بالأسر، فينبسط الواجب على الإجزاء. وحينئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغيري أيضا لاتصف الجزء بالوجوبين. وقد اختلفوا في بيان وجه استحالة اجتماع الوجوبين، ولا يهمنا بيان الوجه فيه بعد الاتفاق على الاستحالة. ولما كان هذا البحث لا نتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العملية في مسألة وجوب المقدمة، مع إنه بحث دقيق يطول الكلام حوله فنحن نطوي عنه صفحا محيلين الطالب إلى المطولات إن شاء.
6 - الشرط الشرعي إن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين: عقلية وشرعية.
1 - (المقدمة العقلية): هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، كتوقف الحج على قطع المسافة.
2 - (المقدمة الشرعية): هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع، كتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما. ويسمى هذا الأمر أيضا (الشرط الشرعي)، باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع، مثل قوله (عليه السلام): (لا صلاة الا بطهور) المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة.
والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان إن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي؟ ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا - على ما يظهر من بعض تقريرات درسه - إلى إن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري، وسماه (مقدمة داخلية بالمعنى الأعم)، باعتبار إن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءً له (4) فهو واجب بالوجوب النفسي. ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد - أي منشأ انتزاعه هو القيد - والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، إذ لا وجود للعنوان المنتزع الا بوجود منشأ انتزاعه - فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد، وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟ ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الإصفهاني (رحمه الله) ، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة.
وهو على حق في مناقشاته: أما (أولا) فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به، لا يخلو أما إن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وأما إن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه، ولا ثالث لهما. فإن كان من قبيل (الأول) فيجب إن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، ولكن بمعنى إن متعلق الأمر لا بد إن يكون الخاص بما هو خاص وهو المركب من المقيد والقيد فيكون القيد والتقييد معا داخلين. والسر في ذلك واضح، لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض وما يفي بالغرض - حسب الفرض - هو الخاص بما هو خاص أي المركب من المقيد والقيد، لا
إن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به، لأن المفروض إن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية، فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم بلا وجه بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق، كما لا وجه لتسميته بالشرط. وإن كان من قبيل (الثاني) فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا ومثل هذا لا يعقل إن يدخل في حيز الأمر النفسي، لأن الغرض - كما قلنا - لا يدعو بالأصالة الا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج، وأما ماله دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض فلا يدعو إليه الغرض في عرضه ذات السبب، بل الذي يدعو إلى أيجاد شرط التأثير لا بد إن يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه. ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، وإنما الفرق إن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض الا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد إن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به، أما بالأمر المتعلق بالمأمور به أي يأخذه قيدا فيه كان يقول مثلا صل عن طهارة، أو بأمر مستقل كان يقول مثلا: تطهر للصلاة. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة فيه تبعية وكذا الأمر به. يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه تبعية وكذا الأمر به. فإن قلتم - على هذا - يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط، قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه، وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا. وأما (ثانيا) فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه فإن هذا لا يوجب إن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد مقدمة داخلية، بل هو مقدمة خارجية، فإن وجود الطهارة - مثلا - يوجب حصول تقييد الصلاة بها، فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب الفرض. وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس إجزاء المأمور بها الخارجية، فكما إن مقدمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدمة التقييد ليست جزءا.
والحاصل إنه لما فرضتم في الشرط إن التقييد داخل وهو جزء تحليلي فقد فرضتم معه إن القيد خارج، فكيف تفرضونه مرة أخرى إنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد.
7 - الشرط المتأخر لا شك في إن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها، بناء على إن الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة. ومنها ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال وطهارة اللباس للصلاة. وإنما وقع الشك في (الشرط المتأخر). أي إنه هل يمكن إن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟ ومن قال بعدم أمكانه قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي، فإن المقدمة العقلية يستحيل فيها إن تكون متأخرة عن ذي المقدمة، لأنه لا يوجد الشيء الا بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ماله دخل في وجوده لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة. وإذا وجد الشيء فقد انتهى. فأية حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد. ومنشأ هذا الشك والبحث ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط - عند بعضهم - لصوم النهار السابق على الليل. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناء على إنها كاشفة عن صحة البيع لا نافلة. ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا، فبعضهم ذهب إلى أمكان الشرط المتأخر في الشرعيات وبعضهم ذهب إلى استحالته قياسا على الشرط العقلي كما ذكرنا آنفا، والذاهبون إلى الاستحالة أولوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها. وأحسن ما قيل في توجيه أمكان الشرط المتأخر في الشرعيات ما عن بعض مشايخنا الأعاظم (قدس سره) في بعض تقريرات درسه.
وخلاصته: إن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به، وأخرى في شرط الحكم سواء كان تكليفيا أم وضعيا. أما في (شرط المأمور به) فإن مجرد كونه شرطا شرعيا للمأمور به لا مانع منه، لأنه ليس معناه الا أخذه قيدا في المأمور به على إن تكون الحصة الخاصة من المأمور به هي المطلوبة. وكما يجوز ذلك في الأمر السابق والمقارن فإنه يجوز في اللاحق بلا فرق. نعم إذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة إلى إنه رافع للحدث في النهار فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعي بلا فرق. وسر ذلك إن المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعي المأمور به فوجود القيد المتأخر لا شأن له الا الكشف عن وجود تلك الحصة في ظرف كونها مطلوبة. ولا محذور في ذلك إنما المحذور في تأثير المتأخر في المتقدم. وأما في (شرط الحكم) سواء كان الحكم تكليفيا أم وضعيا، فإن الشرط فيه معناه أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه، وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين إن يكون متقدما أو مقارنا أو متأخرا كان يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد أخذه مفروض الوجود بعد وجود الموضوع. ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجي الحصول، فإن لتكليف في فعليته في الجزء الأول وما بعده يبقى مراعى إلى إن يحصل الجزء الأخير من المركب، وقد بقيت - إلى حين حصول كمال الإجزاء - شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما. وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه، فإن الحكم في الشرط المتأخر يبقى في فعليته مراعى إلى إن يحصل الشرط الذي أخذ مفروض الحصول، فكما إن الجزء الأول من المركب التدريجي الواجب في فرض حصول جميع الإجزاء يكون واجبا وفعلي الوجوب من أول الأمر لا إن فعليته تكون بعد حصول جميع الإجزاء، وكذا باقي الإجزاء لا تكون فعليتها بعد حصول الجزء الأخير بل حين حصولها ولكن في فرض حصول الجميع، فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلي الوجوب من أول الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه لا إن فعليته تكون متأخرة حين الشرط.
هذه خلاصة رأي شيخنا المعظم، ولا يخلو عن مناقشة، والبحث عن الموضوع بأوسع مما ذكرنا لا يسعه هذا المختصر.
8 - المقدمات المفوتة ورد في الشريعة المطهرة وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيها في الموقتات كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول أيامه. ووجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر، ووجوب الوضوء أو الغسل - على قول - قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها.. وهكذا. وتسمى هذه المقدمات باصطلاحهم (المقدمات المفوتة) باعتبار إن تركها موجب لتفويت الواجب في وقته كما تقدم. ونحن نقول: لو لم يحكم الشارع المقدس بوجوب مثل هذه المقدمات فإن العقل يحكم بلزوم الإتيان بها، لأن تركها موجب لتفويت الواجب في ظرفه، ويحكم أيضا بأن التارك لها يستحق العقاب على الواجب في ظرفه بسبب تركها. ولأول وهلة يبدو إن هذين الحكمين العقليين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقلية البديهية في الباب من جهتين: أما (أولا) فلأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها، على أي نحو فرض من إنحاء التبعية، لا سيما إذا كان من نحو تبعية المعلول لعلته على ما هو المشهور. فكيف يفرض الواجب التابع في زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع؟ وأما (ثانيا) فلأنه كيف يستحق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته قبل حضور وقته مع إنه حسب الفرض لا وجوب له فعلا. وأما في ظرفه فينبغي إن يسقط وجوبه لعدم القدرة عليه بترك مقدمتهم والقدرة شرط عقلي في الوجوب.
ولأجل التوفيق بين هاتيك البديهيات العقلية التي يبدو كأنها متعارضة - وإن كان يستحيل التعارض في الأحكام العقلية وبديهيات العقل - حاول جماعة من أعلام الأصوليين المتأخرين تصحيح ذلك بفرض انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب وتقدمه عليه، أما في خصوص الموقتات أو في مطلق الواجبات، على اختلاف المسالك. وبذلك يحصل لهم التوفيق بين تلكم الأحكام العقلية، لأنه حينما يفرض تقدم وجوب ذي المقدمة على لسان فلا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل وقت الواجب، وكان استحقاق العقاب على ترك الواجب على القاعدة لأن وجوبه كان فعليا حين ترك المقدمة. أما كيف يفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب وبأي مناط؟ فهذا ما اختلفت فيه الأنظار والمحاولات. فأول المحاولين لحل هذه الشبهة - فيما يبدو - صاحب الفصول الذي قال بجواز تقدم زمان الوجوب على طريقة (الواجب المعلق) الذي اخترعه كما اشرنا إليه في المجلد الأول ص 82. وذلك في خصوص الموقتات، بفرض إن الوقت في الموقتات وقت للواجب فقط لا للوجوب، أي إن الوقت ليس شرطا وقيدا للوجوب بل هو قيد للواجب. فالوجوب - على هذا الفرض - متقدم على الوقت ولكن الواجب معلق على حضور وقته. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو إن التوقف في المشروط للوجوب وفي المعلق للفعل. وعليه لا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل زمان ذيها. ولكن نقول: على تقدير أمكان فرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب فإن فرض رجوع القيد إلى الواجب لا إلى الوجوب يحتاج إلى دليل ونفس ثبوت وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان وجوب ذيها لا يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلق لأن الطريق في تصحيح وجوب المقدمة المفوتة لا ينحصر فيه كما سيأتي بيان الطريق الصحيح. والمحاولة الثانية - ما نسب إلى الشيخ الأنصاري من رجوع القيد في جميع شرائط الوجوب إلى المادة وإن اشتهر القول برجوعها إلى الهيئة. سواء كان الشرط هو الوقت أو غيره كالاستطاعة للحج والقدرة والبلوغ والعقل ونحوها من الشرائط العامة لجميع التكاليف. ومعنى ذلك إن الوجوب الذي هو مدلول الهيئة في جميع الواجبات مطلق دائما غير مقيد بشرط أبدا وكل ما يتوهم من رجوع القيد إلى الوجوب فهو راجع في الحقيقة إلى الواجب الذي هو مدلول المادة، غاية الأمر إن بعض القيود مأخوذة في الواجب على وجه يكون مفروض الحصول والوقوع كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، ومثل هذا لا يجب تحصيله ويكون حكمه حكم ما لو كان شرطا للوجوب، وبعضها لا يكون مأخوذا على وجه يكون مفروض الحصول، بل يجب تحصيله توصلا إلى الواجب لأن الواجب يكون هو المقيد بما هو مقيد بذلك القيد. وعلى هذا التصوير فالوجوب يكون دائما فعليا قبل مجيء وقته، وشأنه في ذلك شأن الوجوب على القول بالواجب المعلق لا فرق بينهما في الموقتات بالنسبة إلى الوقت فإذا كان الواجب استقباليا فلا مانع من وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذيها.
والمحاولة الثالثة - ما نسب إلى بعضهم من إن الوقت شرط للوجوب لا للواجب كما في المحاولتين الأوليتين، ولكنه مأخوذ فيه على نحو الشرط المتأخر. وعليه فالوجوب يكون سابقا على زمان الواجب نظير القول بالمعلق فيصح فرض وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذيها لفعلية الوجوب قبل لسان فتجب مقدمته. وكل هذه المحاولات مذكورة في كتب الأصول المطولة وفيها مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر، ومع الغض عن المناقشة في إمكانها في أنفسها لا دليل عليها الا ثبوت وجوب المقدمة قبل زمان ذيها، إذ كل صاحب محاولة منها يعتقد إن التخلص من إشكال وجوب المقدمة قبل زمان ذيها، ينحصر في المحاولة التي يتصورها فالدليل الذي يدل على وجوب المقدمة المفوتة قبل وقت الواجب لا محالة يدل عنده على محاولته. والذي اعتقده إنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدمة قبل زمان ذيها، فإن الصحيح - كما افاده شيخنا الإصفهاني (رحمه الله) - إن وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب ذيها ولا مترشحا منه، فليس هناك إشكال في وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذيها حتى نلتجئ إلى إحدى هذه المحاولات لفك الإشكال، وكل هذه الشبهة إنما جاءت من هذا الفرض وهو فرض معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذيها، وهو فرض لا واقع له أبدا، وإن كان هذا القول يبدو غريبا على الأذهان المشبعة بفرض إن وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، بل نقول أكثر من ذلك: إنه يجب في المقدمة المفوتة إن يتقدم وجوبها على وجوب ذيها، إذا كنا نقول بأن مقدمة الواجب واجبة، وإن كان الحق - وسيأتي - عدم وجوبها مطلقا. ولبيان عدم معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذيها: نذكر إن الأمر - في الحقيقة - هو فعل الأمر، سواء كان الأمر نفسيا أم غيريا، فالأمر هو العلة الفاعلية له دون سواه، ولكن كل أمر إنما يصدر عن إرادة الأمر لأنه فعله الاختياري والإرادة بالطبع مسبوقة بالشوق إلى فعل المأمور به، أي إن الأمر لا بد إن يشتاق أولا إلى فعل الغير على إن يصدر من الغير، فإذا اشتاقه لا بد إن يدعو الغير ويدفعه ويحثه على الفعل فيشتاق إلى الأمر به. وإذا لم يحصل مانع من الأمر فلا محالة يشتد الشوق إلى الأمر حتى يبلغ الإرادة الحتمية فيجعل الداعي في نفس الغير للفعل المطلوب وذلك بتوجيه الأمر نحوه. هذا حال كل مأمور به، ومن جملته (مقدمة الواجب)، فإنه إذا ذهبنا إلى وجوبها من قبل المولى لا بد إن نفرض حصول الشوق أولا في نفس الأمر إلى صدورها من المكلف، غاية الأمر إن هذا الشوق تابع للشوق إلى فعل ذي المقدمة ومنبثق منه، لأن المختار إذا أشتاق إلى تحصيل شيء وأحبه اشتاق وأحب بالتبع كل ما يتوقف عليه ذلك الشيء على نحو الملازمة بين الشوقين. وإذا لم يكن هناك مانع من الأمر بالمقدمات حصلت لدى الأمر - ثانيا - الإرادة الحتمية التي تتعلق بالأمر بها فيصدر حينئذ الأمر. إذا عرفت ذلك، فإنك تعرف إنه إذا فرض إن المقدمة متقدمة بالوجود الزماني على ذيها على وجه لا يحصل ذوها في ظرفه ولسان الا إذا حصلت هي قبل حلول لسان، كما في أمثلة المقدمات المفوتة، فإنه لا شك في إن الأمر يشتاقها إن تحصل في ذلك الزمان المتقدم، وهذا الشوق بالنسبة إلى المقدمة يتحول إلى الإرادة الحتمية بالأمر، إذ لا مانع من البعث نحوها حينئذ، والمفروض إن وقتها قد حان فعلا فلا بد إن يأمر بها فعلا. أما ذو المقدمة فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه والأمر به قبل وقته لعدم حصول ظرفه، فلا أمر قبل الوقت، وإن كان الشوق إلى الأمر به حاصل حينئذ ولكن لا يبلغ مبلغ الفعلية لوجود المانع. والحاصل إن الشوق إلى ذي المقدمة والشوق إلى المقدمة حاصلان قبل وقت ذي المقدمة، والشوق الثاني منبعث ومنبثق من الشوق الأول ولكن الشوق إلى المقدمة يؤثر أثره ويصير إرادة حتمية لعدم وجود ما يمنع من الأمر ، دون الشوق إلى ذي المقدمة لوجود المانع من الأمر. وعلى هذا، فتجب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها ولا محذور فيه، بل هو أمر لا بد منه ولا يصح إن يقع غير ذلك. ولا تستغرب ذلك فإن هذا أمر مطرد حتى بالنسبة إلى أفعال الإنسان نفسه، فإن اشتاق إلى فعل شيء اشتاق إلى مقدماته تبعا، ولما كانت المقدمات متقدمة بالوجود زمانا على ذيها، فإن الشوق إلى المقدمات يشتد حتى يبلغ درجة الإرادة الحتمية المحركة للعضلات فيفعلها، مع إن ذي المقدمة لم يحن وقته بعد، ولم تحصل له الإرادة الحتمية المحركة للعضلات وإنما يمكن إن تحصل له الإرادة الحتمية إذا حان وقته بعد طي المقدمات. فإرادة الفاعل التكوينية للمقدمة متقدمة زمانا على إرادة ذيها، وعلى قياسها الإرادة التشريعية، فلا بد إن تحصل للمقدمة المتقدمة زمانا قبل إن تحصل لذيها المتأخر زمانا، فيتقدم الوجوب الفعلي للمقدمة على الوجوب الفعلي لذيها زمانا، على العكس مما اشتهر، ولا محذور فيه بل هو المتعين. وهذا حال كل متقدم بالنسبة إلى المتأخر فإن الشوق يصير شيئا فشيئا قصدا و إرادة، كما في الأفعال التدريجية الوجود. وقد تقدم معنى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها فلا نعيد، وقلنا إنه ليس معناه معلوليته لوجوب ذي المقدمة وتبعيته له وجودا كما اشتهر على لسان الأصوليين. (فإن قلت): إن وجوب المقدمة - كما سبق - تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، ولا شك في إن الوقت - على الرأي المعروف - شرط لوجوب ذي المقدمة، فيجب إن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا به، قضاء لحق التبعية. (قلت) إن الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى إنه دخيل في مصلحة الأمر كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، وإن كان دخيلا في مصلحة المأمور به، ولكنه لا يتحقق البعث قبله، فلا بد إن يؤخذ مفروض الوجوب بمعنى عدم الدعوة إليه لأنه غير اختياري للمكلف. أما عدم تحقق وجوب الموقت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت. والسر واضح لأن البعث حتى البعث الجعلي منه يلازم الانبعاث إمكانا ووجودا فإذا أمكن الانبعاث أمكن البعث وإلا فلا، وإذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نحوه حتى الجعلي. ومن اجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلق لأنه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث. وهذا بخلاف المقدمة قبل وقت الواجب فإنه يمكن الانبعاث نحوها فلا مانع من فعلية البعث بالنظر إليها لو ثبت، فعدم فعلية الوجوب قبل زمان الواجب إنما هو لوجود المانع لا لفقدان الشرط، وهذا المانع موجود في ذي المقدمة قبل وقته مفقود في المقدمة. ويتفرع على هذا فرع فقهي وهو: إنه حينئذ لا مانع في المقدمة المفوتة العبادية كالطهارات الثلاث من قصد الوجوب في النية قبل وقت الواجب لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة.
والحاصل: إن العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة قبل وقت ذيها ولا مانع عقلي من ذلك هذا كله من جهة إشكال انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها. وأما من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوبه، فيعلم دفعه مما سبق فإن التكليف بذي المقدمة الموقت يكون تام الاقتضاء وإن لم يصر فعليا لوجود المانع وهو عدم حضور وقته. ولا ينبغي الشك في إن دفع التكليف مع تماميه اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم. وهذا يعد ظلما في حقه وخروجا عن زي الرقية وتمردا عليه، فيستحق عليه العقاب واللوم من هذه الجهة، وإن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلي المنجز. وهذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة للحج، فإن مثله لا يعد ظلما وخروجا عن زي الرقية وتمردا على المولى، لأنه ليس فيه تفويت لغرض المولى التأم الاقتضاء. والمدار في استحقاق العقاب هو تحقق عنوان الظلم للمولى القبيح عقلا.
9 - المقدمة العبادية ثبت بالدليل إن بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة الا إذا وقعت على وجه عبادي، وثبت أيضا ترتب الثواب عليها بخصوصها. ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. وقد سبق في الأمر الثاني الإشكال فيها من جهتين: من جهة إن الواجب الغيري لا يكون الا توصليا، فكيف يجوز إن تقع المقدمة بما هي مقدمة عبادة، ومن جهة ثانية إن الواجب الغيري بما هو واجب غيري لا استحقاق للثواب عليه. وفي الحقيقة إن هذا الإشكال ليس الا إشكالا على أصولنا التي أصلناها للواجب الغيري، فنقع في حيرة في التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيري وبين عبادية هذه المقدمات الثابتة عباديتها، وإلا فكون هذه المقدمات عبادية يستحق الثواب عليها أمر مفروغ عنه لا يمكن رفع اليد عنه. فأذن، لا بد لنا من توضيح ما أصلناه في الواجب الغيري بتوجيه عبادية المقدمة على وجه يلائم توصلية الأمر الغيري، وقد ذهبت الآراء أشتاتا في توجيه ذلك. ونحن نقول على الاختصار: إنه من المتيقن الذي لا ينبغي إن يتطرق إليه الشك من أحد، إن الصلاة - مثلا - ثبت من طريق الشرع توقف صحتها على إحدى الطهارات الثلاث، ولكن لا تتوقف على مجرد أفعالها كيفما اتفق وقوعها، بل إنما تتوقف على فعل الطهارة إذا وقع على الوجه العبادي أي إذا وقع متقربا به إلى الله تعالى. فالوضوء العبادي - مثلا - هو الشرط وهو المقدمة التي تتوقف صحة الصلاة عليها. وعليه، لا بد إن يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الأمر الغيري به، لأن الأمر الغيري - حسبما فرضناه - إنما يتعلق بالوضوء العبادي بما هو عبادة، لا بأصل الوضوء بما هو. فلم تنشأ عباديته من الأمر الغيري حتى يقال إن عباديته لا تلائم توصلية الأمر الغيري، بل عباديته لا بد إن تكون مفروضة التحقق قبل فرض تعلق الأمر الغيري.
ومن هنا يصح استحقاق الثواب عليه لأنه عبادة في نفسه ولكن ينشأ من هذا البيان إشكال آخر، وهو إنه إذا كانت عبادية الطهارات غير ناشئة من الأمر الغيري، فما هو الأمر المصحح لعباديتها، والمعروف إنه لا يصح فرض العبادة عبادة الا بتعلق أمر بها ليمكن قصد امتثاله، لأن قصد امتثال الأمر هو المقوم لعبادة العبادة عندهم. وليس لها في الواقع الا الأمر الغيري. فرجع الأمر بالأخير إلى الغيري لتصحيح عباديتها.
على إنه يستحيل إن يكون الأمر الغيري هو المصحح لعباديتها، لتوقف عباديتها - حينئذ - على سبق الأمر الغيري، والمفروض إن الأمر الغيري متأخر عن فرض عباديتها لأنه إنما تعلق بها بما هي عبادة، فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهو خلف محال، أو دور على ما قيل. وقد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة. وأحسنها - فيما أرى بناء على ثبوت الأمر الغيري أي وجوب مقدمة الواجب وبناء على إن عبادية العبادة لا تكون الا بقصد الأمر المتعلق بها - هو إن المصحح لعبادية الطهارات هو الأمر النفسي الاستحبابي لها في حد ذاتها السابق على الأمر الغيري بها. وهذا الاستحباب باق حتى بعد فرض الأمر الغيري، ولكن لا بحد الاستحباب الذي هو جواز الترك إذ المفروض إنه قد وجب فعلها فلا يجوز تركها، وليس الاستحباب الا مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب، فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم، بل يشتد وجوده، فيكون الوجوب استمرار له كاشتداد السواد والبياض من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة أقوى، وهو وجود واحد مستمر. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر الغيري حينئذ يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه فليست عباديتها متأتية من الأمر الغيري حتى يلزم الإشكال. ولكن هذا الجواب - على حسنه - غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة. وسر ذلك إنه لو كان المصحح لعباديتها هو الأمر الاستحبابي النفسي بالخصوص لكان يلزم الا تصح هذه المقدمات الا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الأمر الاستحبابي فقط، مع إنه لا يفتي بذلك احد، ولا شك في إنها تقع صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال أمرها الغيري، بل بعضهم اعتبر قصده في صحتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها.
فنقول (إكمالا للجواب): إنه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها إن المأمور به بالأمر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداعي امتثال الأمر الاستحبابي. كيف وهذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحده بعد ورود الأمر الغيري، فكيف يفرض إن المأمور به هو المأتي به بداعي امتثال الأمر الاستحبابي. بل مقصود المجيب إن الأمر الغيري لما كان متعلقه هو الطهارة بما هي عبادة، ولا يمكن إن تكون عباديتها ناشئة من نفس الأمر الغيري بما هو أمر غيري - فلا بد من فرض عباديتها لا من جهة الأمر الغيري وبفرض سابق عليه، وليس هو إلا الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بها، وهذا يصحح عباديتها قبل فرض تعلق الأمر الغيري بها، وإن كان حين توجه الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده وهو جواز الترك، ولكن لا تذهب بذلك؟؟ عباديتها، لأن المناط في عباديتها ليس جواز الترك كما هو واضح، بل المناط مطلوبيتها الذاتية ورجحانها النفسي، وهي باقية بعد تعلق الأمر الغيري. وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة واندكاك الاستحباب فيه، بمعنى إن الأمر الغيري يكون استمرار لتلك المطلوبية - فإنه حينئذ لا يبقى الا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليها، ويكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا غاية الأمر إن عباديته لم تجئ من اجل نفس كونه أمرا غيريا، بل من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبية النفسية وذلك الرجحان الذاتي الذي حصل من ناحية الأمر الاستحبابي النفسي السابق. وعليه، فينقلب الأمر الغيري عباديا، ولكنها عبادية بالغرض لا بالذات حتى يقال إن الأمر الغيري توصلي لا يصلح للعبادية. من هنا لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها، لأن الاستحباب بحده قد اندك في الأمر الغيري فلم يعد موجودا حتى يصح قصده. نعم يبقى إن يقال: إن الأمر الغيري إنما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة، لأنه حسب الفرض متعلقه هو الطهارة بصفة العبادة لا ذات الطهارة، والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فكيف صح إن يؤتى بذات العبادة بداعي امتثال أمرها الغيري ولا أمر غيري بذات العبادة؟ ولكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول: إذا كان الوضوء - مثلا - مستحبا نفسيا فهو قابل لأن يتقرب به من المولى، وفعلية التقرب تتحقق بقصد الأمر الغيري المندك فيه الأمر الاستحبابي.
وبعبارة أخرى: قد فرضنا الطهارات عبادات نفسية في مرتبة سابقة على الأمر الغيري المتعلق بها والأمر الغيري إنما يدعو إلى ذلك، فإذا جاء المكلف بها بداعي الأمر الغيري المندك فيه الاستحباب والمفروض ليس هناك أمر موجود غيره - صح التقرب به ووقعت عبادة لا محالة، ليتحقق ما هو شرط الواجب ومقدمته.
هذا كله بناء على ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة وبناءً على إن المناط عبادية العبادة هو قصد الأمر المتعلق بها. وكلا المبنيين نحن لا نقول بهما. أما الأول فسيأتي في البحث الآتي الدليل على عدم وجوب مقدمة الواجب فلا أمر غيري أصلا. وأما الثاني فلأن الحق إنه يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى. غاية الأمر إن العبادات قد ثبت إنها توقيفية فما لم يثبت رضا المولى بالفعل وحسن الانقياد وقصد وجه الله بالفعل لا يصح الإتيان بالفعل عبادة بل يكون تشريعا محرما. ولا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل على إن يكون أمرا فعليا من المولى ولذا قيل: يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي ومحبوبيتها الذاتية للمولى حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلي بها. وإذا ثبت ذلك فنقول في تصحيح عبادية الطهارات: إن فعل المقدمة بنفسه يعد شروعا في امتثال ذي المقدمة الذي هو حسب الفرض في المقام عبادة في نفسه مأمور بها. فيكون الإتيان بالمقدمة بنفسه يعد امتثالا للأمر النفسي بذي المقدمة العبادي. ويكفي في عبادة الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى مع عدم ما يمنع من التعبد به. ولا شك في إن قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي بفعل مقدماته قاصدا بها التوصل إلى الواجب النفسي العبادي يعد طاعة وانقيادا للمولى. وبهذا تصحح عبادية المقدمة وإن لم نقل بوجوبها الغيري ولا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيري. ومن هنا يصح إن تقع كل مقدمة عبادة ويستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار وإن لم تكن في نفسها معتبرا فيها إن تقع على وجه العبادة، كتطهير الثوب - مثلا - مقدمة للصلاة، أو كالمشي حافيا مقدمة للحج أو الزيارة غاية الأمر إن الفرق بين المقدمات العبادية وغيرها إن غير العبادية لا يلزم فيها إن تقع على وجه قربي بخلاف المقدمات المشروط فيها إن تقع عبادة كالطهارات الثلاث.
ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث من إن الثواب على ذي المقدمة يوزع على المقدمات باعتبار دالتها في زيادة حمازة الواجب، فإن ذلك التأويل مبني على فرض ثبوت الأمر الغيري وإن عبادية المقدمة واستحقاق الثواب عليها لا ينشأن الأمر الا من جهة الأمر الغيري، أتباعا للمشهور المعروف بين القوم. فإن قلت: إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به فعلا يعقل إن يكون الأمر بذي المقدمة داعيا بنفسه إلى المقدمة الا إذا قلنا بترشح أمر آخر منه بالمقدمة، فيكون هو الداعي. وليس هذا الأمر الآخر المترشح الا الأمر الغيري. فرجع الإشكال جذعا.
قلت: نعم الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، ولكنا لا ندعي إن الأمر بذي المقدمة هو الذي يدعو إلى المقدمة، بل نقول إن العقل هو الداعي إلى فعل المقدمة توصلا إلى فعل الواجب، وسيأتي إن هذا الحكم العقلي لا يستكشف منه ثبوت أمر غيري من المولى. ولا يلزم إن يكون هناك أمر بنفس المقدمة لتصحيح عباديتها ويكون داعيا إليها. والحاصل إن الداعي إلى فعل المقدمة هو حكم العقل، والمصحح لعباديتها شيء آخر هو قصد التقرب بها، ويكفي في التقرب بها إلى الله إن يأتي بها بقصد التوصل إلى ما هو عبادة. لا إن الداعي إلى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتها، ولا إن المصحح لعبادية العبادة منحصر قصد الأمر المتعلق بها، وقد سبق توضيح ذلك. وعليه، فإن كانت المقدمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث فالعقل لا يحكم الا بإتيانها على أي وجه وقعت، ولكن لو أتى بها المكلف متقربا بها إلى الله توصلا إلى العبادة صح ووقعت على صفة العبادية واستحق عليها الثواب. وإن كانت المقدمة عملا عباديا كالطهارة من الحدث فالعقل يلزم بالإتيان بها كذلك، والمفروض إن المكلف متمكن من ذلك، سواء كان هناك أمر غيري أم لم يكن، وسواء كانت المقدمة في نفسها مستحبة أم لم تكن. فلا إشكال من جميع الوجوه في عبادية الطهارات.
النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها بعد تقديم تلك التمهيدات التسعة نرجع إلى أصل المسألة، وهو البحث عن وجوب مقدمة الواجب الذي قلنا إنه آخر ما يشغل بال الأصوليين. وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها، ببيان تحرير النزاع. وهو - كما قلنا - الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذ قلنا إن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب أي إنه يدرك لزومها - ولكن وقع البحث في إنه هل يحكم أيضا بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها؟ لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن نذكر أهمها، ونذكر ما هو الحق منها، وهي:
1 - القول بوجوبها مطلقا.
2 - القول بعدم وجوبها مطلقا (وهو الحق وسيأتي دليله).
3 - التفصيل بين السبب فلا يجب، وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعد فيجب.
4 - التفصيل بين السبب وغيره أيضا، ولكن بالعكس أي يجب السبب دون غيره.
5 - التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري، باعتبار إنه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب، وبين غيره فيجب بالوجوب الغيري. وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني.
6 - التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا، ولكن بالعكس، أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره.
7 - التفصيل بين المقدمة الموصلة، أي التي يترتب عليها الواجب النفسي فتجب ، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجب. وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول.
8 - التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاري.
9 - التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد، وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها. فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم أرادته.
10 - التفصيل بين المقدمة الداخلية، أي الجزء، فلا تجب، وبين المقدمة الخارجية فتجب. وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها.
وقد قلنا إن الحق في المسألة - كما عليه جماعة (5) من المحققين المتأخرين - القول الثاني وهو عدم وجوبها مطلقا. والدليل عليه واضح بعد ما قلناه ... من إنه في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حكما داعيا للمكلف إلى فعل الشيء لا يبقى مجال للأمر المولوي فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة. وذلك لأنه إذا كان الأمر بذي المقدمة داعيا للمكلف إلى الإتيان بالمأمور به فإن دعوته هذه - لا محالة بحكم العقل - تحمله وتدعوه إلى الإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له. ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى، مع علم المولى - حسب الفرض - بوجود هذا الداعي، لأن الأمر المولوي - سواء كان نفسيا أم غيريا - إنما يجعله المولى لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به، إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داع.
بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من المولى، لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. وبعبارة أخرى: إن الأمر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة فأي أمر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي للدعوة إليها بما هي مقدمة. ومع كفاية الأمر بذي المقدمة لتحريكه إلى المقدمة وللدعوة إليها فأية حاجة تبقى إلى الأمر بها من قبل المولى، بل يكون عبثا ولغوا؟؟ بل يمتنع لأنه تحصيل للحاصل. وعليه، فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على الإرشاد وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الأوامر الإرشادية في موارد حكم العقل وعلى هذا يحمل قوله (عليه السلام): (إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة). ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية: (إنه لا وجوب غيري أصلا، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط. فلا موقع أذن لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري. فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأصولية).
________________
(1) راجع عن معنى الملازمة وأقسامها الثلاثة الجزء الأول من المنطق للمؤلف ص 79 الطبعة الثانية.
(2) راجع دلالة الإشارة الجزء الأول ص 135، فإنه ذكرنا هناك إن دلالة الإشارة ليست من الظواهر فلا تدخل في حجية الظهور، وإنما حجيتها - على تقديره - من باب الملازمة العقلية.
(3) يرى السيد الجليل المحقق الخوئي إن المقدمة أمر قابل لأن يأتي به الفاعل مضافا به إلى المولى، فيترتب على فعلها الثواب إذا أتى بها كذلك. ولا ملازمة عنده بين ترتب الثواب على عمل وعدم استحقاق العقاب على تركه، ولا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه. وهو رأي وجيه باعتبار إن فعل المقدمة يعد مشروعا في امتثال ذيها.
(4) إن الفرق بين الجزء والشرط هو إنه في الجزء يكون التقييد والقيد معا داخلين في المأمور به، وأما في الشرط فالتقييد فقط يكون داخلا والقيد يكون خارجا، يعني إن التقييد يكون جزءا تحليليا للمأمور به إذ يكون المأمور به - في المثال - هو الصلاة بما هي مقيدة بالطهارة، أي إن المأمور به هو المركب من ذات الصلاة والتقييد بوصف الطهارة. فذات الصلاة جزء تحليلي والتقييد جزء تحليلي آخر.
(5) أول من تنبه إلى ذلك وأقام عليه البرهان بالأسلوب الذي ذكرناه - فيما أعلم - أستاذنا المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وقد عضد هذا القول السيد الجليل المحقق الخوئي دام ظله. وكذلك ذهب إلى هذا القول وأوضحه سيدنا المحقق الحكيم دام ظله في حاشيته على الكفاية.



|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تقيم حفلاً بذكرى عيد الغدير الأغر
|
|
|