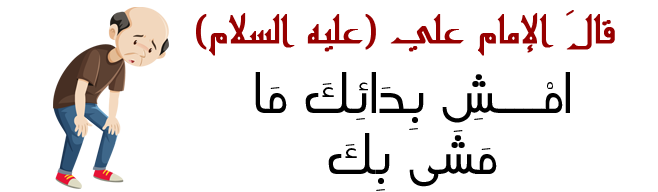
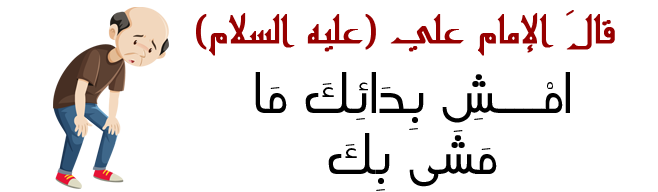

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2016
التاريخ: 12-1-2017
التاريخ: 19-11-2016
التاريخ: 12-1-2017
|
[جواب الشبهة]
بحوث المدرستين حول الصحبة والصحابة [ تتضمن ما يلي ] :
الفصل الأوّل : تعريف الصحابي لدى المدرستين :
تعريف الصحابي في مدرسة الخلفاء تعريف الصحابي بمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ضابطتهم لمعرفة الصحابي مناقشة ضابطة معرفة الصحابي .
تعريف الصّحابيّ لدى المدرستين :
تعريف الصحابيّ في مدرسة الخلفاء :
قال ابن حجر في مقدّمة الإصابة، الفصل الأول في تعريف الصحابيّ:
الصحابيّ من لقي النبي ( صلى الله عليه [ واله ] ) مؤمنا به ، ومات على الإسلام.
فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، و من روى عنه أو لم يرو، و من غزا معه أو لم يغز، و من رآه رؤية و لو لم يجالسه، و من لم يره لعارض كالعمى(1).
وذكر في (ضابط يستفاد من معرفته صحبة جمع كثير) و قال: (إنّهم كانوا في الفتوح لا يؤمّرون إلّا الصحابة).
(و انّه لم يبق بمكة و لا الطّائف أحد في سنة عشر إلّا أسلم و شهد مع النبي حجّة الوداع) و (أنّه لم يبق في الأوس و الخزرج أحد في آخر عهد النبي( صلى الله عليه [ واله ] ) إلّا دخل في الإسلام) و (ما مات النبيّ( صلى الله عليه [ واله ] ) و أحد منهم يظهر الكفر) (2).
وإذا راجع باحث أجزاء كتابنا (خمسون ومائة صحابيّ مختلق) يرى مدى تسامحهم في ذلك ومبلغ ضرره على الحديث.
تعريف الصّحابيّ بمدرسة أهل البيت (عليهم السلام ) :
إن مدرسة أهل البيت ترى أنّ تعريف الصحابي: هو ما ورد في قواميس اللغة العربية كالآتي:
الصاحب و جمعه: صحب، و أصحاب، و صحاب، وصحابة(3) و (الصاحب: المعاشر(4) والملازم(5))، (و لا يقال إلّا لمن كثرت ملازمته) (6) ، (و انّ المصاحبة تقتضي طول لبثه) (7).
وبما أنّ الصّحبة تكون بين اثنين، يتّضح لنا أنّه لا بدّ أن يضاف لفظ (الصاحب) و جمعه (الصحب و ...) إلى اسم ما في الكلام، و كذلك ورد في القرآن في قوله تعالى: يا صاحِبَيِ { يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ} [يوسف: 39] و {أَصْحَابُ مُوسَى} [الشعراء: 61] ، وكان يقال في عصر الرسول( صلى الله عليه [ واله ] ) : (صاحب رسول اللّه) و (أصحاب رسول اللّه) مضافا إلى رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) كما كان يقال: (أصحاب بيعة الشّجرة) و (أصحاب الصفّة) مضافا إلى غيره، و لم يكن لفظ الصاحب و الأصحاب يوم ذاك أسماء لأصحاب الرسول( صلى الله عليه [ واله ] ) و لكنّ المسلمين من أصحاب مدرسة الخلافة تدرّجوا بعد ذلك في تسمية أصحاب رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) بالصحابيّ و الأصحاب، و على هذا فإنّ هذه التسمية من نوع (تسمية المسلمين) و (مصطلح المتشرّعة).
كان هذا رأي المدرستين في تعريف الصحابي.
ضابطتهم لمعرفة الصحابيّ :
ذكر مترجمو الصحابة بمدرسة الخلفاء ضابطة لمعرفة الصحابي، كما نقلها ابن حجر في الإصابة و قال:
وممّا جاء عن الأئمة من الأقوال المجملة في الصفة الّتي يعرف بها كون الرجل صحابيّا و إن لم يرد التنصيص على ذلك، ما أورده ابن أبي شيبة في مصنّفه من طريق لا بأس به: أنّهم كانوا في الفتوح لا يؤمّرون إلّا الصحابة(8).
والرواية الّتي جاءت من طريق لا بأس به بهذا الصدد هي الّتي رواها الطبريّ و ابن عساكر بسندهما، عن سيف، عن أبي عثمان، عن خالد و عبادة، قال فيها:
وكانت الرؤساء تكون من الصحابة حتى لا يجدوا من يحتمل ذلك(9).
وفي رواية أخرى عند الطبري عن سيف قال:
إنّ الخليفة عمر كان لا يعدل أن يؤمّر الصحابة إذا وجد من يجزي عنه في حربه. فإن لم يجد ففي التّابعين بإحسان، و لا يطمع من انبعث في الردّة في الرئاسة ... (10).
مناقشة ضابطة معرفة الصّحابي :
إنّ مصدر الروايتين هو سيف المتّهم بالوضع والزندقة(11).
وسيف يروي الضابطة عن أبي عثمان، وأبو عثمان الّذي يروي عن خالد وعبادة في روايات سيف، تخيّله سيف: يزيد بن أسيد الغسّاني، وهذا الاسم من مختلقات سيف من الرواة(12).
ومهما تكن حال الرواة الّذين رووا أمثال هذه الروايات، وكائنين من كانوا، فإنّ الواقع التاريخيّ يناقض ما ذكروا؛ فقد روى صاحب الأغاني وقال:
أسلم امرؤ القيس على يد عمر وولّاه قبل أن يصلي للّه ركعة واحدة (13).
وتفصيل الخبر في رواية بعدها عن عوف بن خارجة المرّي قال:
واللّه إنّي لعند عمر بن الخطاب في خلافته، إذ أقبل رجل أفحج (14) أجلح أمعر يتخطّى رقاب الناس حتى قام بين يدي عمر، فحيّاه بتحيّة الخلافة.
فقال له عمر: فمن أنت ؟
قال: أنا امرؤ نصرانيّ، أنا امرؤ القيس بن عدي الكلبي.
فعرفه عمر، فقال له: فما تريد ؟
قال: الإسلام.
فعرضه عليه عمر، فقبله. ثمّ دعا له برمح فعقد له على من أسلم بالشّام من قضاعة(15). فأدبر الشّيخ و اللّواء يهتزّ على رأسه- الحديث(16).
ويخالفه – أيضا - ما في قصّة تأمير علقمة بن علاثة الكلبي بعد ارتداده، وقصّته كما في الأغاني و الإصابة(17) بترجمته ما يلي:
أسلم علقمة على عهد رسول اللّه و أدرك صحبته. ثمّ ارتدّ على عهد أبي بكر. فبعث أبو بكر إليه خالدا ففرّ منه.
قالوا: ثمّ رجع فأسلم.
وفي الإصابة:
شرب الخمر على عهد عمر، فحدّه، فارتدّ و لحق بالروم. فأكرمه ملك الروم، قال له: أنت ابن عمّ عامر بن الطفيل. فغضب و قال: لا أراني أعرف إلّا بعامر(18). فرجع و أسلم.
وفي الأغاني والإصابة- واللفظ للأوّل-:
لمّا قدم علقمة بن علاثة المدينة و كان قد ارتدّ عن الإسلام، و كان لخالد بن الوليد صديقا، فلقيه عمر بن الخطاب في المسجد في جوف اللّيل، و كان عمر يشبه بخالد، فسلّم عليه و ظنّ أنه خالد.
فقال له: عزلك؟
قال: كان ذلك.
قال: واللّه ما هو إلا نفاسة عليك و حسدا لك.
فقال له عمر: فما عندك معونة على ذلك؟
قال: معاذ اللّه، إنّ لعمر علينا سمعا و طاعة و ما نخرج إلى خلافه.
فلمّا أصبح عمر أذن للنّاس، فدخل خالد و علقمة. فجلس علقمة إلى جنب خالد، فالتفت عمر إلى علقمة فقال له :
إيه يا علقمة ، أنت القائل لخالد ما قلت ؟
فالتفت علقمة إلى خالد، فقال:
يا أبا سليمان أفعلتها؟
قال: ويحك! و اللّه ما لقيتك قبل ما ترى، و إنّي أراك لقيت الرجل.
قال: أراه و اللّه.
ثم التفت إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! ما سمعت إلّا خيرا.
قال: أجل، فهل لك أن أوّليك حوران(19) ؟
قال: نعم.
فولّاه إياها فمات بها، فقال الحطيئة يرثيه- الحديث.
وزاد في الإصابة:
فقال عمر: لأن يكون من ورائي على مثل رأيك أحبّ إليّ من كذا و كذا.
كان ما نقلناه هو الواقع التاريخيّ غير أن علماء مدرسة الخلفاء استندوا إلى ما رووا و اكتشفوا ممّا رووا ضابطة لمعرفة صحابة رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) و أدخلوا في عداد الصّحابة مختلقات سيف بن عمر المتّهم بالزندقة ممّا درسناه في كتابنا (خمسون و مائة صحابيّ مختلق).
بعد دراسة رأي المدرستين في تعريف الصحابيّ، ندرس في ما يأتي أمر عدالة الصّحابة لدى المدرستين.
الفصل الثاني : عدالة الصحابة لدى المدرستين :
ضابطة لمعرفة المؤمن و المنافق :
رأي مدرسة الخلفاء في عدالة الصّحابة :
ترى مدرسة الخلفاء أنّ الصّحابة كلّهم عدول، و ترجع إلى جميعهم في أخذ معالم دينها.
قال إمام أهل الجرح والتعديل الحافظ أبو حاتم الرازي(20) في تقدمة كتابه:
(فأما أصحاب رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) فهم الّذين شهدوا الوحي و التّنزيل، و عرفوا التّفسير و التّأويل، و هم الّذين اختارهم اللّه عزّ و جلّ لصحبة نبيّه( صلى الله عليه [ واله ] ) و نصرته و إقامة دينه و إظهار حقّه، فرضيهم له صحابة، و جعلهم لنا أعلاما و قدوة، فحفظوا عنه( صلى الله عليه [ واله ] ) ما بلّغهم عن اللّه عزّ و جلّ، و ما سنّ و شرع و حكم و قضى و ندب و أمر و نهى و حظر و أدّب، و وعوه و أتقنوه، ففقهوا في الدّين، و علموا أمر اللّه و نهيه و مراده، بمعاينة رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) و مشاهدتهم منه تفسير الكتاب و تأويله، و تلقّفهم منه و استنباطهم عنه؛ فشرّفهم اللّه عزّ و جلّ بما منّ عليهم و أكرمهم به من وضعه إيّاهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشكّ و الكذب و الغلط و الريبة و الفخر واللّمز، وسمّاهم عدول الأمّة، فقال عزّ ذكره في محكم كتابه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143]. ففسّر النبيّ( صلى الله عليه [ واله ] ) عن اللّه عزّ ذكره قوله: وَسَطاً قال: عدلا. فكانوا عدول الأمّة، و أئمة الهدى، و حجج الدّين، و نقلة الكتاب و السنّة.
و ندب اللّه عزّ و جلّ إلى التمسّك بهديهم و الجري على منهاجهم و السلوك لسبيلهم و الاقتداء بهم، فقال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ... } [النساء: 115] .
ووجدنا النبيّ( صلى الله عليه [ واله ] ) قد حضّ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة و وجدناه يخاطب أصحابه فيها، منها أن دعا لهم فقال: «نضّر اللّه امرأ سمع مقالتي فحفظها و وعاها حتّى يبلغها غيره». و قال( صلى الله عليه [ واله ] ) في خطبته: «فليبلّغ الشاهد منكم الغائب» و قال: «بلّغوا عنّي و لو آية، و حدّثوا عني و لا حرج».
ثمّ تفرّقت الصّحابة- رضي اللّه عنهم- في النواحي و الأمصار والثغور، و في فتوح البلدان و المغازي و الإمارة و القضاء و الأحكام، فبثّ كلّ واحد منهم في ناحيته و البلد الّذي هو به ما وعاه و حفظه عن رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) (21) و أفتوا في ما سئلوا عنه ممّا حضرهم من جواب رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) عن نظائرها من المسائل، و جرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة و القربة إلى اللّه تقدّس اسمه لتعليم الناس الفرائض و الأحكام و السنن الحلال و الحرام، حتّى قبضهم اللّه عزّ و جلّ. رضوان اللّه و مغفرته و رحمته عليهم أجمعين.
وقال ابن عبد البرّ في مقدمة كتابه: الاستيعاب(22):
(ثبتت عدالة جميعهم). ثمّ أخذ بإيراد آيات و أحاديث وردت في حقّ المؤمنين منهم نظير ما أوردناه من الرازي.
وقال ابن الاثير في مقدمته لكتاب أسد الغابة(23):
(...إنّ السنن الّتي عليها مدار تفصيل الأحكام و معرفة الحلال و الحرام إلى غير ذلك من أمور الدّين، إنّما ثبتت بعد معرفة رجال أسانيدها و رواتها، و أوّلهم و المقدّم عليهم أصحاب رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) فإذا جهلهم الإنسان كان بغيرهم أشدّ جهلا و أعظم إنكارا، فينبغي أن يعرفوا بأنسابهم و أحوالهم ...
والصّحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلّا في الجرح والتعديل، فإنّهم كلّهم عدول لا يتطرّق إليهم الجرح ...).
وقال الحافظ ابن حجر في الفصل الثالث، في بيان حال الصّحابة من العدالة، من مقدمة الإصابة(24): (اتّفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول، و لم يخالف في ذلك إلّا شذوذ من المبتدعة ...).
وروى عن أبي زرعة أنّه قال: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) فاعلم أنّه زنديق، و ذلك أنّ الرسول حقّ، و القرآن حقّ، و ما جاء به حقّ، و إنّما أدّى ذلك إلينا كلّه الصّحابة، و هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب و السنّة، و الجرح بهم أولى و هم زنادقة) (25).
كان هذا رأي مدرسة الخلفاء في عدالة الصّحابة، و في ما يلي رأي مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك.
رأي مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في عدالة الصّحابة :
ترى مدرسة أهل البيت تبعا للقرآن الكريم: أنّ في الصّحابة مؤمنين أثنى عليهم اللّه في القرآن الكريم و قال في بيعة الشجرة مثلا: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 18]. فقد خصّ اللّه الثّناء بالمؤمنين ممّن حضروا بيعة الشجرة و لم يشمل المنافقين الّذين حضروها مثل عبد اللّه بن أبيّ و أوس بن خولي(26).
وكذلك تبعا للقرآن ترى فيهم منافقين ذمّهم اللّه في آيات كثيرة مثل قوله تعالى : {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ } [التوبة: 101].
وفيهم من أخبر اللّه عنهم بالإفك، أي من رموا فراش رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) بالإفك (27) - نعوذ باللّه من هذا القول- و فيهم من أخبر اللّه عنهم بقوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } [الجمعة: 11]. وكان ذلك عند ما كان رسول اللّه قائما في مسجده يخطب خطبة الجمعة.
وفيهم من قصد اغتيال رسول اللّه في عقبة هرشى عند رجوعه من غزوة تبوك (28) ، أو من حجّة الوداع (29).
وإنّ التشرف بصحبة النبيّ( صلى الله عليه [ واله ] ) ليس أكثر امتيازا من التشرف بالزواج بالنبيّ( صلى الله عليه [ واله ] ) ، فإن مصاحبتهن له كانت من أعلى درجات الصحبة، و قد قال اللّه تعالى في شأنهن : {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا * يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ... } [الأحزاب: 30، 32].
وقال في اثنتين منهنّ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التحريم: 4] - إلى قوله تعالى:- {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ * وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ... * وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ... } [التحريم: 10 - 12] التحريم من أوّل السورة إلى آخرها.
ومنهم من أخبر عنهم الرسول( صلى الله عليه [ واله ] ) في قوله عن يوم القيامة:
«و إنّه يجاء برجال من أمّتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربّ أصيحابي. فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} [المائدة: 117].
فيقال: إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم»(30) وفي رواية: ليردنّ عليّ ناس من أصحابي الحوض حتّى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي. فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك»(31).
وفي صحيح مسلم:
ليردنّ عليّ الحوض رجال ممّن صاحبني حتّى إذا رأيتهم و رفعوا إليّ اختلجوا دوني، فلأقولنّ: أي ربّ أصيحابي. فليقالنّ لي: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» (32).
ضابطة لمعرفة المؤمن و المنافق :
لمّا كان في الصحابة منافقون لا يعلمهم إلّا اللّه، و قد أخبر نبيّه بأنّ عليّا لا يحبّه إلّا مؤمن و لا يبغضه إلّا منافق، كما رواه الإمام عليّ (عليه السلام) (33) وأمّ المؤمنين أمّ سلمة (34) و عبد اللّه بن عباس (35) ، و أبو ذرّ الغفاري (36) ، وأنس بن مالك (37) ، و عمران بن حصين (38).
وكان ذلك شائعا و مشهورا في عصر رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) :
قال أبو ذرّ: ما كنّا نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم اللّه و رسوله و التخلّف عن الصّلوات و البغض لعليّ بن أبي طالب (39).
وقال أبو سعيد الخدري: إنّا كنّا لنعرف المنافقين- نحن معاشر الأنصار- ببغضهم عليّ بن أبي طالب (40).
وقال عبد اللّه بن عبّاس: إنّا كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) ببغضهم عليّ بن أبي طالب (41).
وقال جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ: ما كنّا نعرف المنافقين إلّا ببغض عليّ بن أبي طالب (42).
لهذا كلّه و لقول رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) في حقّ الإمام عليّ (عليه السلام):
«اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه» (43) .
فهم يحتاطون في أخذ معالم دينهم من صحابيّ عادى عليّا و لم يواله، حذرا من أن يكون الصحابيّ من المنافقين الّذين لا يعلمهم إلّا اللّه.
الفصل الثالث : خلاصة بحث الصحابة لدى المدرستين :
الصحابي وعدالته في مدرسة الخلفاء الصحابي في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) :
الصّحابيّ وعدالته في مدرسة الخلافة :
ترى مدرسة الخلفاء أنّ الصحابيّ من لقي النبيّ( صلى الله عليه [ واله ] ) مؤمنا به، و لو ساعة من نهار، و مات على الإسلام.
وأنّه لم يبق بمكّة و الطائف أحد سنة عشر إلّا أسلم و شهد مع النبي( صلى الله عليه [ واله ] ) حجّة الوداع.
وأنّه لم يبق في الأوس و الخزرج أحد في آخر عهد النبيّ( صلى الله عليه [ واله ] ) إلّا دخل في الإسلام.
وأنّهم (كانوا في الفتوح لا يؤمّرون إلّا الصحابة) و بهذه القاعدة عدّوا جمعا في عداد الصّحابة ممّن برهنّا في كتابنا (خمسون ومائة صحابيّ مختلق) أنّهم مختلقون و لم يكن لهم وجود في التاريخ.
وترى أنّ جميع الصّحابة عدول لا يتطرق إليهم الجرح، و من انتقص أحدا منهم فهو من الزنادقة، ثمّ يلتزمون بصحّة كلّ ما رواه من سمّي في اصطلاحهم بالصحابيّ، و يأخذون من جميعهم معالم دينهم.
الصحابيّ في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) :
ترى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) أن لفظ الصحابيّ ليس مصطلحا شرعيّا، و إنّما شأنه شأن سائر مفردات اللّغة العربية، و(الصاحب) في لغة العرب بمعنى الملازم و المعاشر و لا يقال إلّا لمن كثرت ملازمته، و الصّحبة نسبة بين اثنين، و لذلك لا يستعمل الصاحب و جمعه الأصحاب و الصحابة في الكلام إلّا مضافا، كما ورد في القرآن الكريم { يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ} [يوسف: 39] و {أَصْحَابُ مُوسَى} [الشعراء: 61] . وكذلك كان يستعمل في عصر الرسول( صلى الله عليه [ واله ] ) و يقال: صاحب رسول اللّه، و أصحاب رسول اللّه، مضافا إلى رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) أو مضافا إلى غيره، مثل قولهم (أصحاب الصّفّة) لمن كانوا يسكنون صفّة مسجد الرسول( صلى الله عليه [ واله ] ) ثمّ استعمل الصحابيّ بعد رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) بلا مضاف إليه و قصد به أصحاب رسول اللّه ( صلى الله عليه [ واله ] ) وصار اسما لهم، وعلى هذا فإنّ (الصحابي) و (الصحابة) من اصطلاح المتشرّعة و تسمية المسلمين و ليس اصطلاحا شرعيّا.
أمّا عدالتهم؛ فإنّ مدرسة أهل البيت ترى، تبعا للقرآن الكريم، أنّ في الصّحابة منافقين مردوا على النفاق، و رموا فراش رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) بالإفك، و حاولوا اغتيال رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) و أخبر عنهم الرسول أنّهم يوم القيامة يختلجون دون رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) فينادي: أصيحابي أصيحابي ، فيقال له:
إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم.
وأنّ منهم مؤمنين أثنى اللّه عليهم و الرسول( صلى الله عليه [ واله ] ) في أحاديثه، و أنّهم المقصودون في ما ورد من الثناء في القرآن و الحديث، و قد عيّن النبيّ( صلى الله عليه [ واله ] ) العلامة الفارقة بين المؤمن و المنافق: حبّ الإمام عليّ و بغضه، و من ثمّ فإنّهم ينظرون في حال الراوي فإن كان ممّن قاتل الإمام عليّا أو الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) وعاداهم فإنّهم لا يلتزمون بأخذ ما يروي أمثال هؤلاء، صحابيا كان أو غير صحابيّ.
__________________
(1) الإصابة 1/ 10.
وهذا القول بمدرسة الخلفاء هو مصدر الشهيد الثاني حين قال في كتابه الدراية؛ الباب الرابع في بعض المصطلحات في أسماء الرجال وطبقاتهم : (الصحابيّ) من لقي النبيّ مؤمنا به و مات على الإسلام.
(2) المصدر السابق ص 16 و قبله ص 13.
(3) راجع لسان العرب، مادة:( صحب).
(4) راجع لسان العرب، مادة:( صحب).
(5) مفردات الراغب، مادة:( صحب).
(6) مفردات الراغب، مادة:( صحب).
(7) مفردات الراغب، مادة:( صحب).
(8) الإصابة 1/ 13.
(9) الطبري ط. أوربا، 1/ 2151.
(10) الطبري ط: أوربا، 1/ 2457- 2458.
(11) راجع ترجمة سيف في أول الجزء الأول من كتاب عبد اللّه بن سبأ.
(12) راجع مخطوطة( رواة مختلقون) للمؤلّف و كتاب عبد اللّه بن سبأ ط. بيروت سنة 1403 ه 1/ 117.
(13) الأغاني، ط. ساسي، 14/ 158.
(14) الأفحج: من تدانت صدور قدميه و تباعد عقباه. و الأجلح: الّذي انحسر شعره عن جانبي رأسه. و الأمعر: قليل الشعر.
(15) قضاعة: قبائل كبيرة، منهم قبائل حيدان و بهراء و بلى و جهينة، ترجمتهم في جمهرة أنساب ابن حزم ص 440- 460. و كانت ديارهم في الشحر ثمّ في نجران ثمّ في الشّام، فكان لهم ملك ما بين الشام و الحجاز إلى العراق، راجع مادة قضاعة، معجم قبائل العرب 3/ 957.
(16) الأغاني، ط. ساسي 14/ 157، و أوجزه ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص 284.
(17) ترجمته في الإصابة 2/ 496- 498، و الأغاني، ط. ساسي 15/ 56، و قصة تنافر علقمة و عامر في الأغاني 15/ 50- 55، و في جمهرة ابن حزم ص 284.
(18) وقعت منافرة بين علقمة و عامر ذكرها الأخباريون ، قال في الأغاني، ط. ساسي 15/ 50: انّ علقمة كان قاعدا ذات يوم يبول، فبصر به عامر، فقال: لم أر كاليوم عورة رجل أقبح ....
فقال علقمة: أما و اللّه ما وثبت على جاراتها و لا تنازل كناتها، يعرض بعامر ....
فقال عامر: و اللّه لأنا أكرم منك حسبا و أثبت منك نسبا ....
فقال علقمة: لأنا خير منك ليلا و نهارا.
فقال عامر: لأنا أحبّ إلى نسائك- إلى آخر القصة، في الأغاني، و ترجمة علقمة في الإصابة.
قال المؤلف:
ولذلك أنف علقمة من أن يكرم لأنه ابن عمّ عامر و يشتهر ذلك عنه.
(19) حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة و مزارع. معجم البلدان 2/ 358.
(20) هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327 ه، و كتابه هذا( تقدمة المعرفة لكتاب الجرح و التعديل) ط. حيدر آباد سنة 1371 ه، نقلنا ما أوردناه من ص 7- 9 منه.
(21) أنّ مدرسة الخلافة منعت نشر حديث الرسول وخاصة كتابته إلى رأس المائة من الهجرة!
(22) الاستيعاب فى أسماء الاصحاب للحافظ المحدث أبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البرّ النمري القرطبى المالكي( 368- 463 ه).
(23) أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم الجزريّ المعروف بابن الأثير( ت: 630 ه)، 1/ 3.
(24) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجر( 773- 852 ه) و قد رجعنا إلى ط. المكتبة التجارية سنة 1358 ه بمصر، 1/ 17- 22.
(25) الإصابة 1/ 18. و أبو زرعة: هو عبيد اللّه بن عبد الكريم بن يزيد. قال ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 536 الترجمة 1479: إمام حافظ ثقة مشهور من الطبقة الحادية عشرة من الرواة. مات سنة أربع وستّين ومأتين ، و روى عنه من أصحاب الصحاح مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة.
أقول: لست أدري ما ذا يقول الإمام أبو زرعة في حقّ المنافقين من أصحاب رسول اللّه(صلى الله عليه السلام).
(26) راجع خبر بيعة الشجرة بيعة الرضوان في مغازي الواقدي ص 604. و إمتاع الاسماع للمقريزي ص 291.
(27) إشارة إلى قصة الإفك التي نزلت في شأنها الآيات 11- 17 من سورة النور في براءة أمّ المؤمنين عائشة عمّا رميت به كما روتها هي، أو في براءة مارية عما رميت به على قول غيرها، كما في الجزء الثاني من أحاديث أمّ المؤمنين عائشة.
(28) مسند أحمد 5/ 390 و 453. و راجع صحيح مسلم 8/ 122- 123، باب صفات المنافقين. و مجمع الزوائد 1/ 110 و 6/ 195. ومغازي الواقدي 3/ 1042. و إمتاع الأسماع للمقريزي ص 477، و في تفسير : {وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا} [التوبة: 74] بتفسير الدر المنثور للسيوطي 3/ 258- 259.
(29) ورد في أحاديث الشيعة أنّ ذلك كان عند مرجعه من حجّة الوداع و بمناسبة واقعة غدير خم بأرض الجحفة. راجع البحار، ط. المكتبة الإسلامية بطهران سنة 1392 ه، 28/ 97
(30) صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، باب و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلمّا توفيتني، و كتاب الأنبياء، باب و اتّخذ اللّه إبراهيم خليلا. و الترمذي، أبواب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحشر، و تفسير سورة طه.
(31) البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، 4/ 95، وراجع كتاب الفتن، باب ما جاء في قول اللّه تعالى : {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } [الأنفال: 25] . وابن ماجة، كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، ح 5830. و راجع مسند أحمد 1/ 453 و 3/ 28 و 5/ 48.
(32) صحيح مسلم كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا، 4/ 1800 ح 40.
(33) الإمام علي ابن عمّ الرسول أبي طالب بن عبد المطّلب: ولد في جوف الكعبة، كما رواه الحاكم في المستدرك 3/ 483، والمالكي في الفصول المهمة. وابن المغازلي الشافعي( ت:
483 هـ ) في المناقب، ح 3 ص 7. والشبلنجي في نور الأبصار ص 96. و كانت ولادته في 13 رجب سنة ثلاثين من عام الفيل. و بايعه المهاجرون و الأنصار سنة 35 ه. و ضربه ابن ملجم المرادي ليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان سنة 40 للهجرة في محراب مسجد الكوفة، و توفّي في يوم 21 منه. روى عنه أصحاب الصحاح 536 حديثا. راجع ترجمته في الاستيعاب وأسد الغابة و الإصابة و ص 276 من جوامع السيرة.
وروايته في المنافقين في صحيح مسلم 1/ 61، باب الدليل على أنّ حبّ الأنصار و عليّ من الإيمان و بغضهم من علامات النفاق. و صحيح الترمذي 13/ 177، باب مناقب عليّ. و سنن ابن ماجة الباب الحادي عشر من مقدمته. و سنن النسائي 2/ 271، باب علامة المؤمن و باب علامة المنافق كتاب الإيمان و شرائعه و خصائص النسائي ص 38. و مسند أحمد 1/ 84 و 95 و 128. و تاريخ بغداد 2/ 255 و 8/ 417، و 16/ 426. و حلية الأولياء لأبي نعيم 4/ 185 و قال: حديث صحيح متّفق عليه. و تاريخ الإسلام للذهبي 2/ 198. و تاريخ ابن كثير 7/ 354، وبترجمته في كلّ من الاستيعاب 2/ 461 و أسد الغابة 4/ 292. و كنز العمّال 15/ 105. والرياض النضرة 2/ 284. و المناقب لابن المغازلي، ح 225، ص 190.
(34) أمّ سلمة هند ابنة أبي أميّة بن المغيرة القرشي المخزومي: كانت قبل رسول اللّه( ص) عند أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، أسلما قديما و هاجرا إلى الحبشة ثمّ إلى المدينة. و لمّا جرح أبو سلمة بأحد و توفّي سنة ثلاث من الهجرة، تزوّجها رسول اللّه و كانت مصبية، و توفّيت بعد قتل الحسين سنة إحدى و ستين. روى عنها أصحاب الصحاح 378 حديثا. راجع ترجمتها و ترجمة زوجها بأسد الغابة، و جوامع السيرة، ص 276، و تقريب التهذيب، 2/ 617.
وحديثها في شأن المنافقين في سنن الترمذي 13/ 168. و مسند أحمد 6/ 292. و الاستيعاب 2/ 460، بطرق متعددة. و تاريخ ابن كثير 7/ 354. و كنز العمّال ط. الأولى 6/ 158.
(35) عبد اللّه ابن عمّ النبيّ العباس بن عبد المطّلب، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، و توفّي سنة ثمان و ستّين بالطائف، و روى عنه أصحاب الصحاح 1660 حديثا. ترجمته بأسد الغابة- الإصابة و جوامع السيرة ص 276.
(36) أبو ذرّ جندب أو بريد بن جنادة أو عبد اللّه أو السكن أو غير ذلك: تقدم إسلامه و تأخّرت هجرته، فشهد ما بعد بدر من غزوات رسول اللّه. توفّي منفيّا بالربذة سنة اثنتين و ثلاثين من الهجرة. روى عنه أصحاب الصحاح 281 حديثا. ترجمته في التقريب 2/ 420. و جوامع السيرة ص 277. و الجزء الثاني من عبد اللّه بن سبأ.
(37) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي: روى هو أنه خدم النبيّ عشر سنين، كان يخلق ذراعيه بخلوق للمعة بياض كانت به، و كان ذلك من دعاء الإمام عليّ عليه لكتمانه الشهادة بحديث الغدير أن يضربه اللّه بيضاء لا تواريها العمامة، أشار إليه في الأعلاق النفيسة ص 122، و تفصيله بشرح نهج البلاغة 4/ 388، و توفي في البصرة بعد التسعين. روى عنه أصحاب الصحاح 2286 حديثا. ترجمته بأسد الغابة. و التقريب. و جوامع السيرة ص 276. و روايته في شأن المنافقين بكنز العمال ط. الأولى 7/ 140.
(38) أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي الكعبي: أسلم عام خيبر، و صحب الرسول و قضى بالكوفة، و توفّي بالبصرة سنة 52. روى عنه أصحاب الصّحاح 180 حديثا. و روايته بشأن المنافقين بكنز العمّال، ط. الأولى 7/ 140. ترجمته في التقريب 2/ 72. و جوامع السيرة ص 277.
(39) مستدرك الصحيحين 3/ 129. و كنز العمال 15/ 91
(40) أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الخدري: شهد الخندق و ما بعدها. مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستّين و قيل: سنة أربع و سبعين. و روى عنه أصحاب الصحاح 1170 حديثا. ترجمته بأسد الغابة 2/ 289، و التقريب 1/ 289. و جوامع السيرة ص 276. و حديثه في شأن المنافقين في صحيح الترمذي 13/ 167. و حلية أبي نعيم 6/ 284.
(41) في تاريخ بغداد 3/ 153، قال: كانوا عند ابن مسعود فتلا ابن عباس : {يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: 29]. قال: على بن أبي طالب. ثمّ قال: إنّا كنّا نعرف- الحديث.
(42) جابر بن عبد اللّه بن عمرو الأنصاري السلمي: صحابيّ ابن صحابيّ، شهد بيعة العقبة مع أبيه، و شهد 17 غزوة مع النبيّ و صفّين مع الإمام عليّ، و مات بالمدينة بعد السبعين.
روى عنه أصحاب الصحاح 1540 حديثا. ترجمته بأسد الغابة 1/ 256- 257. و التقريب 1/ 122. و جوامع السيرة ص 276. و روايته في شأن المنافقين في الاستيعاب 2/ 464.
والرياض النضرة 2/ 284. و في تاريخ الذهبي 2/ 198 و لفظه:( ما كنّا نعرف منافقي هذه الأمّة). وفي مجمع الزوائد 9/ 133 و لفظه:( ما كنّا نعرف منافقينا معشر الأنصار ...).
(43) سنن الترمذي 13/ 165 باب مناقب علي. و سنن ابن ماجة باب فضل عليّ، الحديث المرقم 116. و خصائص النسائي ص 4 و 30. و مسند أحمد 1/ 84 و 88 و 118 و 119 و 152 و 330 و 4/ 281 و 368 و 370 و 372 و 5/ 307 و 347 و 350 و 358 و 361 و 366 و 419 و 568. و مستدرك الصحيحين 2/ 129 و 3/ 9. و الرياض النضرة 2/ 222- 225.
وتاريخ بغداد 7/ 377 و 8/ 290 و 12/ 343. و مصادر أخرى كثيرة.



|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تقيم حفلاً بذكرى عيد الغدير الأغر
|
|
|