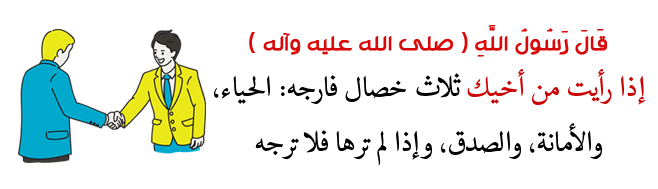
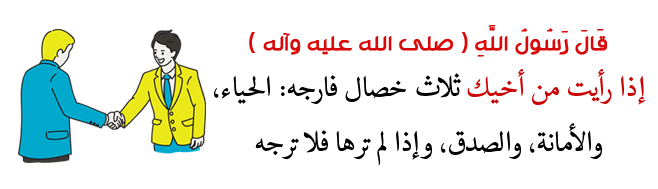

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 26-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
|
اتّفق أكثر العقلاء على امتناع تعلّق التكليف بالمعدوم ، وخالف الأشاعرة وصرّحوا بأنّ المعدوم مكلّف (1). ولا بدّ من تحرير محلّ النزاع ، والإشارة إلى ما هو الحقّ.
فنقول : يتصوّر هاهنا صور :
الأولى : أن يكون المراد من تكليف المعدوم تكليفه تنجيزا ، بأن يطلب منه الفعل في حالة العدم ، ولا ريب في بطلانه ؛ فإنّ الفهم لو كان شرطا للتكليف ، فالوجود أولى بذلك.
والظاهر أنّ الأشعري أيضا لم يقل به.
الثانية : أن يكون المراد منه تكليفه في حالة الوجود ، بأن لا يكون التكاليف الشرعيّة متعلّقة بالمعدوم في حالة عدمه ، بل إذا صار موجودا وحصل فيه شرائط التكليف حدث تعلّقها به ، وعلى هذا لم يتوجّه على المعدوم شيء ، لا تنجيز التكليف ، ولا التعلّق العقلي. وإطلاق تكليف المعدوم على ذلك بناء (2) على أنّه لمّا استمرّ الأمر الأزلي إلى زمان وجوده وصار بعد الوجود داخلا تحته ، فكان للأمر المذكور علاقة ما به في حال عدمه أيضا.
وغير خفيّ أنّ هذا لا ضير فيه ؛ لأنّ بناءه على أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الموجودين الحاضرين بأنّ كلّ معدوم يوجد ، فيكلّفه الله بما كلّفكم ، فالأوامر الإلهيّة لم تتعلّق بالمعدومين مطلقا ، ولكن لمّا علم الله أنّه يوجد المعدومين ، فأخبر الأنبياء بأن يخبروا الموجودين بأنّ من يوجد يكون مكلّفا بما يتضمّن هذه الأوامر ، فيحدث تعلّق الأمر بكلّ أحد بعد وجوده بخبر النبيّ. وهذا ممّا نقول به ، ولكنّ الإطلاق المذكور على ذلك غير مناسب ، والتعليل المذكور غير صالح لتصحيحه ، ومراد الأشاعرة أيضا ليس هذا.
الثالثة : أن يكون المراد منه التعلّق العقليّ ، وهو أنّ المعدوم الذي علم الله في الأزل أنّه يوجد فيما لا يزال قد تعلّق به التكليف الذي يفعله إذا وجد وحصل فيه شرائط التكليف ، وعلى هذا يتعلّق التكليف بالمعدوم ، إلاّ أنّه ليس تعلّقا تنجيزيّا.
واورد عليه : بأنّ مطلق التعلّق يتوقّف على متعلّق موجود ؛ لأنّ الإضافة تتوقّف على المضاف إليه (3).
واجيب : بأنّ المتعلّق هو الموجود العلمي ؛ فإنّ ما تعلّق به التكليف وإن كان معدوما في الخارج، إلاّ أنّه موجود في علم الله ، فتعلّق به التكليف تعلّقا علميّا ، وإذا وجد في الخارج يتعلّق به تعلّقا تنجيزيّا. وهذا هو مراد الأشاعرة (4).
واحتجّوا أمّا أوّلا : فبأنّ كلامه أزلي ، وإلاّ لزم قيام الحوادث (5) بذاتها ، ومن جملة كلامه الأمر والنهي ، وكلّ منهما تكليف ، فيكون التكليف أزليّا. ومن اللوازم الذاتيّة للتكليف التعلّق ؛ لعدم تحقّقه بدونه ، فيكون التعلّق أيضا أزليّا ، ولا يتصوّر ذلك إلاّ بأن يتعلّق التكليف بالمعدوم (6).
وغير خفيّ أنّ كون الكلام عندهم أزليّا بناء (7) على ما ذهبوا إليه من إثبات الكلام النفسي ، وهو باطل عندنا ، بل الكلام مؤلّف من الحروف وهو حادث ، وليس قائما بذاته حتّى يلزم ما ذكر. وقد حقّق ذلك في محلّه.
وأمّا ثانيا : فبأنّا مكلّفون بأوامر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مع كوننا معدومين في حالة أمره (8).
واجيب : بأنّه يحدث تعلّقها بنا (9) بخبر النبيّ إذا وجدنا كما تقدّم. فكلّ موجود وإن دخل تحت الأوامر الصادرة عند عدمه ، إلاّ أنّ تعلّقها به لم يكن عند عدمه ، بل بعد وجوده ؛ فإنّ الآمر إذا علم وجود شخص فيما بعد ، وأراد في وقت عدمه أن يأمره بشيء عند وجوده ، ولم يكن في غرضه تعلّق الأمر به في حالة عدمه ، يجوز أن يأمره به مطلقا من غير تقييد ، كأمر الرجل ولده الذي أيقن من طريق بأنّه سيولد بتعلّم إحدى الصناعات (10).
هذا ، مع أنّ تعلّق التكليف بالمعدوم لا يترتّب عليه فائدة وإن كان له وجود علمي ، وصدور أمر لم يكن فيه فائدة قبيح من الحكيم.
والقول بأنّه يترتّب عليه الفائدة بعد زمان ، أي حالة وجوده ، وهو كاف لخروجه عن القبح مع إمكان ترتّب فائدة على التعلّق في حالة العدم أيضا وإن لم نعلمها (11) ، ضعيف جدّا ، كما لا يخفى.
ثمّ لمّا عرفت أنّ كلامه تعالى ليس أزليّا ، فلا يكون فرق بين أوامره تعالى وخطابات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في شمولها للمعدومين وعدمه. وكيفيّة التفريع أيضا في الجميع واحدة.
وقد وقع الخلاف في شمول خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وآله للمعدومين. وللمجوّزين حجج يمكن إجراؤها فيما نحن فيه. وسيجيئ تحقيقه مع كيفيّة التفريع.
____________
(1) وممّن صرّح به الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 202.
(2) خبر لإطلاق.
(3) راجع : المحصول 2 : 255 ـ 259 ، وتهذيب الوصول : 117 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 202.
(4) راجع : المحصول 2 : 255 ـ 259 ، وتهذيب الوصول : 117 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 202.
(5) في « ب » : « الحادث ».
(6) راجع : المحصول 2 : 255 ـ 259 ، وتهذيب الوصول : 117 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 202.
(7) خبر.
(8) تقدّم تخريجها آنفا.
(9) في « ب » : « بها بناء ».
(10) تقدّم تخريجهما آنفا.
(11) تقدّم تخريجها آنفا.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|