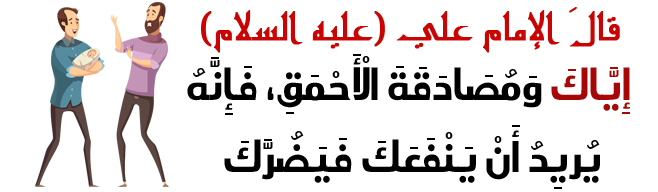
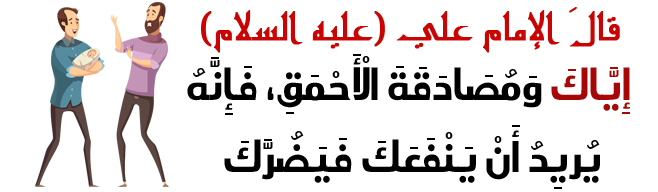

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
|
...قبل الخوض في المرام ينبغي بيان كون المسألة من المسائل الفقهية أو الاصولية أو الكلامية أو أنها من المبادئ الأحكامية؟ كما أنه بناء على [كونها] من المسائل الاصولية هل هي من المباحث العقلية أو اللفظية أو القواعد الكلية التي أمر تطبيقها بيد المجتهد؟.
أقول: قد يتوهم من ظاهر العنوان كونه من المسائل الفقهية وان ذكرها في المقام استطرادي محض لمجرد مناسبته لمدلول الأمر من الوجوب الثابت للشيء بصيغة الأمر أو مادته، واورد عليه: بان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة والصوم وغيرها والبحث عن عنوان المقدمة [غير] المنطبق على شيء مخصوص لا يتكفله علم الفقه.
وفيه: ان كثيرا من القواعد - الاصطيادية وغيرها من القواعد الفقهية - مع أن موضوعها بنفسها ليس عنوانا مخصوصا بل كان موضوعها مرآة للعناوين المخصوصة مثل قاعدة (كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) الشامل للمعاوضات وعقود الضمانات كالقرض وغيرها إذ عنوان ما يضمن في مثلها جعل مرآة إلى نحوى الضمان وما هو موضوع الحكم في كل باب شيء غير الآخر.
ومثل قاعدة الطهارة المعلوم كون موضوعها مرآة للعناوين الخاصة كموضوع قاعدة (كل ما لاقى نجسا فهو نجس) الذي هو أيضا مرآة لعناوين اخرى، ومنها أيضا قاعدة مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب والسنة بناء على أن المراد مخالفة [مضمونها] الحاكية عن امور مختلفة وموارد متفاوته، وحينئذ الأولى جعل المدار في فقهية المسألة اشتمالها على محمول خاص ثابت للعناوين المخصوصة ولو بتوسيط عنوان آخر مرآة لها، إذ حينئذ ما من مسألة فقهية إلا وشأنها ذلك، ولا يرد حينئذ النقوض السابقة أيضا، وحينئذ ربما يكفي هذا المقدار أيضا لإخراج مسألتنا هذه عن المسائل الفقهية إذ مضافا إلى مرآتية موضوعها للعناوين بخصوصية اخرى كان محمولها أيضا مرآة لأحكام خاصة ناشئة عن مناطات مخصوصة علاوة عن اختلافها بحسب المرتبة من الشدة والضعف، بل ولئن الحق بالوجوب باقي الأحكام الخمسة بوحدة المناط كان اختلاف المحمول في المسألة أوضح، وبهذه الملاحظة لا [تتناسب] هذه المسألة مع المسائل الفقهية، كما أن المهم من هذه المسألة اثبات وجوب المقدمة من ناحية وجوب ذيها وان كان وجوب ذيها ثابتا بالأدلة اللبية فلا يناسب جعلها من مباحث الألفاظ إذ لا خصوصية للفظ في هذه الجهة من الكلام، وارجاع هذا العنوان إلى البحث عن الملازمة بين الوجوبين أيضا غير وجيه فلا وجه لإدراجها في المسائل العقلية [غير] المستقلة ومجرد تلازم العنوانين لا يقتضي ارجاع أحدهما إلى الآخر بل لابد في كل عنوان ملاحظة دخوله في أي مسألة. وبهذه الجهة لا وجه لإرجاعها إلى البحث عن المبادئ الأحكامية وان [كان] لا يخلو عن مناسبة.
بل ومن هذه البيانات ظهر أيضا عدم مناسبة مثل هذا العنوان مع كون [المسألة] كلامية كما عرفت من أن مدار ميزان المسألة من أي [المسائل] على ملاحظة نفس العنوان لا على ملاحظة لازمه من حيث التحسين والتقبيح خصوصا مع عدم درك العقل في الباب حسن المقدمة إلا بتوسيط وجوبه [و] وجوب ذيه والا فلا يستقل العقل بحسن ذيه لولا الوجوب فضلا عن حسن مقدمته، وحينئذ فلا يناسب للمقام إلا بجعلها من القواعد الواقعة في طريق حكم كلي فرعي كوجوب عنوان خاص احرزت [مقدميته] بتوسيط هذه الكبرى، بل في كثير من المصاديق الكلية لا يكون امر تطبيقها الا بيد المجتهد فقط نظير مقدمية الوضوء وغيرها.
نعم قد يكون مثل هذه المسألة منتجا لحكم جزئي أيضا ولكن لا يضر ذلك بأصوليته في موارد تطبيق هذه القاعدة على العناوين الكلية المنتجة لحكم كلي. كما [أنه] بعد هذه النتيجة لا يضر بأصوليته عدم اختصاص المجتهد أحيانا بتطبيقه أيضا، وبالجملة لا نعني بالمسألة الاصولية إلا القواعد الواقعة في طريق استنباط حكم كلي لموضوع كلي كما لا يخفى فتدبر جيدا.
وبعدما ظهر ذلك ينبغي في المقام طي امور:
منها: أن مناط المقدمية التي هي محط البحث في المقام هو تقدم الشيء وجودا على غيره [ورتبة] بحيث يرى العقل بين وجوديهما تخلل فاء وأنه وجد فوجد، وحينئذ يخرج باب التلازم الصادق وجودهما معا بلا تخلل الفاء بينهما عن مركز البحث، كما أن باب الطبيعي وأفراده [المتحدين] وجودا أيضا خارج عن هذا العنوان، فتوهم مقدمية الفرد للكلي ليس في محله.
ومنه تقدم الجزء على الكل بالماهية والتجوهر، إذ مثل هذا التقدم أيضا لا يقتضي تخلل الفاء بين وجوديهما، فمثل هذا التقدم أيضا خارج عن مركز البحث كما سنشير إليه أيضا في الأمر الآتي ان شاء الله، بل ربما نقول بخروج التقدم الطبيعي بين الشيئين أيضا عن مركز البحث كالواحد بالإضافة إلى الاثنين.
ومنه أيضا حدوث الشيء بالإضافة إلى بقائه إذ في أمثال ذلك لا يرى العقل وجودين بينهما تخلل فاء وما هو مورد الكلام هو ذلك، كيف؟! ولو فرض وجوب للاثنين لا يترشح منه وجوب آخر للواحد في ضمنه، كيف؟! ولازمه اجتماع المثلين كما سنشير، فلا محيص من كون مركز الوجوب الآخر وجود آخر وهو لا يكون الا بما ذكرنا كما لا يخفى.
ومنها: تقسيمهم المقدمة [إلى] الداخلية والخارجية:
والغرض من الداخلية اجزاء المركبات، والظاهر ان المقصود من المركبات أيضا المركبات الخارجية الاعتبارية، كيف؟ والمركبات العقلية لا جزء لها إلا في موطن العقل وعالم التحليل، وهو خارج عن مصب الوجوب الغيري إذ لا وجود لها بوصف جزئيتها إلا في الذهن [غير] القابل لتوجه الايجاب الغيري المستتبع لامتثال مستقل خارجا، بل في الخارج لا يكون إلا وجودا واحدا محضا كما هو ظاهر، وهكذا الأمر في المركبات الحقيقية الخارجية كتركب الأجسام من العناصر فان الأجزاء المحفوظة فيها لم [تبق] على حقيقتها الأولية بل بتلاقي كل واحد بالآخر انخلعت منها صورتها الأولى وحصلت للمجموع صورة اخرى فانقلبت شيئيتها [إلى] شيئية اخرى، فلها أيضا وجود واحد خارجي بلا وجود لأجزائها في الخارج، فخرجت الأجزاء المزبورة أيضا عن مصب الأحكام الغيرية القابلة لتوجه الوجوب الغيري المستتبع لامتثاله مستقلا قبال وجوبها النفسي، وحينئذ لا مجال لتوهم ادخالها في حريم النزاع، فما هو قابل لإدخالها في حريمه هي المركبات الاعتبارية التي كان لكل جزء منها وجود مستقل غير وجود الآخر خارجا غاية الأمر [شملتها] وحدة اعتبارية من قبل وحدة عارضها من الهيئة المخصوصة كالسرير أو أثرها المخصوص بملاحظة تأثيرها في أمر خاص كمحركية أيادي متعددة لحجر واحد، إذ حينئذ كان مجال توهم ان كل جزء بملاحظة وجوده مستقلا في الخارج يصلح أن يترشح إليها وجوب غيري قبال الوجوب النفسي العارض لمجموعها، وان الفرق بين الجزء والكل حينئذ بصرف اعتبار الانضمام في الكل دونه. فالأجزاء عبارة عن وجود كل واحد لا بشرط الانضمام، والكل عبارة عن الوجودات الزبورة بشرط الانضمام.
والى مثل هذا البيان أيضا نظر من قال في الفرق بين الكل والجزء بأن الأجزاء مأخوذة لا بشرط والكل مأخوذ بشرط شيء، وفي جملة من الكلمات المنسوبة إلى المحققين جعل الفرق بين الكل والاجزاء بأخذ الجزء بشرط لا والكل بشرط شيء، والظاهر أن مراده من بشرط لا صرف ملاحظته في قبال الغير لا ملاحظته مقيدا بعدم ضم الغير إليه كيف! وهو لا يجتمع مع الكل في الوجود مع أن الكل حاو لأجزائه ويستحيل ان يفارق الجزء لكله وجودا خارجيا فلا معنى لأخذها بشرط لا إلا بالمعنى الذي نحن أشرنا إليه الذي هو قابل للاجتماع مع غيره.
وفي قبال هذ الاعتبار اعتبار كل جزء لا بشرط الراجع إلى ملاحظة ذاته بنفسه لا في قبال الغير وبهذه الملاحظة قابل لحمل كل جزء على الآخر وحمل كل واحد على الكل. وهذا المعنى من لا بشرط أيضا غير معنى اللا بشرطية من حيث الانضمام الذي أشرنا إليه سابقا إذ مثل هذا الاعتبار أيضا لا يصحح الحمل المزبور.
وعلى أي حال كل واحد من هذه التعابير ناظر إلى جهة غير جهة اخرى، نعم اعتبار الجزء بشرط لا من حيث الانضمام بالغير كما توهم في التقريرات المنسوبة إلى شيخنا الأعظم في غاية السخافة كما أشرنا ولا أظن صدوره من خريط هذه الصناعة.
وبالجملة كلماتهم مشحونة في مقام الفرق بين الجزء والكل بما ذكرنا، وعلى أي حال من المسلمات عند الكل أن الكل في الوجود الخارجي متحد مع وجود أجزائه ولذا يقال بأن الكل عين الأجزاء بالأسر غاية الأمر يدعى تقدم الأجزاء على الكل بالماهية وبالتجوهر وهو لا ينافي وحدة وجودهما خارجا.
وحينئذ نقول: مع فرض تعلق الوجوب النفسي بهذه الوجودات لا يبقى مجال لتعلق الوجوب الغيري من قبل هذا الوجوب بها إذ الوجود الواحد [لا يحتمل] الوجوبين، وتوهم التأكد في مثل المقام غلط إذ الوجوب الغيري معلول الوجوب النفسي ومتأخر عنه بمقدار تخلل الفاء الحاصل بين العلة والمعلول وهذا الفاء مانع عن اتحاد وجودهما ولو بالتأكد كما أن التقدم بالماهية والتجوهر محضا يمنع كونه مناط ترشح الوجوب بل العقل لا يرى مناطه إلا التقدم خارجا ووجودا.
وحينئذ لا مجال لتوهم ادخال الاجزاء في مركز البحث أصلا، ثم ان ذلك أيضا بناء على ممشى القوم في المقام من تعلق الوجوب النفسي بالمركب والكل المحفوظة كليته وتركبه في المرتبة السابقة عن الوجوب، ولكن لنا في المقام مسلك آخر [لا تنتهي] النوبة بناء عليه إلى ما أشرنا سابقا.
وتوضيح المرام بأن يقال أنه لا شبهة في أن تركب الواجب بما هو واجب وارتباط أجزائه بالآخر في عالم الامتثال وقصده فرع وحدة الوجوب المتعلق بالمتكثرات بلا دخل في ساير الوحدات الطارية على الشيء من عارض خارجي مثل هيئة خارجية وأشكال مخصوصة حاصلة من اضافات بعضها ببعض باتصالها أو انفصالها في جهة تركب الواجب من حيث واجبيته. كيف! ولو فرض تعدد الوجوب المتعلق بكل واحد من الوجودات الموجودة تحت هذه الهيئة لا تكاد [تتصور] حينئذ انتزاع تركب الواجب عنه بل كل واحد من هذه الوجودات واجب مستقل في قبال الآخر ولو كان تحت هيئة مخصوصة دخيلا في تعلق الوجوب بها، ويشهد له أن قصد امتثال كل واحد بما هو واجب ضمني أو غيري حينئذ تشريع محرم غاية الأمر اعتبار كونها تحت هذه الهيئة أوجب تلازم امتثالها خارجا ولكن مجرد ذلك لا يخرج كل واحد عن كونه واجبا مستقلا غير مرتبط في عالم واجبيته بالآخر، وذلك أيضا في فرض دخل الهيئة المخصوصة في تعلق الوجوب بالمتكثرات تحتها بنحو الشرطية أو الشطرية، والا فلو فرض قيام المصلحة بنفس الذوات على الاطلاق بلا دخل للهيئة الخاصة في المصلحة فيصير الوجوب حينئذ [قائما] بنفس المتكثرات بلا دخل لمثل هذه الهيئة فيها.
وفي هذه الصورة لا يكاد يتصور في متعلق الوجوب بما هو كذلك جهة وحدة وارتباط غير الارتباط الناشئ من قبل وحدة وجوبها بحيث لو فرض تعدد وجوبها واستقلال كل واحد بوجوبه لما كانت إلا [واجبات] مستقلة بلا ارتباط بينها في عالم واجبيتها. وحينئذ لا يكاد [يتعلق] الوجوب إلا بالذوات المتكثرة بلا جهة وحدة في معروضه. كيف! والوحدة الناشئة من قبل وحدة الوجوب والارتباط الجائي من قبله يستحيل أخذها في معروضه والمفروض عدم أخذ وحدة اخرى في متعلق وجوبه ولو فرض أخذها فيه أيضا لا دخل لهذه الوحدة في الارتباط في الواجب بما هو واجب بشهادة فرض تعدد وجوب كل واحد مقيدا بهذه الوحدة كما أسلفناه. وحينئذ أين كل [واحد] ارتباطي مأخوذ في متعلق الوجوب وموضوعه كي ينازع بأن جزء الواجب هل واجب غيري بمناط المقدمية أم لا، بل اعتبار الكلية والجزئية بما هو واجب إنما هو في الرتبة المتأخرة عن الوجوب وفي هذه الرتبة لا يكون وجوب، وفي رتبه كان له وجوب ليس هنا صقع الكلية والجزئية كي يصير مركز البحث والقيل والقال في وجوب جزء الواجب كما لا يخفى.
فان قلت: لو تعلق الوجوب الواحد بمتكثرات تحت هيئة واحدة مثل السرير وأمثاله أو الهيئات المخصوصة بأشكال من المسدس والمربع وغيرها في فرض دخل الهيئة المخصوصة في الواجب فقهرا يكون هذا الواحد المتشكل بشكل مخصوص [ذا] أجزاء مرتبطة في رتبة سابقة عن تعلق الوجوب بها ففي هذه الصورة يبقى مجال البحث في أن جزء هذا الواحد المتشكل المعروض للوجوب واجب بوجوب غيري ام لا، فنظر [المتنازعين] في وجوب المقدمات الداخلية إلى أمثال هذا الفرض وهذه الصور.
قلت: بعد فرض عدم دخل هذه الجهة من الوحدة في تركب الواجب بما هو واجب بشهادة فرض تعدد الوجوب لكل واحد من الذوات مع الهيئة القائمة بها نقول: إنه مع فرض تعدد الوجوبات فهل متعلق الوجوبات إلا ذوات [كل واحد] مع هيئتها في عرض واحد بلا اعتبار مقدمية لأجزاء هذا الواحد الخارجي لواجب مركب منها؟
بل غاية ما في الباب حينئذ مقدمية بعض الواجبات لواجب آخر نظرا إلى مقدمية معروضات الهيئة من الذوات للهيئة التي هي أيضا واجب مستقل في عرض وجوب البقية وذلك غير مرتبط بمقدمية الجزء للكل إذ لا يتصور حينئذ تركب وكلية للواجب كما هو ظاهر فكذلك نقول أيضا: إنه لو فرض تعلق وجوب واحد بعين ما تعقلت الوجوبات المتعددة به لابد ان يقال: ان معروض هذا الوجوب الواحد أيضا كل واحد من الذوات في عرض وجوب الهيئة بلا جهة ارتباط في جهة وجوبه إلا وحدة وجوبه نظرا إلى عرضية الجميع في عالم عروض الوجوب فإذا [كان] في [عروض] الوجوب على الجميع عرضية محضة فأين مقدمية شيء لشيء بالنسبة إلى معروض الوجوب بما هو معروضه، ومجرد جزئية الذوات للمركب من حيث الشكل والهيئة لا يوجب جزئيتها لما هو واجب مركب في رتبة سابقة عن وجوبه كما هو ظاهر.
نعم غاية ما في الباب أيضا مقدمية بعض الواجبات الضمنية على واجب ضمني آخر نظير ما فرضنا مقدمية بعض الواجبات المستقلة على بعض في فرض تعدد الوجوب من دون فرق بينهما من تلك الجهة، نعم غاية الفرق بينهما ان هذه المقدمية في فرض تعدد الوجوب يكون موجبا لترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى مقدمته ونتيجته تأكد وجوبه كما هو الشأن في كل واجب نفسي مقدمة لواجب نفسي آخر، ولكن في صورة وحدة الوجوب [لا تصلح] هذه المقدمية ان [تصير] مناط ترشح الوجوب عن ذي المقدمة إلى مقدمته لأن الوجوب الغيري الناشيء عما هو متحد مع وجوبه يستحيل قبوله للتأكد كما انه يستحيل اجتماع الوجوبين أيضا في محل واحد والله العالم.
وبالجملة نقول إنه بعد فرض انتزاع تركب الواجب من وحدة وجوب المتكثرات يستحيل حينئذ تعلق الوجوب بالمركب والكل بما هو مركب اعتباري وكل، بل صقع الكلية والجزئية في المرتبة المتأخرة عن وحدة الوجوب المنشأ لاعتبار الارتباط بين المتكثرات ولذا اشتهر في الأحكام الوضعية انتزاع الجزئية عن الوجوب ومن المعلوم أن لازمه انتزاع الكلية أيضا منه كيف والجزئية والكلية متضايفان منتزعان عن الشيء في رتبة واحدة فمع التزام انتزاع الكلية المساوق للتركب عن الوجوب فلا يكون في الرتبة السابقة اعتبار تركب وكلية بل ليس في هذه المرتبة إلا متكثرات تحت هيئة واحدة قابلة لتعلق وجوب واحد بها فيصير مركبا أو وجوبات متعددة فيصير واجبات متعددة بلا وحدة واجب ولا تركبه.
وحينئذ فمع الالتزام بتأخر صقع الكلية والجزئية رتبة عن وجوب الشيء كيف يبقى له مجال البحث في المقام بأن الوجوب إذا تعلق بالمركب فأجزاؤه الداخلية تحت بحث وجوب المقدمة إذ حينئذ لنا ان نقول: أين مركب اعتباري تعلق به الوجوب كي يبقى المجال للبحث المزبور فتدبر في المقام فانه من مزال الأقدام.
ومنها: تقسيمهم المقدمة [إلى العقلية] والشرعية والعادية:
وقيل بإرجاع الجميع إلى العقليّة وهو كذلك لو كان النّظر في كلّ واحد بعد الفراغ عن مرحلة الإناطة التي هي مناط المقدّمية، وإلاّ فلا شبهة في اختلاف المقامات بالإضافة إلى هذه المرحلة لأنه ربما يكون إناطة أحد الوجودين بالآخر ذاتيا بحيث لو عرض على العقل يرى بينهما الترتّب، وأخرى يكون الإناطة بجعل شرعي ففي مثل هذا الفرض لا يرى العقل بنفسه بينهما إناطة وانّما يرى الإناطة بينهما من ناحية الشرع، وثالثة لا يرى الإناطة المزبورة إلاّ من جهة اقتضاء العادة، وفي الأخير أيضا تارة [تكون] العادة بمثابة لا ينفك عن الإناطة المزبورة دائما وأخرى ينفك عنه أحيانا.
وبهذه الملاحظة أمكن دعوى اختلاف المقدّمات في الانتساب إلى العقل و الشرع و العادة بمناط اختلافهم في مناط المقدّمية الّذي هو جهة إناطة أحدهما بالآخر.
ثمّ لا إشكال في دخول المقدّمات العقليّة والشرعيّة والعاديّة بالمعنى الأوّل في حرم النزاع فيصير مقدّمية نصب السلّم من قبيل المقدّمات العاديّة لكونه على السطح قبال الطهارة التي [تكون] من المقدّمات الشرعيّة و[تحصيل] الماء الّذي هو من المقدّمات العقليّة.
وامّا المقدمات العاديّة بالمعنى الثاني كاعتياده بحركة قبل صلاته مثلا ففي دخوله في حريم النزاع بحث ربما يجزم بخروجه عن مركز البحث، إذ المدار في المقدميّة على اقتضاء انتفاء ذيه وهذا المعنى لا يكاد يتحقّق في مثله غاية الأمر يدخل ذلك في باب المقدميّة الغالبيّة لا مطلقا وهو أجنبيّ عن محلّ الكلام فتدبّر.
ومنها: تقسيمهم المقدّمات إلى المقتضي والشرط وعدم المانع والمعدّ:
ومنشأ هذا التقسيم أيضا ليس إلاّ بلحاظ اختلاف المقدّمات في أنحاء دخلها في وجود ذيها بعد اشتراك الجميع في أصل الدخل الموجب لانتفاء ذيها بانتفائها.
وتوضيح الحال في هذا المقام بأن يقال:
إنّ المقدّمة تارة كان شأنها إعطاء وجود ذيها بحيث يخرج وجود ذيها من كمونه.
وتارة ليس شأنها ذلك بل كان شأنها تحديد دائرة الوجود بنحو يكون بهذا الحدّ قابلا للتحقّق خارجا أو قابلا للتأثير في المقصود و مرجع هذا النحو من الدخل ليس إلى تأثير المقدّمة في وجود شيء لعدم كون الحدّ من سنخ الوجود بل مرجعه إلى تضييق دائرة الوجود بحدّ يكون بذلك الحدّ قابلا للتحقّق خارجا أو قابلا للتأثير في الغرض المقصود.
والحدّ مثل هذا الحد روحه يرجع إلى انتهاء الوجود واتّصاله بالعدم فلا يكون وجودا ولا عدما بل نحو اتصال بينهما ويعبّر عنه بشرّ التركيب وهو أيضا لا يخلو عن مسامحة إذ ليس الحدّ مركّبا منهما بل عبارة عن انتهاء كلّ منهما بالآخر.
ولئن شئت فعبّر عنه بنحو إضافة و اتصال بين الوجود والعدم لا وجود ولا عدم.
نعم له واقعيّة كالوجود في الخارج ولذا لا يكون موجودا ولا معدوما بل بنفسه كالوجود في الخارج غاية الأمر يتبعه.
ثمّ إنّ هذا الحد تارة ذاتيّ لوجود خاصّ وأخرى عرضيّ بمعنى انّه يلاحظ من وجود الشيء مقدارا منه على قيام استعداد التأثير في هذا المقدار وربّما يقاس المقدار المزبور بمقارنته لشيء أو بسبقه به أو لحوقه بحيث يكون مثل هذه الاعتبارات من مقدّرات الوجود بنحو ينحصر استعداد التأثير فيه و في مثله قهرا يستند الأثر إلى أصل وجوده، و حدّه إلى مقداره.
وعليه ربّما تكون التحديدات القياسيّة- كان- لطرف إضافاتها دخل في حدّ الأثر أو في حدّ المؤثّرية.
وبديهي انّ هذا الدخل ليس خللا تأثيريّا- بل هو نحو من الدخل وطور من الارتباط الّذي ليس شأن وجودها إعطاء الوجود بل ليس شأنها إلاّ التحديد الموجب للقابليّة على نحو لا يعلّل كما لا يخفى وبهذه العناية يقال بأنّ شأن أمثال هذه المقدّمات ليس إلاّ إعطاء القابليّة للمعلول وجودا أم تأثيرا.
وممّا يوضح هذه الجهة ملاحظة الشرائط الشرعيّة الصادرة عن العالم بالواقعيّات في تحديد موضوعات حكمه بمقدار قابليتها للتأثير في أغراضه إذ ترى فيها تحديد موضوعه بكونه في حال كذا وبوصف كذا.
ومعلوم أنّ مرجعه إلى تقييد الموضوع بأمور يكون طرف الإضافة لموضوعه الموجب لإناطة الموضوع به وهذه الإناطة ما جاءت إلاّ من جهة دخل المنوط به في الإضافة المزبورة المقدّرة للوجود بكذا مقدار.
وليس شأنه إعطاء وجود الموضوع. كيف! وما به انوجاده ليس إلاّ إرادة المكلّف أو شيء آخر بل تمام شأنه إعطاء تقييد مخرج له عن سعة وجوده وكان محدّدا له.
وإلى ذلك نظر ما اشتهر في الشرط بأنّ التقيّد به داخل في الموضوع دون القيد قبال الجزء الداخل فيه القيد بنفسه ومرجعه إلى ما ذكرنا بأنّ الشرط ممّا به تقييد الشيء وهذا نحو من الدخل وطور من الإناطة الأجنبي عن دخل المؤثّر في الوجود في متأثّره بل غاية دخله إعطاء حدّ فيه به كان قابلا للتأثير و يكون بنحو من العناية دخيلا في قابلية الموضوع في تأثيره.
و لئن شئت قلت كان دخيلا في قابلية الموضوع بما هو موضوع للإنوجاد أيضا.
ثمّ انّ المحدود المزبور إن كان وجوديّا يسمّى شرطا وان كان عدميّا يسمّى وجوده مانعا، وان كان باجتماعهما يسمّى معدّا كالإقدام.
وبهذه الملاحظة ربما يفرق تعريف الشرط وأمثاله مع المقتضي حيث صحّ أن يقال في المقتضي فانّه مما يوجب وجوده وجود معلوله ولو في المحل القابل ولا يصحّ هذا المعنى في الشرط وأمثاله بل لا يصدق فيها إلاّ كونها ممّا يلزم من عدمها عدم المعلول.
ولئن شئت فعبّر فيها بأنها مما يلزم من وجودها قابلية المعلول للإنوجاد ولو لملاحظة دخلها في تحديده بحدّ يكون بذلك الحدّ قابلا له كما أشرنا.
ومن هذا البيان ظهر مطلب آخر وهو أنّ المعلول إذا كان وجودا محدودا كان لحقيقته جهتان أحدهما حيث وجوده والآخر جهة حدّه وتقييده.
ومن المعلوم أنّ جهة الحد والتقيّد قائمتان بحيث الوجود ومعلوم أنّ حيث وجوده مستند إلى المقتضي، وحدّه إلى شرطه أو عدم مانعه.
وحينئذ لجهة وجوده نحو أوّلية يوجب أولويته على جهة حدّه في انتسابه وجودا وعدما إليه.
ولذا اشتهر اسناد عدم المعلول إلى عدم المقتضي حتّى مع وجود المانع بلا اسناد إليه أصلا مع أنّهما جزءان من العلّة بنحو لا يتخلّل بين المعلول وكلّ واحد منهما إلاّ فاء واحد فاصل بين الوجود والموجد والحدّ والمحدّد و لكن هذا المقدار لا يتنافى مع اختلافهما في أصل الدخل و يكون أحد الدخلين في طول الآخر حسب طوليّة الحيثيتين [المحفوظة] في معلولهما الموجب لأولوية استناد المعلول إلى المقتضي وجودا وعدما.
ومن التأمّل فيما ذكرنا أيضا ظهر مطلب آخر وهو ان فيما كان دخله في المعلول من باب التأثير في وجود المعلول كالمقتضي فلا محيص من أن يكون مقارنا زمانا مع المعلول ولا يعقل تقدّمه عنه ولا تأخّره لانتهاء كلّ منهما إلى انفكاك المؤثّر الفعلي عن المتأثّر والعقل يأبى عنه و لذا اشتهر عدم انفكاك العلّة بهذا المعنى عن المعلول زمانا وان اختلفا رتبة بمقدار تخلّل فاء عقلا.
وأمّا ما كان دخله من باب كونه ممّا به الحدّ والتقييد فلا يأبى العقل عن تقدّم ما به قوام حدّ الشيء وتقييده عن الشيء زمانا بل عن تأخيرهما أيضا عن المشروط بحسب الزمان إذ الإضافة إلى الأمور المتقدمة زمانا أو المتأخّرة كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار.
وعمدة ما يختلج في الأذهان في استنكاره الشرائط المتأخّرة توهّمه لزوم مقاربة العلّة بجميع [أجزائها] مع المعلول و هذا المعنى في غاية المتانة بالنسبة إلى أجزاء العلّة الموجدة التي شأنها إعطاء الوجود للمعلول و هو منحصر بالمقتضيات و أمّا بقية أجزاء العلّة المصطلحة التي منها عدم المانع فهي خارجة عن دائرة إعطاء الوجود بل شأنها ليس إلاّ إعطاء القابليّة للمعلول في الإنوجاد.
ولقد تقدّم أنّ مرجع إعطاء القابليّة فيه إلى كونها طرف إضافة لشيء يكون الشيء متحدّدا و مقدّرا به وخارجا عن سعته بنحو يكون بهذا الحدّ قابلا للإنوجاد وفي مثل هذا المعنى لا يأبى العقل عن تقدّمه زمانا أو تأخّره.
ومن العجب عمّن بالغ في إنكار الشرائط المتأخّرة زمانا حيث يكون عمدة تشبثه في مدّعاه بجعل الشرط متمّما للمقتضي في التأثير فلنا حق السؤال بأنه ما المراد من التتميم فان كان الغرض كونه من أجزاء معطيات الوجود فلازمه إرجاع الشرائط طرّا إلى أجزاء المقتضي و هو كما ترى.
ثمّ لازمه إنكار مقدّمية عدم المانع لو كان مناط المقدّمية منحصرا بذلك لعدم تصوّر التأثير و التأثّر بين الوجود والعدم.
وان كان الغرض معنى آخر غير ما ذكر وغير ما أشرنا إليه من الدخل في القابلية بالبيان السابق [فعليه] البيان.
وأظرف من ذلك تعبيرهم الآخر من كون الشرط موصلا لتأثير المقتضي إلى المقتضى وأنّ المؤثّر خصوص المقتضي فهذا البيان أكثر إجمالا من البيان الأوّل إذ مرجع الموصليّة ان كان إلى تأثير الشرط في اتصال الأثر عن المقتضي فهو صرف لفظ لا مفهوم له إذ لا فصل بين المقتضي ومقتضاه كي تحتاج إلى سبب الإيصال فلا محيص من عوده إلى دخل الشرط في أصل التأثير فيعود إلى ما ذكرنا من دخله في قابليّة المحل للإنوجاد من قبل مؤثّره وحينئذ نقول إنّه خرج كليّة باب الشرط عن عالم المؤثّرية وبعد ذلك لا يأبى العقل عن تقدّمه أو تأخّره زمانا عن المشروط كما أسلفناه.
وبالجملة نقول إنّه لا واسطة بين عنوان التأثير في الوجود المعبّر عنه بالموجديّة و بين عنوان تحديد الوجود بحدّ قابل للإنوجاد أو التأثير في المقصود المعبّر عنه بإعطاء القابليّة للإنوجاد و ما يأبى العقل عن تقدّمه أو تأخّره هو الأوّل دون الأخير و لا يتصوّر في البين شق ثالث يجري عليه حكم الموجديّة و ما في كلماتهم من التعابير المزبورة لا يكون إلاّ من باب إعمال نحو من العناية في معطيات القابلية لا انّ غرضهم بيان معنى ثالث خارجا عنهما فلا يغرّنّك حينئذ مثل هذه البيانات لإثبات كون الشرائط أيضا بحكم معطيات الوجود في عدم التقدّم والتأخّر كما لا يخفى.
ثمّ انّ [لأستاذنا] العلاّمة طاب ثراه في المقام كلاما آخر وهو انّ بعد ما التزم بلزوم تقارن أجزاء العلّة بجميعها حتّى الشرائط وعدم الموانع مع المعلول التزم في الأحكام بصحّة الشرط [المتأخر] بإرجاع الشرط إلى وجودها العلمي لا الخارجي والغرض من وجودها العلمي أيضا وجوداتها التصوريّة في عالم الجعل فلا يتنافى مع إرجاع القضايا الشرعيّة إلى القضايا الحقيقيّة الراجعة إلى جعل الحكم منوطا بوجود موضوعه خارجا.
غاية الأمر يدّعى انّ الجاعل في مقام جعله تارة يتصوّر الموضوع أو الحكم منوطا بوجود الشيء سابقا وأخرى متأخّرا كتصوّره منوطا به مقارنا فجعل تصوّر الحكم المجعول أو موضوعه شرط جعله فجعله حينئذ منوط بتصوّر الموضوع أو حكمه لا مجعوله.
نعم لو ارجع العلم إلى شرط المجعول من الحكم أو الموضوع فلا محيص من إرادته العلم التصديقيّ بهما وحينئذ [تخرج] القضيّة عن القضايا الحقيقيّة ويدخل في الخارجيّة حيث إن في القضايا الخارجيّة لا يصلح الحكم من الحاكم إلاّ في طرف جزمه بالتطبيق وذلك هو عمدة الفارق بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة كما لا يخفى.
وأظنّ [أنّ] من راجع كلماته يرى منها ما شرحناه ولا يبقى مجال ردّه بأنّ ما أفيد مبنيّ على خلط القضايا الحقيقيّة بالخارجيّة وانّ كلامه مبنيّ على جعل القضايا الشرعيّة من الخارجيّة مع أنّ كليّة القضايا في العلوم ليست إلاّ من القضايا الحقيقيّة.
وأضعف من ذلك توهّم اقتضاء القضيّة الحقيقيّة إناطة الحكم بوجود موضوعه خارجا وحينئذ يستحيل مجيء الحكم قبل وجود موضوعه بعد إرجاع شرائط الحكم إلى الموضوع طرّا.
وتوضيح الضعف انّه بعد تسليم جميع ما ذكر نقول إنّ الموضوع تارة مقيّد بأمر مقارن مع حكم ذاته و أخرى متقدّم عنه زمانا وثالثة متأخّر عنه كذلك.
فتارة يكون الموضوع المستطيع الظاهر في جري المشتق بلحاظ حال الحكم وتارة الموضوع من استطاع قبل ظرف الحكم وثالثة من يستطيع بعد ظرف الحكم.
فلا شبهة أنّ في جميع هذه الصور ما هو موجود في ظرف الحكم هو ذاته المقيّد بأحد القيود و هو الّذي يستحيل وجود الحكم بدونه واما قيده الخارج عن الموضوع مع دخول تقييده فيه فلا يلزم ان يكون موجودا في ظرف الحكم إلاّ إذا فرض أخذه فيه بنحو المقارنة وحينئذ من أين [تقتضي] القضايا الحقيقيّة استحالة الشرط المتأخّر وحينئذ لا يستأهل أستاذنا الطعن بمثل هذا البيان.
نعم الّذي يصلح لأن يورد عليه هو انّ الجعل تعبديّا لا بدّ وان يكون على وفق المصلحة ففي صورة لحاظ الأمر المتأخّر مقدّمة لجعله فمثل هذا اللحاظ وان كان بنفسه مقدّمة الجعل ولكن بالإضافة إلى المصلحة الداعية على الجعل المزبور لا محيص أن يكون طريقا إلى دخل القيد بوجوده المتأخّر في مصلحة بحيث لو لا وجوده فيما بعد لا يكون العمل [ذا] مصلحة.
وعليه فلا محيص له إلاّ من التزامه بصلاحية الأمر المتأخّر بوجوده الخارجي في المصلحة الفعليّة كيف وبدونه لا يصلح مجيء الجعل بتصوّره أيضا ومع التزامه بذلك لا يبقى مجال تصديقه بلزوم مقارنة اجزاء العلّة خارجا وإرجاع الشرائط المتأخّرة في باب الأحكام إلى شرطيّة وجودها العلمي كي لا ينخرم قاعدة مقارنة أجزاء العلّة مع المعلول.
وكيف كان نقول بعد إخراج الشرائط وجوديّة أم عدميّة عن عالم المؤثّر في الوجود و إرجاعها جميعا إلى محدّدات الوجود و مقيّداتها لا يبقى مجال لإنكار الشرائط المتأخّرة في الوجودات الخارجيّة أيضا فضلا عن الأمورات الجعليّة الكافي في جعلها تصوّر المجعول [بحدوده] الخارجيّة.
بل قيل بأنه ربّما ينتهي الأمر في المجعولات الاعتباريّة إلى توهّم تقدّم المعلول على [علته نظير] جعل الملكيّة- السابقة عن زمان جعله- منوطا بإجازة المالك بناء على كون أمثالها من الاعتباريات المحضة، ففي مثل هذه الصورة ربما يتراءى تقدّم الملكية التي هي معلول جعله على نفس الجعل ولكن حيث لا يكون في البين تأثير وتأثّر بل غاية الأمر كون الجعل المخصوص منشأ اعتبار للمجعول الخاصّ فلا يأبى العقل بعدم المنتزع عن منشأ انتزاعه كما أنّه ربّما يتأخّر عنه كما في العقود التعليقيّة ومن هذه الجهة ربّما يكون أمره أهون من الشرائط في الأمور الواقعيّة.
نعم ما هو منها هو إناطة الجعل بإجازة المالك و لو من جهة دخلها في مصلحة الجعل وفي هذا المقام ربّما كان الشرط مقارنا مع مشروطه لا متأخّرا.
وحينئذ فابتناء هذه المسألة على تصحيح الشرائط المتأخّرة في الواقعيّات لا يخلو عن خلط كما لا يخفى.
وحينئذ فالكشف المشهوري في باب الإجازة غير مرتبط بمرحلة الشرائط المتأخّرة في الأمور الواقعيّة.
نعم ما هو من بابها هو الكشف المنسوب إلى صاحب الفصول من كون الإجازة شرطا [متأخّرا] لجعل الملكية من حين العقد بحيث يكون ظرف الجعل هو حين العقد السابق على الإجازة وهذا المعنى بمعزل عن كلمات المشهور في باب الكشف والنقل للإجازة فراجع إليه.
ولقد اختاره شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه في مكاسبه حيث أبطل كشف الفصول وارجع الكلمات إلى الكشف بالمعنى الأول المنسوب إلى المشهور.
ولكن في إيراده عليه [بزعم] كون أمثاله هذه الأمور الجعليّة بالنسبة إلى مناشئها من باب التأثير والتأثّر كمال المناقشة ولا ضير فيه.
نعم لا بأس بناء على كون أمثال الملكية من قبيل الملازمات الواقعيّة لا الاعتباريّة المحضة كما أشرنا إليه في باب الوضع فتدبّر.
[تتميم فيه تحقيق]
وهو انّه بعد ما عرفت اختلاف أنحاء الدخل في المقدّمات لك أن تقول باختلاف مناط ترشّح الطلب الغيري ولازمه اعتبار نحو اختلاف وميز في الوجوبات الغيريّة بملاحظة اختلاف مناطها وحينئذ يلحظ كلّ واحد من هذه المناطات من حيث قيامها بواحد أو بمتعدّد وبتبعه يعتبر في وجوبه أيضا كذلك.
وحينئذ يرفع بهذا البيان إشكال مشهور آخر في جعلهم- في باب المقدّمة- بعضها واجبا واحدا مركبا وبعضها غير مركّب كما ترى في غسل الأحداث والأخباث بناء على اعتبار التعدّد.
وملخّص الإشكال هو أنّ مناط المقدمية ان كان يترتّب وجود المعلول عليه مستقلا فهذا المعنى غير صادق على الغسلين وان كان المناط بترتّب العدم على العدم فهذا المعنى صادق على واحد من أجزاء الوضوء أيضا فما وجه التفكيك بين هذه الاجزاء مع غسل الأخباث؟.
وحلّ ذلك ليس إلاّ بما ذكرنا من البيان.
وربما أجابوا عن هذه الشبهات بأنّ اختلاف نحوي الوجوب بكيفيّة النّظر إلى الجميع منضما أو منفردا و لقد عرفت أنّ النّظر باختلافه لا يصلح لتغيير الواجب عمّا هو عليه من الوجوب فراجع إلى بحث اجزاء المركّب فتدبّر.
ومنها تقسيمها إلى مقدّمة وجوب و مقدّمة واجب:
وحيث إنّ الوجوب في الأوّل منوط بوجودها يستحيل تأثيره في إيجادها إذ نتيجة التأثير كون الوجود [المتأثّر] مرئيّا في الرتبة المتأخّرة عنه وهذا المعنى لا يناسب مقدّمية الوجوب المرئي في الرتبة السابقة على الوجوب كما لا يخفى.
ولذا اشتهر بأنّ الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه.
وحينئذ فما هو داخل في حريم النزاع هو القسم الثاني من مقدّمة الواجب من دون فرق في ذلك أيضا بين أنحاء المقدّمة من المقتضي أم غيره نعم لو كان المقتضي من سنخ الإرادة ربّما يكون خارجا عن دائرة الوجوب الشرعي وان كان تحت إلزام العقل بإيجاده.
وعمدة النكتة في ذلك هو انّ إرادة المكلّف يرى من شئون الخطاب نفسيّا أم غيريّا نظير دعوته فلا يعقل ان يقع موضوع نفسه كما أوضحناه في بحث الدواعي القربيّة.
وبعبارة أخرى انّ شأن الخطابات نفسيّة أو غيريّة احداث الدواعي والإرادة نحو متعلّقاتها فلا جرم يكون مثل هذه الشئون من معاليلها وتبعاتها وخارجة عن موضوعاتها فلا مجال في مثلها إلاّ إبقاؤها تحت إلزام العقل بإحداثها مقدّمة لإطاعة الخطابات من دون أن يكون موضوعا لها، وحيث ظهر مثل هذه الجهة فنقول.
انّه لا إشكال في بقيّة مقدّمات الواجب المطلق إذ جميعها قابلة لتوجه الخطاب إليها ولو غيريّا و لذا كانت داخلة تحت حريم النزاع في وجوبها غيريّا.
نعم على القول بعدم وجوبها الغيري لا مجال لتوهّم توجّه الخطاب النفسيّ نحوها أيضا إذ الخطابات طرّا لا يتوجّه إلاّ إلى موضوعاتها ومن المعلوم انّ مقدّمات الموضوعات طرّا خارجة عنها وإلاّ فيصير جزء لها وهو خلاف مقدّميتها الناشئة عن ترتّب أحد الوجودين على الآخر، ولقد أوضحنا شطرا منها في باب أجزاء المركّب عند دفع توهّم وجوبها بمناط المقدّمية فراجع.



|
|
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|