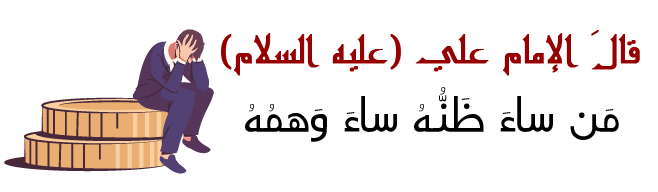
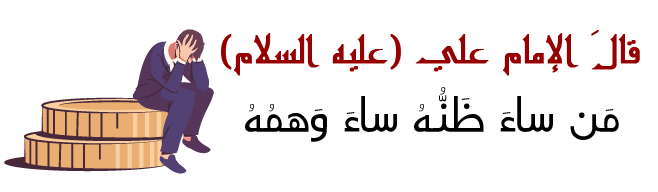

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2014
التاريخ: 20-11-2014
التاريخ: 6-08-2015
التاريخ: 1-12-2018
|
وفيه مباحث:
أ- في حقيقته وأقسامه:
وهو: «بعث من يجب طاعته ابتداءً على ما فيه مشقّة من فعلٍ أو ترك».
فبقيد الابتداء خرج النبيّ والإمام وغيرهما مّمن تجب طاعته، وبقيد المشقّة خرج ما لا مشقّة فيه كالنكاح المُسْتلذّ، واشتراط الإعلام لا أرى دخوله في حقيقته بل في شرائطه.
وينقسم إلى اعتقاد وعمل، والأوّل ينقسم إلى علم عقليّ كالمعرفة باللَّه، وشرعيّ كالعبادات، وإلى ظنّ كالقِبلة.
والثاني: إمّا عقليّ كردّ الوديعة وشكر المنعم والإنصاف وترك الظلم من الواجبات، والتفضّل وحسن المعاشرة من المندوبات.
وإمّا شرعيّ كفعل العبادات الخَمس وغيرها مّما لا يستقلّ العقل بدركه.
ب- في شرائطه:
وهي إمّا راجعة إلى الربّ، وهي كونه عالماً بصفات الأفعال وإلّا لجاز عليه الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن، وبمقدار الثواب وإلّا لأوصل بعض الحقّ فيكون ظلماً، وكونه قادراً على إيصال المستحقّ لما قلناه، وكونه لا يخلّ بالواجب وإلّا لجاز الإخلال ببعض المستحقّ أو بكلّه.
وإمّا راجعة إلى العبد، وهي كونه قادراً على ما كُلّفَ به، وكونه عالماً به أو إمكان علمه، تمكّنه من الشرائط والآلات لعدم إمكان الفعل بدون هذه فيكون التكليف حينئذٍ بالمحال.
وإمّا راجعة إلى التكليف نفسه، وهي انتفاء المفسدة أي لا يكون مفسدة للمكلّف في فعل آخر أو لغيره من المكلّفين، وتقدّمه على زمان الفعل قَدَراً يتمكّن فيه من الاستدلال، وكون متعلّقه ممكناً لما تقدّم، واشتماله على صفةٍ تزيد على حسنه.
ج- في حسنه ووجوبه ووجوههما:
فنقول: أمّا الأوّل، فلأنّه فعله تعالى وقد تقدّم انتفاء القبح عنه، ووجه حسنه التعريض للثواب، لأنّه لما خلق العبد وهيأه لاستحقاق الثواب والعقاب، ولم يكن إيصالهما إليه إلّا مع الطاعة أو المعصية، لاشتمال الثواب على التعظيم والعقاب على الإهانة، ولا يمكن إيصالهما إلّا مع الاستحقاق، لأنّ تعظيم من لا يستحق التعظيم وإهانته قبيحان عقلًا وشرعاً، فلم يكونا لايقينِ بالحكمة.
وأمّا الثاني: فلأنّه لولاه لكان مُغرياً بالقبيح، واللازم كالملزوم في البطلان، والملازمة ظاهرة، فإنّه لمّا خلق الانسان وكمل عقله، وخلق فيه شهوةً للقبيح ونفرةً عن الحسن، مع عدم استقلال عقله بمعرفة كثير من الحسن والقبيح فلو لم يقرّر عنده وجوب الواجب ليتمثله ، وحرمة الحرام ليتجنّبه، لكان بفعل ذلك مغرياً.
وأمّا بطلان اللازم: فلأنّ الإغراء بالقبيح قبيح ضرورةً، فإنّ العقلاء كما يذمّون فاعل القبيح فكذا المُغري به، والعلم بُحسن الحسن وقبح القبيح واستحقاق المدح والذمّ عليهما غير كافٍ، فإنّ كثيراً من العقلاء يعلمون ذلك، ويقضون أوطارهم باللذّات القبيحة مستسهلين للذمّ، غير مختلفين للمدح، وقد بان في أثناء ذلك وجه وجوبه.
د- في أحكامه:
1- أنّه عامّ في حق المؤمن والكافر، لأنّ علّة حسنه هي التعريض لذلك وكون الكافر لا ينتفع به لا يقتضي قبحه، لأنّ ذلك بسوء اختياره لوجود التمكين في حقّه، كما في حقّ المؤمن.
2- اتفق الجبائيان على أنّ المؤمن إذا عُلم كفره لا تجب إماتته، لأنّ تكليفه في المستقبل تعريضٌ للثواب فحسن، كالمبتدأ به المعلوم منه الكفر(1).
وقال الخوارزمي(2): بل تجب إماتته، فإنّ بقاءه مفسدةٌ لا تحسن من اللَّه، وفرق بينه وبين التكليف المبتدأ بأنّ المبتدأ لم يحصل منه الغرض، وهو التعريض للثواب، وهذا قد حصل منه الغرض، فلو أبقاه لنقض غرضه(3).
قيل: وفيه قوّة.
واختلفا في وجوب إبقاء الكافر المعلوم إيمانه، فأوجبه أبو علي(4) لما فيه من اللطفيّة، ومنعه أبو هاشم(5) لأنّه تمكين وليس بلطف فلا يكون واجباً، وهذا أقوى.
ويتفرّع على هذا البحث سؤال بعض الأشاعرة إلزاماً: بفرض إخوةٍ ثلاثة وردوا يوم القيامة- صبيّ ومؤمن وكافر- فيقول الصبيّ: لِمَ لا كلّفتني لأصل إلى ثواب أخي المؤمن؟ فيقول اللَّه تعالى: اني علمت أ نّك لو بلغت لكفرت فلهذا أَمَتُّك، فيقول الكافر: يا ربّ لِمَ لا امَتّني قبل البلوغ كالطفل؟ فتنقطع الحجة باعتبار المصلحة.
فيقال في الجواب: إماتة من يُعلم منه الكفر ليست واجبة، فجاز تخصيص بعض الناس بها دون بعض، أو يقال: الإبقاء مطلقاً تفضّل ليس بواجب، أو أنّ تكليف الصبيّ لو حصل ترتّب عليه مفسدة بعض المكلّفين، وهو وجه قبيح، وتكليف الكافر ليس كذلك(6).
3- أنّ التكليف منقطع لوجوه:
الأوّل: الإجماع عليه.
الثاني: أ نّه لولاه لما أمكن إيصال الثواب، والتالي كما تقدّم في البطلان، وبيان الشرطيّة: إنّ التكليف مشقّة، والثواب مشروط بخلوصه عن المشاقّ فالجمع بينهما محال.
الثالث: لولا انقطاعه لزم الإلجاء، وهو باطل، بيان الملازمة: إنّ إيصال الثواب واجب، فإذا علم المكلّف حصول جزاء الطاعة إذا فعلها في تلك الحال، وكذا جزاء المعصية إذا تركها يكون مُجبراً على ذلك، وهو باطل لاشتراط الاستحقاق بصدور الفعل اختياراً، وإلّا فلا فرق بين صدوره وعدمه.
فإن قلت: هذا يُنتقض بالحدود، و بأنّه عليه السلام كان يخيّر الأعراب بين الإسلام والقتل، وهو إلجاء.
قلت: جواب الأوّل بالمنع من كونها مُلجئة، لتجويز العاصي، وعدم الشعور، بخلاف يوم القيامة فإنّ التجويز غير حاصل لما ثبت من علمه بالجزئيّات.
وجواب الثاني: أنّ هذه الصورة حسنة في ابتداء التكليف لا مطلقاً، وحسنها لاشتمالها على مصلحة، وهو الاطلاع على أدلّة الحقّ فيدعو إلى الدخول في الايمان اختياراً فيستحقّ الثواب، بخلاف ما لو بقي على كفره، فإنّه لا يطّلع حينئذٍ عليها، وإسلامه الأوّل لا يستحقّ به ثواباً.
______________
(1) الذخيرة: 140- 141.
(2) هو أبو محمّد محمود بن محمد بن أحمد الخوارزمي أحد أصحاب قاضي القضاة عبد الجبار الهمداني أخذ عنه وظاهر فضله في العلم. راجع كتاب طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضى: 118.
(3) انظر شرح المقاصد 4: 328.
(4) انظر الذخيرة: 140، وأ مّا أبو علي فهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، أبو علي (235- 303هـ) من أئمّة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة «الجبائية». له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبة إلى جبى( من قرى البصرة) اشتهر في البصرة، ودفن بجبى ، له« تفسير» حافل مطول، ردّ عليه الأشعري.( الأعلام للزركلي 6: 256).
(5) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي( 247- 321)، من أبناء أبان مولى عثمان: عالم بالكلام، من كبار المعتزلة. له آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سميت« البهشمية» نسبة إلى كنيته« أبي هاشم» وله مصنفات،« الشامل- خ» في الفقه و« تذكرة العالم» و«العدّة» في أُصول الفقه.( الأعلام للزركلي 4: 7).
(6) انظر المنقذ من التقليد 1: 249- 250.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|