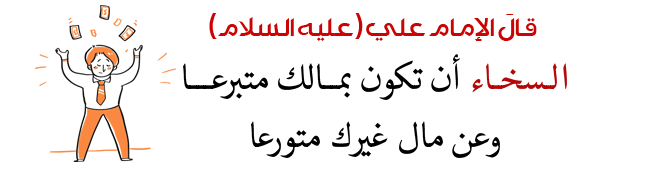
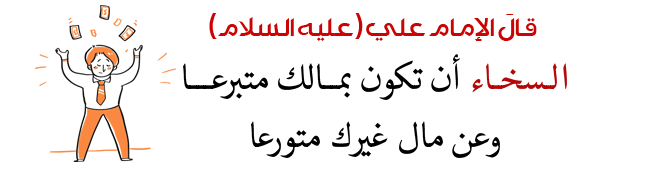

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 26-8-2016
التاريخ: 25-8-2016
|
..الامر بفعل في وقت معين ، هل يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت ـ على تقدير فوات ذلك الفعل في وقته ـ أو لا؟.
فيه مذهبان : الاقتضاء (1) ، وعدمه.
وقوي الاكثر الثاني (2) ، قائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر مجدد ، نحو : ( من نام عن صلاة (3) أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ) (4).
لنا : أن الامر بصوم يوم الخميس ، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى (5) لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في المصلحة ، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة(6) ، دون غيره من الاوقات (7).
احتجوا :
[ أ ] بأن هناك مطلوبين : أحدهما الصوم ، والآخر إيقاعه في يوم الخميس ، فبفوت الثاني لا يسقط الاول ، إذ (8) لا يسقط الميسور بالمعسور (9).
والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره.
[ ب ] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير ، فكذا المأمور به (10).
والجواب : أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله ، لا لرفعه بعده ، وهو معلوم عادة ، والعقل يحكم بأن الغرض (11) في الدين متعلق بإحقاق الحق ، ولا مدخلية للأجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله ، بخلاف المأمور به.
على أنه قياس ، لا نقول به.
هذا ، و (12) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته (13)، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما (14).
فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد ، هو الامر الاول.
وأيضا : إلحاق الفرد المجهول بالأعم الاغلب يوجبه.
ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل ، والله أعلم.
تذنيب : إن أخل المكلف بالفورية ـ بناءاً على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به ذلك؟
على ما اخترناه ـ من أن الامر للفور ـ لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور ، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟ مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه ، ولا على عدمه؟
فيه مذهبان (15) ، والاقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.
لنا : أنا لو خلينا وظاهر الاوامر المطلقة ، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا (16)، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما ، والادلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير ، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد.
والحاصل : أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين : الاول : أدائية (17) الفعل المأمور به في كل وقت ، والثاني : رفع (18) الاثم والحرج بالإتيان به في أي وقت من الاوقات ، وأدلة الفور إنما تقتضي صرفه عن ظاهره في الشيء الثاني دون الاول ، إذ لا منافاة بين الاعتداد بالفعل المأمور به في أي وقت أتى به ، وبين ترتب الاثم على التأخير به ، فلا يجوز صرف الامر عن ظاهره في كلا الشيئين من دون موجب.
ولا يتوهم جريان الدليل في المؤقت ، لأنه لا يقتضي الشيء الاول ، بل ولا الاعتداد بالمأمور به في كل وقت.
نعم ، يبقى الاشكال في الامر المطلق ، إذا علم توقيته بوقت محدود (19) من خطاب آخر ، إذ لا يبعد (20) أن يقال : إن التوقيت مطلقا ظاهر في نفي الادائية والاعتداد به فيما بعد.
والفرق بين الفورية والتوقيت : أن الوقت ـ في التوقيت ـ لابد أن يكون منشأ لمصلحة الفعل ، بخلاف الفورية ، فإن الوقت فيها (21) لا ارتباط له بالفعل ، إلا لأجل أن الفعل الزماني لابد وأن يكون في زمان ، حتى لو أمكن إيقاع الفعل لا في زمان ، لحصل (22) الامتثال.
وكذا يبقى (23) الاشكال فيما يفيد الفور بالأمر الاول ، كأن يقول : ( إفعل معجلا ، أو بسرعة)، فهل يجب الاتيان به فيما بعد وقت الفور حينئذ ، أو لا؟.
أو يقول : ( إفعل ) بناءا على أن الامر بنفسه يفيد الفور.
والاقرب الثاني ، لما مر في المؤقت ، إلا أنه لا يكاد يوجب في الاحكام الشرعية أمر فوري ، إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد.
هذا ، وقد يورد في بعض كتب الاصول في بحث الامر مباحث اخرى ، رأينا عدم إيرادها هنا أولى , إما لان البعض سيجيء ذكره في مباحث الادلة العقلية ، مثل : بحث مقدمة الواجب ، واستلزام الامر بالشيء النهي عن الضد ، وبحث المفاهيم.
وإما لكونه من المسائل الكلامية التي لا تليق بهذه الرسالة ، وإن كانت من المبادئ الفقهية ، مثل: صحة التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرطه ، مع جهل المأمور أو علمه أيضا ، ووجود الواجب الموسع والكفائي ، وامتناع تكليف ما لا يطاق ، وتعلق الامر بالمعدوم ، وتكليف الغافل والمكره ، ونحو ذلك مما يتعلق بمباحث العدل من علم الكلام.
وإما لقلة فائدته ، مثل بحث الواجب التخييري ، وبقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ، وغير ذلك.
_____________
1 ـ ذهب اليه الحنابلة وبعض الفقهاء. كما في : المنتهى : ٩٨.
2 ـ الذريعة : ١ / ١١٦ ، العدة : ١ / ٧٧ ، المستصفى : ٢ / ١١ ، المحصول : ١ / ٣٢٤ ، المعارج : ٧٥ ، تهذيب الوصول : ٣٠.
3 ـ في ط : من نام في وقت صلاة.
4 ـ المستصفى : ٢ / ١١ ، غوالي اللآلي : ١ / ٢٠١ / الفصل التاسع ح ١٧.
5 ـ المنتهى : ٩٨.
6 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : مصلحة.
7 ـ الذريعة : ١ / ١١٧ ، العدة : ١ / ٧٧.
8 ـ كذا في ط : وفي سائر النسخ : ( و) بدل ( اذ ).
9 ـ روى ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا : « لا يترك الميسور بالمعسور» غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ ح ٢٠٥.
10 ـ المستصفى : ٢ / ١١.
11 ـ في ط : الفرض.
12 ـ الواو زيادة من أ.
13 ـ في أ و ط : فواته.
14 ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : ونحوها.
15 ـ الذريعة : ١ / ١٣١ ، معالم الدين : ٥٩.
16 ـ زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وقضاءا.
17 ـ في أ : دائمية.
18 ـ في أ : دفع.
19 ـ في ب : معلوم.
20 ـ في ط : ولا يبعد.
21 ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : فيه.
22 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : يحصل.
23 ـ في ب : لا يبقى.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|