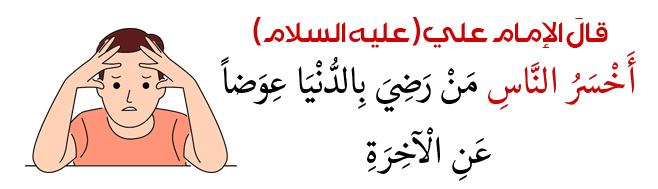
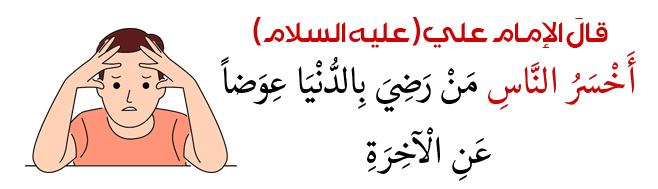
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-04-2015
التاريخ: 22-06-2015
التاريخ: 13-08-2015
التاريخ: 24-06-2015
|
هو حسّان بن ثابت بن المنذر من زيد مناة بن عديّ من بني مالك ابن النجّار؛ والنجار هو تيم اللّه بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. وأم حسان هي الفريعة بنت خالد بن حبيش من الخزرج أيضا. وكان أبوه ثابت وجدّه المنذر من أشراف قومهم والحكّام بين الاوس والخزرج. وكان جدّه خاصة عظيم الكرم محبّا للسلم: لما اختلف الاوس والخزرج بعد يوم سميحة (1) في أمر القتلى والديات، أهدر المنذر ديات قومه الخزرج واحتمل ديات القتلى من الأوس من ماله حرصا على السلم.
ولد حسّان نفسه في يثرب نحو عام 60 ق. ه. (563 م)، ونشأ شاعرا يتكسب بالشعر ويتنقّل بين بلاط جلّق وبلاط الحيرة، وكان إلى الغساسنة أميل. وقد مدح من آل جفنة الغساسنة أولاد الحارث الاعرج (توفي 53 ق. ه. -569 م) وأحفاده. واستمر الغساسنة في برّ حسّان ووصله بالجوائز حتى بعد أن دخل في الاسلام وأضرب عن مدحهم.
ولما هاجر المسلمون من مكّة إلى المدينة دخل حسّان في الاسلام باكرا وانقطع إلى الرسول يمدحه ويرد عنه هجاء المشركين من أمثال عبد اللّه بن الزبعرى وعمرو بن العاص وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلّب. غير انه لم يشهد الغزوات مع الرسول لأنّه كان جبانا.
ولم يكن لحسّان في أيام أبي بكر وعمر نشاط سياسيّ، فلما جاء عثمان عاد له شيء من العصبية الجاهلية وأصبح عثمانيا يمالئ بني أمية على عليّ [عليه السلام]. وقتل عثمان فقال حسّان يشير إلى بني هاشم وإلى عليّ [عليه السلام] خاصة:
يا ليت شعري، ولست الطير تخبرني...ما كان شأن عليّ وابن عفّانا
لتسمعنّ وشيكا في ديارهم... اللّه أكبر، يا ثارات عثمانا
وكذلك كان حسّان خصما لعائشة زوج الرسول، وكان قد غمس لسانه في حديث الافك (5 ه-626 م) منذ أيام الرسول نفسه. ولكنّه عاد فاعتذر إلى عائشة بأبيات منها:
حصان رزان ما تزنّ بريبة...وتصبح غرثى من لحوم الغوافل (2)
وأسنّ حسّان كثيرا ثم عمي في أواخر أيامه، وتوفّي سنة 54 ه (674 م) وقد زادت سنّه على مائة عام.
حسّان بن ثابت من فحول الشعراء، كثير الشعر جيّده. وهو أشعر أهل المدر (3). غير أنه كان في الجاهلية أشعر منه في الاسلام. وعلّل الاصمعيّ ذلك فقال: «الشعر نكد، بابه الشّرّ. فاذا دخل في الخير ضعف. هذا حسّان بن ثابت فحل فحول الجاهلية، فلما جاء الاسلام سقط شعره» (4).
وكانت أغراض شعر حسان في الجاهلية المدح والهجاء القبلي والشخصي، وكان منها الرثاء والخمر والحماسة والفخر والغزل. وظلت هذه الاغراض أغراضه في الاسلام، سوى أنه وقف مدحه على رسول اللّه وقصر هجاءه على المشركين الذين كانوا يتعرضون للرسول وللإسلام بهجائهم (5). واكتسب شعر حسان في الاسلام كثيرا من العذوبة والاخلاص، وكثرت فيه التعابير الاسلامية والاقتباس من القرآن الكريم. وحسان خليق أن يسمّى رأس البديعيين، فهو الذي بدأ فن الشعر في المديح النبوي.
وحسان من الذين أجادوا المديح في الجاهلية وفي الاسلام.
-المختار من شعره:
قال حسان بن ثابت قبل الاسلام يمدح جبلة بن الأيهم (6) آخر ملوك الغساسنة:
للّه درّ عصابة نادمتهم... يوما بجلّق في الزمان الأوّل
يمشون في الحلل المضاعف نسجها... مشي الجمال، إلى الجمال، البزّل (7)
الخالطون فقيرهم بغنيّهم... والمشفقون على الضعيف المرمل (8)
أولاد جفنة حول قبر أبيهم... قبر ابن مارية الكريم المفضل (9)
يغشون حتّى ما تهرّ كلابهم... لا يسألون عن السواد المقبل (10)
يسقون من ورد البريص عليهم... بردى يصفّق بالرحيق السلسل (11)
بيض الوجود كريمة أحسابهم... شمّ الأنوف من الطراز الأوّل
وقال حسان يوم فتح مكّة (8 ه-630 م) يذكر ذلك اليوم ويمدح الرسول ويهجو أبا سفيان بن الحارث. وفي هذه القصيدة وصف للخمر وحماسة:
عفت ذات الاصابع فالجواء... إلى عذراء منزلها خلاء
ومنها:
إذا ما الأشربات ذكرن يوما... فهنّ لطيّب الراح الفداء
نولّيها الملامة ما ألمنا... إذا ما كان مغث أو لحاء (12)
ونشربها فتتركنا ملوكا... وأسدا ما ينهنهها اللقاء (13)
عدمنا خيلنا إن لم تروها... تثير النقع موعدها كداء (14)
ينازعن الأعنّة مصغيات... على أكتافها الأسل الظماء (15)
تظلّ جيادنا متمطّرات... تلطّمهنّ بالخمر النساء (16)
فإمّا تعرضوا عنّا اعتمرنا... وكان الفتح وانكشف الغطاء (17)
وإلاّ فاصبروا لجلاد يوم ...يعزّ اللّه فيه من يشاء
ألا أبلغ أبا سفيان عنّي ...مغلغلة فقد برح الخفاء
بأنّ سيوفنا تركتك عبدا... وعبد الدار سادتها الإماء (18)
هجوت محمّدا، وأجبت عنه... وعند اللّه في ذاك الجزاء (19)
أ تهجوه ولست له بكفؤ... فشرّكما لخيركما الفداء
هجوت مباركا برّا حنيفا... أمين اللّه شيمته الوفاء (20)
أمن يهجو رسول اللّه منكم... ويمدحه وينصره سواء
فإنّ أبي ووالده (21) وعرضي... لعرض محمّد منكم وقاء
في سنة 9 ه (630 م) وفد بنو تميم على الرسول في المدينة، بعد أن كان الاسلام قد عم في بلاد العرب وفتحت مكة نفسها في العام السابق. وكان بنو تميم يعتدّون بعددهم وبقوتهم ووجاهتهم في العرب. فلما دخلوا على الرسول قالوا له: «يا محمّد، جئنا نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا». قال: «قد أذنت لخطيبكم». فقام عطارد بن حاجب فخطب مفتخرا بتميم فردّ عليه من المسلمين ثابت بن قيس. ثم قام الزبرقان بن بدر شاعر بني تميم فأنشد قصيدة مطلعها:
نحن الكرام فلا حيّ يعادلنا...منّا الملوك وفينا تنصب البيع (22)
فلمّا فرغ من إنشاده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه[وآله] وسلم لحسان بن ثابت: «قم، يا حسّان، فأجب الرجل». فقام حسان فقال:
انّ الذوائب من فهر وإخوتهم... قد بيّنوا سنّة للناس تتّبع (23)
يرضى بهم كلّ من كانت سريرته ...تقوى الإله، وكلّ الخير يصطنع
قوم إذا حاربوا ضرّوا عدوّهم... أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا
سجيّة تلك فيهم غير محدثة... ان الخلائق، فاعلم، شرّها البدع (24)
ان كان في الناس سبّاقون بعدهم... فكلّ سبق لأدنى سبقهم تبع
لا يرقع الناس ما أوهت أكفّهم...عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا (25)
ان سابقوا الناس يوما فاز سبقهم...أو وازنوا أهل مجد بالنّدى متعوا (26)
أعفّة ذكرت في الوحي عفّتهم ...لا يطبعون ولا يرديهم طمع (27)
لا يفخرون إذا نالوا عدوّهم...وان أصيبوا فلا خور ولا جزع (28)
أكرم بقوم رسول اللّه شيعتهم... إذا تفاوتت الأهواء والشيع
لحسان بن ثابت بضع مراث في الرسول أشهرها التي تلي:
بطيبة رسم للنبيّ ومعهد...منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد (29)
ولا تمّحي الآيات من دار حرمة... بها منبر الهادي الذي كان يصعد (30)
وواضح آيات وباقي معالم ...وربع له فيه مصلّى ومسجد
بها حجرات كان ينزل وسطها... من اللّه نور يستضاء ويوقد
يذكّرن آلاء الرسول، وما أرى... لها محصيا نفسي؛ فنفسي تبلّد
مفجّعة قد شفّها فقد أحمد... فظلّت لآلاء الرسول تعدّد
فبوركت، يا قبر الرسول، وبوركت... بلاد ثوى فيها الرشيد المسدّد
وهل عدلت يوما رزيّة هالك... رزيّة يوم مات فيه محمّد
تقطّع فيه منزل الوحي عنهم... وقد كان ذا نور يغور وينجد
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى... حريص على أن يستقيموا ويهتدوا
وما فقد الماضون مثل محمّد... ولا مثله حتّى القيامة يفقد
رباه وليدا فاستتمّ تمامه... على أكرم الخيرات ربّ ممجّد
تناهت وصاة المسلمين بكفّه... فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند (31)
_________________________
1) بئر قرب المدينة
2) الحصان (بفتح الحاء المهملة) المرأة الشريفة المتصونة. الرزان: الوقورة الرصينة. ما تزن بريبة: لا يتطرق الشك إلى سلوكها. غرثى: دقيقة الخصر. وتصبح غرثى من لحوم الغوافل: لا تغتاب أحدا.
3) أهل المدن.
4) راجع الموشح للمرزباني (جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة 1343 ه) ص 62،65.
5) كان يوضع لحسان منبر في مؤخر المسجد فينافح عن رسول اللّه (يرد على الذين كانوا يهجون رسول اللّه) -الكامل 778.
6) انتهى ملك الغساسنة في الشام مع الفتح العربي في أيام عمر بن الخطاب. وقد أسلم جبلة بن الايهم وعاش حينا في الحجاز. وحج جبلة مرة فاتفق أن وطئ أعرابي ثوبه في أثناء الطواف فلطم جبلة الاعرابي. فشكا الاعرابي ذلك إلى عمر، فأمر عمر بأن ينتصف الاعرابي من جبلة بأن يلطمه كما كان جبلة قد لطمه. فقال جبلة لعمر: كيف يلطمني وأنا ملك (من أبناء الملوك، وقد كنت ملكا) وهو سوقة! فقال عمر لجبلة: ان الاسلام قد سوى بينكما. فاستمهل جبلة عمر حتى يروي قليلا في أمره. فلما جاء الليل هرب جبلة إلى بلاد الروم ثم ارتد فيها عن الاسلام. وكانت وفاته في بلاد الروم عام 644 م (23 ه) بعد وفاة عمر بقليل.
7) -يذهبون إلى الحرب في دروع منسوجة طبقتين كما يمشي الجمل البازل (الذي تم نموه فانشق اللحم عن نابه الأخير، وذلك في التاسعة من عمره) إلى الجمل البازل.
8) المرمل: الفقير (تمتلئ أوعية بيته بالرمل لأنها تكون مهملة بدلا من أن تكون مملوءة بالمئونة).
9) جفنة بن عمرو أبو الملوك من بني غسان. مارية بنت الارقم أم الحارث الاعرج من ملوك غسان. -يمدحهم بالشجاعة وبالكرم.
10) يغشون (يأتيهم الضيوف بكثرة) حتى ما تهر (لا تنبح) كلابهم (لأنها تعودت رؤية الضيوف). لا يسألون عن السواد المقبل: موائدهم تكفي للضيوف مهما كان عددهم.
11) يسقون ضيوفهم الخمر ممزوجة بالماء البارد. البريص: مكان نهر بدمشق. بردى: اسم نهر في دمشق. وقيل بردا (ماء باردا).
12) المغث: القتال والشر. اللحاء: السباب. -إذا وقع سباب أو قتال بيننا وبين قومنا فألمنا منه (تألمنا، أسفنا لوقوعه) قلنا: الذنب في ذلك للخمر.
13) نهنه: كف، منع. اللقاء: القتال. وفي رواية: ما ينهنهنا (الكامل 74).
14) موعدها كداء: فتح مكة (كداء: ثنية، طريق ملتوية، في الجبل عند مكة).
15) ينازعن الأعنة: يجذبن الأعنة من أيدي فرسانها (ان شوق الخيل إلى فتح مكة أكثر من شوق فرسان تلك الخيل). الاسل: الرماح. الظماء: العطاش (الرماح أيضا متشوقة إلى فتح مكة).
16) تمطرت الخيل: جاءت مسرعة. تلطمهن. . .: تضرب النساء وجوه الخيل بخمرهن ليرددنها (الصورة غير واضحة في هذه المناسبة).
17) ان خليتم سبيلنا دخلنا مكة معتمرين (زائرين مناسك الحج في غير موسم الحج). وكان الفتح: فتح مكة. انكشف الغطاء: تم وعد اللّه لرسوله بفتح مكة (تحقق الوعد بالغيب).
18) مغلغلة: رسالة.
19) عبد الدار: بطن بن من قريش. «وعبد الدار سادتها الاماء»: (لعل هذا إشارة إلى معركة أحد. كانت الحرب في الجاهلية لبني عبد الدار؛ حمل اللواء يوم أحد نفر منهم ففتلوا كلهم حتى حمله عبد أسود لهم اسمه صواب).
20) البر الذي يبغي الخير لقومه. الحنيف: الذي لم يعبد الاوثان في الجاهلية، بل كان يؤمن باللّه وباليوم الآخر من غير أن يجري على عبادة معينة. وفي رواية: حفيا.
21) والد أبي (جدي).
22) البيع: أماكن العبادة.
23) الذوائب: الشعر المتدلي من الرأس (المقصود: الرؤساء). فهر: قريش (المهاجرون). اخوتهم: الانصار (أهل المدينة). قد بينوا سنة: جاءوا بطريقة (بدين، أي الاسلام).
24) السجية الطبيعة. غير محدثة: قديمة (هؤلاء كانوا منذ أقدم الازمنة على التوحيد). البدع جمع بدعة: الأمر الجديد المخالف لعادات القوم (وفيه شيء من السوء).
25) لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم: لا يصلح أحد ما مزقوه (إذا هزموا أحدا لم يستطيع أحد أن ينصره).
26) متع: ارتفع، بلغ الغاية.
27) طبع (بكسر الباء): فسد. أرداه: أهلكه.
28) الخور (بفتح الخاء والواو-وسكنت الواو هنا): الضعف. الجزع: الاضطراب عند المصيبة.
29) طيبة (بفتح الطاء): المدينة. المعهد: المكان يتذكره الناس ويترددون عليه. همد: سكن، بلي، امحى.
30) الهادي: الرسول. الذي كان (الرسول) يصعد اليه ويخطب منه.
31) يفند: يفسد، يضعف.
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
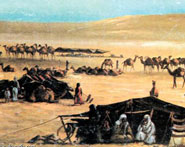 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
دراسة: طريقة قيادة السيارة قد تكشف عن مرض نفسي لدى السائق
|
|
|
|
|
|
|
بتكنولوجيا خاصة.. إنتاج حرير روسي عالي الجودة
|
|
|
|
|
|
|
بالصور: ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يكرمان كوادر العتبة المشاركة بافتتاح ثلاثة مشاريع في البصرة
|
|
|