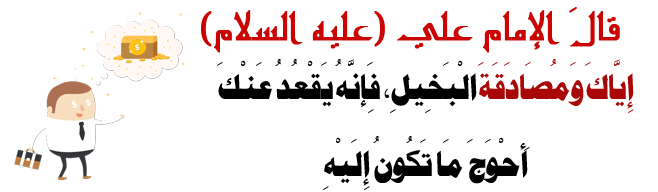
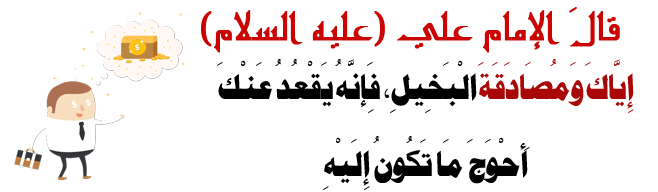

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2016
التاريخ: 30-9-2016
التاريخ: 27-4-2020
التاريخ: 3-4-2022
|
بالسند المتصل عن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى الإلحاد، فقال: "الكِبر أدناه"[1].
ما هو الكِبر؟
الكبر هو عبارة عن حالة نفسية تجعل الإنسان يترفّع ويتعالى على الآخرين، وتصرُّفات الإنسان هي الّتي تدلّ على وجود مثل هذه الحالة عنده.
والكبر هو من آثار العجب وتوابعه، والفرق بينهما أنّ العجب هو الإعجاب بالذّات، بينما الكِبر هو التعالي والتعاظم على الناس. فعندما يتوهّم الإنسان أنّه يمتلك أيّ صفة من صفات الكمال ستنتابه حالة هي مزيج من السرور والتمنُّن وغيرها، وهذه هي صفة العجب، ثمّ يرى أنّ الآخرين لا يملكون هذه الصفة الّتي يتوهّمها في نفسه، فينتابه شعور آخر هو تصوّر التفوّق والتقدّم، وهذا يؤدّي به إلى التعاظم والترفّع، وهذه هي صفة الكِبر.
درجات الكبر من جهة الموضوع:
إنّ للكبر درجات تشبه الدرجات الّتي ذكرناها في العجب، وهي ستّة:
1-الكبر بسبب الإيمان والعقائد الحقّة، ويقابله الكبر بسبب الكفر والعقائد الباطلة.
2-الكبر بسبب التوجهات الفاضلة والصفات الحميدة، ويقابله الكبر بسبب الأخلاق الرذيلة والتوجهات القبيحة.
3-الكبر بسبب العبادات والأعمال الصالحة، ويقابله الكبر بسبب المعاصي والأعمال السيّئة.
وهذه الدرجات يمكن أن تكون وليدة مثيلتها من درجات العجب أو وليدة سبب آخر سوف تأتي الإشارة إليه.
وهناك درجات أخرى للكبر غير هذه تكون بسبب أمور خارجية كالحسب والنسب والمال والجاه والرئاسة وغيرها.
درجات الكبر من جهة الواقع عليه:
إنّ للكبر من هذه الحيثية درجات أيضاً:
1- التكبُّر على الله تعالى، وهذه الدرجة أقبح الدرجات وأشدّها هلكة، وكما يمكن أن تجدها بين أهل الكفر والجحود ومدّعي الألوهية، كذلك يمكن أن تراها بين أهل الدِّين. وهذا التكبُّر هو منتهى الجهل، جهل بالممكن الفقير والمحتاج، وجهل بمقام واجب الوجود الغني والمعطي.
2- التكبُّر على الأنبياء والرسل والأولياء صلوات الله عليهم. وكثيراً ما كان يحصل في زمن الأنبياء، قال تعالى على لسانهم: ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾[2].
وقال تعالى على لسان آخرين: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾[3].
وفي صدر الإسلام وقع الكثير من التكبُّر على أولياء الله، وفي هذا الزمان أيضاً نجد نماذج منه في بعض المحسوبين على الإسلام.
3- التكبُّر على أوامر الله تعالى، وهذا يرجع بحقيقته إلى التكبُّر على الله، وهو يظهر في بعض العاصين، كأن يمتنع أحدهم عن الحجّ لأنّه لا يستسيغ مناسكه من إحرام وغيره، أو يترك الصلاة لأنّ السجود لا يليق بمقامه، وربما يظهر مثل هذا الكبر عند أهل النسك والعبادة وأهل العلم والتديُّن، كأن يترك الآذان تكبُّراً، أو لا يتقبّل الكلام الحقّ إذا جاء ممّن هو مثله أو دونه منزلة.
فقد يسمع الإنسان قولاً من زميل له فيردّه بشدّة ويطعن في قائله، ولكنّه إذا سمع ذلك القول نفسه من كبير في الدِّين أو الدنيا قَبِله[4].
ومن هذا التكبُّر أيضاً من يترك تدريس علم أو كتاب باعتباره لا يليق به، أو يرفض تدريس أشخاص لا مركزية لهم. أو لأنّ عددهم قليل...حتّى وإن علم أنّ في مثل تلك الجماعة رضا الحقّ تعالى.
4- التكبُّر على عباد الله تعالى، وهذا أيضاً يرجع بحسب نظر أهل المعرفة إلى التكبُّر على الله، وأقبحه التكبُّر على العلماء بالله، ومفاسد التكبُّر عليهم أكثر وأخطر من أيّ شيء آخر. ويدخل في هذا التكبُّر أيضاً رفض مجالسة الفقراء، والتقدُّم في المجالس والمحافل وفي المشي والسلوك.
وهذا النوع من التكبُّر شائع بين الناس وشامل لجميع الطبقات، من أشراف وأعيان وعلماء ومحدّثين وأغنياء بل حتّى الفقراء والمعوزين، إلّا من حفظ الله وسلّمه من ذلك.
دقة الطريق:
هناك فرق واضح بين التواضع الحسن والتملُّق القبيح، وبين الإباء الحسن والتكبُّر القبيح، ولكن في بعض الأحيان قد يصبح التمييز بين هذه الأمور على درجة كبيرة من الصعوبة على الإنسان فتختلط عليه هذه الأمور فيظنّ التملُّق تواضعاً والتكبُّر إباءً أو العكس. فلا بدّ للإنسان أن يتعوّذ بالله ليهديه إلى طريق الهداية، وإذا تصدّى الإنسان لإصلاح نفسه وتحرّك نحو الهدف الصحيح، فإنّ الله تعالى سوف يشمله برحمته الواسعة وييسّر له سبيل الهداية.
السبب الأساسي للتكبر:
هناك عدّة عوامل ومبرّرات على المستوى العلمي أو العملي أو غيرهما - قد تدفع الإنسان إلى التكبُّر، ولكنّها كلّها ترجع إلى شيء واحد يمكن اعتباره السبب الحقيقي للتكبُّر، وهو: توهُّم الإنسان الكمال في نفسه ممّا يبعث على العجب الممزوج بحبّ الذات، فيحجب كمال الآخرين ويراهم أدنى منه، ويترفّع عليهم قلبياً أو ظاهرياً.
وقد يحدث أحياناً أنّ صاحب الأخلاق الفاسدة والأعمال القبيحة يتكبّر على غيره، ظانّاً أنّ ما فيه ضرب من الكمال!
وآثار هذه الحالة قد تظهر في سلوك الإنسان بشكل واضح.
نماذج من آثار التكبُّر:
ولنستعرض بعض نماذج التكبُّر لما فيها من فائدة عملية في معرفة هذا المرض والاحتراز عنه:
قد يتصوّر الإنسان نفسه من خواصّ الله المقرّبين وعباده المخلصين فيترفّع على الآخرين ويتعاظم عليهم. ويرى أنّ الحكماء والفلاسفة سطحيين وأنّ الفقهاء والمحدّثين لا يتجاوزون الظاهر في نظراتهم، وأنّ سائر الناس كالبهائم. فينظر إلى عباد الله بعين التحقير والازدراء، ويبدأ هذا المسكين بالكلام عن حبّ الله وعشقه والفناء فيه... مع أنّ المعارف الإلهية تقضي حسن الظنّ بالكائنات، فلو كان قد تذوّق حلاوة المعرفة بالله لما تكبّر على خلقه! لكن الحقيقة أنّ هذه المعارف لم تدخل قلبه، وأنّ هذا المسكين لم يبلغ حتّى مقام الإيمان ولكنّه يتشدّق بأنّه من خواصّ الله!
إنّ بين الفلاسفة أيضاً أناساً يرون أنّهم بما يملكون من براهين ومن علم يمتازون عن غيرهم، فينظرون إلى سائر الناس بعين التحقير ولا يقيمون وزناً لعلم الآخرين، ويرون عباد الله جميعاً ناقصي علم وإيمان فيتكبّرون عليهم في الباطن ويعاملونهم في الظاهر بكبرياء وغرور، مع أنّ العلم بفقر المخلوق، ومقام الخالق ربّ السماوات والأرض يقتضي غير ذلك، والحكيم لا يمكنه إلّا أن يكون متواضعاً بعد معرفته بالمبدأ والمعاد. فهذا لقمان الحكيم يقول في جملة وصاياه لابنه:
﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾[5].
إنّ الكبر منتشر بين علماء سائر العلوم الأخرى، في الطبّ والرياضيات والطبيعة، وكذلك أصحاب الصناعات الهامّة، فكلٌّ منهم يحسب أنّ ما عنده وحده هو العلم وما عند غيره ليس بعلم، فيتكبّر على الناس بباطنه وظاهره.
هناك من أهل النسك والعبادة من يتكبّر على الناس أيضاً، ولا يعتبر الناس حتّى العلماء من أهل النجاة، فإذا ذكر العلم قال: ما فائدة العلم بلا عمل؟ العمل هو الأساس، فينظر بعين الاحتقار إلى جميع الطبقات، مع أنّه لو كان من أهل الإخلاص والعبادة ينبغي لعمله أن يصلحه. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي معراج المؤمن، فصلاته تلك الّتي لم تنهه عن المنكر والّتي تقرّبه من الشيطان والتكبُّر الّذي هو من خواصّ الشيطان، ليست بصلاة، لأنّ الصلاة لا تستدعي ذلك.
الّذي يملك الحسب والنسب يتكبّر على من لا يملكهما، وقد يتكبّر صاحب الجمال على فاقده أو إذا كان كثير الأتباع والأنصار أو له تلامذة كثيرون وأمثال ذلك، فإنّه يتعالى ويتكبّر على الّذي ليس له مثله. بل كما ذكرنا قد يحصل أحياناً أن يتكبّر صاحب الأخلاق الفاسدة والأعمال القبيحة على غيره ظنّاً منه أنّ هذه القبائح هي كمالات.
يقول أحد المحقّقين: "إنّ أدنى درجة الكبر في العالِم هي أن يُدير وجهه عن الناس كأنّه يُعرض عنهم، وفي العابد هي أن يعبس في وجوه الناس ويقطّب جبينه كأنّه يتجنّبهم أو أنّه غاضب عليهم، غافلاً عن أنّ الورع ليس في تقطيب الجبين ولا في عبوس ملامح الوجه ولا في البعد عن الناس والإعراض عنهم، ولا في ليّ الجِيد وطأطأة الرأس ولملمة الأذيال، بل الورع يكون في القلب،
لقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "ها هنا التقوى" وأشار إلى صدره[6].
قد تخفى الآثار:
إنّ المتكبّر قد يمتنع أحياناً لسبب ما من إظهار التكبُّر علانية، فلا يُظهر أيّ أثر لذلك التكبُّر إلّا أنّ هذه الشجرة الخبيثة تمدّ جذورها في قلبه، ولا بدّ من ظهور آثاره في الأوقات الحرجة عندما يخرج عن طوره الطبيعي بسبب الانفعال والغضب وغيره فإذا به تظهر عليه علامات التكبُّر، فيباهي الآخرين بما عنده من علم أو عمل أو أيّ شيء آخر ويفاخرهم به.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|