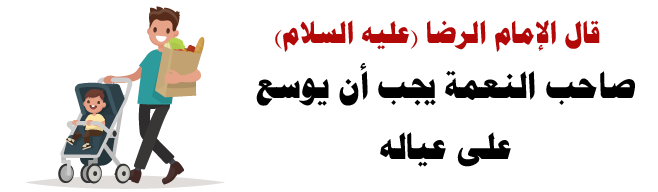
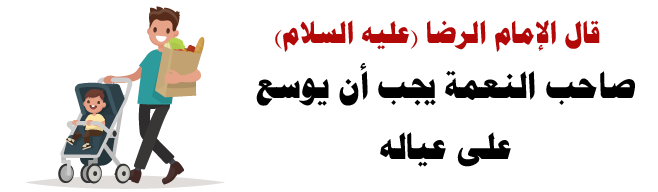

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2021
التاريخ: 6-11-2017
التاريخ: 5-11-2017
التاريخ: 28-3-2021
|
قال تعالى : {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنعام : 27 - 32].
قال تعالى : {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [الأنعام : 27 - 28] .
بين سبحانه ما ينال هؤلاء الكفار يوم القيامة من الحسرة ، وتمني الرجعة ، فقال : {وَلَوْ تَرَى} يا محمد ، أو يا أيها السامع {إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ} فهذا يحتمل ثلاثة أوجه : جائز أن يكون المعنى عاينوا النار . وجائز أن يكونوا عليها وهي تحتهم . قال الزجاج : والأجود أن يكون معناه : أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها ، كما تقول في الكلام : قد وقفت على ما عند فلان ، تريد : قد فهمته وتبينته . وهذا وإن كان بلفظ الماضي ، فالمراد به الاستقبال ، وإنما جاز ذلك لأن كل ما هو كائن يوما مما لم يكن بعد ، فهو عند الله قد كان ، وأنشد في مثله :
ستندم إذ يأتي عليك رعيلنا * بأرعن جرار كثير صواهله (2)
فوضع إذ موضع إذا ، وقد يوضع أيضا إذا موضع إذ كما قال الشاعر :
وندمان يزيد الكأس طيبا * سقيت إذا تعرضت النجوم
{فَقَالُوا} أي : فقال الكفار حين عاينوا العذاب ، وندموا على ما فعلوا {يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ} إلى الدنيا {وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا} أي : بكتب ربنا ورسله ، وجميع ما جاءنا من عنده {وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} يعني من جملة المؤمنين بآيات الله .
{بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ} اختلف فيه على أقوال أحدها : إن معناه بل بدا لبعضهم من بعض ما كان علماؤهم يخفونه عن جهالهم وضعفائهم ، مما في كتبهم ، فبدا للضعفاء عنادهم . وثانيها : إن المراد بل بدا من أعمالهم ما كانوا يخفونه ، فأظهره الله ، وشهدت به جوارحهم ، عن أبي روق . وثالثها : إن المعنى ظهر للذين اتبعوا الغواة ، ما كان الغواة يخفونه عنهم ، من أمر البعث والنشور ، لأن المتصل بهذا قوله : {وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} الآية ، عن الزجاج ، وهو قول الحسن . ورابعها : إن المراد بل بدا لهم وبال ما كانوا يخفونه من الكفر ، عن المبرد . وكل هذه الأقوال بمعنى ظهرت فضيحتهم في الآخرة ، وتهتكت أستارهم .
{وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} أي : لو ردوا إلى الدنيا ، وإلى حال التكليف ، كما طلبوه ، لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب {وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} ويسأل على هذا فيقال : إن التمني كيف يصح فيه الكذب ، وإنما يقع الكذب في الخبر ؟ والجواب : إن من الناس ، من حمل الكلام كله على وجه التمني ، وصرف الكذب إلى غير الأمر الذي تمنوه ، وقال : إن معناه هم كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسهم في الدنيا من الإصابة ، واعتقاد الحق ، أو يكون المعنى : إنهم كاذبون إن خبروا عن أنفسهم ، بأنهم متى ردوا آمنوا ، وإن كان ما حكي عنهم من التمني ، ليس بخبر ، وقد يجوز أن يحمل على غير الكذب الحقيقي بأن يكون المراد أنهم تمنوا ما لا سبيل إليه فكذب أملهم وتمنيهم ، وهذا مشهور في كلام العرب يقولون : كذبك أملك لمن تمنى ما لم يدرك ، وقال الشاعر :
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها * بني شاب قرناها تصر وتحلب (3)
وقال آخر :
كذبتم وبيت الله لا تأخذونها * مراغمة ما دام للسيف قائم
والمراد ما ذكرناه من الخيبة في الأمل والتمني . فإن قيل : كيف يجوز أن يتمنوا الرد إلى الدنيا ، وقد علموا أنهم لا يردون ؟ فالجواب عنه من وجوه أحدها : إنا لا نعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أ حكام الآخرة ، وإنما نقول : إنهم يعرفون الله معرفة لا يتخالجهم فيها الشك ، لما يشاهدونه من الآيات الملجئة لهم إلى المعارف .
وأما التوجع والتمني للخلاص ، والدعاء للفرج ، فيجوز أن يقع منهم ذلك ، عن البلخي . وثانيها : إن التمني قد يجوز فيما يعلم أنه لا يكون ، ولهذا قد يقع التمني على أن لا يكون ما قد كان ، وأن لا يكون فعل ما قد فعله ، وتقضى وقته . وثالثها :
إنه لا مانع من أن يقع منهم التمني للرد ، ولأن يكونوا من المؤمنين ، عن الزجاج .
وفي الناس من جعل بعض الكلام تمنيا ، وبعضه إخبارا ، وعلق تكذيبهم بالخبر دون {لَيْتَنَا} وهذا إنما ينساق في قراءة من رفع {وَلَا نُكَذِّبَ} {وَنَكُونَ} على معنى :
فإنا لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ، فيكونون قد أخبروا بما علم الله أنهم فيه كاذبون ، وإن لم يعلموا من أنفسهم مثل ذلك ، فلهذا كذبهم .
وذكر أن أبا عمرو بن العلاء استدل على قراءته بالرفع في الجميع ، بأن قوله :
{وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} فيه دلالة على أنهم أخبروا بذلك عن أنفسهم ، ولن يتمنوه ، لأن التمني لا يقع فيه الكذب .
- {وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} [الأنعام : 29 - 30] .
ثم أخبر سبحانه عن الكفار الذين ذكرهم قبل هذه الآية ، وإنكارهم البعث والنشور ، والحشر ، والحساب ، فقال : {وَقَالُوا إِنْ هِيَ} أي : ما هي {إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} عنوا بذلك أنه لا حياة لنا في الآخرة ، وإنما هي هذه التي حيينا بها في الدنيا {وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} أي : لسنا بمبعوثين بعد الموت .
ثم خاطب سبحانه نبيه ، صلى الله عليه وآله ، فقال : {وَلَوْ تَرَى} يا محمد {إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ} ليس يصح في هذه الآية شيء من الوجوه التي ذكرناها في قوله : {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ} إلا وجها واحدا ، وهو ان المعنى : عرفوا ربهم ضرورة ، كما يقال : وقفته على كلام فلان أي : عرفته إياه . وقيل أيضا : إن المعنى : وقفوا على ما وعدهم ربهم من العذاب الذي يفعله بالكفار ، والثواب الذي يفعله بالمؤمنين ، في الآخرة ، وعرفوا صحة ما أخبرهم به من الحشر والحساب .
ويجوز أن يكون المعنى : حبسوا على ربهم ينتظر بهم ما يأمرهم به ، وخرج الكلام مخرج ما جرت به العادة من وقوف العبد بين يدي سيده ، لما في ذلك من الفصاحة ، والإفصاح بالمعنى ، والتنبيه على عظم الأمر {قَالَ} أي : يقول الله تعالى لهم ، وجاء على لفظ الماضي ، لأنه لتحققه كأنه واقع . وقيل : معناه تقول الملائكة لهم بأمر الله تعالى {أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ} كما قالت الرسل ، وهذا سؤال توبيخ وتقريع . وقوله {هذا} إشارة إلى الجزاء ، والحساب ، والبعث {قَالُوا} : أي فيقول هؤلاء الكفار مقرين بذلك ، مذعنين له {بلى} هو حق {وربنا} قسم ذكروه ، وأكدوا اعترافهم به {قَالَ} الله تعالى أو الملك بأمره : {فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} أي : بكفركم . وإنما قال : {ذُوقُوا} لأنهم في كل حال يجدون ذلك وجدان الذائق المذوق في شدة الإحساس ، من غير أن يصيروا إلى حال من يشم بالطعام في نقصان الإدراك .
- {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ * وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنعام : 30 - 32] .
ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار ، فقال : {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ} يعني بلقاء ما وعد الله به من الثواب والعقاب ، وجعل لقاءهم لذلك ، لقاء له تعالى ، مجازا ، عن ابن عباس ، والحسن . وقيل : المراد {بِلِقَاءِ} : جزاء الله كما يقال للميت : لقي فلان عمله أي : لقي جزاء عمله . ونظيره : {إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ} [التوبة : 77] . {حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ} أي : القيامة {بَغْتَةً} أي :
فجأة من غير أن علموا وقتها {قَالُوا} عند معاينة ذلك اليوم وأهواله ، وتباين أحوال أهل الثواب والعقاب {يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا} أي : على ما تركنا وضيعنا في الدنيا من تقديم أعمال الآخرة ، عن ابن عباس . قيل : إن الهاء يعود إلى {السَّاعَةُ} عن الحسن ، والمعنى على ما فر طنا في العمل للساعة والتقدمة لها .
قيل : إن الهاء يعود إلى الجنة أي : في طلبها والعمل لها ، عن السدي ، يدل عليه ما رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية قال : يرى أهل النار منازلهم من الجنة ، فيقولون : يا حسرتنا . وقال محمد بن جرير : الهاء يعود إلى الصفقة ، لأنه لما ذكر الخسران دل على الصفقة ، ويجوز أن يكون الهاء يعود إلى معنى ما في قوله {مَا فَرَّطْنَا} أي : يا حسرتنا على الأعمال الصالحة التي فرطنا فيها ، فعلى هذا الوجه يكون {ما} موصولة بمعنى الذي ، وعلى الوجوه المتقدمة يكون {ما} بمعنى المصدر ، ويكون تقديره على تفريطنا {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ} أي : أثقال ذنوبهم {عَلَى ظُهُورِهِمْ} . وقال ابن عباس : يريد آثامهم وخطاياهم . وقال قتادة والسدي : إن المؤمن إذا خرج من قبره ، استقبله أحسن شيء صورة ، وأطيبه ريحا ، فيقول : أنا عملك الصالح ، طال ما ركبتك في الدنيا ، فاركبني أنت اليوم ، فذلك قوله : {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا} [مريم : 85] أي : ركبانا ، وإن الكافر إذا خرج من قبره ، استقبله أقبح شيء صورة ، وأخبثه ريحا ، فيقول : أنا عملك السيء ، طال ما ركبتني في الدنيا ، فأنا أركبك اليوم ، وذلك قوله : {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ} .
وقال الزجاج : هذا مثل جائز أن يكون جعل ما ينالهم من العذاب ، بمنزلة أثقل ما يحمل ، لأن الثقل كما يستعمل في الوزن ، يستعمل في الحال أيضا ، كما تقول :
ثقل علي خطاب فلان ، ومعناه : كرهت خطابه كراهة اشتدت علي ، فعلى هذا يكون المعنى : إنهم يقاسون عذاب آثامهم ، مقاساة تثقل عليهم ، ولا تزايلهم ، وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عليه السلام في قوله : " تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم " .
{أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} أي : بئس الحمل حملهم ، عن ابن عباس . وقيل :
معناه ساء ما ينالهم جزاء لذنوبهم وأعمالهم السيئة ، إذ كان ذلك عذابا ونكالا . ثم رد عليهم قولهم : {مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} [الجاثية : 24] وبين سبحانه أن ما يتمتع به من الدنيا يزول ويبيد فقال : {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} أي : باطل وغرور ، إذا لم يجعل ذلك طريقا إلى الآخرة ، وإنما عنى بالحياة الدنيا أعمال الدنيا ، لأن نفس الدنيا لا توصف باللعب ، وما فيه رضا الله من عمل الآخرة لا يوصف به أيضا ، لأن اللعب ما لا يعقب نفعا ، واللهو ما يصرف من الجد إلى الهزل ، وهذا إنما يتصور في المعاصي .
وقيل : المراد باللعب واللهو : إن الحياة تنقضي وتفنى ، ولا تبقى ، فتكون لذة فانية عن قريب ، كاللعب واللهو . {وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ} وما فيها من أنواع النعيم والجنان {خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} معاصي الله ، لأنها باقية دائمة لا يزول عنهم نعيمها ، ولا يذهب عنهم سرورها .
{أَفَلَا تَعْقِلُونَ} أن ذلك كما وصف لهم ، فيزهدوا في شهوات الدنيا ، ويرغبوا في نعيم الآخرة ، ويفعلوا ما يؤديهم إلى ذلك من الأعمال الصالحة . وفي هذه الآية تسلية للفقراء بما حرموا من متاع الدنيا ، ، وتقريع للأغنياء إذا ركنوا إلى حطامها ، ولم يعملوا لغيرها .
____________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 34-41 .
2 . الرعيل : القطعة من الخيل . وجيش أرعن : هو المضطرب لكثرته . الصواهل جمع الصاهل وهو الفرس .
3 . القرن : ذؤابة المرأة . الصر : جمع اللبن في الضرع . أي : يا بني المرأة التي شاب قرناها حال كونها تصر وتحلب .
{ ولَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ } . عاد سبحانه إلى الحديث عن أحوال المكذبين يوم القيامة ، وانهم حين يرون ما أعد لهم من العذاب ، وما أعد للمؤمنين من الثواب يقولون : { يا لَيْتَنا نُرَدُّ } إلى الدنيا { ولا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا ونَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } . أي نتوب ونعمل صالحا . . ولكن الحسرات والعبرات لا تغني شيئا إلا إذا كانت خوفا من اللَّه وعذابه قبل أن يقع ، أما بعد الوقوع فهي بكاء على الأموات ولهفة على ما فات .
{ بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ } . لا ينجو غدا من عذاب اللَّه إلا من كان واضحا صريحا في هذه الحياة ، تنسجم أقواله مع أفعاله ، وهما معا انعكاس عن ذاته وواقعه ، حتى كأن الجميع شيء واحد عند اللَّه والناس ، أما الغامض المبهم الذي يعرف الخالق منه ما لا يعرفه المخلوق من الرياء والنفاق ، أما هذا فسوف يبدو له جزاء ريائه ونفاقه ، وتذهب نفسه حسرات على إساءته ، ويتمنى الخلاص بالرد إلى الدنيا ، ولكن هيهات . { ولَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ } في قولهم : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . . ولقد قرأنا عن عشرات المجرمين انهم تابوا وهم في غياهب السجن ، حتى إذا خرجوا عادوا إلى اجرامهم . وآثامهم ، {وإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وكانَ الإِنْسانُ كَفُوراً} [الإسراء - 66] .
{ وقالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ } . أي لو ردوا إلى حياتهم الأولى لقالوا ما قالوه من قبل : لا بعث ولا حساب ولا جزاء .
وتسأل : كيف ينكرون ، وقد شاهدوا الهول الأكبر ، وعرضوا عليه ، وتوسلوا للخلاص منه ، وقطعوا عهدا على أنفسهم ان لا يعودوا إلى ما كانوا عليه .
الجواب : انهم يعرفون جيدا ان الحساب والعذاب واقع لا محالة ، ولكنهم يعرفون أيضا أنهم لو أعلنوا الحق وخضعوا له لفاتتهم المغانم والمكاسب ، قال تعالى : {وجَحَدُوا بِها واسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وعُلُوًّا} [النمل - 14] .
{ ولَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ } بعد أن كذبوا بلقائه { قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ } ؟ . قلنا في تفسير الآية الرابعة من هذه السورة : ان اللَّه يدعو إلى الايمان بالحق ، مع إقامة الدليل عليه ، فإن جحده جاحد لزمته الحجة ، وهذه الآية تؤكد ذلك ، وتذكر بالدلائل والبينات التي أنكروها وكذبوا بها { قالُوا بَلى ورَبِّنا } . الآن ، وقد فات ما فات ، ولم يبق إلا الجزاء العادل ، والعذاب لمن كفر وأنكر { قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ } . هذا جزاء كل من آثر العاجلة على الآجلة ، وكتم الحق لهوى في نفسه .
وتسأل : ان قوله تعالى للكافرين : أليس هذا بالحق ، وقوله : ذوقوا العذاب لا يتفق مع الآية 174 من سورة البقرة : {ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ} ؟ .
الجواب : المراد ان اللَّه لا يكلمهم بما يسرهم ، بل بما يسوءهم ، كما في هذه الآية ، وكما في الآية 109 من المؤمنين : {قالَ اخْسَؤُوا فِيها ولا تُكَلِّمُونِ} .
{ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ } وفاز من آمن به { حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها } . قال الإمام (عليه السلام) : ثمرة التفريط الندامة ، وثمرة الحزم السلامة { وهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ } .
الأوزار الذنوب والآثام ، وحملها على الظهر كناية عن ملازمتها لأصحابها ، يقال ركبه الشيطان ، أي لا يفارقه ، والمعنى ان المكذبين بالحق هم أسوأ الناس حالا في الآخرة ، قال بعض المفسرين الجدد :
بل الدواب أحسن حالا ، فهي تحمل أوزارا من الأثقال ، ولكن هؤلاء يحملون أوزارا من الآثام ، والدواب تحط عنها أوزارها ، فتذهب وتستريح ، وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى جهنم مشيعين بالتأثيم .
{ ومَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ ولَهْوٌ } . تقدم نظيره في الآية 185 من آل عمران ج 2 ص 224 .
___________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 178-180 .
قوله تعالى : {وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ} إلى آخر الآيتين . بيان لعاقبة جحودهم وإصرارهم على الكفر والإعراض عن آيات الله تعالى .
وقوله : {يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا} إلخ ، على قراءة النصب في {نُكَذِّبَ} و {نَكُونَ} تمن منهم للرجوع إلى الدنيا والانسلاك في سلك المؤمنين ليخلصوا به من عذاب النار يوم القيامة ، وهذا القول منهم نظير إنكارهم الشرك بالله وحلفهم بالله على ذلك كذبا من باب ظهور ملكاتهم النفسانية يوم القيامة فإنهم قد اعتادوا التمني فيما لا سبيل لهم إلى حيازته من الخيرات والمنافع الفائتة عنهم ، وخاصة إذا كان فوتها مستندا إلى سوء اختيارهم وقصور تدبيرهم في العمل ، ونظيره أيضا ما سيجيئ من تحسرهم على ما فرطوا في أمر الساعة .
على أن التمني يصح في المحالات المتعذرة كما يصح في الممكنات المتعسرة كتمني رجوع الأيام الخالية وغير ذلك قال الشاعر :
ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت الشباب بوع فاشتريت
وقوله : {بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ} إلخ ، ظاهر الكلام أن مرجع الضمائر أعني ضمائر {لَهُمْ} و {كانُوا} و {يُخْفُونَ} واحد وهو المشركون السابق ذكرهم ، وأن المراد بالقبل هو الدنيا فالمعنى أنه ظهر لهؤلاء المشركين حين وقفوا على النار ما كانوا هم أنفسهم يخفونه في الدنيا فبعثهم ظهور ذلك على أن تمنوا الرد إلى الدنيا ، والإيمان بآيات الله ، والدخول في جماعة المؤمنين .
ولم يبد لهم إلا النار التي وقفوا عليها يوم القيامة فقد كانوا أخفوها في الدنيا بالكفر والستر للحق والتغطية عليه بعد ظهوره لهم كما يشير إليه نحو قوله تعالى : {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} [ق : 22] .
وأما نفس الحق الذي كفروا به في الدنيا مع ظهوره لهم فهو كان بادئا لهم من قبل والسياق يأبى أن يكون مجرد ظهور الحق لهم مع الغض عن ظهور النار وهول يوم القيامة باعثا لهم على هذا التمني .
ويشعر بذلك بعض ما في نظير المقام من كلامه تعالى كقوله : {وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ} [الجاثية : 33] ، وقوله : {وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ، وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ} [الزمر : 48] .
وقد ذكروا في الآية أعني قوله : {بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ} وجوها كثيرة أنهاها في المنار إلى تسعة أوجه قال : ( وفيه أقوال الأول أنه أعمالهم السيئة وقبائحهم الشائنة ظهرت لهم في صحائفهم ، وشهدت بها عليهم جوارحهم .
الثاني : أنه أعمالهم التي كانوا يفترون بها ويظنون أن سعادتهم فيها إذ يجعلها الله تعالى هباء منثورا .
الثالث : أنه كفرهم وتكذيبهم الذي أخفوه في الآخرة من قبل أن يوقفوا على النار كما تقدم حكايته عنهم في قوله تعالى : {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ} .
الرابع : أنه الحق أو الإيمان الذي كانوا يسرونه ويخفونه بإظهار الكفر والتكذيب عنادا للرسول واستكبارا عن الحق ، وهذا إنما ينطبق على أشد الناس كفرا من المعاندين المتكبرين الذين قال في بعضهم : {وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا} .
الخامس : أنه ما كان يخفيه الرؤساء عن أتباعهم من الحق الذي جاءت به الرسل بدا للأتباع الذين كانوا مقلدين لهم ، ومنه كتمان بعض أهل الكتاب لرسالة نبينا صلى الله عليه وآله وصفاته وبشارة أنبيائهم به .
السادس : أنه ما كان يخفيه المنافقون في الدنيا من أسرار الكفر وإظهار الإيمان والإسلام .
السابع : أنه البعث والجزاء ومنه عذاب جهنم ، وأن إخفاءهم له عبارة عن تكذيبهم به ، وهو المعنى الأصلي لمادة الكفر .
الثامن : أن في الكلام مضافا محذوفا أي بدا لهم وبال ما كانوا يخفونه من الكفر والسيئات ونزل بهم عقابه فتبرموا وتضجروا وتمنوا التفصي منه بالرد إلى الدنيا ، وترك ما أفضي إليه من التكذيب بالآيات وعدم الإيمان كما يتمنى الموت من أمضه الداء العضال لأنه ينقذه من الآلام لا لأنه محبوب في نفسه ، ونحن لا نرى رجحان قول من هذه الأقوال بل الصواب عندنا قول آخر ، وهو :
التاسع : أنه يظهر يومئذ لكل من أولئك الذين ورد الكلام فيهم ولأشباههم من الكفار ما كان يخفيه في الدنيا ما هو قبيح في نظره أو نظر من يخفيه عنهم ، انتهى ، ثم عمم الكلام لرؤساء الكفار وأتباعهم المقلدة وللمنافقين والفساق ممن يقترف الفواحش ويخفيها عن الناس أو يترك الواجبات ويعتذر بأعذار كاذبة ويخفي حقيقة الحال في كلام طويل .
وبالرجوع إلى ما قدمناه من الوجه والتأمل فيه يظهر ما في كل واحد من هذه الأقوال من وجوه الخلل فلا نطيل .
وقوله : {وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ} تذكير لفعل ما تقرر في نفوسهم من الملكات الرذيلة في نشأة الدنيا فإن الذي بعثهم إلى تمني الرجوع إلى الدنيا والإيمان فيها بآيات الله والدخول في جماعة المؤمنين إنما هو ظهور الحق المتروك بجميع ما يستتبعه من العذاب يوم القيامة ، وهو من مقتضيات نشأة الآخرة المستلزمة لظهور الحقائق الغيبية ظهور عيان .
ولو عادوا إلى الدنيا لزمهم حكم النشأة ، وأسدلت عليهم حجب الغيب ، ورجعوا إلى اختيارهم ، ومعه هوى النفس ووسوسة الشيطان وقرائح العباد والاستكبار والطغيان فعادوا إلى سابق شركهم وعنادهم مع الحق فإن الذي دعاهم وهم في الدنيا إلى مخالفة الحق والتكذيب بآيات الله تعالى هو على حاله مع فرض ردهم إلى الدنيا بعد البعث ، فحكمه حكمه من غير فرق .
وقوله : {وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ} أي في قولهم : {يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا} إلخ ، والتمني وإن كان إنشاء لا يقع فيه الصدق والكذب إلا أنهم لما قالوا : {نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ} أي ردنا الله إلى الدنيا ولو ردنا لم نكذب ، ولم يقولوا : نعود ولا نكذب ، كان كلامهم مضمنا للمسألة والوعد أعني مسألة الرد ووعد الإيمان والعمل الصالح كما صرح بذلك في قوله : {وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ} [السجدة : 12] وقوله : {وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} [الفاطر : 37] .
وبالجملة قولهم : {يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ} إلخ ، في معنى قولهم ربنا ردنا إلى الدنيا لا نكذب بآياتك ونكن من المؤمنين ، وبهذا الاعتبار يحتمل الصدق والكذب ، ويصح عدهم كاذبين .
وربما وجه نسبة الكذب إليهم في تمنيهم بأن المراد كذب الأمل والتمني وهو عدم تحققه خارجا كما يقال : كذبك أملك ، لمن تمنى ما لا يدرك .
وربما قيل : إن المراد كذبهم في سائر ما يخبرون به عن أنفسهم من إصابة الواقع واعتقاد الحق ، هو كما ترى .
قوله تعالى : {وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا} إلى آخر الآيتين . ذكر لإنكارهم الصريح للحشر وما يستتبعه يوم القيامة من الإشهاد وأخذ الاعتراف بما أنكروه ، والوثنية كانت تنكر المعاد كما حكى الله عنهم ذلك في كلامه غير مرة ، وقولهم بشفاعة الشركاء إنما كان في الأمور الدنيوية من جلب المنافع إليهم ودفع المضار والمخاوف عنهم .
فقوله : {وَقالُوا إِنْ هِيَ} إلخ ، حكاية لإنكارهم أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا لا حياة بعدها ، وما نحن بمبعوثين بعد الممات ، وقوله : {وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا} كالجواب وهو بيان ما يستتبعه قولهم : ( إِنْ هِيَ إِلَّا ) ، {إلخ} للنبي صلى الله عليه وآله في صورة التمني لمكان قوله : {وَلَوْ تَرى} وهو أنهم سيصدقون بما جحدوه ، ويعترفون بما أنكروه بقولهم : {وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} إذ يوقفون على ربهم فيشاهدون عيانا هذا الموقف الذي أخبروا به في الدنيا ، وهو أنهم مبعوثون بعد الموت فيعترفون بذلك بعد ما أنكروه في الدنيا .
ومن هنا يظهر أن الله سبحانه فسر البعث في قوله : {وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ} بلقاء الله ، ويؤيده أيضا قوله في الآية التالية : {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ} إلخ ، حيث بدل الحشر والبعث والقيامة المذكورات في سابق الكلام لقاء ثم ذكر الساعة أي ساعة اللقاء .
وقوله : {أَلَيْسَ هذا} أي أليس البعث الذي أنكرتموه في الدنيا وهو لقاء الله {بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} به وتسترونه .
قوله تعالى : {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ} إلى آخر الآية ، قال في المجمع ، : كل شيء أتى فجأة فقد بغت يقال : بغته الأمر يبغته بغتة انتهى ، وقال الراغب في المفردات ، : الحسر كشف الملبس عما عليه يقال : حسرت عن الذراع ، والحاسر من لا درع عليه ولا مغفر ، والمحسرة المكنسة ـ إلى أن قال ـ والحاسر المعيا لانكشاف قواه ـ إلى أن قال ـ والحسرة الغم على ما فاته والندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه أو انحسر قواه من فرط غم أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه . انتهى موضع الحاجة .
وقال : الوزر ( بفتحتين ) الملجأ الذي يلتجأ إليه من الجبل ، قال : {كَلَّا لا وَزَرَ إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ} والوزر ( بالكسر فالسكون ) الثقل تشبيها بوزر الجبل ، ويعبر بذلك عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل ، قال {لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً} الآية كقوله : {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ} ، انتهى .
والآية تبين تبعة أخرى من تبعات إنكارهم البعث وهو أن الساعة سيفاجئهم فينادون بالحسرة على تفريطهم فيها ويتمثل لهم أوزارهم وذنوبهم وهم يحملونها على ظهورهم وهو أشق أحوال الإنسان وأردؤها ألا ساء ما يزرون ويحملونه من الثقل أو من الذنب أو من وبال الذنب .
والآية أعني قوله : {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ} بمنزلة النتيجة المأخوذة من قوله : {وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا} إلى آخر الآيتين ، وهي أنهم بتعويضهم راحة الآخرة وروح لقاء الله من إنكار البعث وما يستتبعه من أليم العذاب خسروا صفقة .
قوله تعالى : {وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ} إلخ ، تتمة للكلام فيه بيان حال الحياتين : الدنيا والآخرة والمقايسة بينهما فالحياة الدنيا لعب ولهو ليس إلا فإنها تدور مدار سلسلة من العقائد الاعتبارية والمقاصد الوهمية كما يدور عليه اللعب فهي لعب ، ثم هي شاغلة للإنسان عما يهمه من الحياة الأخرى الحقيقية الدائمة فهي لهو ، والحياة الآخرة لكونها حقيقية ثابتة فهي خير ولا ينالها إلا المتقون فهي خير لهم .
_________________________
1. تفسير الميزان ، ج7 ، ص 45-49 .
قال تعالى : {وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ} [الانعام : 27-28] .
يقظة عابرة عقيمة :
في هاتين الآيتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين ، وفيهما يتجسد مشهد من مشاهد نتائج أعمالهم لكي يدركوا المصير المشؤوم الذي ينتظرهم فيستيقظون ، أو تكون حالهم ـ على الأقل ـ عبرة لغيرهم ، فتقول الآية : {وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ . . .} (2) لتبيّن لك مصيرهم السيئ المؤلم .
إنّهم في تلك الحال على درجة من الهلع بحيث أنّهم يصرخون : ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعوض عن أعمالنا القبيحة ، ونعمل للنجاة من هذا المصير المشؤوم . ونصدق آيات ربّنا ، ونقف إلى جاب المؤمنين : {فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (3) .
الآية التّالية تؤكّد أن ذلك ليس أكثر من تمن كاذب ، وإنّما تمنوه لأنّهم رأوا في ذلك العالم كل ما كانوا يخفونه ـ من عقائد ونيات وأعمال سيئة ـ مكشوفا أمامهم ، فاستيقظوا يقظة مؤقتة عابرة : {بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ} .
غير أن هذه اليقظة ليست قائمة ثابتة ، بل إنّها قد حصلت لظروف طارئة ، ولذلك فحتى لو افترضنا المستحيل وعادوا إلى هذه الدنيا مرّة أخرى لفعلوا ما كانوا يفعلونه من قبل وما نهوا عنه : {وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ} لذلك فهم ليسوا صادقين في تمنياتهم ومزاعمهم {وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ} .
{وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ * وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ} [الانعام : 29-32] .
في تفسير الآية الأولى احتمالان :
الأوّل : أنّها استئناف لأقوال المشركين المعاندين المتصلبين الذين يتمنون ـ عند ما يشاهدون أهوال يوم القيامة ـ أن يعودوا إلى دار الدنيا ليتلافوا ما فاتهم ، ولكن القرآن يقول إنّهم إذا رجعوا لا يتجهون إلى جبران ما فاتهم ، بل يستمرون
على ما كانوا عليه ، وأكثر من ذلك فإنّهم يعودون إلى إنكار يوم القيامة {وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} (4) .
الاحتمال الثّاني : أنّ الآية تشرع بكلام جديد يخصّ نفرا من المشركين ممّن كفروا بالمعاد كليا ، فقد كان بين مشركي العرب فريق لا يؤمنون بالمعاد ، وفريق آخر يؤمنون بنوع من المعاد .
الآية التّالية تشير إلى مصيرهم يوم القيامة ، يوم يقفون بين يدي الله : {وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِ} ، فيكون جوابهم أنّهم يقسمون بأنّه الحقّ : {قالُوا بَلى وَرَبِّنا} .
عندئذ : {قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} لا شك أنّ «الوقوف بين يدي الله» لا يعني إنّ لله مكانا ، بل يعني الوقوف في ميدان الحساب للجزاء ، كما يقول بعض المفسّرين ، أو أنّه من باب المجاز ، مثل قول الإنسان عند أداء الصّلاة أنّه يقف بين يدي الله وفي حضرته .
الآية التي بعدها فيها ، إشارة إلى خسران الذين ينكرون المعاد ، فتقول : {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ} ، إنّ المقصود بلقاء الله هو ـ كما قلنا من قبل ـ اللقاء المعنوي والإيمان الشهودي (الشهود الباطني) ، أو هو لقاء مشاهد يوم القيامة والحساب والجزاء .
ثمّ تبيّن الآية أنّ هذا الإنكار لن يدوم ، بل سيستمر حتى قيام يوم القيامة ، حين يرون أنفسهم فجأة أمام مشاهده الرهيبة ، ويشهدون بأعينهم نتائج أعمالهم ، عندئذ ترتفع أصواتهم بالندم على ما قصروا في حق هذا اليوم : {حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها} .
و «الساعة» هي يوم القيامة ، و «بغتة» تعني فجأة وعلى حين غرة ، إذ تقوم القيامة دون أن يعلم بموعدها أحد سوى الله تعالى ، وسبب إطلاق «الساعة» على يوم القيامة إمّا لأنّ حساب الناس يجري سريعا فيها ، أو للإشارة إلى فجائية حدوث ذلك ، حيث ينتقل الناس بسرعة خاطفة من عالم البرزخ إلى عالم القيامة .
و «التحسر» هو التأسف على شيء ، غير أنّ العرب عند تأثرهم الشديد يخاطبون «الحسرة» فيقولون : «يا حسرتنا» ، فكأنّهم يجسدونها أمامهم ويخاطبونها .
ثمّ يقول القرآن الكريم {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ} .
«الأوزار» جمع «وزر» وهو الحمل الثقيل ، وتعني الأوزار هنا الذنوب ، ويمكن أن تتخذ هذه الآية دليلا على تجسد الأعمال ، لأنّها تقول إنّهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم ، ويمكن أيضا أن يكون الاستعمال مجازيا كناية عن ثقل حمل المسؤولية ، إذ أنّ المسؤوليات تشبه دائما بالحمل الثقيل .
وفي آخر الآية يقول الله تعالى : {أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ} .
في هذه الآية جرى الكلام على خسران الذين ينكرون المعاد ، والدليل على هذا الخسران واضح ، فالإيمان بالمعاد ، فضلا عن كونه يعد الإنسان لحياة سعيدة خالدة ، ويحثه على تحصيل الكمالات العلمية والعملية ، فان له تأثيرا عميقا على وقاية الإنسان من التلوث بالذنوب والآثام ، وهذا ما سوف نتناوله ـ إن شاء الله ـ عند بحث الإيمان بالمعاد وأثره البناء في الفرد والمجتمع .
ثمّ لبيان نسبة الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة ، يقول الله تعالى : {وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} فهؤلاء الذين اكتفوا بهذه الحياة ، ولا يطلبون غيرها ، هم أشبه بالأطفال الذين يودون أن لو يقضوا العمر كلّه في اللعب واللهو غافلين عن كل شيء .
إن تشبيه الحياة الدنيا باللهو واللعب يستند إلى كون اللهو واللعب من الممارسات الفارغة السطحية التي لا ترتبط بأصل الحياة الحقيقية ، سواء فاز اللاعب أم خسر ، إذ كل شيء يعود إلى حالته الطبيعية بعد اللعب .
وكثيرا ما نلاحظ أنّ الأطفال يتحلقون ويشرعون باللعب ، فهذا يكون «أميرا» وذاك يكون «وزيرا» وآخر «لصا» ورابع يكون «قافلة» ، ثمّ لا تمضي ساعة حتى ينتهي اللعب ولا يكون هناك «أمير» ولا «وزير» ولا «لص» ولا
«قافلة»! أو كما يحدث في المسرحيات أو التمثيليات ، فنشاهد مناظر للحرب أو الحبّ أو العداء تتجسد على المسرح ، ثمّ بعد ساعة يتبدد كل شيء .
والدنيا أشبه بالتمثيلية التي يقوم فيها الناس بتمثيل أدوار الممثلين ، وقد تجتذب هذه التمثيلية الصبيانية حتى عقلاءنا ومفكرينا ، ولكن سرعان ما تسدل الستارة وينتهي التمثيل .
«لعب» على وزن «لزج» من «اللعاب» على وزن «غبار» وهو الماء الذي يتجمع في الفم ويسيل منه ، فإطلاق لفظة «اللعب» على اللهو والتسلية جاء للتشابه بينه وبين اللعاب الذي يسيل دون هدف .
ثمّ تقارن الآية حياة العالم الآخر بهذه الدنيا ، فتقول : {وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ} .
فتلك حياة خالدة لا تفنى في عالم أوسع وعلى أرفع ، عالم يتعامل مع الحقيقة لا المجاز ومع الواقع ، لا الخيال ، عالم لا يشوب نعمه الألم والعذاب ، عالم كلّه نعمة خالصة لا ألم فيه ولا عذاب .
ولكن إدراك هذه الحقائق وتمييزها عن مغريات الدنيا الخداعة غير ممكن لغير المفكرين الذين يعقلون ، لذلك اتجهت الآية إليهم بالخطاب في النهاية .
في حديث رواه هشام بن الحكم عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام قال : «يا هشام إنّ الله وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال : {وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ} (5) .
غني عن القول أنّ هدف هذه الآيات هو محاربة الانشداد بمظاهر عالم المادة ونسيان الغاية النهائية ، أمّا الذين جعلوا الدنيا وسيلة للسعادة فهم يبحثون ـ في الحقيقة ـ عن الآخرة ، لا الدنيا .
________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 48-54 .
2. «لو» شرطية ، وقد حذف الجواب لوضوحه .
3. ينبغي الانتباه إلى نقطة مهمّة في الآية : في القراءة المشهورة التي بين أيدينا «نردّ» مرفوعة و «ولا نكذب» و «نكون» منصوبتان ، مع أنّ الظاهر يدل على أنّهما معطوفتان على «نردّ» وخير تعليل لذلك هو القول بأنّ «نردّ» جزء من التمني ، و «ولا نكذب» جواب التمني ، و «الواو» هنا بمنزلة «الفاء» ومعلوم أن جواب التمني إذا وقع بعد الفاء كان منصوبا ، إن مفسرين كالفخر الرازي والمرحوم الطبرسي وأبي الفتوح الرازي أوردوا تعليلات أخرى ، ولكن الذي قلناه أوضح الوجوه ، وعليه فهذه الآية تكون شبيهة بالآية (58) من سورة الزمر : {لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} .
4. بحسب هذا الاحتمال «وقالوا» معطوفة على «عادوا» وهذا ما يقول به صاحب تفسير «المنار» .
5. تفسير «نور الثقلين» ، ج 1 ، ص 711 .



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|