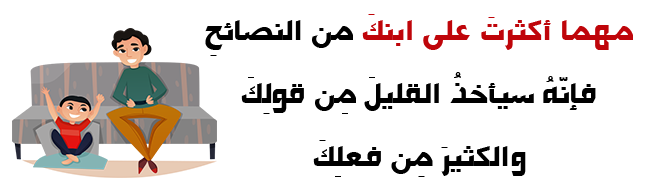
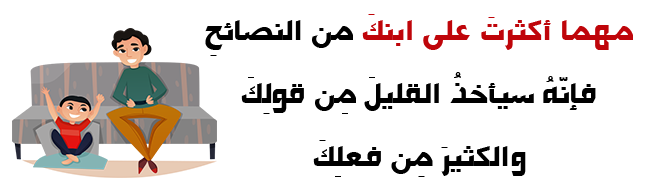

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-3-2021
التاريخ: 5-11-2017
التاريخ: 5-11-2017
التاريخ: 10-6-2021
|
قال تعالى : {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} [الأنعام : 1 - 3] .
بدأ الله تعالى هذه السورة بالحمد لنفسه إعلاما بأنه المستحق لجميع المحامد ، لأن أصول النعم وفروعها منه تعالى ، ولأن له الصفات العلى ، فقال : {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} يعني : اخترعهما بما اشتملا عليه من عجائب الصنعة ، وبدائع الحكمة . وقيل : إنه في لفظ الخبر ، ومعناه الأمر ، أي : إحمدوا الله ، وإنما جاء على صيغة الخبر ، وإن كان فيه معنى الأمر ، لأنه أبلغ في البيان من حيث إنه يجمع الأمرين ، وقد ذكرنا من معنى الحمد لله وتفسيره في الفاتحة ، ما فيه كفاية {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور} يعني : الليل والنهار ، عن السدي ، وجماعة من المفسرين . وقيل : الجنة والنار ، عن قتادة . وإنما قدم ذكر الظلمات ، لأنه خلق الظلمة قبل النور ، وكذلك خلق السماوات قبل الأرض . ثم عجب سبحانه ، ممن {جَعَلَ} له شريكا مع ما يرى من الآيات الدالة على وحدانيته ، فقال : {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} أي : جحدوا الحق .
{بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} أي : يسوون به غيره ، بأن جعلوا له أندادا ، مأخوذ من قولهم : ما أعدل بفلان أحدا أي : لا نظير له عندي . وقيل : معنى يعدلون : يشركون به غيره ، عن الحسن ، ومجاهد . ودخول {ثُمَّ} في قوله : {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} دليل على معنى لطيف ، وهو أنه سبحانه أنكر على الكفار العدل به ، وعجب المؤمنين من ذلك . ومثله في المعنى قوله فيما بعد {ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ} والوجه في التعجيب أن هؤلاء الكفار ، مع اعترافهم بأن أصول النعم منه ، وأنه هو الخالق والرازق ، عبدوا غيره ، ونقضوا ما اعترفوا به ، وأيضا فإنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضر من الحجارة والموات {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ} يعني به آدم . والمعنى أنشأ أباكم ، واخترعه من طين ، وأنتم من ذريته ، فلما كان آدم أصلنا ، ونحن من نسله ، جاز أن يقول لنا {خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ} . {ثُمَّ قَضَى أَجَلًا} أي : كتب وقدر أجلا ، والقضاء يكون بمعنى الحكم ، وبمعنى الأمر ، وبمعنى الخلق ، وبمعنى الإتمام والإكمال {وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} قيل فيه أقوال أحدها : إنه يعني بالأجلين : أجل الحياة إلى الموت ، وأجل الموت إلى البعث وقيام الساعة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة والضحاك ، واختاره الزجاج . وروى أيضا عطاء ، عن ابن عباس قال : قضى أجلا من مولده إلى مماته ، وأجل مسمى عنده من الممات إلى البعث ، لا يعلم ميقاته أحد سواه ، فإذا كان الرجل صالحا ، واصلا لرحمه ، زاد الله له في أجل الحياة ، ونقص من أجل الممات إلى البعث ، وإذا كان غير صالح ، ولا واصل ، نقصه الله من أجل الحياة ، وزاد في أجل المبعث . قال : وذلك قوله : {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} [فاطر : 11] .
وثانيها : إنه الأجل الذي يحيا به أهل الدنيا إلى أن يموتوا ، وأجل مسمى عنده : يعني الآخرة ، لأنه أجل دائم ممدود ، لا آخر له ، وإنما قال {مُسَمًّى عِنْدَهُ} لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ، في السماء ، وهو الموضع الذي لا يملك فيه الحكم على الخلق سواه ، عن الجبائي ، وهو قول سعيد بن جبير ، ومجاهد .
وثالثها : إن {أَجَلًا} يعني به : أجل من مضى من الخلق ، و {أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} يعني به : آجال الباقين ، عن أبي مسلم .
ورابعها : إن قوله : {قَضَى أَجَلًا} عنى به النوم ، يقبض الروح فيه ، ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة . {وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} : هو أجل موت الانسان ، وهو المروي عن ابن عباس . ويؤيده قوله : {وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [الزمر : 42] والأصل في الأجل هو الوقت . فأجل الحياة هو الوقت الذي يكون فيه الحياة . وأجل الموت ، أو القتل هو الوقت الذي يحدث فيه الموت أو القتل ، وما يعلم الله تعالى أن المكلف يعيش إليه لو لم يقتل لا يسمى أجلا حقيقة ، ويجوز أن يسمى ذلك مجازا ، وما جاء في الأخبار من أن صلة الرحم تزيد في العمر ، والصدقة تزيد في الأجل ، وأن الله تعالى زاد في أجل قوم يونس ، وما أشبه ذلك ، فلا مانع من ذلك .
وقوله : {ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ} خطاب للكفار الذين شكوا في البعث والنشور ، واحتجاج عليهم ، بأنه سبحانه خلقهم ونقلهم من حال إلى حال ، وقضى عليهم الموت ، وهم يشاهدون ذلك ، ويقرون بأنه لا محيص منه ، ثم بعد هذا يشكون ويكذبون بالبعث ، ومن قدر على ابتداء الخلق ، فلا ينبغي أن يشك في أنه يصح منه إ عادتهم ، وبعثهم .
ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال : {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ} فيه وجوه على ما ذكرناه في الإعراب . فعلى التقدير الأول يكون معناه : الله يعلم في السماوات وفي الأرض سركم وجهركم ، ويكون الخطاب لجميع الخلق ، لأن الخلق إما أن يكونوا ملائكة فهم في السماء ، أو بشرا ، أو جنا ، فهم في الأرض . فهو سبحانه عالم بجميع أسرارهم ، وأحوالهم ، ومتصرفاتهم ، لا يخفى عليه منها شيء .
ويقويه قوله : {وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} أي : يعلم جميع ما تعملونه من الخير والشر ، فيجازيكم على حسب أعمالكم وعلى التقدير الثاني : يكون معناه إن المعبود في السماوات وفي الأرض ، أو المنفرد بالتدبير في السماوات وفي الأرض ، يعلم سركم وجهركم ، فلا تخفى عليه منكم خافية ، ويكون الخطاب لبني آدم ، وإن جعلت اسم الله علما على هذا التقدير ، ثم علقت به قوله {فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} لم يجز . وإن علقته بمحذوف ، يكون خبر {اللَّهُ} ، أو حالا عنه ، أوهم بأن يكون الباري سبحانه في محل تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
وقال أبو بكر السراج : ان {اللَّهُ} وإن كان اسما علما ، ففيه معنى الثناء والتعظيم الذي يقرب بهما من الفعل ، فيجوز أن يوصل لذلك بالمحل ، وتأويله :
وهو المعظم ، أو نحو ذا في السماوات وفي الأرض ، ثم قال : {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ} ومثل ذلك قوله سبحانه : {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف : 84] قال الزجاج : فلو قلت : هو زيد في البيت والدار ، لم يجز إلا أن يكون في الكلام دليل على أن زيدا يدبر أمر البيت والدار ، فيكون المعنى : هو المدبر في البيت والدار .
ولو قلت : هو المعتضد والخليفة في الشرق والغرب ، أو قلت : هو المعتضد في الشرق والغرب جاز ، وعلى مقتضى ما قاله أبو بكر والزجاج يكون في متعلقة بما دل عليه اسم الله ، ويكون {هُوَ اللَّهُ} مبتدأ وخبرا ، والمعنى : وهو المنفرد بالإلهية في السماوات وفي الأرض لا إله فيهما غيره ، ولا مدبر لهما سواه . وإن جعلت {فِي السَّمَاوَاتِ} خبرا بعد خبر ، فيكون التقدير : وهو الله ، وهو في السماوات وفي الأرض ، يعني أنه في كل مكان ، فلا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان ، ثم أخبر سبحانه عن هذا المعنى مبينا لذلك ، مؤكدا له ، بقوله : {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ} أي الخفي المكتوم والظاهر المكشوف منكم .
{وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} : والمعنى يعلم نياتكم وأحوالكم وأعمالكم . وهذا الترتيب الذي ذكرته في معاني هذه الآية التي استنبطتها من وجوه الإعراب مما لم أسبق إليه ، وهو في استقامة فصوله ، ومطابقة أصول الدين كما تراه ، لا غبار عليه ، وفيه دلالة على فساد قول من يقول بأن الله تعالى في مكان دون مكان ، تعالى عن ذلك وتقدس . وفي قوله : {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ} دلالة على أنه عالم لنفسه ، لأن من كان عالما بعلم ، لا يصح ذلك منه .
________________________
1 . مجمع البيان ، ج7 ، ص 7-10 .
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ والأَرْضَ وجَعَلَ الظُّلُماتِ والنُّورَ} .
هذه الآيات الثلاث من الآيات الكونية الدالة على وحدانيته وعظمته ، وتشير الآية الأولى إلى خلق السماوات والأرض ، والظلمات والنور ، والثانية إلى خلق الإنسان وبعثه بعد الموت ، والثالثة إلى علم اللَّه وإحاطته بكل شيء .
ومعنى الحمد الثناء ، وقوله تعالى : الحمد للَّه يريد به التعليم ، أي قولوا يا عبادي الحمد للَّه ، والثناء على اللَّه حسن على كل حال ، حتى عند الضراء ، لأنه أهل للتقديس والتعظيم . . فان أصابتك مصيبة ، وقلت عندها : الحمد للَّه فإنك تعبر بذلك عن صبرك على الشدائد ، وإيمانك القوي الراسخ الذي لا يزعزعه شيء ، ويتأكد حسن الحمد ورجحانه عند السراء ودفع البلاء ، لأنه شكر للَّه على ما أسبغ وأنعم .
ووصف اللَّه سبحانه نفسه بخالق السماوات والأرض والظلمات والنور لينبه العقول إلى أنه لا شريك له في الخلق والألوهية ، فيكون هو وحده الجدير بالحمد والإخلاص له في العبودية {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} . ومحل التعجب والغرابة ان هذا الكون العجيب بأرضه وسمائه ، وهذه البينات الواضحة ، والدلائل القاطعة لم تخترق ذاك الظلام الكثيف على عقل المشرك وقلبه الذي أعماه عن الحق ، وصور له ان للَّه مساويا في استحقاق الحمد والعبادة .
{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ} . أي خلق أصلكم ، وهو آدم ، وآدم من تراب وماء ، أو خلق مادة كل فرد من البشر من طين ، لأنه من لحم ودم ، وهما من النبات ولحم الحيوان المتولد من النبات ، والنبات من الطين {ثُمَّ قَضى أَجَلًا وأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} . للقضاء معان ، منها الحكم والأمر : {وقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} أي أمر . . ومنها الإخبار والإنهاء : {وقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ} أي انهينا . ومنها الحتم الذي لا مفر منه : {وإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} وهذا المعنى هو المراد هنا .
واللَّه سبحانه قضى لكل فرد من عباده أجلين : أحدهما ينتهي بموته ، وبعده يعرف كم عاش . وثانيهما لإعادته وبعثه بعد الموت ، وعلم هذا عند اللَّه وحده ، ولا يطلع عليه أحدا من خلقه ، كما دلت على ذلك كلمة عنده . {ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ} . أي تشكّون ، والمعنى : أبعد ان قامت الدلالة على قدرة اللَّه في الخلق الكبير ، وهو الكون ، وفي الخلق الصغير ، وهو خلق الإنسان وموته وبعثه ، أبعد هذا تشكون في وجود اللَّه ووحدانيته وعظمته ! . . وخير تفسير لهذه الجملة قول علي أمير المؤمنين (عليه السلام) : عجبت لمن شك في اللَّه ، وهو يرى خلق اللَّه ، وعجبت لمن نسي الموت ، وهو يرى الموت ، وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى ، وهو يرى النشأة الأولى .
{وهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وجَهْرَكُمْ ويَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ} . ذكر سبحانه في الآية الأولى انه خالق السماوات والأرض ، والنتيجة الحتمية لهذا انه موجود في السماوات والأرض ، ومعنى وجوده فيهما وجود آثاره ، وذكر في الآية الثانية انه خالق الإنسان ومميته ومعيده ، واللازم القهري لذلك انه يحيط علما بسره وجهره ، وما يكسبه من إيمان وكفر ، وإخلاص ونفاق ، وأقوال وأفعال تعود عليه بالخير أو الشر .
_________________________
1 . تفسير الكاشف ، ج3 ، ص158-159 .
غرض السورة هو توحيده تعالى بمعناه الأعم أعني أن للإنسان ربا هو رب العالمين جميعا منه يبدأ كل شيء وإليه ينتهي ويعود كل شيء ، أرسل رسلا مبشرين ومنذرين يهدي بهم عباده المربوبين إلى دينه الحق ، ولذلك نزلت معظم آياتها في صورة الحجاج على المشركين في التوحيد والمعاد والنبوة ، واشتملت على إجمال الوظائف الشرعية والمحرمات الدينية .
وسياقها ـ على ما يعطيه التدبر ـ سياق واحد متصل لا دليل فيه على فصل يؤدي إلى نزولها نجوما .
وهذا يدل على نزولها جملة واحدة ، وأنها مكية فإن ذلك ظاهر سياقها الذي وجه الكلام في جلها أو كلها إلى المشركين .
وقد اتفق المفسرون والرواة على كونها مكية إلا في ست آيات روي عن بعضهم أنها مدنية . وهي قوله تعالى : {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام : 91] إلى تمام ثلاث آيات ، وقوله تعالى : {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} [الأنعام : 151] إلى تمام ثلاث آيات .
وقيل : إنها كلها مكية إلا آيتان منها نزلتا بالمدينة ، وهما قوله تعالى : {قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ} والتي بعدها .
وقيل : نزلت سورة الأنعام كلها بمكة إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل من اليهود ، وهو الذي قال : {ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} الآية .
وقيل : « إنها كلها مكية إلا آية واحدة نزلت بالمدينة ، وهو قوله تعالى : {وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ} الآية .
وهذه الأقوال لا دليل على شيء منها من جهة سياق اللفظ على ما تقدم من وحدة السياق واتصال آيات السورة ، وسنبينها بما نستطيعه ، وقد ورد عن أئمة أهل البيت عليه السلام وكذا عن أبي وعكرمة وقتادة : أنها نزلت جملة واحدة بمكة .
قوله تعالى : {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ} افتتح بالثناء على الله وهو كالمقدمة لما يراد بيانه من معنى التوحيد ، وذلك بتضمين الثناء ما هو محصل غرض السورة ليتوسل بذلك إلى الاحتجاج عليه تفصيلا ، وتضمينه العجب منهم ولومهم على أن عدلوا به غيره والامتراء في وحدته ليكون كالتمهيد على ما سيورد من جمل الوعظ والإنذار والتخويف .
وقد أشار في هذا الثناء الموضوع في الآيات الثلاث إلى جمل ما تعتمد عليه الدعوة الدينية في المعارف الحقيقية التي هي بمنزلة المادة للشريعة ، وتنحل إلى نظامات ثلاث :
نظام الكون العام وهو الذي تشير إليه الآية الأولى ، ونظام الإنسان بحسب وجوده ، وهو الذي تشتمل عليه الآية الثانية ، ونظام العمل الإنساني وهو الذي تومئ إليه الآية الثالثة .
فالمتحصل من مجموع الآيات الثلاث هو الثناء عليه تعالى بما خلق العالم الكبير الذي يعيش فيه الإنسان ، وبما خلق عالما صغيرا هو وجود الإنسان المحدود من حيث ابتدائه بالطين ومن حيث انتهائه بالأجل المقضي ، وبما علم سر الإنسان وجهره وما يكسبه .
وما في الآية الثالثة : « {وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ} ، بمنزلة الإيضاح لمضمون
الآيتين ، السابقتين والتمهيد لبيان علمه بسر الإنسان وجهره وما تكسبه نفسه .
فقوله : {خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ} إشارة إلى نظام الكون العام الذي عليه تدبر الأشياء على كثرتها وتفرقها في عالمنا في نظامه الجاري المحكم إلا عالم الأرض الذي يحيط به عالم السماوات على سعتها ثم يتصرف بها بالنور والظلمات اللذين عليهما يدور رحى العالم المشهود في تحوله وتكامله فلا يزال يتولد شيء من شيء ، ويتقلب شيء إلى شيء ، ويظهر واحد ويخفى آخر ، ويتكون جديد ويفسد قديم ، وينتظم من تلاقي هذه الحركات المتنوعة على شتاتها الحركة العالمية الكبرى التي تحمل أثقال الأشياء ، وتسير بها إلى مستقرها .
والجعل في قوله : {وَجَعَلَ الظُّلُماتِ} إلخ بمعنى الخلق غير أن الخلق لما كان مأخوذا في الأصل من خلق الثوب كان التركيب من أجزاء شتى مأخوذا في معناه بخلاف الجعل ، ولعل هذا هو السبب في تخصيص الخلق بالسماوات والأرض لما فيها من التركيب بخلاف الظلمة والنور ، ولذا خصا باستعمال الجعل . والله أعلم .
وقد أتى بالظلمات بصيغة الجمع دون النور ، ولعله لكون الظلمة متحققة بالقياس إلى النور فإنها عدم النور فيما من شأنه أن يتنور فتتكثر بحسب مراتب قربه من النور وبعده بخلاف النور فإنه أمر وجودي لا يتحقق بمقايسته إلى الظلمة التي هي عدمية ، وتكثيره تصورا بحسب قياسه التصوري إلى الظلمة لا يوجب تعدده وتكثره حقيقة .
قوله تعالى : {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} مسوق للتعجب المشوب بلوم أي إن الله سبحانه بخلقه السماوات والأرض وجعله الظلمات والنور متوحد بالألوهية متفرد بالربوبية لا يماثله شيء ولا يشاركه ، ومن العجب أن الذين كفروا مع اعترافهم بأن الخلق والتدبير لله بحقيقة معنى الملك دون الأصنام التي اتخذوها آلهة يعدلون بالله غيره من أصنامهم ويسوون به أوثانهم فيجعلون له أندادا تعادله بزعمهم فهم ملومون على ذلك .
وبذلك يظهر وجه الإتيان بثم الدال على التأخير والتراخي فكأن المتكلم لما وصف تفرده بالصنع والإيجاد وتوحده بالألوهية والربوبية ذكر مزعمة المشركين وأصحاب الأوثان أن هذه الحجارة والأخشاب المعمولة أصناما يعدلون بها رب العالمين فشغله التعجب
زمانا وكفه عن التكلم ثم جرى في كلامه وأشار إلى وجه سكوته ، وأن حيرة التعجب كان هو المانع عن جريه في كلامه فقال : {الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} .
قوله تعالى : {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً} يشير إلى خلقه العالم الإنساني الصغير بعد الإشارة إلى خلق العالم الكبير فيبين أن الله سبحانه هو الذي خلق الإنسان ودبر أمره بضرب الأجل لبقائه الدنيوي ظاهرا فهو محدود الوجود بين الطين الذي بدأ منه خلق نوعه وإن كان بقاء نسله جاريا على سنة الازدواج والوقاع كما قال تعالى : {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ} [السجدة : 7 ، 8] .
وبين الأجل المقضي الذي يقارن الموت كما قال تعالى : {كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ} : (العنكبوت : ـ 57) ومن الممكن أن يراد بالأجل ما يقارن الرجوع إلى الله سبحانه بالبعث فإن القرآن الكريم كأنه يعد الحياة البرزخية من الدنيا كما يفيده ظاهر قوله تعالى : {قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ، قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ ، قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} : [المؤمنون ـ 114] ، وقال أيضا : {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ، ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ ، وقال الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [الروم : ـ 56] .
وقد أبهم أمر الأجل بإتيانه منكرا في قوله : {ثُمَّ قَضى أَجَلاً} للدلالة على كونه مجهولا للإنسان لا سبيل له إلى المعرفة به بالتوسل إلى العلوم العادية .
قوله تعالى : {وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} تسمية الأجل تعيينه فإن العادة جرت في العهود والديون ونحو ذلك بذكر الأجل وهو المدة المضروبة أو آخر المدة باسمه ، وهو الأجل المسمى ، قال تعالى : {إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة : ـ 282] وهو الأجل بمعنى آخر المدة المضروبة ، وكذا قوله تعالى : {مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ} [العنكبوت : ـ 5] وقال تعالى في قصة موسى وشعيب : {قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ـ إلى أن قال ـ قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ} [القصص ـ 28] وهو الأجل بمعنى تمام المدة المضروبة .
والظاهر أن الأجل بمعنى آخر المدة فرع الأجل بمعنى تمام المدة استعمالا أي أنه استعمل كثيرا « الأجل المقضي » ثم حذف الوصف واكتفي بالموصوف فأفاد الأجل معنى الأجل المقضي ، قال الراغب في مفرداته : يقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان « أجل » فيقال : دنا أجله عبارة عن دنو الموت ، وأصله استيفاء الأجل ، انتهى .
وكيف كان فظاهر كلامه تعالى أن المراد بالأجل والأجل المسمى هو آخر مدة الحياة لإتمام المدة كما يفيده قوله : {فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ} الآية .
فتبين بذلك أن الأجل أجلان : الأجل على إبهامه ، والأجل المسمى عند الله تعالى . وهذا هو الذي لا يقع فيه تغير لمكان تقييده بقوله {عِنْدَهُ} وقد قال تعالى : {وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ} [النحل : ـ 96] وهو الأجل المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل قال تعالى : {إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} [يونس : 49] .
فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير المسمى نسبة المطلق المنجز إلى المشروط المعلق فمن الممكن أن يتخلف المشروط المعلق عن التحقق لعدم تحقق شرطه الذي علق عليه بخلاف المطلق المنجز فإنه لا سبيل إلى عدم تحققه البتة .
والتدبر في الآيات السابقة منضمة إلى قوله تعالى : {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ ، يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ} [الرعد : 39] يفيد أن الأجل المسمى هو الذي وضع في أم الكتاب ، وغير المسمى من الأجل هو المكتوب فيما نسميه بلوح المحو والإثبات ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن أم الكتاب قابل الانطباق على الحوادث الثابتة في العين أي الحوادث من جهة استنادها إلى الأسباب العامة التي لا تتخلف عن تأثيرها ، ولوح المحو والإثبات قابل الانطباق على الحوادث من جهة استنادها إلى الأسباب الناقصة التي ربما نسميها بالمقتضيات التي يمكن اقترانها بموانع تمنع من تأثيرها .
واعتبر ما ذكر من أمر السبب التام والناقص بمثال إضاءة الشمس فإنا نعلم أن هذه الليلة ستنقضي بعد ساعات وتطلع علينا الشمس فتضيء وجه الأرض لكن يمكن أن يقارن ذلك بحيلولة سحابة أو حيلولة القمر أو أي مانع آخر فتمنع من الإضاءة ، وأما إذا كانت الشمس فوق الأفق ولم يتحقق أي مانع مفروض بين الأرض وبينها فإنها تضيء وجه الأرض لا محالة .
فطلوع الشمس وحده بالنسبة إلى الإضاءة بمنزلة لوح المحو والإثبات ، وطلوعها مع حلول وقته وعدم أي حائل مفروض بينها وبين الأرض بالنسبة إلى الإضاءة بمنزلة أم الكتاب المسمى باللوح المحفوظ .
فالتركيب الخاص الذي لبنية هذا الشخص الإنساني مع ما في أركانه من الاقتضاء المحدود يقتضي أن يعمر العمر الطبيعي الذي ربما حددوه بمائة أو بمائة وعشرين سنة وهذا هو المكتوب في لوح المحو والإثبات مثلا غير أن لجميع أجزاء الكون ارتباطا وتأثيرا في الوجود الإنساني فربما تفاعلت الأسباب والموانع التي لا نحصيها تفاعلا لا نحيط به فأدى إلى حلول أجله قبل أن ينقضي الأمد الطبيعي ، وهو المسمى بالموت الاخترامي .
وبهذا يسهل تصور وقوع الحاجة بحسب ما نظم الله الوجود إلى الأجل المسمى وغير المسمى جميعا ، وأن الإبهام الذي بحسب الأجل غير المسمى لا ينافي التعين بحسب الأجل المسمى ، وأن الأجل غير المسمى والمسمى ربما توافقا وربما تخالفا والواقع حينئذ هو الأجل المسمى البتة .
هذا ما يعطيه التدبر في قوله : {ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} وللمفسرين تفسيرات غريبة للأجلين الواقعين في الآية : منها : أن المراد بالأجل الأول ما بين الخلق والموت والثاني ما بين الموت والبعث ، ، ذكره عدة من الأقدمين وربما روي عن ابن عباس .
ومنها : أن الأجل الأول أجل أهل الدنيا حتى يموتوا ، والثاني أجل الآخرة الذي لا آخر له ، ونسب إلى المجاهد والجبائي وغيرهما .
ومنها : أن الأجل الأول أجل من مضى ، والثاني أجل من بقي من سيأتي ، ونسب إلى أبي مسلم .
ومنها : أن الأجل الأول النوم ، والثاني الموت .
ومنها : أن المراد بالأجلين واحد ، وتقدير الآية الشريفة : ثم قضى أجلا وهذا أجل مسمى عنده .
ولا أرى الاشتغال بالبحث عن صحة هذه الوجوه وأشباهها وسقمها يسوغه الوقت على ضيقه ، ولا يسمح بإباحته العمر على قصره .
قوله تعالى : {ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ} من المرية بمعنى الشك والريب ، وقد وقع في الآية التفات من الغيبة إلى الحضور ، وكأن الوجه فيه أن الآية الأولى تذكر خلقا وتدبيرا عاما ينتج من ذلك أن الكفار ما كان ينبغي لهم أن يعدلوا بالله سبحانه غيره ، وكان يكفي في ذلك ذكرهم بنحو الغيبة لكن الآية الثانية تذكر الخلق والتدبير الواقعين في الإنسان خاصة فكان من الحري الذي يهيج المتكلم المتعجب اللائم أن يواجههم بالخطاب ويلومهم بالتجبيه كأنه يقول : هذا خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور عذرناكم في الغفلة عن حكمه لكون ذلك أمرا عاما ربما أمكن الذهول عما يقتضيه فما عذركم أنتم في امترائكم فيه وهو الذي خلقكم وقضى فيكم أجلا وأجل مسمى عنده ؟ .
قوله تعالى : {وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ} الآيتان السابقتان تذكران الخلق والتدبير في العوالم عامة وفي الإنسان خاصة ، ويكفي ذلك في التنبه على أن الله سبحانه هو الإله الواحد الذي لا شريك له في خلقه وتدبيره .
لكنهم مع ذلك أثبتوا آلهة أخرى وشفعاء مختلفة لوجوه التدبير المختلفة كإله الحياة وإله الرزق وإله البر وإله البحر وغير ذلك ، وكذا للأنواع والأقوام والأمم المتشتتة كإله السماء وإله هذه الطائفة وإله تلك الطائفة فنفى ذلك بقوله : {وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ} .
فالآية نظيرة قوله : {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ} [الزخرف : 84] مفادها انبساط حكم ألوهيته تعالى في السماوات وفي الأرض من غير تفاوت أو تحديد ، وهي إيضاح لما تقدم وتمهيد لما يتلوها من الكلام .
قوله تعالى : {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ} السر والجهر متقابلان وهما وصفان للأعمال ، فسرهم ما عملوه سرا وجهرهم ما عملوه جهرا من غير ستر .
وأما ما يكسبون فهو الحال النفساني الذي يكسبه الإنسان بعمله السري والجهري من حسنة أو سيئة فالسر والجهر المذكوران ـ كما عرفت ـ وصفان صوريان لمتون الأعمال الخارجية ، وما يكسبونه حال روحي معنوي قائم بالنفوس فهما مختلفان بالصورية والمعنوية ، ولعل اختلاف المعلومين من حيث نفسهما هو الموجب لتكرار ذكر العلم في قوله : {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ} .
والآية كالتمهيد لما ستتعرض له من أمر الرسالة والمعاد فإن الله سبحانه لما كان عالما بما يأتي به الإنسان من عمل سرا أو جهرا ، وكان عالما بما يكسبه لنفسه بعمله من خير أو شر ، وكان إليه زمام التربية والتدبير كان له أن يرسل رسولا بدين يشرعه لهداية الناس على الرغم مما يصر عليه الوثنيون من الاستغناء عن النبوة كما قال تعالى : {إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى} [الليل : 12] .
وكذا هو تعالى لما كان عالما بالأعمال وبتبعاتها في نفس الإنسان كان عليه أن يحاسبهم في يوم لا يغادر منهم أحدا كما قال تعالى : {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ ص : 28] .
______________________
1 . تفسير الميزان ، ج7 ، ص 5-12 .
تبدأ السّورة بالحمد لله والثناء عليه ، ثمّ تشرع بتوعية الناس على مبدأ التوحيد ، عن طريق خلق العالم الكبير (السموات والأرض) أولا ، ثمّ عن طريق خلق العالم الصغير (الإنسان) ثانيا : {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ} الله الذي هو مبدأ الظّلمة والنّور ، وبخلاف ما يعتقده الثنويون ، وهو وحده خالق كل شيء : {وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ} .
غير أنّ الكافرين والمشركين ، بدلا من أن يتعلموا من هذا النظام الواحد درس التوحيد ، يصطنعون لله الشريك والشبيه : {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (2) .
نلاحظ أنّ القرآن يذكر عقيدة المشركين بعد حرف العطف «ثم» الذي يدل في اللغة العربية على الترتيب والتراخي ، وهذا يدل على أن التوحيد كان في أوّل الأمر مبدأ فطريا وعقيدة عامّة للبشر ، بعد ذلك حصل الشرك كانحراف عن الأصل الفطري .
أمّا لماذا استعملت الآية كلمة «الخلق» بشأن السموات والأرض ، وكلمة «جعل» بشأن النّور والظلمة ، فإنّ للمفسّرين في ذلك كلاما كثيرا ، ولكن أقربه إلى الذهن هو القول بأنّ «الخلق» يكون في أصل وجود الشيء ، و «الجعل» يكون بشأن الخصائص والآثار والكيفيات التي هي نتيجة لخلق تلك المخلوقات ، ولما كان النّور والظلمة حالتين تابعتين فقد عبّر عنهما بلفظة «جعل» .
وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في تفسير هذه الآية قوله : «وكان في هذه الآية ردّ على ثلاثة أصناف منهم ، لما قال : {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ} فكان ردّا على الدهرية الذين قالوا : إنّ الأشياء لا بدء لها وهي دائمة ، ثمّ قال : {وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ} فكان ردّا على الثنوية الذين قالوا : إنّ النّور والظلمة هما المدبران .
ثمّ قال : {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} فكان ردّا على مشركي العرب الذين قالوا : إنّ أوثاننا آلهة» (3) .
هل الظّلمة من المخلوقات ؟
تفيد الآية إنّه مثلما أن «النّور» من مخلوقات الله ، فإنّ «الظلمة» كذلك من مخلوقاته ، مع أنّ الفلاسفة والمختصين بالعلوم الطبيعية يعرفون أنّ الظلمة هي انعدام النّور ، ولهذا فلا يمكن اطلاق صفة «المخلوق» على المعدوم إذن ، كيف تعتبر الآية المذكورة الظلمة من المخلوقات ؟
في ردّ هذا الاعتراض نقول .
أوّلا : الظّلمة ليس تعني دائما الظلام المطلق ، بل كثيرا ما تطلق على النّور الضعيف جدا بالمقارنة مع النّور القوي ، فنحن جميعا نقول ، مثلا ، ليل مظلم ، مع العلم بأنّ ظلام الليل ليس ظلاما مطلقا ، بل هو مزيج من نور النجوم الضعيف أو مصادر أخرى للنور ، وعلى هذا يكون مفهوم الآية هو أنّ الله جعل لكم نور النهار وظلام الليل ، فالأوّل نور قوي والآخر نور ضعيف جدا وواضح أنّ الظلمة ، بهذا المعنى ، تكون من المخلوقات .
وثانيا : صحيح أنّ الظلمة المطلقة أمر عدمي ، ولكن الأمر العدمي ـ في ظروف خاصّة ـ يكون نابعا من أمر وجودي ، أي أنّ يوجد الظلمة المطلقة في ظروف خاصة لهدف معين ، لا بدّ أن يكون قد استعمل لذلك وسائل وجودية ، فإذا أردنا أنّ نجعل الغرفة مظلمة لتحميض صورة ـ مثلا ـ فعلينا أن نمنع النّور لكي تحصل الظلمة في تلك اللحظة المعينة ، وظلمة هذا شأنها ظلمة مخلوقة (مخلوقة بالتبع) .
وإذا لم يكن (العدم المطلق) مخلوقا ، فإن (العدم الخاص) له نصيب من الوجود ، وهو مخلوق .
النّور رمز الوحدة ، والظلمة رمز التشتت : الأمر الآخر الذي ينبغي الالتفات إليه هنا هو أنّ لفظة (نور) ترد في القرآن بصيغة المفرد ، بينما الظلمة تأتي بصيغة الجمع (ظلمات) .
وقد يكون هذا إشارة لطيفة إلى حقيقة كون الظلام (المادي والمعنوي) مصدرا دائما للتشتت والانفصال والتباعد ، بينما النّور رمز التوحد والتجمع .
طالما شاهدنا أنّنا في الليلة الصيفية الظلماء نوقد سراجا في فناء الدار ، ثمّ لا تمضي إلّا دقائق حتى نرى مختلف أنواع الحشرات تتجمع حول السراج مؤلفة تجمعا حيا حول النّور ، ولكننا إذا أطفأنا السراج تفرقت الحشرات كل إلى جهة ، كذلك الحال في الشؤون المعنوية والاجتماعية . فنور العلم والقرآن والإيمان أساس الوحدة ، وظلام الجهل والكفر والنفاق أساس التفرق والتشتت .
قلنا : إنّ هذه السورة تسعى إلى لفت نظر الإنسان إلى العالم الكبير لتثبيت قواعد عبادة الله والتوحيد في القلوب ، توجه نظره أوّلا إلى العالم الكبير ، والآية التّالية تلفت نظره إلى العالم الصغير (الإنسان) فتشير إلى أعجب أمر ، وهو خلقه من الطين فتقول {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ} .
صحيح أنّنا ولدنا من أبوينا ، لا من الطين ، ولكن بما أنّ خلق الإنسان الأوّل كان من الطين ، فيصح أن نخاطب نحن أيضا على أننا مخلوقين من الطين .
وتستمر السورة فتشير إلى مراحل تكامل عمر الإنسان فتقول : إنّ الله بعد ذلك عين مدّة يقضها الإنسان على هذه الأرض للنمو والتكامل : {ثُمَّ قَضى أَجَلاً} .
«الأجل» في الأصل بمعنى «المدّة المعينة» و «قضاء الأجل» يعني تعيين تلك المدّة أو إنهاءها ، ولكن كثيرا ما يطلق على الفرصة الأخيرة اسم «الأجل» ، فتقول ، مثلا : جاء أجل الدّين ، أي أنّ آخر موعد التسديد الدّين قد حل . ومن هنا أيضا يكون التعبير عن آخر لحظة من لحظات عمر الإنسان بالأجل لأنّها موعد حلول الموت .
ثمّ لاستكمال البحث تقول : {وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} .
بعد ذلك تخاطب الآية المشركين وتقول لهم : {ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ} أي تشكون في قدرة الخالق الذي خلق الإنسان من هذه المادة التافهة (الطين) واجتاز به هذه المراحل المدهشة ، وتعبدون من دونه موجودات لا قيمة لها كالأصنام .
لا شك أنّ «الأجل المسمى» و «أجلا» في الآية مختلفتان في المعنى ، أمّا اعتبار الإثنين بمعنى واحد فلا ينسجم مع تكرار كلمة «أجل» خاصّة مع ذكر القيد : «مسمى» في الثّاني .
لذلك بحث المفسّرون كثيرا في الاختلاف بين التعبيرين ، والقرائن الموجودة في القرآن والرّوايات التي وصلتنا عن أهل البيت عليهم السلام تفيد أنّ «أجل» وحدها تعني غير الحتمي من العمر والوقت والمدّة ، و «الأجل المسمى» بمعنى الحتمي منها ، وبعبارة أخرى «الأجل المسمى» هو «الموت الطبيعي» و «الأجل» هو الموت غير الطبيعي .
ولتوضيح ذلك نقول : إنّ الكثير من الموجودات لها من حيث البناء الطبيعي والذاتي الاستعداد القابلية للبقاء مدّة طويلة ، ولكن قد تحصل خلال ذلك موانع تحول بينها وبين الوصول إلى الحد الطبيعي الأعلى ، افترض سراجا نفطيا يستطيع أنّ يبقى مشتعلا مدّة عشرين ساعة مع الأخذ بنظر الاعتبار سعته النفطية ، غير أن هبوب ريح قوية ، أو هطول المطر عليه أو عدم العناية به ، يكون سببا في قصر مدّة الإضاءة ، فإذا لم يصادف السراج أي مانع ، وظل مشتعلا حتى آخر قطرة من نفطه ثمّ انطفأ نقول : إنّه وصل إلى أجله المحتوم ، وإذا أطفأته الموانع قبل ذلك ، فيكون عمره «أجل» غير محتوم .
والحال كذلك بالنسبة للإنسان ، فإذا توفرت جميع ظروف بقائه وزالت جميع الموانع من طريق استمرار حياته ، فإن بنيته تضمن بقاءه مدّة طويلة إلى حد معيّن ، ولكنّه إذا تعرض لسوء التغذية ، أو ابتلى بنوع من الإدمان ، أو إذا انتحر ، أو أعدم لجريمة ومات قبل تلك المدّة ، فإنّ موته في الحالة الاولى يكون أجلا محتوما ، وفي الحالة الثّانية أجلا غير محتوم .
وبعبارة أخرى : الأجل الحتمي يكون عند ما ننظر إلى «مجموع العلل التامّة» . والأجل غير الحتمي يكون عند ما ننظر إلى «المقتضيات» فقط .
استنادا إلى هذين النوعين من الأجل يتّضح لنا كثير من الأمور ، من ذلك مثلا ما نقرؤه في الرّوايات والأحاديث من أن صلة الرحم تطيل العمر ، وقطعها يقصر العمر ، وواضح أنّ العمر هنا هو الأجل غير الحتمي .
أمّا قوله تعالى : {فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف ، 34] . فهو الأجل المحتوم ، أي أنّ الإنسان قد وصل إلى نهاية عمره ، وهو لا يشمل الموت غير المحتوم السابق لأوانه .
ولكن علينا أن نعلم ـ على كل حال ـ أنّ الأجلين يعينهما الله ، الأوّل بصورة مطلقة ، والثّاني بصورة معلقة أو مشروطة ، وهذا يشبه بالضبط قولنا : إنّ هذا السراج ينطفئ بعد عشرين ساعة بدون قيد ولا شرط ، ونقول إنّه ينطفئ بعد ساعتين إذا هبت عليه ريح ، كذلك الأمر بالنسبة للإنسان والأقوام والملل ، فنقول : إنّ الله شاء أن يموت الشخص الفلاني أو أن تنقرض الأمّة الفلانية بعد كذا من السنين ، ونقول إنّ هذه الأمّة إذا سلكت طريق الظلم والنفاق والتفرقة والكسل والتهاون فإنّها ستهلك في ثلث تلك المدّة ، كلا الأجلين من الله ، الأوّل مطلق والآخر مقيد بشروط .
جاء عن الإمام الصادق عليه السلام تعقيبا على هذه الآية قوله : «هما أجلان : أجل محتوم وأجل موقوف» كما جاء عنه في أحاديث أخرى أنّ الأجل الموقوف قابل للتقديم والتأخير ، والأجل الحتمي لا يقبل التغيير (4) .
{وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ} [الأنعام : 3] .
هذه الآية تكمل البحث السابق في التوحيد ووحدانية الله ، وترد على الذين يقولون بوجود إله لكل مجموعة من الكائنات ، أو لكل ظاهرة من الظواهر ، فيقولون : إله المطر ، وإله الحرب ، وإله السلم ، وإله السماء ، وما إلى ذلك ، تقول الآية : {وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ} (5) أي كما أنّه خالق كل شيء فهو مدبر كل شيء أيضا ، وبذلك ترد الآية على مشركي الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أنّ الخالق هو «الله» لكنّهم كانوا يؤمنون أنّ تدبير الأمور بيد الأصنام .
هنالك احتمال آخر في تفسير الآية ، وهو أنّها تعني حضور الله في كل مكان ، في السموات والأرض ، ولا يخلو منه مكان ، فليس هو بجسم ليشغل حيزا معينا ، بل هو المحيط بكل الأمكنة .
من الطبيعي أن يكون الحاكم على كل شيء والمدبر لكل الأمور والحاضر في كل مكان عارفا بجميع الأسرار والخفايا ولهذا تقول الآية : إنّ ربّا كهذا {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ} .
قد يقال بأنّ (السرّ) و (الجهر) يشملان أعمال الإنسان ونواياه ، وعلى ذلك فلا حاجة لذكر {وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ} .
ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ «الكسب» هو نتائج العمل والحالات النفسية الناشئة عن الأعمال الحسنة والأعمال السيئة ، أي أنّ الله يعلم أعمالكم ونواياكم ، كما يعلم الآثار التي تخلفها تلك الأعمال والنوايا في نفوسكم ، وعلى كل حال ، فانّ ذكر العبارة هذه يفيد التوكيد بشأن أعمال الإنسان .
_______________________
1- تفسير الأمثل ، ج3 ، ص9-15 .
2ـ «يعدلون» من «عدل» على وزن «حفظ» بمعنى التساوي ، وهي هنا بمعنى (العديل) أي الشريك والشبيه والمثيل .
3ـ تفسير «نور الثقلين» ، ج 1 ، ص 701 .
4ـ تفسير «نور الثقلين» ، ج 1 ، ص 504 .
5ـ ثمّة اختلاف بين المفسّرين حول إعراب هذه العبارة القرآنية والظاهر أنّ «هو» مبتدأ و «الله» خبر . و{فِي السَّماواتِ ...} جار ومجرور متعلقان بفعل تدل عليه كلمة «الله» والتقدير : (هو المتفرد في السموات والأرض بالألوهية) .



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|