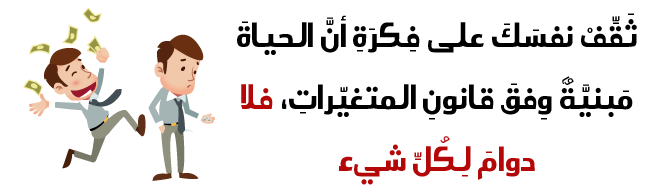
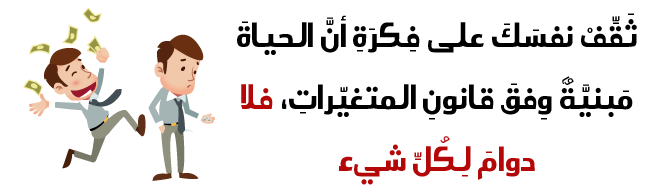

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-2-2017
التاريخ: 1-3-2017
التاريخ: 10-5-2017
التاريخ: 2-3-2017
|
قال تعالى : {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177]
{ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب } بين سبحانه أن البر كله ليس في الصلاة فإن الصلاة إنما أمر بها لكونها مصلحة في الإيمان و صارفة عن الفساد وكذلك العبادات الشرعية إنما أمر بها لما فيها من الألطاف والمصالح الدينية وذلك يختلف بالأزمان والأوقات فقال ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة حتى يضاف إلى ذلك غيره من الطاعات التي أمر الله بها عن ابن عباس ومجاهد واختاره أبو مسلم وقيل معناه ليس البر ما عليه النصارى من التوجه إلى المشرق ولا ما عليه اليهود من التوجه إلى المغرب عن قتادة والربيع واختاره الجبائي والبلخي.
{ولكن البر من آمن بالله} أي لكن البر بر من آمن بالله كقولهم السخاء حاتم والشعر زهير أي السخاء سخاء حاتم والشعر شعر زهير عن قطرب والزجاج والفراء واختاره الجبائي وقيل ولكن البار أو ذا البر من آمن بالله أي صدق بالله ويدخل فيه جميع ما لا يتم معرفة الله سبحانه إلا به كمعرفة حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته الواجبة والجائزة وما يستحيل عليه سبحانه ومعرفة عدله وحكمته.
{واليوم الآخر} يعني القيامة ويدخل فيه التصديق بالبعث والحساب والثواب والعقاب {والملائكة} أي وبأنهم عباد الله المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون {والكتاب } أي وبالكتب المنزلة من عند الله إلى أنبيائه {والنبيين } وبالأنبياء كلهم وأنهم معصومون مطهرون وفيما أدوه إلى الخلق صادقون وإن سيدهم وخاتمهم محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) وإن شريعته ناسخة لجميع الشرائع والتمسك بها لازم لجميع المكلفين إلى يوم القيامة {وآتى المال } أي وأعطى المال .
{على حبه } فيه وجوه ( أحدها ) إن الكناية راجعة إلى المال أي على حب المال فيكون المصدر مضافا إلى المفعول وهو معنى قول ابن عباس وابن مسعود قال هو أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ( وثانيها ) أن تكون الهاء راجعة إلى من آمن فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل ولم يذكر المفعول لظهور المعنى ووضوحه وهو مثل الوجه الأول سواء في المعنى (وثالثها) أن تكون الهاء راجعة إلى الإيتاء الذي دل عليه قوله {وآتى المال } والمعنى على حبه الإعطاء ويجري ذلك مجرى قول القطامي :
هم الملوك وأبناء الملوك لهم *** والآخذون به والساسة الأول
فكني بالهاء عن الملك لدلالة قول الملوك عليه ( ورابعها ) أن الهاء راجعة إلى الله لأن ذكره سبحانه قد تقدم أي يعطون المال على حب الله وخالصا لوجهه قال المرتضى قدس الله روحه لم نسبق إلى هذا الوجه في هذه الآية وهو أحسن ما قيل فيها لأن تأثير ذلك أبلغ من تأثير حب المال لأن المحب للمال الضنين به متى بذله وأعطاه ولم يقصد به القربة إلى الله تعالى لم يستحق شيئا من الثواب وإنما يؤثر حبه للمال في زيادة الثواب متى حصل قصد القربة والطاعة ولو تقرب بالعطية وهو غير ضنين بالمال ولا محب له لا يستحق الثواب {ذوي القربى } أراد به قرابة المعطي كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه سئل عن أفضل الصدقة فقال جهد المقل على ذي الرحم الكاشح وقوله لفاطمة بنت قيس لما قالت يا رسول الله إن لي سبعين مثقالا من ذهب قال اجعليها في قرابتك ويحتمل أن يكون أراد قرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) كما في قوله {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) .
{واليتامى} اليتيم من لا أب له مع الصغر قيل أراد يعطيهم أنفسهم المال وقيل أراد ذوي اليتامى أي يعطي من تكفل بهم لأنه لا يصح إيصال المال إلى من لا يعقل فعلى هذا يكون اليتامى في موضع جر عطفا على القربى وعلى القول الأول يكون في موضع نصب عطفا على {ذوي القربى } {والمساكين} يعني أهل الحاجة {وابن السبيل } يعني المنقطع به عن أبي جعفر ومجاهد وقيل الضيف عن ابن عباس وقتادة وابن جبير {والسائلين} أي الطالبين للصدقة لأنه ليس كل مسكين يطلب.
{وفي الرقاب} فيه وجهان (أحدهما) عتق الرقاب بأن يشتري ويعتق (والآخر) في رقاب المكاتبين والآية محتملة للأمرين فينبغي أن تحمل عليهما وهو اختيار الجبائي والرماني وفي هذه الآية دلالة على وجوب إعطاء مال الزكاة المفروضة بلا خلاف وقال ابن عباس في المال حقوق واجبة سوى الزكاة وقال الشعبي هي محمولة على وجوب حقوق في مال الإنسان غير الزكاة مما له سبب وجوب كالإنفاق على من يجب عليه نفقته وعلى من يجب عليه سد رمقه إذا خاف عليه التلف وعلى ما يلزمه من النذور والكفارات ويدخل في هذا أيضا ما يخرجه الإنسان على وجه التطوع والقربة إلى الله لأن ذلك كله من البر واختاره الجبائي قالوا ولا يجوز حمله على الزكاة المفروضة لأنه عطف عليه الزكاة وإنما خص هؤلاء لأن الغالب أنه لا يوجد الاضطرار إلا في هؤلاء .
{وأقام الصلاة} أي أداها لميقاتها وعلى حدودها {وآتى الزكاة} أي أعطى زكاة ماله {والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} أي والذين إذا عاهدوا عهدا أوفوا به يعني العهود والنذور التي بينهم وبين الله تعالى والعقود التي بينهم وبين الناس وكلاهما يلزم الوفاء به {والصابرين في البأساء والضراء} يريد بالبأساء البؤس والفقر وبالضراء الوجع والعلة عن ابن مسعود وقتادة وجماعة من المفسرين {وحين البأس } يريد وقت القتال وجهاد العدو.
وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه يريد إذا اشتد الحرب {أولئك } إشارة إلى من تقدم ذكرهم {الذين صدقوا } أي صدقوا الله فيما قبلوا منه والتزموه علما وتمسكوا به عملا عن ابن عباس والحسن وقيل الذين صدقت نياتهم لأعمالهم على الحقيقة .
{وأولئك هم المتقون } أي اتقوا بفعل هذه الخصال نار جهنم واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن المعني بها أمير المؤمنين (عليه السلام) لأنه لا خلاف بين الأمة إنه كان جامعا لهذه الخصال فهو مراد بها قطعا ولا قطع على كون غيره جامعا لها ولهذا قال الزجاج والفراء أنها مخصوصة بالأنبياء المعصومين لأن هذه الأشياء لا يؤديها بكليتها على حق الواجب فيها إلا الأنبياء .
__________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج1 ، ص485-488.
ذكر اللَّه سبحانه في هذه الآية أمورا اعتبرها أركانا للبر والتقوى والصدق في الايمان ، ومن هذه الأمور ما يتعلق بالعقيدة ، ومنها ما يتعلق ببذل المال ، ومنها بالعبادة ، ومنها بالأخلاق ، وقبل أن يشير إلى كل صنف منها مهد بقوله تعالى :
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ}. هذا خطاب عام يشمل الجميع ، حتى ولوكان سبب النزول خاصا ، لأن العبرة بعموم اللفظ ، لا بسبب النزول ، والمراد بالخطاب توجيه المؤمنين والمصلين إلى أن مجرد الصلاة إلى ناحية معينة ليس هو الخير المقصود من الدين ، لأن الصلاة انما شرعت لإقبال المصلي على اللَّه ، والاعراض عمن سواه . وبعد هذا التمهيد شرع ببيان أصول العقيدة التي هي من أركان البر ، وحصرها بخمسة أمور تضمنها قوله تعالى :
{ولكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ والْمَلائِكَةِ والْكِتابِ والنَّبِيِّينَ} . الايمان باللَّه هو الأساس لعمل البر ، والباعث على طاعة اللَّه في جميع ما أمر به ،
ونهى عنه ، والايمان بالملائكة ايمان بالوحي المنزل على الأنبياء ، وانكار الملائكة انكار للوحي والنبوة : {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ} – [الشعراء 194]. والايمان بالكتاب ايمان بالقرآن ، والايمان بالنبيين ايمان بشرائعهم . .
وترجع هذه الأمور الخمسة إلى ثلاثة : الايمان باللَّه والنبوة واليوم الآخر ، لأن الايمان بالنبي يتضمن الايمان بالملائكة والكتاب . ثم أشار سبحانه إلى التكاليف المالية بقوله :
{وآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ} . قيل : ان الضمير في حبه عائد إلى اللَّه تعالى ، حيث تقدم اسمه جل وعلا في قوله : ( مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ ) . ويكون المعنى ان المعطي أعطى المال لوجه اللَّه . وقيل : بل يعود الضمير على المال ، ويجري مجرى قوله تعالى : {لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} . وقوله :
{ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ} . وهذا هو الأظهر ، لأن الضمير يعود إلى الأقرب ، دون الأبعد . ثم ان المراد بإيتاء المال هنا غير الزكاة الواجبة ، لأنه تعالى عطف عليه إيتاء الزكاة ، والعطف يقتضي التغاير .
وذكرت الآية من الذين ينبغي اعطاؤهم المال ستة أصناف :
1 – ذو القربى ، وهم قرابة صاحب المال ، لأنهم أحق الناس بالبر والصلة ، قال تعالى : {ولا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى} – [النور 22 ]. وتجب نفقة القريب على قريبه إذا كان من الآباء والأبناء ، مع عجزه عن الإنفاق على نفسه وقدرة الآخر عليه ، وما عدا ذلك يكون إيتاء ذوي القربى مستحبا لا واجبا عند الفقهاء (2) .
2 - اليتامى الذين لا مال لهم ، ولا كفيل يعولهم ، فيجب على أهل اليسار كفالتهم وكفايتهم ، مع عدم وجود بيت مال للمسلمين .
3 - المساكين ، وهم أهل الحاجة الذين لا يمدون للناس يد المذلة .
4 - ابن السبيل ، وهو الذي انقطع في السفر ، ولا يستطيع العودة إلى وطنه من غير عون .
5 - السائلون الذين يمدون إلى الناس كف المذلة ، وهذا السؤال محرم شرعا الا لضرورة ملحة ، تماما كأكل الميتة في رأينا ، ويكفي دليلا على تحريمه انه ذل وهوان ، والإهانة محرمة من حيث هي ، سواء أصدرت من الغير ، أم من النفس ، وفي الحديث : (لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي) والمرة بكسر الميم القوة ، والسوي سليم الجسم ، والمراد به القادر على الكسب .
6 - في الرقاب ، أي شراء العبيد ، ثم عتقهم وتحريرهم من العبودية ، ولا مورد لهذا الصنف اليوم بعد أن الغي الرق .
وتجمل الإشارة إلى ان هذه الأصناف الستة ذكرها اللَّه سبحانه على سبيل المثال ، دون الحصر . . فان هناك أمورا كثيرة يحسن فيها بذل المال كإنشاء المدارس ، ودور الأيتام ، والمصحات ، والدفاع عن الدين والوطن ، وسائر المشاريع العامة .
وإذا توقفت صيانة النفس المحترمة على بذل المال وجب بذله على المستطيع ، لأن هذه الصيانة واجبة ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب .
وأشار تعالى إلى الركن العبادي للبر بقوله : {وأَقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ} .
والصلاة تزكية للنفس ، والصوم تزكية للبدن ، والزكاة تزكية للمال .
وأشار إلى الركن الأخلاقي بقوله سبحانه : {والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا} .
والعهد الذي يجب الوفاء به على قسمين : الأول ما يكون بين العبد وربه ، مثل اليمين والنذر والعهد بالشروط المذكورة في كتب الفقه ، وفصلنا ذلك في الجزء الخامس من كتاب (فقه الإمام جعفر الصادق) .
النوع الثاني من العهد الذي يجب الوفاء به المعاملات التي تجري بين الناس ، كالبيع والإجارة والدين ، وما إلى ذلك . . والمؤمن البار يفي بجميع التزاماته ، حتى ولولم يكن عليه اثباتات وسندات ترغمه على الوفاء وأداء الحق . . أما الوعد فلا يجب الوفاء به شرعا ، بل يستحب عند الفقهاء .
ومن الأخلاق الحميدة التي هي من أركان البر الصبر في الشدائد المشار إليه بقوله تعالى : {والصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ والضَّرَّاءِ وحِينَ الْبَأْسِ} . والبأساء الفقر ، والضراء المرض ، وما إليه ، وحين البأس شدة الحرب ، وليس القصد من الصبر على الفقر والمرض الرضا بهما . . كلا ، فان الإسلام قد أوجب السعي جهد المستطاع للتخلص من الفقر والمرض والجهل ، ومن كل ما يعوق الحياة عن التقدم ، وانما القصد ان لا ينهار الإنسان أمام الشدائد ، وان يتماسك ويتمالك ويعمل بروية وثبات للتخلص مما ألمّ به من النوازل . . وقال بعض المفسرين :
انما خص اللَّه هذه الثلاث بالذكر ، مع ان الصبر محمود في جميع الأحوال ، لأن هذه الثلاث أشد البلاءات جميعا ، فمن صبر فيها كان في غيرها أصبر .
{أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} . أولئك إشارة إلى الذين استجمعوا كل هذه الخصال من أصول العقيدة ، وبذل المال وتأدية العبادة للَّه ، والأخلاق الحميدة ، وانهم الصادقون في ايمانهم ، المتقون بأفعالهم لغضب اللَّه وعذابه ، أما الذين يقولون بأفواههم آمنّا ، ولا ينفقون ما يحبون ، ويفون بما يلتزمون ، ويصبرون في الشدائد ، أما هؤلاء فهم أبعد الناس عن البر وأهله .
البارّ في مفهوم القرآن :
تعرضت هذه الآية لخمسة أمور : أولها أصول العقيدة ، وثانيها التكاليف المالية ، وثالثها العبادة ، ورابعها الوفاء بالعهد ، وخامسها الصبر في الشدائد ، والأخيران من شؤون الأخلاق .
وبديهة ان العبادة كالصلاة والصوم أثر من آثار الايمان باللَّه ، وعلامة من علاماته التي لا تنفك عنه ، لأن من لا يعترف بوجود اللَّه لا يتعبد له . . أما بذل المال والوفاء بالعهد والصبر في الشدائد فتكون من المؤمن والجاحد ، فان أكثر المؤمنين باللَّه أو الكثير منهم يقولون ما لا يفعلون ، ويبخلون بالقليل ، حتى على أنفسهم ، وينهارون جزعا أمام كل فاجعة ونازلة . . وقد يضحي الجاحد بالغالي والثمين في سبيل العدالة والانسانية ، ويثبت في الشدائد ، ويصدق في جميع أقواله وأفعاله . . إذن ، لا تلازم بحسب الظاهر بين الايمان والخلق الحميد ، ولا بين الكفر والخلق الذميم أما في الواقع فلا ايمان بلا تقوى .
ولكن هذه الآية : {لَيْسَ الْبِرَّ} الخ . . قد اعتبرت الايمان والأخلاق الحميدة
كلا لا يتجزأ ، ووحدة لا تنفصم بالنسبة إلى البر والخير ، فلا الايمان باللَّه وحده يجعل الإنسان من الأبرار ، ولا الأخلاق من غير ايمان تجعله كذلك ، بل لا بد من الايمان والأخلاق والتعبد للَّه . . وعليه فالبارّ في مفهوم القرآن هو المؤمن المتعبد الوفي الكريم الصابر .
____________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص270-274.
2- قال الحنفية : تجب نفقة للقريب على قريبه إذا كانت القرابة موجبة لحرمة الزواج . وقال الحنابلة :
يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه . وقال المالكية : لا تجب النفقة إلا على الأبوين والأولاد من الصلب فقط دون بقية الفروع والأصول . وقال الإمامية والشافعية : تجب نفقة على الآباء وان علوا ، والأبناء وان نزلوا دون غيرهم من الأقارب .
قيل: كثر الجدال والخصام بين الناس بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وطالت المشاجرة فنزلت الآية.
قوله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب}، البر بالكسر التوسع من الخير والإحسان، والبر بالفتح صفة مشبهة منه، والقبل بالكسر فالفتح الجهة ومنه القبلة وهي النوع من الجهة، وذوو القربى الأقرباء، واليتامى جمع يتيم وهو الذي لا والد له، والمساكين جمع مسكين وهو أسوأ حالا من الفقير، وابن السبيل المنقطع عن أهله، والرقاب جمع رقبة وهي رقبة العبد، والبأساء مصدر كالبؤس وهو الشدة والفقر، والضراء مصدر كالضر وهو أن يتضرر الإنسان بمرض أو جرح أو ذهاب مال أو موت ولد، والبأس شدة الحرب.
قوله تعالى: {ولكن البر من آمن بالله}، عدل عن تعريف البر بالكسر إلى تعريف البر بالفتح ليكون بيانا وتعريفا للرجال مع تضمنه لشرح وصفهم وإيماء إلى أنه لا أثر للمفهوم الخالي عن المصداق ولا فضل فيه، وهذا دأب القرآن في جميع بياناته فإنه يبين المقامات ويشرح الأحوال بتعريف رجالها من غير أن يقنع ببيان المفهوم فحسب.
وبالجملة قوله {ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر}، تعريف للأبرار وبيان لحقيقة حالهم، وقد عرفهم أولا في جميع المراتب الثلاث من الاعتقاد والأعمال والأخلاق بقوله: {من آمن بالله} وثانيا بقوله: {أولئك الذين صدقوا} وثالثا بقوله: {وأولئك هم المتقون}.
فأما ما عرفهم به أولا فابتدأ فيه بقوله تعالى: {من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين}، وهذا جامع لجميع المعارف الحقة التي يريد الله سبحانه من عباده الإيمان بها، والمراد بهذا الإيمان الإيمان التام الذي لا يتخلف عنه أثره، لا في القلب بعروض شك أو اضطراب أو اعتراض أو سخط في شيء مما يصيبه مما لا ترتضيه النفس، ولا في خلق ولا في عمل، والدليل على أن المراد به ذلك قوله في ذيل الآية {أولئك الذين صدقوا} فقد أطلق الصدق ولم يقيده بشيء من أعمال القلب والجوارح فهم مؤمنون حقا صادقون في إيمانهم كما قال تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] وحينئذ ينطبق حالهم على المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان التي مر بيانها في ذيل قوله تعالى { إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ} [البقرة: 131]. ثم ذكر تعالى نبذا من أعمالهم بقوله: {وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلوة وآتى الزكوة}، فذكر الصلاة - وهي حكم عبادي - وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } [العنكبوت: 45] ، وقال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ، وذكر الزكاة - وهي حكم مالي فيه صلاح المعاش - وذكر قبلهما إيتاء المال وهو بث الخير ونشر الإحسان غير الواجب لرفع حوائج المحتاجين وإقامة صلبهم.
ثم ذكر سبحانه نبذا من جمل أخلاقهم بقوله: {والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس}، فالعهد هو الالتزام بشيء والعقد له - وقد أطلقه تعالى – وهو مع ذلك لا يشمل الإيمان والالتزام بأحكامه كما توهمه بعضهم - لمكان قوله {إذا عاهدوا}، فإن الالتزام بالإيمان ولوازمه لا يقبل التقيد بوقت دون وقت - كما هو ظاهر - ولكنه يشتمل بإطلاقه كل وعد وعده الإنسان وكل قول قاله التزاما كقولنا: لأفعلن كذا ولأتركن، وكل عقد عقد به في المعاملات و المعاشرات ونحوها، والصبر هو الثبات على الشدائد حين تهاجم المصائب أو مقارعة الأقران، وهذان الخلقان وإن لم يستوفيا جميع الأخلاق الفاضلة غير أنهما إذا تحققا تحقق ما دونهما، والوفاء بالعهد والصبر عند الشدائد خلقان يتعلق أحدهما بالسكون والآخر بالحركة وهو الوفاء فالإتيان بهذين الوصفين من أوصافهم بمنزلة أن يقال: إنهم إذا قالوا قولا أقدموا عليه ولم يتجافوا عنه بالزوال.
وأما ما عرفهم به ثانيا بقوله: {أولئك الذين صدقوا}، فهو وصف جامع لجمل فضائل العلم والعمل فإن الصدق خلق يصاحب جميع الأخلاق من العفة والشجاعة والحكمة والعدالة وفروعها فإن الإنسان ليس له إلا الاعتقاد والقول والعمل، وإذا صدق تطابقت الثلاثة فلا يفعل إلا ما يقول ولا يقول إلا ما يعتقد، والإنسان مفطور على قبول الحق والخضوع له باطنا وإن أظهر خلافه ظاهرا فإذا أذعن بالحق وصدق فيه قال ما يعتقده وفعل ما يقوله وعند ذلك تم له الإيمان الخالص والخلق الفاضل والعمل الصالح، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } [التوبة: 119] ، والحصر في قوله {أولئك الذين صدقوا}، يؤكد التعريف وبيان الحد، والمعنى - والله أعلم - إذا أردت الذين صدقوا فأولئك هم الأبرار.
وأما ما عرفهم به ثالثا بقوله وأولئك هم المتقون، الحصر لبيان الكمال فإن البر والصدق لولم يتما لم يتم التقوى.
والذي بينه تعالى في هذه الآية من الأوصاف الأبرار هي التي ذكرها في غيرها.
قال تعالى: { إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} [الإنسان: 5 - 12] ، فقد ذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق لوجه الله والوفاء بالعهد والصبر، وقال تعالى أيضا: {كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ } [المطففين: 18 - 22]. - إلى أن قال - { يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ} [المطففين: 25] - إلى أن قال {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ} [المطففين: 28] ، بالتطبيق بين هذه الآيات والآيات السابقة عليها يظهر حقيقة وصفهم ومآل أمرهم إذا تدبرت فيها، وقد وصفتهم الآيات بأنهم عباد الله وأنهم المقربون، وقد وصف الله سبحانه عباده فيما وصف بقوله: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } [الحجر: 42] ، ووصف المقربين بقوله: { وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ} [الواقعة: 10 - 12] ، فهؤلاء هم السابقون في الدنيا إلى ربهم السابقون في الآخرة إلى نعيمه، ولو أدمت البحث عن حالهم فيما تعطيه الآيات لوجدت عجبا.
وقد بان مما مر أن الأبرار أهل المرتبة العالية من الإيمان، وهي المرتبة الرابعة على ما مر بيانه سابقا، قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام: 82].
قوله تعالى: {والصابرين في البأساء} ، منصوب على المدح إعظاما لأمر الصبر، وقد قيل إن الكلام إذا طال بذكر الوصف بعد الوصف فمذهبهم أن يعترضوا بين الأوصاف بالمدح والذم، واختلاف الإعراب بالرفع والنصب.
_________________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج1 ، ص355-358.
أساس البّر
جاء في تفسير آيات تغيير القبلة، أن النصارى كانوا يتجهون في عباداتهم نحو الشرق واليهود نحو الغرب، وقرر الله الكعبة قبلة للمسلمين، وكانت في اتجاه الجنوب وسطاً بين الإِتجاهين.
ومرّ بنا الحديث عن الضّجة التي أثيرت بين اعداء الإسلام والمسلمين الجدد بشأن تغيير القبلة.
الآية أعلاه تخاطب هؤلاء وتقول: {لَيْسَ الْبِرَّ أن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ}.
(البرّ) في الاصل التوسّع، ثم أُطلق على أنواع الإِحسان، لأن الإِنسان بالإحسان يخرج من إطار ذاته ليتسع ويصل عطاؤه إلى الآخرين.
و(البّر) بفتح الباء، فاعل البرّ، وهي في الأصل الصحراء والمكان الفسيح، وأطلقت على المحسن بنفس اللحاظ السابق.
ثمّ يبين القرآن أهم أصول البّر والإحسان وهي ستة، فيقول: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ}.
هذا هو الأساس الأوّل: الإِيمان بالمبدأ، والمعاد، والملائكة المأمورين من قبل الله، والمنهج الإِلهي، والنبيّين الدعاة إلى هذا المنهج. والإِيمان بهذه الأُمور يُضيء وجود الإِنسان، ويخلق فيه الدافع القوي للحركة على طريق البناء والأعمال الصالحة.
جدير بالذكر أن الآية تقول: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ...} ولم تقل ولكن البَرَّ بفتح الباء، أو البار بصيغة اسم الفاعل. أي أن الآية استعملت المصدر بدل الوصف، وهذا يفيد بيان أعلى درجات التأكيد في اللغة العربية. فحين يقول أحد: عليٌ(عليه السلام)هو العدل في عالم الإنسانية. فهو يقصد أنه عادل للغاية وأن العدالة قد ملأت وجوده بحيث أن من يراه فكأنما لا يرى سوى العدالة متجسدة. وحين يقول: بني أُمية ذلّ الإِسلام، فيعني أن كل وجودهم ذلّ للإِسلام.
ثم تذكر الآية الإِنفاق بعد الإِيمان، وتقول: {وَآتَى الْمَالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ}.
إنفاق المال ليس بالعمل اليسير على الجميع، خاصة إذا بلغ الإِنفاق درجة الإِيثار، لأن حبّ المال موجود بدرجات متفاوتة في كل القلوب. وعبارة {عَلى حُبِّهِ} إشارة إلى هذه الحقيقة. هؤلاء يندفعون للإِنفاق رغم هذا الحبّ للمال من أجل رضا الله سبحانه.
الآية عددت ستة أصناف من المحتاجين إلى المال:
ذكرت بالدرجة الاُولى ذوي القربى، ثم اليتامى والمساكين، ثم أُولئك الذين اعترتهم الحاجة مؤقتاً كابن السبيل وهو المسافر المحتاج، ثم تذكر الآية بعد ذلك السائلين إشارة إلى أنّ المحتاجين ليسوا جميعاً أهل سؤال. فقد يكونون متعففين لا تبدو على سيمائهم الحاجة. لكنهم في الواقع محتاجون، وعن هؤلاء قال القرآن في موضع آخر: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} [البقرة: 273].
ثم تشير الاية إلى الرقيق الذين يتعطشون إلى الحرية والاستقلال بالرغم من عدم احتياجهم المادي وتأمين نفقتهم على عهدة مالكيهم.
والأصل الثالث من أصول البرّ: إقامة الصلاة: {وَأَقَامَ الصَّلاَةَ}. والصلاة إن أدّاها الفرد بشروطها وحدودها، وباخلاص وخضوع، تصده عن كل ذنب وتدفعه نحو كل سعادة وخير.
والأصل الرابع: أداء الزكاة والحقوق المالية الواجبة: {وَآتَى الزَّكَاةَ}.
فالآية سبق أن ذكرت الإِنفاق المستحب، وهنا تذكر الإِنفاق الواجب. بعض النّاس يكثر من المستحبات في الإنفاق ويتساهل في الواجب، وبعضهم يلتزم بالواجب فقط ولا ينفق درهماً في إيثار. والمحسنون الحقيقيون هم الذين ينفقون في المجالين معاً.
يلفت النظر أن الآية ذكرت عبارة {عَلى حُبِّهِ} بعد الإِنفاق المستحب، ولم تذكر ذلك مع الزكاة الواجبة. ولعل ذلك يعود إلى أن أداء الحقوق الواجبة وظيفة إلهية وإجتماعية، والفقراء ـ في منطق الإِسلام ـ شركاء في أموال الأغنياء، ودفع المال للشريك لا يحتاج إلى العبارة المذكورة.
الخامس من الأُصول: الوفاء بالعهد: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا}، فالثقة المتبادلة رأس مال الحياة الإِجتماعية. وترك الوفاء بالعهد من الذنوب التي تزلزل الثقة وتوهن عرى العلاقات الإِجتماعية، من هنا وجب على المسلم أن يلتزم بثلاثة أُمور تجاه المسلم والكافر، وإزاء البرّ والفاجر، وهي: الوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، واحترام الوالدين(2).
الأساس السادس والأخير من أُسس البرّ في نظر الإِسلام: الصبر {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ} حال الفقر والمسكنة{ وَالضَّرَّاءِ } حال المرض{ وَحِينَ الْبَأْسِ } حال القتال مع الاعداء.(3).
ثم تؤكد الآية على أهمية الأُسس الستة وعلى عظمة من يتجلّى بها، فتقول: {أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}.
صدقهم يتجلّى في انطباق أعمالهم وسلوكهم مع إيمانهم ومعتقداتهم، وتتجلى تقواهم في إلتزامهم بواجبهم تجاه الله وتجاه المحتاجين والمحرومين وكل المجتمع الإِنساني.
والملفت للنظر أن الصفات الست المذكورة تشمل الاُصول الإِعتقادية والأخلاقية والمناهج العملية. فتضمنت الآية كل أُسس العقيدة، وكذلك أشارت إلى الإِنفاق والصلاة والزكاة بين المناهج العملية، وهي أُسس ارتباط المخلوق بالخالق، والمخلوق بالمخلوق. وفي الحقل الأخلاقي ركزت الآية على الوفاء بالعهد، وعلى الصبر والإِستقامة والثبات، وهي أساس كل الصفات الأخلاقية السامية.
___________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج1 ، ص408-411.
2 ـ أصول الكافي، ج 2، باب البر بالوالدين، ص 129، حديث 15.
3 ـ البأساء من البؤس وهو الفقر، والضراء تعني الألم والمرض، وحين البأس أي حين الحرب (مجمع البيان، الآية).



|
|
|
|
15 نوعا من الأطعمة تساعدك على ترطيب جسمك خلال موجة الحر
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تختار شركة "سبيس إكس" لـ"مهمة خاصة" في 2030
|
|
|
|
|
|
|
بالصور: بمناسبة عيد الغدير الاغر.. قراءة خطبة النبي الأكرم (ص وآله) بالمسلمين في يوم (غدير خم)
|
|
|