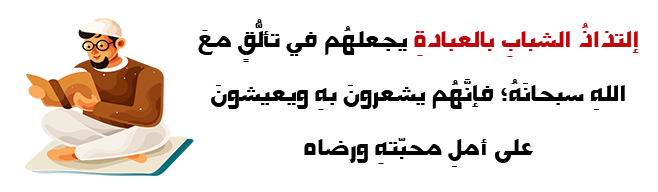
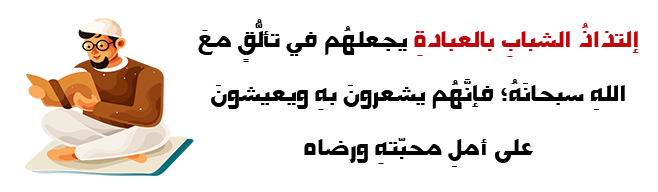

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-5-2017
التاريخ: 10-2-2017
التاريخ: 1-3-2017
التاريخ: 14-2-2017
|
قوله تعالى : {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } [البقرة : 3] .
لما وصف القرآن بأنه هدى للمتقين بين صفة المتقين فقال {الذين يؤمنون بالغيب } أي يصدقون بجميع ما أوجبه الله تعالى أو ندب إليه أو أباحه وقيل يصدقون بالقيامة والجنة والنار عن الحسن وقيل بما جاء من عند الله عن ابن عباس وقيل بما غاب عن العباد علمه عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة وهذا أولى لعمومه ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدي (عليه السلام) ووقت خروجه وقيل الغيب هو القرآن عن زر بن حبيش وقال الرماني الغيب خفاء الشيء عن الحسن قرب أو بعد إلا أنه كثرت صفة غايب على البعيد الذي لا يظهر للحس وقال البلخي الغيب كل ما أدرك بالدلائل والآيات مما يلزم معرفته وقالت المعتزلة بأجمعها الإيمان هو فعل الطاعة ثم اختلفوا فمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل ومنهم من اعتبر الفرائض حسب واعتبروا اجتناب الكبائر كلها وقد روى الخاص والعام عن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان وقد روي ذلك على لفظ آخر عنه أيضا الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول واتباع الرسول وأقول أن أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاءت به رسله وكل عارف بشيء فهو مصدق به يدل عليه هذه الآية فإنه تعالى لما ذكر الإيمان علقه بالغيب ليعلم أنه تصديق للمخبر به من الغيب على معرفة وثقة ثم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفهما عليه فقال { ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون } والشيء لا يعطف على نفسه وإنما يعطف على غيره ويدل عليه أيضا أنه تعالى حيث ذكر الإيمان إضافة إلى القلب فقال وقلبه مطمئن بالإيمان وقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) الإيمان سر وأشار إلى صدره والإسلام علانية وقد يسمى الإقرار إيمانا كما يسمى تصديقا إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إيمانا لفظيا لا حقيقيا وقد تسمى أعمال الجوارح أيضا إيمانا استعارة وتلويحا كما تسمى تصديقا كذلك فيقال فلان تصدق أفعاله مقاله ولا خير في قول لا يصدقه الفعل والفعل ليس بتصديق حقيقي باتفاق أهل اللغة وإنما استعير له هذا الاسم على الوجه الذي ذكرناه فقد آل الأمر تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق به على نحو ما تقتضيه اللغة ولا يطلق لفظه إلا على ذلك إلا أنه يستعمل في الإقرار باللسان والعمل بالأركان مجازا واتساعا وبالله التوفيق وقد ذكرنا في قوله { ويقيمون الصلوة } وجهين اقتضاهما اللغة وقيل أيضا إنه مشتق من القيام في الصلوة ولذلك قيل قد قامت الصلاة وإنما ذكر القيام لأنه أول أركان الصلاة وأمدها وإن كان المراد به هو وغيره والصلاة في الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة على وجوه مخصوصة وهذا يدل على أن الاسم ينقل من اللغة إلى الشرع وقيل إن هذا ليس بنقل بل هو تخصيص لأنه يطلق على الذكر والدعاء في مواضع مخصوصة وقوله تعالى { ومما رزقناهم ينفقون } يريد ومما أعطيناهم وملكناهم يخرجون على وجه الطاعة وحكي عن ابن عباس أنه الزكاة المفروضة وعن ابن مسعود أنه نفقة الرجل على أهله لأن الآية نزلت قبل وجوب الزكاة وعن الضحاك هو التطوع بالنفقة وروي محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) أن معناه ومما علمناهم يبثون والأولى حمل الآية على عمومها وحقيقة الرزق هوما صح أن ينتفع به المنتفع وليس لأحد منعه منه وهذه الآية تدل على أن الحرام لا يكون رزقا لأنه تعالى مدحهم بالإنفاق مما رزقهم والمنفق من الحرام لا يستحق المدح على الإنفاق بالاتفاق فلا يكون رزقا .
___________________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج1 ، ص86-87 .
العالم بكل شيء لا مكان له :
قيل : ان عالما كان يجلس في مكان الصدارة ، والناس من حوله يستمعون
له ، ويخشعون ، فحسده منافس له في المهنة ، فقال له بمسمع من الجميع :
ما قولك بكذا ؟ وسأله مسألة أشبه بالطلاسم .
فقال العالم : لا أعلم .
قال السائل : ان المكان الذي أنت فيه لمن يعلم ، لا لمن لا يعلم .
قال العالم : ويلك ، ان هذا المكان لمن يعلم شيئا ولا يعلم أشياء ، والذي يعلم كل شيء لا مكان له .
أجل ، ان الإنسان يستحيل أن يحيط بكل شيء علما : {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا } [الإسراء : 85] .
المعرفة :
لا أحد من الناس يخلق عالما بشيء من الأشياء ، وانما تتجدد له المعرفة آنا بعد آن بسبب من أسبابها ، حتى اسمه العلم لا يعرفه إلا بعد أن ينادى به أكثر من مرة ، وقد ذكر أهل الاختصاص للمعرفة أسبابا ، منها :
1 - أن يتلقى الإنسان معلوماته من إحدى حواسه الخمس ، كمعرفته الألوان بالبصر ، والأصوات بالسمع ، والروائح بالأنف ، والطعوم بالذوق ، والصلابة وما إليها باللمس . . ومثلها ما يتصوره الإنسان عن طريق مشاعره الباطنية ، كالجوع والشبع ، والحب والبغض .
2 - أن يتلقى معارفه من المراقبة والتجربة .
3 - أن يتلقاها بالبديهة ، أي أن يشترك في معرفتها جميع العقلاء مثل : واحد وواحد اثنان ، والأشياء المساوية لواحد متساوية ، والشيء النافع خير من الضار ، أو يتلقاها من إعمال الفكر واجتهاد العقل الذي يتلقاها بدوره من الحواس ، أو التجربة أو البديهة ، مثل الحكم على كل قطعة من قطع الحديد بأنها جسم صلب ، فان هذا الحكم على كل قطعة ما وقع منها في خبرة الحس ، وما لم يقع ، ان هذا الحكم لا يعتمد على اختبار كل القطع الحديدية ، وانما اعتمد على مجرد تصور العقل وتنبؤه بوجود قدر جامع بين جميع قطع الحديد ، وعلى هذا يكون الحكم الشامل عقليا لكنه استخرج من المعرفة التي تستند إلى التجربة .
4 - أن لا يتلقى معلوماته من الحس ، أو التجربة ، أو القوة العقلية ، بل يتلقاها مباشرة وبلا واسطة . وذلك بعد جهاد النفس لتنقيتها من الشوائب كما يقول المتصوفة . . وبكلمة أوضح ان القلب عند المتصوفة تماما كالعقل عند غيرهم فكما ان العقل يدرك بعض الأشياء بالبديهة ، ومن غير نظر ، والبعض يدركه بالاجتهاد والنظر كذلك القلب ، فإنه يشعر بأشياء من غير حاجة إلى جهاد النفس ، كشعوره بالحب والبغض والبعض يشعر به بعد جهاد النفس ، كوجود الباري وصفاته ، فالاجتهاد العقلي عندنا يقابله جهاد النفس عند المتصوفة .
ولا أحد يستطيع أن يناقش الصوفي في آرائه ومعتقداته ، لأنك إذا سألته عن الدليل يجيبك بأن ايماني وعلمي ينبع من ذاتي وحدها . . وإذا قلت له : ولما ذا لا ينبع هذا الإيمان ، وهذا العلم من ذوات الناس ، كل الناس ؟ يقول : لأنهم لم يمروا بالتجربة الروحية التي مررت بها .
ونحن نقف من هذا التصوف موقف المحايد المتحفظ ، فلا نثبته ، لبعده عما عرفنا وألفنا ، ولا ننفيه ، لأن المئات من العلماء في كل عصر ، حتى في عصرنا هذا يؤمنون بالتصوف على تفوقهم ، واختلافهم في الجنس والدين والوطن واللغة ، وليست لدينا أية حجة تنفي التجارب الشخصية البحتة ، ومن الجائز أن تكون تجربة الصوفي أشبه شيء باللحظات التي يلهم فيها الشاعر والفنان ، ولكن هذا شيء يعنيه وحده ، ولا حجة له فيه على غيره ، حيث لا ضابط له ، ولا رابط .
الغيب :
وهناك أشياء لا وسيلة إلى معرفتها بالحس والتجربة والقوة العقلية ، منها :
اللوح المحفوظ والملائكة ، وإبليس ، وحساب القبر ، والجنة والنار . ومنها :
انقلاب العصا حية ، واحياء الموتى ، وما إلى ذلك مما أخبر به النبي ، ولا يستقل العقل بإدراكه ، ولم نره نحن بالعين ، كل ذلك هو المقصود بالغيب في قوله تعالى : { يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ } . فالغيب هو الذي لا يمكن التوصل إلى معرفته الا بالوحي من السماء على لسان من ثبتت نبوته وصدقه بالعقل : {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} [الأنعام : 59] . وبهذا يتبين ان الايمان بالغيب جزء من الإسلام ، وان من لا يؤمن به فليس بمسلم . . وأيضا يتبين ان ما لا يمكن استكشافه بالمشاهدة والتجربة ، أو بالعقل ، ولم تنزل به آية من كتاب اللَّه ، أو تأتي به رواية عن رسول اللَّه فهو أسطورة وخرافة ، كأكثر ما يرويه الرواة من الإسرائيليات ، وما إليها .
الدين والعلم :
والغريب ان الطبيعيين يؤمنون بالغيب ، لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما بأن الكون وجد صدفة . . وليس من شك ان الايمان بالصدفة ايمان بالغيب ، لأن الطبيعيين لم يشاهدوها بالعيان ، إذ المفروض انهم وجدوا بعد الكون ، وأيضا لم يدركوها بالعقل ، لأن العقل يبطل الصدفة ، أولا تقع تحت اختباره اثباتا ولا نفيا - على الأقل - .
والأغرب انهم يسمحون لأنفسهم أن يفترضوا وجود مادة لطيفة يطلقون عليها اسم الأثير ، ومنها وجد الكون بزعمهم ، بل يؤمنون بذلك ايمانا لا يشوبه ريب ، ثم يحرمون على غيرهم أن يفترض ويؤمن بوجود قوة حكيمة مدبرة وراء هذا الكون . . مع العلم بأن هذا الافتراض أقرب إلى العقل والقلب من افتراض وجود مادة عمياء صماء .
وعلى أية حال ، فان الغيب يدل اسمه عليه ، يدرك بالوحي فقط ، لا بالتجربة ولا بالعقل . . أجل شرطه الوحيد أن لا يتنافى مع العقل ، لا أن يستقل العقل بإدراكه . . وعلى هذا فلا يبقى مجال لأية محاولة تهدف إلى اخضاع الوحي ونصوصه للعلم التجريبي . . ان مهمة هذا العلم تنحصر في محاولة الإنسان لفهم الطبيعة ، والسيطرة عليها ، ويجيب عن هذه الأسئلة : ما هي القوى التي تتألف منها طبائع الأشياء من جماد ونبات وحيوان ؟ وكيف نصمم طائرة تزيد سرعتها على سرعة الصوت ؟ ولا يدرك العلم التجريبي من أوجد الطبيعة ونظامها .
أما الدين فإنه يعرفنا بأسباب الوجود ويعطينا المفاتيح الرئيسية لمعرفة خالق الكون ويقودنا إلى ما ينبغي عمله في هذه الحياة ، لنحقق أهدافنا الروحية والمادية . ان المصنع وحده ، والحقل وحده ، أوهما معا لا يفيان بجميع أغراض الإنسان وأهدافه ، لأن الإنسان ليس جسما ومادة فقط ، انه مادة وروح وعاطفة ووعي . .
ان في داخل الإنسان رحمة شاملة ، اسمها الانسانية ، ونورا ساطعا ، اسمه العقل الذي يتصاغر أمامه ، ويتضاءل العالم الأكبر .
ان مطالب جسمنا هذا المحسوس من الأكل والشرب والنوم قد فرضت نفسها علينا فرضا ، ولا خيار لنا في رفضها ، فنحن نسعى للقيام بها دون اختيار ، ولا يختلف في ذلك فرد عن فرد عالما كان أو جاهلا ، نبيا أو غير نبي . أما الروح فتختلف مواهبها ومطالبها باختلاف الأشخاص والأفراد ، وكثيرا ما يكبت الإنسان عواطفه وميوله ، ويكظم غيظه ، ويتجرعه طواعية ، لا قسرا ، ويكون الخير كل الخير في هذا الكبت والردع ، على العكس من الجسم إذا لم نلب مطالبه .
هذا ، ولوكان الإنسان جسما فقط لتحكم به علماء الطبيعة ، كما يتحكمون بالمادة ، ولاستطاعوا أن يعرفوا أسرار النفس وكوامنها ، وان يحولوا جحودها إلى ايمان ، وإيمانها إلى جحود ، وحزنها إلى فرح وفرحها إلى حزن ، وحبها إلى بغض وبغضها إلى حب ، وإدراكها إلى جنون ، وجنونها إلى ادراك ، وشيخوختها إلى شباب ، وشبابها إلى شيخوخة . . ولو استرسلت في هذا الباب لملأت العديد من الصفحات . . وأرجو أن أوفق لعرض هذه المسألة في المناسبات الآتية بصورة أكمل وأوضح .
والقصد من هذه الإشارة هو البيان بأن موضوع العلم التجريبي شيء ، وموضوع الدين والوحي شيء آخر . . فالأول موضوعه المادة جامدة كانت ، أو نامية ، وهدفه الكشف عما تحتوي عليه من قوى ، والثاني موضوعه حياة الإنسان بشقيها المادي والروحي ، وان شئت قلت حياته الروحية والعملية . أما هدفه فهو أن يعيش الناس ، كل الناس عيشة راضية مرضية .
أجل ، ان الإسلام يحترم العقل والعلم النافع ، ويحث على طلبه ، ويعتبره فريضة على كل مسلم ومسلمة ، ويرفع أهله درجات ، ومن أجل هذا يجب على المسلم بما هو مسلم أن يعتقد بأنه لا شيء في العلم الصحيح أو العقل السليم ، يتنافى مع الإسلام ، ولا في أحكام الإسلام ما يتنافى معهما . . ان عدم المنافاة والمناقضة شرط أساسي ، أما أن يستقل العقل ، أو العلم التجريبي بإدراك كل حكم من أحكام الإسلام فليس بشرط .
وتسأل : لقد ثبت عن الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله ) قوله : « أصل ديني العقل » وهو بظاهره يدل على ان العقل يدرك جميع الأحكام الدينية الاسلامية ؟ .
الجواب : ان الإسلام يرتكز أول ما يرتكز على الألوهية والنبوة ، ومنهما تنبع تعاليمه وأحكامه ، والسبيل إلى معرفتهما هو العقل (2) ، وعليه يكون معنى الحديث الشريف ان الإسلام الذي يرتكز على الألوهية والنبوة اعتمد في إثباتهما على العقل ، لا على التقليد والمتابعة العمياء ، ولا على الخرافات والأساطير .
قد تحكم السلطة على شخص بالإقامة الجبرية في بلد معين ، وتحجر عليه ان يتعداه إلى غيره ، وتلزمه بالحضور كل يوم في الدائرة المختصة اثباتا لوجوده ، فان تخلف كان مسؤولا .
واختط الإسلام للمؤمن مخططا خاصا يثبت به ويؤكد كل يوم خمس مرات إيمانه باللَّه فاطر السماوات والأرض ، وإخلاصه في جميع أعماله : { وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [الأنعام : 79] . . {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام : 162 ، 163] .
ومن ترك الصلاة جاحدا فهو مرتد عن الإسلام ، أو متهاونا فهو فاسق مستحق للعقاب . وبهذا نجد تفسير قول الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة : « ان رسول اللَّه شبه الصلاة بالحمّة - هي عين تنبع بالماء الحار - تكون على باب الرجل ، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات ، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن » .
أي ان المواظبة على الصلاة تزكي القلب من الارتداد والفسق ، تماما كما يطهر الاغتسال الجسم من الأقذار ، وأي شيء أقذر من الكفر والفسوق ؟ !
{ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ} :
الإنفاق هنا يشمل جميع ما يبذله الإنسان في سبيل الخير زكاة كان ، أو غيرها . . وليس من شك ان البذل في سبيل الخير راجح في ذاته ، ولكن هل : يجب في الأموال شيء غير الزكاة والخمس ؟
لقد جاء في طريق السنة ، كما عن الترمذي ، وفي طريق الشيعة كما عن الكافي ان في الأموال حقا آخر . وفسر الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) هذا الحق بأنه الشيء يخرجه الرجل من ماله ، ان شاء أكثر ، وان شاء أقل على قدر ما يملك ، واستدل بقوله تعالى : {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات : 19] . .
والآية 24 من سورة المعارج : {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } [المعارج : 24 ، 25] .
غير ان أكثر العلماء حملوا ذلك على الاستحباب دون الوجوب إلا الشيخ الصدوق من الشيعة ، حيث نقل عنه القول بأن في الأموال حقا لازما غير الخمس والزكاة ، يخرجه المالك حسب ما يملك كثرة وقلة . . ومهما يكن ، فان الذي لا شك فيه ان بذل المال في سبيل الخير يطهر من الأقذار ، وينجي من عذاب النار ، قال تعالى في الآية 103 من سورة التوبة : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة : 103] .
_________________________________
1- تفسير الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص42-48 .
2- يعرف الله سبحانه بالعقل عن طريق الكون ، ويعرف النبي بالعقل عن طريق المعجزة .
{يؤمنون} : الإيمان تمكن الاعتقاد في القلب مأخوذ من الأمن كأن المؤمن يعطي لما أمن به الأمن من الريب والشك وهو آفة الاعتقاد ، والإيمان كما مر معنى ذو مراتب ، إذ الإذعان ربما يتعلق بالشيء نفسه فيترتب عليه أثره فقط ، وربما يشتد بعض الاشتداد فيتعلق ببعض لوازمه ، وربما يتعلق بجميع لوازمه فيستنتج منه أن للمؤمنين طبقات على حسب طبقات الإيمان .
وقوله سبحانه : { بِالْغَيْبِ } ، الغيب خلاف الشهادة وينطبق على ما لا يقع عليه الحس ، وهو الله سبحانه وآياته الكبرى الغائبة عن حواسنا ، ومنها الوحي ، وهو الذي أشير إليه بقوله : {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} [البقرة : 4] فالمراد بالإيمان بالغيب في مقابل الإيمان بالوحي والإيقان بالآخرة ، هو الإيمان بالله تعالى ليتم بذلك الإيمان بالأصول الثلاثة للدين ، والقرآن يؤكد القول على عدم القصر على الحس فقط ويحرص على اتباع سليم العقل وخالص اللب .
___________________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج1 ، ص43-44 .
الإيمان بالغيب :
«الغيب والشهود» نقطتان متقابلتان ، عالم الشهود هو عالم المحسوسات ، وعالم الغيب هوما وراء الحس . لأنّ «الغيب» في الأصل يعني ما بطن وخفي . وقيل عن عالم ما وراء المحسوسات «غيب» لخفائه عن حواسّنا . التقابل بين العالمين مذكور في آيات عديدة كقوله تعالى : { عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } [الحشر : 22] .
الإيمان بالغيب هو بالضبط النقطة الفاصلة الاُولى بين المؤمنين بالأديان السماوية ، وبين منكري الخالق والوحي والقيامة . ومن هنا كان الإيمان بالغيب أول سمة ذكرت للمتّقين .
المؤمنون خرقوا طوق العالم المادي ، واجتازوا جدرانه ، إنّهم بهذه الرؤية الواسعة مرتبطون بعالم كبير لا متناه . بينما يصرّ معارضوهم على جعل الإنسان مثل سائر الحيوانات ، محصوراً في موقعه من العالم المادي . وهذه الرؤية المادية تقمّصت في عصرنا صفات العلمية والتقدمية والتطورية!
لو قارنّا بين فهم الفريقين ورؤيتهما ، لعرفنا أن : { يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} يعتقدون أن عالم الوجود أكبر وأوسع بكثير من هذا العالم المحسوس ، وخالق عالم الوجود غير متناه في العلم والقدرة والإدراك ، وأنّه أزليّ وأبديّ . وأنّه صمّم هذا العالم وفق نظام دقيق مدروس . ويعتقدون أنّ الإنسان ـ بما يحمله من روح إنسانية ـ يسمو بكثير على سائر الحيوانات . وأنّ الموت ليس بمعنى العدم والفناء ، بل هو مرحلة تكاملية في الإنسان ، ونافذة تطل على عالم أوسع وأكبر .
بينما الإنسان المادي يعتقد أن عالم الوجود محدود بما نلمسه ونراه . وأن العالم وليد مجموعة من القوانين الطبيعية العمياء الخالية من أي هدف أو تخطيط أو عقل أو شعور . والإنسان جزء من الطبيعة ينتهي وجوده بموته ، يتلاشى بدنه ، وتندمج أجزاؤه مرّة اُخرى بالمواد الطبيعية . فلا بقاء للإنسان ، وليس ثمّة فاصلة كبيرة بينه وبين سائر الحيوانات (2) !
ما أكبر الهوة التي تفصل بين هاتين الرؤيتين للكون والحياة ! وما أعظم الفرق بين ما تفرزه كل رؤية ، من حياة إجتماعية وسلوك ونظام !
الرؤية الاُولى تربّي صاحبها على أن ينشد الحق والعدل والخير ومساعدة الآخرين . والثانية ، لا تقدّم لصاحبها أي مبرّر على ممارسة الأمور اللهم إلاّ ما عاد عليه بالفائدة في حياته المادية . من هنا يسود في حياة المؤمنين الحقيقيين التفاهم والإخاء والطّهر والتعاون ، بينما تهيمن على حياة الماديين روح الإستعمار والإستغلال وسفك الدماء والنهب والسلب . ولهذا السبب نرى القرآن يتخذ من «الإيمان بالغيب» نقطة البداية في التقوى .
يدور البحث في كتب التّفسير عن المقصود بالغيب ، أهو إشارة إلى ذات الباري تعالى ، أم أنه يشمل ـ أيضاً ـ الوحي والقيامة وعالم الملائكة وكل ما هو وراء الحس ؟ ونحن نعتقد أن الآية أرادت المعنى الشامل لكلمة الغيب ، لأن الإيمان بعالم ما وراء الحس ـ كما ذكرنا ـ أول نقطة افتراق المؤمنين عن الكافرين ، إضافة إلى ذلك ، تعبير الآية مطلق ليس فيه قيد يحدده بمعنى خاص .
بعض الروايات المنقولة عن أهل البيت(عليهم السلام) تفسّر الغيب في الآية ، بالمهدي الموعود المنتظر (سلام الله عليه) والذي نعتقد بحياته وخفائه عن الأنظار ، وهذا لا ينافي ما ذكرناه بشأن معنى الغيب ، لأن الروايات الواردة في تفسير الآيات تبين غالباً مصاديق خاصة للآيات ، دون أن تحدد الآيات بهذه المصاديق الخاصة ، وسنرى في صفحات هذا التّفسير أمثلة كثيرة لذلك . والروايات المذكورة بشأن تفسير معنى الغيب ، تستهدف في الواقع توسيع نطاق معنى الإيمان بالغيب ، ليشمل حتى الإيمان بالمهدي المنتظر(عليه السلام) ويمكننا القول أنّ الغيب له معنى واسع قد نجد له بمرور الزمن مصاديق جديدة .
الإرتباط بالله :
الصفة الاُخرى للمتقين هي أنهم {يُقيمُونَ الْصَّلاةَ} .
«الصّلاة» باعتبارها رمز الإرتباط بالله ، تجعل المؤمنين المنفتحين على عالم ما وراء الطبيعة على ارتباط دائم بالخالق العظيم . فهم لا يحنون رؤوسهم إلا أمام الله ، ولا يستسلمون إلاّ لرب السماوات والأرض ، ولذلك لا معنى في قاموس حياتهم لعبادة الاوثان ، أو التسليم أمام الجبابرة والطواغيت .
مثل هذا الإنسان يشعر أنّه أسمى من جميع المخلوقات الاُخرى ، إذ أنّه منح لياقة الحديث مع ربّ العالمين ، وهذا الإحساس الوجداني أكبر عامل في تربية الموجود البشري .
الإنسان الذي يقف خمس مرات يوميّاً أمام الله ، يتضرع إليه ويناجيه ، ينطبع فكره وعمله وقوله بطابع إلهي ، ومثل هذا الإنسان لا ينهج طريقاً فيه سخط الله (على أن يكون تضرعه لله صادراً عن أعماق قلبه ومنطلقاً من تمام وجوده) (3) .
الإرتباط بالنّاس :
المتقون ـ إضافة إلى ارتباطهم الدائم بالخالق ـ لهم إرتباط وثيق ومستمر بالمخلوقين ، ومن هنا كانت الصفة الثالثة التي يبيّنها لهم القرآن أنّهم {ومِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} .
يلاحظ أن القرآن لا يقول : ومن أموالهم ينفقون ، بل يقول : {ومِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ} ، وبذلك وسّع نطاق الإنفاق ليشمل المواهب المادية والمعنوية .
فالمتقون لا ينفقون أموالهم فسحب ، بل ينفقون من علمهم ومواهبهم العقلية وطاقاتهم الجسميّة ومكانتهم الإجتماعية ، وبعبارة اُخرى ينفقون من جميع إمكاناتهم لمن له حاجة إلى ذلك دون توقّع الجزاء منه .
الملاحظة الاُخرى : إن الإنفاق قانون عام في عالم الخليقة ، وخاصة في التركيب العضوي لكل موجود حي . قلب الإنسان لا يعمل لنفسه فقط ، بل ينفق ما عنده لجميع خلايا البدن . الدماغ والرئة وسائر أجهزة البدن تنفق دائماً من ثمار عملها ، والحياة الجماعية ـ أساساً ـ لا مفهوم لها دونما إنفاق (4) .
الإرتباط بالنّاس في الحقيقة حصيلة الإرتباط بالله . فالإنسان المرتبط بالله يؤمن أن كل ما لديه من نِعَم إنّما هي مواهب إلهيّة مودعة لديه لفترة زمنيّة معينة . ومن هنا فلا يزعجه الإنفاق بل يسره ويفرحه ، لأنه بالإنفاق قسّم مال الله بين عباد الله ، وبقيت له نتائج هذا العمل وبركاته المادية والمعنوية . وهذا التفكير يطهّر روح الإنسان من البخل والحسد ، ويحوّل الحياة من ساحة لتنازع البقاء إلى مسرح للتعاون حيث يشعر كل فرد بأنه مسؤول أن يضع ما لديه من مواهب تحت تصرف كل المحتاجين ، مثل الشمس تفيض بأشعتها على الموجودات دون أن تتوقع من أحد جزاء .
في حديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام) بشأن تفسير الآية {وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} يقول : «إنَّ مَعْنَاهُ وِمِمّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبُثُّونَ» (5) .
بديهي أنّ الرّواية لا تريد أن تجعل الإنفاق مختصاً بالعلم ، بل إن الإمام الصادق يريد ـ بذكر هذا اللون من الإنفاق ـ أن يوسّع مفهوم الإنفاق كي لا يكون مقتصراً على الجانب المالي كما يتبادر إلى الأذهان لأول وهلة .
ومن هنا يتضح ضمنياً أن الإنفاق المذكور في الآية ، لا يقتصر على الزكوات الواجبة والمستحبة ، بل يتسع معناه ليشمل كل مساعدة بلا مقابل .
_______________________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج1 ، ص 65-69 .
2 ـ نقلا عن : «محمّد والقرآن» .
3 ـ بشأن أهمية الصلاة وآثارها التربوية الكبرى ، راجع تفسير الآية 114 من سورة هود (في المجلد السابع من هذا التّفسير) .
4 ـ راجع بشأن الإنفاق وأهميته وآثاره ، المجلد الثاني من هذا التّفسير ، ذيل الآيات 261 ـ 274 من سورة البقرة .
5 ـ مجمع البيان ، ونور الثقلين ، في تفسير الآية المذكورة .



|
|
|
|
15 نوعا من الأطعمة تساعدك على ترطيب جسمك خلال موجة الحر
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تختار شركة "سبيس إكس" لـ"مهمة خاصة" في 2030
|
|
|
|
|
|
|
بالصور: بمناسبة عيد الغدير الاغر.. قراءة خطبة النبي الأكرم (ص وآله) بالمسلمين في يوم (غدير خم)
|
|
|