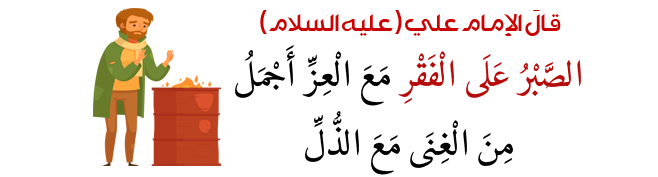
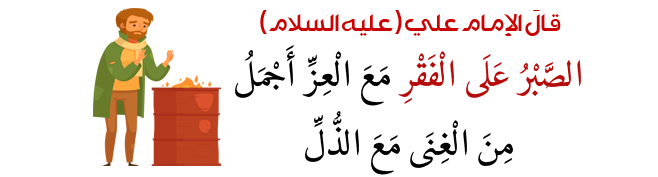

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
التاريخ: 22-5-2019
التاريخ: 10-9-2016
التاريخ: 22-5-2019
|
المتبادر بدوا من معنى الاستحسان هو اعمال الذوق ومقتضيات الطبع في مقام التعرّف على الحكم الشرعي ، فمتى ما وجد المجتهد انّ هذا الفعل ملائما لما يقتضيه الطبع فهذا يكشف عن ان حكم هذا الفعل الواقعي هو الإباحة ، وبخلافه ما لو كان الفعل مستبشعا تمجّه الطباع وتشمئز له النفوس ويتنافى مع الذوق فهذا يعبّر عن انّ حكمه الواقعي هو الحرمة لو كانت مرتبة الاشمئزاز والاستقذار شديدة جدا ، أما لو كانت مرتبة الاستقذار والاستبشاع بمستوى أدنى من الحالة السابقة فإنّ هذا يكشف عن ان حكم هذا الفعل عند الله تعالى هو الكراهة.
وهذا المعنى للاستحسان يمكن ان يستفاد من كلام الشافعي ـ والذي لا يرى حجية الاستحسان ـ حيث قال في مقام الرد على دعوى حجية الاستحسان : « أفرأيت اذا قال المفتي في النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس وقال استحسن ، فلا بدّ ان يزعم انّ جائزا لغيره ، ان يستحسن خلافه فيقول كل حاكم في بلد ومفت بما يستحسن ، فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا، فإن كان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاءوا وان كان ضيقا فلا يجوز ان يدخلوا فيه ».
فإنّ هذا النص كما تلاحظون صريح في انّ الشافعي يفهم من الاستحسان المعنى الذي ذكرناه ، وذلك لأنّ ملاحظته في مرتبة متأخرة عن فقدان النص يعبّر عن انّ الاستحسان ليس بمعنى تقديم أقوى النصين ظهورا أو سندا ـ كما ذكر البعض ـ وملاحظته مترتبا على القياس يعبّر عن ان الاستحسان ليس بمعنى العدول عن قياس الى قياس أقوى ـ كما ذكر البعض ـ كما يعبّر عن انّ الاستحسان لا يدخل تحت أيّ وجه من وجوه القياس المذكورة ، ومن هنا يتمحض معنى الاستحسان ـ بحسب فهم الشافعي ـ في مجموعة من المحتملات.
منها انّ مراد الشافعي من الاستحسان هو المصالح المرسلة ، وهذا الاحتمال غير مراد جزما ، وذلك لانّ المصالح المرسلة تخضع لضوابط عقليّة أو عقلائية أو شرعية كما سيتضح ذلك في الحديث عن المصالح المرسلة ، فلو كان مراده ذلك لكان إشكاله ـ وهو انّه يلزم من القول بحجية الاستحسان « ان يقول كل حاكم في بلد ومفت بما يستحسن » ـ غير وارد ، إذ انّ الضوابط العقلية والعقلائية وكذلك الشرعية مطردة والاختلاف انما هو في موارد تطبيقها وهذا حاصل حتى في الكتاب والسنة وكذلك القياس ، وهذا ما يعبّر عن انّ الشافعي لا يقصد بالاستحسان المصالح المرسلة.
وبما ذكرناه يتضح عدم إرادته للحسن والقبح العقليين أو العقلائيين ، وكذلك يتّضح عدم إرادته من الاستحسان ما يعبّر عنه بحجية العرف.
وبسقوط تمام المحتملات يتعيّن كون المراد من معنى الاستحسان هو ما ذكرناه ، إذ هو الذي يرد عليه إشكال الشافعي ، فالذوق وما يلائم الطبع وكذلك الاشمئزاز والاستقذار والاستبشاع كلها حالات نفسانية تخضع لعوامل تربوية أو اجتماعية أو ثقافية ، وهي تختلف من بلد لآخر ومن بيئة لأخرى ، بل قد يتفاوت المجتمع الواحد في ذلك فتجد انّ طبقة معينة أو شريحة خاصة تنفر من بعض الأطعمة وتستقذرها والحال انّ نفس هذه الأطعمة تستهوي طبقة اخرى من المجتمع أولا أقل لا تكون مستقذرة عندهم ، كما نلاحظ ان بعض المجتمعات تمارس بعض الأعمال وترى انها ملائمة للذوق والتحضّر ، ونجد مجتمعات اخرى تستبشع هذه الأعمال وترى انها من التخلّف والتسافل الى مستوى الحيوان ، وما ذلك إلاّ لاختلاف التربية والثقافة.
ثم انّ المجتمع الواحد قد يمرّ بأطوار وظروف تتغيّر معها طبائعه ومذاقاته.
وبهذا اتضح انّ ما يفهمه الشافعي من معنى الاستحسان هو ما ذكرناه.
ويمكن تأكيد هذا الفهم ببعض التعريفات المذكورة للاستحسان فقد نقل صاحب محاضرات في اسباب اختلاف الفقهاء عن المبسوط ـ كما ذكر ذلك السيد الحكيم ـ انّ الاستحسان « هو الأخذ بالسماحة وانتفاء ما فيه الراحة ».
وكذلك نقل عن ابن قدامة انّ الاستحسان « دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ».
والتعريف الاول يعبّر عن الحكم بمناط الاستحسان لا بدّ وان يكون متناسبا مع السماحة والسهولة ، فلو كان فعل من الأفعال متناسبا مع انس النفس ومتناغما مع مذاقها وموجبا لراحتها واستجمامها فهذا يقتضي الحكم بإباحته بل وباستحبابه ، لأنّه هو مقتضى الأخذ بالسماحة وانتفاء ما فيه الراحة ، فلو حكمنا بحرمته لأخذنا بما فيه التعب وأوردنا المكلّف موارد النصب وهو ما ينافي مآرب النفس في الطرب.
وأما التعريف الثاني فنتساءل ما هو الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد ويتعذّر عليه التعبير عنه ، فحتما ليس هو من قبيل النصوص الشرعية ولا هو من قبيل البراهين العقلية ولا هو قياس من الأقيسة وإلاّ لأجاد التعبير عنه ، ولو كان من قبيل المصالح المرسلة أو سدّ الذرائع أو ما الى ذلك فما هو الموجب لانتفاء القدرة على التعبير عنه ، نعم لو كان الذوق هو الدليل فإنّ من الصعب التعبير عنه إلاّ ان يكون المجتهد شاعرا.
المعنى الثاني للاستحسان : هو « ما يستحسنه المجتهد بعقله » ، وهذا التعريف منقول عن ابن قدامة ، وهو يحتمل معان ثلاثة :
الاحتمال الاول : انّ مراده من الاستحسان العقلي هو خصوص مدركات العقل القطعية الأعم من مدركات العقل العملي ـ كإدراك العقل لحسن العدل وقبح الظلم ـ ومدركات العقل النظري كإدراكه للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو انّ مراده مختص بالأول.
الاحتمال الثاني : انّ مراده من الاستحسان العقلي هو مطلق ما يستحسنه العقل الأعم من العقل النظري والعملي والقطعي والظني.
والظاهر من التعريف انّ المتعين هو الاحتمال الثاني ، وذلك لعدم وجود ما يوجب اختصاصه بالأول ، ومن هنا يكون الاستحسان شاملا للقياس والاستقراء وسدّ الذرائع ، لانها جميعا من صغريات ما يستحسنه العقل الاعم من القطعي والظني ، وعليه فليس الاستحسان ـ بناء على هذا المعنى ـ دليلا مستقلا في مقابل الدليل العقلي ، وذلك حتى بناء على الاحتمال الاول ، وهذا ما يعبّر عن وجود خلل في التعريف.
المعنى الثالث : انّ الاستحسان هو « العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة ». وهذا التعريف نقله ابن قدامة أيضا.
واحتمالات المراد من هذا التعريف ثلاثة :
الاول : انّ الاستحسان يعني تقديم الدليل المخصص من الكتاب والسنة على عمومات الكتاب واطلاقاته وكذلك عمومات السنة واطلاقاتها. مثلا قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } [المائدة: 96] ، فالآية الكريمة تدلّ بإطلاقها على حلّية أكل طعام البحر ، فلو ورد دليل من السنة مفاده « حرمة أكل ما لا فلس له » فإنّ هذا الدليل يكون مقدما بالاستحسان أي بقاعدة حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص.
الثاني : انّ المراد من الاستحسان هو تقديم الآيات والروايات ـ في مقام التعرّف على الحكم الشرعي ـ على سائر الأدلة الاخرى سواء كان من قبيل الإجماع أو العقل أو القياس أو ما الى ذلك فكل ما سوى الكتاب والسنة يكون في مرحلة متأخرة عنهما في مقام المرجعية ، أي لا يلجأ الى غير الكتاب والسنة في موارد اشتمالهما أو أحدهما على حكم المسألة المبحوث عنها.
الثالث : انّ الاستحسان يعني الخروج عمّا يقتضيه القياس بسبب وجود دليل خاص من الكتاب والسنة ، بمعنى انّه في فرض التعارض بين ما يدلّ عليه الكتاب والسنة وبين ما يقتضيه القياس فإنّ الاستحسان يقتضي تقديم ما يدلّ عليه الكتاب والسنة.
والظاهر إرادة هذا المعنى من التعريف بقرينة قوله « العدول بحكم مسألة عن نظائرها » ، فإنّ هذا التعبير يناسب القياس والذي يعني إسراء حكم من مسألة الى نظائرها من المسائل ، فلو كانت احدى هذه المسائل مما قام الدليل الخاص من الكتاب والسنة على انّ حكمها مناف لحكم نظائرها من المسائل فإنّ مقتضى الاستحسان هو تقديم الدليل الخاص من الكتاب والسنة.
والذي يؤكد ما ذكرناه انّ التعبير بالعدول لا يناسب التخصيص ـ والذي هو الاحتمال الاول ـ إذ انّ العدول يستبطن وجود قاعدة كلية متبناة تقتضي حكما معينا إلاّ انّ ثمة شيئا أوجب العدول عن هذه القاعدة ، والتخصيص ليس من هذا القبيل ، وذلك لأنّ المخصص لو كان متصلا فإنّ حكم المسألة المستفاد من المخصّص ثابت بنفس الخطاب المفيد للعموم ، فليس من قاعدة تقتضي حكما مغايرا وتكون المسألة الخارجة بالتخصيص مشمولة له أولا ثم تخرج بواسطة الدليل الخاص حتى يصدق العدول ، إذ انّ العموم من أول الأمر لا يشمل المسألة الخارجة بالمخصص المتصل ، وأمّا لو كان المخصّص منفصلا فكذلك لا يكون التعبير بالعدول دقيقا لو كان المراد منه التخصيص ، إذ ان التعويل على الاطلاق أو العموم قبل الفحص عن المخصّص أو المقيّد غير صحيح ، وذلك للعلم الإجمالي بوجودات مخصّصات ومقيّدات منفصلة في الخطابات الشرعية ، فمع الفحص والعثور على المخصّص المنفصل لا يكون العمل بمقتضى المخصص أو المقيد عدولا عن العموم والاطلاق ، وذلك لانّ الاطلاق وكذلك العموم لم يكونا مرادين بالإرادة الجدية من أول الأمر بل المراد الجدّي منهما هو غير ما يقتضيه المخصّص المنفصل.
وبهذا يتنقح ان لا قاعدة كلية مبتناة تم العدول عنها في موارد التخصيص بل انّ المخصّص يثبت في عرض العموم والاطلاق وانما قد يتفق العثور على العموم قبل العثور على المخصّص وقد ينعكس الأمر فنعثر على المخصّص قبل العثور على العموم أو الاطلاق وحينئذ فما معنى التعبير بالعدول.
وأما الاحتمال الثالث فيناسبه التعبير بالعدول ، وذلك لأنّ القياس ضابطة عقلية كلية محددة المعالم لا يقال في موردها انّ بعض مواردها خارج من أول الأمر بل انّ كل ما يخرج عنها يكون عدولا عن مقتضاها الى شيء آخر.
هذا ما يناسب سقوط الاحتمال الاول ، وأما الاحتمال الثاني فهو أبعد من الاحتمال الأول ، وذلك لأنّ الاستحسان فيه بمعنى تقديم الكتاب والسنة على سائر الادلة ، ولا نجد مناسبة للتعبير بالعدول لو كان هذا المعنى هو المراد ، إذ انّ هذا المعنى لا يعني أكثر من بيان الترتيب المرحلي للأدلة في مقام المرجعية والاستنباط للأحكام الشرعية.
والمتحصّل انّ حمل التعريف على الدقة يقتضي كون المراد منه ما ذكرناه وهو الخروج عن القاعدة الكليّة المستلهمة بواسطة القياس في موارد وجود الدليل الخاص من الكتاب والسنة ، وهذا ما تؤكده مقتضيات القياس ، إذ ان القياس العقلي لا يفرق بين مسألة واخرى بل يعطي ضابطة كلية لنظائر المسألة المقيس عليها إلاّ انّ المجتهد يعدل عمّا يقتضيه القياس بسبب وجود الدليل الخاص من الكتاب والسنة.
والذي يعزّز ما استظهرناه من التعريف ما نقل عن البزودي ـ وهو من الاحناف ـ قال : ان الاستحسان هو « العدول عن موجب قياس الى قياس أقوى أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه ».
والمناسب لما ذكرناه هو قوله « أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه » حيث اعتبر المعدول عنه هو القياس وليس هو دليل آخر كعمومات الكتاب والسنة.
ثم انّ هذا التعريف أوسع دائرة من التعريف السابق حيث جعل الموجب للعدول عن القياس مطلق الدليل الأقوى ، فلو اعتبرنا انّ الإجماع وكذلك المصالح المرسلة أقوى دليليّة من القياس كان ذلك موجبا للعدول عما يقتضيه القياس ، وكذلك لو كان هناك قياس أقوى دليليّة من قياس آخر فلا بدّ من العدول عن القياس المرجوح بمقتضى الاستحسان ، إلاّ انّ هذا التعريف لم يشر الى ما هي الضابطة لتشخيص أقوائية أحد القياسين على الآخر ، والمحتمل في ضابطة الأقوائية أحد امور :
الأمر الاول : مناسبة القياس الأقوى للمصلحة.
ولو كانت هذه هي الضابطة لما صحّ عدّ الاستحسان دليلا برأسه ، فهو حينئذ يرجع الى المصالح المرسلة فهي المائز ـ بناء على هذا الاحتمال ـ بين القياس الأقوى من القياس الأضعف، وهذا ما يوجب استبعاد هذا الاحتمال ، إذ انّ الظاهر منهم هو اعتبار الاستحسان دليلا مستقلا في عرض الأدلة الاخرى.
الأمر الثاني : مناسبته لسدّ الذرائع أو العرف وهذا الاحتمال أيضا ساقط لعين ما ذكرناه في الأمر الاول.
الأمر الثالث : انّ الضابطة في أقوائية قياس على آخر هو الذوق وملائمات الطبع ، وهذا الاحتمال هو المتعين ، إذ لا يرد عليه الإشكال الوارد على الاحتمال الاول والثاني ، كما لا يتصوّر ان تكون ضابطة الاقوائية هو موافقة القياس الأقوى للكتاب والسنة والإجماع ، إذ انّ ظاهر التعريف هو انّ الدليل على حكم المسألة هو أحد القياسين لا غير ، إلاّ انّه لمّا كان أحد القياسين منافيا لما يقتضيه الآخر كان ذلك مستوجبا للبحث عن الأقوى منهما.
هذا بالإضافة الى انّ الثالث من الامور المحتملة متناسب مع مجموعة من التعريفات المذكورة للاستحسان كما بينا ذلك.
المعنى الرابع : ما نقل عن الشاطبي من المالكية انّ الاستحسان هو « العمل بأقوى الدليلين ».
ولم نتبين المراد من هذا التعريف ، فهل المراد منه هو إعمال الاستحسان لتشخيص ما هو الدليل الأقوى أو انّ المراد من الاستحسان هو نفس الأخذ بالدليل الأقوى والأقوائية تثبت بواسطة اخرى غير الاستحسان ، فنفس الأخذ بما يقتضيه الكتاب الكريم وطرح ما يقتضيه الخبر الواحد المنافي هو الاستحسان ، أو انّ الاستحسان معناه هذه القاعدة الكليّة وهي كلما تعارض دليلان فالحجيّة تكون في طرف الأقوى منهما ، وهذا المعنى أيضا لا يشخّص لنا ضابطة الأقوائية.
فبناء على الاحتمال الثاني لا يكون الاستحسان من الأدلة على الحكم الشرعي وانما يكون مجرّد اصطلاح يطلق على هذه الحالة التي يعمل فيها المجتهد بالدليل الأقوى.
وأما الاحتمال الثالث : فهو خلاف ظاهر التعريف ، إذ انّ هذه القاعدة لا تعدو إما ان تكون قاعدة عقلية منشؤها إدراك العقل لاستحالة ترجيح المرجوح واستحالة التخيير بين المرجوح والراجح ، وإمّا انّها قاعدة مستفادة من الشرع أو من دليل آخر ، وإطلاق عنوان الاستحسان عليها مجرّد اصطلاح وهو ينافي دعوى دليليته على الحكم الشرعي ، ولو سلمنا استفادتها من الاستحسان فهذا لا يقتضي أكثر من كونها من موارد ما يكشف عنه الاستحسان لا أنها هي الاستحسان نفسه ، وحينئذ لا يصلح تعريف الاستحسان بها فلا بدّ من التماس تعريف للاستحسان لو كان هذا الاحتمال هو المتعيّن ، وهذا ما يؤكد سقوط هذا الاحتمال ، على انّه لا معنى محصّل من هذا الاحتمال ، وذلك لأن الظاهر من التعريف انّ المجتهد إنّما يلجأ للاستحسان في حالة تعارض الأدلة مع إحراز دليلية كل واحد منهما على الحكم الشرعي لو لا التعارض ، وحينئذ لا معنى لأن يقال خذ بما هو الأقوى منهما ، لان ذلك لا يعالج المشكلة ، فهو أشبه بما لو سألك سائل عن أي الطرقين أسلك وكان غرضه التعرّف على الطريق الاقرب فتجيبه بقولك « اسلك أقرب الطريقين » فهنا لا يكون السائل قد تحصّل على الجواب الناجع ، لأنّه انّما يسأل عن الطريق الأقرب.
نعم لو كان يعلم بالطريق الأقرب إلاّ انّه لا يعلم أهو ملزم بسلوك الطريق الاقرب أو هو مخير مثلا فإنّ الجواب بالقول « اسلك الطريق الأقرب » يكون ناجعا ، إلاّ انّ ذلك خلاف الظاهر من مرجعية الاستحسان في ظرف التعارض ، لأن الظاهر انّه لا يلجأ للاستحسان للتعرّف على هذه القاعدة فحسب بل يلجأ اليه لتشخيص الدليل الأقوى من الدليل الأضعف.
ومن هنا يكون المتعيّن من الاحتمالات هو الاحتمال الأول ، وبهذا يكون تعريف الاستحسان ـ بناء على هذا الاحتمال ـ هو المشخّص للدليل الأقوى الذي يلزم العمل به ، فيكون التعريف من قبيل التعريف بالفائدة والنتيجة ، فهذا وان كان خلاف الظاهر من التعريفات إلاّ انّ ذلك مألوف في التعريفات التي يكون الغرض منها إعطاء صورة عن المعرّف كما يقال في تعريف الخمر انّه المسكر ، فهو تعريف بما ينتج عنه.
والمتحصّل انّ هذا الاحتمال وان كان خلاف الظاهر من التعريف إلاّ انّه لمّا كان الاحتمال الثاني ـ والذي هو أقرب بحسب الصياغة اللفظية للتعريف ـ بعيد جدا كما ذكرنا والاحتمال الثالث ساقط لابتلائه بما ذكرناه من إشكال فيدور التعريف بين الإجمال وعدم انفهام معنى محصل له وبين الاحتمال الأول ، والظاهر تعيّنه لمناسبته مع تعريفات اخرى ومناسبته كذلك مع مرجعية الاستحسان في مقام التعارض.
ومع تمامية هذا الاحتمال يبقى السؤال عن الآليّة المعتمدة للاستحسان لتشخيص الدليل الأقوى والتي هي جوهر الاستحسان ، حيث قلنا انّ هذا التعريف ـ بناء على الاحتمال الاول ـ لا يكشف لنا سوى عن النتيجة المترتبة على الاستحسان ، وهي تشخيص الدليل الأقوى وأما الآلية المعتمدة لذلك فلا بدّ من استفادتها من مورد آخر.
وهنا مجموعة من الاحتمالات نوردها لغرض البحث عمّا هو المتعيّن منها :
الاحتمال الاول : إنّ الآلية المعتمدة لتشخيص الدليل الأقوى هو الكتاب المجيد أو السنة أو العقل القطعي والظني أو مناسبة أحد الدليلين لما تقتضيه المصلحة العامة أومناسبة أحدهما للمرتكزات العرفية أو تناسب أحدهما لسدّ الذرائع المفضية للحرام فهو حينئذ يكون الاقوى أو تناسب أحدهما لفتح الذرائع المفضية للواجب فهو الاقوى من الدليل الفاقد لهذه الخصوصية.
الاحتمال الثاني : ملائمة أحد الدليلين للطبع أو منافاة أحدهما للمذاقات العامة فيكون ما يقابله هو الأقوى.
الاحتمال الثالث : هو مجموع هذه المرجحات.
أمّا الترجيح بالكتاب أو بالسنة أو بالعقل أو بالمصلحة أو بسدّ الذرائع أو فتحها أو بالمرتكزات العرفية فمن غير المناسب أن يطلق عليها الترجيح بالاستحسان بل المناسب ان يقال ترجيح أحد الدليلين بالكتاب أو بالعقل وهكذا.
وما قد يقال انّه مجرّد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
نقول انّ هذا الكلام صحيح إلاّ اننا لا نحرز انّ ترجيح أحد الدليلين بالكتاب مثلا يصطلح عليه بالاستحسان حتى نقول لا مشاحة في الاصطلاح وانما نبحث عن ان مصطلح الاستحسان على أيّ شيء يطلق ، وحينئذ لا بدّ من ملاحظة الاعتبارات والمناسبات بين المصطلح والمصطلح عليه ، ومن الواضح عدم التناسب بين ترجيح أحد الدليلين بالكتاب المجيد وبين مصطلح الاستحسان.
وأما الاحتمال الثالث فيضعفه ما نجده في كلمات القوم من عدم انحصار الترجيح وتشخيص الاقوى بالاستحسان ، فلو كان الاحتمال الثالث هو المتعين لكان جامعا لتمام المرجحات وهذا ما لا يمكن قبوله لملاحظة انّ الاستحسان في كلماتهم يكون في عرض مرجحات اخرى وفي حالات يكون في طولها مما يعبّر عن انّ الاحتمال الثالث ليس هو المقصود.
ومن هنا يتعين الاحتمال الثاني ، إذ هو الذي لا يرد على الإشكال الوارد على الاحتمال الاول كما لا يرد عليه الإشكال الوارد على الاحتمال الثالث ، فمن المناسب جدا ان يقال حين ترجيح أحد الدليلين بما يلائم الطبع والمذاقات العامة من المناسب انّ يقال انّ الترجيح تم بالاستحسان ، على انّ هذا الاحتمال هو المناسب لبعض التعريفات المذكورة للاستحسان.
ثم انّه لو افترضنا جدلا ان الاحتمال الثالث هو المتعيّن لكان علينا ان نمارس عملية الاستذواق لغرض تشخيص الدليل الاقوى ولو في الحالات التي لا يكون معها مرجح آخر ، كما لو تعارض خبران ولم يكن ثمة مرجح من المرجحات الاخرى فإنّ علينا ان نلاحظ ما هو الدليل المناسب لمقتضيات الذوق وملائمات الطبع ، وهذا هو المستفاد مما ذكره السرخسي في مبسوطة ، حيث ذكر ان من تعريفات الاستحسان هو « طلب السهولة في الاحكام مما يبتلي به الخاص والعام » وكذلك ما نقله عن بعض من انّ الاستحسان هو « الأخذ بالسماحة وانتفاء ما فيه الراحة » « والأخذ بالسعة وابتغاء الدعة » ، فإنّ هذه التعريفات تعبّر عن انّه يحوم في حمى الاحتمال الذي رجّحناه أو يكون الاستحسان متضمنا للمعنى الذي ذكرناه.
وأما احتمال ان تكون الآلية لتشخيص الدليل الأقوى هو مجموع المرجحات باستثناء ما ذكرناه في الاحتمال الثاني فهو وان كان معقولا إلاّ انّه يتنافى ـ كما ذكرنا ـ مع عدّ الاستحسان مرجحا في عرض المرجحات الاخرى وفي حالات يكون في طولها مما يؤكد عدم إرادة هذا الاحتمال.
المعنى الخامس : وهو ما نقل عن المالكيّة من انّ الاستحسان هو« الالتفات الى المصلحة والعدل ».
وهنا لم يحدّد لنا التعريف متى يلجأ المجتهد للالتفات الى المصلحة والعدل ، وهل انّ الالتفات لذلك يكون في ظرف التعارض بين الأدلة ، فيكون الاستحسان من وسائل علاج التعارض أو ان الالتفات يكون ابتدائيا ، بمعنى انّه يكون وسيلة للكشف عن الحكم الشرعي فيكون في عرض الأدلة الاخرى ، أو انّ الالتفات يكون لغرض محاكمة الأدلة الشرعية والعقلية وغيرها فما كان منها مناسبا للمصلحة والعدل فهي صالحة للدليلية ، أما مع منافاتها للمصلحة والعدل فهي لا تصلح للدليلية والكاشفية عن الحكم الشرعي فتكون للاستحسان فوقية على سائر الأدلة ، إذ هو المشخص ـ بناء على هذا الاحتمال ـ للحجّة منها من غير الحجة حتى في ظرف عدم التعارض.
على انّ التعريف لم يشخّص لنا مرتبة المصلحة الموجبة للترجيح لو كان الاحتمال الاول هو المراد ، كما انّه لم يبيّن لنا مقدار المصلحة المؤثرة في الكشف عن الحكم الشرعي لو كان الاحتمال الثاني هو المقصود ، كما انّه لم يوقفنا على ماهية وحدود المصلحة الموجبة لثبوت الحجية لبعض الأدلة وانتفائها عن أدلة اخرى لو كان الاحتمال الثالث هو المراد.
ومن هنا لا ندري ما هو العلاج في حالة تعارض المصلحتين أو تزاحمهما وبأيّ وسيلة يتوسّل المجتهد لترجيح احدى المصلحتين ، ثم ما ذا لو تعارض أو تزاحم العدل مع المصلحة بأن كان أحد الدليلين مناسبا للمصلحة وكان الآخر مناسبا لمقتضيات العدل أو كان أحد الفعلين مناسبا للمصلحة والآخر للعدل ولم يكن ثمة مرجح من المرجحات الاخرى.
مثلا لو كان هناك رجل يحرق في كل ليلة بيتا من بيوتات البلدة وكان قطع مادة الفساد الذي يحدثه هذا الرجل يتوقف على حبس مجموعة من الرجال وتعذيبهم لغرض التعرّف على الجاني منهم ولم يكن ثمة وسيلة اخرى لقطع مادة الفساد.
فهنا يكون حبس هؤلاء الرجال وتعذيبهم متناسبا مع المصلحة العامة إلاّ انّه مناف للعدل ، إذ لا إشكال انّ حبس غير الجاني وتعذيبه من الظلم ، فهذه الحالة لا يجيب عليها التعريف المذكور أيضا.
على انّه يمكن الإيراد على التعريف بأن الاستحسان لا يكون ـ بناء عليه ـ دليلا مستقلا بل هو راجع الى المصالح المرسلة والى ما يدركه العقل من حسن العدل وقبح الظلم ، وحينئذ لا يكون الاستحسان إلاّ تكثيرا للمصطلحات بلا مغزى ، وهذا يتنافى مع الصناعة العلمية ، هذا بالإضافة الى انّ الظاهر من كلمات الاصوليين وفقهاء القوم انّ الاستحسان دليل مستقل في عرض الأدلة كالمصالح المرسلة والدليل العقلي وليس هو مصطلح ثان للمصالح المرسلة والدليل العقلي. ومن هنا يكون التشكيك في دقة هذا التعريف كبيرا جدا.
هذا تمام الكلام في معنى الاستحسان ، ولا بأس ببيان الأدلة التي استدلّ بها على حجية الاستحسان.
ذكر السيد الحكيم في كتابه الاصول العامة انّه استدلّ على ذلك بآيتين من الكتاب المجيد وبرواية من السنة الشريفة وبالإجماع ، ونحن نعرض لهذه الأدلة تباعا.
الدليل الاول : قوله تعالى {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } [الزمر: 18]
وتقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة لصالح القول بحجية الاستحسان ، انّ الله تعالى امتدح عباده اللذين يتبعون أحسن القول ، وهذا ما يعبّر عن حجية الاستحسان وإلاّ لما امتدح الله تعالى عباده المتصفين بالعمل بالاستحسان.
وقبل الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة نقول : انّ المراد من عنوان الأحسن يحتمل ثلاثة احتمالات :
الاحتمال الأول : انّه عنوان اضافي نسبي ، وحينئذ يكون معنى الآية هو حجية كل قول أو رأي إذا اضيف ونسب الى رأي آخر كان أحسن منه بقطع النظر عن كون القولين واجدين للحجيّة في نفسيهما أو لا ، فمحض الأحسنية هي المناط في ثبوت الحجية للقول المتصف بها.
وواضح انّ هذا الاحتمال غير مراد جزما ، إذ من غير المعقول ان يكون القول أو الرأي غير واجد للحجية وبمجرّد ان يضاف الى رأي آخر ويتفوق عليه نسبيا يكون ذلك موجبا لاتصافه بالحجيّة ، فالرأي حينما يكون منافيا لنظر الشارع لا يكون رجحانه على رأي آخر مناف أيضا للشارع موجبا لثبوت الحجيّة للرأي الراجح وإلاّ لما صحّ ان تكون للشارع متبنيات خاصة تثبت بموجبها حجية بعض الأقوال وعدم حجية أقوال اخرى ، إذ انّ الاقوال التي لم تثبت لها الحجيّة متفاضلة بلا ريب ، وحينئذ يكون الافضل منها حجة يلزم التعبّد به وهذا خلاف بناء الشارع على عدم حجيتها ، هذا لو كان المراد من الأحسنية هو الأحسنية الواقعية وإلا لو كان المراد من الأحسنية هو الأحسنية بنظر كل أحدد للزم الهرج والمرج ، إذ انّ الأحسنية بهذا المعنى تخضع لعوامل نفسية وملاحظة المصالح الشخصية وهي متفاوتة من شخص لآخر ومتزاحمة في غالب الأحيان ، وعندئذ يجرّ كل واحد النار الى قرصه ، وتكون لغة الغاب هي المحكمة في المجتمعات وبها يختلّ النظام ، وهذا ما يورث الجزم بعدم إرادة الآية الشريفة لهذا المعنى.
الاحتمال الثاني : انّ المراد من عنوان الأحسنية هي الأحسنية الواقعية في إطار الأقوال الواجدة للحجية في نفسها وبقطع النظر عن تفاضلها ، وحينئذ يكون المراد أحد احتمالات ثلاثة :
الاول : ان يكون كل واحد من القولين واجدا للحجية في حدّ نفسه ما لم يتعارضا أو يتزاحما واذا تعارضا أو تزاحما فإنّ الحجية تسقط عن القول المفضول وتبقى الحجية للقول الأحسن. فما يقتضيه القياس مثلا حجة في حدّ نفسه وكذلك ما يقتضيه النص القرآني إلاّ انّه حينما يتعارضان أو يتزاحمان فإنّ الحجيّة تسقط عن المفضول منهما وهو ما يقتضيه القياس.
الثاني : ان يكون كل واحد من القولين واجدا للحجيّة ولا يكون التفاضل بينهما موجبا لسقوط المفضول حتى في ظرف التعارض أو التزاحم نعم الارجح هو الأخذ بالقول الفاضل.
الثالث : ان تكون الآية بصدد بيان راجحية اختيار القول الفاضل وليست متصدية لحالات التعارض أو التزاحم.
والاحتمال الراجح من هذه الاحتمالات هو الأول وذلك بقرينة ذيل الآية الشريفة {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ} [الزمر: 18] هذا لو كنا نبني على حجية مفهوم الوصف فيكون المتبع للأحسن هو الذي هداه الله عزّ وجلّ ، وبمفهوم الوصف يكون غيره من أهل الضلال ، إلاّ أنّ المعروف بين الاعلام هو عدم حجية مفهوم الوصف ، وعليه لا يكون الاتصاف بالهداية لمتّبع الأحسن ملازما لانتفائها عن غير المتّبع للأحسن خصوصا مع ملاحظة المعطوف على وصف الهداية وهي قوله {وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: 18] أي أولوا العقول الراجحة ، فإنّ هذا الوصف يشعر بأن الأخذ بالأحسن من صفات الكمال وليس هو الفيصل بين الحق والباطل والهداية والضلال ، فالهداية والتعقّل من المفاهيم المشككة ، فمن الناس من يأخذ منهما بحظ وافر فهذا هو الأهدى والأعقل ، ومنهم من يكون حظه منهما أقل وهذا لا يقتضي انسلاب صفة الهداية والتعقل عنه.
ومن هنا لا يمكن استظهار المعنى الاول ، ولا يبعد ان يكون المعنى الثالث هو المتعين من هذا الاحتمال ، وذلك لأنّه بعد عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم لا يكون ثمة مبرّر لاستظهار تصدّي الآية الشريفة لعلاج حالات التعارض والتزاحم ، إذ المبرّر لاستظهار تصدّي الآية لذلك هو مفهوم الوصف ، إذ به يثبت انّ متّبع غير الأحسن لا يكون مهديّا وهذا معناه سقوط الحجية عن القول غير الأحسن وذلك يقتضي انّ الآية متصدية لعلاج حالات التعارض والتزاحم ، إذ لا معنى لسقوط أحد القولين عن الحجية بمجرّد أنّ أحدهما أحسن من الآخر إذا لم يكونا متعارضين أو متزاحمين ، وعليه وبعد عدم حجية مفهوم الوصف تكون الآية بصدد بيان راجحية اختيار القول الأحسن من القولين الواجدين للحجيّة وليست متصدّية لعلاج حالات التعارض والتزاحم أصلا ، لا أقل انّ هذا المعنى محتمل جدا وليس المعنى الاول مترجح عليه فتكون الآية الشريفة مجملة من هذه الجهة.
على انّه لو كان المعنى الاول من هذا الاحتمال هو المتعيّن لما كانت الآية الشريفة صالحة للاستدلال بها على حجية الاستحسان ، وذلك لأن المعنى الاول لا يقتضي أكثر من حجيّة القول الاحسن وسقوط الحجية عن غير الاحسن اما كيف نشخّص الأحسن من القولين فهذا ما لم تتصد الآية الشريفة لبيانه.
فالتعريف الاول والثاني والثالث والخامس كلها متصدية لتشخيص الأحسن من الأقوال والبحث إنما هو عن ثبوت الحجية لهذه المشخصات ولا يمكن إثبات حجية ذلك بالكبرى الكلية المستفادة من الآية الشريفة ، إذ من الواضح ان القضايا لا تنقح موضوعاتها ، فحينما يقول المولى أكرم العلماء فإنه ليس متصديا لإثبات انّ زيدا عالما وان بكرا عالما ، وهنا أيضا حينما يقول « الأحسن هو الحجة » لا يكون ذلك موجبا لإثبات انّ الأحسن هو المستفاد بواسطة الذوق وملائمات الطبع أو العقل أو المصلحة أو ما الى ذلك ، نعم لو ثبت من خارج الآية الشريفة انّ الأحسن يتشخص بواسطة الذوق أو المصلحة أو العقل فإنّه يمكن التمسّك بالآية الشريفة لإثبات الحجية لهذه الصغريات ، إذن فلا بدّ من التماس دليل آخر على حجية الاستحسان في إثبات ما هو أحسن.
نعم يبقى الكلام في التعريف الرابع وهو انّ الاستحسان يعني « العمل بأقوى الدليلين » ، وقد احتملنا للمراد منه ثلاثة احتمالات ورجحنا الاحتمال الاول وبناء عليه يكون التعريف متصديا أيضا لتشخيص القول الأحسن وبذلك يكون مشمولا للإشكال الوارد على التعريفات الاخرى ، وأما بناء على الاحتمال الثاني فالاستحسان ليس من أدلة الحكم الشرعي ، وأما بناء على الاحتمال الثالث فهو مطابق للآية بناء على المعنى الاول من الاحتمال الثاني لها إلاّ انّه لا ينفع لإثبات المطلوب بعد ان كان مفاده حجية الدليل الأقوى دون تشخيص ما هو الدليل الاقوى من الدليل الأضعف.
الاحتمال الثالث : لمعنى الآية الشريفة انّ المراد من عنوان الأحسن هو الأحسن الواقعي إلاّ انّه في مقابل القول الباطل ، فالآية الشريفة تمتدح اللذين يأخذون بالقول الحق ، وذلك بقرينة السياق.
ولكي تتضح الدعوى نذكر الآية الشريفة بتمامها وكذلك التي سبقتها والتي تليها {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ * أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ * لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ..... } [الزمر: 17 - 20].
فالآية الشريفة واقعة في هذا السياق وهي تعبّر عن انّ المهديين واولي الألباب واللذين لهم البشرى هم اللذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا لربهم واتّبعوا أحسن القول ، وفي مقابلهم من حقت عليه كلمة العذاب وليس من سبيل لإنقاذهم من النار.
والذي يؤكد ما ذكرناه انّ الآية الشريفة رتبت البشارة على اجتناب عبادة الطاغوت والإنابة لله جلّ وعلا ثم عطفت ذلك ببيان العلة من البشارة وهي اتباع أحسن القول ، فأحسن القول هو اجتناب الطاغوت والإنابة لله جلّ وعلا ، فالتوصيف هنا باتباع أحسن القول سيق لغرض التعليل أو لغرض الاحتراز وكلاهما يصبان في صالح المطلوب كما هو واضح.
ثم لم تكتف الآيات بزفّ البشرى للذين يتبعون أحسن القول أي اللذين اجتنبوا الطاغوت بل أوضحت مصير غيرهم فقالت {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ } [الزمر: 19] فليس هنا حالة برزخية فاما اتباع أحسن القول وهو المستوجب للبشرى وإمّا اتباع الطرق الاخرى وهو المستوجب للعذاب.
وبهذا اتضح انّ الأحسنية في الآية الشريفة ليست في مقابل الحسن وانّما هي في مقابل سيّئ القول وباطله فهي على غرار قوله تعالى {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى} [يونس: 35] فأحقية الذي يهدي للحق بالاتباع ليست في مقابل استحقاق من لا يهدي للإتباع ، فالذي لا يهدي لا يستحق الإتباع بل يحرم اتباعه.
وبتمامية استظهار هذا الاحتمال تكون الآية غير نافعة لأثبات ما يروم القوم إثباته من حجية الاستحسان ، وما قد يقال من انّه يمكن إثبات حجية الاستحسان بواسطة التمسّك بأطلاق اللذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
نقول انه لو تم الإطلاق ـ بناء على هذا الاحتمال ـ فإنّ الإشكال الوارد على المعنى الاول من الاحتمال الثاني لمعنى « الاحسن » وارد هنا أيضا فراجع.
الدليل الثاني : قوله تعالى : {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } [الزمر: 55]
وهذه الآية الشريفة تحتمل عدة احتمالات نذكر أهمها :
الاحتمال الاول : انّ الآية الشريفة في صدد التأكيد على اتباع التكاليف الإلزامية ، فإنها أحسن ما انزل من الله جلّ وعلا ، وذلك في مقابل الأحكام التكليفية الغير الإلزامية ، فهي وان كانت حسنة إلاّ التكاليف الإلزامية أحسن ، ولعل منشأ الأحسنية هو ان الملاكات في موردها تامة ، فالأحسنية بلحاظ ما يعود على المكلّف من نفع وما يندفع عنه من ضرر ، أو بلحاظ انّ اتباعها هو المنجي من النار ، وأما التكاليف غير الإلزامية فهي بالإضافة الى انّ ما يعود منها على المكلّف ليس بمستوى ما يعود عليه من اتباع التكاليف الإلزامية ، فهي بالإضافة لذلك فإنّ اتباعها لا يوجب النجاة من النار والفوز بالجنة لو كان المتبع لها تاركا للتكاليف الإلزامية.
الاحتمال الثاني : انّ الآية الشريفة متصدّية لعلاج حالات التعارض والتزاحم وان المكلّف ملزم بالأخذ بأحسن ما انزل ، ولمّا كان التعارض فيما انزل غير معقول فيتعين القول إما باختصاص تصدّي الآية الشريفة لحالات التزاحم أو انّ المراد مما انزل هم الأعم من القرآن الكريم وسائر الأدلة ـ فإن التعارض حينئذ معقول ، وذلك كما لو تعارض خبر ثقة مع ظهور آية ـ أو يكون المراد من التعارض هو التعارض الصوري بين متشابهات الآيات ومحكماتها فالأحسن حينئذ هو الأخذ بالمحكمات ، والأحسنية هنا بلحاظ المكلّف لجهله بالمراد من المتشابهات.
الاحتمال الثالث : انّ الآية تخاطب الكفار أو العصاة وتعظهم باتباع أحسن ما انزل اليهم ، فقد انزل اليهم التهديد والوعيد بالنار والعذاب كما انزلت اليهم البشرى بالمغفرة عند ما ينيبون الى ربهم ويتوبون اليه من قبل ان يباغتهم العذاب.
والأحسنية هنا بلحاظهم حيث انّ الاوفق بحالهم هو التوبة والإنابة لانها تستوجب المغفرة. ويمكن ان يستظهر هذا المعنى بواسطة سياق الآية الشريفة {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ.....} [الزمر: 54 - 56] ، وهذا المعنى استظهره الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله.
وأوفق احتمال يناسب دعوى دليلية الآية الشريفة على حجية الاستحسان هو الاحتمال الثاني إلاّ انّه مع مخالفته لظهور الآية الشريفة لا تثبت به الدعوى.
أما مخالفته لظهور الآية الشريفة فواضح بملاحظة سياق الآية وسابقتها والتي تليها ، فهي تأمر بالإنابة والرجوع الى الله تعالى قبل فوات الأوان ومباغتة العذاب ، وهذه اللغة لا تناسب أهل الطاعة واللذين يبحثون عن حكم الله تعالى ويتحرّون مظانه ، فهل من المناسب لو جاءك طالب الحق يبحث عن وظيفته الشرعية أترى من المناسب أن تهدده وتزجره وأي أحد من أهل المحاورة يقبل بهذا النحو من البيان حتى نقبل ذلك على الله جلّ وعلا ، ولو تنزلنا وقلنا انّ المعنى المتعين من الآية الشريفة هو الاحتمال الثاني فإنّه لا ينفع لإثبات الدعوى وذلك لأمور :
أولا : لانّه أجنبي عما يراد اثباته من حجية الاستحسان ـ بناء على التعريف الاول والثاني والثالث والخامس ـ فإنها جميعا بصدد تحديد صغرى الدليل الاقوى ، وهذا ما لم تتصد الآية الشريفة لبيانه حتى بناء على الاحتمال الثاني ، إذ انها ـ بناء عليه ـ بصدد بيان حجية الدليل الاقوى اما ان تشخيص الدليل الاقوى يتم بواسطة الذوق وملائمات الطبع أو ما يستحسنه العقل أو ما يدلّ عليه الكتاب والسنة أو ما يناسب المصلحة أو العدل فهذا ما لا يمكن استفادته من الآية الشريفة حتى بناء على الاحتمال الثاني.
واما التعريف الرابع فكذلك يرد عليه نفس الإشكال بناء على ما استظهرنا وهو الاحتمال الاول ، وأما الاحتمال الثالث للتعريف فهو صياغة ثانية للآية بناء على احتمالها الثاني ، وعليه لا يكون الاستحسان أكثر من لزوم العمل بالدليل الأقوى أما ما هو الدليل الاقوى فهذا ما لا يتصدى التعريف الرابع ـ بناء على احتماله الثالث ـ لبيانه.
ثانيا : الآية ـ بناء على احتمالها الثاني ـ أخص من المدعى في بعض التعريفات كالتعريف الاول حيث لا تختص حجية الاستحسان ـ بناء عليه ـ بحالات التعارض أو التزاحم بل هو حجة حتى في غير مورديهما وكذلك الكلام في التعريف الثاني بل وحتى الخامس لو كان الالتفات الى المصلحة والعدل مطردا حتى في غير حالات التعارض والتزاحم كما هو مقتضى اطلاق التعريف.
الدليل الثالث : وهو من السنة الشريفة وهو ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن مسعود انّه قال « انّ الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فوجد أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيّئ ».
والإشكال على الاستدلال بهذه الرواية من جهتين :
الجهة الاولى : تتصل بالسند حيث انّ ابن مسعود رحمه الله لم يسند الرواية الى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فهي مقطوعة ، وهذا ما يوهن الاستدلال بها على المطلوب إذ لعلها كلاما لابن مسعود نفسه ، نعم بناء على حجية قول الصحابي يمكن الاستدلال بهذا النص إلاّ انّ الاستدلال حينئذ يكون بقول الصحابي لا بالسنّة الشريفة ، وعندئذ يكون الدليل مبنائيا ، فمن لا يرى حجية قول الصحابي لا يصلح هذا الدليل لإلزامه ، وذلك لا يمثل طعنا في الصحابي الجليل ابن مسعود إذ فرق بين عدالة الرجل وبين حجية قوله واجتهاده.
الجهة الثانية : إنّ لفظ المسلمين في قوله « فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن » ظاهر في العموم المجموعي أي ما رآه مجموع المسلمين ، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن محلّ البحث ، إذ انّها انّما تثبت حجية الإجماع لا حجية الاستحسان الذي قد يختص به مجتهد أو مجتهدان ، على انّه لا يبعد ان يكون ذلك مختص بالصحابة حيث رتبت الرواية حجية ما يراه المسلمون حسنا على نظر الله جلّ وعلا إلى قلوب العباد ووجدانه امتياز قلوب الصحابة على سائر قلوب العباد ، إذ لا معنى لثبوت حجية استحسان المسلمين بسبب ان قلوب الصحابة خير قلوب العباد إذ لا ارتباط بين السبب ونتيجته مما يوجب استظهار انّ الذي ثبت لاستحسانه الحجية هو خصوص الصحابة ، فتكون الرواية أخص من المدعى ـ لو بنينا على انّها في صدد إثبات حجية الاستحسان وإلاّ فهي ـ كما هو الظاهر من الرواية ـ أجنبية عن محل البحث ، إذ انّها متصدية لإثبات حجية إجماع الصحابة.
ثم انّ الإنصاف انّ الرواية ليست متصدية للحديث عما يكشف عن الحكم الشرعي وان رؤية أو استحسان المسلمين يكشف عن حكم الله الواقعي بل هي تعبّر عن انّ قلوب المسلمين أو الصحابة لمّا كانت على الفطرة لم تتغلّف بحجب الضلال والكفر أو انّها تخلّصت منها بالإيمان والهداية فإنّ لها حينئذ ان تتعرّف على موارد الفضيلة والرذيلة والخير والشر ، إذ ان ضمير الإنسان إذا خلا من الكفر والعصبية فإنّه يكون دليل الخير والصلاح.
هذا ما يستظهر من الرواية فهي من الروايات الأخلاقية التي لا صلة لها بالدعوى ، والتعبير «بما رآه المسلمون » ناشئ عن انّ الوقوف على موارد الفضيلة والرذيلة لا يختص بفرد دون آخر بعد افتراض سلامة الفطرة.
والذي يؤكد ما ذكرناه انّ الرواية رتّبت الفقرة الأخيرة وهي قوله « ما رآه المسلمون حسنا » على نظر الله جلّ وعلا لقلوب العباد ووجدانه انّ قلوب الصحابة خير قلوب العباد ، وواضح انّ القلب لا يكشف عن الحكم الشرعي وإلاّ فما معنى اختلاف المسلمين في فتاواهم المعتمدة على الاستحسان إلاّ ان يقال ان قلب المسلّم مشرّع وليس كاشفا وحينئذ يجب الالتزام بأن ما يوحيه قلب كل مسلم من حكم حجة عليه ولو لم يكن هذا المسلم مجتهدا ، وذلك لأنّ الرواية لم تجعل هذه الصفة لمسلم دون آخر حتى تكون صلاحية ذلك منحصرة بالمجتهد ، وهذا ما لا يلتزم به القائلون بالاستحسان.
الدليل الثالث : دعوى الإجماع على حجية الاستحسان.
والظاهر عدم وجود دعوى بهذه السعة وانما هي موارد .. وقليلة أيضا ـ ادّعي انّ اجماع الأمة عليها نشأ عن الاستحسان ، وحينئذ نقول : إن صرّح حينئذ في معقد هذه الإجماعات انّها نشأت عن الاستحسان فإنّ الاستحسان يثبت في الجملة أي في الموارد التي تجمع الأمة قاطبة على صلاحيته لإثبات حكم أو نفي حكم ولا يصحّ التعدّي منها الى موارد اخرى ، كما لا بدّ من ملاحظة أي نحو من الاستحسان الذي أجمعت الأمة على أهليته لإثبات حكم ذلك المورد ومع تشخيصه يكون هو المتعين من أنحاء الاستحسان ، إذ انّ غيره ليس موردا للإجماع فلا يمكن الاستدلال بالإجماع على حجيته ، ومع عدم تشخيصه لا يصح إعمال الحدس لتحديده ، وذلك لأنه اجتهاد خاص لا يمكن تحميل اجماع الامة عليه وإلاّ فهو خروج عن الاستدلال بالإجماع.
هذا كلّه لو صرّح في معقد الإجماع بأن مدركه هو الاستحسان وأما مع عدم التصريح فلا مبرّر للاستدلال على حجيّته بالإجماع إلاّ الحدس والاجتهاد وهو خروج عن الاستدلال بالإجماع.
والظاهر انّ تمام الموارد القليلة التي ادعي قيام الإجماع عليها وانّه ناشئ عن الاستحسان هي من هذا القبيل ، إذ من المتعذّر عادة إحراز انّ المنشأ من تبني كل فرد أو عالم من الامة لهذا الحكم هو الاستحسان ، وعدم وجود ما يبرّر الإجماع من نص لا يقتضي تعين المدرك في الاستحسان فلعلّ المدرك هو السيرة العقلائية أو المتشرعية ، ولعلّ المناشيء مختلفة فكل فريق نشأ تبنيه للحكم عن مدرك غير الذي نشأ عنه تبني الفريق الآخر فيتكون الإجماع ولكن بمناشئ مختلفة.
هذا بالإضافة الى عدم تمامية دعوى إجماع الأمة على حجية الاستحسان ، فإنّ هذه الدعوى منقوضة بمذهب الامامية حيث يبنون جميعا على عدم حجيته وكذلك الظاهرية والشافعية.
وبهذا يتضح سقوط تمام الأدلة التي استدلّ بها على حجية الاستحسان ، وهو كاف لسقوطه عن الحجية من غير حاجة لإثبات ذلك ، فإن الأدلة الظنية التي لم يقم الدليل القطعي على حجيتها باقية على الأصل وهو عدم الحجية. لقوله تعالى {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: 36].



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|