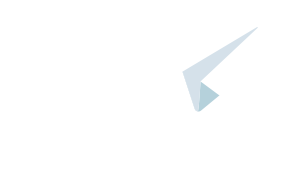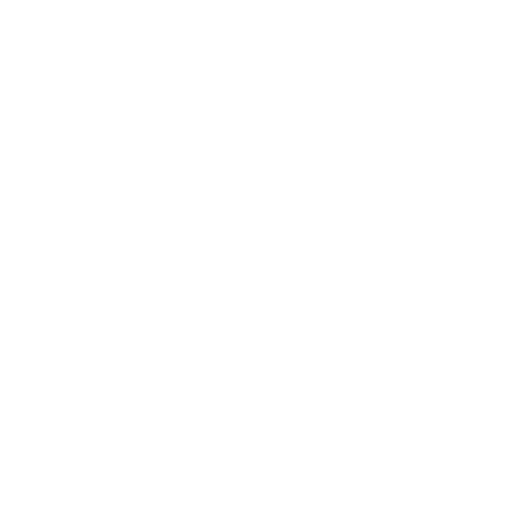الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


الآداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

أخلاقيات عامة
بحث مفصّل حول الرياء
المؤلف:
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
المصدر:
الأخلاق في القرآن
الجزء والصفحة:
ج1 / ص 240 ـ 255
2024-12-07
2732
الرّياء: النقطة المقابلة للإخلاص هي: «الرّياء»، وقد ورد ذمّه بكثرةٍ في الآيات والروايات الشريفة، التي نهرت النّاس من هذا العمل المُشين، واعتبرته من أوضح مصاديق الشّرك الخفي، وعلّة بطلان الأعمال، وعلامة من علامات النّفاق.
ونجد فيها أنّ الرّياء يهدم الفضائل، ويزرع بذور الرّذائل في روح الإنسان، وُ يشغله عن الهدف الأساسي الحقيقي، في خطّ الرّسالة والاستقامة.
وهو أداةٌ قويةٌ مؤثرةٌ بيد الشّيطان الرّجيم، لإضلال وصرف النّاس عن الطّريق الصّحيح، وتحويلهم من دائرة الإيمان، إلى دائرة الكفر والانحراف.
ونعود هنا للآيات القرآنية الكريمة، التي ترينا وجه المرائي القبيح، والنّتائج السلبيّة المترتّبة على الرّياء:
1 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ)([1]).
2 ـ (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)([2]).
3 ـ (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً)([3]).
4 ـ (وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً)([4]).
5 ـ (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)([5]).
6 ـ (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ* وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ)([6]).
تفسير واستنتاج:
«الآية الاولى»: تبيّن أن المنّ بالصدقات وإيذاء الآخرين، يدخل في عداد الرّياء ويمحق أعمال الخير، وتبيّن أنّ المرائي لا يعيش الإيمان بالله ولا باليوم الآخر، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى ...)، وبعدها يشبّه هؤلاء الناس بمثل الذي يُنفق أمواله من موقع الرّياء: (كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...).
وجاء في ذيل الآية: تشبيهٌ جميلٌ جدّا لأعمالهم العقيمة، التي لا تثمر في نطاق المعنويّات وترتب الثّواب، فأعمالهم كالصّخر الذي يعلوه التراب، فيَشتَبِه الفلاح في أمره، فيبذر فيه البذور بأمل الخصب والزّرع، فيأتي المطر ويزيل كلّ شيءٍ، فقال: (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً).
ومن المؤكد أنّ مثل هذا العمل والزرع، لن يثمر أو يورق، فكذلك سبحانه وتعالى، لا يهدي من ينطلق في تعامله مع الله تعالى من موقع الرّياء والكفر، (لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ).
فعرّفت الآية مثل هؤلاء الأفراد بالمرائين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومرّة اخرى عرّفتهم بالكافرين، الذين تتحرك أعمالهم كالسّراب المخادع، الذي لا قيمة له، لأنّهم بذروا أعمالهم في أرض الرّياء السّبخة التي لا تصلح للزراعة، ويوجد احتمال آخر في تفسير الآية، وهو أنّ المرائي نفسه بمثابة قطعة الصّخر، التي لا يثبت عليها التراب، ولا يفيد معه أيّ بذرٍ من بذور الخير والصّلاح.
نعم! فأرواحهم مريضةٌ وأعمالهم عقيمة، لا تقوم على أساس من الخير، ونيّاتهم مشوبة بدرن الرّياء والشّرك الخَفي.
واللّطيف: أنّ الآية التي تلتها في سورة البقرة، شبّهت أعمال المخلصين، بجُنينةٍ لا بذور فيها إلّا بذور الصّلاح، فأصابها وابلٌ فنبتت نَباتاً حسناً، فأثمرت ثمراً مضاعفاً ومُباركاً فيها.
«الآية الثانية»: خاطبت الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وأمرته بإيصال التّوحيد الخالص للنّاس، انسجاما مع خطّ الرّسالة، وباعتبار أَنَّ التّوحيدَ أصلٌ أساسي في الإسلام: (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ).
وبذلك يستوحي المؤمن من جو الآية الكريمة، أنّ الأعمال يجب أن تكون خالصةً ومنزّهةً من أدران الشّرك: (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً).
وعليه فإنّ الشّرك في العبادة، يهدم أساس التّوحيد، والاعتقاد بالمعاد في حركة الإنسان والحياة، أو بتعبيرٍ أدق: فإنّ جواز السّفر إلى الجنّة الخالدة، يتمثل بِخُلوص العمل في دائرة السّلوك والنيّة.
وجاء في شأن نزول الآية: قال ابن عباس: أنّها نزلت في جُندب بن زهير العامري، قال: يا رسول الله إنّي أعمل العمل لله تعالى، واريد به وجه الله تعالى، إلّا أنّه إذا اطلع عليه أحد من الناس سرّني ؛ فقال النّبي (صلى الله عليه وآله): «إنَّ اللهَ طَيِّبٌ وَلا يَقْبَلُ إِلّا الطَّيِّبَ وَلا يَقْبَلُ ما شُورِكَ فِيهِ» ([7]).
وجاء في شأن نزول الآية أيضاً، قال طاووس: قال رجل: يا رسول لله! إني احبّ الجهاد في سبيل الله تعالى واحبّ أن يرى مكاني، فنزلت الآية. ([8])
وَوَرد مثل هذا المضمون بالنّسبة للإنفاق وصِلة الرّحم ([9])، وتبيّن أنّ الآية الآنفة: نزلت بعد الأسئلة المختلفة، في الأعمال المشوبة بغير الأهداف الإلهيّة، وقد اعتبرت المُرائي على حدّ من يعيش حالة الشّرك بالله والشّخص الذي لا إيمان له بالآخرة.
ونقرأ في حديثٍ آخر، عن الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «مَنْ صَلّى يُرائي فَقَدْ أَشرَكَ، وَمَنْ صامَ يُرائِي فَقَدْ أَشرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرائي فَقَدْ أَشرَكَ، ثُمَّ قَرَأ: فَمَنْ كانَ يَرجُوا لِقاءَ رَبِّهِ ...» ([10]).
«الآية الثّالثة»: بيّنت أنّ الرّياء هو من فعل المنافقين: (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً).
والجدير بالذكر أنّ النّفاق عبارةٌ عن ازدواجية الظّاهر والباطن، وكذلك الرّياء فهو ازدواجية الظاهر والباطن، حيث يتحرك المرائي في أعماله لجلب الأنظار، فمن الطّبيعي أن يكون الرّياء من برامج المنافقين.
«الآية الرابعة»: اعتبرت الأعمال التي ينطلق بها الإنسان من موقع الرّياء، مساويةٌ لعدم الإيمان بالله تعالى واليوم الأخر: (وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً).
وعليه فإنّ المرائين هم أصحاب الشيطان، الذين يفتقدون الإيمان الحقيقي بالمبدأ والمعاد.
«الآية الخامسة»: تنهى المسلمين من التشبّه بأعمال المشركين الكفّار، الذين لا يفعلون شيئاً إلّا للرياء والتّفاخر فقط: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ).
فطبقاً للقرائن والشواهد الموجودة، وتصديق المفسّرين، فإنّ هذه تشير إلى خروج المشركين من قريش في يوم بَدر، بحليّهم وزينتهم وقد جلبوا معهم آلات الطّرب واللّعب واللهو والنبّيذ، وهم يقصدون جلب أنظار أصحابهم من المشركين الوثنيين.
وجاء في بعض التّفاسير، أنّ منطقة بدر، كانت تعتبر من المراكز التّجارية لعرب الجاهليّة في وقتها، وأنّ أبا جهل جاء بوسائل الطرب والجواري، لغرض مُراءاة النّاس، وفَقْأ العيون كما يقول المثل الشّائع.
وعلى كلّ حال، فإنّ القرآن الكريم قد نهى المؤمنين من أمثال هذه الأعمال الشائنة، ودعاهم إلى ترويض النّفس بالإخلاص والتّقوى، للتغلب على تلك الحالات النفّسية الخطرة، وأن لا ينسوا مصير المُرائين وأتباع الشّيطان في معركة بدر.
«والآية الأخيرة»: من الآيات مورد البحث، نجدها تذّم الرّياء ولكن بصورة اخرى فتقول: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ* وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ).
فقد جاءت كلمة «الويل»، في (27) مورداً من القرآن، واختصت في الأغلب بالذّنوب الكبيرة الخطرة جدّاً، وهنا تحكي عن شدّة قُبح ذلك العمل في واقع الإنسان وروحه.
إنّ ما ورد في الآيات الآنفة الذكر، يوضح إلى درجةٍ كبيرةٍ، قُبحَ هذه الخطيئة، وأخطارها وآثارها السلبيّة على سعادة الإنسان في حركة الحياة، ومن الواضح فإنّ الرّياء يقف حَجرَ عثرةٍ في طريق تهذيب النّفس، وطهارة القلب والرّوح للإنسان المؤمن.
الرّياء في الرّوايات الإسلاميّة:
تطرقت الرّوايات لهذا الأمر بقوّةٍ وأهميّة بالغةٍ، وعرّفت الرّياء بأنّه من أخطر الذّنوب، ومنها:
1 ـ ما وَرد عن الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أنّه قال: «أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيكُمْ الرّياء والشَّهوةُ الخَفِيّةُ» ([11]).
ويمكن أن يكون المراد من الشّهوة الخفيّة، هو المقاصد الخفيّة للرياء.
2 ـ وأيضاً ما نقل عنه (صلى الله عليه وآله): «أَدنى الرِّياءِ شِركٌ» ([12]).
3 ـ وأيضاً عنه (صلى الله عليه وآله): «لا يَقْبَلُ اللهُ عَملاً فِيهِ مِقدارُ ذَرَّةٍ مِنْ رِياءٍ» ([13]).
4 ـ وعنه (صلى الله عليه وآله): «إِنَّ المُرائِي يُنادى يَومَ القِيامَةِ يا فاجِرُ يا غادِرُ يا مُرائي ضَلَّ عَمَلُكَ وَحَبَطَ أَجْرُكَ إِذْهَبْ فَخُذْ أَجْرَكَ مِمَّن كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ» ([14]).
5 ـ وقال أحد أصحاب الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يوم ما باكياً، فقلت: ما يُبكيك يا رسول الله؟ فقال: «إنّي تَخَوَّفْتَ عَلى أُمَّتِي الشَّركَ، أَمّا إِنّهُمْ لا يَعَبُدُونَ صَنَماً وَلا شَمْساً وَلا قَمَراً وَلا حَجرَاً، وَلَكِنَّهُم يُراؤُونَ بِأَعْمالِهِم» ([15]).
6 ـ وفي حديث آخر عنه (صلى الله عليه وآله) قال: «إِنَّ المَلَكَ لَيَصْعَدُ بِعَمَلِ العَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ فَإِذا صَعَدَ بِحَسَناتِهِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اجْعَلُوها فِي سِجِّينٍ إِنَّهُ لَيسَ إِيَّايَ أَرادَ بِها» ([16]).
7 ـ وأيضاً عنه (صلى الله عليه وآله): «يَقُولُ اللهُ سُبْحانَهُ إِنِّي أَغْنَى الشُّرَكاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً ثُمَّ أَشْرَكَ فِيهِ غَيرِي فَأَنَا مِنْهُ بريء وَهُوَ لِلَّذِي أَشرَكَ بِهِ دُونِي» ([17]).
هذه الأحاديث السّبعة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بيّنت أنّ إثم الرّياء بدرجةٍ من الشدّة، بحيث لا يضاهيه شيءٌ من الذّنوب والخطايا، وما ذلك إلّا للنتائج السّيئة للرّياء في نفس وروح الإنسان، وكذلك على مستوى الفرد والمجتمع.
أمّا ما ورد عن الأئمّة (عليهم السلام):
8 ـ ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)، ينقل عن جدّه (عليه السلام): «سَيأَتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ تَخْبَثُ فِيهِ سَرائِرِهُمْ وَتَحْسُنُ فِيهِ عَلانِيَّتِهِم، طَمَعاً في الدُّنيا لا يُريدُونَ بِهِ ما عِنْدَ رَبِّهِم يَكُونَ دِينُهُمْ رِياءً، لا يُخالِطُهُم خَوْفٌ، يَعُمُّهُمُ اللهُ بِعِقابٍ فَيَدْعُونَهُ دُعاءَ الغَرِيقِ فلا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ» ([18]).
9 ـ وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: «كُلُّ رِياءٍ شِرْكٌ، إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كانَ ثَوابُهُ لِلنّاسِ، وَمَنْ عَمِلَ للهِ كانَ ثَوابُهُ عَلَى اللهِ» ([19]).
10 ـ وفي حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «المُرائِي ظاهِرُهُ جَمِيلٌ وَباطِنُهُ عَلِيلٌ» ([20]).
وقال أيضاً: «ما أَقْبَحَ بِالإِنسانِ باطِناً عَلِيلاً وَظاهِراً جَمِيلاً» ([21]).
وما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعن الأئمّة الهداة، في هذا المجال كثير.
فلسفة تحريم الرّياء:
قد يتعجّب البعض الذين يعيشون السّذاجة الفكريّة، عند نظرهم وللوهلة الاولى، للروايات التي تتعرض لمسألة الرّياء، ونتائج المرعبة، ويتصورون أنّ عمل الإنسان إذا كان سليماً ومنتجاً في واقعه الخارجي، فأيّاً كانت النيّة والدّافع، فلن يؤثر ذلك في تغيير العمل، فالذي يبني مُستَشفاً! أو مسجداً أو يعبّد الطّرق والجسور .. وغيرها من الامور التي تصبّ في الصّالح العام للناس، فعمله صحيحٌ وحسنٌ مهما كانت نيّته، فلْندَع النّاس يفعلوا الخير، وما لنا والنيّة!!
ولكن الخطأ الفادح يكمن هنا لأنّه: أولاً: إنّ كلّ عملٍ وفعلٍ يترتب عليه نوعان من ردود الفعل، أحدهما ما ينعكس أثره في نفس الإنسان، والآخر ما يترتب على الفعل في الخارج، فالمُرائي يحطّم نفسه من الدّاخل ويُبعدها عن التّوحيد والدّين الحنيف، ويوقعها في وادي الشّرك، ويعتبر عزّته واحترامه رهنٌ بيدَ النّاس، وينسى قُدَرة الباري تعالى في دائرة التّصرف في عالم الوجود، وبهذا يكون الرّياء نوعاً من الشّرك بالله تعالى، ويُفضي إلى نتائج وخيمة على مستوى الأخلاق والقِيَم الإنسانية.
وثانياً: بالنّسبة للعمل الخارجي، الذي يقصد به الرّياء والسّمعة، فالمجتمع هو الخاسر الأوّل في هذا المضمار، لأنّ المرائي يسعى لتحسين عمله، على مستوى الظّاهر فحسب دون الاهتمام بالباطن، ممّا يُفضي إلى تحويل العمل، إلى انحراف وإفسادٍ على المستوى الإجتماعي.
وبعبارةٍ اخرى: إنّ المجتمع الذي يتّخذ من الرّياءِ مركباً، في ممارسات الأفراد، سيكون كلّ شيءٍ فيه بلا مُحتوى، ك: (الثقافة، الاقتصاد، السياسة، الصحة والنظام والقوى الدفاعية) وكلّها ستهتم بالظّاهر فقط، ولا يكون الهدف منها نيل السّعادة الحقيقيّة للأفراد، بل سيركضون وراء كلّ شيءٍ برّاقٍ وجميلِ الظاهر، وأمّا باطنه، فالله العالم.
وهذا النّوع من الاتجاه، يورد صدمات وضربات ومضرّات في حركة الواقع الإجتماعي، لا تخفى على ذهن الفطن الكيّس.
علامات المُرائي:
قد يصاب بعض الأشخاص، لدى مطالعتهم لتلك الأحاديث التي تُشدّد على المرائي بالوسَوسة النّاشئة من الإبهام في تشخيص موضوع الرّياء، ورغم أنّ الجَدير بالإنسان التّشديد في مسألة الرّياء، لأنّ نفوذه خفيٌّ جدّاً، وكم حَدَث للإنسان، أن يعمل عملاً ويبقى لفترةٍ طويلةٍ غير ملتفتٍ لأصابته بالرّياء، كالقصّة المعروفة عن أحد المؤمنين السّابقين، حيث نقل عنه، أنّه قضى صلوات جماعته كلّها، التي صلّاها في سنوات من عمره الطويل، ولمّا سألوه عن السّبب قال: إنّي كنت دائماً اصلّي الجماعة في الصّف الأول، وفي يوم من الأيّام تأخّرت بعض الشّيء، فلم أجد مكاناً في الصّف المقدّم، فاضطررت للوقوف خلف الجميع، فشعرت في نفسي بالأذى من ذلك، وتنبّهت لهذه المسألة، فأعدت جميع الصّلوات لأنّها كانت رياء؟!
بالطّبع، الإفراط والتّفريط في هذه المسألة، مَثَلُه كَمَثَلِ بقيّةِ المسائل، غير محمودٍ، وخطأٌ محضٌ، والمفروض التَّنبّه للرياء من خلال تتبع مقدماته وعلاماته، ولا نَدع مجالاً للوساوس في إطار اكتشاف هذه الحالة السّلبية، في دائرة السّلوك الخارجي، والواقع النّفسي، ولعلماء الأخلاق الأفاضل أبحاثٌ لطيفةٌ في هذا المضمار، ومنهم العلّامة المرحوم الفَيض الكاشاني ؛، فقد طرح سؤالاً في كتابه: «المحجّة البيضاء»، وقال: فبأيّ علامةٍ يُعرف العالم والواعِظ، أنّه صادق مخلصٌ في وعظه، غير مريدٍ رئاء النّاس؟.
قال في جواب هذا السؤال: «فاعلم أنّ لذلك علاماتٍ، إحداها أنّه لو ظهر من هو أحسن منه وعظاً وأغزرُ منه علماً، والنّاس له أشدّ قبولاً، فرح به ولم يحسده، نعم لا بأسَ بالغِبطة، وهي: أن يتمنّى لنفسه مثل عمله، والاخرى أنّ الأكابِر إذا حَضروا مجلسه لم يتغيّر كلامه، بل يبقى كما كان عليه، فينظر إلى الخلق بعينٍ واحدةٍ، والاخرى: أن لا يحبّ إتّباع النّاس له في الطريق، والمشي خلفه في الأسواق، ولذلك علاماتٌ كثيرةٌ يطول إحصاؤها» ([22]).
وأفضل المعايير لمعرفة المرائي من غيره، هو ما وردنا عن الأئمّة الأطهار، ومن جملة الأحاديث:
1 ـ في حديثٍ عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، قال: «أَمّا عَلامَةُ المُرائي فَأرْبَعَةٌ: يَحْرُصُ في العَمَلِ للهِ إِذا كانَ عِنْدَهُ أَحَدٌ وَيَكْسَلُ إِذا كانَ وَحْدَهُ وَيَحْرُصُ في كُلِّ أَمْرِهِ عَلَى الَمحمَدَةِ وَيُحْسِنُ سَمْتَهُ بِجُهْدِهِ» ([23]).
2 ـ وَوَرد في نفس هذا المعنى في حديثٍ عن أمير المؤمنين، بألفاظٍ جميلةٍ، فقال: «لِلمُرائي أرْبَعة عَلاماتٍ: يَكْسَلُ إذا كانَ وَحدَهُ، وَيَنْشُطُ إِذا كانَ في النّاسِ، وَيَزِيدُ في العَمَلِ إِذا اثنِيَ عَلَيهِ، وَيَنْقُصُ مِنْهُ إِذا لَمْ يُثْنَ عَلَيهِ» ([24]).
وورد نفس هذا المعنى عن لقمان الحكيم أيضاً ([25]).
وخلاصة القول: إنّ كلّ عملٍ، كان القصد منه المباهاة للناس، فهو دليلٌ على الرّياء، ومهما كان هذا القصد غامضاً وخفيّاً في دائرة الوعي، فهو دليلٌ على ازدواجية شخصيّة الإنسان في التعامل مع نفسه، في الخلأ والملأ.
وهذا الأمر في الحقيقة بالغ في الدقّة والغموض، لدرجةٍ أنّ الإنسان يخدع وجدانه وضميره، بإتيان نفس الأعمال التي يأتي بها في الملأ، وبدرجةٍ عاليةٍ من الجودة والحُسن، في خلوته ليقنع نفسه أنّه لا يُرائي، لأنّه يساوي بأعماله في الظّاهر والباطن، ولكنّ الحقيقة هي ازدواجية ذلك الشّخص، ففي كلا الحالتين يكون مرائياً.
بالطّبع يجب اجتناب الإفراط والتّفريط في هذه المسائل، لأننا وجدنا اناساً امتنعوا من أداء كثيرٍ من الواجبات وحُرموا من الثّواب حذراً أو خوفاً من الرّياء، فلم يؤلّفوا كتاباً، ولم يرشدوا أحداً من النّاس، ولم يصعدوا المنابر، لا لِشيءٍ إلّا لأنّهم كانوا يعيشون الخوف من الوقوع في الرّياء؟!
وقد ورد في الرّوايات، أنّ من يقصد القُربة إلى الله تعالى، إذا أتى بعملٍ ما علانيةً، وعرف به الناس وفرح هو من ذلك، ما دام قصده هو التّقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلن يؤثّر ذلك على عمله ([26]).
ولا يخفى على القارئ الكريم، أنّ القصد من هذا الأمر، هو تشجيع النّاس إلى سلوك طريق الخير والصّلاح، وإمضاء أعمالهم المتقرّب بها إلى الله تعالى، في السّر والعلانية، والمهم هو قصد القُربة وإخلاص النيّة فقط.
وجاءت الآيات والرّوايات، مؤكّدةً لهذا المعنى، وحثّت الإنسان على الإنفاق والتّصدق في السرّ والعلانية، وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنّه يدلّ على إمكانيّة الإتيان بالأعمال علانيةً، وبدوافع إلهيّة بعيداً عن الرّياء.
ويوجد خمسُ آياتٍ شجّعت على الإنفاق سرّاً وعلانيةً، أو سِرّاً وجهراً ([27]).
مضافاً إلى أنّ قسماً كبيراً من العبادات، يؤدّى في العلانية، فإذا ما لم يتسلط الإنسان على نفسه في خط الإلتزام الديني، ويُمسك بزمامها في دائرة النّوازع الذاتيّة، فَسيخسر هو والمجتمع كثيراً من أشكال الثّواب والخير، وستختل أركان بعض العبادات في خطّ الممارسة والعمل.
علاجُ الرِّياء:
يوجد طريقان لِمُعالجة حالة الرّياء، فالرّياء مَثَلُه كَمَثَلِ سائر الأخلاق السلبيّة والسّلوكيّات الذّميمة، ففي بادئ الأمر، علينا التّركيز على معرفةِ العِلَل، وجذور هذه الحالة السّلبية في الواقع النّفسي، لأجل القضاء عليها، ثم التّحرك نحو دراسة عواقبها المؤلمة، والكشف عنها في عمليّة التّصدي لها، وتوخي جانب الحَذر منها.
بالطّبع لقد أشرنا آنفاً، أنّ الرّياء هو: «الشّرك الأفعالي»، والغفلة عن حقيقة التّوحيد، فإذا ما تأصلت حقيقة التّوحيد الأفعالي في قلوبنا، واستحكمت في نفوسنا، واستيقنّا أنّ العزّة لله جميعاً، من موقع المشاهدة الوجدانية، ورأينا أنّ الرّزق والضرّ والنّفع بيده وهو المسخّر للقلوب، فسوف لن نختار سواه بدلاً، ولن نُدنّس أنفسنا وأفعالنا بحالة الرّياء الشّنيعة، التي لا تنسجم مع خطّ التّوحيد في دائرة الأفعال، فالذي يعيش اليقين الرّاسخ بهذه الحقيقة، وهي أنّ مَنْ يكون مع الله تعالى، يكون كلّ شيءٍ معه، وبدونه فهو لا شيء، ويرى بعين البصيرة، مِصداق قوله تعالى: (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ)([28]).
وإذا أدركنا هذه الحقيقة القرآنية التي تقرر أنّ العزّة لله تعالى: (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً)([29]).
أجل إذا ترسّخَ الإيمان بهذه الحقائق الإيمانيّة في أعماق الرّوح، فلا يجد الإنسان في نفسه باعثاً على الرّياء والنّفاق، وكسب الجاه والمقام لدى الناس والمُفاخرة والمُباهاة.
وقال بعض علماء الأخلاق، إنّ دعامة الرّياء وأساسِه هو حبّ الجاه والمُقام، وعند تحليلنا لمفهوم الرّياء، نجد أنّه يتكون من ثلاثة أركانٍ:
«حبّ الثّناء والمدح من الناس»، و «الفرار من مذمّتهم»، و «الطّمع لِما في أيديهم».
ثم يضرب لذلك مثلاً وهو المجاهد في سبيل الله، فتارةً يكون قصدُه المُباهاة والمفاخرة، وإظهار شجاعته وبطولاته للناس، واخرى خوفاً من أن يتّهمه الناس بالجُبن والخوف، وثالثةً يكون دافعه الحصول على الغنائم، والفائز الوحيد، هو الذي يدافع عن الحقّ والدّين لا غير.
هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ اخرى، عند ما يتأمل الإنسان في سلبيات الرّياء وأضراره ونتائجه القاتلة، نرى أنّه كالنّار التي تقع على عبادات الإنسان وطاعاته، فتحوّلها إلى رماد تذروه الرّياح، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل هو ذنبٌ عظيمٌ يسوّد وجه صاحبه في الدّنيا والآخرة ...
الرّياء: حشرة الأرضة التي تَنخر دَعامات بيت سعادة الإنسان، لينهار به في وادٍ سحيقٍ من الشّقاء والظلّام ..
والرّياء بدوره نوعٌ من أنواع الكفر والنّفاق والشّرك ...
والرّياء يسحق الشّخصيّة والحريّة والكرامة، وأشدّ النّاس بؤساً يوم القيامة، المراؤون.
فهذه حقائقٌ تردع الإنسان، وتبعده عن ذلك الأمر الشنيع.
ولا ننسى أنّ المرائي سيفتَضِح، إن عاجلاً أو آجلاً في هذه الدّنيا، وستظهر حقيقته الزّائفة على فلتات لسانه وشَطحات كلماته، وهذا العامل له قسطٌ من التأثير في عمليّة الرّدع النّفسي، لحالة الرّياء في واقع الإنسان، مضافاً إلى أنّ لذّة العمل الصالح، والنيّة الطيّبة التي تطرأ على الإنسان، لا تقاس بشيءٍ، وهو أمرٌ يكفي لإخلاص النيّة.
ويعتقد البعض، أنّ إحدى طرق المعالجة، هي السّعي إلى إخفاء العبادات والحسنات، ولا يُمارسها في العلن، ليتخلّص تدريجيّاً من هذه العقدة المستعصيّة في الذّات المرائيّة.
ولكن هذا لا يعني، عدم الحضور في صلاة الجَماعة والجُمعة والحج، لأنّها تعدّ أيضاً خسارةً كُبرى لا تُعوّض.
هل النّشاط في العبادة يُنافي الإخلاص؟
يُراود هذا السّؤال أذهان الكثيرين، وهو أنّهم يشعرون بنشاطٍ روحي، بعد الإتيان بالعبادة بالمستوى المطلوب، فهل أنّ هذا الشّعور بالنّشاط، يتقاطع مع الإخلاص، أو أنّه علامةٌ على الرياء؟.
والجواب: أنّ النّشاط إذا استمدّ اصوله، من التّوفيق الإلهي والنّور المعنوي المستقى من العبادة، ومعطياتها على روح الإنسان، فلا تَثريب ولا ضير، ولا يُنافي الإخلاص في النيّة، أمّا لو كان النّشاط ينشأ من مشاهدة الناس له، فإنّه يُنافي الإخلاص، رغم أنّه لا يكون سبَباً في بُطلان الأعمال، شريطةَ أن لا يتغيّر مقدار وكيفيّة العمل بسبب مشاهدة الناس له.
وَوَرد هذا المعنى في الرّوايات الإسلاميّة:
منها ما وَرد عن أحد أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام)، أنّه قال: سألتُ الإمام (عليه السلام)، عن الرّجل يعمل الشّيء من الخير، فيراه إنسانٌ فيسّره ذلك.
قال (عليه السلام): «لا بَأْسَ، ما مِنْ أَحَدٍ إِلا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ في النّاسِ الخَيرُ، إذا لَمْ يَكُنْ صَنَعَ ذَلِكَ لذَلِكَ» ([30]).
وفي حديثٍ آخر عن أبي ذر (رحمه الله)، ـ عند ما سأل الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ـ، قال: قلت يا رسول الله: الرّجل يعملُ العمل لنفسه ويحبّه الناس.
قال (صلى الله عليه وآله): «تِلكَ عاجِلُ بُشرى المُؤمِنِ» ([31]).
ما الفرق بين الرّياء والسّمعة:
هذا سؤال يفرض نفسه أيضاً، فهل يوجد فرق بين الرّياء والسّمعة؟، وهل أنّهما يتنافيان مع إخلاص النيّة، ويوجبان بطلان العمل؟.
الجواب: الرّياء: هو فعل الخير أمام مرأى ومسمع من النّاس، لكسب الوجاهة لديهم، وليشار إليه بالبنان من موقع المدح والثّناء.
وأمّا السّمعة، فهي أداء أفعال الخير بعيداً عن أنظار النّاس، ولكن لِيُفهمَهم لاحقاً أنّه هو الذي فعل هذه الامور، ليكتسب بذلك وجاهةً لديهم، والحقيقة أن الدّافع لِكِلا الإثنين غير إلهي، فالأوّل يؤدّي عمل الخير أمام مرأى الناس، والثّاني بصورةٍ غير مُباشرةٍ وعن طريق السّماع، ولا فرق بينهما في دائرة فساد النيّة، وبطلان العمل وفقدان قصد القربة.
ولكن إذا فسّرنا السمعة بأنّها أداء الفعل بقصد القُربّة، ولكن إذا علم النّاس في الآجل ومدحوه وأثنوا عليه، فإنّه يفرح بذلك، فلا شكَّ بأنّ هذه الحالة لا توجب بُطلان العمل.
ويمكن أن يتحرك الإنسان في سلوكيّاته وأعماله، بقصد القُربة المطلقة، ولكنّه يرويها للناس بعد ذلك ليحتل مكانةً بينهم، «وهذا العمل يُسمى بالرّياء اللّاحق»، فهذا السّلوك أيضاً لا يُبطل العمل، لكنّه يُقِّلل من قيمته إلى أدنى حدّ، وخصوصاً من النّاحية الأخلاقيّة.
وقد تحدّث بعض من كبار الفُقهاء، عن كيفيّة نفوذ وتوغّل الرّياء في أعمال الإنسان، وقالوا أنّها على عَشرِ صُوَرٍ:
الصّورة الاولى: أن يكون قصده من الفعل: مشاهدة النّاس له، ولا شكّ ببطلانها.
الصورة الثّانية: أن يكون الهدف فيها الباري تعالى، والرّياء مَعاً، وهذه الحالة أيضاً موجِبةُ: للبطلان والإحباط.
الثّالثة: أن يُرائي في جزءٍ من الأعمال الواجبة، كما لو مارس الرّياء في الرّكوع، أو السّجود وحده في الصّلاة الواجبة، ولا شك في كونه يستوجب البُطلان، حتى لو كان هناك مجالاً للاستدراك، وحاله حالَ ما لو فقد وضوءه وهو في أثناء الصّلاة، وإن كان الأحوط أن يأتي بالجزء الذي وقع فيه الرّياء، ثم إعادة الصّلاة بعد الإنتهاء.
الصّورة الرّابعة: الرّياء في الجزء المستحب، كما في القُنوت، فهو أيضاً من دواعي البُطلان.
الخامسة: أصلُ العمل والقَصد، يكون الله تعالى، ولكنّه يؤدّيه في مكانٍ عام: (كالمسجد)، من دون قصد ربّاني فيه، وهو باطلٌ أيضاً.
السّادسة: أن يُرائي في وقت العمل، فأصل الصّلاة لله تعالى، ولكنّه يُرائي في أدائها في أوّل وقتها، فعمله باطلٌ أيضاً.
السّابعة: أن يُرائي في بعض خُصوصيات وأوصاف العمل، كما لو صلّى الجماعة، وهو في حالةٍ من الخشوع والخضوع المُفتعلة، وهو باطلٌ أيضاً، فالموصوف يتبع الأوصاف في هذه الحالة.
الثّامنة: أن تأتي بالعمل قربةً إلى الله، ولكنّه يرائي في مقدّمات العمل، فيذهب إلى المسجد بقصد الصّلاة والثّواب، ولكنّ حركته نحو المسجد بقصد الرّياء. فالكثير من الفُقهاء لا يرون بُطلان العمل لمثل هذا النوع من الرّياء، لأنّ مقدّمات الرّياء حدثت بعيداً عن العمل، وهو ما تقتضيه القاعدة الفِقهيّة.
التّاسعة: أن يُؤدّي بعض الأوصاف الخارجيّة بنيّة الرّياء، كما لو صلّى للهِ تعالى، ولكنّه يحنّك نفسه رياءً، فبالرغم من قبح هذا العمل، ولكنّه لا يُبطل الصلاة. ([32])
عاشراً وأخيراً: أن يتحرّك في إتيانه بالعمل، من موقع القربة المطلقة لله تعالى، ولكن إذا شاهده الناس، فإنّه يشعر في قرارة نفسه بالفرح، من دون أن يؤثّر ذلك على كيفيّة العمل، فهذا القسم لا يوجب البُطلان أيضاً، لأنّه لا يعدّ من الرّياء.
ونصل هنا إلى نهاية بحثنا حول الرّياء، وإن كنّا قد أعرضنا عن كثيرٍ من الأمور، اجتنابا للتّطويل.
[1] سورة البقرة ، الآية 264.
[2] سورة الكهف ، الآية 110.
[3] سورة النّساء ، الآية 142.
[4] سورة النساء ، الآية 28.
[5] سورة الأنفال ، 47.
[6] سورة الماعون ، الآية 4 إلى 7.
[7] تفسير القُرطبي ، ج 11 ، ص 69.
[8] المصدر السابق.
[9] المصدر السابق.
[10] الدر المنثور ، (طبقاً لتفسير الميزان ، ج 13 ، ص 407).
[11] المحجّة البيضاء ، ج 6 ، ص 141.
[12] المصدر السابق.
[13] المصدر السابق.
[14] المصدر السابق.
[15] المصدر السابق.
[16] اصول الكافي ، ج 2 ، ص 295.
[17] ميزان الحكمة ، ج 2 ، ص 1017 ، الطبعة الجديدة.
[18] اصول الكافي ، ج 2 ، ص 296.
[19] المصدر السابق ، ص 293.
[20] أمالي الصّدوق ، ص 398 ؛ غرر الحكم ، ج 1 ، ص 60 ، الرقم 1614.
[21] غُرر الحِكم ، ج 2 ، ص 749 ، الرقم 209.
[22] المحجّة البيضاء ، ج 6 ، ص 200.
[23] تُحف العقول ، ص 17.
[24] شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ج 2 ، ص 180.
[25] الخصال : (طبقاً لنقل ميزان الحكمة ، ج 2 ، ص 1020) ، الطّبعة الجديدة.
[26] راجع وسائل الشّيعة ، ج 1 ، الباب 15 ، من أبواب مقدمة العبادات ، ص 55.
[27] سورة البقرة ، الآية 274 ؛ الرّعد ، 22 ؛ إبراهيم ، 31 ؛ النّحل ، 75 ؛ فاطر ، 29.
[28] سورة آل عمران ، الآية 160.
[29] سورة النّساء ، الآية 139.
[30] وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 55.
[31] وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 55.
[32] ـ نَسترعي الانتباه : إلى أنّ التّحنيك في الصّلاة لم يثبت استحبابه، وما ورد في الرّوايات فهو يشمل كلّ الحالات والأوقات، وفي وقتنا الحاضر يحتمل أن يكون من لِباس الشّهرة.
 الاكثر قراءة في الكذب و الرياء واللسان
الاكثر قراءة في الكذب و الرياء واللسان
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











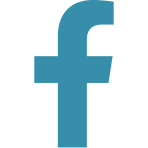

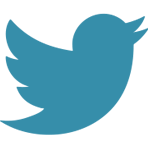

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)