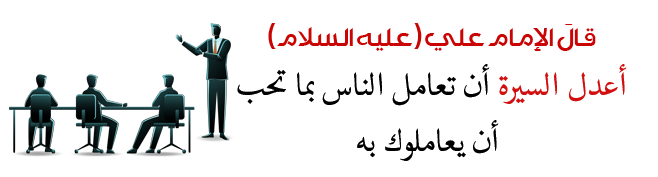
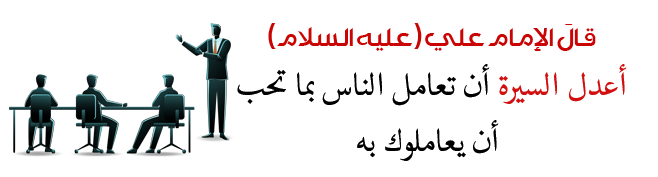

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-10
التاريخ: 19-2-2022
التاريخ: 2024-12-07
التاريخ: 2024-12-10
|
الحسد عبارة عن كراهة النعمة الحاصلة للغير ممّا يظنّ أنها مصلحة له من حيث إنّها كذلك، وبالأوّل يخرج الغبطة كما أنّ بالأخير يخرج الغيرة، وله بواعث كثيرة.
منها: ما يؤول إلى رذالة القوّة الشهوية، كحبّ الجاه والمال وغيرهما من الشهوات الدنيوية، وشدّة الحرص عليها، فيحبّ أن يكون له ما حصل لغيره منها، أو يزول عنه حتّى يتفرّد به.
والخوف (1) من فوت المقاصد كما يتّفق للمتزاحمين على أمر واحد كتحاسد الضرّات في الزوجية، والاخوة في نيل المنزلة عند أبويهم، والتلامذة عند استاذهم، وخواصّ الملك في التقرّب لديه، وعلماء بلدة واحدة في نيل الجاه أو غيره.
أو البخل، فإنّ من الناس من يفرح بابتلاء جميع الناس بأنواع المحن، ويحزن من سعة عيشهم وحسن حالهم بدون باعث ظاهر من عداوة أو توقّع نفع أو وصول مكروه وغيرها، بل يبخل بنعمة الله على عباده من دون غرض، وهذا أخبث الحسّاد وأسوأهم.
ومنها: ما يؤول إلى الغضبية كالعداوة والبغضاء لكون الطباع مجبولة على الفرح من ابتلاء العدوّ والحزن من وصول نعمة إليه.
أو التكبّر حيث إنّ بعض الطباع مجبولة على الترفّع على الناس، وتوقّع الانقياد والتذلّل منهم، فإذا نال أحد منهم نعمة خيف من عدم التحمّل لكبره والترفّع عن خدمته والانقياد له، بل انعكاس الأمر كما يتّفق كثيراً، وكان حسد قريش للنبي صلى الله عليه وآله من هذا القبيل.
أو التعزّز، وهو عدم التحمّل لترفّع الأقران، وتكبّر النظراء عليه مع العلم بأنّهم لو أصابوا بعض النعم تكبّروا عليه واستصغروه.
أو التعجّب، بحيث يرى النعمة أعظم ممّا يستحقّه صاحبها، فيتعجّب عن فوزه بها، ويحبّ زوالها عنه، كما وقع للأمم السالفة مع أنبيائهم.
ومنها: ما يتركّب من القسمين.
لكن الباعث الكلّي في جميع هذه الأقسام هو الجهل، إذ العالم باستحالة اقتناء شخص واحد لجميع فوائد الدنيا لا يطلبه، والعالم بأنّ كلّ ما يحدث في العالم صادر عن الحكمة الأزليّة والارادة الذاتية التي يستحيل تخلّفه عنها والا لزم النقص أو الجهل عليه تعالى، لا يميل إلى خلافه. والعالم بأنّ زوال النعم الالهية مضافاً إلى كونه نقصاً وفقداً لكمال الافاضة في المحلّ اللائق بها شرّ لكونه عدماً، وقد تحقّق في محلّه أنّ الاعدام شرور كما أنّ الموجودات خيرات يميل إلى الشرّ ويطمع حصوله من الخير المحض؟ والعالم بأنّ حصول المقاصد وفواتها ممّا يتعلّق بمشيئته تعالى بحيث إنّه القادر على ما يشاء الفاعل لما يريد، ولا مدخل لوصول النعمة إلى الغير وعدمه فيهما كيف يطلب زوالها منه أو عدم حصولها له؟ وكذا العالم بأنّه تعالى أعلم باستعداد الأشخاص للنعم وقابليّتهم ولولاه لما أثر بعضهم ببعضها دون بعض، وفي حال دون حال مع كونه حكيماً كيف يستحقر غيره ويتعجّب عمّا أفيض عليه من النعم؟
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الباعث على الحسد مركّب من رذائل القوّة العاقلة إحدى القوّتين الأخريين (2) أو الثلاثة بأسرها، وهو من أشدّ الأمراض وأصعبها، وقد الله تعالى في مقام الانكار: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 54] وقال صلى الله عليه وآله: «قال الله تعالى لموسى بن عمران: لا تحسدنّ الناس على ما آتيتهم من فضلي ولا تمدّنّ عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك، فإنّ الحاسد ساخط لنعمي، صادّ لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس منّي» (3).
وقال صلى الله عليه وآله: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» (4).
وقال الصادق عليهالسلام: «الحاسد مضرّ بنفسه قبل أن يضرّ بالمحسود، كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة ولآدم الاجتباء والهدى والرفع إلى محلّ حقائق العهد والاصطفاء، فكن محسوداً ولا تكن حاسداً، فإنّ ميزان الحاسد أبداً خفيف يثقل ميزان المحسود، والرزق مقسوم، فما ينفع الحسد الحاسد وما يضرّ المحسود الحسد، والحسد من عمى القلب وجحود فضل الله، وهما جناحان للكفر، وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد، وهلك مهلكاً لا ينجو منه أبداً، ولا توبة للحاسد؛ لأنّه مصرّ عليه، معتقد به، مطبوع فيه يبدو بلا معارض ولا سبب، والطبع لا يتغيّر عن الأصل، وإن عولج» (5).
وقد تبيّن من هذه الأخبار وممّا ذكرناه:
أوّلاً: أنَّ الحسد يضرّ في دين الحاسد لما يتفرّع عليه من المعاصي كالغدر والعداوة للمؤمن وترك النصح والتعظيم والمراعاة له وغير ذلك، ولكونه ساخطاً معانداً لله في قضائه طالباً للشرّ والنقص له ولعباده. وفي دنياه أيضاً لعدم انقطاع فيوضه تعالى بتمنّاه (6) فيتعذّب دائماً بأشدّ الحسرة والألم مؤثرا لنفسه ما يريده لأعدائه من الحزن والغمّ والتعرّض للافتضاح ديناً ودنيا من دون فائدة ينالها. ولا يضرّ بدين المحسود ودنياه، إذ لا ينقطع عنه ما قدّر له من أياديه تعالى، ولا ينفع تدبيراته في دفعها، كما تشهد التجربة به، ولو زالت النعم بالحسد لم يتنعّم من الخلق أحد، إذ لا أحد الا وله حاسد يحسد، ولضرّه وشرّه يقصد، بل ينفع دينه بتخفيف أوزاره ومعاصيه، وتثقيل حسناته بما يفعله الحاسد به من الغشّ والاهانة والبهتان والغيبة، فيزيد بحسده نقمة أخرويّة إلى دنيوية، كما يزداد الحاسد بحسده نعمة أخروية إلى دنيوية، ودنياه أيضاً حيث إن أهمّ الأغراض الدنيوية مساءة الأعداء وابتلاؤهم بأنواع الهمّ والغمّ والبلاء، وأيّ البلاء أعظم ممّا نال حاسده من الغموم والهموم وتجدّدها بتجدّد نعمة عليه من نعم الله تعالى، بل ربما صار الحسد باعثاً لاشتهار المحسود وانتشار فضله، كما قيل:
وإذا أراد الله نشر فضيلة *** طويت أتاح لها لسان حسوده
فيكون الحاسد عدوّاً لنفسه صديقاً لعدوّه، ولذا قيل: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد، إنّه يرى النعمة عليك نقمة عليه.
واعلم أنّ الحسد إنما يتصوّر في الماديات غير القابلة للاشتراك والعموم، بحيث لو حظي بها واحد حرم الآخر عنها، فحاطبها لا يريد ضرّه بالذات، وإنّما يلزمه بواسطة اختلاف المقاصد، فأمّا الفضائل النفسيّة والمعارف الحقّة والمطالب العلميّة واللذّات الأخرويّة، فهي لكونها عن المادة مبرّاة وعن سمة النقص والزوال معرّاة تزيد بكثرة الإفاضة، وتعمّ نفعها، فلا يتصوّر فيها الحسد إلا إذا استخدمت للدّنيا وجعلت من وسائلها كما في علمائها، فيكون التحاسد بينهم فيما جعلوه غاية لها لا فيها نفسها، إذ لا يتصوّر التحاسد الا مع التوارد على المقاصد التي لا تفي بطلّابها وقاصديها وتضيق كالسجن على وارديها، والعلم لا يتناهى ولا يبيد، فلا يقصر عنها، بل يزيد، وأمّا اللذّات الأخرويّة فلا تضيق بالكثرة وتقول هل من مزيد، فلا حسد بين طلّاب الآخرة أصلاً. {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47]
ثم إنّ مساواة أحوال العدوّ لدى عدوّه ليست اختياريّة لأغلب النفوس، فالتكليف به لعامة الناس ممّا لا يليق بالحكيم والقدر المكلّف به عموماً ما يظهر أثره في الجوارح، ويبعث على المعاصي الظاهرة كالغيبة والبهتان والغشّ والإهانة وغيرها، فإنّ التكاليف الظاهرة الشرعيّة العامّة للمكلّفين لا يتعلّق الا بأعمال الجوارح كما أشرنا إليه سابقاً.
ويدلّ عليه في خصوص المقام النبويّ المشهور: «رفع عن أمّتي ـ إلى قوله: ـ والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد» (7).
وفي الخبر النبوي أيضاً: «ثلاث لا ينفكّ المؤمن عنهنّ: الحسد والظنّ والطيرة.. وله منهنّ مخرج، إذا حسدت فلا تبغِ ـ أي لا تعمل به ـ، وإذا ظننتَ فلا تحقّق، وإذا تطيّرت فامضِ» (8).
وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضاً: «ثلاثة في المؤمن له منهنّ مخرج ومخرجه من الحسد ألّا يبغي» (9).
والأخبار الدالّة على الذمّ والنهي كسائر ما دلّ على ذمّ صفات القلب والنهي عنها إمّا من قبيل ذكر الأسباب وإرادة المسبّبات كما هو الشائع في المحاورات، أو من قبيل التأكيدات الواردة في المستحبّات والغليظات الشديدة حثّاً للنفوس الناقصة عليها.
وقد خبط في المقام بعض الأعلام (10) وأصرّ في القول بالحرمة مطلقاً، وحمل ما ذكرناه من الأخبار على ما يكون فيه ارتياح للنفس بزوال النعمة طبعاً مع كراهته له من جهة العقل والدين حتّى يكون تلك الكراهة في مقابلة الحبّ الطبيعي بناء على أنّ الأخبار الناهية عن الحسد تدلّ على كون الحاسد آثماً، والحسد عبارة عن صفة القلب دون الأفعال الظاهرة.
وفيه مضافاً إلى ما عرفت سابقاً أنّ ترك الأعمال الظاهرة مع التمكّن منها يستلزم الكراهة من جهة العقل والدين، إذ مع فقد المانع ووجود الباعث المقتضي يتمّ علّة الوجود، فلا يتصوّر تخلّف المعلول عنها.
وأمّا مع عدم التمكّن مع الشوق إلى الأعمال الظاهرة والهمّ بها فقد عرفت أنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ من همّ بسيّئة ولم يعملها لم يكتب عليه، والاجماع المدّعى في كلام جماعة أنّه معفو عنه مضافاً إلى هذه الأخبار فإنّها مقيّدة وتلك مطلقة، فلا بدّ من حملها عليها، على أنّ من اتّصف بالإيمان بل اتّسم بالإسلام وعلم أنّ الحسد مبغوض لله تعالى ومذموم بحسب الشريعة سيّما إذا تبيّن له ذلك بحسب العقل أيضاً كيف لا يكرهه ولا يمقته بقلبه، بل من يظهر آثاره في جوارحه أيضاً يمقته ويكرهه شرعاً كسائر المعاصي والآثام لوجود القوّة العقلية الكارهة لها والمانعة له عن ارتكابها فيه، غاية ما هناك صيرورتها مغلوبة من الشهوية والغضبية والجنود الطبيعية والشيطانية، وهو واضح، ولمّا كانت أعمال الجوارح كلّها ناشئة عن أعمال القلب ومتسبّبه منها ورد كمل التأكيد في قلعها وقمعها كي لا يبتلى برسوخ تلك الأسباب فيه بمسبّباتها، فمن جاهد نفسه مع اتّصافها برذيلة تقودها إلى الآثار السيّئة بمنعها وحفظها عن تلك الآثار كان مجاهداً بالجهاد الأكبر الذي يوازي نزع الروح بل أشدّ وأصعب، فكيف يعدّ عاصياً مع أنّه السالك حينئذ إلى المقصد والمشتغل بعلم السلوك الصعب الذي نحث عليه من أوّل الكتاب إلى تاليه. والاقامة (كذا) بعد ما عوّد نفسه على ترك مقتضياتها وآثارها يلزمه زوال تلك الملكة تدريجاً، ويسهل عليه ذلك إلى أن تنعدم بالمرّة.
وممّا ذكر يظهر أنّ علاج هذا المرض لا يمكن الا بإزاحة علله من الرذائل الباعثة عليه، فيبدّل الحرص والطمع بالقناعة، والتكبّر بالتواضع، والدناءة بعلوّ الهمّة، والجهل بالمعرفة، والحقد بالمحبّة، ثم المواظبة على الامتناع من آثاره، والاتيان بأضدادها قولاً وفعلاً على سبيل العنف والقهر والمجاهدة للنفس حتى تعتاد، ولو حصّل فضيلة التوحيد وشاهد الارتباط الخاص الذي بينه تعالى وبين خلقه وعلم أنه من أقوى الروابط وأضبطها لم يلاحظ الموجودات الا من حيث الانتساب إليه تعالى بارتضاعها من لبان الوجود بثدي واحدة وشرب ماء الفيض والجود من شريعة واحدة، فلا ينظر إليهم بعين السخط والعدوان وإن أصيب منهم بأنواع البليّة، بل لم يلحظهم الا بعين المودّة والرحمة، كما هو شأن كمّل العارفين المستغرقين في حبّ الله وأنسه، والمحظوظين بنعمة معرفته.
تذنيب: قد أشرنا إلى أنّ الغبطة تمنّي مثل ما للمغبوط من غير إرادة زواله عنه، ويسمّى منافسة أيضاً، وإطلاق الحسد عليه في بعض الأخبار اتّساع لمقاربتهما، وهي في الأمور الدينية والفضائل النفسية ممدوحة، إذ سببها حبّ الله وحبّ طاعته، وأمّا في الأمور الدنيوية غير المحرّمة فهي وإن لم تكن محرّمة الا أنّها لابتنائها على حبّ الدنيا والتنعّم بها مذموم ينقص بها درجته ويحجب بسببها عن المقامات المحمودة كالرضا والتوكّل والقناعة والزهد.
قال بعض الأعلام: لو كانت الغبطة مقصورة على مجرّد حبّ الوصول إلى مثل ما للمغبوط من دون حبّ المساواة له وكراهة النقصان عنه لم يكن فيه حرج، وإن كان معهما فهناك موضع خطر، إذ زوال النقصان إما بالوصول إلى نعمة المغبوط أو زوالها عنه، فإذا انسدّ أحدهما مالت النفس إلى الآخر، إذ لا يبعد أن يكون المريد للمساواة، العاجز عنها منفكّاً عن الميل إلى زوالها عنه حتّى يزول نقصانه عنه به، فإن كان بحيث لو فوّض الأمر إليه سعى فيه كان حسداً مذموماً وإن منعه العقل عنه لكن يجد من طبعه الفرح والسرور بزوالها عنه كان أيضاً حسداً مذموماً الا أن يكون مبغضاً لنفسه على تلك الحالة مجاهداً لها في دفعها، فيكون معفوّاً عنه ـ انتهى ملخّصاً (11) فتأمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كذا والظاهر «أو الخوف».
(2) في «ج»: مركب من رذائل القوّة والعاقلة في إحدى القوتين الآخرتين أو الثلاثة بأسرها.
(3) الكافي: 2 / 307، كتاب الإيمان والكفر، باب الحسد، ح 6.
(4) المحجة البيضاء: 5 / 325، وفي الكافي: 2 / 306 عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: «إنّ الحسد يأكل الإيمان...» الحسنات، وفي ب: الإيمان وفي ج الإيمان الحسنات واستظهر الكاتب عطف الثاني على الأوّل.
(5) المحجة البيضاء: 5 / 328 نقلاً عن مصباح الشريعة الباب 51، في الحسد.
(6) كذا، والصحيح: بتمنّيه.
(7) راجع الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(8) جامع السعادات: 2 / 199.
(9) المحجة البيضاء: 5 / 349.
(10) هو المولى مهدي النراقي صاحب جامع السعادات فراجع: 2 / 211، وكذا أبو حامد كما في المحجة البيضاء (5 / 348 ـ 349).
(11) جامع السعادات: 2 / 197 ـ 198.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|