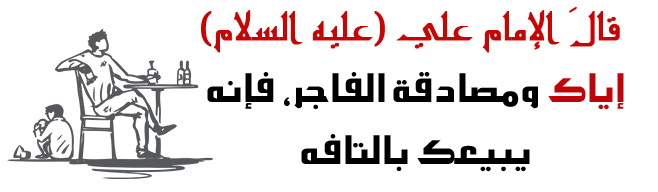
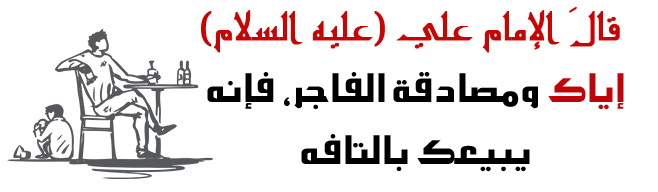

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-08-2015
التاريخ: 5-08-2015
التاريخ: 9-3-2019
التاريخ: 25-10-2014
|
ينبغي أن نبيّن أوّلا حقيقة الكلام والمتكلم، ثمّ نشير إلى الطريق الذي به يعلم كونه تعالى متكلما وكلامه، ثمّ نبيّن صفة كلامه واختلاف القول فيه، فنقول:
أمّا الكلام، فهو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف التي يمكن تهجّيها إذا وقع ممّن يصحّ منه أو من قبيله الإفادة ذكرنا الحروف التي يصحّ تهجيها تحرّزا من صرير الباب وخرير الماء وغيرهما وذكرنا انتظامه من حرفين، لأنّ الحرف الواحد لا يكون كلاما. ولا يعترضه قولهم: «ق» و«ع»، من وقى يقي، ووعى يعي. لأنّ الأصل في ذلك: «اوق» و«اوع»، وإنما صار كذلك لضرب من التصريف. فالحروف الساقطة هي في نية الثبات، وقد قيل: إنّ قوله: «ق» المنطوق به هو حرفان، إذ فيه هاء مختلسة من حيث لا يمكن التكلّم بحرف واحد، ولا بدّ من متحرّك يبتدأ به وساكن يوقف عليه.
وقلنا فصاعدا، تحرّزا من الكلمات الثلاثيّة والرباعيّة والخماسيّة، وقلنا:
إذا وقع ممّن يصحّ منه أو من قبيله الإفادة تحرّزا ممّا يقع من بعض الطيور كالطوطي، فانّ ذلك لا يسمّى كلاما على الحقيقة إذا لا يصحّ الإفادة، وقلنا:
أو من قبيله، تحرّزا ممّا يقع من الطفل فانّه يسمّى كلاما حقيقة، وإن لم يصحّ منه الإفادة من حيث أنّه من قبيل من يصحّ منه الإفادة والذي يبيّن أن الكلام هو ما جمع هذه الأوصاف ما قد علمنا من حال أهل اللغة أنّهم يسمّون ما حصلت فيه هذه الأوصاف كلاما وما لم يجمع هذه الأوصاف لا يسمونه كلاما.
وأمّا المتكلّم، فهو من وقع منه الكلام الذي وصفناه بحسب قصده وداعيه وبيانه بالرجوع إلى أهل اللسان أيضا، فانّهم إنما يسمّون الإنسان متكلّما إذا وقع منه الكلام بحسب قصده وداعيه محققا أو مقدّرا، وإذا لم يقع منه ذلك لا يسمّونه متكلّما إلّا على وجه التغليب دون الإفادة.
يبيّنه أنّهم لما اعتقدوا في بعض ما يسمّونه من المصروع انّه واقع بحسب قصد الجنّي وداعيه، أضافوه إلى الجنّي وقالوا: تكلّم الجنّيّ على لسانه. فدلّ ذلك على أنّ المتكلّم عندهم من وصفناه.
وأمّا الطريق إلى إثبات كلامه تعالى وكونه متكلّما، فهو السمع وما نعلمه ضرورة من دين الرسول، عليه السّلام وقوله: إنّ اللّه تعالى أنزل القرآن عليّ، وأنّه كلامه ووحيه إليّ، والإجماع منعقد على ذلك أيضا. هذا هو الطريق إلى معرفة كلام اللّه تعالى، فأمّا العقل فلا دلالة فيه على ثبوت كلامه تعالى وأنّه متكلّم، إنّما دلّ العقل على أنّه قادر على الكلام فحسب.
فإن قيل: فكيف تستدلّون بقول النبيّ عليه السلام، وما نعلم من دينه ضرورة على ثبوت كلامه تعالى، وأنتم إنّما تعلمون نبوّته وصحّة قوله بالقرآن الذي هو كلامه تعالى. فهل هذا إلّا استدلال بكلّ واحد من الأمرين على الآخر، إذ لا تعلمون نبوّته إلّا بالقرآن- الذي هو كلام اللّه تعالى- الّا بقوله، فيصير دورا. وكذا إن استدللتم بالإجماع، لأنّ المجمعين إنما يعلمون كون القرآن كلام اللّه تعالى بقول النبيّ، فيكون حكمهم كحكمه. ومن وجه آخر وهو أنّ صحة الإجماع إنّما تعلم إما بالقرآن أو بالخبر، وصحّتهما مبنيّة على العلم بنبوّته عليه السلام التي إنما تعلم بالقرآن ...
قلنا: أوّل ما نقوله أنه يمكننا معرفة نبوّته وصحّة قوله عليه السلام من دون القرآن بل بمعجزاته الأخر، كحنين الجذع وتسبيح الحصى وكلام الذراع المسموم، الى ما لا يحصى كثرة، فلا يتجه عليه الدور الذي ألزمه السائل، ثمّ وإن استدللنا بالقرآن على نبوّته عليه السلام لزمه، فانّ الإلزام مندفع أيضا. وذلك لأنّه يمكننا أن نعلم نبوّته بالقرآن قبل أن نعلم أنه كلام اللّه تعالى تعيينا.
فإن قيل: وكيف يمكنكم ذلك؟
قلنا: بأن نقول: إذا علمنا عجز العرب عن معارضة القرآن عند تحدّيه صلى اللّه عليه وآله إيّاهم فلا بدّ من أن يكون عجزهم: إمّا من جهة الصرفة التي هي سلب اللّه تعالى إيّاهم العلوم التي كانوا بها متمكّنين من الإتيان بمثل القرآن في الفصاحة، وذلك خارق عادة ظهر عليه من جهته تعالى، إذ لا يقدر على الصرفة التي فسّرناها غير اللّه تعالى، سواء كان القرآن من فعل اللّه أو من فعل الرسول، عليه السلام، تقديرا، وإمّا من جهة فرط فصاحة القرآن إمّا بأن يكون القرآن، نفسه من فعل اللّه تعالى، فيكون هو الخارق للعادة بعينه، أو يكون من فعل الرسول عليه السلام تقديرا، فنقول: والرسول لا يتمكّن من الإتيان قبل فصاحة القرآن إلّا بعلوم زائدة خصّه اللّه تعالى بها، فيكون خلق تلك العلوم فيه خارقا للعادة.
ولا قسم وراء ذلك. فمع تردّدنا وتميّلنا بين هذه الوجوه نقطع على أنّه ظهر عليه، صلى اللّه عليه وآله خارق عادة من جهته تعالى، إمّا الصرفة، وإمّا نفس القرآن، وإمّا اختصاص الرسول بالعلوم الزائدة. فنعلم بذلك نبوته عليه السلام وصحّة قوله ثمّ إذا قال: القرآن كلام اللّه تعالى، نقطع على ذلك، فاندفع الإشكال. وأمّا ما ذكره السائل من أنّ الإجماع إنّما يعلم إمّا بالقرآن أو بالخبر، فليس كذلك عندنا، لأنّا إنّما نعلم صحّة الإجماع بدليل العقل، وهو أنّ الزمان لا يخلو من معصوم إذا علمنا ذلك نعلم أنّ ما أجمع عليه جمع أهل العصر يكون حجة.
فإن قيل: فكأنكم بهذا القول نقضتم ما قلتم: إنّا إنّما نعلم كونه تعالى متكلّما وكلامه بالسمع: وذلك لأنّكم إذا علمتم ذلك بالإجماع على ما ذكرتم وعلمتم صحّة الإجماع بالعقل على ما تدّعون، كان ذلك نقضا لقولكم: إنّا نعلم كلامه تعالى بالسمع.
قلنا: لا تناقض في قولنا. وذلك لأنّا وإن علمنا صحّة الإجماع من دون الاستدلال بالآية والخبر، فانّما نعلم إجماع الأمّة على أنّ القرآن كلام اللّه تعالى، وأنّه متكلّم وله كلام بأن نسمع منهم ذلك القول، أو بأن ينقل إلينا ذلك منهم. وإذا كان كذلك، كنّا قد علمنا ذلك بالسمع الذي حصل من جهتهم.
وشيء آخر: وهو أنّ المجمعين ومن قوله حجة فيما بينهم إنما يعلمون ذلك بقول السئول فسلم قولنا من التناقض.
فإن قيل: والرسول صلى اللّه عليه وآله بماذا يعلم أنّ القرآن كلام اللّه تعالى؟
إن قلتم بقول جبرئيل مع معجزة تظهر عليه، قلنا: فجبرئيل بما ذا علم؟ وكذا إن اسندتم إلى ملك آخر.
قلنا: إنّما يعلم أوّل من يسمع كلام اللّه تعالى بأن يسمع كلاما يتضمّن أنّه كلام اللّه تعالى ويقترن إليه معجزة دالة على صدقه. وذلك كما أسمع تعالى موسى كلامه من الشجرة مع اقتران قلب العصا حيّة إليه. وبيان ذلك في قوله تعالى: {نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ} [القصص: 30، 31] ، إلى آخر الآية.
إذا ثبت أن الطريق إلى معرفة كلام اللّه تعالى هو السمع، فالسمع الدال عليه هو ما ذكرناه من قول الرسول عليه السلام وما هو معلوم من دينه ضرورة واتّفاق المسلمين عليه.
وإذا تقرّر هذا، فكلام اللّه تعالى إنما هو من جنس الأصوات والحروف.
وذلك لأنّ اللّه تعالى خاطب العرب بلغتهم، وكذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إنما كان يخاطبهم بلغتهم وقد كان منهم. فيجب حمل الكلام الوارد في خطاب اللّه تعالى في مثله قوله: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ } [التوبة: 6] ، {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا } [النساء: 164] وفي خطاب الرسول عليه السلام على ما تعرفه العرب في معنى هذه اللفظة، وقد بيّنا أنّهم يعنون بالكلام ما انتظم من حرفين فصاعدا، على ما ذكرناه ولا يعرفون غيره.
فإن قيل: كيف يقولون ذلك؟ وقد يقول أحدهم: «في نفسي كلام».
قال الشاعر:
إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
قلنا: هذا مجاز واستعارة، وإنّما المراد به أنّ في النفس والفؤاد العزم على الكلام أو العلم بكيفيّة نظم الكلام أو الفكر فيها وبيانه: أن كما يقال: «في نفسي كلام»، كذلك يقال: «في نفسي بناء واد»، و« في نفسي السفر إلى مكة» ولا يدلّ هذا على أنّ البناء أو السفر يكون في النفس، وإنّما المراد ما ذكرناه من العزم على السفر أو البناء.
إذا ثبت أن كلام اللّه تعالى من جنس الحروف والأصوات لم يبق شكّ في حدوثه، وأنّه تعالى فاعله ومحدثه، أحدثه بحسب مصالح العباد التي يعلمها.
فمن جملة ما تكلّم به: التوراة والإنجيل والقرآن.
وإنّما قلنا: «لا شكّ في حدوث الكلام المنظوم من الأصوات والحروف»، لأنّ الأصوات مدركة، فنعلم وجودها إذا كانت موجودة وعدمها إذا كانت معدومة ضرورة، فنسمع كلاما بعد أن لم نسمعه، ثمّ ينقضي سماعنا له. مع ما قد تحقق أن الإدراك ليس بمعنى، فيعلم أنّها ما كانت فكانت ثمّ انعدمت، فكيف يشكّ في حدوث ما هذا سبيله؟
وبعد، فانّ الكلام إنّما يكون كلاما بأن يترتّب البعض منه على البعض مثلا، كقولنا: «الحمد»، لأنّه إنما صار كذلك بتقدّم الهمزة على اللام، واللام على الحاء، والحاء على الميم، والميم على الدالّ.
و لو لا هذا الترتّب لم يكن بأن يكون الحمد أولى من أن يكون الدمح أو المدح، أو غيرهما من التركيب.
وإذا كان كذلك فما يقع مرتّبا من الحروف بأن يكون البعض منه في أثر غيره والغير متقدّم عليه، كيف يكون قديما، والحرف الأوّل الذي يكون متقدّما على باقي الحروف في الكلمة كيف يكون قديما، وقد تعقّبه المحدث وما سبقه إلّا بأقلّ قليل الأوقات وقد قال اللّه تعالى: {وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى} [هود: 17] ، يعنى به القرآن.
وما كان قبله شيء لا يكون قديما. وقال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا } [الزخرف: 3] ، والمجعول لا يكون قديما وأضافه الى العربية وهي محدثة. وقد صرّح بحدوثه في قوله تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ} [الأنبياء: 2] ولا يجوز حمل الذكر على غير الكلام، بدلالة قوله: «إِلَّا اسْتَمَعُوهُ» وكلّ هذا تنبيهات، وإلّا فالأمر في حدوث الأصوات والحروف اظهر من أن يخفى ويحتاج إلى إطناب.
ووافقنا في حدوث الأصوات والحروف والكلام المركّب منها الكلابيّة والأشعريّة وسائر الفرق. فانّ الكلابيّة والأشعريّة إنّما يخالفون في إثبات كلام ليس من جنس الحروف والأصوات للّه تعالى، ويدّعون قدمه...
أمّا الكلام المركّب من الحروف والأصوات فلا خلاف من جهتهم في حدوثه، وإنّما المخالف في حدوث الكلام المركّب من الأصوات والحروف الحنابلة وإذا أحسنّا الظنّ بهم قلنا: إنّهم لا يحققون معنى القدم. وكأنّهم يعنون بالقديم ما تقادم وجوده على ما تعرفه العرب، فيعتقدون تقادم وجود القرآن، على ما ورد في الأخبار، من انّه: «كان اللّه ولم يكن معه شيء ثمّ خلق الذّكر» (1) أي: أوّل ما خلق اللّه تعالى الكلام.
واعلم أنّا انّما نكلّم في حدوث القرآن هؤلاء الحنابلة، فنبيّن لهم أنه ليس بقديم وإن كان نزاعهم في ذلك عنادا فامّا الصفاتيّة فانّا لا نكلّمهم في قدم كلامه تعالى، وذلك لأنّهم يسلّمون حدوث الكلام الذي وصفناه، وإنّما يدّعون أنّه تبارك وتعالى متكلّم بكلام قائم بذاته ليس هو من جنس الأصوات والحروف. ولو ثبت له ذلك، فانّا لا ننازعهم في قدمه، لأنه لا احد من الأمّة يثبت ذلك المعنى ويذهب إلى أنّه محدث، بل كلّ من أثبته أثبته قديما وإنّما نكلّمهم في إثباته، ونبيّن لهم أنّه غير معلوم، لا ضرورة ولا استدلالا.
وقد تمسّك مثبتوا قدم القرآن بوجوه:
منها: أن قالوا: إنّ اللّه تعالى أخبر عن أنّه إنّما يكون الأشياء بقوله «كن» في قوله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40] فلو كان «كن» محدثا لكان من فعله على ما تقولونه، فيكون مكونا فيجب أن يكونه ب «كن» آخر مثله. والكلام في الثاني كالكلام في الأوّل وذلك يؤدّي إلى التسلسل، وهو محال. فلم يبق إلّا أن يكون كلمة «كن» قديمة وإذا ثبت قدمها ثبت قدم القرآن بأسره، إذ لم يفرّق أحد من الأمّة بين بعض القرآن وبين بعضه في قدم أو حدوث.
والجواب عن ذلك أن نقول: إنّ ما ذكره اللّه تعالى ليس إخبارا عمّا ظننتموه، من أنّه يفعل الأشياء بكلمة «كن»، وإنما هو خبر عن أنّه إذا أراد شيئا كوّنه وفعله بسرعة من دون أن يحتاج فيه إلى مهلة وزمان، مثل ما يقوله الواحد منّا لمن استبطأ فعله الذي أمره به: «لست ممّن يقول للشيء كن فيكون».
يبيّن ما ذكرناه أنّ ذلك لو كان خبرا عما ذكروه لكان ذلك خطابا للمعدوم وأمرا له بأن يكوّن نفسه، أ فيليق بالحكيم أن يخاطب المعدوم ويأمره بان يكوّن نفسه؟ [و] هل يقدر المعدوم على تكوين نفسه؟
ثم نقول لهم: كلمة «كن» مركبة من الكاف والنون، والكاف مقدّم على النون، فكيف يتصوّر في النون تقدّمه الكاف أن يكون قديما؟ وكيف يمكن أن يكون الكاف قديما؟ وقد تعقبه النون المحدث، وما تقدّمه إلّا بأقلّ قليل الأوقات، مع وجوب تقدّم القديم على المحدث بما لو قدّر أوقاتا لكانت بلا نهاية وبعد، فانّ في الآية ما يدلّ على حدوث «كن»، وذلك لأنّه تعالى قال: «إذا أردناه»، و«إذا» يفيد الاستقبال. فدلّ ذلك على أن قول «كن» يوجد منه تعالى في المستقبل، فلا يكون قديما.
تمسّكوا أيضا بأن قالوا في القرآن أسماء اللّه، مثل اللّه، الرّحمن، الرّحيم، إلى غيرها، والاسم هو المسمّى فلو كان القرآن محدثا، لكان أسماء اللّه محدثة، فليزم حدوث ذاته تعالى.
والجواب عن ذلك أن نقول: هذا بناء على أصل فاسد غير مسلّم، وهو أنّ الاسم هو المسمّى، فلم قلتم ذلك؟ وما دلالتكم عليه؟ وكيف يمكن ادّعاء القول بأنّ الاسم هو المسمّى؟ مع علمنا بأنّ الاسم هو القول الدالّ بالوضع الثاني على القول الذي يدلّ على معنى غير مقرون بزمانه مضيّا او استقبالا او حالا؟ والقول الذي وصفناه إنّما يحلّ اللسان، ومسمّاه ربما كان جبلا او سماء او أرضا، فكيف يكون هو هو؟ أ فليس يلزم على هذا أن يكون ذلك المسمى، جبلا كان او غيره، في لسان القائل المتكلّم بالاسم ومخارج حروفه؟ وكذلك أفلا يلزم فيمن ذكر اسم العسل أن يجد حلاوة العسل؟ إذ حسّ الذوق ومحلّ القول متقارب، بل ربما كانوا متحدا، وكذا في من ذكر النار كان يلزم أن يحرق لسانه وفمه.
ثمّ يقال لهم، بعد التجاوز عن هذه المطالبات والإلزامات: أو ليس في القرآن أسماء غير اللّه تعالى من أنبيائه وأوليائه وأعدائه، كما أنّ فيه أسماء اللّه تعالى. فلو دلّ كون أسماء اللّه تعالى في القرآن على أنّه قديم، فليدلّ كون أسماء غير اللّه تعالى فيه على أنّه محدث، فيلزم أن يكون القرآن قديما محدثا، وذلك معلوم بطلانه بالضرورة.
تمسّكوا أيضا بأن قالوا: لو لم يكن كلام اللّه قديما، لم يكن اللّه تعالى متكلّما لم يزل والحيّ إذا لم يكن متكلما كان إما أخرس أو ساكتا، والخرس والسكوت مستحيلان عليه تعالى، لكونهما صفتي نقص، فيجب أن يكون متكلّما لم يزل، وفي ذلك قدم كلامه.
والجواب عنه أن نقول: التقسيم الذي أورد تموه في الحيّ مطلقا غير مسلّم ولا حاضر. وهو باطل بالصائح والصارخ فانّهما ليسا متكلّمين ولا أخرسين ولا ساكتين.
إن قالوا: نزيد في التقسيم، بأن نقول: الحيّ إذا لم يكن أخرس ولا ساكتا ولا صارخا ولا صائحا، كان متكلّما والصياح والصراخ لا يجوزان عليه تعالى، كما لا يجوز عليه الخرس والسكوت، فيجب أن يكون متكلّما.
قلنا: التقسيم غير حاضر مع هذه الزيادة أيضا. وذلك لأنّ الدليل قد دلّ على تقديم القدرة على الفعل. فمن ابتدأت القدرة فيه في تلك الحالة ليس هو صائحا ولا صارخا ولا ساكتا ولا أخرس ولا متكلّما، بل هو خال من جميع هذه الأقسام.
فإن قالوا: فيمكن تشبيه حاله تبارك وتعالى بحال من ابتدأت القدرة فيه مع كونه قادرا لم يزل بالاتفاق، ومع أنّه لا تعلّق لكلامه بقدرته عندنا إلّا من حيث إنّهما وصفان له.
قلنا: مقصودنا ممّا أوردناه أن نبيّن لكم أن تقسيمكم غير حاصر، وأنّه يجب عليكم أن تراعوا شيئا آخر. وهو أن تقولوا: الحيّ إذا صحّ أن يتكلّم ولم يكن أخرس ولا ساكتا ولا صائحا ولا صارخا، وجب أن يكون متكلّما ومهما اعتبرتم صحّة كون الحيّ متكلّما ننازعكم في صحّة كونه تعالى متكلّما لم يزل، ونقول لكم: بيّنوا أنّه صحّ أن يتكلّم لم يزل، فانّ ذلك عندنا يستحيل، كما يستحيل أن يحسن أو ينعم لم يزل.
ثمّ نقول لهم: هذه التقسيمات إنّما ترد على الحيّ الذي يتكلّم بآلة وذلك أنّ الخرس إنما هو آفة آلة الكلام التي يتعذّر الكلام معها، والسكوت إنّما هو الكفّ عن استعمال آلة الكلام في الكلام وأسبابه. فالحيّ الذي له آلة الكلام لا تخلو البتة من أن تكون مئوفة أو لا تكون مئوفة. إن كانت مئوفة فهو الأخرس، وإن لم يكن مئوفة فإمّا أن يستعملها في أسباب الكلام أو الصياح أو الصراخ،. ولا يستعملها. إن استعملها كان متكلّما أو صائحا أو صارخا، وإن لم يستعملها كان ساكتا فانكشف أنّ هذه التقسيمات إنّما ترد على ذي الآلة.
فأمّا الحيّ الذي يتنزّه عن الآلات فهذه التقسيمات لا تتعاقب عليه.
ما هذا إلّا كأن يقول قائل: الحيّ في الشاهد إذا لم يكن متحرّكا كان ساكنا واذا لم يكن ساكنا كان متحرّكا، ثمّ يقول: إذا لم يكن اللّه ساكنا وجب أن يكون متحرّكا، وإن لم يكن متحركا وجب أن يكون ساكنا. فكما يقال له هذان الوصفان إنما تعاقبا على الحيّ منّا لكونه جسما لا يلزم أن يتعاقب هذان الوصفان عليه، يقال له كذلك في مسألتنا إذا لم يكن اللّه تعالى متكلما لا يلزم أن يكون أخرس أو ساكتا، لما بيّناه.
ثمّ نقول للمتمسّك بهذه الطريقة إن كان من الصفاتية كأصحاب الأشعريّ وابن كلاب: إن انتفاء الخرس والسكوت في الشاهد إنّما دلّ على ثبوت كلام محدث من جنس الأصوات والحروف، وأنتم لا تثبتون كلامه تعالى من جنس الأصوات والحروف. فأيّ جهة لكم في ذلك.
إن قالوا: انتفاء الخرس والسكوت المعقولين في الشاهد هو الذي يقتضي كلاما من جنس الحروف والأصوات أو الخرس والسكوت اللذان ننفيهما عن اللّه تعالى، بخلاف ما عقلناه في الشاهد.
قلنا: وإذا عنيتم بالخرس والسكوت خلاف ما عقلناه في الشاهد من معنى اللفظين، فمن أين أنّ ذلك الخرس والسكوت من أوصاف النقص، وأنّهما مغنيان عنه تعالى، فلعلّهما ثابتان.
ثم نقول لجميعهم: وإثبات كونه تعالى متكلّما لم يزل هو إثبات النقص في حقّه تعالى. وذلك لأنّ المتكلّم إنّما يكون منقوصا هاذيا وفي حكم العابث إذا أفاد كلامه غيره أو يتكلّم على وجه التكرار للحفظ أو يغنّي ليطرب بغنائه ولم يكن لم يزل من لم يستفيد بكلامه تعالى فائدة، والقسمان الآخران مستحيلان فيه تعالى، فيلزم في المتكلّم لم يزل أن يكون هذيانا، تعالى اللّه عن ذلك وعن جميع النقائص.
فإن قيل: إذا أثبتّم كلامه تعالى من جنس الأصوات والحروف، ومعلوم أن الحروف والأصوات لا تبقى، فعلى هذا ما تكلّم اللّه تعالى به ما بقى فينبغي أن لا يكون ما يقرؤه القارءون من القرآن في الصلوات وغيرها كلام اللّه وأن لا يكون كلام اللّه فيما بيننا. وزائدا على ذلك يلزم أن لا يكون الرّسول عليه السلام سمع كلام اللّه فيما أوحى اللّه تعالى إليه بواسطة جبرئيل وشيء آخر:
وهو أنّه إذا كان ما يقرؤه القارئون ويتلوه التالون فعلا لهم، لوقوعه بحسب قصودهم ودواعيهم، وجب أن يكونوا قد أتوا بمثل القرآن، وذلك ينقض كونه معجزا.
قلنا: لا يلزمنا شيء من ذلك مع ما ذهبنا في كلام اللّه تعالى إلى ما حكاه السائل عنّا وذلك لأنّ الكلام إنّما يضاف على الوجه المشار إليه إلى من ابتدأ مثل ذلك النظم دون من يحكيه فلا يقال فيما ينشده الواحد منّا من شعر لبيد، مثلا، إنّه كلام المنشد وشعره، ولو قال قائل ذلك لكذّبه كلّ من يعلم أنّه من إنشاء لبيد، ويقول: إنّ هذا كلام لبيد وشعره. وكذا في الخطبة التي يوردها خطيب من خطب ابن نباتة مثلا، فانّه لا يقال إنّه من كلام الخطيب، وإنّما يقال إنّه من كلام ابن نباتة وهذه الإضافة حقيقة عرفيّة. وبيان كونها حقيقة أنّ كلّ من يسمعها لا يسبق إلى فهمه منها إلّا المعنى الذي ذكرناه، ولا يحتاج في حملها على هذا المعنى إلى قرينة، وهذا من دلائل الحقيقة.
فإن قيل: كيف يكون ما يحدثه الواحد منّا ويقع بحسب قصده وداعيه كلام اللّه تعالى؟ وكيف يصحّ الجمع بين هاتين الإضافتين؟ سيّما ومن مذهبكم أنّ المتكلّم بالكلام هو فاعله.
قلنا: حدوث ما نحدثه من قراءة كلام اللّه تعالى بحسب قصودنا ودواعينا، لا يمنع من إضافته إلى اللّه تعالى على الوجه الذي ذكرناه، وبالمعنى المشار إليه، وهو أن يقال إنّه كلامه تعالى أي هو المبتدئ بمثل هذا النظم، لا على معنى انّه الذي يحدثه في الحال. وهذا ظاهر في الأمثلة التي ضربناها. والتحقيق فيه: أنّا لا نقول فيما نتلوه ونوجده من الحروف والأصوات أنّه من فعل اللّه، وانّما نقول هو كلامه تعالى. وكما يجوز في شخص واحد أن يكون ولدا لشخص واحد ويكون عبدا للّه تعالى، ولا يمنع إضافته بالولادة إلى شخص آخر من إضافته إلى اللّه تعالى بالعبوديّة، فكذلك لا يمنع إضافة ما نقرؤه بالحروف في الحال إلينا من إضافته إليه تعالى، بالمعنى الذي ذكرناه، وهو انّه المبتدئ بمثل ذلك النظم، ولا تنافي بين الإضافتين.
فإن قيل: إضافة الشخص الواحد إلى أبيه وإضافته إليه تعالى إنما هما إضافتان بمعنيين مختلفين.
قلنا: وكذلك إضافة ما نقرؤه من القرآن إلينا وإلى اللّه تعالى إنّما هي بمعنيين مختلفين إذ معنى إضافته إلينا أنّا نحدثه، ومعنى إضافته إليه تعالى أنّه المبتدئ بمثل هذا النظم حتى حفظناه وتعلّمناه وأمكننا قراءته، وقد بيّنا أنّ هذه الإضافة إليه تعالى حقيقية، لابتدار المعنى الذي ذكرناه منها إلى الأفهام.
فأمّا ما ذكره السائل من أنّ هذا يقدح في كون القرآن معجزا يتحدّى به- فغير لازم، وذلك لأنّ التحدّي بالقرآن ما وقع بمعنى أنّكم أيّها العرب أو غيركم تعجزون عن حفظ ما أتيت به وحكايته وقراءته، وإنّما وقع بمعنى أن يأتوا من قبل أنفسهم بكلام مثل القرآن في الفصاحة ابتداء على ما جرت به عادتهم في تحدّي بعضهم بعضا بشعر أو خطبة وما ذكره السائل وقع لأبي عليّ وأبي الهذيل قبله.
القول بأن للكلام معنى، سوى الحرف والصوت وما يتركّب منهما، يوجد مع الصوت مسموعا، ومع الكتابة مكتوبا، ومع الحفظ محفوظا، وأنّه يصحّ بقاؤه ووجوده في حالة واحدة على اتحاده في أماكن متباعدة.
و بيّنا الجواب عن هذا السؤال على هذا المذهب، فقالا: التالي لكلام اللّه تعالى يوجد مع تلاوته عين كلام اللّه تعالى الذي أوجده فهو باق موجود مع تلاوة كلّ تال، ولا يلزمنا شيء ممّا ذكره السائل. واحتجا لصحّة مذهبهما بأن قالا:
لو لم يكن الكلام موجودا مع الكتابة لما صحّ تلاوته من الكتابة، ولو لا أنّه موجود مع الحفظ لما تمكّن الحافظ له من قراءته. وأيضا فانّ تلاوة القرآن ربما تقبح من بعض المكلّفين، كالجنب والحائض، ولا يجوز وصف القرآن وكلام اللّه تعالى بالقبح. وهذا مذهب باطل لا يحتاج إلى ارتكابه في جواب سؤال السائل. على ما بيّنا القول فيه.
ونحن نبيّن بطلان ما تمسّكا به لنصرة مذهبهما ثمّ ندلّ ابتداء على بطلان هذا المذهب.
أمّا قولهما: «لو لا وجود الكلام مع الكتابة لما أمكن قدرة الكلام من الكتابة»، فالردّ عليه أنّ التلاوة من الكتابة إنّما أمكن، لا لما ذكرتموه، بل لأنّها رقوم جعلت أمارات دالّة على الحروف والأصوات، بالمواضعة عليها. فمن عرف تلك المواضعة ونظر في الكتابة أمكنه تلاوة الكلام بالاستدلال بها عليه، وعلى هذا فانّ الكتابة والرقوم الدالة على كلام واحد تختلف باختلاف الخطوط واختلاف المواضعة عليها، والكلام الواحد لا يختلف.
ألا ترى أنّ الكلام العربي لو كتب بالخطّ العربيّ والسريانيّ واليونانيّ لكانت الرقوم مختلفة والكلام غير مختلف وكذلك التوراة لو كتب بالخطّ العربيّ لكان الخطّ العربيّ مخالفا للخطّ العبريّ، وعبارات التوراة غير مختلفة، وبعد، فلو دلّ إمكان تلاوة الكلام من الكتابة على أنّه موجد معها، فليدلّ على أنّه موجود مع الإشارة والعقد على الأصابع لإمكان تلاوته منهما بتقدّم مواضعه عليهما، ومعلوم خلاف ذلك.
وأيضا فكان يلزم، في الأميّ الذي لا يعرف الخطّ، أن يعرف الكلام بالنظر في الكتابة، لأنّه موجود معها كما لو سمع كلاما بلغة لا يعرفها، فانّه يعلم الكلام ووجوده وثبوته، وإنّما لا يعلم معناه.
بعد، فانّ صورة الميم في بعض الخطوط تشبه صورة الصاد في بعضها، وكذلك القول في صورة النون والراء والزاء، وفي الخطّ العربيّ صورة الباء والتاء والثاء واحدة، وكذا صورة الجيم والحاء والخاء واحدة، وكذا القول في الدال والذال والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء، والظاء، والعين والغين. فليس بعض هذه الحروف بأن يوجد مع بعض هذه الرقوم أولى من البعض، فيجب أن يكون كلّ حرف من حروف الكلام موجودا مع كلّ رقم من رقومه المتشابهة.
وأيضا فانّه يلزم أن يكون القرآن، وغيره من كتب اللّه موجودة مع جميع أجسام العالم، لأنّه يمكن إظهار كتابه القرآن والكتب في جميع الأجسام، لا بإثبات شيء فيها، بل بإزالة أبعاض عن حواليها، كما يظهره النقّارون، لأنّهم بالنّقر لم يثبتوا شيئا ما كان ثابتا، وإنما أزالوا بعض ما كان ثابتا، والكلام موجود مع الكتابة على قول أبي عليّ، فكما لم يتجدّد كتابة ما كانت ينبغي أن لا تجدّد، ينبغي أن لا يتجدّد حصول كلام هناك ما كان قبله. فاتضح لزوم ما ذكرناه من وجود القرآن وجميع كتب اللّه تعالى من جميع أجسام العالم.
وأمّا قولهما: «الحافظ للقرآن يمكنه تلاوة القرآن». فالجواب عنه أن نقول: إنّما أمكنه ذلك، لأنّه علم كيفيّة ترتيب تلك الكلمات واستقرّ ذلك العلم فيه واستمرّ، فأمكنه إيقاع الكلمات وإحداث الحروف والأصوات مرتبة على ما علمه كما أنّ العالم بالصياغة أو التجارة أو غيرهما من الصناعات يمكنه إيقاع صنعته محكمة مطابقة لما علمه، ولم يدلّ ذلك على أنّ تلك الصناعة أمر موجود في حفظه زائدا على حفظه وعلمه.
وأمّا قولهما: «تلاوة القرآن قد تقبح من بعض المكلّفين والقرآن لا يوصف بالقبح»، فالجواب عنه أن نقول: بلى، لا يجوز وصف القرآن بالقبح، لأنّه يوهم انّ ما تكلّم اللّه به وأنزله على رسوله كان قبيحا، ولا نقول ذلك ونقول هذا الذي يأتي به الجنب أو الحائض ممّا ابتدأ اللّه تعالى بمثل نظمه يقبح منهما.
فالموصوف بالقبح هو فعلهما، لا فعل اللّه تعالى. ولا نقول كلام اللّه تعالى قبيح، لما فيه من إبهام أن ما فعله اللّه قبيح.
ثم الدليل على بطلان القول- بأن للكلام معنى سوى الحروف والأصوات على ما ذكراه- هو انّه لو كان كذلك لوجب أن يتصور ثبوت الحروف والأصوات المنظومة على ما ذكرناه من دون الكلام أو ثبوت الكلام من دون تلك الأصوات والحروف، إذ لا يمكن ان يقال: كلّ واحد منهما محتاج إلى صاحبه، للزوم حاجة الشيء إلى نفسه فيه، فلئن كان المحتاج إنّما هو الكلام لتصوّر وجود الأصوات والحروف من دون الكلام، وإن كان المحتاج هو الأصوات والحروف لتصور وجود الكلام من دون الحروف والأصوات ومعلوم خلاف ذلك.
فإن قيل: أليس أبو عليّ وابو الهذيل قالا: بأنّ الكلام موجود مع الكتابة والحفظ، وليس معهما صوت وحرف، فقد انفصل الكلام من الحرف والصوت.
قلنا: إنّما أجازا وجود الكلام من دون الحرف والصوت، بناء منهما على اعتقاد أنّ الكلام معنى غير الصوت. وإنّما يلزم هذا في غيرهما وغير من يذهب إلى مذهبهما من العقلاء. ومعلوم أنّ غيرهما من العقلاء لا يجوّزون ذلك.
أمّا الصفاتيّة فانّهم أثبتوا كلام اللّه تعالى معنى قائما به مخالفا للحرف والصوت. والأشعريّ منهم ذهب إلى أنّ الكلام معنى قائم بذات المتكلّم شاهدا وغائبا وقد ذكرنا أنّا لا نكلّمهم في قدم ذلك المعنى أو حدوثه، إنّما نكلّمهم في إثباته فنقول لهم: ما ادّعيتموه من المعنى القائم بذات المتكلّم، لا نعلمه ضرورة فما الطريق إلى إثباته؟
إن قالوا: أليس المتكلّم بالنطق والعبارة قبل شروعه في إيراد العبارات يجد أمرا يديره في خاطره ويورد عبارات مطابقة له؟ فذلك الأمر هو الذي نثبته وهو موجود في النفس.
قلنا: ما يجده المتكلّم في نفسه ممّا أشرتم إليه إنّما هو إمّا علم بكيفيّة ترتيب ما يورده من العبارات أو نظر في كيفيّة إيرادها أو عزم على إيرادها، لا يعقل وراء ذلك معنى آخر.
فإن قالوا: نستدلّ بالعبارات المطابقة لما في قلبه على المعنى الذي نثبته.
قلنا: الدلالة ينبغي أن يكون لها تعلّق بمدلولها ليكون بأن يدلّ على مدلولها أولى من أن يدلّ على غيره. وهذه العبارات ليست إلّا حوادث مرتبة على وجه الإحكام مختصّة ببعض الوجوه الجائزة عليها، ككونها أمرا ونهيا أو خبرا إلى غيرها، لا وجه لها سوى ما ذكرناه، فهي بحدوثها وصحّته تدلّ على كون فاعلها قادرا، وبإحكامها على كونه عالما، وبوقوعها على وجه دون وجه على كونه مريدا وكارها لا تدلّ على غير ما ذكرناه، لعدم العلقة بينه وبين غيره. فثبت أنّه لا طريق إلى إثبات ما ذكروه ولا هو معلوم ضرورة فوجب نفيه.
و يمكن تجويز هذه الجملة على وجه يكون ابتداء استدلال على بطلان مذاهبهم بأن يقال ما تدّعونه من المعنى القائم بنفس المتكلّم غير معلوم ضرورة، ولا يدلّ عليه دليل فوجب نهيه، وإلّا أدّى إلى فتح باب الجهالات.
إن قالوا: إليه طريق وأشاروا بذلك إلى العبارة، فالكلام عليه ما سبق.
فان تمسّكوا بما ذكرناه من قبل من قول القائل «في نفسي كلام»، وقول الشاعر: «انّ الكلام لفي الفؤاد»، فالجواب منه ما سبق.
ثمّ نقول لهم: هذا توصّل إلى إثبات المعنى بالعبارة. وذلك باطل، لأنّ المعبّر عن أمر إمّا أن يعبّر عمّا علمه أو عن ما لم يعلمه. فإن عبّر عمّا لم يعلمه، لم تكن في عبارته حجّة، وإن عبّر عمّا يعلمه فعلمه لا يخلو من أن يكون ضروريا أو استدلاليا إن كان ضروريا فليذكره حتّى ننظر فيه، ويلزم عليه أن لا يكون مختصّا به دون غيره. وإن كان استدلاليّا، فليذكر دليله، فانّ الحجّة فيه، لا في عبارته.
و قد حكى بعضهم أنّه تعالى متكلّم لنفسه. والردّ عليه هو أن نقول: إضافة الصفة إلى النفس فرع على إثباتها. والمتكلّم ليس له بكونه متكلّما صفة، فكيف تكون نفسيّة. وإنّما المتكلّم هو فاعل الكلام. كما أنّ المحسن هو فاعل الإحسان.
فالقول بأنّه متكلّم لنفسه يتناقض من حيث ان وصفه بأنه متكلّم يقتضي أنّه فعل كلاما وأن له كلاما، ووصفه بأنّه متكلّم لنفسه يقتضي أنّه متكلّم لا بكلام، فيتناقض القولان. كما لو قال قائل في المحسن أنّه لمحسن لنفسه أو متفضّل لنفسه أو فاعل لنفسه.
ثم يلزمهم على قولهم هذا: أن يكون تعالى متكلّما بسائر ضروب الكلام، حتّى يكون متكلّما بالكذب، وأن يكون آمرا بكلّ ما يمكن الأمر به، ناهيا عن كلّ ما يمكن النهي عنه، وكلّ ما يصحّ الأمر به يصحّ النهي عنه فيلزم أن يكون آمرا بجميع ما هوناه عنه، ناهيا عن جميع ما هو آمر به، وأن يكون مكلّما لكلّ أحد، لأنّ جميع ذلك أقسام خاصّة داخلة تحت وصفه بأنّه متكلّم، وكونه متكلّما عامّ يشمل جميع هذه الأقسام، والصفة العامّة إذا كانت نفسيّة كانت الصفة الخاصّة الداخلة تحتها، نفسيّة أيضا.
فإن قالوا: أليس هو تبارك وتعالى عالما لذاته عندكم ولا يلزمكم أن يكون جاهلا أو بصفة المقلّد والمبخت. فكذلك هو عندنا صادق لنفسه، فلا يلزم أن يكون كاذبا وكذلك أو ليس هو عالما ولا يلزم أن يكون معلّما لنفسه؟ كذلك يكون متكلّما لنفسه عندنا، ولا يكون مكلّما لنفسه، فلا يلزم أن يكون مكلّما لكلّ أحد.
قلنا: أوّلا، هذا الاعتذار لا يمكنكم أن تذكروه في كونه آمرا وناهيا لأنّه قد ثبت أنّه آمر بأشياء، وناه عن أشياء، فيلزمكم في الأمر والنهي ما ذكرناه.
وأمّا ما قلتموه، في كونه متكلّما وكونه مكلّما وقياسهما على ما نقوله في كونه عالما ومعلّما، فغير صحيح، وذلك لأنّ كونه مكلّما يدخل تحته كونه متكلّما، لأنّ كونه مكلّما معناه كونه مخاطبا لغيره فيكون متكلّما معه، فيدخل في كونه متكلّما بما به دخل في كونه مكلّما. فإذا كان متكلّما لنفسه، اتّجه أن يكون مكلّما لنفسه. وليس كذلك ما نقوله في كونه عالما ومعلّما، لأنّ معنى كونه معلّما إنما هو خلق العلم في قلب الغير أو نصب الدليل له. هذا في اللّه تعالى: فأمّا في الشاهد، فمعناه تكرير الكلام على الغير ليعلمه أو يحفظه، أو إشارة إلى الطريق الذي به يعلم الشيء. وهذا المعنى غير داخل في فائدة وصفنا العالم بأنّه عالم، فلا يلزمنا إذا وصفناه تعالى بأنّه عالم لنفسه أن يكون معلما لنفسه ويلزمكم أن يكون مكلّما لنفسه، لأنّ ما به يكون مكلّما به يكون متكلّما فافترقا.
أمّا قولكم: «هو تعالى صادق لنفسه فيمنع كونه صادقا من كونه كاذبا. كما أن عندكم كونه عالما يمنع من كونه جاهلا» فالرّدّ عليه أنّ كونه عالما ثبت عندنا بالدلالة، فمن اين قلتم إنّه صادق؟
إن قالوا: لأنّه أخبر عن أشياء وجدنا مخبراتها على ما تعلّق به خبره كإخباره عن خلق الأرض والسماء وخلق الإنسان من النطفة.
قلنا: وأخباره تعالى التي وصفتموها انّما تكون صدقا إذا قصد بها الإنباء عن السماء والأرض المخلوقتين وعن الإنسان المخلوق، ولئن قصد بها إلى غير ما ذكرناه لم يكن صدقا كقول القائل: «محمد رسول اللّه»، ان لم يعن به محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطلب، صلوات اللّه عليه وعلى آله، فمن أين إنّه تعالى قصد إلى الإنباء عن هذه الأشياء المخلوقة دون غيرها؟
ثمّ يقال لهم لم نساعدكم على انّه تعالى صادق فيما أخبر عنه من السماوات والأرضين وخلق الحيوانات وغيرها ونلزمكم أن يكون كاذبا، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا في غير ما أخبر عنه بالعبارة والحرف والصوت. إذ ما ثبت أنّه أخبر عن غيرهما حتّى تدعو أنّه صادق فيها.
إن قالوا إنّه تعالى أخبر عن كلّ ما يمكن الإخبار عنه صدقا، ظهر بطلان قولهم، إذ ما يمكن الإخبار عنه بالصدق من مستقبلات الامور، من مقدوراته تعالى غير متناهية، والأخبار متناهية، فكيف يمكن أن يقال إنّه أخبر عن جميعها؟
_________________
( 1) صحيح البخاري ج 4 ص 128 كتاب بدء الخلق ح 2.



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|