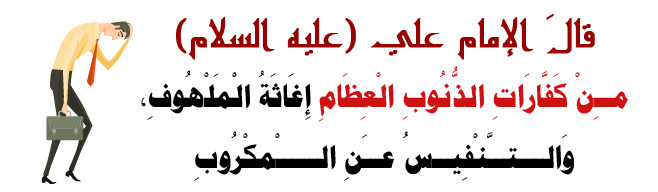
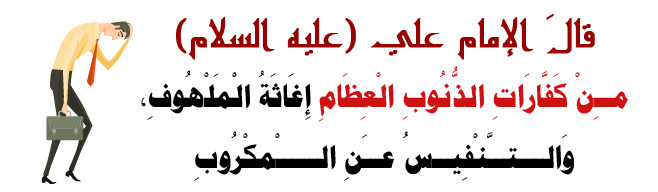

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
التاريخ: 21-9-2016
التاريخ: 10-4-2022
التاريخ: 24-7-2020
|
{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [المائدة: 78]
بيان لشدة غضبه عز وجل على الذين كفروا من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بالنبي وما أنزل إليه ، واللعن هو البعد عن الرحمة الإلهية التي لا يستغني عنها المخلوق في حياته المادية والمعنوية ، ولعنهم إنما كان من الله تعالى على لسان أنبيائهم ولعله لأجل ذلك أتى الفعل بالمجهول ، إما لبيان الكبرياء والعظمة ، أو لأجل أن الله تعالى منبع كل خير ورحمة وقد لعنا (عليه السلام) من كفر من بني إسرائيل بالله وواحد من رسله وفيه من التعريض لهم بأنهم ملعونون على لسان أنبيائهم أنفسهم وذلك لعصيانهم وتمردهم على الحق وأحكام الله تعالى كما ذكره عز وجل في ما يأتي ، والآية تدل على أن اللعن كان بلسانهم دون الكتابة واللغة كما قيل وهو أدل على تقبيحهم وبعدهم.
قال تعالى : {ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ } [البقرة: 61].
تأكيد لما سبق وبيان السبب في استحقاقهم اللعن ، فإن كان بسبب العصيان له عز وجل واستمرارهم على العدوان ، والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل لبيان الامتداد والاستمرار الذي ذكرناه ، والآية الشريفة تدل على أن اللعن إنما هو بحسب أعمالهم القبيحة وتجاوز الحد في العصيان واعتداءهم المتكرر المستمر دون غيرهما.
بيان خصوصيات العصيان والاعتداء المستمر فإنهم أصروا على ذلك غاية الإصرار الاعتداء على حدود الله وتجاوز الحد في العصيان والتناهي من التفاعل الدال على الشدة في فعل المنكر وتماديهم فيه، فهم جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر به وعدم النهي عنه في ما بينهم ، فكان لا ينهى بعضهم بعضاً ولا يتناهون عنه لو صدر منهم ، والمنكر هو كل فعل منهى عنه والجملة مفسرة لما قبلها من المعصية والاعتداء ومفيدة لاستمرارها ، والنهي عن المنكر مما لا ريب في حسنه عقلا ووجوبه شرعا لما فيه من حفظ الدين والمنع عن تجرؤ الفساق على إظهار فسقهم وفجورهم ، وإذا ترك سيتجرأ الكثيرون على اقتراف المنكرات مما يوجب شيوعها في المجتمع الذي سيؤول إلى الضياع والفساد ويستحق الطرد من الرحمة الإلهية التي بها حياة الفرد والمجتمع.
وقد ذكرنا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،.
تعجيب من سوء فعلهم وتأكيد حاصل من القسم - لذم ما كانوا يعملونه من المعاصي والآثام ، وفي الآية الشريفة زجر شديد لمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال تعالى : { تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [المائدة: 80].
تأكيد آخر لما سبق بالاستشهاد بالحس وبذكر بعض أحوال الحاضرين التي هي من آثار فعل السالف وسيرتهم الراسخة الدالة على كونهم معتدين على دين الله الذي إذا أحبوه وقدروه حق التقدير لتولوا أهل التوحيد وآمنوا بالله ورسوله ولما تولوا أعداء الله من الذين كفروا وهو مشركوا نريش الذين عاندوا الحق، وقد ذكرنا سابقاً أن تولي الكفار يوجب الانخراط معهم والدخول في سلكهم وذلك ينبئ عن ضعف العقيدة وعصيان الله والتمرد على أحكامه.
قال تعالى : {لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ} [المائدة: 80].
ذم آخر مؤكد لما قدموه لأنفسهم وهو تولي الكفار في الدنيا ليلقوا جزائه ووباله في العقبى وفي ذكر { أنفسهم } الدلالة على أن الولاية إنما كانت عن هوى النفس وميولها المادية لا عن عقيدة بمن تولوهم.
قال تعالى : {أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} [المائدة: 80].
بيان للجزاء العظيم والوبال الكبير الذي استحقوه وفي الآية كمال الذم والتسفيه لهم إن وضع جزاء العمل وعاقبته موضع العمل كأن أنفسهم قدمت لهم جزائه بتقديم نفسه.
وذكر الدخول في العذاب والخلود بعد استيلاء السخط عليهم لبيان أنهم لا محيص لهم عن الدخول في العذاب ولا يحيدون عنه مصرفاً لأن النجاة منه إنما يكون برضاه الله تعالى عنهم وهم لم يعملوا إلا ما أوجب سخطه ونقمته عليهم.
قال تعالى : {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ} [المائدة: 81].
بيان لسبب تولي هؤلاء اليهود للذين كفروا وهو عدم الإيمان بالله وإعراضهم عما كانوا يقدسونه ويحترمونه، فإنهم لو كانوا كذلك لكانوا آمنوا بالله والنبي وما أنزل إليه من الهدى والفرقان ولما اتخذوا أولئك الكافرين من عبدة الأصنام والأوثان أولياء وأنصار إلا أنهم أشباههم في الكفر فانجذبوا إليهم ، بخلاف ما إذا كانوا مؤمنين ، فإن الإيمان يقطع كل سبب سرى حب الله تعالى ويكون رادعاً عن تولي الذين كفروا قطعا ويحتمل أن يرجع الضمير إلى الذين كفروا ، أي ولو كان الذين كفروا - وهم المشركون - يؤمنون بالله وبالنبي محمد (صلى الله عليه واله) وما أنزل إليه من الفرقان والهدى لما اتخذوا اليهود أولياء لأن الإيمان فيهم يستدعي قطع الصلة عن توليهم ، ولكن الظاهر هو المعنى الأول بقرينه ذيل الآية الشريفة.
إضراب عما سبق ولبيان العلة في عدم الإيمان لأن الكثير من هؤلاء اليهود فسقوا عن الدين وخرجوا عن طاعة رب العالمين ولا عبرة بالقليل فإنه لا يؤثر في أخلاق الأمة وسيرتها.
تفصيل في أخلاق الطائفتين اليهود والنصارى بالنسبة إلى أصل الإيمان بعد بيان اشتراكهما في بعض الرذائل النفسانية وذكر ما اختص به بعضهما كقول اليهود { يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة: 64] وقول النصارى { إن ألله هو المسيح أبن مريم } والوجدان يتعدى إلى مفعولين وهما أشد واليهود.
وفي { لتجدن } تأكيد أن اللام ونون التوكيد، والجملة عامة تشمل الناس واليهود والتنزيل وبعده أيضا ، كما هو المعروف والمحسوس ولعله لهذا عبر عز وجل بقوله { لتجدن } الدال على الوجود المحسوس وفي تقديم اليهود على الذين أشركوا إشعار في تقدمهم عليهم في العداوة وفي التعبير بالذين أشركوا دون المشركين مع أنه أخصر للمبالغة في الذم ، كما أن التعبير بالذين آمنوا لأنه أظهر في علية ما في حيز الصلة ، وعداوة اليهود والذين أشركوا معروفة منذ ظهور الإسلام إلى يومنا هذا لأن الكلام سبق لبيان الضابط العام كما في كثير من الآيات النازلة في شأنهم ، فلا تختص الآية بعصر التنزيل كما ذكره بعض المفسرين وإنما أشرك عز وجل اليهود والمشركين لتضاعف كفرهم وتمردهم على الحق واستمرارهم على تكذيب الأنبياء ومعاداتهم وانهماكهم في اتباع الهوى ، وكونهم على التقليد.
قال تعالى : {وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى} [المائدة: 82].
بيان لشدة عطف النصارى ورقة قلوبهم ولين جانبهم وحسن إقبالهم على الحق ، فهم الذين قالوا : { نحن أنصار الله } فكان ابتغاؤهم نصرة الله ، فهم لم يكافحوا الحق بالرد كما كافحه اليهود ولعله لأجل ذلك لم يعبر عز وجل بالنصارى كما قل جل شأنه اليهود لصلابتهم وامتناعهم عن الانقياد. وإنما ذكر عز وجل { أقربهم } دون غيره ولم يجعل جل شأنها ما به الاشتراك شيئاً واحداً قد تفاوتا فيه بالشدة واضعف كأن يقال : " لتجدن أبعد الناس مودة " أو أضعفهم مودة ونحو ذلك لبيان شدة التفاوت بينهما وكمال التباين بين الفريقين فإن أحدهما في أقصى المراتب من أحد النقيضين والآخر في أقرب النقيض الآخر.
بيان السبب في كونهم أقرب مودة للذين آمنوا وقد ذرك عز وجل أموراً ثلاثة :
الأول : إن فيهم قسيسين وهم طائفة العلماء الذين يتولون تعليم المسيحيين وتربيتهم الدينية والرؤساء فيهم في هذا المجال والقس والقسيسين مأخوذ من تقسيس الشيء إذا تتبعه سمي به لتتبعه آثار العلم والمعاني ، وهي رتبة دينية عند النصارى دون الأسقف ، ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا هنا ، ولا بد أن يكون أصل إطلاقه على بعض العلماء منهم حقاً لأن القرآن الكريم يذكرهم في مقام المدح لهم ثم انحرفوا كما هو الشأن في كثير من الأمور الدينية عند اليهود والنصارى، ولعل السبب ما ذكره بعض العلماء أن النصارى ضيعت الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه وبقي من علمائهم واحد على الحق والاستقامة يقال له قسيس ، فمن كان على هديه ودينه فهو قسيس ، وكيف كان فهم علماء يذكرون قومهم مقام الحق ومعارف الدين ويرشدونهم إلى ما هو الأصلح لهم.
الثاني : الرهبان وهو جمع الراهب وهو المتبتل المنقطع في الصومعة أو الدير للعبادة وحرمان النفس من النعم الدنيوية كالزواج والولد ولذات الطعام والزينة، وهو من الرهبة أي المخافة مع تحرز ، والترهب التعبد والرهبانية من فرط الرهبة غلو في تحمل التعبد، والرهبانية يكون جمعاً ويكون واحداً وجمعه رهابين، كذا قيل.
والرهبنة دخلت في المسيحية لأسباب عديدة ولا يمكن أن نتغاضى عن السبب الأهم وهو أن الانقطاع عن العلائق الدنيوية أمر مركوز في الإنسان فقد يطغى الجانب الروحي في الإنسان ولأسباب معروفة فيتبتل للعبادة والطاعة وينقطع عن الدنيا وعلائقها وزخارفها، وقد يتغلب الجانب المادي فيحدث الإقبال على الدنيا والإعراض عن الجانب الآخر، وهذه الرهبانية قد تكون ممدوحة إذا كانت مطابقة لروح الشريعة الإلهية وأحكامها وقد تكون مذمومة إذا خالفتها ، كما قال تعالى : {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} [الحديد: 27] ، وفي الحديث " لا رهبانية في الإسلام "، وقد ذكروا أسباباً عديدة لدخول الرهبانية في النصارى ، بعضها لا تخلو من المناقشة وإن كان لتعاليم المسيحية وإدراك بعض علمائهم بطلان هذا العالم وخداع مظهره الخلاب وقوع بعض الاضطهاد عليهم في ابتداء أمرهم وغير ذلك من الوجوه الأثر الكبير في دخولها فيهم ، وقد مرت عندهم بمراحل متعددة متطورة بدءاً من الهروب من الناس إلى الاختلاء في الكهوف بقصد محاربة النفس والإكثار من العبادة والتأمل مع المحافظة على الوحدة والتفرد ، وبمرور الزمن كثر عددهم وصار عندهم نوع من العشرة والاجتماع بينهم بعد تعرضهم إلى المخاطر ، فبنت لهم الصوامع فنشأت الأديرة وكثرت ثم صار لها أسباب وتواعد، فأصبح الالتحاق بهذا السلك أمراً ليس بالهين ، وكيف كان فالرهبانية الموجودة عندهم وإن كانت بدعة ولكن لا ينافي تأثيرها في تقريب النصارى من مودة المسلمين ، ولما كان القساوسة والرهبان بكثرة في النصارة ، بل صارت عقيدة ، وفكرة عندهم أوجبت نسبة المردة إلى جنس النصارى.
الأمر الثالث : أنهم لا يستكبرون أي بأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق والإعانة له لما فيهم من روح التواضع حتى صار شعارهم وأشهر آدابهم وأمروا بمحبة الأعداء .
والآية الكريمة تدل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والزهد في الدنيا والإعراض عن الشهوات محمودة اينما كانت وأن اجتماعها في أي فرد يوجب الإذعان للحق وذلك لأن الإنسان اذا أراد السعادة في الدارين فلا بد أن يتوخاها في علم ليدرك به حقيقة الدين وأحكامه ومعارفه ليتمكن من العمل بها فإن العلم والعمل متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر فى نيل السعادة وهما لا يتحققان إلا مع إزالة الموانع من النفس وأهمها الاستكبار عن الحق بجميع هيئاته المتمثلة في العصبية والعادات والتقاليد الموروثة والبيئة التي يعيش فيها والتربية الفاسدة التي تربى بها ، كل تلك موانع وحجب تمنع النفس من العلم الحق وحق العمل وهذا من الأمر المحسوس وقد دنت عليه البراهين العقلية والفعلية فإن العصبية في النفس تمنع من الخضوع للحق والعلم به ، كما أن العادات السيئة لها الأثر الكبير في باب الأعمال فإن استقرارها في النفس لا يبقى لها فراغاً لأن تتفكر في أمرها أو تتدبر في الخلاص منها فهي مانعة من العمل الصالح لا سيما إذا استقرت في المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه الفرد ، حينئذ يصعب إزالتها وتركها ولكن لا تصل إلى الامتناع كما هو المعلوم ، فإن النفس وإن وقعت في الحرج والمشقة في ابتداء الأمر إذا كان الفعل الصادر منها مخالفاً لتلك العادات إلا أنها تسهل إذا استمرت عليها حتى تصير عادات بالتكرار وتصبح طبيعية ثانوية فإن الطبايع عادات ولها الأثر الكبير في النفس والمجتمع في تصحيحها أو إفادها وحينئذ إذا علم الإنسان بالحق ونزع العناد واللجاج عن النفس فأذعن وخضع له صار العلم داعياً للعمل وتقبل النفس إتيانه ، ولا بد أن لا ننسى أن ما ذكرنا ممكن وواقع في الخارج وإن كان التلقي لعمل يختلف شدة وضعفاً مع وجود الحواجب النفسانية كما عرفت ولكن الأرضية الخصبة هي الإعراض عن الدنيا والزهد فيها فإنها تسهل كثيراً للنفس ممارسة العمل الذي يدعو إليه العلم الحق ومن كل ذلك يعلم أن الآية الشريفة تشير إلى حقيقة من الحقائق الاجتماعية التي طالما اختلف فيها علماء الاجتماع والنفس في العادات والتقاليد ورواب النفس التي لها الأثر الكبير في الفرد والمجتمع وكيفية التخلص منها ومدى تأثيرها في الأجيال واختلاف القيم بسببها ، والقرآن الكريم يرشدنا إلى أوضح السبل في الحد من تأثيرها والتغلب عليها ثم إزالتها، فالمجتمع إذا اشتمل على علماء يهتمون بتربية الأفراد وتعليمهم ورجال يمثلون الجانب التطبيقي للعلم الحق ليذعن عن العامة بتطابق العلم مع العمل وإمكانه حتى مع وجود عادات سيئة متفشية بينهم فتعتاد على قبول الحق والخضوع له وعدم الاستكبار إذا انكشف لهم الواقع ، ولأجل ذلك كان النصارى أقرب مودة للحق وأسلس قياداً لقبول الإسلام والإذعان له لوجود تلك الحقيقة فيهم ، فإن منهم علماء لا يزالون يذكرونهم الحق والدعوة لله تعالى، ثم فيهم زهاد يعرضون عما يوجب البعد عن السعادة، فكان من نتيجة التطابق بينهما إن أثرت التربية الدينية والعملية فيهم لأنهم لا يستكبرون عن قبول الحق، وهذه الأمور إذا تحققت في أي مجتمع كان أقرب إلى قبول دين الحق .
وهذا بخلاف اليهود الذين خلوا عنها وقد وصفهم عز وجل في مواضع عديدة من القرآن الكريم بأنهم يتكبرون وفيهم علماء لا يذعنون للحق بل لا يدعون رذيلة إلا يقترفونها فنشأ على ذلك مجتمعهم واستحكمت فيهم عادات سيئة لا يمكن إزالتها بسهولة ، ومن هنا يظهر سر قوله تعالى فيما سبق {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ } [المائدة : 79] فصاروا قرناء مع المشركين الذين فقد فيهم العلماء الزهاد وفيهم رذيلة الاستكبار ولا ينفع وجود القلة إذا كان الكثير منهم على ذلك، كما بينه القرآن الكريم ولا سيما في الآيات السابقة { وأكبرهم فاسقون}.
مظهر من مظاهر التواضع للحق وعدم الاستكبار من قوله وبيان لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم لقبول الحق ، والفيض الصباب عن امتلاء ، وفاضت العين بالدمع أي سال دمعها بكثرة إما لامتلائها حتى يتدفق الدمع من جوانبها، أو يراد منها المبالغة أي كأن الأعين ذابت وصارت دمعاً جاريا ، و(من) في قوله تعالى : { من الدمع } للابتداء متعلقة بمحنوف حال من (الدمع) أي حال كونه ناشئاً من معرفة الحق.
وقيل إنها للسبب متعلقة بتفيض وما مصدرية.
ومن في قوله تعالى { من الحق } بيانية لـ ( ما ) بناء على أنها موصولة.
وقيل إنها للتبعيض متعلقة بــ { عرفوا } على معنى أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم ، فكيف لو عرفوه كله ، وهذا يلائم قول من يخص الآية الشريفة بواقعة معينة كالتي ورد في النجاشي وجماعته ، والأول أولى لبيان أن ذلك شأنهم عند سماع القرآن.
وكيف كان فالآية الشريفة تبين خصيصة من خصائص الذين قالوا أنا نصارى التي عرفوا بها وهي الرقة، المعروفة عندهم مما توجب العبرة والاستعبار والدموع الغزيرة فيكون الخطاب عاما.
بيان لمقالهم بعد بيان حالهم من الحق فيقولون عند معرفتهم له
يريدون به إنشاء الإيمان متضرعين لدى الله عز وجل في قبوله وجعلهم ممن شهد على الحق بأنه حق وهي منزلة عظيمة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم في الاعتقاد والعلم والعمل، وقد كان من صفاء سريرة هؤلاء أن عرفوا الحق وتواضعوا له حق التواضع وجرت دموعهم بغزارة عظيمة فرحاً لوصولهم إلى الحق شوقاً إلى الحقيقة والوصول إليها ، فألهمهم الله تعالى أن يطلبوا منه الدخول في زمرة الشاهدين وإن كانوا في بدء إسلامهم وهذا المعنى قد حرم منه قوم الرسول (صلى الله عليه واله) فإنهم لجفوتهم وقساوة قلوبهم وبعدهم عن الحق والحقيقة ولانتفاء المعرفة فيهم مع أن الرسول الكريم (صلى الله عليه واله) بين ظهرانيهم لم يدركوا تلك المعاني السامية التي وصل إليها الذين قالوا أنا نصارى.
تقرير لما سبق ، وتثبيت لإيمانهم باستبعاد ما يوجب انتفاءه مع قيام الداعي فيهم وهو الطمع والانخراط مع الصالحين ، وهذه الأمور مطلوبة في تثبيت الإيمان وتوكيده ، فإن مجرد القول والاعتقاد لا يضمن البقاء لكثرة الشواغل وما يوجب الانصراف وهم في بدء إسلامهم مع ما يرونه من الفتن والامتحان فيحتاج هذا الأمر المهم إلى ما يوجب التوكيد والتثبيت ليضمن به الاستمرار والبقاء وديمومة الإيمان.
وفي مقالهم هذا بيان لسر طلبهم من الله أن يكتبهم من الشاهدين وهو استقرار الإيمان في القلوب وعدم خلوفهم منه ليتم بذلك سبب الشهادة فإنها بمعنى الشهود وهو الحضور ، فإذا لم يستقر الإيمان ولم يستقر القلب عليه وكان متزلزلا فكيف يمكن أن يدخل في زمرة الشاهدين.
ومما ذكرنا تعرف الوجه في الاستفهام فلا يصغى إلى ما قيل فيه ، فراجع.
بيان لرسوخ الإيمان في قلوبهم فطمعوا في الله تعالى أن يجعلهم مع القوم الصالحين وهم الذين خلصت نواياهم من كل شين وصلحت نفوسهم بالفضائل وتزكت أعمالهم باستقامتها وتطابقها لما يرضاه الله تعالى.
والجملة مستأنفة لبيان رسوخ الإيمان بعدما نفوا عنهم ما يوجب عدول الإيمان عنهم وفي الإتيان بلفظ { مع} دلالة على الدخول في مداخلهم والانخراط معهم.
الاثابة المجازاة اي جزاهم الله تعالى ومنحهم من الثواب الجزيل بقولهم الذي عبر عن خلوص واعتقاد راسخ كما دل عليه قوله تعالى : {مما عرفوا} فإن القول إذ اقترن بالمعرفة كما الإيمان ، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة، كما عرفت والجزاء كان عظيماً وهو جنات تجري من تحتها الأنهار ليتم بها البهجة والسرور خالدين فيها أبدا.
أي أن ذلك الأمر الجليل من الثواب الجزيل جزاء كل محسن الذي اعتاد الخير والإحسان ، فيشملهم ذلك الجزاء إما بالمطابقة أو بالأولى ، والآية الشريفة على قبول مناجاتهم مع الله ودعواتهم بذكر اللازم.
بيان للترهيب والوعيد بعد ذكر الوعد والترغيب لتتم المقابلة التي جرت عليها عادة القرآن الكريم وليتم التحذير من المخالفة بعد الترغيب إلى الثواب فإنه بعدما ذكر للمؤمنين من الأجر الجزيل والثناء الجميل ذكر ما أعد للكافرين المكذبين من الجزاء الوبيل فتم ذلك باستيفاء الأقسام وتبين الأشياء.



|
|
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|