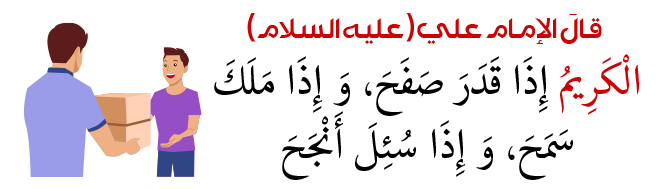
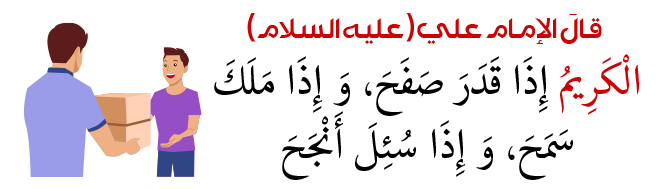

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-09-2014
التاريخ: 3-10-2014
التاريخ: 3-12-2015
التاريخ: 24/9/2022
|
قوله تعالى : {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام : 102] ظاهره و عموم الخلقة لكل شيء و انبساط إيجاده تعالى على كل ما له نصيب من الوجود و التحقق، و قد تكرر هذا اللفظ أعني قوله تعالى : {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد : 16] منه تعالى في كلامه من غير أن يوجد فيه ما يصلح لتخصيصه بوجه من الوجوه قال تعالى : {قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: 16] و قال تعالى : {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [الزمر: 62] .
وقال تعالى { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [غافر: 62].
و قد نشبت بين الباحثين من أهل الملل في هذه المسألة مشاجرات عجيبة يتبعها أقاويل مختلفة حتى من المتكلمين و الفلاسفة من النصارى و اليهود فضلا عن متكلمي الإسلام و فلاسفته، و لا يهمنا المبادرة إلى إيراد أقوالهم و آرائهم و التكلم معهم، و إنما بحثنا هذا قرآني تفسيري لا شغل لنا بغير ما يتحصل به الملخص من نظر القرآن الكريم بالتدبر في أطراف آياته الشريفة.
نجد القرآن الكريم يسلم ما نتسلمه من أن الموضوعات الخارجية و الأشياء الواقعة في دار الوجود كالسماء و كواكبها و نجومها و الأرض و جبالها و وهادها و سهلها و بحرها و برها و عناصرها و معدنياتها و السحاب و الرعد و البرق و الصواعق و المطر و البرد و النجم و الشجر و الحيوان و الإنسان لها آثار و خواص هي أفعالها و هي تنسب إليها نسبة الفعل إلى فاعله و المعلول إلى علته.
و نجده يصدق أن للإنسان كسائر الأنواع الموجودة أفعالا تستند إليه و تقوم به كالأكل و الشرب و المشي و القعود و كالصحة و المرض و النمو و الفهم و الشعور و الفرح و السرور من غير أن يفرق بينه و بين غيره من الأنواع في شيء من ذلك فهو يخبر عن أعماله و يأمره و ينهاه، و لو لا أن له فعلا لم يرجع شيء من ذلك إلى معنى محصل.
فالقرآن يزن الواحد من الإنسان بعين ما نزنه نحن معشر الإنسان في مجتمعنا فنعتقد أن له أفعالا و آثارا منسوبة إليه نؤاخذه في بعض أفعاله التي ترجع بنحو إلى اختياره كالأكل و الشرب و المشي و نصفح عنه فيما لا يرجع إلى اختياره من آثاره القائمة به كالصحة و المرض و الشباب و المشيب و غير ذلك.
فالقرآن ينظم النظام الموجود مثل ما ينتظم عند حواسنا و تؤيده عقولنا بما شفعت به من التجارب، و هو أن أجزاء هذا النظام على اختلاف هوياتها و أنواعها فعالة بأفعالها مؤثرة متأثرة في غيرها و من غيرها و بذلك تلتئم أجزاء النظام الموجود الذي لكل جزء منها ارتباط تام بكل جزء، و هذا هو قانون العلية العام في الأشياء، و هو أن كل ما يجوز له في نفسه أن يوجد و أن لا يوجد فهو إنما يوجد عن غيره فالمعلول ممتنع الوجود مع عدم علته، و قد أمضى القرآن الكريم صحة هذا القانون و عمومه، و لو لم يكن صحيحا أو تخلف في بعض الموارد لم يتم الاستدلال به أصلا، و قد استدل القرآن به على وجود الصانع و وحدانيته و قدرته و علمه و سائر صفاته.
و كما أن المعلول من الأشياء يمتنع وجوده مع عدم علته كذلك يجب وجوده مع وجود علته قضاء لحق الرابطة الوجودية التي بينهما.
و قد أنفذه الله سبحانه في كلامه في موارد كثيرة استدل فيها من طريق ما له من الصفات العليا على ثبوت آثارها و معاليلها كقوله: و هو الواحد القهار و قوله: إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز حكيم، إن الله غفور رحيم و غير ذلك، و استدل أيضا على كثير من الحوادث و الأمور بثبوت أشياء أخرى يستعقب ثبوتها بعدها كقوله : {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ} [يونس: 74] و غير ذلك مما ذكر من أمر المؤمنين و الكافرين و المنافقين و لو جاز أن يتخلف أثر من مؤثره إذا اجتمعت الشرائط اللازمة و ارتفعت الموانع المنافية لم يصح شيء من هذه الحجج و الأدلة البتة.
فالقرآن يسلم حكومة قانون العلية العام في الوجود، و أن لكل شيء من الأشياء الموجودة و عوارضها و لكل حادث من الحوادث الكائنة علة أو مجموع علل بها يجب وجوده و بدونها يمتنع وجوده هذا مما لا ريب فيه في بادئ التدبر.
ثم إنا نجد أن الله سبحانه في كلامه يعمم خلقه على كل ما يصدق عليه شيء من أجزاء الكون قال تعالى: {قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] إلى غير ذلك من الآيات المنقولة آنفا، و هذا ببسط عليته و فاعليته تعالى لكل شيء مع جريان العلية و المعلولية الكونية بينها جميعا كما تقدم بيانه.
و قال تعالى : {الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان : 2] و قال: {الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50] و قال : { الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى } [الأعلى: 2، 3] إلى غير ذلك من الآيات.
و في هذه الآيات نوع آخر من البيان أخذت فيه الأشياء منسوبة إلى الخلقة و أعمالها و أنواع آثارها و حركاتها و سكناتها منسوبة إلى التقدير و الهداية الإلهية فإلى تقديره تعالى تنتهي خصوصيات أعمال الأشياء و آثارها كالإنسان يخطو و يمشي في انتقاله المكاني و الحوت يسبح و الطير يطير بجناحيه قال تعالى: { فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [النور: 45] و الآيات في هذا المعنى كثيرة، فخصوصيات أعمال الأشياء و حدودها و أقدارها تنتهي إليه تعالى، و كذلك الغايات التي تقصدها الأشياء على اختلافها فيها و تشتتها و تفننها إنما تتعين لها و تروم نحوها بالهداية الإلهية التي تصحبها منذ أول وجودها إلى آخره، و ينتهي ذلك إلى تقدير العزيز العليم.
فالأشياء في جواهرها و ذواتها تستند إلى الخلقة الإلهية و حدود وجودها و تحولاتها و غاياتها و أهدافها في مسير وجودها و حياتها كل ذلك ينتهي إلى التقدير المنتهي إلى خصوصيات الخلقة الإلهية و هناك آيات أخرى كثيرة ناطقة بأن أجزاء الكون متصل بعضه ببعض متلائم بعض منه مع بعض متوحدة في الوجود يحكم فيها نظام واحد لا مدبر له إلا الله سبحانه، و هو الذي ربما سمي ببرهان اتصال التدبير.
فهذا ما ينتجه التدبر في كلامه تعالى غير أن هناك جهات أخرى ينبغي للباحث المتدبر أن لا يغفل عنها و هي ثلاث : إحداها : أن من الأشياء ما لا يرتاب في قبحه و شناعته كأنواع الظلم و الفجور التي ينقبض العقل من نسبتها إلى ساحة القدس و الكبرياء و القرآن الكريم أيضا ينزهه تعالى عن كل ظلم و سوء في آيات كثيرة كقوله : {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] و قوله : {قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} [الأعراف: 28] و غير ذلك، و هذا ينافي عموم الخلقة لكل شيء فمن الواجب أن تخصص الآية بهذا المخصص العقلي و الشرعي.
وينتج ذلك أن الأفعال الإنسانية مخلوقة للإنسان و ما وراءه من الأشياء ذواتها و آثارها مخلوقة لله سبحانه.
على أن كون الأفعال الإنسانية مخلوقة له تعالى يبطل كونها عن اختيار الإنسان، و يبطل بذلك نظام الأمر و النهي و الطاعة و المعصية و الثواب و العقاب و إرسال الرسل و إنزال الكتب و تشريع الشرائع.
كذا ذكره جمع من الباحثين.
و قد ذهب على هؤلاء في بحثهم أن يفرقوا بين الأمور الحقيقية التي تنال الوجود و التحقق حقيقة، و الأمور الاعتبارية و الجهات الوضعية التي لا ثبوت لها في الواقع، و إنما اضطر الإنسان إلى تصورها أو التصديق بها حاجة الحياة، و ابتغاء سعادة الوجود بالاجتماع و التمدن فخلطوا بين الجهات الوجودية و العدمية في الأشياء، و قد تقدمت نبذة من هذا البحث في الكلام على الجبر و التفويض في الجزء الأول من الكتاب.
و الذي يناسب المقام من الكلام أن ظاهر قوله: {الله خالق كل شيء} يعمم الخلقة لكل شيء ثم قوله تعالى : {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة: 7] يثبت الحسن لكل ما خلقه الله، و يتحصل من الآيتين أن كل ما يصدق عليه اسم شيء ما خلا الله فهو مخلوق، و أن كل مخلوق فهو متصف بالحسن فالخلق و الحسن متلازمان في الوجود فكل شيء فهو من جهة أنه مخلوق لله أي بتمام واقعيته الخارجية حسن فلو عرض لها عارض السوء و القبح كان من جهة النسب و الإضافات و أمور أخرى غير جهة واقعيته و وجوده الحقيقي الذي ينسب به إلى الله سبحانه و إلى فاعله المعروض له.
و بالجملة الخلقة في عين أنها تعم كل شيء إنما تتعلق بالموضوعات و الأفعال الواقعة في ظرف الاجتماع المعنونة بمختلف عناوينها بجهة تكوينها و واقعيتها الخارجية، و أما ما وراء ذلك من جهات القبح و الحسن و المعصية و الطاعة و سائر الأوصاف و العناوين الاجتماعية الطارئة على الأفعال و الموضوعات فالخلق و الإيجاد لا يتعلق بها، و ليس لها ثبوت إلا في ظرف التشريع أو القضاء الاجتماعي و ساحة الاعتبار و الوضع.
و إذا تبين أن ظرف تحقق الأمر و النهي و انتشاء الحسن و القبح و الطاعة و المعصية و تعلق الثواب و العقاب و ارتباطهما بالفعل و كذا سائر الأمور و العناوين الاجتماعية كالمولوية و العبودية و الرئاسة و المرؤوسية و العزة و الذلة و نحو ذلك غير ظرف التكوين و ساحة الواقعية الخارجية التي يتعلق بها الخلق و الإيجاد ظهر أن عموم الخلقة لكل شيء لا يستلزم شيئا من المفاسد التي ذكروها كبطلان نظام الأمر و النهي و الثواب و العقاب و غير ذلك مما تقدم ذكره.
و كيف يسوغ لمن تدبر كلامه تعالى أن يفتي بمثل هذه الثنوية و كلامه مشحون بأنه خالق كل شيء و أنه الله الواحد القهار و أن قضاءه و قدره و هدايته التكوينية و ربوبيته و تدبيره شامل لكل شيء لا يشذ عنه شاذ، و أن ملكه و سلطانه و إحاطته و كرسيه وسع كل شيء، و أن له ما في السماوات و الأرض و ما ظهر و ما بطن، و كيف يستقيم شيء من هذه التعاليم الإلهية المنبئة عن توحيده في ربوبيته مع وجود ما لا يحصى من مخلوقات غيره خلال مخلوقاته.
الثانية : أن القرآن الكريم إذ ينسب خلق كل شيء إليه تعالى و يحصر العلة الفاعلة فيه كان لازمه إبطال رابطة العلية و المعلولية بين الأشياء فلا مؤثر في الوجود إلا الله، و إنما هي عادته تعالى جرت أن يخلق ما نسميه معلولا عقيب ما نسميه علة من غير أن تكون بينهما رابطة توجب وجود المعلول منهما عقيب العلة فالنار التي تستعقب الحرارة نسبتها إلى الحرارة و البرودة على السواء، و الحرارة نسبتها إلى النار و الثلج على السواء غير أن عادة الله جرت أن يخلق الحرارة عقيب النار و البرودة بعد الثلج من غير أن يكون هناك إيجاب و اقتضاء بوجه أصلا.
و هذا النظر يبطل قانون العلية و المعلولية العام الذي عليه المدار في القضاء العقلي و ببطلانه ينسد باب إثبات الصانع و لا تصل النوبة مع ذلك إلى كتاب إلهي يحتج به على بطلان رابطة العلية و المعلولية بين الأشياء، و كيف يسع أن يبطل القرآن الشريف حكما صريحا عقليا و يعزل العقل عن قضائه؟ و إنما تثبت حقيته و حجيته بالحكم العقلي و القضاء الوجداني، و هو إبطال النتيجة لدليلها الذي لا يؤثر إلا إبطال النتيجة لنفسها.
و هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا من جهة خلطهم بين العلل الطولية و العرضية و إنما يستحيل توارد العلتين على شيء إذا كانتا في عرض واحد لا إذا كانت إحداهما في طول الأخرى، مثال ذلك أن العلة التامة لوجود النار كما توجب وجود النار كذلك توجب وجود الحرارة و لا يجتمع مع ذلك في الحرارة إيجابان و لا تعمل فيها علتان تامتان مستقلتان بل علة معلولة لعلة.
و بتقريب آخر أدق: منشأ الخطأ هو عدم التمييز بين الفاعل بمعنى ما منه و الفاعل بمعنى ما به و لاستقصاء القول في المسألة محل آخر.
الثالثة : و هي قريبة المأخذ من الثانية أنهم لما وجدوا أنه تعالى ينسب خلق كل شيء إلى نفسه، و هو تعالى مع ذلك يسلم وجود رابطة العلية و المعلولية بين الأشياء أنفسها حسبوا أن ما له علة ظاهرة معلومة من الأشياء فهي العلة له دونه تعالى و إلا لزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد و لا يبقى لتأثيره تعالى إلا حدوث الأشياء و بدء وجودها و لذا تراهم يرومون إثبات الصانع من جهة حدوث الأشياء كحدوث الإنسان بعد ما لم يكن و حدوث الأرض بعد ما لم تكن و حدوث العالم بعد ما لم يكن.
و يضيفون إلى ذلك وجود أمور أو حدوث حوادث مجهولة العلل للإنسان كالروح و كالحياة في الإنسان و الحيوان و النبات فإن الإنسان لم يظفر بعلل وجودها بعد، و البسطاء منهم يضيفون إلى ذلك أمثال السحب و الثلوج و الأمطار و ذوات الأذناب و الزلازل و القحط و الغلاء و الأمراض العامة و نحو ذلك مما لا يظهر عللها الطبيعية للأفهام العامية ثم كلما لاح لهم في شيء منها علته الطبيعية انهزموا منه إلى غيره و بدلوا موقفا بآخر أو سلموا للخصم.
و هذا بحسب اللسان العلمي هو أن الوجود الممكن إنما يحتاج إلى الواجب في حدوثه لا في بقائه، و هو الذي يصر عليه جم غفير من أهل الكلام حتى صرح بعضهم: أنه لو جاز العدم على الواجب لم يضر عدمه وجود العالم تعالى الله و تقدس، و هذا - فيما نحسب - رأي إسرائيلي تسرب في أذهان عدة من الباحثين من المسلمين و من فروع ذلك قولهم باستحالة البداء و النسخ، و الرأي جار سار بين الناس مع ذلك.
و كيف كان هو من أردء الأوهام و الاحتجاج القرآني يخالفه فإن الله سبحانه يستدل على وجود الصانع و وحدته بالآيات المشهودة في العالم و هو النظام الجاري في كل نوع من الخليقة و ما يجري عليه في مسير وجوده و أمد حياته من التغير و التحول و الفعل و الانفعال و المنافع التي يستدرها من ذلك و يوصلها إلى غيره كالشمس و القمر و النجوم و طلوعها و غروبها و ما يستجلبه الناس من منافعها و التحولات الفصلية الطارئة على الأرض و البحار و الأنهار و الفلك التي تجري فيها و السحب و الأمطار و ما ينتفع به الإنسان من الحيوان و النبات و ما يجري عليه من الأحوال الطبيعية و التغيرات الكونية من نطفية و جنينية و صباوة و شباب و شيب و هرم و غير ذلك.
و جميع ذلك من الجهات الراجعة إلى الأشياء من حيث بقائها و موضوعاتها علل أعراضها و آثارها و كل مجموع منها في حين علة للمجموع الحاصل بعد ذلك الحين، و حوادث اليوم علل حوادث الغد كما أنها معلولة حوادث الأمس.
و لو كانت الأمور من حيث بقائها مستغنية عن الله سبحانه و استقلت بما يكتنف بها من الحوادث و يطرأ عليها من الآثار و الأعمال لم يستقم شيء من هذه الحجج الباهرة و البراهين القاهرة و ذلك أن احتجاج القرآن بهذه الآيات البينات من جهتين : إحداهما : من جهة الفاعل كما يشير إليه أمثال قوله تعالى : {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [إبراهيم : 10] فإن من الضروري أن شيئا من هذه الموجودات لم يفطر ذاته و لم يوجد نفسه، و لا أوجده شيء آخر مثله فإنه يناظره في الحاجة إلى إيجاد موجد، و لو لم ينته الأمر إلى أمر موجود بذاته لا يقبل طرو العدم عليه لم يوجد في الخارج شيء من هذه الأشياء فهي موجودة بإيجاد الله الذي هو في نفسه حق لا يقبل بطلانا و لا تغيرا بوجه عما هو عليه.
ثم إنها إذا وجدت لم تستغن عنه فليس إيجاد شيء شيئا من قبيل تسخين المسخن مثلا حيث تنصب الحرارة بالانفصال من المسخن إلى المتسخن فيعود المتسخن واجدا للوصف بقي المسخن بعد ذلك أو زال، إذ لو كانت إفاضة الوجود على هذه الوتيرة عاد الوجود المفاض مستقلا بنفسه واجبا بذاته لا يقبل العدم لمكان المناقضة، و هذا هو الذي يعبر عنه الفهم الساذج الفطري بأن الأشياء لو ملكت وجود نفسها و استقلت بوجه عن ربها لم يقبل الهلاك و الفساد فإن من المحال أن يستدعي الشيء بطلان نفسه أو شقاءها.
و هو الذي يستفاد من أمثال قوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص : 88] و قوله : {وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا} [الفرقان : 3] و يدل على ذلك أيضا الآيات الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه هو المالك لكل شيء لا مالك غيره، و أن كل شيء مملوك له لا شأن له إلا المملوكية.
فالأشياء كما تستفيض منه تعالى الوجود في أول كونها و حدوثها كذلك تستفيض منه ذلك في حال بقائها و امتداد كونها و حياتها فلا يزال الشيء موجودا ما يفيض عليه الوجود و إذا انقطع عنه الفيض انمحى رسمه عن لوح الوجود قال تعالى : { كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا } [الإسراء : 20] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
وثانيتهما : من جهة الغايات كما تشير إليه الآيات الواصفة للنظام الجاري في الكون متلائمة أجزاؤه متوافقة أطرافه يضمن سير الواحد منها إيصال الآخر إلى كماله و يتوجه ما وقع في طرف من السلسلة المترتبة إلى إسعاد ما في طرف آخر منها ينتفع فيها الإنسان مثلا بالنظام الجاري في الحيوان و النبات، و النبات مثلا بالنظام الجاري في الأرض و الجو المحيط بها، و تستمد الأرضيات بالسماويات و السماويات بالأرضيات فيعود الجميع ذا نظام متصل واحد يسوق كل نوع من الأنواع إلى ما يسعد به في كونه و يفوز به في وجوده و تأبى الفطرة السليمة و الشعور الحي إلا أن يقضي أن ذلك كله من تقدير عزيز عليم و تدبير حكيم خبير.
و ليس هذا التقدير و التدبير إلا عن فطر ذواتها و إيجاد هوياتها و صوغ أعيانها بضرب كل منها في قالب يقدر له أفعاله و يحصره في ما أريد منه في موطنه و ما يؤول إليه في منازل هيئت على امتداد مسيره، و الذي يقف عليه آخر ما يقف، و هي في جميع هذه المراحل على مراكب الأسباب بين سائق القدر و قائد القضاء.
قال تعالى : {لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ } [الأعراف : 54] ، و قال {أَلَا لَهُ الْحُكْمُ} [الأنعام : 62] و قال : {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة : 148] و قال : {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} [الرعد : 41] و قال : {هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [الرعد : 33].
و كيف يسع لمتدبر في أمثال هذه الآيات أن يعطف واضح معانيها و صريح مضامينها إلى أن الله سبحانه خلق ذوات الأشياء على ما لها من الخصوصيات و الشخصيات ثم اعتزلها و ما كان يسعه إلا أن يعتزل و يرصد فشرع الأشياء في التفاعل و التناظم بما فيها من روح العلية و المعلولية و استقلت في الفعل و الانفعال و خالقها يتأملها في معزله و ينتظر يوم يفنى فيه الكل حتى يجدد لها خلقا جديدا يثيب فيه من استمع لدعوته في حياته الأولى و يعاقب المستكبر المستنكف، و قد صبر على خلافهم طول الزمان غير أنه ربما غضب على بعض ما يشاهده منهم فيعارضهم في مشيتهم، و يمنع من تأثير بعض مكائدهم على نحو المعارضة و الممانعة.
أي أنه تعالى يخرج من مقام الاعتزال في بعض ما تؤدي الأسباب و العلل الكونية المستقلة الجارية إلى خلاف ما يرتضيه، أو لا يؤدي إلى ما يوافق مرضاته فيداخل الأسباب الكونية بإيجاد ما يريده من الحوادث، و ليس يداخل شيئا إلا بإبطال قانون العلية الجاري في المورد إذ لو أوجد ما كان يريده من طريق الأسباب و العلل كان التأثير على مزعمتهم للعلل الكونية دونه تعالى، و هذا هو السر في إصرار هؤلاء على أن المعجزات و خوارق العادات و نحوهما إنما تتحقق بالإرادة الإلهية وحدها و نقض قانون العلية العام، فلا محالة يتم الأمر بنقض السببية الكونية و إبطال قانون العلية و يبطل بذلك أصل قولهم: إن الأشياء مفتقرة إليه تعالى في حدوثها غنية عنه في بقائها.
فهؤلاء القوم لا يسعهم إلا أن يلتزموا أحد أمرين : إما القول بأن العالم على سعته و نظامه الجاري فيه مستقل عن الله سبحانه غير مفتقر إليه أصلا و لا تأثير له تعالى في شيء من أجزائه و لا التحولات الواقعة فيه إلا ما كان من حاجته إليه في أول حدوثه و قد أحدثه فارتفعت الحاجة و انقطعت الخلة .
أو القول بأن الله هو الخالق لكل ما يقع عليه اسم شيء و المفيض له الوجود حال الحدوث و في حال البقاء، و لا غنى عنه تعالى لذات و لا فعل طرفة عين.
و قد عرفت أن البحث القرآني يدفع أول القولين لتعاضد الآيات على بسط الخلقة و السلطة الغيبية على ظاهر الأشياء و باطنها و أولها و آخرها و ذواتها و أفعالها حال حدوثها و حال بقائها جميعا فالمتعين هو الثاني من القولين و البحث العقلي الدقيق يؤيد بحسب النتيجة ما هو المتحصل من الآيات الكريمة.
فقد ظهر من جميع ما تقدم : أن ما يظهر من قوله : { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } [الرعد : 16] على ظاهر عمومه من غير أن يتخصص بمخصص عقلي أو شرعي.



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|