نجد والحجاز قراءة أكاديمية في ذاكرة الحضارة وصراع الهوية
الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي
11/8/2025
التاريخ ليس سردًا جامدًا للأحداث، بل هو شريان الهوية الحيّ الذي يمدّ الحاضر بمعناه، ويحفظ للأمة ملامحها وسط تقلبات الزمان. فمن خلال صفحاته تتشكل خرائط الحضارة، حين تتلاقى الشعوب وتتبادل المعارف، وحين يتصارع البناء والهدم، فيولد من رحم ذلك مزيج يصوغ ملامح العالم. وفي قلب هذه الخرائط، يبرز الحجاز ومكة المكرمة بوصفهما نقطة التقاء فريدة بين ضفتين حضاريتين كبريين أسهمتا في صياغة صورة العالم القديم.
وعلى مرّ العصور، لم يخلُ المشهد من محاولات لتحوير مسار السرد التاريخي، إذ عمدت قوى متعددة إلى إعادة تشكيل الصورة بما يخدم مصالحها، فتارةً تحرف السجلات، وتارةً تفرض روايات تتجاهل الأصول الحقيقية للمجد الذي نشأ في تلك البقعة المباركة. وترافق ذلك مع سعي حثيث لغرس سرديات بديلة في وعي الناس، هدفها قطع الصلة بين الأجيال وجذورها التاريخية.
ومع ذلك، تبقى الحقائق الأصيلة حيّة في الوثائق الموثوقة، وفي الشواهد الأثرية، وفي البنية الثقافية العميقة التي لا يمكن اقتلاعها بسهولة. فالحضارة التي ولدت على هذه الأرض لم تكن ومضة عابرة، بل ثمرة تراكم روحي وثقافي طويل، اجتمع فيه الوحي الإلهي مع إرث الإنسان، ليترك بصمة لا تمحى في مسار التاريخ البشري.
ومن المفارقات أن بعض من يضعون أنفسهم في مصافّ المثقفين، إنما يعانون في حقيقة الأمر من خلل معرفي وفكري عميق. ولأنهم يدركون هذا النقص، يسعون عن وعي أو دونه إلى سده بأساليب ملتوية، فيسخرون أقلامهم لحرف القارئ عن الحقائق الراسخة وتزييف الوعي العام. ويزداد هذا السلوك وضوحًا عند أولئك الذين تلاحقهم عقد متصلة بأصولهم أو أنسابهم، فيستخدمون ما لديهم من أدوات ثقافية وقدرات تعبيرية لا لبناء الوعي، بل لتقويضه، عبر تشويه الحقائق وزرع المفاهيم المضللة.
وقد حفظ لنا التاريخ أمثلة كثيرة لمثل هؤلاء؛ فكم من كاتب في عصور الانحطاط الثقافي سخّر موهبته لتزييف الوقائع خدمةً لنزاعات سلطوية أو أهواء شخصية، كما جرى في بعض البلاطات الملكية حين تحوّل الأدب والشعر إلى أداة للتملق، بدل أن يكون لسانًا للحقيقة. وهي محاولات، مهما اكتست ببلاغة الألفاظ، تبقى هزيلة في جوهرها، تكشف عجز أصحابها أمام بصيرة المجتمع، وتؤكد أن الثقافة حين تفقد نزاهتها، تتحول من منارة إلى أداة تضليل.
وأخطر ما في هذا النهج حين يطال الحقائق التاريخية الثابتة، إذ تتجرأ بعض الأقلام على تزويرها وصياغة روايات بديلة، محاولةً صناعة تاريخ موازٍ يخدم أغراضًا ضيقة. وتبلغ الخطورة ذروتها حين تتبنى مؤسسات الحكم نفسها هذا المسار، فتوفر له الغطاء الرسمي والإمكانات التي تجعل عملية التشويه ممنهجة. لكن هذه الروايات المصطنعة، مهما انتشرت، سرعان ما تتهاوى أمام ميزان البحث التاريخي الجاد، تمامًا كما سقطت دعاوى قديمة عند مواجهة الأدلة النقشية، أو الوثائق المؤرخة، أو شهادات المعاصرين للأحداث. والتاريخ الإسلامي خير شاهد، فقد تهاوت كثير من الروايات الملفقة التي رُوّجت في عصور النزاعات السياسية أمام النقد العلمي والتحقيق المخطوطي.
وقد شهدت الأمة أمثلة صارخة على هذا النوع من التحريف، لعل أبرزها ما مسّ الرسالة المحمدية في عهد الحكمين الأموي والعباسي، حين جرى العبث بجوهر الدين وتقسيمه إلى مذاهب وفرق متناحرة. تم ذلك عبر وضع نصوص مختلقة نُسبت زورًا إلى رسول الله ﷺ، حتى صارت بعض هذه الروايات بما تحويه من تناقضات وإساءات مبطنة جزءًا من الموروث الحديثي المعتمد لدى مختلف الفرق. ومن يطالع كتب الحديث الكبرى سيدرك حجم ما تسلل إليها من أقوال وأفعال غريبة، وهي موجودة بلا استثناء في مصنفات جميع المذاهب.
وحين نعلم أننا لا نملك من صحيح البخاري مخطوطة تعود إلى زمن مؤلفه، وأن أقدم نسخة كاملة ظهرت بعد قرن ونصف من وفاته، أي بعد أربعة قرون من رحيل الرسول ﷺ، وفي قلب حقبة مضطربة سياسيًا ومذهبيًا، يصبح من الطبيعيلمن يلتمس الحقيقة بعين الباحثأن يلتفت إلى مصادر أقرب عهدًا بزمن النبوّة، حيث تقل المسافة وتتضاءل فرص التأثير والتحريف. وهذه الملاحظة لا تخص البخاري وحده، بل تمتد إلى سائر كتب الصحاح التي جُمعت ودُوِّنت في فترات متأخرة، أو في فترات قريبة منها، خاضعة لذات الظروف والسياقات.
بل إن الكتب الحديثية الآخرى التي كتبت في تلك الفترات أو قريبا منها، تعترف بأن الأحاديث الواردة فيها لا تكتسب صفتها القطعية إلا بعد عرضها على كتاب الله تعالى، فتُؤخذ ما وافق كتاب الله، ويردّ ما عارضه. ومن هنا، فإن التقديس الحقيقي لا يجب أن يكون لمن دون الحديث أو من صحّح مصادره، بل التقديس المطلق لكتاب الله وحده.
وقد دفع هذا الواقع علماء الأمة من شتى المدارس إلى ابتكار مناهج صارمة لتمييز الصحيح من السقيم، فظهرت تصنيفات مثل: الصحيح، والحسن، والضعيف، والمتواتر، والمرسل، وغيرها مما لا يحيط بها إلا المتخصصون. ومع ذلك، بقي أثر تلك الروايات الموضوعة عميقًا، إذ غذّت الانقسام المذهبي وأضعفت وحدة الأمة، وحوّلت الرسالة السماوية من نبع هداية جامع إلى ساحة صراع دائم. وتؤكد هذه الحادثة أن تحريف النصوص المقدسة ليس مجرد خطأ علمي، بل جريمة حضارية تستهدف ذاكرة الأمة وهويتها الروحية. وما زال المشهد يتكرر إلى يومنا هذا في أرض نجد والحجاز، منذ أن بسط الأعراب المشكوك في نسب كثير منهم سيطرتهم عليها، مواصلين نهج الإقصاء والتزييف، وممعنين في طمس الملامح الأصيلة لتاريخها وروحها، كما فعل أسلافهم من قبل.
وفي أيامنا هذه، نشهد محاولة جديدة لا تقل خطورة، تتمثل في السعي لتكريس الانتماء الحجازيالنجدي بوصفه الأصل الجامع لكل شيء: من اللغة، إلى الحضارات التي ازدهرت في وادي الرافدين ووادي النيل واليمن. وهو ادعاء يقوم على طمس السياقات التاريخية لهذه المراكز العريقة، وتجاوز الحقائق الموثقة، في مسعى لإعادة تشكيل الوعي الجمعي. ويتم تمرير هذا التشويه عبر المناهج الدراسية بأسلوب يذكّر بالطريقة ذاتها التي حُرِّف بها الإسلام الأصيل في العصور الماضية.
والمفارقة المؤلمة أن الإسلام المطبّق في كثير من تلك الدول اليوم لا يمت بصلة إلى جوهر الرسالة المحمدية القائمة على الرحمة والعدل. فقد نجحت هذه المشاريع مرحليًا في فرض نمط من التدين القائم على التكفير والإقصاء، دينٌ مغذّى بأحاديث موضوعة وأفكار دخيلة، حتى صار بعض الناس لا يرى الحق إلا من خلال منظارها الضيق. ولأجل ذلك، أُنفقت مليارات الدولارات لبناء منظومة فكرية مغلقة أنتجت ويلات وصراعات ما زالت الأمة تدفع ثمنها حتى اللحظة. وهذه الظاهرة ليست سوى فصل جديد من فصول محاولات تزييف الهوية الدينية والتاريخية للأمة، وهي دعوة مفتوحة للباحثين والمفكرين للوقوف بجدية أمام هذا الانحراف وإعادة الاعتبار للحقائق الموثقة.
لنعد بذاكرتنا إلى شخصية من أعظم رموز التوحيد في التاريخ الإنساني، النبي إبراهيم عليه السلام، الذي وُلد في أرض الرافدين، في مدينة أور الكلدانية، إحدى حواضر الحضارة السومرية البابلية المتعاقبة، الواقعة جنوبي العراق قرب موقع محافظة الناصرية اليوم. نشأ إبراهيم في بيئة وثنية تتوزع معتقداتها بين عبادة الأصنام والكواكب والنجوم، وهي ممارسات شائعة في المجتمعات الرافدينية آنذاك. غير أن فطرته السليمة وعقله المتأمل قاداه إلى رفض هذه الطقوس، فدعا قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد.
اقترن دعوته بالفعل، فكسر الأصنام التي كان قومه يعكفون عليها، متحديًا سلطة دينية واجتماعية راسخة. وبلغ الصدام ذروته حين واجه النمرود، أحد ملوك بابل الجبابرة في التاريخ القديم، الذي تروي عنه المصادر والأساطير أنه حكم مملكة واسعة امتدت رقعتها عبر بلاد الرافدين. وتبقى هذه المواجهة بين إبراهيم والنمرود من أبرز الشواهد على صراع التوحيد مع الطغيان السياسي والديني في بدايات التاريخ، وهي قصة خلدتها الكتب السماوية والموروث الإنساني.
جادل إبراهيمُ النمرودَ في وجود الله، وهي القصة التي وثقها القرآن الكريم في مشهد بليغ يخلّد حجة التوحيد أمام جبروت السلطان. ولما عجز النمرود عن مواجهة البرهان، لجأ إلى البطش، فأمر بإحراق إبراهيم، لكن مشيئة الله تعالى جعلت النار بردًا وسلامًا عليه، في حادثة باتت رمزًا لانتصار الحق على الطغيان.
بعد هذه الحادثة، هاجر إبراهيم مع زوجته سارة التي كانت من حَرّان الواقعة في تركيا الحالية وابن أخيه النبي لوط عليه السلام. أقام في حَرّان مدة يدعو قومها إلى عبادة الله، ثم واصل رحلته إلى أرض كنعان (فلسطين)، حيث أسس هناك دعوته للتوحيد. وعندما ضربت المجاعة أرض كنعان، انتقل إلى مصر، فاستقبله ملكها وأكرمه، ويُروى أنه أهدى له جارية قبطية موحدة تُدعى هاجر، لتكون عونًا لزوجته سارة.
عاد إبراهيم إلى فلسطين ومعه سارة وهاجر، وهناك طلبت سارة من زوجها أن يتزوج هاجر، فأنجبت له ابنه البكر إسماعيل عليه السلام، الذي سيغدو شخصية محورية في تاريخ النبوات، وحلقة وصل بين الرسالات الإلهية.
وهكذا، فإن إسماعيل عليه السلام يمتد بجذوره إلى حضارتين عريقتين: حضارة الرافدين من جهة الأب، وحضارة وادي النيل من جهة الأم، كما تؤكد المصادر التاريخية الموثوقة. ثم جاء أمر الله لإبراهيم أن يتوجه إلى الحجاز، ليترك زوجته هاجر وابنه الرضيع في وادٍ مقفر، غَيْرِ ذِي زَرْعٍ.
وعندما نتأمل المشهد القرآني الذي يصور هذه الرحلة، نجد أمامنا لوحة مهيبة تمزج بين قداسة الوحي وملحمة العمران البشري. يقول الخليل في دعائه الخالد: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ [إبراهيم: 37]. كان الوادي جرداء بلا ماء أو نبات، ولا قرية عامرة أو معلم حضاري، صحراء ساكنة تحت لهيب الشمس. وهناك، ترك إبراهيم القادم من أرض الرافدين زوجته هاجر وابنه إسماعيل، فاتحًا فصلًا جديدًا في مسيرة النبوات، ومؤذنًا بتحول سيجعل من قلب الصحراء لاحقًا مركزًا روحيًا وحضاريًا للعالم.
في ذلك العصر، كانت أطراف الجزيرة العربية وحدها تحتضن المراكز الحضارية الكبرى: جنوبها في اليمن حيث مدن سبأ ومعين وحِمير، وشمالها المتصل ببلاد الشام حيث قامت حضارات ثمود والأنباط. أما الحجاز ونجد قبل عهد إسماعيل عليه السلام، فكان صحراء مترامية الأطراف، لا يعرفها الاستقرار البشري إلا عابرًا، إذ كانت تمر بها قوافل طريق البخور في رحلاتها التجارية من اليمن إلى أسواق الشام، فتتوقف أحيانًا عند وجود الماء، ثم تمضي في طريقها. وكان الوادي الذي سيعرف لاحقًا باسم مكة مجرد محطة عابرة لا أكثر.
في هذا الوادي نشأ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ولم يكن في طفولته يتحدث العربية، فأصل أبيه من العراق، ولسان أمه القبطية هاجر كان غير عربي. لكن المشهد تبدل حين فجّر الله عين زمزم تحت قدميه، فكان ذلك حدثًا مفصليًا في تاريخ الحجاز ونجد. ساق القدر إلى مكة قبيلة جرهم، من العرب العاربة القادمين من اليمن، فاستأذنوا هاجر أن يجاوروها عند الماء.
هنا بدأ التحول الحضاري: نشأ إسماعيل بين أبناء جرهم، يسمع لغتهم ويخالطهم ويتشرّب فصاحتهم، حتى برع عليهم في البيان، فصار أول من نطق بالعربية الفصحى من غير العرب، وهو لم يتجاوز العاشرة. ومن نسله، عبر جدّه الأعلى عدنان، عُرفت العرب المستعربة، الذين جمعوا بين إرث النسب وروح الحضارات التي وفدوا منها.
ومن هنا تبدأ الحكاية الكبرى: فقد أصبح إسماعيل عليه السلام جسرًا حضاريًا وروحيًا بين إرث أبيه النبوي القادم من أرض الرافدين، وإرث العرب الأصيل القادم من اليمن، جامعًا بين صفاء العقيدة وبلاغة اللسان. ومن نسله انبثقت قبائل العرب المستعربة، حتى خرجت منهم قبيلة قريش، ومن بطونها جاء محمد ﷺ الذي أُنزل عليه القرآن بلسان عربي مبين، فوحّد برسالته أمةً فرّقتها العادات والمصالح.
وعند ذكر قريش، تبرز نقطة بالغة الأهمية، وهي أن هذه القبيلة في أصلها الخالص تنتسب إلى بني هاشم. أما إقحام بني أمية ضمن النسب القرشي فلم يكن حقيقة راسخة في الموروث التاريخي المبكر، بل ظهر لاحقًا في ظل الدولة الأموية، كجزء من عملية أوسع لتشكيل هوية تاريخية تخدم شرعية الحكم. وإذا عدنا إلى المصادر الموثوقة، بعيدًا عن ما دوّن تحت تأثير السلطة الأموية أو في مراحل لاحقة متأثرة بها، سنجد حقائق مختلفة تمامًا عن أصول بني أمية، حقائق تتطلب قراءة دقيقة ونقدية لسلاسل الأنساب والنصوص التراثية.
تورد بعض المصادر المعتبرة روايات مغايرة لما اشتهر في كتب التاريخ التي تأثرت بالتدوين الأموي، إذ تشير إلى أن أمية بن عبد شمس لم يكن عربيًا قرشيًا خالص النسب، بل كان عبدًا ذا أصل رومي، تبناه عبد شمس بعد أن أعتقه، على عادة بعض القبائل في الجاهلية بضم الموالي وإلحاقهم بأنسابها.
ففي بحار الأنوار للعلامة المجلسي (ج31، ص530) جاء: أمية لم يكن من صُلب عبد شمس وإنما هو من الروم، فاستلحقه عبد شمس فنسبه إليه، فبنو أمية كلهم ليسوا من صميم قريش، وإنما هم يُلحقون بهم. ويستشهد المجلسي بقول الإمام علي عليه السلام: ليس المهاجر كالطليق، وليس الصريح كاللصيق، إشارةً إلى أن نسبهم ملصق بقريش وليس أصيلًا فيه.
وفي كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي (ج1، ص76) ورد أن عبد شمس تبنّى غلامًا روميًا يدعى "أمية" بعد أن أعتقه، فصار يُعرف بـ"أمية بن عبد شمس"، ومنه انحدر نسل بني أمية. وينقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (ج4، ص11) ما يؤيد هذا المعنى، موضحًا أن الإمام علي عليه السلام كان يصفهم بـ"اللصيق" لا "الصريح" في النسب.
وبحسب هذه الشهادات، فإن بني أمية وفق منظور تلك المصادر لا يُعدّون من السابقين الاولين الذين امتدحهم القرآن، بل هم أقرب إلى ما وصفه تعالى بقوله: الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا [التوبة: 97]، أي أنهم دخلاء على النسب القرشي الأصيل بالتبني. وهذا التفسير ينسجم في سياق تلك الروايات مع مواقفهم الحادة تجاه النبي ﷺ وأهل بيته، بدءًا من قيادتهم جيوش المشركين في بدر وأحد، وصولًا إلى استيلائهم على الخلافة وما صاحبها من ظلم وجور ترك أثره العميق في تاريخ الأمة.
نعود إلى الحكاية اللغوية لإسماعيل عليه السلام، فهي مرتبطة أوثق ارتباط بالجغرافيا الكبرى للتاريخ. فالعراق كان موطن إبراهيم الخليل، ومن أرضه انطلقت الشرارة الإيمانية الأولى، واليمن كانت مهد العرب العاربة الذين حملوا اللغة العربية إلى مكة عبر قبيلة جرهم. ومن هذا التلاقي، صارت العربية ثمرة حضارتين عريقتين: حضارة الرافدين التي أنجبت النبوة والرسالة، وحضارة اليمن التي أورثت اللسان والفصاحة، ليلتقي الإرثان في مكة، حيث أصبحت العربية لسان الوحي ووعاء حضارة خالدة.
ومن رحم هذا اللقاء، وُلدت الحضارة المكية التي امتد إشعاعها في الحجاز ونجد، حتى غدت قلب الجزيرة النابض وموئل الحجيج من كل فج عميق، بعدما كانت صحراء قاحلة بلا ماء ولا عمران. وفي تلك العصور، كان البدو الرحّل وهم قلة يجوبون الفيافي بحثًا عن الماء، حتى اضطر بعضهم، في ظروف القحط الشديد، إلى استخدام أبوال الإبل لغسل الأيدي والوجوه، بل وشربه عند الضرورة القصوى. واليوم، ورغم ما طرأ على أحفاد تلك القبائل من مظاهر التمدن والرفاه المادي، بل والانغماس في أنماط من الترف الماجن، ما زال بعضهم يمارس شرب بول الإبل تحت مسميات مختلفة، منها ما يُسوَّق على أنه علاج، في مشهد يكشف استمرار بعض الموروثات القديمة في ثوب جديد.
ومن الحقائق التي لا تطمسها الادعاءات ولا يمحوها التزوير، أن الحضارة التي ازدهرت في الحجاز ونجد لم تنشأ من فراغ، ولم تتشكل من جذور طارئة، بل كانت ثمرة التقاء منبعين عظيمين من منابع التاريخ الإنساني: وادي الرافدين، حيث بزغ فجر النبوة الإبراهيمية، واليمن، حيث تبلورت العروبة في أبهى صورها اللغوية والثقافية. ومن لم تمتد جذوره إلى أحد هذين المنبعين، فلا يحق له أن يدّعي دور المؤسس أو مصدر المجد، لأن هذا الإرث الحضاري ميراث تاريخي متجذر في أرضين أنجبتا الرسالة واللسان، واجتمعتا في مكة لتغيّرا مجرى التاريخ، وتحولا تلك البقعة الجرداء إلى مركز إشعاع روحي وثقافي للعالم كله.
مرّت على بني هاشم بعد رحيل رسول الله ﷺ فترات عصيبة اتسمت بالاضطهاد والمضايقات، خصوصًا من بعض الأعراب الذين أظهروا الإسلام ولم يخالط الإيمان قلوبهم، وفي مقدمتهم بنو أمية. وقد شهد التاريخ محطات مفصلية في هذا الصراع، أبرزها قرار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام العودة إلى أرض أجداده في بلاد الرافدين، ونقل عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة المنورة إلى الكوفة، لتكون قاعدة لقيادته السياسية والعسكرية في مواجهة الأعراب من بني أمية على أرض العراق.
وتكرر المشهد مع سبطه الإمام الحسين عليه السلام، الذي رفض مبايعة يزيد بن معاوية، مفضّلًا العودة إلى أرض أجداده بعد أن تلقى رسائل من أهل العراق تدعوه لنصرتهم. لكن جيوش الأمويين القادمة من الشام شنت عليه حربًا ضروسًا انتهت بمأساة كربلاء الخالدة، التي ما زالت الأمة تستحضرها في وجدانها وطقوسها حتى يومنا هذا.
واستمر حضور بني هاشم في أرض الرافدين بعد تلك الأحداث، حيث عاشوا فيها ودفنوا في ربوعها: من بينهم أبو الفضل العباس وستة عشر من أهل بيت الحسين في كربلاء، والإمام موسى الكاظم والإمام محمد الجواد في الكاظمية، والإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري في سامراء، وفيها أيضًا كانت غيبة الإمام المهدي عليه السلام. وهنا يجدر تصحيح مفهوم شائع تتناقله وسائل الإعلام، وهو قولهم إن بني هاشم "هاجروا" من الجزيرة إلى العراق. والصحيح أن نقول: إنهم عادوا إلى أرض أجدادهم في الرافدين، إذ كان وجودهم في الحجاز أشبه بإقامة المهاجرين إليها، وفق الإرادة الإلهية التي قضت بهجرتهم إليها في مرحلة معينة من التاريخ.
كما اختار العباسيون وهم من بني هاشم إقامة دولتهم في أرض الأجداد، فجعلوا من بغداد منطلقًا للحضارة العباسية التي بلغت ذروة مجدها العلمي والثقافي. ومع استمرار حملات الاضطهاد ضد الهاشميين في الحجاز ونجد على مدى القرون، عاد معظمهم إلى العراق وإلى مدن الري في إيران حاليًا، ولم يبقَ في الحجاز إلا قلة قليلة، بينما أحكم الأعراب سيطرتهم على الحرمين الشريفين، وانتهكوا حرماتهما، وبثوا الفساد في أرض الحجاز.
وليس غريبًا، في زمن تختلط فيه الحقائق بالأهواء، أن ترتفع أصوات مجهولي النسب وأصحاب المصالح العابرة، ومن لا يزالون يرددون عادات البداوة في ثوب جديد، محاولين الاستحواذ على هذا الإرث العظيم وتشويه تاريخ مكة والحجاز. إنهم يستغلون الجهل والضبابية، ويعملون على طمس ملامحها الروحية والنضالية، لينسبوها إلى أنساب لا صلة لها بالأرض ولا بالشجر ولا بالإنسان الذي خط بقدميه رمالها، وسقاها بعرقه ودمه عبر القرون.
لكن هؤلاء، مهما علت أصواتهم وكثرت دعاواهم، لن يغيروا حقائق التاريخ، ولن يمحوا شهادة القرآن الكريم، ولن ينالوا من عظمة الحضارة التي نسجتها دماء الأنبياء وصاغتها ألسنة العرب الأوائل. ستظل مكة شامخة كما كانت، تاجًا يزين رؤوس كل من تمتد جذوره المباركة إلى منبعيها الخالدين: أرض الرافدين واليمن. فصناع الحضارة لا يطأطئون رؤوسهم ولا يستجدون الاعتراف، أما من يحاول سرقة حضارة غيره ونسبها لنفسه، فإنه يكشف بفعلته عن هشاشة أصله وضعف حجته.
إن التاريخ، مهما حاول المزورون العبث به، يظل عصيًا على التحريف ما دام في الأمة من يحفظه ويدافع عنه بالحجة والبرهان. لقد رأينا كيف تشكلت حضارة الحجاز من تزاوج إرثين عظيمين: إرث وادي الرافدين، حيث بزغت النبوة الإبراهيمية، وإرث اليمن، حيث وُلدت العروبة في أبهى صورها. ومن هذا التلاقي التاريخي وُلدت مكة لتكون قلب الجزيرة النابض وموئل الوحي ومنارة هداية للعالمين.
وعلى مر القرون، حاولت قوى سياسية وقبلية وشخصية أن تنتحل هذا الإرث وتنسبه لأنساب دخيلة لا تمت إلى جذوره المباركة بصلة. ومع ذلك، لم تنجح هذه المحاولات في محو الحقائق التي توثقها النصوص القرآنية، والمصادر التاريخية المعتبرة، وسير الأعلام الصادقين.
إن حماية هذا الإرث ليست دفاعًا عن الماضي فحسب، بل هي صون لجوهر الهوية العربية والإسلامية، وضمان لاستمرار الوعي الأصيل الذي بُني على تضحية الأنبياء ومواقف المصلحين. ومكة، بما تمثله من رمزية روحية وتاريخية، ستظل شامخة في وجدان الأمة، عصية على التزييف، باقية ما بقيت الكلمة الصادقة والرواية الأمينة والأجيال التي تحفظ العهد وتحمل الأمانة. وليس غريبًا اليوم أن يكون أبناء الرافدين هم الجبهة المتقدمة في الدفاع عن الإسلام الأصيل، متمسكين بالنهج المحمدي الذي نقله آل البيت والأئمة المعصومون، ورافضين كل ما أُلصق به من تزوير على يد أعراب بني أمية وأحفادهم.

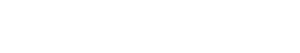

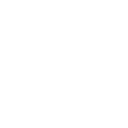


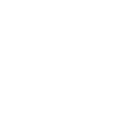














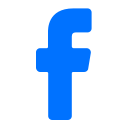

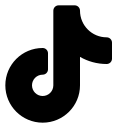





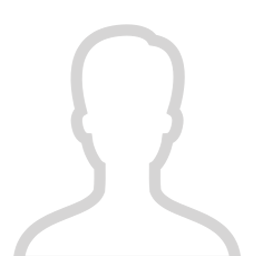


.png) وائل الوائلي
وائل الوائلي .png) منذ 1 يوم
منذ 1 يوم 




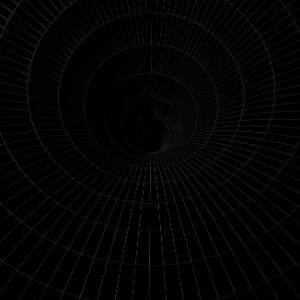





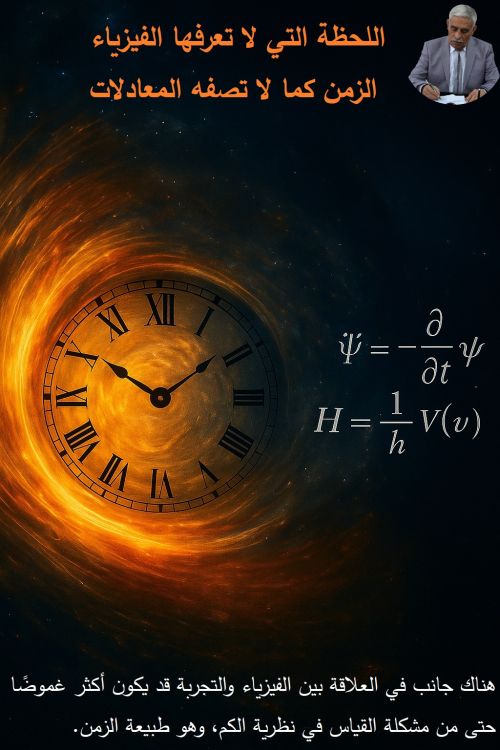
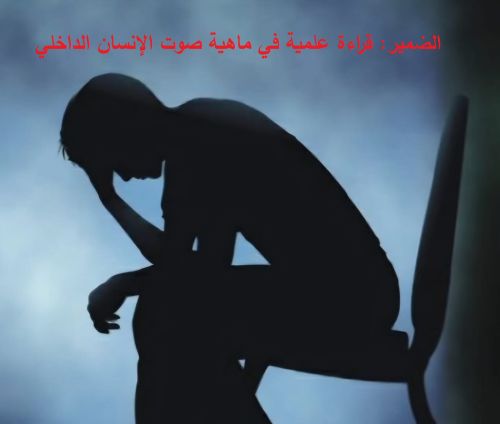



 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى) EN
EN