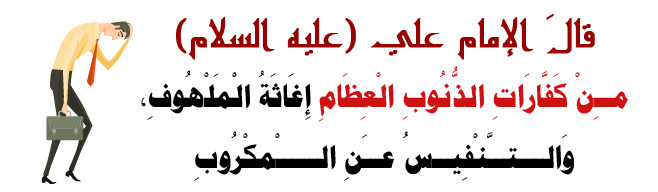
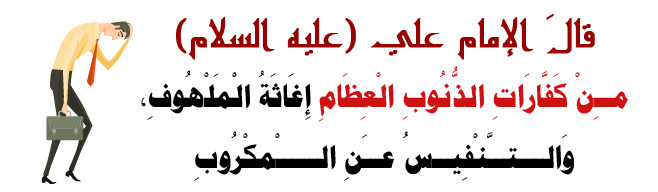

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2018
التاريخ: 29-4-2018
التاريخ: 25-4-2018
التاريخ: 26-4-2018
|
دور الدلالة في الترجمة
عرض كثير من الباحثين لمشكلة الترجمة وقصورها عن تصوير كل ما بتضمنه النص المترجم من أفكار وأخيلة وجمال لفظي. وأحسن القائمون بعملية لترجمة في كل عصور التاريخ بتلك الصعوبات التي تصادفهم، ووقفوا علي بعض أسرارها، ولكنهم مع هذا لم ينصرفوا عن الترجمة، بل ظلوا يتابعون جهودهم جيلا بعد جيل وعصراً بعد عصر، فيوفقون حيناً ويخفقون أحياناً. ذلك لأن الأمم والشعوب قد رأت منذ القدم حاجتها الملحة في اتصال بعضها ببعض، وفي تبادل الثقافة كما تتبادل السلع. ثم تبين للمفكرين في الأمم أن تبادل الثقافة يحول دونه حصون منيعة قصلت بين بني الإنسان. وتلك هي التي نسميها باللغات. فأداة التفكير تختلف من أمة إلي أخري، وقد نتسع مسافة الخلف حتي ليخيل إلينا أن الاتصال عسير أو مستحيل، وقد تقرب فيراها الباحث هينة يسيرة.
وقد استطاع دارسو اللغات البشرية ، أن يقسموها لنا في صورة فصائل أو أسر، وتتضمن كل فصيلة، عدداً من اللغات التي تنتمي إلي أرومة واحدة وأصل واحد، ولذا تشابهت في كثير من عناصرها، فأمكنت الرحلة بين فروعها دون عناء كبير. أما حين كانت الرحلة بين لغة من فصيلة، وأخري من غير فصيلتها فقد كان العنت والمشقة.
وأولئك الذين حاولوا التطلع إلي ما وراء تلك الحصون التي ندعوها باللغات نفر قليل من الناس في كل أمة، بل في كل عصر. وهم الذين قربوا بين الشعوب، ووصلوا الإنسان بأخيه الإنسان، رغبة في تبادل النافع والمعارف، عسي أن يتكون من الناس جميعاً مجتمع إنساني يسوده التعاون والتفاهم.
وقد عرف أصحاب الدنيات البشرية القديمة شدة حاجتهم إلي الترجمة ولسوا معها صعوبة الانتقال بأفكار الصبن وحكمتهم إلي بيئة اليونان، أو إلى بيئة المصريين القدماء. لأن اللغة الصينية واليونانية والمصرية القديمة تلتمي إلي فصائل لغوية متباينة.
ص131
وجاء العرب فحاولوا فقل فلسفة اليونان و علو مهم إلي اللغة العربية فصادفوا المشقة والعسر، ولم يحقق النجاح منهم إلا القليل، لأن أكثر المترجمين في العصر العربي نقلوا آثار اليونان عن السريانية لا عن لغتها الأصلية، مما جعل السيرافي يتشكك في صحة هذا النقل، ويثير تلك المحاورة الطريفة (1) التي كانت بينه و بين «يونس بن متي» في حضرة الوزير ابن الفرات المتوفي سنة 320 هـ .
فالسيرافي أحد علماء العربية في القرن الثالث الهجري، وممن عاصروا المترجمين الذين اضطلعوا بنقل علوم اليونان و فلسفتهم. ونلحظ في تلك المناظرة التي سجلها أبو حيان التوحيدي في رسالته ثورة السيرافي علي ترجمة «يونس بن متي» وشكه في صحتها، فهو يتحفظ في الترجمة عامة ويخاطب يونس بقوله [علي أن هناك صرا ما علق بك ولا أسفر ل.. تلك ، وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخري من جميع جهاتها بحدود صفاتها ، في أسمائها وأفعالها، وصروفها وتأليفها وتقديمها وتأخيرها واستعارتها و تحقيقها .. إلخ].
وهكذا نري أن مشا كل الترجمة كانت موضوع مدارسة ومناظرة بين القدماء كما هي بين المحدثين. وقد زاده دراسة وتفصيلا عبد القاهر الجرجاني منذ ما يقرب من تسعة قرون في كتابه «أسرار البلاغة (2) »، وخرج علي الناس بنظريته في
الترجمة التي يحدثنا فيها عن أن العرب تعرف أجراء الجسم في الإنسان والحيوان معرفة تامة ، وقد وضعت لكل جزء منها لفظاً خاصا، فالشفة في الإنسان هي «المشفر» للبعير «والجحفلة» للفرس. وهذه فروق ربما وجدت في غير لغة العرب وربما لم توجد. ويري عبدالقاهر أن بعضاً من الشعراء والرجاز قد استعملوا بعض هذه االألفاظ مكان البعض الآخر. وأحد... لفظة منها محل لفظة أخري، متأثرين بالإنشاد والانفعال ، دون أن يهدف عملهم هذا إلي نكتة بلاغية. أو زيادة في تصوير. فقد استعمل السجاج كلمة «المرسن» وهي للبعبر ووصف بها «انف المرأة» في قوله [وفاهما ومرسنا مسرحا] ، واستعمل شاعر آخر كلمة «الجحفل» التي تعني شفة الفرس في وصف ناقته بأن للماء صوتاً مسموعا عند نزوله ما بين مشفرها وبين وريديها كأنه صوت مبرد الحداد فقال:
تسمع للما كصوت المحل بين وريديها وبين الجحفل
ص132
ووصف ثالث «صغار الإبل» بأنها «حفان» وهذه حاصة بصغار النعام، وأطلق رابع كلمة «الشفة» الخاصة بالإنسان علي «جحفلة» الفرس. ويعتبر عبد القاهر مثل هذه الاستعمالات من الاستعارات غير المفيدة التي لا تعدو أن تكون توسعاً في اللغة ، وليس من الضروري أن يكون في غير لغة العرب، بل هو خاصة من خواص اللغة العربية، ولا يصح أن تنقل كما هي في لغة أخري. فالفارسي مثلا إذا أراد أن يترجم إلي لغته نصا من النصوص السابقة وجب أن ينقله بالمعني؛ أي بالكلمة العامة التي تدل علي «الشفة» لا بالمكلمة الخاصة التي تدل علي نوع الحيوان.
أما الاستعارة المفيدة كأن تصف رجلا بأنه «أسد» ، أو طائرة بأنها «عقاب أو نسر» كما في قول شوقي:
أعقاب في عنان الجو لاح أصحاب فر من هوج الرياح
فهنا يري «عبد القاهر» وجوب النقل باللفظ ومراعاة الاستعارة. فهو يري في نقل الاستعارة غير المفيدة بلفظها مجالا للسخرية والضحك في حين أنه يري دن نقل الاستعارة المفيدة بمعناها حرماناً من نكتة بلاغية. ويعبر عن هذا بقوله [فعرف اللغة وطرقها الخاصة يترجم بالمعني، أما هذه الاستعارة المفيدة والتشبيه المفيد والكناية المفيدة فتنقل كما هي من لغتها المترجم منها إلي اللغة المترجم إليها ، فقلا لفظيا علي طريق الاستعارة أو التشبيه أو المجاز، وإلا فقدت جمالها وبلاغتها].
فعبد القاهر الجرجاني وهو فارسي الأصل و على علم باللفتين العربية والفارسية ولعله مارس الترجمة بين اللغتين فاتضحت له تلك المشاكل التي تصادف المترجمين، يحاول أن يضع لنا نهجا عاما يلتزمه المترجم ولا يحيد عنه.
وفي الحديث عن مشاكل الترجمة لا يصح أن تقحم ضعف المترجم في اللغة التي يترجم منها أو التي يترجم إليها، إذ لا يسمي المترجم مترجماً حقاً إلا حين يسيطر علي اللغتين كتابة وفراءة كذلك يحدر بنا أن نفترض إخلاص المترجم في عمله وحسن نيته. وأنه حين أخرج النص المترجم .. فإنه قد بذل الجهد و تحري الصواب ولم يكن متأثر بمذهب خاص يصبغ ترجمته بصبغة خاصة، أي أن للترجمة مشاكل وصعوبات حتي مع إتقان المترجم للغتين، وأمانته وإخلاصه في عمله.
ومن تلك الصعوبات ما نسميه بهندسة الجملة فاللغات تختلف في النظام الذي تخضع له الجمل في تركيب كلماتها، وعلاقة كل كلمة بالأخرى، فالفعل مكان خاص من الجملة، وللفاعل مكان اخر، وله مفعول مكان ثالث وهكذا.
ص133
وقد يضطر المترجم إلي التقديم أو التأخي ، وإلي عملية تنظيمية خاصة حتي تبدو ترجمته جارية علي المنهج المألوف في اللغة المترجم إليها. كذلك من صعوبات الترجمة كل ما يتعلق بجمال الألفاظ وموسيقاها. فقد يوثر الكاتب لفظاً علي آخر لا لشيء سوي أن اللفظ له رنة رتيبة في أذن الكاتب والسامع. أو لأنه ينسجم مع ما سبقه من ألفاظ أو ما يليه منها، فتتكون من عباراته وجمله سلسلة من الأصوات اللغوية المنسجمة التي لا تنبو في الآذان والأسماع. وتلك هي الصفة التي نفتقدها في كل ترجمة، ولا سيما في ترجمة الألفاظ العربية.
فاللغة العربية من اللغات التي عنيت بموسيقي ألفاظها وعباراتها في كل العصور. فلها مما يسمي بالمحسنات اللفظية فنون و فنون، تعرض لها المطولات من كتب البلاغة العربية، وتسوق لها شواهد كثيرة من النظم والنثر. وبلغ تفنن الكتاب والشعراء والخطباء في تلك العناية اللفظية أن وضع لها المتأخرون من دارسي البلاغة قواعد ونظما أو شكت أن تصبح علما مستقلا من علوم اللغة العربية هو ما يطلق عليه «البديع» . ومن أشهر فنون البديع ما يسمي بالجناس كقول رجل للمأمون بتظلم من عامل له (3) : [يا امير المؤمنين ما ترك لي فضة إلا فضها، ولا ذهبا إلا ذهب به، ولا غلة إلا غلها، ولا ضيعة إلا أضاعها، ولا عرضا إلا عرض له. ولا ماشية إلا امتشها، ولا جليلا إلا أجلاه] . ويقال إن المأمون قد عجب من فصاحته وقضى حاجته !
فكيف السبيل إلي ترجمة مثل هذا الكلام وهو كثير في اللغة العربية، وأي موقف يمكن أن يلتزمه المترجم حين تعرض له تلك المحسنات اللفظية التي قصدها الأدباء ، وعمدوا إليها لتزيين آدابهم، وجعلها تتصف بالروعة والجمال؟
وليس يعنينا هنا علي كل حال البحث في هاتين المشكلتين، مشكلة هندسة الجمل، ومشكلة الجمال اللفظي، وإنما الذي نهدف إليه من هذا الفصل هو تلك المشكلة الكبرى في الترجمة. وهي التي تقصل بدلالة الكلمات وحدود معانيها بين لغة وأخرى. ذلك لأن الكلمات تكتسب دلالتها في كل لغة بعد تجارب كثيرة من الأحداث الاجتماعية التي يمر بها المرء، وترتبط الكلمة في ذهن كل منا بتلك الأحداث ارتباطاً وثيقاً، فتتلون دلالتها بها، وتظلل تلك الدلالة بالتجارب الخاصة للإنسان في حياته. وهي لدي فرد من البيئة الاجتماعية توحي بظلال من الدلالة قد لا تخطر في ذهن
ص134
آخر من نفس البيئة. لأن تجاربهما مع الكلمة مختلفة، ونظرة كل منهما لها متباينة، تبعا لتلك الأحداث التي ارتبطت بها في حياتهما. غير أن هناك قدرا مشتركا لدلالة الكلمات في كل بيئته ، هو الذي علي أساسه يكون التعامل بالكلمات، وعلي مستواه يكون التفاهم بين الأفراد.
فإذا تغيرت الكلمة وخرجت من بيئتها الاجتماعية إلي بيئة أخري، أي إلي لغة أخري، احتاج المترجم إلي جهد للحصول علي ما يناطرها أو يرادفها في دلالتها، لتودي في ذهن السامع الجديد في البيئة الجديدة نفس الدلالة، أو ما يقرب منها في بيئتها الأصلية. وهنا يمكن أن يقال إن المترجم قد وفق في مهمته، وأعطي صورة صحيحة لدلالة الكلمة.
وعلى قدر شيوع الكلمة في البيئة الاجتماعية، وعلي قد ما تمر به من تجارب في الأحداث الدنيوية، تكتسب تلك الظلال الدلالية، وتترامي حدودها، وتتضح صورتها في الأذهان، ويقال عن الكلمة حينئذ إن دلالتها واضحة قوية لا غموض فيها ولا إبهام، فلا تكاد الأذن تتلقفها حتي يخطر في الذهن لها صورة بارزة العالم والحدود، تضطرب لها النفوس، وتتفعل العواطف. وهذا هو السر في أن بعض الكلمات ذات الدلالات المنفردة يتحايل عليها الناس في كل بيئة باصطناع ألفاظ قليلة الشيوع أو ألفاظ أجنبية عن اللغة، رغبة في أن تصبح الصورة مغطاة بستار رقيق يخفي شيئاً من معالمها، ويقلل من وضوحها، فلا تخدش الحياء، ولا تبعث علي النفور والاشمئزاز. وتتضح هذه الظاهرة في الكلمات المعبرة عن أعضاء التناسل، والعملية الجنسية وألفاظ الموت والأمراض والكوارث وغيرها. مما يكني عنه بألفاظ أخري بعد زمن معين.
ودلالة الكلمات في مجال الأفكار وفي النشاط العلمي تلتزم عادة حدوداً لا تكاد تتعداها، فهي بين أصحاب الفكر وذوي الثقافات المتشابهة، متماثلة أو متقاربة في دلالاتها، ولا سيما حين تعرض تلك الكلمات لظواهر الطبيعة والأحوال الكونية في العالم. ولذا يقال دائما إن ترجمة العلوم أيسر وأسهل، لأن دلالة الألفاظ فيها محدودة مضبوطة، وليست محل جدل أو نزاع في غالب. الأحيان. فأهم ما يعني به صاحب العلم هو الفكرة والنظرة الموضوعية، دون تأثر بشعور فردي دو بعاطفة شخصية.
أما في ترجمة النصوص الأدبية فالمشكلة أشد عسراً، وأصعب منالا. ذلك لان الآداب تعتمد علي التصوير والعاطفة، والتأثير والانفعال، إلي جانب ما يمكن أن تشتمل عليه من أفكار. ولا يكون الأدب أدبا إلا بخروج الكلمات عن دلالتها اللغوية، وشحنها يقيض من الصور والأخيلة. ومترجم الأدب لا يقنع عادة إلا بترجمة أدبية
ص135
تبرز نواحي الجمال في النص المترجم كي يتذوق القارئ أكبر قدر ممكن من جمال النص الأصلي، ويقف علي عناصر المهارة فيه.
وليست ترجمة الآداب بمستحيلة أو فوق طاقة البشر، غير أنها تحتاج إلي الجهد والمثابرة ، وتتوقف إلي حد كبير علي السيطرة والقوة في اللغتين. وقد عبر أحد الدارسين من المحدثين عن هذا بقوله [إن لغة كل أمة وبخاصة اللغة الأدبية متحملة بعواطف خاصة قد لا تدركها الألفاظ، ولكن يدركها الأديب وحده. وكثيرا ما نقف أمام نص من النصوص وقفه المتردد الذي يتمي لو أنه راي الاديب فيسأله عما اراد بهذا النص، وبود أن لو كان حيا ليسأله عما يريد، بل هو يرجع بذهنه مستعرضا ظروف الأديب، نافخا فيه الحياة من جديد ليسأله عما يريد! ذلك أن من المعاني ما لايزال في بطن الشاعر كما يقولون، لا نعثر عليه إلا بالجهد، وإلا بعد أن نتصرف علي قاموسه و نفسيته، ومقدار احترامه لمدلولات الألفاظ، ومقدار جرأته في الخروج عليها (1) ] .
فإذا كان هذا هو الشأن في النصوص الأدبية التي هي من خلق الشعراء والكتاب ، وهم ليسوا إلا طبقة موهوبة من الناس والبشر، فماذا يكون موقف المترجم إزاء النصوص الدينية المقدسة التي لا يقف أثرها عند عاطفة عبارة ، أو انفعال وقتي، بل هي تسيطر علي العقول والقلوب. وتحاط تلك النصوص الدينية عادة بهالة من القداسة والطهر تسمو بها فوق مستوي الإنسان.
من أجل هذا لم يكن من الغريب أن بتحرج أمهر المترجمين في نقل هذه النصوص المقدسة إلى لغة أخرى، لا عن تزمت أو تاثم تدفعهم إليه العاطفة الدينية وحدها، بل لأنهم رأوها من الآداب في الذروة العليا إذا تسامت، فخشوا أن يزيفوها، أو يخلطوا في تراكيبها ووصلات أجزائها.
وظل هذا الشعور يلازم الكتاب في كل العصور حتي أيامنا هذه. إذ يري جمهور المفكرين في كل زمان أن نقل تلك النصوص الدينية أشبه بنقل الزهرة من منيتها قد يعرضها للجفاف ونضب العبير، وأنه من واجب القارئ أن يتعرف علي النص الديني في بيئته ، فمن العسير أن يتذوقه في غير لغته كتذوق أصحاب اللغة له، فهو منا لسمو والإعجاز بحيث إذا أراك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنما قد جسمت حتي رأتها العيون. وإن شاء لطف الأوصاف الجسمانية حتي تعود روحانية لا تنالها الظنون (4)
ص136
ولنا في قصة الترجمة السبعينية للعهد القديم مثل طيب يرينا كيف اختلفت الآراء في ترجمة النصوص الدينية للتوراة وكتب الأنبياء.
وأول ذكر لهذه الترجمة ما ورد في كتابات أحد أجبار اليهود في القرن الثاني قبل الميلاد، ثم شاع أمر هذه الترجمة بين اليهود أولا، ثم بين المسيحيين بعد ذلك. وقد اضطربت الروايات التاريخية بعض الاضطراب في شأن هذه الترجمة ف وحيكت حولها بعض القصص والأساطير. وأشهر تلك الروايات وأكثرها ذيوعا، تلك التي تحدثنا عن أن أحد البطالمة حكام مصر في القرن الثالث قبل الميلاد أراد تأسيس مكتبة الاسكندرية ومدها بنفائس الكتب في العالم. فنصحه بعض خلصائه باستدعاء نفر من أخبار اليهود في فلسطين ليقوموا بترجمة العهد القديم من البرانية إلي اليونانية وكانت اليونانية حينئذ لغة الكتابة والعلم، فطلب من الرئيس الديني لليهود في فلسطين أن يأذن بقدوم اثنين و سبعين حبرا من اخبار اليهود إلي الاسكندرية ليضطلعوا بهذا الشأن الخطير، علي أن يكون كل ستة منهم من قبيلة من قبائل اليهود الاثنتي عشرة. فلما قدموا و معهم نسخة معتمدة للعهد القديم بلغته الأصلية، أكرم بطليموس وفادتهم وأقام لهم الولائم والاحتفالات، ثم أمر بوضعهم في جزيرة لينقطعوا لتلك الترجمة وليتكون منهم ما يشبه المؤتمر الديني. وكان أن أتموا الترجمة في نحو سبعين يوما كما تقول الرواية.
ويري بعض النقاد أنه بالرجوع إلي نصوص الترجمة اليونانية، والبحث فيها تتضح معالم وإشارات تبرهن علي أن الذين قاموا بالترجمة لم يكونوا من يهود فلسطين، وإنما كانوا من يهود الاسكندرية. وقد كان بالإسكندرية حينئذ جالية يهودية كبيرة، ولعلهم رأوا القيام بهذه الترجمة لتيسير العبادة، وأداء الشعائر الدينية علي أبناء الطائفة في لغة البيئة الجديدة. وهي أيضاً أشهر لغة علمية في ذلك الزمن. ذلك لأن يهود فلسطين حينئذ لم يكونوا علي اتصال وثيق باللغة اليونانية، ومن المشكوك فيه أن يكون بينهم ذلك العدد الوفير من العارفين بها والمسيطرين عليها ليستطيعوا القيام بمثل هذه الترجمة. غير أن هذا النقد نفسه يمكن أن يوجه إلي يهود الإسكندرية الذين لم يعيشوا في كنف البطالة قبل هذه الترجمة أكثر من 35 عاما، وتلك مدة قصيرة لا تكفي لإتقان لغة من اللغات في جيل من الأجيال، إتقانا يسمح لبعض أهله بإتمام مثل هذه الترجمة. فإذا أضيف إلي ذلك أنه لم يعرف عن اليهود أنهم يتحمسون إلي ترجمة نصوصهم الدينية من العبرانية إلي لغات البيئات التي ينزحون إليها، رأينا أن فكرة قيام اليهود في الإسكندرية بهذه الترجمة يعتورها بعض
ص138
الضعف ولا تكاد تجد ما يقوبها أو يؤيدها.
وأيا ما كان الشأن في أصل المترجمين وبيئتهم، فقد تمت الترجمة السبعينية قبل الميلاد بزمن طويل، وثبت وجودها وتداولها بين اليهود قبل المسيحية، كما ثبت انتشارها من الإسكندرية، وانتقالها إلي البيئات الأخرى التي عاش بها اليهود. بل تعدّ هذه الترجمة أقدم مصدر لنصوص العهد القديم، فليس بين أيدينا الآن نسخة عربية تعادلها في القدم أو تقرب منها، رغم أن العبرانية هي اللغة الأصلية للعهد القديم.
ويري فريق من النقاد والباحثين أن أقسام الترجمة السبعينية غير متكافئة. وأن بعضها جيد غاية الجودة، في حين أن بعضها الأخر لم يصل إلي نفس المستوي، مما يدل في رأيهم، علي تعدد القائمين بالترجمة، واختلاف قدرتهم عليها.
وجاءت المسيحية فوجدت الترجمة السبعينية مشهورة متداولة بين اليهود، واعتمد عليها كتاب الأناجيل من الحواريين اعتماداً كبيراً، فلم يرجعوا إلي النص العبراني إلا في النادر من الأحيان.
ولم تكد المسيحية تثبت أقدامها في أنحاء كثيرة من العالم حتي وجدنا اليهود يتفكرون لهذه الترجمة السبعي..ية. ويحاولون تجريحها والانتقاص منقدرها، ولا سيما في تلك المواضع التي يشتم منها التنبؤ أو الإرهاص بقدوم المسيح.
ورغم أن الترجمة السبعينية قد بلغت بين المسيحيين حد القداسة في القرون الأولي للمسيحية ، وجدنا بعض الكتاب والنقاد يحاولون إصلاحيا وتعديل بعض نصوصها، ثم إخراجها إلي الناس في ثوب جديد. وكان لهذا أن تمت ثلاث تراجم جديدة للعهد القديم باللغة اليونانية خلال القرن الثاني بعد الميلاد: -
أ- أولاها ترجمة عالم يهودي يدي «أقويلا» (Apuila) في سنة 136 ميلادية. وهي ترجمة حرفية، التزم فيها صاحبها التمسك بظاهر النصوص العبرية وصيفها، وكان يهدف من ترجمته ألا يترك حجة للمسيحيين يعتمدون عليها في فكرة الإرهاص بمولد المسيح في نصوص العهد القديم.
ب- سيماخوس Symmachus وهو كما وصفه النقاد نصف مسيحي. وكان من الأدباء المسيطرين علي زمام اللغة اليونانية، فجاءت ترجمته أدبية سامية في أسلوبها، رائعة في تخير ألفاظها؛ وإن ضحت ببعض معالم النص العبري.
ج- ثيودوشن Theodotion وهو أيضا نصف مسيحي. وقد اتخذ لنفسه مسلكا
ص138
وسطاً بين الترجمتين السابقتين، فكانت ترجمته مما لا يوصف بالحرفية الخالصة، أو يعد من الترجمات الأدبية التي بطغي فيها الذوق الشخصي للمترجم علي النصوص المترجمة.
ثم ظهرت بعد هذا عدة ترجمات أخرى أشهرها ترجمة «أوريجين» (Origen) الذي أعاد الترجمة بعد أن تبينت له عدة فروق بين النص اليوناني والنص العبري، فأصلح الأخطاء وأعاد المحذوف، وأخرج للناس نسخته وقد قسمت إلى أعمدة عرض فيها التراجم السابقة كما عرض فيها النص العبراني الأصلي، حتي تكون وافية بالمقارنة، فيستنير بها الباحث الدارس. وآخر ترجمتين للعهد القديم باللغة اليونانية، كانتا في القرن الرابع الميلادي، فيها اتبعت نفس الطريقة التي اتبعها «أوريجين» . وهاتان الترجمتان كانتا أكثر تداولا واعتماداً في الكنيسة الشرقية . ثم لم تكن هناك محاولة أخري لترجمة يونانية بعدا القرن الرابع الميلادي.
وهكذا نري أنه رغم أن المسيحيين في كل العصور قد نظروا إلي الترجمة السبعينية نظرة تكاد تبلغ حد القداسة، ورغم أن كل الترجمات الحديثة إلي اللغات الأوربية قد أسست علي تلك الترجمة اليونانية، وجدنا عدداً من الكتاب يعيدون المحاولة، ولا يقنعون بما جاء في الترجمة السبعينية، فيستبدلون بألفاظها أخري، لأن تجاربهم مع الألفاظ ودلالاتها متباينة، وشعورهم إزاءها مختلف، هذا يؤثر لفظا بعينه ويأبي استعمال غيره، وذلك يتخير لفظا آخر ويتمسك به، وكلهم مخلص أمين في عمله، حريص علي إتقانه، وكلهم يفهمون النصوص الأصلية ويحاولون جهدهم تصويرها والتعبير عنها.
وكذلك يمكن القول في الترجمات القرآنية، إلي اللاتينية، والفرنسية، والإنجليزية، فقد تعددت تلك الترجمات . واختلفت في كثير من ألفاظها، لا لشيء سوى أن تجارب المترجمين مع الألفاظ متباينة، وما يحيط بالألفاظ من ظلال المعاني والدلالات يختلف من مترجم إلي آخر. وليس من الحكمة أن نفترض سوء النية في هؤلاء المترجمين، أو أن نشك في نواياهم، وليس من المقبول أن نتصور جهلهم بإحدى اللغتين المترجم منها والمترجم إليها، فكلهم من أهل الفكر الذين يحافظون علي سمعتهم، ويحرصون علي أن يوصفوا بالأمانة والإخلاص في عملهم ولذلك يجدر بنا حين نستعرض تلك الترجمات المختلفة لألفاظ القرآن الكريم أن نفترض فيمن قاموا بها البعد عن الغرض أو الهوي، وأنهم كانوا ممن يحسنون فهم العربية،
ص139
ويجيدون الكتابة باللغة المترجم إليها. ثم مع هذا أو رغم هذا نراهم يختلفون في تخبر الألفاظ وإيثار بعضها علي بعض، تبع اًلاختلاف تجاربهم معها، وتبعاً لاختلاف حدود هب وظلالها في ذهن كل منهم.
وقد رجعنا إلي ترجمة الألفاظ القرآنية إلي اللغة الإنجليزية فوجدنا أقدمها يرجع إلي سنة 1734 ميلادية وهي التي قام بها «جورج سيل» Coorge Sale، ثم أعاد الترجمة بعده ج. م. «رودويل» J.M. Rodwell في سنة 1876 ثم «يلمار» E.H. Palmer في سنة 1880 . وهؤلاء الثلاثة لم يكونوا من المسلمين أو معتنقي الدين الإسلامي، ولكنهم بذلوا الجهد، وجاءوا بما وسعته طاقتهم في إخلاص وأمانة ومثابرة.
ثم ظهرت بعدهم ثلاث ترجمات أخري لألفاظ القرآن قام بها قوم من المسلمين، وممن يتمكون ويعترون بالدين الإسلامي، ويحرصون علي إظهار تعاليمه و أحكامه في صورة وضاءة مشرفة، لا يشينها شين ولا يشوبها زيف، فيذلوا جهدهم، واستنفذوا طاقتهم، وأتوا بما وسعهم وهؤلاء هم محمد علي الباكستاني سنة 1917، مرمدوك بكتال Marmaduke Pickthall سنة 193، وأخيرا يوسف علي الباكستاني منذ سنوات.
وحين نستعرض هذه الترجمات السنة، نراها تشترك في ألفاظ كثيرة جداً، ونراها مع ذلك تختلف في بعض الألفاظ والعبارات التي رغم أنها جميعاً تؤدي المعني في عمومه، فقد تباينت إزاءها نظرة المترجمين و موقفهم منها. ولتوضيح ذلك وقع اختيارنا علي بضع آيات من آخر سورة البقرة هي قوله تعالى:
[ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته علي الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا علي القوم الكافرين].
فبينما نري معظم المترجمين يترجم كلمة «البقرة» بالكلمة الإنجليزية Cow، نري أحدهم يستعمل كلمة أخري هي Heifer. كذلك بينما نراهم يشتركون جميعاً في كلمة Soul» للنفس، وفي كلمة Burden - للإصر، نراهم يختلفون في ترجمة الألفاظ الآتية:
ص140
(1) يكلف force. ... (2)burden (3)require. (1)
(6)Place a burden (5)task impose a dnty (4)
(2) وسعها its Capacity (3) its power (2) its Capacity. (1)
(6)what it Can bear (5)its Scope ability (4)
(3) يؤخذ Punish (3) Catch up(2) Punish(1)
Condenm (6) Condemn (5) Punish (4)
(4) أخطأنا full into sin (2) act sinfully (1)
make a mistake (4) make mistake (1)
fall into error (6) miss the mark (5)
(5) اعف عنا forgive (3)Blot out our sins (2) Be favourable (1)
Blot out our sins (6) Pardon (5) Pardon (4)
اغفر لنا Parodn (3) forgive (2) Spare us (1)
grant forgiveness (6) absolve (5) grant Protection (4)
(6) مولانا Sovereign (3) Proteclor (2) Pardon (1)
Protector (6) Proteclor (5) Patron (4)
وها نحن أولاء تعرض نص الترجمات المختلفة للآبات القرآنية الآ..فة الذكر مرتبة علي حسب تاريخ ظهورها.
.George Sale . 1734 (1)
God will not force any soul beyond its capacity : It shall have the good wbich it gaineth, and it ahall suffer the evll which it gaineth. O Lord. Punish us not, if we forget, or act stnfully: O Lord, lay not on us a burden like that which thou hast laid on those who have been before us, neither make us. O Lord, to hear what we have not strength to bear, but be favourable unto us, and spare us, and be merciful unto us. Thou art our parton, help us therefore against the unbelteving nations.
ص141
J. M. Rodwell. 1876 (2)
God will not burden any soul beyond its power. It shall enjoy the good which it hath acquiresd. And shall bear the evil for the acquirement of which it laboured. O our Lord, punish us not if we forget, or fall into sin: O our LordL:and lay not on us a load like that which Thou hast laid on those who have been before us: O our Lord : and lay not on us that for which we have not strength : but blot out blot out our sing and forgive us, and have pity on us. Thou art our protector: help us then against the unbelievers.
E. H. palmer. 1880.(3)
God will not require of the soul save its capacity. It shall have what it has earned, and it shall owe what has been earned from it. Lord, catch us not up, if we forget or make mistake. Lord; load us not with a burden, as Thou hast loaded those who were before us. Lord. Make us not to carry what wd have not strength for, but forgive us. And pardon us, and have mercy on us. Thou art our Soveriegn, then help us against the people who do not belive!
maulvi Muhamman Ali: 1917.(4)
Allah does not impose upon any soul a duty but to the extent of its ability. For it is (the tenefit of) what it has earned, and upon it (the evil of) what it has wrought.
Our Lord : do not punish us if we forget or make a mistake. Our Lord : do not lay on us a burden as Thou didst lay on those before us; our Lord: do not impose upen us that which we have not the strength to bear; and pardon us and grant us protection and have mercy on us, Thou art our parton. So help us against the unbelieving people.
Marmaduke Pickthall: 1930(5)
Allah tasketh not a soul beyond its scope. For it (is only) that which it hath earned, and against it (only) that which it hath deserved.
ص142
Our Lord! Condernn us not if we forget, or miss the mark! Our Lord! Lay not on us such a burden as Thou didst lay on those before us! Our Lord! Impose not on ua that which we have not the strenglh to bear! Pardon us. Absolve us and have mercy on us. Thou, our Protector, and give us victory over the disbelieving folk.
يوسف علي (6)
On no soul doth God Place a burden greater than it can bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns. (pray): "Our Lord" ! Condemn us not if we forget or fall into error;Our Lord! Lay not on us a burden like that which ... hon didst lay on. Those before us; Our Lord! Lay not on us a burden grcater than we have strength to bear Blot out our sins, and grant us forgiveness. Have mercy on us. Thou Art our Protector; Help us Against those who stand Against Faith.
وليس بعسير بعد هذا العرض لعدة ترجمات للألفاظ القرآنية ، إدراك السر في اختلاف المسلمين حول ترجمة القرآن الكريم. إذ يري جمهور كبير منهم أن ترجمة القرآن مهما بلغ المترجم من القوة في اللغتين لا تكاد تحقق الهدف، وذلك لأن للغة العربية نواحي خاصة من فنون البلاغة تعني بها كل العناية، وتذيع في أساليبها ولا تكاد تشبهها في هذه لغة أخرى. فمع فنون الجمال اللفظي التي أشرنا إليها انفاً ، تتصف اللغة العربية بالعناية بالمجاز والاستعارة والكناية أو التورية وغيرها من فنون القول الوثيقة الصلة بدلالة الألفاظ. وقد تجلت هذه الحقيقة بصورة أروع حين عرض بعض الباحثين من القدماء لألفاظ القرآن بالشرح والتفسير، وتبين لهم أنه لا يتم فهم ألفاظ القرآن إلا بعد التصرف علي أساليبه، وما يمكن أن ينطوي وراء تعبيراته، من المعاني والمقاصد. ولذا وضع أبو عبيدة كتابه المسمى «مجاز القرآن» وتحدث فيه عن المجازات القرآنية، و دلالتها اللطيفة. ويصف أبو عبيدة الآيتين:
{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} و {وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}.
ص143
بقوله : إن هذا ظاهره الأمر وباطنه الزجر، وهو من سنن العرب.
ثم ظهر لابن قتيبة كتاب تحت عنوان (تأويل مشكل القرآن)، وفيه يعرض ابن قتيبة لما خفي عن العامة الذين لا يعرفون إلا اللفظ وظاهر دلالته علي معناه، وفيه يقول إن للقرآن من القوة والجمال ما قد يخفي علي غير أهل الذوق و أرباب البصيرة بالفن الأدبي. ولذلك لا يعرف فضل القرآن إلا من كثر نظره واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب واقتنائها في الأساليب، وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات (5) .
ففي قوله تعالى: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي} يقول ابن قتيبة: لم يرد في هذا الموضوع أني أحببتك ، وان كان يحبه ، وإنما أراد أنه حببه إلي القلوب
وقربه إلي النفوس. ويقول في قوله تعالي «وجعلنا نومكم سباتا»: ليس السبات هنا النوم، ولكن السبات الراحة، أي جعلنا النوم راحة لأبدانكم.
ويمثل ابن قتيبة للاستعارة في القرآن بقوله تعالي: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ} ويشرح الآية بقوله : أي كان كافراً فهديناه، وجعلنا له ايمانا يهتدي به سبيل الخير والنجاة.
ومن كنايات القرآن قوله تعالي {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، أي طهور نفسك من الذنوب ، فكني عن الجسم بالثياب لأنها تشتمل عليه.
ومن أساليب القرآن في رأي ابن قتيبة: أن يأتي الكلام علي مذهب الاستفهام وهو تقرير كقوله سبحانه {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ} ، وكأن يأتي علي الاستفهام و هو تعجب كقوله « عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ »!؟ ، وكأن يأتي علي مذهب الاستفهام وهو توبيخ كقوله {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ}!.
ثم ظهر بعد كتاب ابن فتيبة أثر جليل الشأن هو كتاب إعجاز القرآن للباقلاني. وفي بعض فصول هذا الكتاب يعرض المؤلف الكثير من فنون البلاغة العربية، كالتمثيل والمطابقة والتجنيس والمقابلة والموازنة والمساواة والتوشيح والكناية ... الخ.
وظهر معه كتاب آخر هو (تلخيص البيان في مجازات القرآن) للشريف الرضي. وفيه يقصر المؤلف دراسته علي البحث في المجاز القرآني، أي في الألفاظ المستعملة في غير ما وضعت له كقوله تعالى: {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ} .
ص144
فالمراد بتفتيح أبواب السماء تسهيل سبل الأمطار حتي لا يحبسها حابس. وقوله (فالتفي الماء علي أمر قد قدر)، أي اختلط ماء الأمطار المنهمرة بماء العيون المتفجرة، فالتقي الماء ان علي ما قدره الله سبحانه من غير زيادة ولا نقصان.
وأخيراً نجد كتاب (بدائع القرآن لابن أبي الإصبع) المتوفي سنة 654 هـ وفيه يسوق المؤلف من فنون البلاغة التي وردت في آيات القرآن نحو مائة فن، كالمجاز والاستعارة والكناية و الإرداف والتمثيل والتشبيه والإيجاز ... الخ.
وفي الحق أنه لا يكاد المرء ين...ي من تصفح هذه الكتب و أمثالها حتي يحس في قرارة نفسه أن الوقوف علي دلالات الألفاظ القرآنية أمر عسير المنال، دونه صعوبات جمة، فلا يكاد يسلم المترجم لها من الزلل أو القصور في إبرار تلك الدلالات، وتصويرها بالقدر الذي يقارب ما هي عليه في منبتها القرآني من جمال وروعة وإعجاز لأهل اللسن والفصاحة، في كل زمان و مكان.
ص145
________________
(1) المقتبسات لأبي حيان التوحيدي ص 71 .
(2) اسرار البلاغة ص23.
(3) تيارات أدبية بين الشرق و الغرب. الدكتور ابراهيم سلامة ص 37 .
(4) أسرار البلاغة، ص 33 .
(5) البيان المر... ص 11 .



|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية ينجز تصوير 39 مخطوطًا قديمًا نادرًا في قرية كاخك الإيرانية
|
|
|