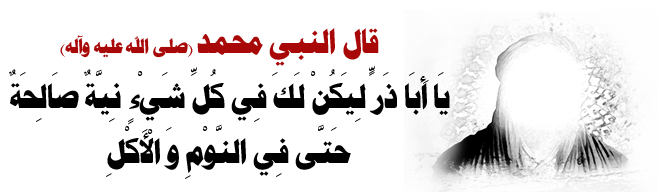
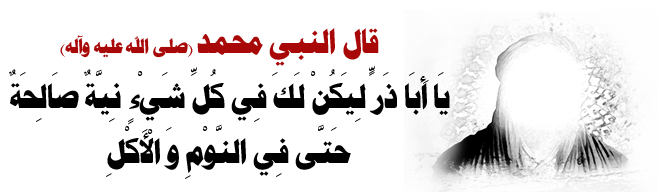

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2018
التاريخ: 21-4-2018
التاريخ:
التاريخ: 26-4-2018
|
تصوّر معي صديقين يتحدثان ويقول أحدهما للآخر (لا تصدقه فهو كذاب هل يعقل أن تنضخ العين بالنفط في وسط الصحراء بعد ثوانٍ)!!
لكي يفهم السامع المراد من هذه العبارة، لابد أن يكون قد مر قبل سماعها بتجارب كثيرة يستعين بها على الإحاطة بظروف هذا الكلام وملابساته. ولا يتم فهمه لها بغير الوقوف على تلك الظروف والملابسات التي منها صلة المتكلم بالتحدث
ص33
عنه، بل وصلة المتكلم بالسامع، وما يمكن أن يتضمنه المشروع الذي يدور حوله الحديث من إمكانيات مالية وفنية وترتيب وتنظيم. ولابد للمتكلم والسامع في مثل هذا الحديث من تجارب علمية سابقة تتصل بالنفط والطبيعة تكونها، وموقعها الجغرافي، وغير ذلك من بيانات ومعلومات مشتركة، بين السامع والمتكلم على أساسها يفهم أحدهما الآخر ودونها لا يتم هذا الفهم.
وتتبع تلك الظروف والملابسات يستلزم الرجوع الى الوراء زمنا طويلا، وتقصى حالات وتجارب كثيرة لا تتسع لها صفحات من الوصف للوقوف على تفاصيلها. هذا الى أن لنفسية كل من المتكلم والسامع دخلا في فهم هذا الحديث. فهل من طبيعة المتكلم المغالاة أو التشاؤم. وهل من طبيعة السامع حسن الظن بالناس، أو التشكك والريبة في سلوكهم، إلى غير ذلك من ظروف معقدة لا تكاد تقع تحت حصر.
ولكي يتنبأ اللغوي بأن مثل هذا الحديث يستجيب له السامع بالقدر نفسه الذي أراده المتكلم، لابد له من الإحاطة بكل هذا الظروف والملابسات، وليست هذه الإحاطة بالأمر الهين السهل، لأنها تتطلب زمنا طويلا وبحثا مستفيضا.
وليس يعتمد الفهم على مجرد نطق المتكلم بتلك الكلمات، فقد يلفظ بها هذا المتكلم أمام سامع آخر يقف أمامها مشدوها لا يدري الهدف منها، ولا يلبث أن يتساءل: ما هذا الذي
تتحدث عنه؟ ولماذا لا أصدقه؟ وأي صحراء تعني؟ وأي موقع في هذه الصحراء؟ ومن القائمون بهذا المشروع؟ ومن الممولون له؟ بل قد يتساءل عما إذا كان النفط يستخرج من عيون الأرض, أو يصنع في معامل ومصانع تقوم بتركيبة كما تركب الأدوية والمستحضرات!!
فالفهم عن طريق الوقوف على تلك الظروف والملابسات عملية تتم قبل الفهم للنص اللغوي أو العبارة المنطوق بها.
دعنا نفترض أن المشاركة قد تمت بين كل من المتكلم والسامع في ظروف سابقة، بحيث أصبح كل منهما يقف على كل الملابسات، وأصبح من الممكن لهذا المتكلم أن ينطق بمثل هذه العبارة، كما أصبح من الممكن لهذا السامع أن يستجيب لها، ثم دعنا بعد هذا نتساءل عن الدلالات التي يستمدها السامع مثل هذا المنطوق:
ص34
تتضمن هذه العبارة أنواعا من الدلالات يمكن أن تقسم بحسب مصدرها الى ما يأتي:
1- دلالة صوتية:
وهي التي تستمد من طبيعة بعض الأصوات في هذه العبارة، فكلمة (تنضخ) كما يحدثنا كثير من اللغويين القدماء تعبر عن فوران السائل في قوة وعنف. وهي إذا قورنت بنظيرها (تنضخ) التي تدل على تسرب السائل في تؤده وبطء، يتبين لنا أن صوت الخاء في الأولى له دخل في دلالتها، فقد أكتسبها في رأى أولئك اللغويين تلك القوة وذلك العنف.. وعلى هذا فالسامع يتصور بعد سماعه كلمة (تنضخ) عيناً يفور منها النفط فوراناً قوياً عنيفاً.
والفضل في مثل هذا الفهم يرجع الى إيثار على آخر، أو مجموعة من الأصوات على الأخرى في الكلام المنطوق به.
هناك إذاً نوع من الدلالة تستمد من طبيعة الأصوات، وهي التي نطلق عليها اسم الدلالة الصوتية.
ومن مظاهر هذه الدلالة الصوتية (النبر) فقد تتغير الدلالة باختلاف موقعه من الكلمة. فبعض الكلمات الانجليزية تستعمل (اسماً) إذا كان النبر على المقطع الأول منها، فإذا انتقل النبر على مقطع آخر من الكلمة أصبحت (فعلا) وتستعمل حينئذ استعمال الأفعال.
أما في جملتنا السابقة (هل يعقل أن تنضخ العين في وسط الصحراء في ثوان)، فيمكن أن نزيد الضغط أو النبر على "وسط الصحراء" فيصبح موضع الغرابة أن ينبثق بئر النفط في وسط الصحراء، وأن هذا من غير المألوف في مهنة التنقيب عنه، وإن سواحل البحار مثلا هي المكان الطبيعي لمثل هذه الآبار. أما إذا زاد المتكلم الضغط أو النبر على (في ثوان) كان محل الغرابة أن تتم مثل هذه العملية المعقدة في مثل هذا الزمن القصير.
ومن مظاهر الدلالة الصوتية، ما نسميه بالنغمة الكلامية intonation وتلعب هذه النغمة في بعض اللغات دوراً هاماً. ففي اللغة الصينية مثلا قد يكون للكلمة الواحدة عدة دلالات، لا يفرق بينها إلا اختلاف النغمة في النطق.
خذ مثلا تلك العبارة العامية (لا يا شيخ؟!) وتذكر أنك تستطيع أن تنطق بها بعدة نغمات، وهي مع كل نغمة من تلك النغمات تفيد دلالة خاصة، فهي مرة لمجرد
ص35
الاستفهام، وأخرى للتهكم والسخرية، وثالثة للدهشة والاستغراب.. وهكذا.
فتغير النغمة قد يتبعه تغير في الدلالة في كثير من اللغات.
2- الدلالة الصرفية:
هناك نوع من الدلالة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتها، ففي جملتنا السابقة تخير المتكلم (كذّاب) بدلا من (كاذب)؛ لأن الأولى جاءت على صيغة يجمع اللغويون القدماء على أنها تفيد المبالغة. فكلمة (كاذب) تزيد في دلالتها على الكلمة (كاذب)، وقد استمدت هذه الزيادة من تلك الصيغ المعينة، فاستعمال كلمة (كذاب)، يمد السامع بقدر من الدلالة، لم يكن ليصل إليه أو يتصوره لو أن المتكلم استعمل (كاذب).
3- الدلالة النحوية:خ
يحتم نظام الجملة العربية او هندستها ترتيبا خاصا لو اختل أصبح من العسير أن يفهم المراد منها. تصور مثلا أن جملتنا السابقة أصبحت (لا تصدقه في وسط الصحراء فهو يعقل في ثوان النفط كذاب العين تنضخ).
4- الدلالة المعجمية أو الاجتماعية:
وهي الدلالة التي نوجه اليها هنا كل عنايتنا، كالدلالة التي تستفاد من (التصديق)، و دلالة (الكذب)، (الصحراء) و(النفط)، و (النضوخ) إلى آخر ما في جملتنا السابقة.
فكل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة معجمية أو اجتماعية، تستقل عما يمكن أن تةحيه أصوات هذه الكلمة أو صيغتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسية، التي يطلق عليها الدلالة الاجتماعية.
فكلمة (الكذاب) في جملتنا الآنفة الذكر تدل على الشخص يتصف بالكذب؛ وتلك هي دلالتها الاجتماعية غير أنها اكتسبت عن طريق صيغتها قدرا آخر من الدلالة يسمى بالدلالة الصرفية.
والفعل (تنضخ) كلمة تدل على تسرب السائل، وتلك هي دلالتها الأساسية، ولكنها في رأي اللغويين قد اكتسبت عن طريق تكوينها الصوتي وطبيعة الأصوات فيها، قوة وعنفا في تلك الدلالة الأساسية.
ومع أن كل كلمة دلالتها الاجتماعية المستقلة، نلحظ أنه حين تتركب الجملة
ص36
من عدة كلمات تتخذ كل كلمة موقفاً معيناً من هذه الجملة، بحيث ترتبط الكلمات بعضها ببعض على حساب قوانين لغوية خاصة بالنظام النحوي، وفيه تؤدي كل كلمة وظيفة معينة.
ولا يتم الفهم أو يكمل إلا حين يقف السامع على كل هذه الدلالات. وليس من الضروري أن نتصور السامع على علم بالنظام الصرفي والنحوي في اللغة على الصورة المعقدة التي نراها في كتب النحاة الأول. ولا نفترض في السامع لكي يتم فهمه لجمله من الجملة من الجمل أن يكون قد اتصل أي نوع من الاتصال بعلوم اللغة من نحو وصرف، بل يكفي أن يكون السامع قد عرف عن طريق التلقي والمشافهة في تجارب سابقة الفرق بين استعمال كلمتي (الكذاب) و (الكاذب) وأن يكون قد تعود من المناسبات الكثيرة كيفية تكوين الجمل والربط الصحيح بين كلماتها.
ويكتسب أبناء اللغة كل هذه الدلالات عن طريق التلقي والمشافهة، ويتطلب هذا الكسب زمنا ليس بالقصير قبل أن يسطر المرء على لغة أبويه، وتصبح أنظمتها بمثابة العادات الكلامية، يؤديها دون شعور بخصائصها، أو على الأقل دون أن يشعر بها شعور عالم النحو والصرف.
ولا تلبث الدلالات الصوتية والصرفية والنحوية بعد المران الكافي أن تحل من كل منا منطقة اللاشعورية أو شبه الشعورية يراعيها بطريقة تكاد تكون آلية دون جهد أو عناء كبير، وتلك هي المرحلة التي يعرفها اللغويون بالسليقة اللغوية.
أما الدلالة الاجتماعية للكلمات فتضل تحتل بؤرة الشعور، لأنها الهدف الأساسي في كل كلام. وليست العمليات العضوية التي تقوم بها في النطق بالأصوات إلا وسائل يرجو المتكلم أن يصل عن طريقها الى ما يهدف من فهم أو افهام.
وقد اختص المحدثون من اللغويين تلك الدلالة الاجتماعية بالدراسة وبالبحث وجعلوا منها فرعا دراسيا مستقلا سموه semantics ، زادت عنايتهم به خلال القرن العشرين.
ويبدو أن بعض اللغويين من المحدثين يميلون الى التفرقة بين الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية، إذ إن المعاجم وإن كانت مهمتها الأساسية هي توضيح تلك الدلالات الاجتماعية، غير أنها قد تعرض لبحث مسائل من النحو والصرف. فليس من مهمة المعجم الحديث أن يبين كيف نشتق اسم الفاعل من كل فعل من أفعال اللغة، ولا الجمع لكل اسم من أسماء اللغة، ولكن المعجم قد يعرض لشيء من هذا حين
ص37
تكون الصيغة الشائعة غير جارية على النظام المألوف لاسم الفاعل أ, الجمع، فعالم اللغة يحاول تقعيد القواعد ويوقفنا على المطرد القياسي منها ليستطيع كل منها استنباطه بنفسه، أو قياسها دون حاجة الى سماعها من غيره، أو الكشف عنها في معجم من المعاجم. فإذا استقرت تلك القواعد وأصبح كل منا، يدرك كيف يشتق اسم الفاعل اشتقاقا قياسيا مطردا وكيف يجمع الاسم جمعا قياسيا مطردا، وكيف يستخرج المضارع من الماضي أو العكس بطريقة قياسية مطردة، لم يعد هنالك حاجة الى نص على كل هذا في صلب المعاجم. أما ما يجري على غير المألوف من جموع أو مشتقات.. فتلك هي التي يعني بها بعض مؤلفي المعاجم، ويرى من الضروري النص عليها.
وقد أدرك هذه الحقيقة العلمية معظم أصحاب المعاجم العربية القديمة، فنراهم في غالب الأحيان لا ينصون إلا على الصيغ الغربية غير الجارية على القياس والاطراد في ظواهر اللغة.
فليس من الضروري أن ينص صاحب المعجم العربي على أن جمع (السيف) (سيوف) لأن هذا هو المطرد القياسي، ولكنه قد يرى من الضروري أن تشير إلى أنه جمع أيضا على (أسياف). وليس من الضروري أن ينص على مضارع الفعل (نكح) هو (ينكح) بفتح الكاف، ولكنه قد ينص على سماع المضارع بكسر الكاف أيضا.
ومن الحق أن يقال عنا إن معاجمنا العربية القديمة لم تلتزم هذا الطريق السوي في عرض مفرداتها، بل جمع بعضها بين المطرد القياسي والشاذ السماعي في كثير من الأحيان. ولعل تشعب القواعد العربية واختلاف وجهات النظر فيها، بل واضطرابها في بعض الأحيان كل هذا جعل مهمة واضع المعجم العربي عسيرة.
ولكن المعاجم قديمها وحديثها تتخذ من الدلالة الاجتماعية للكلمات هدفاً أساسيا، ونكاد توجه إليها كل عنايتها. فلا غرابة إذاً ألّا يفرق بعض اللغويين بين الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية، وهذا هو ما ارتضيناه هنا أو قنعنا به. فكلما ذكرنا الدلالة المعجمية لا نعني بها غير الدلالة الاجتماعية.
تلك هي الدلالات المتعددة التي يمكن أن تستفاد من النص المنطوق به، أما تلك الدلالات الأخرى التي تستمد من الظروف والملابسات أو ما يسمى أحيانا بسياق الكلام، فمتشعبة معقدة. ولعل من المفيد هنا لبيان قدر هذا السياق من التشعب والتعقيد أن نسوق حدثا لغويا صغيرا نفترض أن يتم بين شخصين متكلم وسامع، محاولين وصف تلك الظروف والملابسات في كل خطوة من خطوات هذا الحدث اللغوي حتى يتم فهمه، ويتحقق الهدف منه.
ص39



|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|