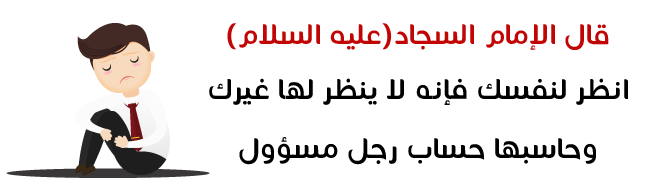
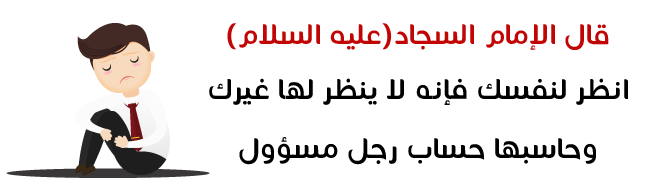

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2017
التاريخ: 8-10-2017
|
قال تعالى : {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ } [الصف: 1 - 5].
{سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم} مر تفسيره وإنما أعيد هاهنا لأنه استفتاح السورة بتعظيم الله من جهة ما سبح له بالآية التي فيه كما يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم وإذا دخل المعنى في تعظيم الله حسن الاستفتاح به {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} قيل إن الخطاب للمنافقين وهو تقريع لهم بأنهم يظهرون الإيمان ولا يبطنونه وقيل إن الخطاب للمؤمنين وتعيير لهم أن يقولوا شيئا ولا يفعلونه قال الجبائي هذا على ضربين ( أحدهما ) أن يقول سأفعل ومن عزمه أن لا يفعله فهذا قبيح مذموم ( والآخر ) أن يقول سأفعل ومن عزمه أن يفعله والمعلوم أنه لا يفعله فهذا قبيح لأنه لا يدري أ يفعله أم لا ولا ينبغي في مثل هذا أن يقرن بلفظة إن شاء الله {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} أي كبر هذا القول وعظم مقتا عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه وقيل معناه كبر أن تقولوا ما لا تفعلونه وتعدوا من أنفسكم ما لا تفون به مقتا عند الله {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا} أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا وقيل يقاتلون في سبيله مصطفين {كأنهم بنيان مرصوص} كأنه بني بالرصاص لتلاؤمه وشدة اتصاله وقيل كأنه حائط ممدود رص على البناء في إحكامه واتصاله واستقامته أعلم الله سبحانه أنه يحب من ثبت في القتال ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص ومعنى محبة الله إياهم أنه يريد ثوابهم ومنافعهم.
ثم ذكر سبحانه حديث موسى (عليه السلام) في صدق نيته وثبات عزيمته على الصبر في أذى قومه تسلية للنبي (صلى الله عليه واله وسلم) في تكذيبهم إياه فقال {وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم} هذا إنكار عليهم إيذاءه بعد ما علموا أنه رسول الله والرسول يعظم ويبجل ولا يؤذى وكان قومه آذوه بأنواع من الأذى وهو قولهم اجعل لنا إلها واذهب أنت وربك فقاتلا وما روي في قصة قارون أنه دس إليه امرأة وزعم أنه زنى بها ورموه بقتل هارون وقيل إن ذلك حين رموه بالأدرة وقد ذكرنا ذلك عند قوله {ولا تكونوا كالذين آذوا موسى} الآية {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم} أي فلما مالوا عن الحق والاستقامة حلاهم وسوء اختيارهم ومنعهم الألطاف التي يهدي بها قلوب المؤمنين كقوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه عن أبي مسلم وقيل أزاغ الله قلوبهم عما يحبون إلى ما يكرهون ولا يجوز أن يكون المراد أزاغ الله قلوبهم عن الإيمان لأن الله تعالى لا يجوز أن يزيغ أحدا عن الإيمان وأيضا فإنه يخرج الكلام عن الفائدة لأنهم إذا زاغوا عن الإيمان فقد حصلوا كفارا فلا معنى لقوله أزاغهم الله عن الإيمان {والله لا يهدي القوم الفاسقين} أي لا يهديهم الله إلى الثواب والكرامة والجنة التي وعدها المؤمنين وقيل لا يفعل بهم الألطاف التي يفعلها بالمؤمنين بل يخليهم واختيارهم عن أبي مسلم .
ثم عطف سبحانه بقصة عيسى (عليه السلام) على قصة موسى فقال {وإذ قال عيسى بن مريم} أي واذكر إذ قال عيسى بن مريم لقومه الذين بعث إليهم {يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة} المنزلة على موسى {ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} يعني نبينا محمدا (صلى الله عليه واله وسلم) كما قال الشاعر :
صلى الإله ومن يحف بعرشه *** والطيبون على المبارك أحمد
ولهذا الاسم معنيان ( أحدهما ) أن يجعل أحمد مبالغة من الفاعل أي هو أكثر حمدا لله من غيره ( والآخر ) أن يجعل مبالغة من المفعول أي يحمد بما فيه من الأخلاق والمحاسن أكثر مما يحمد غيره وصحت الرواية عن الزهري عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إن لي أسماء أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي أورده البخاري في الصحيح وقد تضمنت الآية أن عيسى بشر قومه بمحمد وبنبوته وأخبرهم برسالته وفي هذه البشرى معجزة لعيسى (عليه السلام) عند ظهور محمد (صلى الله عليه واله وسلم) وأمر لأمته أن يؤمنوا به عند مجيئه {فلما جاءهم} أحمد {بالبينات} أي بالدلالات الظاهرة والمعجزات الباهرة {قالوا هذا سحر مبين} أي ظاهر.
________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج9 ، ص460-463.
{سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وما فِي الأَرْضِ وهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} . شهد كل كائن بلسان المقال أو الحال للَّه سبحانه بالقدرة والحكمة . وتقدم بالحرف الواحد في أول سورة الحديد وأول سورة الحشر ، وتكلمنا مفصلا عن تسبيح الكائنات عند تفسير الآية 44 من سورة الاسراء .
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ} ! ! . كثير من الناس يتعمدون الكذب والخداع ، فيتصرفون في الخفاء ما لا يبدونه علانية . . وليس من شك ان هؤلاء منافقون بكل ما في كلمة النفاق من معنى ، ومن ثم فلا يصح ان يخاطبوا بيا أيها المؤمنون ، وان تظاهروا بالايمان ، ومن الناس من يقول ويعد بنية الصدق والوفاء ، ولكن تعترضه ظروف لا قبل له بها ، فيعجز عن الوفاء على الرغم مما بذله من جهد ، وهذا معذور ، ما في ذلك ريب ، ومنهم من يقول ويعد بنية الوفاء ، ولكن إذا جاء أوان العمل وتهيأت له الأسباب تراجع وألغى إرادته كسلا أوجبنا أو بخلا ، وهذا مؤمن ولكنه مؤمن متهاون ضعيف في إرادته وأمام نفسه الأمّارة بالسوء .
وهذا النوع من الناس هم المخاطبون بقوله تعالى : {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ} . ومن باء بغضب اللَّه فقد هوى إلى عذاب السعير . وقال كثير من المفسرين : ان جماعة من الصحابة كانوا قبل ان تتهيأ أسباب الأمر بالقتال يتمنون ان يفرض عليهم ، فلما تهيأت أسبابه وفرض عليهم تثاقل فريق منهم ، فنزلت فيهم هذه الآية . وليس هذا ببعيد لأن السياق يومئ إليه حيث قال سبحانه بلا فاصل : {إِنَّ اللَّهً يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ} أي محكم ثابت كأنه بني بالرصاص ، ونقل عن علماء الآثار انهم عثروا على أبنية قديمة بنيت بالرصاص ، وقال تعالى حكاية عن ذي القرنين : {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً} - 96 الكهف والقطر الرصاص أو النحاس المذاب . . ومن نافلة القول : ان اللَّه سبحانه يحب تماسك الجماعة وتعاضدها في كل ما يعود عليها بالخير والصلاح .
{وإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ} .
هذا السؤال يحمل جوابه معه لأن بني إسرائيل هم قتلة الأنبياء بنص كتابهم المقدس عندهم ، فقد جاء في سفر نحميا اصحاح 9 آية 26 ما نصه بالحرف :
{وعصوا وتمردوا عليك - أي على اللَّه - وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم وقتلوا أنبياءك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم إليك ، وعملوا إهانة عظيمة} . أما القرآن الكريم فقد سجل عليهم قتل الأنبياء في أكثر من آية . ولوان قائلا يقول : لا شيء أدل على نبوة موسى من إساءة بني إسرائيل إليه ، وهو منقذهم والمحسن إليهم ، وعلى نبوة عيسى من أقدامهم على صلبه ، لوقال هذا قائل لكان لقوله وجه وجيه .
أما إساءة بني إسرائيل إلى موسى فهي على ألوان ، قالوا له : أرنا اللَّه جهرة .
وقالوا له : فاذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون . وقالوا له : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . وقالوا له : لن نصبر على طعام واحد . . إلى غير ذلك .
{فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} . وهذه الآية تنص بصراحة على ان اللَّه سبحانه لا يزيغ أحدا إلا إذا زاغ هو بسوء اختياره ، ولا يهين مخلوقا ويهلكه إلا إذا هو عرض نفسه للهلكة والهوان . . فلا فرق أبدا بين معنى هذه الآية ومعنى قول القائل : من طمع بالحرام أذله اللَّه وأخزاه ، ومن اقتنع بالحلال أعزه وأغناه . .
وبهذه الآية نفسر الآيات التي نسبت بظاهرها الإضلال إلى اللَّه مثل {يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ} أي انه تعالى قد شاء وأراد أن يضل من يسلك سبيل الضلال ، ويهلك من أراد الهلاك لنفسه {واللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ} ما داموا مصرين على الفسق .
{وإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ ومُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} يعني محمدا (صلى الله عليه واله وسلم) وفي آية ثانية : {النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ والإِنْجِيلِ} - 157 الأعراف . وفي ثالثة : {الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وهُمْ يَعْلَمُونَ} - 146 البقرة أعلن القرآن وأصر على ان التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى قد بشرا بنبوة محمد ، وجابه بهذا الحقيقة علماء اليهود والنصارى وتحداهم أن يكذّبوا ، وما ذكر التاريخ ان أحدا منهم كذّب وأنكر ، بل أثبت ان المنصفين منهم اعترفوا وأسلموا كعبد اللَّه بن سلام وغيره مع العلم انهم كانوا ينصبون العداء لرسول اللَّه ، ويبحثون جاهدين عن زلة يدينونه بها .
تحريف التوراة والإنجيل :
وتسأل : بماذا يجيب المسلم إذا قال له يهودي أو نصراني : لقد نص قرآنكم على ان التوراة والإنجيل بشّرا بنبوة محمد (صلى الله عليه واله وسلم) مع انه لا أثر لهذه البشارة فيما لدينا من نسخ التوراة والإنجيل ؟ .
الجواب : إذا سأل هذا السؤال يهودي أو نصراني فللمسلم ان يقول له : لقد أجاب عن سؤالك هذا علماء اليهود والنصارى أنفسهم ، حيث اعترفوا صراحة بأن التوراة الأصلية التي نزلت على موسى قد فقدت ، وبعد سنين طوال ادعى من ادعى بأنه يحفظها عن ظهر قلب ، وكتب دعواه هذه ، ثم قال لها كوني توراة موسى فكانت . . ونفس الشيء حدث للإنجيل الأصيل الذي أنزل على عيسى . . ومن الطريف ان إنجيل السيد المسيح (عليه السلام) قد أولد بعد أن فقد عشرات الأناجيل حتى تجاوز عددها الخمسين . . وفي سنة 325 م اجتمع رؤساء النصارى ، وأقروا 4 أناجيل مع ان عيسى نزل عليه إنجيل واحد فقط لا غير باتفاق النصارى ،
فما الذي جعل الواحد أربعة ؟ ولو أقروا ثلاثة أناجيل لقلنا : لكل أقنوم إنجيل . .
ولا شيء أدل على ان هذه الأناجيل من رجال الكنيسة لا من المسيح انها تحدثت عن صلبه ودفنه وخروجه من القبر وصعوده إلى السماء واختتام حياته على الأرض ، فهل نزل عليه الوحي بعد أن صلب ودفن ؟ وإذا أمكن ذلك فهل من الممكن في حكم العقل والواقع أن ينزل عليه الوحي الذي دوّن في الإنجيل بعد أن صعد إلى السماء واختتم حياته على الأرض ؟ .
سؤال ثان : وأين نجد هذا الاعتراف من علماء اليهود والنصارى ؟ .
الجواب : في العديد من كتبهم العربية والأجنبية ، فمن الكتب العربية قاموس الكتاب المقدس الذي اشترك في وضعه 27 عالما ، فلقد جاء في مادة يوشيا من هذا الكتاب ما نصه بالحرف : (مما لا شك فيه ان معظم الأسفار المقدسة أتلف أو فقد في عصر الارتداد عن اللَّه والاضطهاد) . وفي مادة أسفار : (هناك رأي يقول : ان الذي أضفى صفة القانون على أسفار العهد القديم هم كتّاب الأسفار أنفسهم . . ورأي آخر يقول : هم الكتّاب المقودون - أي المؤيدون - بالروح القدس ، ومعهم قادة الدين من اليهود والمسيحيين الذين قبلوا هذه الأسفار بإرشاد الروح القدس أيضا) . وهذا اعتراف لا يقبل الشك بأن الأسفار الأصلية فقدت ، وان جماعة قد كتبوا ما كتبوا أسفارا وأضفوا عليها صفة القداسة من عند أنفسهم على قول ، وبتأييد الروح القدس على قول آخر . . وسواء أخذنا بالقول الأول أم الثاني فالنتيجة واحدة ، وهي الاعتراف القاطع بأن الأسفار الموجودة الآن ما هي بأسفار موسى وعيسى الأصلية لأن هذه قد فقدت ، وحل محلها أسفار جديدة كتبها الذين زعموا القداسة لأنفسهم أو زعمها لهم قوم آخرون ، وكلهم مؤيّدون بالروح القدس . . والروح القدس عندهم هو روح اللَّه الأقنوم الثالث ، وسمي اللَّه روحا لأنه مبدع الحياة : وقدسا لأن من عمله تقديس قلب المؤمن على حد تعبيرهم .
وقد وضع علماء الإسلام عشرات الكتب للدلالة على تحريف التوراة والإنجيل ، منها كتاب (اظهار الحق) للشيخ رحمة اللَّه الهندي ، وفيه مائة شاهد على تحريف التوراة والإنجيل لفظا ومعنى ، أشار إلى هذا الكتاب صاحب تفسير المنار عند
تفسير الآية 46 من سورة النساء . ومن هذه الكتب الرحلة المدرسية للشيخ جواد البلاغي ، وكتاب (محمد رسول اللَّه في بشارات الأنبياء) لمحمد عبد الغفار ، وكتاب (محمد رسول ، هكذا بشرت الأناجيل) لبشري زخاري ميخائيل ، وآخر كتاب قرأته في هذا الموضوع (البشارات والمقارنات) للشيخ محمد الصادقي الطهراني .
صدر حديثا ، وهو متخم بالشواهد القاطعة من كتب اليهود والنصارى على تحريف التوراة والأناجيل المتداولة الآن .
{فَلَمَّا جاءَهُمْ} - أي جاء عيسى بني إسرائيل - {بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ} . لم يكتف اليهود بقولهم عن السيد المسيح (عليه السلام) : انه ساحر ، حتى قالوا : هو ابن النجار ، كما جاء في إنجيل متى اصحاح 13 آية 55 وإنجيل مرقس اصحاح 6 آية 3 . . ينص الإنجيل على ان اليهود قذفوا السيدة العذراء بالزنا . . ومع هذا نرى الكثير من النصارى يتحالفون مع الصهيونية عدوة الأديان والإنسانية بخاصة المسيحية - يتحالف الكثير منهم مع الصهاينة ضد الإسلام وأهل القرآن الذي يقول : {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ} - 78 المائدة . . وان دل هذا التحالف على شيء فإنما يدل على ان المسيحية عند أنصار إسرائيل هي مجرد شعار لمآرب أخرى ، وان دينهم وضميرهم هو الاستيلاء والاعتداء تماما كالصهاينة .
__________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج7 ، ص312-316.
السورة ترغب المؤمنين وتحرضهم على أن يجاهدوا في سبيل الله ويقاتلوا أعداء دينه، وتنبئهم أن هذا الدين نور ساطع لله سبحانه يريد الكفار من أهل الكتاب أن يطفئوه بأفواههم والله متمه ولوكره الكافرون، ومظهره على الدين كله ولوكره المشركون.
وأن هذا النبي الذي آمنوا به رسول من الله أرسله بالهدى ودين الحق، وبشر به عيسى بن مريم (عليهما السلام) بني إسرائيل.
فعلى المؤمنين أن يشدوا العزم على طاعته وامتثال ما يأمرهم به من الجهاد ونصرة الله في دينه حتى يسعدهم الله في آخرتهم وينصرهم ويفتح لهم في دنياهم ويؤيدهم على أعدائهم.
وعليهم أن لا يقولوا ما لا يفعلون ولا ينكصوا فيما يعدون فإن ذلك يستوجب مقتا من الله تعالى وإيذاء الرسول وفيه خطر أن يزيغ الله قلوبهم كما فعل بقوم موسى (عليه السلام) لما آذوه وهم يعلمون أنه رسول الله إليهم والله لا يهدي القوم الظالمين.
والسورة مدنية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم} تقدم تفسيره، وافتتاح الكلام بالتسبيح لما فيها من توبيخ المؤمنين بقولهم ما لا يفعلون وإنذارهم بمقت الله وإزاغته قلوب الفاسقين.
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} {لم} مخفف لما، و{ما} استفهامية، واللام للتعليل، والكلام مسوق للتوبيخ ففيه توبيخ المؤمنين على قولهم ما لا يفعلون ولا يصغى إلى قول بعض المفسرين: أن المراد بالذين آمنوا هم المنافقون والتوبيخ لهم دون المؤمنين لجلالة قدرهم.
وذلك لوفور الآيات المتضمنة لتوبيخهم ومعاتبتهم وخاصة في الآيات النازلة في الغزوات وما يلحق بها كأحد والأحزاب وحنين وصلح الحديبية وتبوك والإنفاق في سبيل الله وغير ذلك، والصالحون من هؤلاء المؤمنين إنما صلحوا نفسا وجلوا قدرا بالتربية الإلهية التي تتضمنها أمثال هذه التوبيخات والعتابات المتوجهة إليهم تدريجا ولم يتصفوا بذلك من عند أنفسهم.
ومورد التوبيخ وإن كان بحسب ظاهر لفظ الآية مطلق تخلف الفعل عن القول وخلف الوعد ونقض العهد وهو كذلك لكونه من آثار مخالفة الظاهر للباطن وهو النفاق لكن سياق الآيات وفيها قوله: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا} وما سيأتي من قوله: {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة} إلخ، وغير ذلك يفيد أن متعلق التوبيخ كان هو تخلف بعضهم عما وعده من الثبات في القتال وعدم الانهزام والفرار أو تثاقلهم أو تخلفهم عن الخروج أو عدم الإنفاق في تجهز أنفسهم أو تجهيز غيرهم.
قوله تعالى: {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} المقت البغض الشديد، والآية في مقام التعليل لمضمون الآية السابقة فهوتعالى يبغض من الإنسان أن يقول ما لا يفعله لأنه من النفاق، وأن يقول الإنسان ما لا يفعله غير أن لا يفعل ما يقوله فالأول من النفاق والثاني من ضعف الإرادة ووهن العزم وهو رذيلة منافية لسعادة النفس الإنسانية فإن الله بنى سعادة النفس الإنسانية على فعل الخير واكتساب الحسنة من طريق الاختيار ومفتاحه العزم والإرادة، ولا تأثير إلا للراسخ من العزم والإرادة، وتخلف الفعل عن القول معلول وهن العزم وضعف الإرادة ولا يرجى للإنسان مع ذلك خير ولا سعادة.
قوله تعالى: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص} الصف جعل الأشياء على خط مستو كالناس والأشجار.
كذا قاله الراغب، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل ولذا لم يجمع، وهو حال من ضمير الفاعل في {يقاتلون}، والمعنى: يقاتلون في سبيله حال كونهم صافين.
والبنيان هو البناء، والمرصوص من الرصاص، والمراد به ما أحكم من البناء بالرصاص فيقاوم ما يصادمه من أسباب الانهدام.
والآية تعلل خصوص المورد – وهو أن يعدوا الثبات في القتال ثم ينهزموا - بالالتزام كما أن الآية السابقة تعلل التوبيخ على مطلق أن يقولوا ما لا يفعلون، وذلك أن الله سبحانه إذا أحب الذين يقاتلون فيلزمون مكانهم ولا يزولون كان لازمه أن يبغض الذين يعدون أن يثبتوا ثم ينهزمون إذا حضروا معركة القتال.
قوله تعالى: {وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم} إلخ، في الآية إشارة إلى إيذاء بني إسرائيل رسولهم موسى (عليه السلام) ولجاجهم حتى آل إلى إزاغة الله قلوبهم.
وفي ذلك نهي التزامي للمؤمنين عن أن يؤذوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيئول أمرهم إلى ما آل إليه أمر قوم موسى من إزاغة القلوب وقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} [الأحزاب: 57].
والآية بما فيها من النهي الالتزامي في معنى قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 69، 70].
وسياق الآيتين وذكر تبرئة موسى (عليه السلام) يدل على أن المراد بإيذائه بما برأه الله منه ليس معصيتهم لأوامره وخروجهم عن طاعته إذ لا معنى حينئذ لتبرئته بل هو أنهم وقعوا فيه (عليه السلام) وقالوا فيه ما فيه عار وشين فتأذى فبرأه الله مما قالوا ونسبوا إليه، وقوله في الآية التالية: {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} يؤيد هذا الذي ذكرناه.
ويؤيد ذلك إشارته تعالى إلى بعض مصاديق إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقول أو فعل في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ - إلى أن قال - وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا }[الأحزاب: 53، 54]
فتحصل أن في قوله: {وإذ قال موسى لقومه} إلخ، تلويحا إلى النهي عن إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقول أو فعل على علم بذلك كما أن في ذيل الآية تخويفا وإنذارا أنه فسق ربما أدى إلى إزاغته تعالى قلب من تلبس به.
وقوله: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين} الزيغ الميل عن الاستقامة ولازمه الانحراف عن الحق إلى الباطل.
وإزاغته تعالى إمساك رحمته وقطع هدايته عنهم كما يفيده التعليل بقوله: {والله لا يهدي القوم الفاسقين} حيث علل الإزاغة بعدم الهداية، وهي إزاغة على سبيل المجازاة وتثبيت للزيغ الذي تلبسوا به أولا بسبب فسقهم المستدعي للمجازاة كما قال تعالى: { يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ} [البقرة: 26] ، وليس بإزاغة بدئية وإضلال ابتدائي لا يليق بساحة قدسه تعالى.
ومن هنا يظهر فساد ما قيل: إنه لا يجوز أن يكون المراد بقوله: {أزاغ الله قلوبهم} الإزاغة عن الإيمان لأن الله تعالى لا يجوز أن يزيغ أحدا عن الإيمان، وأيضا كون المراد به الإزاغة عن الإيمان يخرج الكلام عن الفائدة لأنهم إذا زاغوا عن الإيمان فقد صاروا كفارا فلا معنى لقوله: أزاغهم الله عن الإيمان.
وجه الفساد أن قوله: لا يجوز له تعالى أن يزيغ أحدا عن الإيمان ممنوع بإطلاقه فإن الملاك فيه لزوم الظلم وإنما يلزم فيما كان من الإزاغة والإضلال ابتدائيا وأما ما كان على سبيل المجازاة وحقيقته إمساك الرحمة وقطع الهداية لتسبيب العبد لذلك بفسقه وإعراضه عن الرحمة والهداية فلا دليل على منعه لا عقلا ولا نقلا.
وأما قوله: إن الكلام يخرج بذلك عن الفائدة فيدفعه أن الذي ينسب من الزيغ إلى العبد ويحصل معه الكفر تحقق ما له بالفسق والذي ينسب إليه تعالى تثبيت الزيغ في قلب العبد والطبع عليه به فزيغ العبد عن الإيمان بسبب فسقه وحصول الكفر بذلك لا يغني عن تثبيت الله الزيغ والكفر في قلبه على سبيل المجازاة.
قوله تعالى: {وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} تقدم في صدر الكلام أن هذه الآية والتي قبلها والآيات الثلاث بعدها مسوقة لتسجيل أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رسول معلوم الرسالة عند المؤمنين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره الكافرون من أهل الكتاب، وما جاء به من الدين نور ساطع من عند الله يريد المشركون ليطفئوه بأفواههم والله متم نوره ولوكره المشركون.
فعلى المؤمنين أن لا يؤذوه (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم يعلمون أنه رسول الله إليهم، وأن ينصروه ويجاهدوا في سبيل ربهم لإحياء دينه ونشر كلمته.
ومن ذلك يعلم أن قوله: {وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل} إلخ، كالتوطئة لما سيذكر من كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رسولا مبشرا به من قبل أرسله الله بالهدى ودين الحق ودينه نوره تعالى يهتدي به الناس.
والذي حكاه تعالى عن عيسى بن مريم (عليهما السلام) أعني قوله: {يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} ملخص دعوته وقد آذن بأصل دعوته بقوله: {إني رسول الله إليكم} فأشار إلى أنه لا شأن له إلا أنه حامل رسالة من الله إليهم، ثم بين متن ما أرسل إليهم لأجل تبليغه في رسالته بقوله: {مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول} إلخ.
فقوله: {مصدقا لما بين يدي من التوراة} بيان أن دعوته لا تغاير دين التوراة ولا تناقض شريعتها بل تصدقها ولم تنسخ من أحكامها إلا يسيرا والنسخ بيان انتهاء أمد الحكم وليس بإبطال، ولذا جمع (عليه السلام) بين تصديق التوراة ونسخ بعض أحكامها فيما حكاه الله تعالى من قوله: {ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم{: آل عمران: 50، ولم يبين لهم إلا بعض ما يختلفون فيه كما في قوله المحكي: {قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ} [الزخرف: 63].
وقوله: {ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} إشارة إلى الشطر الثاني من رسالته (عليه السلام) وقد أشار إلى الشطر الأول بقوله: {مصدقا لما بين يدي من التوراة}.
ومن المعلوم أن البشرى هي الخبر الذي يسر المبشر ويفرحه ولا يكون إلا بشيء من الخير يوافيه ويعود إليه، والخير المترقب من بعثة النبي ودعوته هو انفتاح باب من الرحمة الإلهية على الناس فيه سعادة دنياهم وعقباهم من عقيدة حقة أو عمل صالح أوكليهما، والبشرى بالنبي بعد النبي وبالدعوة الجديدة بعد حلول دعوة سابقة واستقرارها والدعوة الإلهية واحدة لا تبطل بمرور الدهور وتقضي الأزمنة واختلاف الأيام والليالي - إنما تتصور إذا كانت الدعوة الجديدة أرقى فيما تشتمل عليه من العقائد الحقة والشرائع المعدلة لأعمال المجتمع وأشمل لسعادة الإنسان في دنياه وعقباه.
وبهذا البيان يظهر أن معنى قوله (عليه السلام): {ومبشرا برسول يأتي من بعدي} إلخ، يفيد كون ما أتى به النبي أحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أرقى وأكمل مما تضمنته التوراة وبعث به عيسى (عليه السلام) وهو(عليه السلام) متوسط رابط بين الدعوتين.
ويعود معنى كلامه: {إني رسول الله إليكم مصدقا} إلخ، إلى أني رسول من الله إليكم أدعو إلى شريعة التوراة ومنهاجها - ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم - وهي شريعة سيكملها الله ببعث نبي يأتي من بعدي اسمه أحمد.
وهو كذلك فإمعان التأمل في المعارف الإلهية التي يدعو إليها الإسلام يعطي أنها أدق مما في غيره من الشرائع السماوية السابقة وخاصة ما يندب إليه من التوحيد الذي هو أصل الأصول الذي يبتنى عليه كل حكم ويعود إليه كل من المعارف الحقيقية وقد تقدم شطر من الكلام فيه في المباحث السابقة من الكتاب.
وكذا الشرائع والقوانين العملية التي لم تدع شيئا مما دق وجل من أعمال الإنسان الفردية والاجتماعية إلا عدلته وحدت حدوده وقررته على أساس التوحيد ووجهته إلى غرض السعادة.
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: {ذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157] ، وآيات أخرى يصف القرآن.
والآية أعني قوله: {ومبشرا برسول يأتي من بعدي} وإن كانت مصرحة بالبشارة لكنها لا تدل على كونها مذكورة في كتابه (عليه السلام) غير أن آية الأعراف المنقولة آنفا: {يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل} وكذا قوله في صفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): {ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل} الآية: الفتح: 29، يدلان على ذلك.
وقوله: {اسمه أحمد} دلالة السياق على تعبير عيسى (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأحمد وعلى كونه اسما له يعرف به عند الناس كما كان يسمى بمحمد ظاهرة لا سترة عليها.
ويدل عليه قول حسان: صلى الإله ومن يحف بعرشه.
والطيبون على المبارك أحمد.
ومن أشعار أبي طالب قوله: وقالوا لأحمد أنت امرؤ.
خلوف اللسان ضعيف السبب.
ألا إن أحمد قد جاءهم.
بحق ولم يأتهم بالكذب.
وقوله مخاطبا للعباس وحمزة وجعفر وعلي يوصيهم بنصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كونوا فدى لكم أمي وما ولدت.
في نصر أحمد دون الناس أتراسا.
ومن شعره فيه (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد سماه باسمه الآخر محمد: أ لم تعلموا أنا وجدنا محمدا.
نبيا كموسى خط في أول الكتب.
ويستفاد من البيت أنهم عثروا على وجود البشارة به (صلى الله عليه وآله وسلم) في الكتب السماوية التي كانت عند أهل الكتاب يومئذ ذاك.
ويؤيده أيضا إيمان جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وفيهم قوم من علمائهم كعبد الله بن سلام وغيره وقد كانوا يسمعون هذه الآيات القرآنية التي تذكر البشارة به (صلى الله عليه وآله وسلم) وذكره في التوراة والإنجيل فتلقوه بالقبول ولم يكذبوه ولا أظهروا فيه شيئا من الشك والترديد.
وأما خلو الأناجيل الدائرة اليوم عن بشارة عيسى بما فيها من الصراحة فالقرآن – وهو آية معجزة باقية - في غنى عن تصديقها، وقد تقدم البحث عن سندها واعتبارها في الجزء الثالث من الكتاب.
وقوله: {فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين} ضمير {جاء} لأحمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وضمير {هم} لبني إسرائيل أولهم ولغيرهم، والمراد بالبينات البشارة ومعجزة القرآن وسائر آيات النبوة.
والمعنى: فلما جاء أحمد المبشر به بني إسرائيل أو أتاهم وغيرهم بالآيات البينة التي منها بشارة عيسى (عليه السلام) قالوا هذا سحر مبين، وقرىء هذا ساحر مبين.
وقيل: ضمير {جاء} لعيسى (عليه السلام)، والسياق لا يلائمه.
__________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج19 ، ص218-224.
المقاتلون المؤمنون صفّ حديدي منيع:
إعتبرت هذه السورة من السور المسبّحات، ذلك لأنّها تبدأ بتسبيح الله في بدايتها: {سبّح لله ما في السموات وما في الأرض}(2).
ولِمَ لا يسبّحونه ولا ينزّهونه من كلّ عيب ونقص: ( وهو العزيز الحكيم)القدير الذي لا يقهر والحكيم المحيط بكلّ شيء علماً.
إنّ الإلتفات إلى مسألة التسبيح العامّ للكائنات، الذي يتمّ بلسان الحال والقال، وكذلك النظام المدهش العجيب الحاكم فيها والذي هو أفضل دليل على وجود خالق عزيز حكيم .. من شأنه تمكين اُسس الإيمان في القلوب، ومن شأنه أيضاً تمهيد الطريق لأمر الجهاد.
ثمّ يضيف الباريء عزّوجلّ في معرض لوم وتوبيخ للأشخاص الذين لم يلتزموا بأقوالهم: {يا أيّها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون}(3).
وعلى الرغم من أنّ سبب نزول الآية كما مرّ بنا كان متعلّقاً بالجهاد في سبيل الله، وما حدث من فرار في غزوة اُحد، ولكن يستفاد من الآية سعة المفهوم الذي تعرّضت له، وبهذا تستوعب كلّ قول لا يقترن بعمل ويستحقّ اللوم والتوبيخ، سواء يتعلّق بالثبات في ميدان الجهاد أو أي عمل إيجابي آخر.
وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ المخاطب في هذه الآيات هم المتظاهرون بالإيمان والمنافقون، مع أنّ الخطاب في هذه الآية موجّه إلى الذين آمنوا، كما أنّ تعبيرات الآيات اللاحقة تبيّن لنا أنّ المخاطب بذلك هم المؤمنون، ولكنّهم لم يصلوا بعد إلى الإيمان الكامل وأعمالهم غير منسجمة مع أقوالهم.
ثمّ يضيف سبحانه مواصلا القول: {كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}(4) حيث التصريحات العلنية في مجالس السمر والإدّعاء بالشجاعة، ولكن ما أن تحين ساعة الجدّ إلاّ ونلاحظ الهروب والنكوص والإبتعاد عن تجسيد الأقوال المدّعاة.
إنّ من السمات الأساسية للمؤمن الصادق هو الإنسجام التامّ بين أقواله وأعماله وكلّما إبتعد الإنسان عن هذا الأصل، فإنّه يبتعد عن حقيقة الإيمان.
«المقت» في الأصل: (البغض الشديد لمن إرتكب عملا قبيحاً) وكان عرب الجاهلية يطلقون عبارة (نكاح المقت) لمن يتزوّج زوجة أبيه. وفي الجملة السابقة نلاحظ إقتران مصطلح «المقت» مع «الكبر»، والذي هو دليل أيضاً على الشدّة والعظمة، كما هو دليل على الغضب الإلهي الشديد على من يطلقون أقوالا ولا يقرنونها بالأعمال.
يقول المرحوم العلاّمة الطباطبائي في الميزان: فرق بين أن يقول الإنسان شيئاً لا يريد أن يفعله، وبين الإنسان الذي لا ينجز عملا يقوله.
فالأوّل دليل النفاق، والثاني دليل ضعف الإرادة(5).
وتوضيح ذلك أنّ الإنسان الذي يقول شيئاً لم يقرّر إنجازه منذ البداية هو على شعبة من النفاق، أمّا إذا قرّر القيام بعمل ما، ولكنّه ندم فيما بعد فهذا دليل ضعف الإرادة.
وعلى كلّ حال، فمفهوم الآية يشمل كلّ تخلّف عن عمد، سواء تعلّق بنقض العهود والوعود أو غير ذلك من الشؤون، حتّى أنّ البعض قال: إنّها تشمل حتّى النذور.
ونقرأ في رسالة الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر أنّه قال: «إيّاك .. أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك .. والخلف يوجب المقت عند الله والناس، قال الله تعالى: ( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)»(6).
كما نقرأ في حديث عن الإمام الصادق أنّه (عليه السلام) قال: «عدة المؤمن أخاه نذر لا كفّارة فيه، فمن أخلف فبخلف الله بدأ، ولمقته تعرّض، وذلك قوله: ( يا أيّها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)»(7).
ثمّ تطرح الآية اللاحقة مسألة مهمّة للغاية في التشريع الإسلامي، وهي موضوع الجهاد في سبيل الله، حيث يقول تعالى: {إنّ الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنّهم بنيان مرصوص}(8).
ونلاحظ هنا أنّ التأكيد ليس على القتال فحسب، بل على أن يكون «في سبيله» تعالى وحده، ويتجسّد فيه ـ كذلك ـ الإتّحاد والإنسجام التامّ والتجانس والوحدة، كالبنيان المرصوص.
«صف» في الأصل لها معنى مصدري بمعنى (جعل شيء ما في خطّ مستو) إلاّ أنّها هنا لها معنى (اسم فاعل).
«مرصوص» من مادّة (رصاص) بمعنى معدن الرصاص، ولأنّ هذه المادّة توضع بعد تذويبها بين طبقات البناء من أجل إستحكامه وجعله قويّاً ومتيناً للغاية، لذا اُطلقت هذه الكلمة هنا على كلّ أمر قوي ومحكم.
والمقصود هنا أن يكون وقوف وثبات المجاهدين أمام العدو قويّاً راسخاً تتجسّد فيه وحدة القلوب والأرواح والعزائم الحديدية والتصميم القوي، بصورة تعكس أنّهم صفّ متراصّ ليس فيه تصدّع أو تخلخل ..
يقول علي بن إبراهيم في تفسيره موضّحاً مقصود هذه الآية: «يصطفّون كالبنيان الذي لا يزول»(9).
وجاء في حديث عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنّه عندما كان يهيء أصحابه للقتال بصفّين، قال: «إنّ الله تعالى قد أرشدكم إلى هذه المسؤولية حيث قال سبحانه: {إنّ الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنّهم بنيان مرصوص} وعلى هذا فاحكموا صفوفكم كالبنيان المرصوص، وقدموا الدّارع، وأخّروا الحاسر، وعظّوا على الأضراس فإنّه أنبى للسيوف عن إلهام، والتووا في أطراف الرماح، فإنّه أمْوَرُ للأسنّة، وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش، وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات، فإنّه أطرد للفشل، ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها، ولا تجعلوها إلاّ بأيدي شجعانكم ...»(10).
وقوله تعالى : {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبَنِى إسرائيل إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِن التَّوْرَيةِ وَمُبَشِّرَاً بِرَسُول يَأْتِي مِن بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ}:
البشارة بظهور النّبي (أحمد):
تأتي الآية الكريمة ـ أعلاه ـ مكمّلة لمحورين أساسيين تحدّثت عنهما الآيات السابقة وهما (الإنسجام بين القول والعمل) و (وحدة الصفّ الإيماني)، لتستعرض لنا زاوية من حياة النبيين العظيمين (موسى وعيسى) (عليهما السلام)، ومتطرّقة إلى طبيعة التناقض والإنفصام بين أقوال أتباعهم وأعمالهم، بالإضافة إلى (عدم إنسجام صفوفهم) وأخيراً المصير السيء الذي انتهوا إليه.
يقول تعالى: {وإذ قال موسى لقومه يا قوم لِمَ تؤذونني وقد تعلمون أنّي رسول الله إليكم}.
هذه الآية لعلّها إشارة إلى مخالفات بني إسرائيل وذرائعهم في حياة موسى(عليه السلام)، أو أنّها إشارة إلى قصّة (بيت المقدس) حيث قال بنو إسرائيل لموسى(عليه السلام): {إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ـ أي الجبّارين ـ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [المائدة: 24] .
ولهذا فقد بقوا في وادي (التيه) أربعين سنة، ذاقوا فيها وبال أمرهم لتهاونهم في أمر الجهاد، ولإدّعاءاتهم الواهية.
ولكن مع الإلتفات إلى الآية (69) من سورة الأحزاب يظهر أنّ المراد من هذا الإيذاء هو ما كانوا ينسبونه لموسى (عليه السلام) من تهم، كما يبيّن ذلك قوله تعالى: {يا أيّها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ممّا قالوا وكان عند الله وجيهاً}.
حيث اتّهم (عليه السلام) بقتل أخيه هارون (عليه السلام)، واُخرى ـ معاذ الله ـ بالعلاقة مع امرأة فاسقة (وذلك ضمن مخطّط قارون للتهرّب من إعطاء الزكاة)، وثالثة بالسحر والجنون، كما أُلصقت به (عليه السلام) عدّة عيوب جسمية اُخرى، جاء شرحها في تفسير الآية ـ أعلاه ـ من سورة الأحزاب(11).
كيف يستسيغ هؤلاء أدعياء الإيمان إلصاق أمثال هذه التّهم بأنبيائهم!؟
إنّ هذه الممارسة تمثّل في الواقع نموذجاً صارخاً للتناقض بين القول والعمل، ممّا حدا بموسى (عليه السلام) إلى مخاطبة أصحابه: لماذا تسيؤون إليّ مع علمكم بأنّي رسول الله إليكم؟
وممّا لا شكّ فيه أنّ هذه الممارسات لم تبق بدون عقاب كما نقرأ ذلك في نهاية الآية حيث، قال تعالى: {فلمّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين}.
وهكذا تنزل بمثل هذا الإنسان أعظم الدواهي، حيث يحرم من الهداية الإلهية وينحرف قلبه عن الحقّ(12).
إنّ ما يستفاد من المفهوم الذي إستعرضته الآية المباركة أنّ الهداية والضلالة وإن كانت من قبل الله سبحانه، إلاّ أنّ مقوّماتها وأرضيتها تكون من الإنسان نفسه، حيث يقول سبحانه: ( فلمّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم) وذلك ما يوضّح أنّ الخطوة الاُولى من الإنسان نفسه، ويقول سبحانه من جهة اُخرى: {والله لا يهدي القوم الفاسقين}.
فإذا صدر من الإنسان ذنب ومعصية فقد يسلب منه التوفيق والهداية الإلهية وعندئذ يصاب بالحرمان الأكبر.
وقد بحثنا مفصّلا في هذا المجال في تفسير الآية (36) من سورة الزمر، (فراجع).
وتشير الآية اللاحقة إلى مسألة تكذيب بني إسرائيل لرسالة عيسى (عليه السلام)ومخالفتهم له، حيث يضيف تعالى: ( وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إنّي رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يديّ من التوراة ومبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد).
وهذا بيان من عيسى (عليه السلام) أنّه يمثّل همزة وصل وحلقة من الرسالة بين نبيين وكتابين واُمّتين، فقد سبقته رسالة موسى (عليه السلام) وكتابه، وستليه رسالة الإسلام على يد النبي العظيم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومن هنا نلاحظ أنّ عيسى (عليه السلام) لم يكن يدّعي غير الرسالة الإلهية وفي مقطع زمني خاصّ، وأنّ ما نسب إليه من الاُلوهية، أو أنّه ابن (لله) كان كذباً وإفتراء محضاً.
وبالرغم من أنّ قسماً من بني إسرائيل قد آمنوا بالرّسول الموعود، إلاّ أنّ الأكثرية الغالبة كان لهم موقف عدائي متشدّد تجاهه، ممّا دعاهم وسوّل لهم إنكار معاجزه الواضحة، وذلك ما يجسّده قوله تعالى: {فلمّا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين}.
العجيب هو أنّ اليهود كانوا قد شخّصوا الرّسول العظيم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل مشركي العرب، وتركوا أوطانهم شوقاً إلى لقائه والإيمان به، حيث استقرّوا في المدينة ترقّباً لظهوره ولإجابة دعوته ..، إلاّ أنّ المشركين قد سبقوهم إلى الإيمان بالرّسول الموعود وبقي الكثير من اليهود على لجاجتهم وإصرارهم وعنادهم وإنكارهم له.
ذهب بعض المفسّرين إلى إرجاع الضمير في ( فلمّا جاءهم) إلى رسول الإسلام (محمّد) كما أوضحناه أعلاه، إلاّ أنّ قسماً آخر يرى أنّه يعود إلى السيّد المسيح (عليه السلام)، أي عندما أتاهم المسيح بالمعاجز الواضحة أنكروها وادّعوا أنّها سحر.
ومن خلال ملاحظة الآيات اللاحقة يتبيّن لنا أنّ الرأي الأوّل أصحّ حيث يتركّز الحديث فيها على رسالة الإسلام ورسوله الكريم.
_________________
1- الامثل ، ناصر مكارما الشيرازي ، ج14 ، ص152-159.
2 ـ تحدّثنا مراراً في هذا التّفسير حول كيفية التسبيح العام لكائنات العالم ومن ضمن ذلك ما ورد في نهاية الآية (44) من سورة الإسراء ونهاية الآية (41) من سورة النور.
3 ـ (لِمَ) في الأصل كانت (لما) (مركبة من لام جارّة، وما إستفهامية) ثمّ سقطت الفها بسبب كثرة الإستعمال.
4 ـ اعتبر بعض المفسّرين (كبر) من أفعال (المدح والذمّ)، (تفسير روح البيان نهاية الآيات مورد البحث)، كما فهم البعض منها معنى التعجّب (تفسير الكشّاف).
5 ـ الميزان، ج19، ص287.
6 ـ نهج البلاغة الرسالة رقم 53 ص444 صبحي الصالح.
7 ـ اُصول الكافي، ج2، باب خلف الوعد.
8 ـ (صفّاً) منصوبة على أنّها حال.
9 ـ نور الثقلين، ج5، ص311.
10 ـ المصدر السابق ، ص310 ، وجاء شبيه بهذا المعنى في نهج البلاغة، خطبة (124)، (صبحي الصالح).
11 ـ التّفسير الأمثل الآية أعلاه من سورة الأحزاب.
12 ـ «زاغوا»: من مادّة (زيغ) بمعنى الإنحراف عن الطريق المستقيم.



|
|
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
|
|
جامعة العميد تحتفي بذكرى ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام)
|
|
|