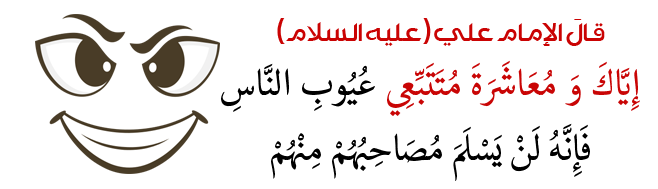
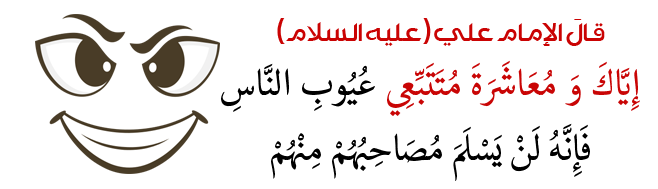

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-2-2017
التاريخ: 24-2-2017
التاريخ: 13-2-2017
التاريخ: 27-2-2017
|
قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء : 97-99] .
أخبر تعالى عن حال من قعد عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الوفاة ، فقال { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ } : أي قبض أرواحهم ، أو تقبض أرواحهم { الْمَلَائِكَةُ } الملائكة : ملك الموت ، أو هو وغيره ، فإن الملائكة تتوفى ، وملك الموت يتوفى ، والله يتوفى ، وما يفعله ملك الموت ، أو الملائكة ، يجوز أن يضاف إلى الله إذ فعلوه بأمره ، وما تفعله الملائكة جاز أن يضاف إلى ملك الموت ، إذ فعلوه بأمره {ظالمي أنفسهم} : أي في حال هم فيها ظالموا أنفسهم ، إذ بخسوها حقها من الثواب ، وأدخلوا عليها العقاب ، بفعل الكفر {قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} : أي قالت لهم الملائكة : فيم كنتم؟ أي في أي شيء كنتم من دينكم ، على وجه التقرير لهم ، أو التوبيخ لفعلهم .
{قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا ، بكثرة عددهم وقوتهم ، ويمنعوننا من الإيمان بالله ، واتباع رسوله على جهة الاعتذار { قَالُوا } أي قالت الملائكة لهم : {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} : أي فتخرجوا من أرضكم ودوركم ، وتفارقوا من يمنعكم من الإيمان بالله ورسوله ، إلى أرض يمنعكم أهلها من أهل الشرك ، فتوحدوه ، وتعبدوه ، وتتبعوا رسوله .
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في معناه : إذا عمل بالمعاصي في أرض ، فاخرج منها . ثم قال تعالى { فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ } : أي مسكنهم جهنم { وَسَاءَتْ } هي : أي جهنم { مَصِيرًا } لأهلها الذين صاروا إليها ، ثم استثنى من ذلك فقال { إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ } الذين استضعفهم المشركون { مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ } وهم الذين يعجزون عن الهجرة ، لإعسارهم ، وقلة حيلتهم ، وهو قوله {لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} في الخلاص من مكة . وقيل : معناه لا يهتدون لسوء معرفتهم بالطريق ، طريق الخروج منها : أي لا يعرفون طريقا إلى المدينة ، عن مجاهد ، وقتادة ، وجماعة من المفسرين .
{ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ } معناه : لعل الله أن يعفو عنهم لما هم عليه من الفقر ، ويتفضل عليهم بالصفح عنهم ، في تركهم الهجرة من حيث لم يتركوها اختيارا { وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا } أي لم يزل الله ذا صفح بفضله ، عن ذنوب عباده ، بترك عقوبتهم على معاصيهم . { غَفُورًا } أي : ساترا عليهم ذنوبهم ، بعفوه لهم عنها .
قال عكرمة : وكان النبي يدعو عقيب صلاة الظهر : " اللهم خلص الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، وضعفة المسلمين ، من أيدي المشركين "!
_________________________
1. مجمع البيان ، ج3 ، ص 169-170 .
كان للمسلمين في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هجرتان من مكة : إحداهما إلى الحبشة ، وكانت لخمس سنين من مبعثه ، والثانية إلى المدينة ، وكانت بعد ثماني سنين من الأولى ، ومن الصحابة من هاجر الهجرتين ، كجعفر بن أبي طالب الذي ختم حياته بالشهادة بعد أن قطعت يداه ، فأكرمه اللَّه عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة ، ومن أجلهما سمي الطيار .
أما سبب الهجرة فهو الابتعاد عن الوقوع في التهلكة ، واللجوء إلى مكان الأمن ، وتدبير الخطة للجهاد المنظم ، ومصارعة الباطل وصرعه . . وبالهجرة وفضلها انتصر الإسلام على أعدائه ، ولولاها لانطفأت شعلته ، وتحول إلى رماد تذروه الرياح ، ومن هنا كانت الهجرة حينذاك هي الفضيلة العظمى ، والمنقبة الأولى التي لا يدانيها شيء .
هاجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة إلى المدينة ، وأمر المسلمين بالهجرة إليها .
فاستجاب له كثيرون ، وتخلف آخرون تمسكا بأموالهم ومصالحهم ، لأن المشركين كانوا لا يدعون مهاجرا يحمل معه شيئا من ماله ، ويشددون عليه بالأذى ، ويمنعونه من إقامة دينه ، وهو عاجز عن الدفاع والمقاومة ، ولكنه كان قادرا على الخلاص والتحرر من الاضطهاد ، وإقامة الدين على أكمل الوجوه بالهجرة من دار الحرب على المسلمين إلى دار الإسلام والأمان ، إلى المدينة ، حيث النبي والصحابة . . لذلك وبخ اللَّه سبحانه الذين آثروا البقاء في دار الكفر والحرب على الدين وأهله ، وبخهم وأنبهم بلسان ملائكة الموت قائلا :
{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ } بترك الجهاد والهجرة إلى دار الإسلام ، والرضا بالبقاء في دار الكفر والإذلال والإخلال بواجبات الدين ، وتكثير الكافرين وتقليل المؤمنين { قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ } أي قال ملائكة الموت للذين تركوا الهجرة : في أي شيء كنتم ؟ . . وليس هذا سؤالا في واقعه ، وإنما هو تأنيب وتبكيت ، وبديهة ان التأنيب يكون على شيء واقع ومعلوم ، وهو هنا تخلفهم عن إخوانهم المهاجرين الذين أطاعوا الرسول في تنفيذ خطته لتحطيم الشرك وإعلاء كلمة اللَّه .
وان سأل سائل : هل كان هذا التوبيخ من ملائكة الموت للمتخلفين حين الاحتضار وقبل الموت ، أم بعده ؟ .
أجبناه : ان علم هذا عند ربي ، وقد سكت عنه ، فنسكت نحن أيضا عما سكت اللَّه عنه ، قال رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : « ان اللَّه سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها » .
{ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ } . هذا اعتذار واعتلال من المتخلفين ، ومعناه ان المتخلفين أجابوا الملائكة الذين أنبوهم على التقصير في أمر الدين ، أجابوهم : كنا عاجزين في دار الشرك عن القيام بواجبات الدين ، لأن المشركين اضطهدونا ، ومنعونا من ممارسة ما نعتقد ، فرد الملائكة هذا الاعتذار و ( قالُوا » - لهم مبكتين - : { أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها } . أي كنتم قادرين على الهجرة إلى دار الإسلام ، حيث تتخلصون من الذل ، وتقيمون الدين في حرية ، كما فعل غيركم من المسلمين . . وان دل هذا الحوار على شيء فإنما يدل على ان اللَّه سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد إتمام الحجة . . بل إلا بعد تراكم الحجج عليه ، بحيث لا يدع للمذنب ملجأ إلا مغفرته تعالى ورحمته التي وسعت كل شيء . . اللهم وأنا شيء فلتسعني رحمتك .
{ فَأُولئِكَ - أي المتخلفون - مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وساءَتْ مَصِيراً إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والْوِلْدانِ } - الذين - لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا } .
بعد أن هدد سبحانه وتوعد المتخلفين استثنى منهم المعذورين لمرض أو عدم النفقة ، وأسقط عنهم تكليف الهجرة ، لأن اللَّه لا يكلف نفسا إلا وسعها .
وتسأل : ان استثناء الرجال والنساء المعذورين له وجه معلوم . . فما الوجه لاستثناء الولدان ، مع العلم بأنهم ليسوا من أهل التكليف ؟ .
وأجيب عن هذا السؤال بأن المراد بالولدان هنا العبيد والإماء . . أما نحن فنجيب بأن كثيرا من الولدان يستطيعون الهجرة بخاصة المراهقين ، بل ان بعضهم أقدر عليها من الكبار ، ومن أجل هذا قد يتوهم متوهم ان الهجرة تجب على من قدر منهم ، فدفع اللَّه هذا التوهم ، وبيّن ان الهجرة تجب على كل قادر إلا إذا كان من الولدان .
________________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، 417-419 .
قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ } لفظ { تَوَفَّاهُمُ } صيغة ماض أو صيغة مستقبل ـ والأصل تتوفاهم حذفت إحدى التاءين من اللفظ تخفيفا ـ نظير قوله تعالى { الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ } [النحل : 28] .
والمراد بالظلم كما تؤيده الآية النظيرة هو ظلمهم لأنفسهم بالإعراض عن دين الله وترك إقامة شعائره من جهة الوقوع في بلاد الشرك والتوسط بين الكافرين حيث لا وسيلة يتوسل بها إلى تعلم معارف الدين ، والقيام بما تندب إليه من وظائف العبودية ، وهذا هو الذي يدل عليه السياق في قوله { قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ } إلى آخر الآيات الثلاث .
وقد فسر الله سبحانه الظالمين ( إذا أطلق ) في قوله { لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً } : [ الأعراف : 45 ] ، ومحصل الآيتين تفسير الظلم بالإعراض عن دين الله وطلبه عوجا ومحرفا ، وينطبق على ما يظهر من الآية التي نحن فيها.
قوله تعالى : { قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ } أي فيما ذا كنتم من الدين ، وكلمة « م » هي ما الاستفهامية حذفت عنها الألف تخفيفا .
وفي الآية دلالة في الجملة على ما تسميه الأخبار بسؤال القبر ، وهو سؤال الملائكة عن دين الميت بعد حلول الموت كما يدل عليه أيضا قوله تعالى : { الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً } : الآيات [ النحل : 30 ] .
قوله تعالى : { قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها } كان سؤال الملائكة { فِيمَ كُنْتُمْ } سؤالا عن الحال الذي كانوا يعيشون فيه من الدين ، ولم يكن هؤلاء المسئولون على حال يعتد به من جهة الدين فأجابوا بوضع السبب موضع المسبب وهو أنهم كانوا يعيشون في أرض لا يتمكنون فيها من التلبس بالدين لكون أهل الأرض مشركين أقوياء فاستضعفوهم فحالوا بينهم وبين الأخذ بشرائع الدين والعمل بها .
ولما كان هذا الذي ذكروه من الاستضعاف ـ لو كانوا صادقين فيه ـ إنما حل بهم من حيث إخلادهم إلى أرض الشرك ، وكان استضعافهم من جهة تسلط المشركين على الأرض التي ذكروها ، ولم تكن لهم سلطة على غيرها من الأرض فلم يكونوا مستضعفين على أي حال بل في حال لهم أن يغيروه بالخروج والمهاجرة كذبتهم الملائكة في دعوى الاستضعاف بأن الأرض أرض الله كانت أوسع مما وقعوا فيه ولزموه ، وكان يمكنهم أن يخرجوا من حومة الاستضعاف بالمهاجرة ، فهم لم يكونوا بمستضعفين حقيقة لوجود قدرتهم على الخروج من قيد الاستضعاف ، وإنما اختاروا هذا الحال بسوء اختيارهم.
فقوله { أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها } الاستفهام فيه للتوبيخ كما في قوله { فِيمَ كُنْتُمْ } ويمكن أن يكون أول الاستفهامين للتقرير كما هو ظاهر ما مر نقله من آيات سورة النحل لكون السؤال فيها عن الظالمين والمتقين جميعا ، وثاني الاستفهامين للتوبيخ على أي حال.
وقد أضافت الملائكة الأرض إلى الله ، ولا يخلو من إيماء إلى أن الله سبحانه هيأ في أرضه سعة أولا ثم دعاهم إلى الإيمان والعمل كما يشعر به أيضا قوله بعد آيتين { وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً } (الآية) .
ووصف الأرض بالسعة هو الموجب للتعبير عن الهجرة بقوله { فَتُهاجِرُوا فِيها } أي تهاجروا من بعضها إلى بعضها ، ولو لا فرض السعة لكان يقال : فتهاجروا منها.
ثم حكم الله في حقهم بعد إيراد المساءلة بقوله {فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً} .
قوله تعالى : { إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ } ، الاستثناء منقطع ، وفي إطلاق المستضعفين على هؤلاء بالتفسير الذي فسره به دلالة على أن الظالمين المذكورين لم يكونوا مستضعفين لتمكنهم من رفع قيد الاستضعاف عن أنفسهم وإنما الاستضعاف وصف هؤلاء المذكورين في هذه الآية ، وفي تفصيل بيانهم بالرجال والنساء والولدان إيضاح للحكم الإلهي ورفع للبس. وقوله { لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً } الحيلة كأنها بناء نوع من الحيلولة ثم استعملت استعمال الآلة فهي ما يتوسل به إلى الحيلولة بين شيء وشيء أو حال للحصول على شيء أو حال آخر ، وغلب استعماله في ما يكون على خفية وفي الأمور المذمومة ، وفي مادتها على أي حال معنى التغير على ما ذكره الراغب في مفرداته (2) .
والمعنى : لا يستطيعون ولا يتمكنون أن يحتالوا لصرف ما يتوجه إليهم من استضعاف المشركين عن أنفسهم ، ولا يهتدون سبيلا يتخلصون بها عنهم فالمراد من السبيل على ما يفيده السياق أعم من السبيل الحسي كطريق المدينة لمن يريد المهاجرة إليها من مسلمي مكة ، والسبيل المعنوي وهو كل ما يخلصهم من أيدي المشركين ، واستضعافهم لهم بالعذاب والفتنة .
( كلام في المستضعف )
يتبين بالآية أن الجهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور وضعف ليس فيه صنع للإنسان الجاهل كان عذرا عند الله سبحانه.
توضيحه : أن الله سبحانه يعد الجهل بالدين وكل ممنوعية عن إقامة شعائر الدين ظلما لا يناله العفو الإلهي ، ثم يستثني من ذلك المستضعفين ويقبل منهم معذرتهم بالاستضعاف ثم يعرفهم بما يعمهم وغيرهم من الوصف ، وهو عدم تمكنهم مما يدفعون به المحذور عن أنفسهم ، وهذا المعنى كما يتحقق فيمن أحيط به في أرض لا سبيل فيها إلى تلقي معارف الدين لعدم وجود عالم بها خبير بتفاصيلها ، أو لا سبيل إلى العمل بمقتضى تلك المعارف للتشديد فيه بما لا يطاق من العذاب مع عدم الاستطاعة من الخروج والهجرة إلى دار الإسلام والالتحاق بالمسلمين لضعف في الفكر أو لمرض أو نقص في البدن أو لفقر مالي ونحو ذلك كذلك يتحقق فيمن لم ينتقل ذهنه إلى حق ثابت في المعارف الدينية ولم يهتد فكره إليه مع كونه ممن لا يعاند الحق ولا يستكبر عنه أصلا بل لو ظهر عنده حق اتبعه لكن خفي عنه الحق لشيء من العوامل المختلفة الموجبة لذلك .
فهذا مستضعف لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا لا لأنه أعيت به المذاهب بكونه أحيط به من جهة أعداء الحق والدين بالسيف والسوط ، بل إنما استضعفته عوامل أخر سلطت عليه الغفلة ، ولا قدرة مع الغفلة ، ولا سبيل مع هذا الجهل.
هذا ما يقتضيه إطلاق البيان في الآية الذي هو في معنى عموم العلة ، وهو الذي يدل عليه غيرها من الآيات كقوله تعالى { لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ } [ البقرة : 286 ] فالأمر المغفول عنه ليس في وسع الإنسان كما أن الممنوع من الأمر بما يمتنع معه ليس في وسع الإنسان .
وهذه الآية أعني آية البقرة كما ترفع التكليف بارتفاع الوسع كذلك تعطي ضابطا كليا في تشخيص مورد العذر وتمييزه من غيره ، وهو أن لا يستند الفعل إلى اكتساب الإنسان ، ولا يكون له في امتناع الأمر الذي امتنع عليه صنع ، فالجاهل بالدين جملة أو ، بشيء من معارفه الحقة إذا استند جهله إلى ما قصر فيه وأساء الاختيار استند إليه الترك وكان معصية ، وإذا كان جهله غير مستند إلى تقصيره فيه أو في شيء من مقدماته بل إلى عوامل خارجة عن اختياره أوجبت له الجهل أو الغفلة أو ترك العمل لم يستند الترك إلى اختياره ، ولم يعد فاعلا للمعصية ، متعمدا في المخالفة ، مستكبرا عن الحق جاحدا له ، فله ما كسب وعليه ما اكتسب ، وإذا لم يكسب فلا له ولا عليه .
ومن هنا يظهر أن المستضعف صفر الكف لا شيء له ولا عليه لعدم كسبه أمرا بل أمره إلى ربه كما هو ظاهر قوله تعالى بعد آية المستضعفين { فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً } وقوله تعالى {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [ براءة : 106 ] ورحمته سبقت غضبه .
قوله تعالى : { فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ } (3) ، هؤلاء وإن لم يكسبوا سيئة لمعذوريتهم في جهلهم لكنا بينا سابقا أن أمر الإنسان يدور بين السعادة والشقاوة وكفى في شقائه أن لا يجوز لنفسه سعادة ، فالإنسان لا غنى له في نفسه عن العفو الإلهي الذي يعفى به أثر الشقاء سواء كان صالحا أو طالحا أو لم يكن ، ولذلك ذكر الله سبحانه رجاء عفوهم .
وإنما اختير ذكر رجاء عفوهم ثم عقب ذلك بقوله { وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً } اللائح منه شمول العفو لهم لكونهم مذكورين في صورة الاستثناء من الظالمين الذين أوعدوا بأن مأواهم جهنم وساءت مصيرا .
_________________________
1. تفسير الميزان ، ج5 ، ص 43-47 .
2. قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن - مادة حول - " والحيلة والحويلة ما يتوصل به إلى حالة ما في بغية وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث وقد تستعمل فيما فيه كلمة ولهذا قيل في وصف الله عزوجل : {وهو شديد المحال} [الرعد : 13] . أي : الوصول ف نفيةٍ من الناس إلى ما فيه حكمه .. والحيلة من الحول ولكن قلبت وأوها ياء لأنكسار ما قبلها ومنه قيل : رجل حُولٌ . انتهى .
قول تعالى : {والوالدان} ثم يتعرض المحقق قدس سره لمعناه . وقد أرجع الزمخشري معناه إلى ثلاثة احتمالات الأول : الأطفال ، الثاني : المراهقون ، والثالث : العبيد والإماء قال في الكشاف " فإن قلت : كيف أدخل الوالدان في جملة المستثنين كأنهم يستبقون الوعيد مع الرجال والنساء لو استطاعوا حيلة اهتدوا سبيلاً ؟ قلت : الرجال والنساء قد يكونون مستطيعين مهتدين وقد لا يكونون كذلك وأما الوالدان فلا يكونون إلا عاجزين عن ذلك فلا يتوجه عليهم وعيد لأن سبب خروج الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد إنما هو كونهم عاجزين فإذا كان العجز متمكناً في الولدان لا ينفكون عنه كانوا خارجين من جملتهم ضرورة . هذا إذا أريد بالولدان الأطفال ويجوز أن يراد بهم المراهقون منهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء فيليحقوا بهم في التكليف وإن أريد بهم العبيد البالغون فلا سؤال .
3. قال في الكشاف : فإن قلت لم قيل " عسى الله أن يعفو عنهم " بكلمة الأطماع ؟ قلت : للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه حتى أن المضطر بين الاضطرار من حقه أن يقول عسى الله أن يعفو عني فكيف بغيره . انتهى واعلم أن العفو مشروط بحسن النية وقصد الهجرة فإن ترك الهجرة أمر خطير لابد للمؤمن أن يعده ذنباً - وإن كان مضطراً - ويلزمه أن يترصد الفرصة من الهجرة ويعلق قلبه بها أبداً .
تشير الآيات الثلاث الأخيرة إلى المصير الأسود الذي كان من نصيب أولئك الذين ادعوا الإسلام ولكنهم رفضوا أن يطبقوا خطة الإسلام في الهجرة ، فانحرفوا إلى مزالق رهيبة ، فكانت نتيجة انحرافهم أن أصابهم القتل وهم في صفوف المشركين.
فالقرآن الكريم يذكر كيف أنّ الملائكة لدى قبضهم لأرواح هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ، يسألونهم عن حالهم في الدنيا وأنّهم لو كانوا حقا من المسلمين ، فلما ذا اشتركوا في صفوف المشركين لقتال المسلمين {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ...) فيجيب هؤلاء بأنّهم تعرضوا في مواطنهم للضغط وأن ذلك أعجزهم عن تنفيذ الأمر الإلهي (قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} .
لكن عذرهم هذا لم يقبل منهم ، إذ يرد الملائكة عليهم قائلين : لما ذا لم تتركوا موطن الشرك وتنجوا بأنفسكم من الظلم ، والكبت عن طريق الهجرة إلى أرض غير أرضكم من أرض الله الواسعة ، {قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها} .
وفي النهاية تشير الآية إلى مصير هؤلاء فتقول بأنّ الذين امتنعوا عن الهجرة لأسباب واهية أو لمصالحهم الشخصية ، وقرروا البقاء في محيط ملوث وفضلوا الكبت والقمع على الهجرة فإن مكان هؤلاء سيكون في جهنم ، وإن نهايتهم وعاقبتهم هناك ستكون سيئة لا محالة : {فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً} .
أمّا الآية الاخرى من الآيات الثلاث المذكورة ، فهي تستثني المستضعفين والعاجزين الحقيقيين لا المزيفين ، فتقول : إنّ أولئك الرجال والنساء والأطفال الذين لم يجدوا لأنفسهم مخرجا للهجرة ، ولم يتمكنوا من إيجاد وسيلة للنجاة من محيطهم الملوث ، فهم مستثنون من حكم العذاب ، لأنّ هؤلاء معذورون في الحقيقة ، وإنّ الله لا يكلف نفسا ما لا تطيق ، {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} .
والآية الأخيرة من الآيات الثلاث المذكورة تبيّن احتمال أن يشمل الله بعفوه هؤلاء، إذ تقول : {فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً} .
سؤال : وقد يرد هنا سؤال وهو : لو أن هؤلاء الأشخاص كانوا في الحقيقة معذورين ، فلما ذا لا تعدهم الآية بعفو إلهي حتمي ، بل تبين احتمال أن يشملهم هذا العفو إذ تأتي الآية بعبارة «عسى» لتأكيد احتمالية الأمر؟
والجواب : هذا السؤال هو نفس الجواب الذي ذكرناه في ذيل الآية (٨٤) من سورة النساء والذي بيّنا من خلاله أن القصد من استخدام مثل هذه العبارات هو أن الحكم الوارد في الآية مقيد بشروط خاصّة يجب الالتفات إليها ، وهنا يكون الشرط هو أن يتبادر هؤلاء المستضعفون حقيقة إلى الهجرة ـ دون تردد ـ حتى ما سنحت لهم فرصة ذلك دون أن يقصروا في هذا الأمر فعند ذلك يشملهم العفو الإلهي .
__________________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 267-268.



|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يحتفي بذكرى عيد الغدير في بغداد
|
|
|