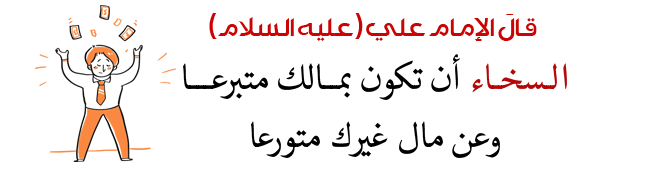
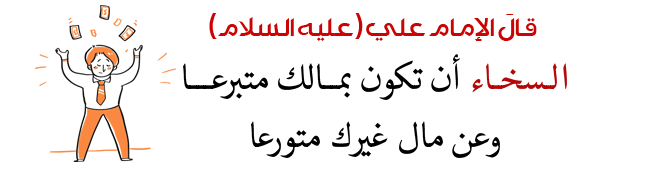

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2014
التاريخ: 25-10-2014
التاريخ: 25-10-2014
التاريخ: 25-10-2014
|
واعلم أنّ الإرادة في اللغة : المشيئة وقد اختلف في معناها الاصطلاحيّ ، فقيل : هي عبارة عن اعتقاد النفع ـ سواء يقينيا أو غيره ـ فالقادر الذي يكون نسبة قدرته إلى طرفي المقدور ـ أعني الفعل والترك ـ بالسويّة ، إذا اعتقد نفعا في أحد طرفيه ، يرجّح ذلك الطرف عنده ، وصار هذا الاعتقاد مع القدرة مخصّصا لوقوعه منه.
وقيل : هذا الاعتقاد هو المسمّى بالداعي إلى الفعل أو الترك. وأمّا الإرادة ، فهي ميل يعقب اعتقاد النفع ، كما أنّ الكراهة انقباض يعقب اعتقاد الضرر ؛ وذلك لأنّا كثيرا نعتقد نفعا في شيء ولا نريده إلاّ إذا أحدث فينا ميل بعد هذا الاعتقاد.
وردّ بأنّا لا نجعلها مجرّد اعتقاد النفع أو ظنّه ، بل نفع له أو لغيره ممّن يؤثر خيره بحيث يمكن وصول ذلك النفع إليه أو إلى غيره إذا لم يكن هناك مانع من تعب أو معارضة.
وما ذكر من الميل إنّما يحصل لمن لا يقدر على تحصيل ذلك الشيء قدرة تامّة كالشوق إلى المحبوب لمن لا يصل إليه. وأمّا القادر التامّ القدرة ، فيكفي فيه الاعتقاد المذكور.
وذهبت الأشاعرة ـ على ما حكي عنهم (1) ـ إلى أنّ الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه ، فلا يكون شيء منهما لازما فضلا عن أن يكون نفسها ؛ فإنّ الهارب عن السبع إذا ظهر له طريقان متساويان في الإفضاء إلى المقصود يختار أحدهما باختياره من غير توقّف على ترجيح أحدهما لنفع يعتقده فيه ، ولا على ميل يتبعه ، بل يرجّح أحدهما على الآخر بمجرّد الإرادة ؛ إذ لا يخطر بباله طلب مرجّح ، ولهذا لم يتوقّف متفكّرا أصلا ، بل لا يخطر بباله سوى النجاة.
وكذلك العطشان إذا كان عنده قدحان متساويان من كلّ جهة.
وأجيب بأنّ المرجّح موجود وهو شاعر به وإن لم يكن شاعرا بأنّه شاعر لأجل الدهشة ؛ وذلك لأنّ الطبيعة تقتضي سلوك الطريق الذي على يساره ؛ لأنّ القوّة أكثر ، والقويّ يدفع الضعيف كما يشاهد فيمن يدور على عقبه.
وأمّا القدحان فيختار ما هو الأقرب إلى اليمين.
ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّ الهارب عن السبع ليس فيه إرادة وشعور أحيانا ، وفي صورة الشعور يرجّح أحد الطريقين ؛ لمرجّح يقتضيه.
وبالجملة ، فالإرادة على الأوّل عبارة عن العلم بالمصلحة أو المفسدة في الفعل أو الترك ، الذي يوجب الميل إلى أحدهما ، فمعنى كونه تعالى مريدا أنّه يفعل الأشياء بالقصد والشعور والإرادة والعلم بكونها ممّا فيه مصلحة.
والمشيئة عبارة عن الميل إلى أحدهما وطلبه.
والاختيار عبارة عن ترجيح الفعل أو الترك فيفعل أو يترك.
والثلاثة متلازمة الوجود بالنسبة إلى الله تعالى ؛ لأنّه تعالى غنيّ مطلق ، وقادر مطلق ، وفعل الأشياء وتركها منوطان إلى المصلحة والمفسدة الراجعتين إلى المخلوق ، فالعلم بالمصلحة المخصوصة بوقت يقتضي اختيار الفعل ؛ لعدم وجود المعارض والمنازع بالنسبة إليه تعالى واستحالة التردّد فيه تعالى بخلاف غيره تعالى ؛ فإنّه يمكن أن يعلم مصلحة شيء ولا يطلبه ، أو يطلبه ولا يختاره ؛ لعدم القدرة عليه.
وقد يحصل العلم بالمصلحة والمفسدة بعد التردّد وقد لا يحصل.
وكيف كان فإذا كان الإرادة من شعب العلم ، يكون وجه ثبوتها له تعالى ووجه كونها عين الذات ظاهرين ... مضافا إلى أنّ تخصيص بعض الممكنات بالوقوع دون بعض ، وفي بعض الأوقات دون بعض ـ مع استواء نسبته إلى الكلّ ـ لا بدّ له من مخصّص غير خارج ؛ لئلاّ يلزم احتياج الواجب في فاعليّته إلى أمر منفصل ، وذلك المخصّص هو الإرادة.
ويظهر ممّا ذكر أنّه تعالى كاره ؛ لأنّ إرادة الشيء تستلزم كراهة ضدّه إن لم تكن نفسها ، مضافا إلى أنّه تعالى نهى العباد ـ بالنهي التنزيهي ـ عن المكروهات ، فهو تعالى يكون كارها لها ، فالكراهة من متفرّعات الإرادة ، وهذا في إرادة الواجب.
وأمّا إرادة الممكن ، فلها مراتب حاصلة بعد الخطور :
الأولى : الميل الحاصل من اعتقاد النفع.
والثانية : العزم الذي هو توطين النفس إلى أحد الأمرين بعد سابقة التردّد فيهما.
والثالثة : الجزم الحاصل بعد زوال التردّد بالكلّيّة.
ولا يستلزم شيء منها الفعل ؛ لإمكان أن يجزم بأنّه سيقصد الفعل وقد حصل زوال التردّد بالكلّيّة ؛ لزوال شرط من شرائط الفعل أو حدوث مانع من موانعه ، فلا يوجد الفعل ، فإذا لم يكن ذلك التوطين البالغ حدّ الجزم موجبا للفعل ، فالذي لم يبلغه كان أولى بعدم الإيجاب.
والرابعة : القصد ، وهي الإرادة المقارنة للفعل التي لم تنفكّ عنه ، فكلّ فعل اختياريّ للممكن مسبوق بالأحوال الخمسة ، بل الستّة إن قلنا بأنّ الشوق الحاصل من اعتقاد النفع المسمّى بالميل غير نفس ذلك الاعتقاد ، كما هو الظاهر.
والدليل النقليّ على ذلك قوله تعالى : {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82]وقوله تعالى : {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هود: 107] ونحو ذلك.
وقال الفاضل اللاهيجي :
« الدليل على ثبوت الإرادة له تعالى ـ بعد ما اتّفق جميع أرباب العقول وأهل الملل على إطلاق القول بأنّه تعالى مريد ، وشاع ذلك في كلام الله عزّ وجلّ وكلام الأنبياء : ـ هو كونه تعالى قادرا ؛ فإنّ القادر لا يصحّ أن يصدر عنه ـ من حيث هو قادر ـ أحد الطرفين بخصوصه ؛ لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين ، بل لا بدّ من أن يتخصّص ويترجّح أحد الطرفين ليصحّ صدوره عنه ، ويكون ذلك لا محالة بصفة شأنها ذلك ؛ لامتناع التخصيص من غير مخصّص ، واحتياج الواجب تعالى في فاعليّته إلى أمر منفصل.
ولا يمكن أن يكون المخصّص هو مطلق العلم ؛ لكونه كالقدرة في تساوي النسبة إلى الطرفين.
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : ( وتخصيص بعض الممكنات ) دون بعض ( بالإيجاد في وقت) دون وقت ( يدلّ على إرادته ).
ثمّ الفرق بين الإرادة والاختيار هو أن الاختيار إيثار لأحد الطرفين وميل إليه ، والإرادة هو القصد إلى إصدار ما يؤثره ويميل إليه. وأمّا في البارئ تعالى ، فيشبه أن يكون كلاهما واحدا.
وأمّا المشيئة ففي شرح المقاصد : أنّه لا فرق بينها وبين الإرادة إلاّ عند الكراميّة ؛ حيث جعلوا المشيئة صفة واحدة أزليّة تتناول ما شاء الله بها من إحداث محدث ، والإرادة حادثة متعدّدة تعدّد (2) المرادات (3).
ثمّ اختلفوا في أرادته تعالى (4) : فعند الأشاعرة وجمهور معتزلة البصرة : صفة قديمة زائدة على الذات ، قائمة بها كسائر الصفات الحقيقيّة عندهم.
وعند الجبائيّة : صفة زائدة قائمة لا بمحلّ.
وعند الكرامية : صفة حادثة قائمة بالذات.
وعند ضرار : نفس الذات.
وعند النجّار : صفة سلبيّة هي كون الفاعل ليس بمكره ولا ساه.
وعند الفلاسفة : العلم بالنظام الأكمل.
وعند الكعبي : إرادته لفعله تعالى العلم به ، ولفعل غيره الأمر.
وعند المحقّقين من المعتزلة كأبي الحسن وجماعة من رؤساء المعتزلة كالنّظام والجاحظ والعلاّف والبلخيّ والخوارزميّ : العلم بما في الفعل من المصلحة. ويسمّيه أبو الحسين بالداعي، واختاره المصنّف ، فقال : ( وليست زائدة على الداعي وإلاّ لزم التسلسل أو تعدّد القدماء ).
يعني لو كانت الإرادة زائدة على الداعي الذي هو عين الذات ، لكانت إمّا حادثة في الذات ـ على ما زعمه الكراميّة ـ أو لا في محلّ ـ على ما زعمه الجبائيّة ـ وعلى التقديرين يلزم التسلسل ؛ لأنّ حدوث الإرادة يستلزم ثبوت إرادة أخرى مخصّصة للأولى ، ويعود الكلام فيهما. وإمّا قديمة قائمة بذاته تعالى ـ على ما زعمه الأشاعرة ـ فيلزم تعدّد القدماء.
واعلم أنّ إرادته تعالى عند جمهور المتكلّمين عبارة عن القصد إلى إصدار الفعل كما في المشاهد (5).
وعند الفلاسفة يمتنع القصد على الواجب تعالى ؛ لأنّ الفاعل بالقصد يكون فعله لغرض ، وكلّ قاصد للغرض مستكمل به سواء كان الغرض عائدا إليه أو إلى غيره ؛ لأنّ إيصال النفع إلى الغير إذا كان عن قصد شوقي يكون استكمالا (6).
قال الشيخ في الإشارات : الجود إفادة ما ينبغي لا لعوض ، ولعلّ من يهب السكّين لمن لا ينبغي ليس بجواد ، ولعلّ من يهب ليستعيض معامل ليس بجواد. وليس العوض كلّه عينا بل وغيره حتّى الثناء والمدح والتخلّص من المذمّة والتوسّل إلى أن يكون على الأحسن ، أو على ما ينبغي، فمن جاد ليشرف ، أو ليحمد ، أو ليحسن به ما يفعل ، فهو مستعيض غير جواد ، فالجواد الحقّ هو الذي يفيض منه الفوائد لا لشوق منه وطلب قصديّ لشيء يعود إليه. واعلم أنّ الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به ، أو لم يحسن منه ، فهو [ بما ] (7) يفيده من فعله متخلّص (8). انتهى.
وما قيل (9) من أنّه لم لا يجوز أن يقصد أحد شيئا يحبّه بمجرّد أنّه خير في نفسه لا لأنّه خير له؟ فجوابه أنّ ما هو خير في نفسه لو لم يكن أولى به ، لم يكن إرادته قصدا ، بل يكون الداعي إلى فعله مجرّد العلم بخيريّته لا أمر آخر ، فيكون إرادته عقليّة محضة.
نعم ، البارئ تعالى يحبّ ذاته ويبتهج بها أجلّ ابتهاج ، فيحبّ أفعاله لأجل ذاته ؛ لأنّ من أحبّ شيئا أحبّ آثاره ، فيثبتون لأفعاله غرضا هو ذاته. وهذا معنى قولهم : إنّه هو الفاعل والغاية ، لكن بذلك لا يصحّح تعلّق القصد بأفعاله ؛ لأنّ القصد إنّما يكون عن شوق إلى ملائم أو موافق لو لم يحصل لم يكن الفاعل على كماله ، فواجب الوجود ليس فاعلا بالقصد عند الفلاسفة ، بل فاعلا بالعناية ، فإرادته تعالى عندهم عبارة عن عنايته أعني علمه بنظام الكلّ ، الذي هو السبب لهذا النظام المشاهد ...
قال الشيخ في إلهيّات الشفاء : فذلك النظام لأنّه يعقله هو مستفيض كائن موجود ، وكلّ معلوم الكون ، وجهة الكون عن مبدئه عند مبدئه وهو خير غير مناف وهو تابع لخيريّة ذات المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتيهما ، فذلك الشيء مراد ، لكن ليس مراد الأوّل على نحو مرادنا حتّى يكون له فيما يكون عنه غرض ، فكأنّك قد علمت استحالة هذا وستعلم ، بل هو لذاته مريد هذا النحو من الإرادة العقليّة (10).
ثمّ قال : فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه ، ولا مغايرة المفهوم لعلمه ، فقد بيّنّا أنّ العلم هو بعينه الإرادة التي له. وهذه الإرادة ـ على الصورة التي حقّقناها ، التي لا تتعلّق بغرض في فيض الوجود ـ لا تكون غير نفس الفيض وهو الجود ، فقد كنّا حقّقنا لك من أمر الجود ما إذا تذكّرته ، علمت أنّ هذه الإرادة نفسها تكون جودا (11).
وقال في رسالته (12) في إثبات المبدأ الأوّل : فصل في بيان إرادته.
هذه الموجودات كلّها صادرة عن ذاته ، ومن مقتضى ذاته ، فهي غير منافية له ، ولأنّه يعشق ذاته ، فهذه الأشياء كلّها مرادة لأجل ذاته ، فكونها مرادة له ليس لأجل غرض ، بل لأجل ذاته ؛ لأنّها مقتضى ذاته ، فليس يريد هذه الموجودات لأنّها هي ، بل لأجل ذاته ، ولأنّها مقتضى ذاته.
مثلا لو كنت تعشق شيئا لكان جميع ما يصدر عنه معشوقا لك لأجل ذلك الشيء. ونحن إنّما نريد الشيء لأجل الشهوة أو اللذّة لا لأجل ذات الشيء المراد ، ولو كانت الشهوة أو اللذّة أو غيرهما من الأشياء شاعرة بذاتها ، وكان مصدرا لأفعال عنها ذاتها ، لكانت مريدة لتلك الأشياء لذاتها ؛ لأنّها صادرة عن ذاتها ، والإرادة لا تكون إلاّ لشاعر بذاته ، وكلّ ما يصدر عن فاعل فإنّه إمّا أن يكون بالذات أو بالعرض ، وما يكون بالذات يكون إمّا طبيعيّا وإمّا إراديا ، وكلّ فعل يصدر عن علم فإنّه لا يكون بالطبع ولا بالعرض ، فإذن يكون بالإرادة.
وكلّ فعل يصدر عن فاعل والفاعل يعرف صدوره عنه ، ويعرف أنّه فاعله ، فإنّ ذلك الفعل صدر عن علم ، وكلّ فعل صدر عن إرادة فإمّا أن يكون مبدأ تلك الإرادة علما أو ظنّا أو تخيّلا.
مثال ما يصدر عن العلم فعل المهندس أو الطبيب ، ومثال ما يصدر عن الظنّ التحرّز ممّا فيه خطر ، ومثال ما يصدر عن التخيّل فإمّا أن يكون شيئا يشبه شيئا عاليا ، أو طلبا لشيء يشبه شيئا حسنا ليخلصه بمشابهة الأمر العالي أو الأمر الحسن.
ولا يجوز أن يكون فعل واجب الوجود بحسب الظنّ أو بحسب التخيّل ؛ فإنّ ذلك يكون لغرض ، ويكون معه انفعال ؛ فإنّ الغرض يؤثّر في ذي الغرض فإذن ينفعل عنه ، وواجب الوجود بذاته ص2 من جهة انفعاله عن الغرض ، فلا يكون واجب الوجود بذاته ، فإذن يجب أن يكون إرادته علميّة.
ثمّ قال : الأولى أن نفصّل أمر الإرادة ، فنقول : نحن إذا أردنا شيئا ، فإنّا نتصوّر ذلك الشيء تصوّرا إمّا ظنّيّا وإمّا تخيّليا وإمّا علميّا ، وأنّ ذلك الشيء المتصوّر موافق ، والموافق هو أن يكون حسنا أو نافعا ، ثمّ يتبع هذا التصوّر والاعتقاد شوق إليه وإلى تحصيله ، فإذا قوي الشوق والإجماع حرّكت القوّة التي في العضلات الآليّة إلى تخيّله.
ولهذا السبب تكون أفعالنا تابعة للغرض ، وقد بيّنّا أنّ واجب الوجود تامّ ، بل فوق التامّ ، فلا يصحّ أن يكون فعله لغرض ، فلا يصحّ أن يعلم أنّ شيئا هو موافق له ، فيشتاقه ثمّ يحصّله ، فإذن إرادته من جهة العلم أن يعلم أنّ ذلك الشيء كونه خير من لا كونه ، وأنّ وجود ذلك يجب أن يكون على الوجه الفلانيّ حتّى يكون وجودا فاضلا ، فلا يحتاج بعد هذا العلم إلى إرادة أخرى ليكون هذا الشيء موجودا ، بل نفس علمه بنظام الأشياء الممكنة على الترتيب الفاضل هو سبب موجب لوجود تلك الأشياء على النظام الموجود والترتيب الفاضل.
فلوازم ذاته ـ أعني المعلومات ـ لم يعلمها ، ثمّ رضي بها ، بل لمّا كان صدورها عن مقتضى ذاته ، كان نفس صدورها عنه رضاه بها ، فإذا لم يكن صدورها عنه منافيا لذاته ، بل مناسب لذات الفاعل ، وكلّ ما كان غير مناف وكان مع ذلك يعلم الفاعل أنّه فاعله ، فهو مراده ؛ لأنّه مناسب له ، فنقول : هذه المعلومات صدرت عن مقتضى ذات الواجب الوجود بذاته المعشوقة له مع علم منه بأنّه فاعلها وعلّتها ، وكلّ ما صدر عن شيء على هذه الصفة فهو غير مناف لذلك الفاعل ، وكلّ فعل يصدر عن فاعل ـ وهو غير مناف له ـ فهو مراده.
فإذن الأشياء كلّها مرادة لواجب الوجود. وهذا هو المراد الخالي عن الغرض ؛ لأنّ الغرض في رضاه بصدور تلك الأشياء عنه أنّه مقتضى ذاته المعشوقة ، فيكون رضاه بتلك الأشياء لأجل ذاته ، فيكون الغاية في فعله ذاته.
ومثال هذا إذا أحببت شيئا لأجل إنسان ، كان المحبوب بالحقيقة ذلك الإنسان ، فكذلك المعشوق المطلق هو ذاته.
ومثال الإرادة فينا أنّا نريد شيئا فنشتاقه ؛ لأنّا محتاجون إليه ، وواجب الوجود يريده على الوجه الذي ذكرنا ، ولكنّه لا يشتاق إليه ؛ لأنّه غنيّ عنه ، فالغرض لا يكون إلاّ مع الشوق ؛ فإنّه يقال: لم طلب هذا؟ فيقال : لأنّه يشتاقه ، وحيث لا يكون الشوق لا يكون الغرض. انتهى.
وهذا الذي نقلناه من هذه الرسالة ذكره بعينه في التعليقات أيضا (13).
وقال أيضا في التعليقات : والعناية هي أن يعقل الواجب الوجود بذاته أنّ الإنسان كيف يجب أن تكون أعضاؤه ، والسماء كيف يجب أن تكون حركتها ليكونا فاضلين ، ويكون نظام الخير فيهما موجودا من دون أن يتبع هذا العلم الشوق ، أو غرض آخر سوى علمه بما ذكرناه مع موافقة معلومه لذاته المعشوقة له ؛ فإنّ الغرض وبالجملة ، النظر إلى أسفل ، أعني (14) لو خلق الخلق طلبا لغرض ، أعني أن يكون غرض الخلق أو الكمالات الموجودة في الخلق ـ أعني ما يتبع الخلق ـ طلب كمال ، لم يكن لو لم يخلق. وهذا لا يليق بما هو واجب الوجود من جميع جهاته.
فإن قال قائل : إنّا قد نفعل أفعالا بلا غرض ولا يكون لنا فيها نفع كالإحسان إلى إنسان من دون أن يكون لنا فيه فائدة ، فكذلك يصحّ أن يكون واجب الوجود يخلق الخلق لأجل الخلق لا لغرض آخر كما نحسن إلى إنسان ما.
قلنا : إنّ مثل هذا الفعل لا يخلو عن غرض ؛ فإنّا نريد الخير بالغير ليكون لنا اسم حسن ، أو ثواب أو شيء هو أولى بأن يكون لنا من أن لا يكون (15). انتهى.
وقال في الرسالة : إنّ الغرض ـ أعني الغاية ـ هو السبب في أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن ، فلا يجوز أن يكون لواجب الوجود بذاته ـ الذي هو تامّ ـ أمر يجعله على صفة لم يكن عليها ؛ فإنّه يكون ناقصا عن تلك الجهة. وتلك الصفة إمّا أن تكون فضيلة أو نقصانا ، وعلى جميع الأحوال فإنّ ذلك لا يليق به لا النقصان ولا التكميل.
ثمّ قال : وقد عرفت إرادة واجب الوجود بذاته ، وأنّها بعينها علمه وهو بعينه عنايته ، وأنّ هذه الإرادة غير حادثة ، وبيّنّا أنّ منّا أيضا إرادة على هذا الوجه. انتهى.
إذا عرفت هذا ، فاعلم : أنّ الأشبه أنّ مراد محقّقي المعتزلة من كون الإرادة عين الداعي الذي هو العلم بالأصلح إنّما هو الذي ذهب إليه الفلاسفة على ما ذكرنا (16) ، فيكون الواجب تعالى عندهم أيضا فاعلا بالعناية [ بالمعنى ] (17) وإن لم يقولوا به بحسب اللفظ.
والغرض تصحيح إطلاق الإرادة عليه تعالى التي هي هي بحسب اللغة والعرف بمعنى القصد التابع للشوق ؛ فإنّ ذلك ممتنع عليه تعالى.
وبالجملة ، القصد أمر معلوم بالوجدان لا يمكن أن يكون عين العلم ولا عين الذات ، فكلّ من قال بكون الإرادة عين العلم لا ينبغي أن يكون مراده بها هو القصد ، فيكون مراده أنّه تعالى فاعل بمجرّد العلم المتعلّق بالخيريّة والمصلحة في الفعل ، فتكون إرادته عقليّة محضة.
وهذا هو مراد الفلاسفة من الفاعل بالعناية ، فهؤلاء المحقّقون يوافقونهم في المعنى الذي هو مرادهم من العناية وإن لم يوافقوهم في اصطلاح الفاعل بالعناية بحسب اللفظ.
ثمّ من لم يقل بالعناية والعلم المقدّم في الواجب تعالى من المنتسبين إلى الفلاسفة ، كصاحب الإشراق قال بكونه تعالى فاعلا بالرضى ، وهو ما يكون فعله مقارنا للعلم والشعور من غير تقديم للعلم على الفعل (18).
وأنت خبير بأنّ هذا لا يكون من الفاعل بالإرادة والاختيار في شيء ؛ فإنّ الفاعل المختار ما يكون فعله صادرا عن علم سواء كان ذلك مستتبعا للقصد ، كما في الفاعل بالقصد ، أولا ، كما في الفاعل بالعناية ؛ فإنّ كليهما داخلان في الفاعل المختار.
فأمّا الفاعل بالرضى فليس فعله عن علم أصلا وإن كان مقارنا للعلم ، فلا يكون من الفاعل المختار ، بل هو من الفاعل بالإيجاب ؛ فإنّ الموجب ما لا يكون فعله عن علم سواء كان مقارنا له كما في الفاعل بالرضى ، أو لا كما في الفاعل بالطبع ، فعند من ينفي العلم عن الواجب تعالى مطلقا ـ كما مرّ نقلا عن بعض الأوائل (19) ـ يكون تعالى فاعلا بالطبع ، تعالى عن ذلك. وعند من يقول بالعلم الحضوري المقارن فقط كصاحب الإشراق يكون فاعلا بالرضى. وكلاهما داخلان في الفاعل الموجب ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
واعلم أنّ الإمام الرازيّ أيضا في المباحث المشرقيّة رجع إلى سبيل التحقيق في إرادته تعالى ، فقال : فإذا كانت إرادة الله تعالى دائمة الوجود ، لم تكن تلك الإرادة قصدا إلى التكوين ؛ لأنّ القصد إلى الشيء يستحيل بقاؤه بعد حصول ذلك الشيء ، فثبت أنّ إرادة الله تعالى ليست عبارة عن القصد ، بل الحقّ في معنى كونه مريدا أنّه تعالى يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكلّ أنّه كيف يكون ذلك النظام ويكون لا محالة كائنا مستفيضا ، وهو خير غير مناف لذات المبدأ الأوّل ، فعلم المبدأ بفيضانه عنه ، وأنّه غير مناف لذاته هو إرادته لذلك ورضاه.
ثمّ إنّا إذا حقّقناه ، حكمنا بأنّ الفرق بين المريد وغير المريد ـ سواء كان في حقّنا ، أو في حقّ الله تعالى ـ هو ما ذكرناه ؛ فإنّ إرادتنا ما دامت متساوية النسبة إلى وجود المراد وعدمه ، لم تكن صالحة لترجيح أحد ذينك الطرفين على الآخر ، وإذا صارت نسبتها إلى وجود المراد أرجح بالنسبة إلى عدمه ، وثبت أنّ الرجحان لا يحصل إلاّ عند الانتهاء إلى حدّ الوجوب ، لزم منه الوقوع ؛ لأنّ الإرادة الجازمة إنّما تتحقّق عند الله ، وهنا لك قد صارت موجبة للفعل.
فإذن ما يقال من الفرق بين الموجب والمختار : إنّ المختار يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل ، والموجب لا يمكنه أن لا يفعل ، كلام باطل ؛ لأنّا بيّنّا أنّ الإرادة متى كانت متساوية النسبة ، لم تكن جازمة ، وهناك يمتنع حدوث المراد ، ومتى ترجّح أحد طرفيها على الآخر صارت موجبة للفعل ، ولا يبقى بينها وبين سائر الموجبات فرق من هذه الجهة ، بل الفرق ما ذكرناه أنّ المريد هو الذي يكون عالما بصدور الفعل غير المنافي عنه ، وغير المريد هو الذي لا يكون عالما بما يصدر عنه كالقوى الطبيعيّة وإن كان الشعور حاصلا لكنّ الفعل لا يكون ملائما له ، بل منافرا مثل الملجأ إلى الفعل ؛ فإنّ الفعل لا يكون مرادا (20). انتهى كلامه ، فتأمّل فيه ؛ فإنّه بظاهره يشعر بكون الفاعل بالرضى أيضا داخلا في المريد. والتحقيق ما ذكرناه ، هذا.
فإن قيل : إرادته تعالى لا يصحّ أن تكون عين علمه ؛ فإنّه تعالى يعلم كلّ شيء ولا يريد كلّ شيء ؛ فإنّه لا يريد شرّا ولا ظلما ولا كفرا ولا شيئا من القبائح والسيّئات ؛ فإرادته أمر آخر وراء علمه تعالى.
قلنا : لا يلزم من كون إرادته عين علمه بكلّ شيء أن يتعلّق إرادته أيضا بكلّ شيء ؛ فإنّ الإرادة ليست هو العلم مطلقا ، بل العلم بما فيه مصلحة وخير. وهذا كما أنّ سمعه وبصره راجعان عند المحقّقين إلى العلم ، ولا يلزم منه تعلّق السمع بما سوى المسموع ، ولا تعلّق البصر بما سوى المبصر ، فليتفطّن.
فإن قلت : ما ذا تقول فيما رواه ثقة الإسلام رئيس المحدّثين أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ في كتاب الكافي (21) والشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه القمّيّ في كتابي التوحيد (22) والعيون (23) عن الأئمّة الطاهرين وسادتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في حدوث الإرادة والمشيئة ، وأنّهما من صفات الفعل دون صفات الذات؟
وذكر محمّد بن يعقوب في الكافي (24) في الفرق بين صفات الفعل وصفات الذات ما حاصله : أنّ كلّ شيئين وصفت الله بهما ، وكانا جميعا في الوجود ـ كما أنّ في الوجود ما يريده وما لا يريده ، وما يرضاه وما يسخطه وما يحبّه ويبغضه ـ فهما من صفات الفعل ؛ فإنّهما لو كانا من صفات الذات كانت الصفات التي هي عين الذات ناقضا بعضها لبعض ، فيكون ما يريده ناقضا لما لا يريده ، وما يسخطه ناقضا لما يرضاه ، وما يبغضه ناقضا لما يحبّه ، وهذا محال.
وكلّ شيئين وصفته تعالى بأحدهما وكان في الوجود ، ولم يكن الآخر في الوجود مثل العلم والقدرة ؛ فإنّ في الوجود ما يعلمه ويقدر عليه ، وليس في الوجود ما لا يعلمه ولا يقدر عليه ، فهو من صفات الذات. هذا ، فإذا كانت الإرادة محدثة ومن صفات الفعل ، فكيف يجوز أن تكون عين العلم القديم الذي هو عين ذاته تعالى (25)؟!
قلت : لعلّ المراد من الإرادة في تلك الروايات إنّما هو القصد إلى الفعل على ما يفهمه الجمهور من لفظ الإرادة ، والخطاب إنّما معهم ، وعلى هذا فتخلّف المراد عن الإرادة بمعنى القصد نقص وعجز لا يليق بجنابه تعالى ، والمراد حادث ، فيجب كون الإرادة أيضا حادثة لكن نسبة القصد إليه تعالى ليست على الحقيقة ؛ لامتناعه عليه تعالى ، بل بمعنى ترتّب الغاية والأثر ، بمعنى أنّ كلّ ما يمكن أن يترتّب على القصد في غيره تعالى ، فهو مرتّب على ذاته تعالى فقط من غير توسّط القصد على ما قالوا في صفة الرحمة وغيرها ، فإطلاق لفظ القصد والإرادة في حقّه إنّما هو على سبيل التمثيل.
وعلى هذا فيكون المراد من حدوث إرادته هو حدوث مراده تعالى حسب اقتضاء علمه تعالى بالمصلحة فيه.
وممّا يدلّ صريحا على ما ذكرنا : ما رواه في الكافي عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام فكان من سؤاله أن قال له : فله رضا وسخط؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : نعم ، ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، وذلك أنّ الرضا حال يدخل عليه ، فينقله من حال إلى حال ؛ لأنّ المخلوق أجوف معتمل مركّب، للأشياء فيه مدخل ، وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه ؛ لأنّه أحديّ الذات وأحديّ المعنى ، فرضاه ثوابه ، وسخطه عقابه ، من غير شيء يتداخله ، فيهيجه وينقله من حال إلى حال ؛ لأنّ ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين (26).
هذا كلامه صلوات الله عليه وسلامه.
ونعم ما قال بعض (27) أفاضل إخواننا الإلهيين ـ كثّر الله أمثاله في العالمين ـ في هذا المقام ما محصّله أنّ التحقيق أنّ للإرادة والمشيئة جهة ثبات هي أزليّة وعين ذاته تعالى ، وجهة تجدّد هي إضافة حادثة مع حدوث المشيء والمراد ، كما أنّ العلم والقدرة كذلك إلاّ أنّ جهة الثبات في العلم والقدرة أدلّ على الكمال والبهاء ؛ حيث يوجب (28) تخلّف متعلّقيهما عنهما تحقّق العلم والقدرة وإن لم يكن المقدور والمعلوم ، وذلك ممّا يعدّ غاية في كمال العلم والقدرة جدّا.
فلذلك عدّتا من صفات الذات ، وجهة التجدّد في المشيئة والإرادة أدلّ على العزّ والجلال ؛ حيث يوجب عدم تخلّف المشيء والمراد عنهما ، وذلك ممّا يعدّ في غاية العزّ والجلال ، فلذلك عدّتا من صفات الفعل. وخطاب الشارع إنّما هو مع الجماهير ، فينبغي أن يذكر في نعته تعالى معهم ما يكون أدلّ عندهم على الكمال ، وأظهر في العزّ والجلال هذا. ولنا في هذا المقام تحقيق آخر ذكرناه في كتابنا المسمّى بگوهر مراد (29) فليرجع إليه من أراد » (30).
__________________
(1) انظر « المحصّل » : 255 ـ 256 ؛ « شرح المواقف » 6 : 64 ـ 70 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 337 ـ 340.
(2) في المصدر : « بعدد ».
(3) « شرح المقاصد » 4 : 134.
(4) « شرح المقاصد » 4 : 132 ـ 136 ؛ « شرح المواقف » 8 : 81 ـ 87.
(5) انظر « المحصّل » : 391 ـ 399 ؛ « نقد المحصّل » : 281 ـ 287 ؛ « مناهج اليقين» : 171 ـ 175 ؛ « أنوار الملكوت » : 67 ـ 68 ؛ « شرح المواقف » 8 : 81 ـ 87 ؛ « شرح المقاصد » 4 : 128 ـ 137 ؛ « إرشاد الطالبين » : 203 ـ 205.
(6) « الشفاء » الإلهيّات : 414 ـ 415 ، الفصل السادس من المقالة التاسعة ؛ « النجاة » : 284 ـ 285 ؛ « المبدأ والمعاد » لابن سينا : 88 ـ 90 ؛ « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 3 : 142 ـ 144 ؛ « شرح مسألة العلم » : 44 ـ 46.
(7) الزيادة أضفناها من المصدر.
(8) « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 3 : 145 و 150.
(9) « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 3 : 145 و 150.
(10) « الشفاء » الإلهيّات : 366 ـ 367 ، الفصل السابع من المقالة الثامنة.
(11) نفس المصدر : 367.
(12) الرسالة غير متوفّرة لدينا.
(13) « التعليقات » : 16 ـ 17 ، مع الاختلاف في بعض العبارات.
(14) أي لو خلق الخلق طلبا لغرض لكان النظر إلى أسفل. وكلمة « أعني » الثانية تفسير لـ « الغرض ». وكلمة « أعني » الثالثة تفسير للكمالات.
(15) « التعليقات » : 18.
(16) راجع ص 259 من هذا الجزء.
(17) ليست في « شوارق الإلهام ».
(18) نسب إلى الإشراقيّين في « الأسفار الأربعة » 2 : 224 ؛ « الشواهد الربوبيّة » : 55 ؛ « المبدأ والمعاد » للصدر الشيرازيّ : 134 ؛ « شرح المنظومة » قسم الحكمة : 121. ولم نعثر على تصريح بذلك في مصنّفات شيخ الإشراق.
نعم ، ربّما يستفاد ذلك من كلامه في نفي العناية وعدم قوله بمقالة الدهريّين والمتكلّمين في كونه تعالى فاعلا بالقصد أو بالطبع ، وعدم قوله بالقسر والجبر. راجع « حكمة الإشراق » ضمن « مصنّفات شيخ الإشراق » 2 : 153.
(19) « شوارق الإلهام » : 514. وانظر « شرح مسألة العلم » : 22 ؛ « الأسفار الأربعة » 6 : 180 ؛ « المبدأ والمعاد » للصدر الشيرازيّ : 90 ؛ « المباحث المشرقيّة » 2 : 492 ـ 498 ؛ « المحصّل » : 384 ؛ « نقد المحصّل » : 277 ـ 280 و 294 ؛ « شرح المواقف» 8 : 71 ـ 72.
(20) « المباحث المشرقية » 2 : 513 ـ 515.
(21) « الكافي » 1 : 109 ـ 110 باب الإرادة أنّها من صفات الفعل ... ، ح 1 ـ 7.
(22) « التوحيد » : 145 ـ 148 باب صفات الذات وصفات الأفعال ، ح 13 ـ 19 و: 336 ـ 344 باب المشيئة والإرادة ، ح 1 ـ 13.
(23) « عيون أخبار الرضا » 1 : 179 ـ 191 ، الباب 13 ، ح 1.
(24) « الكافي » 1 : 111 ـ 112 ، آخر باب الإرادة أنّها من صفات الفعل.
(25) « عيون أخبار الرضا » 1 : 179 ـ 191 ، الباب 13 ، ح 1.
(26) « الكافي » 1 : 110 باب الإرادة أنّها من صفات الفعل ... ، ح 6.
(27) في هامش « ب » : وهو مولانا محمّد محسن صاحب كتاب الوافي سلّمه الله من العاهات. منه ;.
انظر « الوافي » 1 : 446 ـ 448 و 458.
(28) في « ب » : « يوجد ».
(29) « گوهر مراد » : 249 ـ 257.
(30) انتهى كلام الفاضل اللاهيجي ، انظر « شوارق الإلهام » : 549 ـ 554.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|