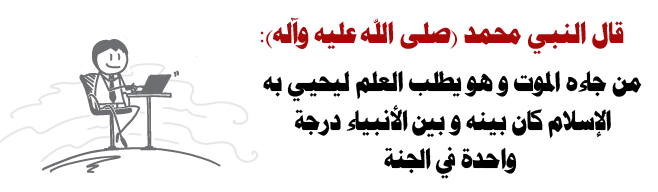
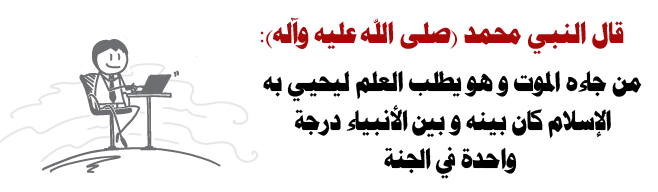

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 25-8-2016
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 26-8-2016
|
عُرِّفت المقدّمة بأنّها ما يتوصّل بها إلى شيء آخر على وجه لولاه لما أمكن تحصيله، وقد قسّموا المقدّمة إلى داخلية وخارجية، إلى عقلية وشرعية وعادية، إلى مقدّمة الوجود والصحّة، إلى مقدمة الوجوب والعلم، إلى السبب والشرط والمعد والمانع، إلى المقدّمة المفوّتة وغير المفوّتة، وإلى العبادية والتوصلية، وقد بحثنا في هذه الأُمور في كتاب الموجز(1) فلا نعيد.
والذي تجب الإشارة إليه في المقام هو تقسيم الشرط إلى شرط التكليف وشرط الوضع، وشرط المأمور به.
فشرط التكليف كالأُمور العامّة، مثل : العقل، والبلوغ، والقدرة.
وشرط الوضع كشرط الصحّة مثلاً نظير الإجازة في بيع الفضولي، إذ لولاها لما وصف العقد الصادر من الفضولي بالصحّة التامّة.
وشرط المأمور به كالطهارة من الحدث والخبث.
تقسيم الشرط إلى متقدّم ومقارن ومتأخّر: قسَّم الأُصوليون الشرطَ إلى متقدّم و مقارن ومتأخر، وإليك أمثلته:
أ: ما هو متقدّم في وجوده زماناً على المشروط، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة و نحوها، بناء على أنّ الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة .
ب: ما هو مقارن للمشروط للزوم وجوده طول العمل، كالاستقبال وطهارة اللباس.
ج: ما هو متأخّر عن المشروط في وجوده زماناً، كالاغتسال في الليل للمستحاضة، الذي هو شرط لصحّة صوم النهار السابق، وكإجازة المالك التي هي شرط لصحّة بيع الفضولي من أوّل إنشائه على القول بأنّ الإجازة كاشفة لا من حين صدور الإجازة(على القول بأنّ الإجازة ناقلة) وإلاّ يكون من قبيل المقارن.
دليل القائل بوجوب المقدّمة
اشتهر القول بأنّ مقدّمة الواجب واجبة، ومقدّمة الحرام حرام. ولنقدّم الكلام في حكم الأُولى، فنقول: قد استدلّ على وجوب المقدّمة بوجوه:
الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراساني، حيث قال: إنّ الوجدان أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها، بحيث ربّما يجعلها في قالب الطلب مثله، و يقول ـ مولوياً: ادخل السوق واشتر اللحم مثلاً.
بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب ادخل، مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثاً مولوياً وأنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أُخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه وأنّه مقدّمة له.(2)
يلاحظ عليه: أنّ الوجدان يشهد على خلافه، و انّه ليس هنا إلاّ بعث واحد، والأمر بالمقدّمة إمّا إرشاد إلى المقدمية، أو تأكيد لذيها، و يشهد على ذلك أنّه لو سئل المولى عن وحدة بعثه و تعدّده، لأجاب بوحدته و إن هنا بعثاً واحداً متعلقاً بالمطلوب الذاتي.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني، وحاصله انّه لا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية في جميع لوازمها، غير انّ التكوينية تتعلّق بفعل نفس المريد، و التشريعية تتعلّق بفعل غيره; و من الضروري انّ تعلّق الإرادة التكوينية بشيء يستلزم تعلّقها بجميع مقدّماته قهراً.
نعم لا تكون هذه الإرادة القهرية فعلية، فيما إذا كانت المقدمية مغفولاً عنها، إلاّ انّ ملاك تعلّق الإرادة بها، و هو المقدّمية على حاله. فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية، فتكون الإرادة التشريعية مثلها أيضاً.(3)
يلاحظ عليه: بالفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وذلك لانّ الإرادة التكوينية تتعلّق بنفس الفعل الصادر من المريد، ولا يصدر الفعل من الفاعل إلاّ بعد تعلّق الإرادة التكوينية بمقدّماته، فيريد كلّ مقدّمة بإرادة خاصة.
وأمّا الإرادة التشريعية فلا تتعلق بنفس الفعل الصادر من الغير، من دون فرق بين نفس الفعل و مقدمته، لأنّ الإرادة تتعلق بما هو واقع تحت اختيار المريد، و فعل الغير نفسه ومقدّماته غير واقع تحت اختيار المريد، و عندئذ فإرادة
المريد(الآمر) تتعلّق بما هو تحت اختياره وهو الأمر والبعث لا فعل الغير.
وقد صار تصّور إمكان تعلّق إرادة الآمر بفعل الغير سبباً لإشكالات كثيرة نبهنا عليها في موضعها.
هذا كلّه حول دراسة أدلّة القائلين بالوجوب وقد ذكرنا بعض أدلّتهم، وأمّا دليل القائل بعدم الوجوب فأمتنه ما يلي:
دليل القائل بعدم وجوب المقدّمة وهو انّ الغرض من الإيجاب المولوي هو جعل الداعي وإحداثه في ضمير المكلّف، لينبعث ويأتي بالمتعلّق، مع أنّ وجوبها إمّا غير باعث، أو غير محتاج إليه، فإنّ المكلّف إن كان بصدد الإتيان بذي المقدّمة، فالأمر النفسي الباعث إلى ذيها، باعث إليها أيضاً، ومعه لا يحتاج إلى باعث آخر بالنسبة إليها. وإن لم يكن بصدد الإتيان بذيها و كان مُعرضاً عنه، لما حصل له بعث بالنسبة إلى المقدّمة.
والحاصل: انّ الأمر المقدمي يدور أمره بين اللغوية ـ إذا كان المكلّف بصدد الإتيان بذيها ـ وعدم الباعثية وإحداث الداعوية أبداً ، إذا لم يكن بصدد الإتيان بذيها.
ما هو الواجب من المقدّمة؟
ثمّ إنّ القائلين بوجوب المقدّمة اختلفوا فيما هو الواجب:
1. الواجب هو نفس المقدّمة من حيث هي هي، وهذا القول هو المشهور.
2. الواجب هو المقدّمة الموصلة، وهو خيرة صاحب الفصول.
3. الواجب هو المقدّمة بقصد التوصل إلى ذيها، وهو خيرة الشيخ الأنصاري.
استدلّ صاحب الفصول على مختاره: بأنّ الحاكم بالملازمة بين الوجوبين هو العقل، ولا يرى العقل إلاّ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ما يقع في طريق حصوله وسلسلة وجوده، و فيما سوى ذلك لا يدرك العقل أيّة ملازمة بينهما.
وأُورد عليه: بأنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب، لثبوت مناط الوجوب ـ أعني التمكن من ذيها ـ في مطلقها وعدم اختصاصه بالمقيّد بذلك منها.
ولكن الحقّ انّه لو قلنا بوجوب المقدّمة لاختصّ الوجوب بالموصلة منها، وذلك لأنّ الغاية تُحدِّد حكم العقل وتضيّقه، وذلك لأنّ التمكّن من ذي المقدّمة وإن كان غاية لوجوبها لكنّها ليست تمامها، والغاية التامة هي كون المقدّمة الممكِّنة، موصلة لما هو المطلوب، وإلاّ فلو لم تكن موصلة، لما أمر بها، لأنّ المفروض أنّ المقدّمة ليست مطلوبة وإنّما تطلب لأجل ذيها.
وإن شئت قلت: إنّ المطلوب الذاتي هو التوصّل خارجاً، دون التوقّف، فلو فرض إمكان التفكيك بينهما، لكان الملاك هو التوصّل خارجاً دون التوقف.
وبما انّ المقدّمة في متن الواقع على قسمين يتعلّق الوجوب بالقسم الموصل في الواقع ونفس الأمر دون غيره.
وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا توقّف إنقاذ النفس المحترمة على إتلاف مال الغير إذا كان أقلّ أهمية منها، ولو افترضنا أنّه أتلفه ولم ينقذ الغريق، فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة لم يرتكب الحرام، لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، بخلاف ما إذا قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة، فبما أنّها لم يكن موصلة لم تكن واجبة بل باقية على حرمتها.
واستدلّ على القول الثالث: بأنّ قصد التوصّل قيد للواجب، فالواجب هو خصوص ما أوتي به بقصد التوصّل.
يلاحظ عليه: أنّه دعوى بلا برهان، فإنّ ملاك الوجوب هو التوقّف ـ إذا لم نقل بوجوب المقدّمة الموصلة ـ وهو متحقّق فيما قصد به التوصّل وما لم يقصد، ولا معنى لأخذ ما لا دخالة له في موضوع الوجوب.
فخرجنا بالنتائج التالية:
أ. عدم وجوب المقدّمة على الإطلاق .
ب. على فرض وجوبها فالواجب هو المقدّمة الموصلة.
ج. على القول بالملازمة بين الوجوبين يترتّب عليها وجوب المقدّمة في الواجبات و حرمتها في المحرمات، و بذلك تكون المسألة (وجوب المقدّمة) من المسائل الأُصولية لوقوعها كبرى لاستنباط حكم شرعي كما في الموارد التالية:
1. إذا تعلّق النذر بالواجب، فلو قلنا بوجوب المقدّمة يكفي في الامتثال الإتيان بكلّ واجب غيري، وإلاّ فلابدّ من الإتيان بواجب نفسي.
2. إذا أمر شخص ببناء بيت، فأتى المأمور بالمقدّمات، ثمّ انصرف الآمر، فعلى القول بأنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّمته يصير الآمر ضامناً لها، فيجب عليه دفع أُجرة المقدّمات وإن انقطع العمل.
3. لو قلنا بوجوب المقدّمة شرعاً، يحرم أخذ الأُجرة عليها، كما إذا أخذ الأُجرة على تطهير الثوب الذي يريد الصلاة فيه، لما تقرر في محلّه من عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجبات.
4. لو كان لواجب واحد مقدّمات كثيرة، كالحجّ من أخذ جواز السفر، وتذكرة الطائرة، يحصل الفسق بترك هذين الأمرين على وجه لا يمكن تداركهما، لصدق الإصرار على الصغيرة إذا كانت مخالفة الأمر المقدّمي معصية صغيرة، ولا يتوقف حصول الفسق على ترك ذيها.
5. إذا كانت المقدّمة أمراً عبادياً، كالطهارات الثلاث، فلو قلنا بأنّ قصد الأمر الغير يكفي في كون الشيء عبادة، فعلى القول بوجوب المقدّمة يكفي قصد الأمر الغيري في عباديّتها، وإلاّ فلابدّ في تصحيح عبادية الطهارات الثلاث من محاولة أُخرى مذكورة في محلّها.
في حكم مقدّمة المستحب والمكروه والحرام لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب تكون مقدّمة المستحب مستحبة، كالمشي إلى زيارة الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، إنّما الكلام في مقدّمة المكروه فالظاهر انّها مكروهة بعامة أجزائها كالمشي إلى الطلاق، لأنّ لكلّ جزء مدخلية في تحقّق المبغوض فيسري إليها البغض كسريان الحبّ إليها في مقدّمة الواجب.
ويمكن أن يقال بكراهة الجزء الأخير من العلّة التامة لموضوع المكروه.
ومنه يظهر حال مقدّمة الحرام، فإذا كان الملاك للحرمة هو المدخلية فيحرم كلّ مقدّمة من مقدّمات الحرام، شرطاً كان أو معدّاً.
وهناك احتمال آخر وهو حرمة الجزء الأخير من العلّة التامة الذي لا ينفك عنه وجود المبغوض وعلى كلّ تقدير فالجميع فروض على أساس غير محقّق وهو وجوب المقدّمة أو حرمتها.
مميّزات الوجوب الغيري
ثمّ إنّه إذا قلنا بالوجوب الغيري فهو يتميز عن النفسي عند المشهور بوجوه:
1. انّ الوجوب الغيري لا يوجد إلاّ بعد افتراض الوجوب النفسي، لكونه معلولاً له.
2. انّ الوجوب الغيري لا يترتب على مخالفته العقاب لوضوح انّ العقاب لا يتعدد، حسب تعدد مقدّمات الواجب النفسي.
3. الوجوب الغيري لا يكون مقصوداً بالذات في مقام الامتثال، وإنّما يكتسب المحبوبية من ناحية الوجوب النفسي الّذي يتوقف امتثاله على امتثال الواجب الغيري.
________________
1. الموجز:45ـ48.
2. كفاية الأُصول: 1/200.
3. أجود التقريرات:1/231، ولاحظ فوائد الأُصول: 1/284.



|
|
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
|
|
ضمن مشروع الورود الفاطمية بنسخته السابعة شعبة الخطابة النسوية تقدّم محاضرات إرشادية لعدد من المدارس المشاركة في حفل التكليف الشرعي
|
|
|