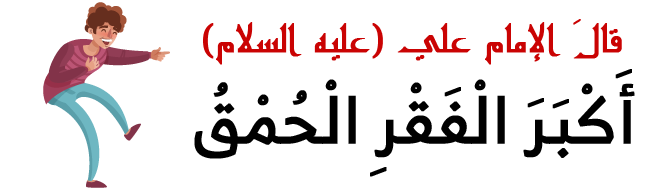
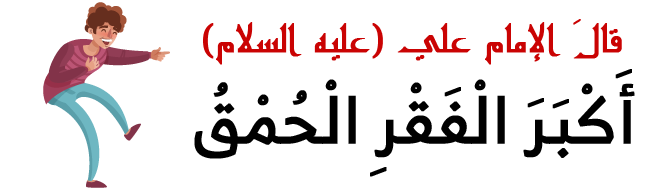
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-09-2015
التاريخ: 14-08-2015
التاريخ: 27-7-2017
التاريخ: 27-7-2017
|
موسيقى الشعر
یرى دارس الشعر العراقي عددا من الظواهر الموسيقية المختلفة الجديرة بالرصد والتتبع ولعل أبرز هذه الظواهر هي التداخل ونعني بها تداخل بحر شعري في بحر آخر والتنوع وهو تنوع الأوزان تبعا للمقاطع الشعرية التي تؤلف بمجموعها القصيدة كاملة والتناوب ونعني به تكوين القصيدة موسيقيا من الشكلين التقليدي والحر وغالبا ما يأتي هذا التناوب على شكل مقاطع أيضا و التدوير وهو جعل موسيقى القصيدة دورة واحدة لا يقف القارئ فيها الا عند انتهائها او انتهاء مقاطعها وبهذا تلغى الأشطر أو الأبيات و الاختلاط الذي هو اختلاط الشعر بالنثر في بنية القصيدة الواحدة لا تقدم بعض هذه الظواهر ما يؤكد ارتباطها بالمضمون الشعري أو وضوح علاقتها بتحولات الموقف أو الانفعالات النفسية التي تعم العمل الشعري كله فليس بين يدي الباحث الآن ما يؤكد - بشكل مقنع - الضرورة الفنية أو النفسية التي تحدو بالشاعر لأن يجعل بنية القصيدة الموسيقية تتناوب على شكلين من الأداء الحر ثم التقليدي أو توجهه الى الافادة من امكانيات تداخل بعض البحور ببعضها الآخر لخدمة قضية موضوعية ما كما ان اختلاط الشعر بالنثر لا يفصح هو الآخر عن وظيفة محددة ولذا فاننا نرى أن ليس ثمة ضرورة لدراسة ظواهر كـ التناوب و الاختلاط و التداخل ما دمنا غير متأكدين - الآن - من وضوح علاقتها بالمضامين الشعرية ان ظاهرتين يمكن للباحث أن يتلمس من خلالهما ذلك الترابط بين البناء لموسيقي للقصيدة وبين المضمون بعبارة أخرى توظيف الموسيقى لإبراز بعض نواحي الموضوعية أو النفسية التي يحرص على ابرازها وهاتان الظاهرتان هما التنوع و التدوير اضافة الى قضية ثالثة هي الايقاع الداخلي لقد بلغت نسبة شيوع التنوع 3,70 وهذه النسبة هي أعلى نسبة تحصل عليها ظاهرة من الظواهر الموسيقية ومع أن التنوع يعتبر نتاجا جماعيا أي أنه لم يشع من خلال اسهامات أفراد معينين الا أنه أخذ بالنمو والتطور الفائق في شعر الحقبة ثالثة ذلك أن نسبته في نتاج شعر الحقبة الأولى كانت 62% وفي نتاج الحقبة الثانية ارتفعت تلك النسبة الى 141 ، أما نسبته في الحقبة الثالثة فقد ارتفعت الى 5,56% وهذا يعني أن لهذه الظاهرة من الشيوع ما يفوق نسبة شيوع أبحر بعينها کالوافر والكامل والسريع ، لأن نسب شيوع هذه الأبحر كانت على التوالي 4,75 ، 4,670 ، %3,06 واذا تذكرنا أن بحر الكامل كان يحتل المرتبة الأولى في نتاج شعر جيل الرواد، أدركنا ما لهذه الظاهرة من الأهمية والايثار لدى مجمل شعراء الحقبة الثالثة من عمر حركة الشعر الحر في العراق ، ولن نكون بعيدين عن الحقيقة . من . خلال تطور نسب شيوع هذه الظاهرة ، ورصد النتاج الذي ينشر الآن في المجلات الأدبية - لو أننا توقعنا أن قضية تنوع الأوزان تبعا للمقاطع سوف تلقى المزيد من الاهتمام والعناية مستقبلا لعل قصيدة السياب رؤ يا في عام 1956 التي كتبها عام 1959 تعد من النماذج المبكرة التي حملت لنا هذه الظاهرة الموسيقية ولم يحاول الشعراء الأخرون تجريبها الا بعد ذلك التاريخ كما حصل في شعر شاذل طاقة وعبد الوهاب البياتي (1)و رؤيا في عام 1956 تقع في سبعة مقاطع واذا شئنا الدقة فانها ثمانية لأن المقطع الأول يمكن أن يعد مقطعين فالشاعر قد فصل بين جزايه بفاصل طباعي واضح ثم ان هذين الجزأين يشيران الى موقفين وحالتين ليستا متطابقتين تماما تبدأ القصيدة بموسيقى بحر الرمل حطت الرؤيا على عيني صفرا من لهيب انها تنقض ، تجتث السواد تقطع الأعصاب تمتص القذى من كل جفن فالمغيب عاد منها توأما للصبح - انهار المداد ليس تطفي غلة الرؤيا صحاري من نحيب أيها الصقر الالهي الغريب أيها المنقض من أولمب في صمت السماء رافعا روحي غنيميدا جريحا صالبا عيني تموزا مسيحا أيها الصقر الالهي ترفق ان روحي تتمزق(2) يقدم هذا المقطع دلالات عديدة منها مأساوية هذه الرؤيا التي تجوب مخيلة الشاعر فهي تشير الى حالة من الفزع والرعب الآتي على شكل أنهار من الدماء وصحاري من نحيب ومنها أن القارئ لا يستطيع أن يربط هذه الرؤيا بواقع معين بحيث تبدو انتماء أو تعبيرا عن زمان ومكان وحدث له أبطال ذوو ملامح واضحة ومنها أيضا أن لغة الشاعر هنا يمكن أن توصف بأنها أداء تصويري فني يقوم على تتابع الصور الشعرية التي تعمد الى الاستعارة أو المجاز ربما كانت هذه الملاحظات الثلاث هي أهم ما يمكن للباحث أن يستشفه من أبيات السياب تلك وحين ينتهي الشاعر من تقدير الصورة العامة للرؤيا مأساويتها واثارتها الرعب يدلف الى جزء آخر من القصيدة ونقرأ في غيمة الرؤيا يوم بلا ميعاد جنكيز هل يحيا جنكيز في بغداد عين بلا أجفان تمتد من روحي شدق بلا أسنان ينداح في الريح يعوي أنا الانسان هنا يتخلى الشاعر عن موسيقى الرمل ويلجأ الى موسيقى السريع ومن يتأمل هذا المقطع سيجد أن بينه وبين الجزء الذي تقدم فرقا في الحالة العاطفية والموقف وفي الأداء أيضا ولعل تهيؤ الشاعر لهذه الحالة الجديدة هو الذي دفعه الى اختيار جديد للغة وللموسيقى وتبرز تلك الفروق من خلال المقارنة بير المقطعين لقد كان الشاعر في الجزء الأول من قصيدته يتحدث عن رؤ يا ليس خص اذا قلنا عنها أنها رؤيا عامة غير محددة ولا مقترنة بواقع ولكنه هنا يمنح رؤيته تلك شيئا من الخصوصية ، ويربطها بمكان وواقع معاش ولذا يتضح للقارئ ان تلك الرؤيا المأساوية انما هي حقيقة تعيشها بغداد حيث يعذب الانسان ويصلب ويمثل به ويقدم لنا هذا المقطع تفاوتا في درجة احساس الشاعر بالمأساة بالرعب ومدى ايغال الفاعلين به كان فعل الرؤيا في المقطع الأول هو انها تنقض تجتث السواد تقطع الأعصاب تمتص القذى من كل جفن وواضح أن احساس المرء وحتى احساس الشاعر بدرجة الرعب المتأتية من تمتص القذى من كل جفن هو أقل بكثير من احساسنا بالرعب الآتي من عين بلا أجفان شدق بلا أسنان ينداح في الريح يعوي أنا الانسان لأن الأبيات هنا تشير الى فعل غريب وعالم لا يخلو من وحشية ، وربما كان تهيؤ الشاعر لابراز المزيد من العنف والرعب هو الذي دفعه الى اختيار هذه الموسيقى الجديدة لتلائم بالتالي حالة تختلف عما كانت عليه في المقطع الأول لا يقدم هذا المقطع تباينا في الحالة أو الموسيقى فحسب وانما تبع هذا التباين تحول آخر يكمن في أداة الشاعر اللغوية وأسلوب التعبير مما يدلل على أن تغير الاحساس بالانفعال لا يتبعه تغير موسيقي فقط ، وانما تغيير في الأداء اللغوي
أيضا ذلك أن لغة الشاعر في الجزء الأول من قصيدته كانت تنمو على شكل نسيج تصويري متتابع كانت لغة استعارة ومجاز تدل على دقة الاختيار والتأني الذي صرفه الى تذكر بعض الرموز الأسطورية ومحاولة توظيفها ، أما اللغة في هذا المقطع فقد اقتربت كثيرا من المباشرة الصريحة أوشكت أن تكون لغة تقرير ولم يعد ذلك الفيض من الصور يصادفنا هنا بل صرنا بمواجهة جمل سريعة مكثفة تنأى عن التصوير جنكيز هل يحيا جنكيز في بغداد عين بلا أجفان شدق بلا أسنان يبدأ المقطع الجديد من القصيدة بعودة الشاعر الى موسيقى الرمل يا جوادا راكضا يعدو على جسمي الطريح يا جوادا ساحقا عيني بالصخر السنابك رابطا بالأربع الأرجل قلبي فاذا بالنبض نقر للدرابك واذا بالنار دربي يمكن اعتبار هذا المقطع نوعا من التعادل في الحالات لأنه يبدو عودة الى الرؤيا العامة التي طرحها الشاعر في بداية المقطع الأول ، ويتضح ذلك من خلال هذه المقارنة اذ ما الفرق بين ما تثيره الأبيات وبين ما تقدم في أول القصيدة حطت الرؤيا على عيني صقرا من لهيب انها تنقض تجتث السواد تقطع الأعصاب تمتص القذى من كل جفن فالمغيب هنا يتضح لنا أن المقطع الثاني هو البديل أو المقابل الذي يقدم الاحساس بمأساوية تلك الرؤيا ومن يتأمل المقطع الثاني جيدا سيجد عددا آخر من العبارات تشير الى مثيلاتها في المقطع الأول وتحمل المعاني والدلالات فالعبارات فالمغيب عاد منها توأما للصبح صالبا عيني ـ تموزا مسيحا تومىء - بشكلها الرمزي - وبما تثيره من أحاسيس الى العبارات التي ترد في المقطع الثاني مازجا بالشيء ظله خالطا فيها يهوذا بالمسيح مدخلا في اليوم ليله ان هذا التقابل في المعاني هذا التشابه في الاحساس بالفاجعة انما يرجع از أن المقطعين يقدمان حالة واحدة موقفا واحدا يصور بشاعة تلك الرؤيا وما دام يقدمان تلك الحالة الواحدة فقد اتفقا بالأداء الموسيقي الذي يجري على بحر الرمل وهنا لا بد أن نشير الى أن المقطعين لا يتفقان موسيقيا فحسب بل يتفقان في النسيج اللغوي الذي يمكن أن يعتبر واحدا في المقطعين لأنه يقوم على تتابع الصور الشعرية بمعنى آخر هو نسيج فني بعيد عن التقرير أو المباشرة غير أن السياب لم يكن ليمضي بالمقطع كله على موسيقى بحر الرمل فلقد عاد مرة أخرى الى السريع في الجزء الأخير من هذا المقطع ماذا جنى شعبي حلت به اللعنة من زاده المحنة رحماك يا ربي ولم يكن لهذا الانتقال من مبرر غير اختلاف الحالة أو الموقف لقد كان الشاعر يصف مأساوية الحدث من خلال شخصه ووقع تلك الرؤ يا عليه أما الآن فلقد انتقل الى موقع المتسائل والمبتهل الى الرب كي ينقذ شعبه ومدينته التي لم يتبق منها ما يشير الى الخصب واليوم في بيدري لم يبق من حبي شيء هنا حبتان يأتي المقطع الثالث امتدادا لبدايات المقطعين المتقدمين أي أنه وصف لليباب وعودة لابراز مأساوية تلك الرؤيا والشاعر هنا يكسب مقطعه صفات بدايات المقطعين اللذين مرا وهما موسيقى بحر الرمل واللغة ذات الأداء التصويري ما الذي يبدو على الأشجار حولي من ظلال ؟
منجل يجتث أعراق المدينة
قاطعا أعراق تموز الدفينة
وكأن عودة الحالة النفسية ألجأت الشاعر مرة أخرى الى أدوات التعبير الشعري التي واجهتنا هناك ، ومن يتأمل هذه البداية الجديدة سيجد شيئا مما أسميناه التعادل في الحالة الذي يقود الى تكرار معان معينة وأبيات ذوات دلالات متشابهة ، فقوله منجل يجتث أعراق الخ
يكاد يكون صياغة لغوية جديدة لما تثيره تلك الأبيات من احساس بالأسى
انها تنقض تجتث السواد
تقطع الأعصاب تمتص القذى من كل جفن
ولا يخفى على القارئ أن المقاطع المتقدمة لا تشترك بأنها تقدم حالة متشابهة ذات موسيقى واحدة ، ولغة تصويرية وانما تفيد كلها من الرموز الأسطورية ، وتحاول توظيفها لخدمة المضمون الأساسي وهو صلب وقتل كل ما يشير الى الخصب والحب والنماء واذا كانت هذه التنوعات في الموسيقى تتم داخل المقطع الواحد فان المقطع الرابع لا يزاوج بين الرمل والسريع ، وانما يكتفي فيه الشاعر بالسريع وحده ولعل قراءة جزء منه ستبين لنا لماذا اكتفى الشاعر بهذا البحر فقط تموز هذا أتيس هذا وهذا الربيع يا خبزنا يا أتيس أنبت لنا الحب وأحي اليبيس التام الحفل وجاء الجميع يقدمون النذور يحيون كل الطقوس ويبذرون البذور سيقان كل الشجر ضارعة والنفوس عطشي تريد المطر شدوا على كل ساق يا رب تمثالك كان المقطع الثاني قد جمع بين احساس الشاعر بالمأساة ووصفه لها وبين شيء من الابتهال ، ولهذا السبب فقد زاوج بين نمطين من الموسيقى ، الرمل للوصف والسريع للابتهال أما المقطع الرابع فقد غدا برمته تكريسا لموقف موحد هو موقف المبتهل الذي يرى الكارثة دون أن يستطيع فعل أي شيء ايجابي ولذا فانه لا يمتلك الا الدعاء والقارئ يستطيع أن يعتبر هذا المقطع عودة أو تتمة الى أبيات الابتهال تلك أي أنها عودة الى الموقف السابق الحالة السابقة مما يتطلب عودة مماثلة الى الموسيقى التي تقدمت ولا شك أن اكتفاء الشاعر بموقف المبتهل وحده هو الذي جعله يرتبط بموسيقى السريع وحدها واذ يعد هذا التنوع الموسيقي - لزوم موسيقى السريع - نابعا عن تغير الحالة النفسية للشاعر عن تباين أحاسيسه بالرؤيا وتأرجحها بين وصف تأثيرها الخاص على روح الشاعر وأثرها في الواقع أي تطبيقات تلك الرؤيا على الناس والمدينة ، فان التغيير يمكن أن يرد الى مبرر آخر مضاف الى ما تقدم وهو ما يمكن أن نرجعه الى طريقة التعبير الشعري ، فلقد مر بنا أن الشاعر كان يفيد من الرموز الأسطورية افادات عابرة المسيح تموز يهوذا غنيميد أي أنها تشير الى المثيل فقط أو المشابهة بين الرمز وذات الشاعر ولكن التوظيف الأسطوري في هذا المقطع بدا أوسع حجما وأكثر ثراء فالشاعر لم يعد يكتفي من الأسطورة برموزها ، وأسمائها فقط وانما أخذ ينظر اليها على أنها أشخاص وحدث أيضا ، هنا لا يلتقي القارئ بأتيس الاله الذي هو صورة أخرى لتموز البابلي ، ويتعرف على مظهر الجدب من خلال موته ، وانما يتلمس توظيف الشاعر للطقوس الاسطورية التي كانت تمارس بغية عودة الخصب، وسقوط المطر ولعل اشارة الشاعر في هامش القصيدة (3) التي جاء فيها قوله أتيس يقابل تموز الاله البابلي عند سكان آسيا الصغرى القدماء يحتفل بعيده في الربيع حيث يربط تمثاله على ساق الشجرة لعلها تهدينا الى معرفة نوعية الطقوس التي كانت تقام لذاك الاله ولا شك أن هذا المقطع يعد تصويرا لتلك الممارسات ، التي حرص الشاعر على ابرازها وسحبها من الماضي لتلامس الواقع المعاصر المجدب الذي ينتظر فجر خلاصه من هنا يتضح لنا أن طريقة التعبير الشعري في هذا المقطع بدأت تقوم على تمثل الأسطورة والافادة الأشمل منها بعد أن كانت في المقاطع المتقدمة اشارات عابرة لرموز وأسماء لقد تباينت الحالة فغدت ابتهالا ، وتباينت طرق التعبير فتم للشاعر توظيف موسيقى جديدة هي موسيقى السريع وحده ان قارئ رؤيا عام 1956 ستتضح له هذه الملاحظة التي تكاد تكون حقيقة ترتبط بهذه القصيدة وهي أنه كلما جنح الشاعر الى التعبير عن احساسه الشخصي بوقع تلك الرؤيا المرعبة عليه ، كلما أفاد من الرمل وحيثما توجه الى تصوير واقع الرؤيا ومدى تأثيرها على الناس والمدينة فان موسيقى أخرى ستكون أداته للتعبير عن ذلك الوقع هي موسيقى السريع في ثلاثة مواقع ، وموسيقى المتدارك في مواقع اخرى تنتهي القصيدة بالمقطع السابع وهذا المقطع هو نهاية الرؤيا نهاية الحكاية لقد حملت الينا المقاطع الستة المتقدمة جزئيات الحدث وتفاصيل الرؤيا ووقعها على ذات الشاعر وعلى الاخرين من حوله وها هو الان في موقف المتأمل التعب ربما المتفائل أيضا هذه حالة جديدة اذن تتطلب نمطا جديدا رجزا ولفني الظلام في المساء فامتصت الدماء صحراء نومي تنبت الزهر فانما الدماء توائم تقدم قصيدة عبد الوهاب البياتي سفر الفقر والثورة المتكونة من ستة مقاطع موقفين أحدهما تشير اليه هذه الأبيات ومن سيبدد الصمتا ومن منا شجاع زمانه ليعيد ما قلنا ومن سيبوح للريح بما يوحي يأنا لم نزل أحياء (4) يطاردني بلا رحمة يسد علي بالظلمة شوارع هذه المدن التي نامت بلا نجمة (5) غريبا كنت في وطني وفي المنفى جراحاتي التي تشفى ستفتح في غد فاها لتصلبني على شباك مستشفى فواها بعيد أنت ياوطني كحلم عبر نافذة القطار أراك في الوسن (6) أتنطق هذه الصخرة وتفتح في غد فاها ويجري الماء منها قطرة قطرة وتنبت فوقها زهرة (7) هذه المقتطفات تشير الى حالة واحدة هي تساؤلات الشاعر عن الخلاص وعما يلاقيه من أسى وغربة ونفى وتوق الى وطنه البعيد ولقد اختار البياتي موسيقى بحر الوافر للتعبير عن أحزانه هذه والتي يمكن أن نصفها بأنها أحزان هادئة ولهجة الشاعر في التعبير عنها لهجة تخلو من الصراخ أو الغضب والعنف غير أن هذه الأحزان لاتظل على هذا النمط من الهدوء انما تنمو أحيانا وتشتد وتثقل على روح الشاعر المغتاب فتحتدم لهجة الغضب ويتخلى عن موقفه الهادئ ويقترب من الثورة وعندما تصل أحزانه الى هذا الحد من العنف تتغير موسيقاه الشعرية وتأخذ هذا الشكل ناديت بالبواخر المسافرة بالبجعة المهاجرة بكل ماكان وما يكون بالنار بالغصون بالنجمة المحطمة بالكلمة أن تحترق لتنطلق منا شرارات تضيء صرخة الثوار(8)هنا يفيد الشاعر من امكانات الرجز للتعبير عن هذه الفورة التي قطعت نمو تلك الأحزان الهادئة وكأن البياتي أدرك البون بين الحالتين مما يتطلب التوجه الى نمط موسيقي آخر مغاير تنتهي قصيدة سفر الفقر والثورة بالمقطع السادس وهو مقطع يلتقي مع المقطع الثاني بكونه تعبيرا عن حالة حزن مشوبة بالغضب الواضح وبلغة أقرب الى الحدة منها الى الهدوء وهنا يعود الشاعر الى بحر الرجز متخليا عن الوافر أصابني الدوار زلت قدمي سقطت في المصيدة وكانت القصيدة أسلحتي الوحيدة في مدن العالم في منازلي الشريدة بها فقات أعين اللصوص والضفادع البليدة لا تتنوع الموسيقى في قصيدة حسب الشيخ جعفر الملكة والمتسول تبعا لتنوع الحالات والمواقف ولكن تبعا لتعدد الأصوات الداخلية و الملكة والمتسول قصيدة حب يتقاسمها صوتان هما صوت الشاعر وصوت البطلة يأتي صوت الشاعر في أغلب أجزاء القصيدة على موسيقى بحر الرجز
وجه ابتهال مدن مهجورة تصيح
وجه ابتهال سفن ضائعة في الريح
وجه ابتهال قشة في الريح
ظبي عراقي طريد متعب جريح
ولم يغير الشاعر في موسيقى صوته الشخصي الا مرة واحدة غير أن التغيير يحدث دائما عندما يبدأ صوت البطلة بالحديث وللشاعر نمطان من التنوع الموسيقي يرافقان أحاديث بطلته التي يمنحها ملامح أسطورية تذكرنا بعشتار القابعة في ظلام العالم السفلي وأول النمطين هو أن حديثها يأتي على وزن آخر هو الرمل آه من يكسر باب القبر ؟ من يغمرني كالندي ينفض عن وجهي غبار الكفن آه من يكسر باب الأبد ينحني يشعل نارا في هشيم الجسد وخيوط الزمن وجه ابتهال مطر صغير ولا يكتفي باضفاء تلك الملامح الأسطورية على بطلته ويكسبها شيئا من ملامح عشتار وانما يحاول أن ينطقها بالموروث الأدبي الأسطوري ولذا فقد جاء أغلب حديثها اقتباسا أو تحويرا لأغنيات سومرية تتعلق بأنانا وعشتار أي أن تغيير الموسيقى صار ينبثق عن مبررين الأول ملاءمته للصوت الآخر في القصيدة والثاني هو اشارة خفية الى صوت الماضي الأسطوري البعيد عن الواقع والذي لا يستطيع الشاعر الامساك به لأن الحبيبة في معظم أشعار حسب الشيخ جعفر غائبة ممانعة أما ثاني النمطين من التنوع الموسيقي لصوت البطلة فهو تنوع في الايقاع أي أنه ينتمي الى موسيقى صوت البطل ولكن بصورة ايقاعية مميزة ، ذلك أن التشكيلة العامة لصوت الشاعر هي في الغالب مستفعلن مستفعلن فعول ولكنه يمنح صوت البطلة الذي يجيء على الرجز أيضا تشكيلة أخرى من تشكيلات هذا البحر هي في الأعم فعولن ومفتعلن وجه ابتهال البقر الوحشي والوعول هائمة تركض في جرحي ابتهال وردة خجول يا أيها الماء الذي يحملني
على يديه مطرا ظلالا أترك على الشاطيء مني زهرة وشالا وخصلة تلهو على وجه الذي يعشقني وحفنة من شجن
تمزق القميص في أصابع ابتهال
بكي القطا الكدري في أصابع ابتهال
واللهب الذاهل في أصابع ابتهال(9)
واذا كان الباحث يستطيع أن يرى عددا من المبررات التي تلجيْ الشاعر الى تغيير موسيقاه فأن سعدي يوسف أشار بصراحة الى أن نوعا من الموسيقى لم يعد ملائما لنقل أفكاره ففي قصيدته اشارة يجيء المقطع الأول منها على وزن المتدارك ويستمر فيه الشاعر الى مدى ثماني صفحات وعندما يصل القارئ الى الصفحة التاسعة يفاجأ بهذه العبارة ضيق أيها المتدارك (10) بعدها ينتقل الى المقطع الثاني من القصيدة الذي يجيء على موسيقى الوافر وبهذه العبارة التي دخلت بنية القصيدة يضع سعدي يوسف أيدينا على السبب الذي جعله ينتقل من المتدارك الى الوافر ، وكان السبب الضيق ليس ضيق الشاعر بالمتدارك ، ولكن امكانات المتدارك لم تكن تتسع لما يريد الشاعر أن يقوله من هنا نستطيع أن ندلف الموضوع مهم ، وهو هل لبعض الأوزان الشعرية علاقة بتقلبات الحالة النفسية أو الانفعال المنبثق عن الموضوع ثورة حب يأس تمني حقد رغبة غضب والى مثل هذا الموضوع أشار حازم القرطاجني حين قال ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به الصغار والتحقير وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس فاذا قصد الشاعر الفخر حاكي غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة واذا قصد في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا وقصد تحقير الشيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء وكذلك في كل مقصد وكانت شعراء اليونانيين تلتزم لكل غرض وزنا يليق به ولا تتعداه فيه الى غيره (11)وربما سبق حازما في ربط علاقة الموسيقى والأوزان بالانفعال الكندي والفارابي وابن سينا ويشير الدكتور جابر عصفور الى هذا فيقول «التفت الكندي الى تشابه الوزن الشعري مع اللحن الموسيقي من حيث تأثيرهما في السلوك فقال ان أوزان الأقوال العددية - وهي الشعر - لها ايقاعات مشاكله لايقاعات الألحان بمعنى أن الايقاعات الثقيلة الممتدة في الزمن - لحنا أو شعراـ تشاكل الشجن والحزن والخفيفة والمتقاربة تشاكل الطرب وشدة الحركة (12) والى مثل ما ذهب اليه حازم القرطاجني ما يوحي به كلام صاحب الصناعتين الشاعر بعد أن تتهيأ له المعاني بأن حين ينصح أطلب لها وزنا يتأتى فيه ايرادها وقافية تحتملها (13) ومما لا شك فيه أن أرسطو هو أول من تحدث في هذه القضية وربط بين موسيقى الشعر والمواقف والحالات، يقول أما الوزن المناسب للهجاء - فهو - الوزن الايامبي أي المفعولي أو بحر القدح والذم اذ أنه هو البحر الذي يستخدمه الناس ليهجو بعضهم بعضا وان الوزن البطولي هو أفخم الأوزان الشعرية ولذا فهو يتقبل بسهولة كبيرة استعمال الكلمات النادرة والمجاز كذلك فان البحر الايامبي المفعولي الوزن والبحر الرباعي التفاعيل هما من ناحية أخرى وزنان مثيران للحركة فالثاني شبيه بالرقص والأول معبر عن العمل (14) ولكن أرسطو كان يتحدث عن الشعر في المسرح أي الأوزان التي تلائم الشخصية في فعلها المسرحي ومع هذا فان كلماته هذه قد ألقت بالكثير من ظلالها على آراء ابن سينا وحازم القرطاجني ولم يصلنا - على حد علم الباحث ـ من تراثنا النقدي ما يجلي هذه المسألة بوضوح ويأتي فيها بالكلمة الفصل وكل ما وصلنا انما هو انطباعات وآراء لا تستند الى دليل علمي وربما أفسدها التطبيق العملي والاستقراء التام لمجمل شعر شعراء العربية على بحور الشعر كافة ويرى الدكتور عز الدين اسماعيل ان فكرة ارتباط الأوزان بالحالات النفسية لها من غير شك قيمتها لكنها لا تصح الا بالنسبة لمن استخدم الوزن للمرة الأولى أعني الشاعر الأول الذي لا نعرفه الآن والذي عبر عن نفسه في وزن شعري بذاته هو الذي اخترع الموسيقى التي تناسب حالته الشعورية (15) ولعل كلمات الدكتور اسماعيل هذه تشير الى لا جدوى الخوض في مسألة من هذا النوع ما دامت مرتبطة بشخص الشاعر الأول وانفعاله الخاص أما الدراسات الحديثة التي تعرضت لعلاقة الوزن بالمعنى ، فلم تصل الى نتيجة يمكن الافادة منها بشكل علمي وحقيقي يقول الدكتور شكري عياد ان مشروعنا لا ينحصر فيما سميناه بالاتجاه اللغوي بل يشمل في نفس الوقت ما سمیناه بالاتجاه النقدي أي البحث في صلة الأوزان بالمعاني وقد لاحظنا أن الدراسات الحديثة في هذا الاتجاه مالت الى الأحكام الذاتية عند بعض الباحثين واكتفت بالأحكام العامة عند آخرين (16) ان الصعوبة التي تعترض طريق أي باحث في هذا الموضوع وهو أي البحور يناسب هذه الحالة ولا يناسب غيرها هي أن تلك الحالات ، ولنأخذ الغضب أو الرغبة مثلا لا يمكن أن تأخذ نمطا واحدا أو مقاسا مطلقا عند الناس كلهم وذلك للفروق الفردية التي تميز الواحد منهم عن الآخر فللحب درجات وللرغبة أيضا وكذلك لحالة الغضب والثورة ولهذا التمايز بمؤشرات الحدة والضعف التي تحكم الحالات علاقة أيضا بنمط الايقاع المتأتي منها ، ولعله من البديهي أ أن نقول ان شاعرا يكتب قصيدة حب أو غضب على الرمل بينما يكتبها الآخر على الكامل وثالث على المتدارك وتصح مثل هذه الحال على الأوزان الأخرى والحالات الأخرى أيضا اننا وفي حدود امكانياتنا المتاحة الآن لا نستطيع الا أن نقول أن الشعراء يغيرون من موسيقاهم داخل القصيدة لضرورات موضوعية نحاول تلمسها وكشفها ولكننا لا نستطيع الخوض في قضية ما اذا كان هذا التغيير يلائم هذه الحالة او لا يلائمها وعندما نريد لطموحنا في كشف قضية موسيقى الشعر وعلاقتها بالانفعال أن تتحقق فان ذلك يتطلب منا جهودا استثنائية لنتوصل بعدها الى الحقيقة التي لا يشوبها شك ولا تفسدها ظنون ولا ريب أن جهودنا هذه ستكون شركة بين نقاد وشعراء ولغويين وموسيقيين وعلماء نفس وأطباء متخصصين بالأصوات معامل ومختبرات وأجهزة صوتية وقبل أن نبدأ بمثل هذا المشروع ينبغي أن نكون قد انتهينا من استقرائنا الشامل للشعر العربي تراثا ومعاصرة ونكون قد بوبنا القصائد تبعاً للحالات النفسية أو الموضوعات العامة أو المواقف الفردية عند هذا وحده ، سوف نستطيع أن نقول أن الرمل مثلا يلائم مواقف الحكاية والقصة ، وأن الكامل يلائم التعبير عن الأحزان الهادئة والخبب عن الفرح والرقص ، وسيكون لقولنا حينئذ قوة الحقيقة العلمية وبدون فعل كهذا ستظل جميع الانطباعات والآراء الفردية آراء وانطباعات ليس أكثر واذ يدرك الباحث أن العلاقة بين الوزن الشعري والانفعالات والمضامين غير واضحة أو مؤكدة بشكل علمي الى الآن فان هذا لا يعني التقاعس عن محاولة دراسة غط آخر من الموسيقى المتغيرة تبعا لتغير حالات ومواقف وانفعالات الشاعر وسيكون مجال هذه الدراسة هو تلمس مدى التغير الحاصل في الايقاع الداخلي للوزن الشعري تبعا لتغير الموقف أو الانفعال بدءا نقول ان هناك افتراضا قائما في الذهن مؤداه أن الأوزان اذا لم تتغير تبعا
للتغير الحاصل في الموقف فلا بد للايقاع الداخلي أن يختلف من مقطع لآخر في القصيدة الواحدة هذا اذا كانت المقاطع تقدم حالات مختلفة وضروري هنا أن شير الى أنه من الصعب دراسة التغيير الحاصل في القصيدة من بيت الى آخر لأن البيت الواحد لا يمكن له أن يقدم حالة عامة متكاملة الملامح تشير الى موقف أو انفعال تام وانما نستطيع أن نتعرف على تلك الحالة من خلال المقطع الذي هو مجموعة من الأبيات تكشف لنا عن المعنى وما وراءه من دوافع نفسية أو اجتماعية بشكل أكثر تكاملا وستكون دراستنا للايقاع الداخلي من خلال مستويين الأول يتعلق بمدى التغيير الحاصل في التفعيلة الأصلية أي بما طرأ عليها من زحافات وعلل والثاني يتعلق بحروف المد ملتفتين الى مدى شيوعها كثرة أو قلة ومحاولة تفسير هذه الظواهر وربطها بالمتغيرات المستشفة من المعنى الذي يقدمه المقطع أما القصائد العينات فقد تم اختيارها مما مثلنا به للاتجاهات الجديدة في الشعر العراقي الحديث، أي القصائد التي تفيد من الفن القصصي أو الدرامي بشكل عام بما في هذه القصائد من جزئيات تتعلق بالحدث بالشخصية بأسلوب التعبير السرد أو الحوار مر بنا في الفصل الأول تعليقنا على قصيدة البياتي مذكرات رجل مجهول التي حاول الشاعر فيها رسم ملامح شخصية لبطل القصيدة نشأته وتكوينه ومواقفه وقلنا ان ما يميز تلك القصيدة هو أن المقاطع فيها تتوالى على شكل امتدادات وتكرار وهي تراكمات لفكرة واحدة غير متطورة كثيرا أن هذا يعني وجود حالة نفسية واحدة لبطل القصيدة عبر مجموعة من المقاطع وها نحن نعود الى القصيدة مرة أخرى لنرى تغيرات الايقاع الداخلي لعدد من المقاطع ولا بد لنا من كتابة المقاطع الثلاثة الاولى مقابلين الأبيات بالرموز « ت » التي تعني أن التفعيلة كانت تامة و « ز » مشيرين بها الى الزحاف الذي أصاب التفعيلة و«ع » الى العلة
أنا عامل أدعى سعيد ت/ع
من الجنوب ع
أبواي ماتا في طريقهما الى قبر الحسين ت/ز/ت/ز
وكان عمري ت/ع
آنذاك ت/ز
سنتين ما أقسى الحياة ت/ع
وأبشع الليل الطويل ز/ز/ع
والموت في الريف العراقي الحزين ز/ع
وكان جدي لا يزال ز/ز/ع
كالكوكب الخاوي على قيد الحياة
يمكن للباحث أن يصف هذا المقطع وصفا مبتسرا بكونه تصويرا الجزء من حياة البطل ، وأن لهجة الشاعر لهجة حزينة تميل الى التقرير والشرح والمقطع بهذه الصفات يقدم نتائج حسابية هي أن تفعيلات المقطع كنه 21 تفعيلة التام منها 6 ونسبته 28,57 والزاحف 8 ونسبته %38,10 أما التفعيلات المعتلة فكانت 7 ونسبتها 33,33 وان حروف المقطع المنقوطة بلغت 152 حرفا وأن بيتين من هذا المقطع اتصفا بالتدويرلا تشير هذه النتائج الى شيء أي أنها لا تقدم لنا ارتباطها الواضح بالحالة النفسية للبطل وكل ما يفهم منها أن الشاعر اختار بشكل غير واع هذه الصيغة الموسيقية لهذا الموقف غير أن مقارنة حسابات هذا المقطع بحسابات المقطع الثاني ستكشف لنا عن نتائج مفيدة
أعرفت معنى أن تكون ؟ ت /ع
متسولا عريان في أرجاء عالمنا الكبير ت از ازاع
وذقت طعم اليتم مثلي والضياع ؟ زازاع
أعرفت معنى. أن تكون ؟ ت/ع
لصا تطارده الظلال زاع
والخوف عبر مقابر الريف الحزين زات اع
ولا يختلف هذا المقطع في تقديمه الحالة النفسية عن المقطع السابق أي ان الأحزان ظلت تميزهما دون فارق كبير في الدرجة فهي أحزان يمكن أن توصف بأنها هادئة لم تلجئ البطل الى الصراخ واحتدام الغضب وبروز فورة الانفعال مثلا كما ان لغة الشاعر ولهجته ظلت مثلما هي في المقطع الأول انها شرح متواصل الجزئيات حياة رافقتها الأحزان هذه الصفات اقترنت بالحسابات الآتية ان عدد التفعيلات 16 كان التام منها 4 بنسبة %25 والزاحف 6 بنسبة %37٫5٪ وكذلك المعتل وان حروف المقطع المنطوقة بلغت 118 حرفا وان التدوير الذي لحق البيتين في المقطع الأول اختفى في هذا المقطع ان هذا يقودنا الى ملاحظة أن النسب التي اقترنت بأنواع التفعيلات لم تتغير كثيرا ( 2857 - 25 تام ( 10 / 38 - 37,5 زاحف 3333 - 375 معتل ) ان بقاء النسب متقاربة انما يشير الى أن الحالة النفسية للبطل لم تختلف في المقطع الأول كثيرا عما آلت اليه في المقطع الثاني ، أي أن الموقف ظل واحدا تقريبا مما أدى الى أن يكون الايقاع الموسيقي متشابها إلى حد بعيد بين المقطعين وان قولنا فيهما تقدم بأن المقاطع توشك أن تكون امتدادات وتراكمات لمعنى واحد متكرر يهدينا الى أن تلك المعاني المتكررة كانت سببا في خلق ايقاع يمكن وصفه بأنه تراكم وامتداد وتكرار أيضا هنا لا بد أن نشير الى أن الرتابة المتأتية من المعاني المتكررة والتي يحسها القارئ في قصيدة البياتي مذكرات رجل مجهول أدت الى خلق رتابة ايقاعية وأظن أن صفة الرتابة التي كثيرا ما واجهتنا في الدراسات النقدية انما ترجع في الأساس الى غیاب التغير الايقاعي وتقارب نسب الزحافات والعلل في تلك القصائد وربما كان للزحافات دور أكثر وضوحا في تغير الايقاع لأنه يتجه به الى صفتين مهمتين هما البطء أو السرعة لا نود أن نستفيض في ذكر احصاءات المقاطع كلها فالثالث والرابع لم يخرجا في النسب عما قدمه المقطعان الأولان لأنهما يعبران عن المعاني المتكررة نفسها في قراءتنا للقصيدة كما مر بنا في الفصل الأول ، قلنا ان الملمح الوحيد والجديد الذي يخرجنا من مأزق متابعة حياة البطل الضيقة الموت والفقر ويعد اضافة ايجابية الى مسار حياته هو انتماؤه الى طبقة المناضلين واختياره الانتماء السياسي وهو الآن تواق الى سفك دم الطاغية هنا ينشأ موقف جديد مختلف وسنقدمه لنرى أتغير الايقاع الداخلي للقصيدة أم ظل ثابتا غير متغير بشكل واضح ؟
ما زلت خادمك المطيع ز/ع
لكنه علم الكتاب ز/ع
وما يثير برأس أمثالي من الهوس الغريب ز/ت/ز/ع
ويقظة العملاق في جسدي الكئيب ز/ز/ع
وشعوري الطاغي بأني في يديك دبابة تدمى ت /ز/ ز/ت / ز ،
وانك عنكبوت ع
وعصرنا الذهبي ، عصر الكادحين ز/ ت / ع
عصر المصانع والحقول ز/ع
ما زال يغريني بقتلك أيها القرد الخليع ز/ز/ ت/ ع
ان الحالة النفسية التي تميز بطل القصيدة هنا خرجت من دائرة الأحزان المتراكمة التي واجهتنا في المقاطع الأولى وغادرتنا لهجة الحزن الهادىء التي كانت تسود تلك الأبيات هنا تتحول اللهجة وتصطبغ بلون الموقف الذي هو الرفض والثورة والتوق الى رؤية دم الطاغية ويلاحظ القارئ أن هذا المقطع السادس تكون من 26 تفعيلة وأتى بظاهرة ايقاعية جديدة ، ذلك أن نصف التفعيلات كان زاحفا ( 13 تفعيلة بنسبة 50٪ ) بينما لم تزد الزحافات في المقاطع المتقدمة كلها عن 39 أو 40 وكان ارتفاع نسبة هذا النمط من التفعيلات على حساب نسبة التفعيلة التامة أي أن الزحاف سلب التفعيلة التامة مكانتها ، اذ انحسرت الى 1923% وهي أدنى نسبة تحصل عليها في جميع حسابات المقاطع السابقة ، فلقد كانت تتراوح بين 25 و 31,82
كما تبين احصاءات نسب المقطعين الثاني والثالث أما نسبة التفعيلة المعتلة فلم تتغير كثيرا لأن عدد هذا النوع من التفعيلات كان 8 وكانت نسبته 30,77٪ أي أنه ظل على درجة واحدة من التغير الذي يتراوح بزيادة أو انخفاض بسيطين ، ففي المقاطع الثلاثة المتقدمة كانت نسبة 33,33 ، 1375 ، 727 ولعل هذا سيقودنا الى تقرير افتراض أول وهو أن التغيير في الانفعال وفي الحالة انما يظهر أثره في الايقاع عن طريق الزحافات أكثر من ظهوره عن طريق العلل وسيظل هذا الافتراض قائما قابلا للامتحان من خلال دراسة مجموعة قصائد ثمة ظاهرة ايقاعية جديدة تنبثق عن تلك الأبيات فبالاضافة الى شيوع نسبة الزحاف شيوعا واضحا فان الباحث يرى أن الزحاف كان يتصف بصفتين أولها الترادف أي مجيء الزحاف بعد الزحاف بشكل لم يسبق له مثيل في المقاطع المتقدمة وثانيهما ان بدايات الأبيات كانت زاحفة باستثناء البيت الخامس فقط ، وربما قادتنا هذه الظاهرة الى تقرير افتراض آخر قابل للامتحان أيضا وهو أنه كلما اشتد الانفعال وتغيرت الحالة النفسية في المقطع الجديد كلما بدأت الأبيات بأكبر عدد من التفعيلات الزاحفة ، أما شيوع الزحاف بشكل عام في المواقف المنفعلة أو المميزة في الحالة النفسية فيمكن تفسيره بأن شدة الانفعال يرافقها في الأداء اللغوي أو الموسيقي نوع من السرعة الملموسة ، أي سرعة في الأداء ، وللرغبة بتوصيل المعنى والتنفيس عن الحالة بشكل أسرع من الشكل العادي ، الهادئ وغير المنفعل ولأن الزحاف - بتعريفه العروضي - هو كل تغيير يتناول ثواني الأسباب ، ويكون بتسكين المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن - فانه يؤدي الى اختصار في عدد الأحرف وتقليص في عدد المتحركات أي أنه من ناحية الأداء الصوتي سيعمل على اختصار الزمن ولهذا فهو يتفق وحالة الانفعال التي تتطلب السرعة ؛ كما يتلاءم مع الحالة الجديدة المتميزة عما سبق أن قدمه الشاعر من حالات في المقاطع الأخرى تقدم قصيدة البياتي هذه ظاهرة ايقاعية ينبغي على الدارس أن يلتفت اليها وهي أن المقطع الأول حمل لنا بيتين مدورين ، وان هذا التدوير تم في مقطع تبرز فيه عناصر الحكاية بشكل أوضح من المقاطع الأخرى ذلك أن المقاطع الآتية أقرب الى أن تكون تصويرا لمواقف البطل بينما يبدو المقطع الأول اسهاما في تقديم التاريخ الشخصي ولذا فان عنصر الحكاية كان سمة له ان هذا يقودنا الى طرح سؤال نحاول الاجابة عنه في مكان آت من البحث وسنظل منتبهين الى حضوره دائما والسؤال هو ما العلاقة بين التدوير وعناصر الحكاية ؟ لعل المشكلة التي تواجه دارس الايقاع الداخلي وتغيراته في القصيدة تتعلق بقضية حروف المد التي تكسب المقطع اذا شاعت شيوعا واضحا نوعا من البطء الموسيقي أو ما يمكن أن يوصف بالتراخي الموسيقي كما ان انعدامها أو قلتها يسهم في اضفاء نمط من الموسيقى الأقرب الى السرعة لكن كيف يمكن للباحث أن يحسب حروف المد ؟ ان أي دارس سيجد في نفسه أمنية هي لو كان باستطاعته أن يستمع الى القصيدة كما ينشدها الشاعر المؤلف لكن رغبة من هذا البرع ستبدو مستحيلة التحقق ، لأن أكثر من شاعر مهم من شعراء هذا البحث موتى وستبدو الرغبة صعبة التحقق لو أن الباحث - شأنه الآن شأني - لا يمتلك تسجيلا صوتيا للسياب أو حسين مردان أو شاذل طاقة أو البياتي مثلا ذلك أن قراءة الشاعر لقصيدته ستكون معبرة الى حد بعيد عن احساسه وانفعاله وابرازه شدة أو ضعفا وستوضح بشكل جلى أين هي حروف المد التي سيوليها الشاعر عناية وتركيزا في النطق معروف أن بعض حروف المد يمكن للقارىء أن يمتد بها زمنيا وبعضها الآخر لا يستحق ذلك الامتداد فلو أننا قرأنا هذا البيت أبواي ماتا في طريقهما الى قبر الحسين لوجدنا أن الألف في أبواي تفرض على القارىء أن يمتد بها في الزمن وكذلك الألف في ماتا لكن الياء في طريقهما والحسين لا تتطلب بشكل ضروري امتدادا في الزمن ان القارىء يستطيع أن يمتد بهما وله ألا يمتد أيضا وهذه الحرية التي تواجهه تخلق أشكالا حسابيا بمعنى أتحسب أم لا تحسب في البدء جربت اللجوء الى حساب كافة حروف المد بلا استثناء وانتهيت في أكثر من قصيدة الى أن نسب الشيوع كانت متقاربة ، والتقارب اذا شاع في أكثر من مقطع أو قصيدة - مع تباين الحالات - فانه لا يشير الى شيء لا يقدم حكما ولا يهدي الى معرفة نمط وظيفة هذه الحروف في التأثير على نوعية الايقاع ، فقررت أن أقرأ القصائد قراءة منشد أو ممثل وحاولت قدر الامكان ان تكون قراءتي أقرب الى روح النص أي الى تمثل الانفعال أو الحالة النفسية أو الموقف الفكري وهذا النمط من القراءة يقود الى عدم حساب عدد من الحروف التي لا تتطلب الامتداد في الزمن ، في النطق ، ومع هذا كله فان احصاءات الحروف كما يقدمها البحث تعتبر نسبية لأنها غالبا ما تتراوح بين الزيادة والنقص الزيادة القليلة أو النقص القليل الذي لا يتعدى حرفا أو حرفين في المقطع الواحد كانت جميع حروف المقطع الأول المنطوقة 152 حرفا وبلغت حروف المد 16 حرفا أي بنسبة 10,53% أما المقطع الثاني فكانت حروفه 117 وحروف المد 12 والنسبة %10٫26٪ والمقطع السادس بلغت حروفه 186 وحروف المد 8 والنسبة 4,30٪ من هذه الحسابات يتضح أن أعلى نسبة الحروف المد كانت في المقطع الأول وبعبارة أخرى ان تلك النسبة جعلت المقطع ذا ايقاع بطيء مميز عن المقاطع الاخرى ، وتبدو هذه النتيجة طبيعية مع ما يقدمه المقطع من حالة ، ذلك أن البطء يتلاءم مع القصيدة ذات العنصر الحكائي ، والحكائي الحزين بالذات ، أما المقطعان الثاني والثالث فنسبة حروف المد فيهما متقاربة ومرد هذا التقارب يرجع الى أنهما يقدمان حالة نفسية واحدة ، وموقف واحد هو شرح لمعنى الحرمان والخوف والأحزان التي مر بها بطل القصيدة ، ويلاحظ أيضا أن النسبة حصلا عليها لم تكن لتفرق كثيرا عن نسبة الحروف في المقطع الأول ، وهذا التقارب ناتج عن امتداد حالة الحزن الهادىء التي تعم القصيدة والتي خلقت نمطا من الايقاع الأقرب الى البطء ان النقلة الكبيرة في نوعية الايقاع تبرز بوضوح في المقطع السادس ذلك أن نسبة حروف المد فيه بلغت 4,30 أي أنها أقل من نصف نسبة المقطع الأول مما أكسب أبيات البياتي هنا نمطا من الايقاع السريع ، ويبدو هذا منسجها مع حالة البطل النفسية وموقفه الفكري لأنه في هذا المقطع انتقل من الشارح الذي يروى أحزانه ، الى الثائر المحتدم بالغضب الذي يخاطب الطاغية ويعلن أن عصر المصانع والحقول ما زال يغريني بقتلك أيها القرد الخليع سيحاول الباحث أن ينتقل الى قصيدة أخرى تنتمي الى الأداء القصصي في الشعر وذلك في محاولة لتلمس صحة الافتراضات التي قدمتها قصيدة البياتي والقصيدة الجديدة هي غريب على الخليج القصيدة كما قدمها السياب تتألف من ثلاثة مقاطع غير أن المقطع الأول الذي هو أطول المقاطع جدير بأن يجزأ الى مجموعة من المحاور الداخلية لأنه يحمل عددا من الحالات والانفعالات غير المتطابقة تماما ، وتغير تلك الحالات والمواقف مكن الدارس من تقسيمه الى خمسة محاور
الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل ز/ت/ت/ع
وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل ت/ت/ز/ع
زحم الخليج بهن مكتدحون جوابو بحار ت/ت/ت/ع
من كل حاف نصف عار ز/ع
وعلى الرمال على الخليج ت /ع
جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج ت/ت/ت/ع
ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج ت/ت/ت/ع
هذا هو المحور الأول من محاور المقطع ويتفرد بصفات ممكن اجمالها بكونها وصف الشاعر لمكان الحدث وفيه أيضا وصف لشيء من ملامح الشخصية ، والمحور يقدم هذا الوصف بلغة هادئة مشوبة بحزن شفيف ، ان هذا كله أدى الى هذه النتائج الحسابية عدد التفعيلات 24 التام منها 14 = 58,33 والزاحف 3 = 12,5 والمعتل 7 = 2917 وحروف المقطع المنطوقة كلها 182 وحروف المد 20 = 309
99، 10% أما المحور الثاني فتقدمه هذه الأبيات
أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج ز/ز/ت /ع
صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق ز/ت/ت/ع
كالمد يصعد كالسحابة كالدموع الى العيون ز/ت/ت/ع
الريح تصرخ بي عراق زاع
والموج يعول بي عراق عراق ليس سوى عراق ز/ت/ت/ع
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون ز/ت/ت/ع
والبحر دونك يا عراق ز/ع
ان الذي حدا بالباحث لأن يجعل هذه الأبيات محورا جديدا هو أنها تتميز عن الأبيات السابقة بكونها تجسيدا لصوت البطل - الشاعر - الداخلي ففي المحور الأول كان السياب يصف الخارج ، أعني مكان الحدث ، وها هو الآن يتعمق احساسه الداخلي وكانت لهجته في المحور الأول لهجة حزن هادئ ، لا صراخ فيها ولا عويل، غير أنه الآن باك محتدم بالأسى والشكل والدموع هذا المحور اذن يقدم حالة توشك أن تكون مغايرة للحالة الأولى ومن هنا استحقا أن تكون محورا ، لا بد له أن يقدم ايقاعا داخليا مغايرا أيضا والا فان الايقاع والموسيقى بشكل عام ستكون غير موظفة توظيفا ايجابيا منسجما مع شدة الانفعال تكون هذا المحور من 24 تفعيلة كان التام منها 9 = 37,5 والزاحف 8 = 3333 والمعتل 7 = 2917 ، وحروف المقطاع كله 176 ومجموع حروف المد 11 = 6,25 ، ولو قارنا بين هذه النسب ونسب المحور الأول لاتضح لنا الى أي حد ارتفعت نسبة الزحافات على حساب التفعيلات التامة كانت نسبة التام في المحور الأول 583 وغدت هنا 37,5, بينما ارتفعت نسبة الزحاف من 5و12 الى أي انها تضاعفت أكثر من مرتين ونصف ولعل هذا التغيير في عنصر مهم من عناصر الايقاع يرتبط بتغير الحالة النفسية للشاعر من محور لآخر بمعنى أن السياب كلما توغل في الاحساس بالحزن وشدة وقعه عليه كلما مالت التفعيلة في شعره لأن تكون زاحفة ان الافتراض الذي طرحناه من خلال قصيدة البياتي وهو أن الاحساس بشدة الانفعال يتطلب السرعة في الأداء والسرعة تتلاءم مع الزحافات يتأكد لنا مرة أخرى هنا في قصيدة السياب مر بنا في المقطع السادس من قصيدة البياتي المتقدمة الافتراض بأن شدة الانفعال تقود الشاعر الى أن يبدأ أغلب أبياته بالزحاف ويقدم لنا هذا المحور من قصيدة السياب ما يؤكد ذاك الافتراض أيضا أما التفعيلة المعتلة فلم تتغير نسبتها في هذا المحور عن نسبتها في المحور الأول وظلت 29,17 غير أن التفعيلة المعتلة لم تعد كما كانت في المحور الأول ، لقد تغيرت أيضا وضروري أن نشير الى أن التفعيلة التي رافقت ذاك المحور كانت في أبياته جميعها متفاعلاتن بينما لم ترد متفاعلاتن في هذا المحور غير مرة واحدة ، وحلت محلها التفعيلة المعتلة متفاعلان وهذا يشير الى أن التفعيلة المعتلة هنا لعبت دورا واضحا في خلق ايقاع ينأى عن ذاك الايقاع لأنها تقدم نمطا من التنوع الذي يبعد بالايقاع عن أن يكون مكررا أو متطابقا مع ما تقدم هذا اضافة الى أن الزمن الموسيقي الذي تقدمه (متفاعلان) هو أقصر من الزمن الذي تقدمه متفاعلاتن AM أي ما مجموعه 21 بينما يكون زمن متفاعلان HIFA أي ما مجموعه 2 فقط ولعل هذا الاختصار بالزمن الذي تقدمه التفعيلة المعتلة هنا كان تجاوبا لمتطلبات الحالة التي تميل الى خلق الايقاع السريع الملائم للانفعال ، أي أن الزحاف والعلة تآزرا هنا لخدمة المضمون الذي يتطلب ايقاعا سريعا ولعل القارئ سيلمس التغير الكبير في نسبة حروف المد ، فلقد انخفضت من 10,99 في المحور الأول الى 6,25٪ في هذا المحور ذلك لأن الشاعر في أبياته تلك كان يصف ويصف ما هو خارج انفعالات النفس وكان هادئا والوصف جزء من متطلبات حكايته والحكاية والهدوء يميلان الى شيوع حروف المد بينما يتطلب الانفعال الطاغي السرعة التي تتنافى مع كثرة حروف المد يأتي المحور الثالث وهو أطول محاور القصيدة بدءا من قول الشاعر بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق وانتهاء بقوله ان كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء وتجنبا للافاضة فاننا سنشير باختصار الى مميزات هذا المحور والى النسب العامة في هذا المقطع يتكرس عنصر الحكاية اذ يروي لنا الشاعر شيئا من وصف الغربة ، وماضيه وذكرياته وطفولته في قريته وما كان يدور فيها من أحاديث علقت بذاكرته منذ كان صغيرا وينتهي المحور بمخاطبة الحبيبة ومشاركتها الحديث عن تلك الأيام وفي المحور عموما يهدأ انفعال الشاعر الذي كان طاغيا في المحور الثاني وتهدأ لهجته أيضا وأحزانه بدأت تميل لأن تكون شفيفة تحمل لون الماضي الجميل الذي لن يعود في هذا المحور انخفضت نسبة الزحاف الى 2824% بينما كانت في محور الأسى الذي سبقه 33,33 وارتفعت نتيجة لهذا نسبة التفعيلة التامة التي صارت 45,88% بينما كانت في ذاك المحور %37٫5 ويشير انخفاض نسبة الزحاف الى الهدوء الواضح في الحالة النفسية لأن الشاعر لم يعد باكيا صارخا انما غدا قاصا يروي حكاية هادئة تتطلب ايقاعا أقرب الى البطء ولا توجب اللجوء الى السرعة التي تخلقها التفعيلات الزاحفة ان افتراضنا الذي مر بنا في قصيدة البياتي وتأكد في قصيدة السياب وهو أنه كلما اشتد انفعال الشاعر كلما بدأ أبياته بتفعيلة زاحفة يؤكده هذا المحور أيضا ، وأعني أنه كلما هدأت فورة الشاعر وقلت حدة انفعاله كلما لجأ الى التفعيلة التامة في بدايات سطوره ونلاحظ هنا أن مجموع أبيات هذا المحور كانت 26 بيتا ، البدايات التامة هي14 والزاحفة 12 أما التفعيلة المعتلة فقد انخفضت نسبتها انخفاضا غير كبير عما كانت عليه في محور الأسى فبلغت %2588 بعد أن كانت 2917٪ ، ويلاحظ في هذه التفعيلة المعتلة غلبة صيغة « متفاعلان » على متفاعلاتن » وهذا يبين أن الذي أسهم في خلق الايقاع البطيء الهادئ هو انحسار الزحاف لأن التفعيلة المعتلة
متفاعلان توشك أن تكون - بشيوعها - انتماء الى ايقاع المحور الثاني أي أن دور التفعيلة المعتلة في هذا المحور لم يسهم كثيرا في ابراز الايقاع البطيء الذي لعبت فيه حروف المد دورا مهما جدا اذ بلغت 75 حرفا من مجموع 625 حرفا هي جميع حروف المحور الثالث أي بنسبة %12 ، ان هذه النسبة توشك أن تكون ضعف نسبة المحور الثاني التي كانت 625 ولذا فان شيوع حروف المد هنا كان موظفا بشكل ايجابي لخدمة المضمون الذي هو استرسال بتذكر الماضي من خلال عنصر الحكاية التي لا يشوبها انفعال صارخ والتي تتطلب البطء في الايقاع قادتنا قصيدة البياتي التي قدمت أكثر من بيت مدور مرتبط بعنصر الحكاية ، الى افتراض هو ما اذا كان للحكاية التي تتطلب الاسترسال علاقة بظاهرة التدوير ويظل هذا الافتراض قائما فالمحور الثالث لهذه القصيدة يقدم أربعة أبيات مدورة هي بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق وكنت دورة اسطوانة وهي النخيل أخاف منه اذا ادلهم مع الغروب فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين وواضح للقارئ أن التدوير هنا يرتبط مرة أخرى بعناصر الحكاية أيضا وسيبقى الافتراض في ذهن الباحث وهو يتحدث عن الظواهر الموسيقية في حركة الشعر العراقي المعاصر يبدو المحور الرابع الذي يبدأ بقول الشاعر أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه وينتهي بالبيت من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق (17) يبدو وكأنه امتداد للمحور الثاني لأنه يتصف بصفاته فهما يقدمان حالة واحدة هي التوق الى الوطن ويرسمان معا أحزان الغربة القاسية المفروضة على الشاعر حقا ان هذا المحور يقدم معاني جديدة هي الربط بين الحبيبة وبين الوطن ، ثم موقف الشاعر الفكري من قضية الخيانة لكن هذه المعاني الجديدة لا تخرج المحور عن الحالة الأساسية التي هي الحنين والحزن المتراكم الواضح في لهجة الشاعر ، واذا كانت نسبة الزحاف في المحور الثالث محور القصة الهادئة قد بلغت 28,24 فانها ارتفعت في هذا المحور الى نسبة 36,21 لأن عدد التفعيلات التي أصابها الزحاف بلغت 21 تفعيلة من مجموع 58 ، أي أنها فاقت نسبتها في المحور الثاني محور الأسى لأنها كانت 33,33 وهذا يدلل بشكل واضح على ارتباط الزحافات قلة أو كثرة بنوع الانفعال ودرجته أي أن الايقاع الداخلي يتغير تبعا لتغير انفعال الشاعر قوة أو ضعفا أما نسبة التفعيلة التامة في هذا المحور فقد كانت نسبة الزحاف ذاتها وهذه هي المرة الأولى التي يساوى فيها الزحاف نسبة التام ، حقا ان الزحافات كانت ترتفع في محاور الحزن الشديد ولكنها لم ترق الى نسبة التام فيما تقدم من الأبيات ان الباحث يمكن أن يؤكد ، بشكل لا يقبل الشك العلاقة التي تربط شدة الانفعال بشيوع الزحاف من خلال محاولة احصائية جديدة تقوم على الفصل بين جزأين من أجزاء هذا المحور الجزء الأول هو الذي يبدأ من أحببت فيك وينتهي بـ الى الولادة ويتصف هذا الجزء بأنه يقدم شوق الشاعر الى وطنه من خلال مخاطبة الحبيبة ، أما الجزء الثاني الذي يحمل موقف الشاعر من قضية الخيانة ويجمع بين تقديس الوطن والحنين الطاغي اليه ، فانه يدلل على شدة الانفعال أكثر من الجزء الأول وتبعا لهذا الافتراض يمكن لنا حساب الزحافات ، التي بلغت 10
تفعيلات من مجموع 26 تفعيلة أي بنسبة 38،45 بينما تكون التفعيلة التامة بعدد 8 أي بنسبة 30,77٪ هنا يتضج التامة أن الزحاف تفوق بشكل واضح على التفعيلة وعموما فان هذا المحور الرابع يضع أيدينا على صدق الافتراض الذي بدأ بقصيدة البياتي وهو أن شدة الانفعال تلجئ الشاعر الى بدء أكبر عدد من أ أبياته بتفعيلة زاحفة ولذا فان بدايتين فقط من بدايات سطور السياب كانتا بتفعيلتين تامتين وأربع عشرة بداية كانت بتفعيلة زاحفة بلغ عدد التفعيلة المعتلة 16 تفعيلة وبقيت نسبتها غير متغيرة بشكل كبير الا أن أغلب هذه التفعيلات كان على صيغة متفاعلان وليس متفاعلاتن التي لم تتكرر غير أربع مرات بهذا تسهم متفاعلان بمواكبة الايقاع السريع الذي قدمه ذاك العدد الأكبر من الزحافات أي أنها وظفت لخدمة الايقاع الذي يملأ روح الشاعر ويلائم حالته النفسية بينما بدت وظيفتها في المحور الثالث غير مؤكدة أو واضحة أما حروف المد فمجموعها 33 حرفا وحروف المحور المنطوقة كلها 426 وبلغت نسبتها 7,75% ولو أننا قارناها بنسبة حروف مد المحور الثالث محور القصة التي كانت 12 % لاتضح لنا انخفاض النسبة وقلة الشيوع الذي يتوافق مع الايقاع السريع للمحور كله أي أن حروف المد توظفت هي الأخرى لابراز نوع الايقاع المطلوب لخدمة الحالة النفسية وانفعالات الشاعر لا يود الباحث أن يستفيض بالحديث عن نتائج احصاءات بقية القصيدة تجنبا للاطالة وخوفا من التكرار غير أنه يشير الى أن حسابات بقية القصيدة لا تتناقض مع النتائج التي تقدمت، بل تؤكد صحتها وصحة الافتراضات في نمط آخر من القصائد التي تنتمي الى الأداء القصصي والتي يتكرس فيها اهتمام الشاعر بالقصة ويتجاوز عنايته الشخصية فقط حيث ينصرف الى برسم متابعة الحدث يحاول الدارس أن يتجه تتغيرات الايقاع وجهة أخرى لا ترتبط بتباين انفعالات الشاعر ذاته وانما الجزئيات الحدث القصصي كله وصف المكان الأبطال صوت الشاعر معلقا أو صوته متدخلا ناطقا بآراء البطل صوت البطل نفسه ثم طبيعة الايقاع في لغة السرد وهل يختلف عن ايقاع لغة الحوار في المواقف الدرامية المتضادة هذا كله من أجل تلمس التغير الحاصل في الايقاع تبعا لتغير هذه الشؤون وسوف يبتعد الدارس - قدر الامكان - عن ايراد النصوص الشعرية ورموزها المؤثرة في الايقاع الشعري ويكتفي بالحديث عن الحالة أو تغير الموقف مقارنا ذلك بالنسب المئوية التي ارتبطت بتلك التغيرات أما النص الشعري ورموزه فسيكون ملحقا لهذا الفصل تبدأ القصيدة القصصية المومس العمياء بتصوير مكان الحدث المدينة الكابية التي ما تزال تشرب ليلها المرير ويقدم هذا المقطع نمطين من الوصف الأول هو الوصف الخارجي للمدينة ويحمل هذا الوصف بعض احساس الشاعر بسواد مكان الحدث والأبيات التي تشير الى هذا الوصف تبدأ من أول القصيدة وتنتهي بقوله وكأنها نذر تبشر أهل بابل بالحريق يقابل هذه الأبيات الأبيات الأخرى التي تعكس شدة احساس الشاعر بمأساوية المكان تعكس الادانة الواضحة للمدينة وأهلها وحياتها قابيل أخف دم الجريمة بالأزاهر والشفوف وبما تشاء من العطور أو ابتسامات النساء عمياء كالخفاش في وضح النهار هي المدينة والليل زاد لها عماها واذ نقارن بين وصف المكان في هذين المحورين يتضح لنا هذه النتائج في المحور الأول 20 تفعيلة كان التام منها 10 ونسبته 50% وهي نسبة عالية جدا والزاحف منها 5 ونسبته %25 وهي تقل بشكل كبير عن نسبة التام أما التفعيلة المعتلة فعددها ه ونسبتها %25 وحروف المحور المنطوقة 148 وحرف المد 15 ونسبتها الى حروف المحور 10,14 في المحور الثاني 47 تفعيلة ، التام منها 16 والزاحف 17 والمعتل 14 والنسب على التوالي 34,04، 361، 29,79 وحروف المحور كلها 352 وعدد حروف المد 32 ونسبتها 909% وفي هذا المحور تغيرت النسب تماما كان التام 50٪ فغدا 34,04 ذلك أن الزحافات المتلاحقة سلبته تلك القيمة الحسابية العالية التي كان يتمتع بها ، لأن الشاعر كان في موقع من يصف من الخارج دون أن : يسبغ على المكان الكثير من احساسسه به وما أن تغير احساسه بالمكان وبدا له أنه أكثر سوادا وأفجع حتى تغير ايقاعه الشعري ومالت نسبة الزحاف الى الارتفاع الواضح كما تغيرت تبعا لذلك نسبة حروف المد التي كانت في المحور الأول 10,14٪ وأضحت هنا 9,09 اسهاما منها في خلق الايقاع السريع المتوافق مع احساس الشاعر المأساوي بمكان الحدث في المحور الأول كانت نسبة التفعيلة المعتلة 25% وهي نسبة تعادل نسبة التفعيلة الزاحفة بينما قلت في هذا المحور عن نسبة التفعيلة الزاحفة ، صارت 29,79 مقابل 17 36، وهذا التغير كله ، في النسب كلها انما هو لتغير نمط وصف الشاعر للمكان الذي حمل الينا احساسه المرير والحزين به ثمة ملاحظة جديرة بالالتفات وهي أن ارتفاع نسبة التفعيلة التامة في المحور الأول وانخفاض نسبة الزاحفة يذكرنا بنسب المحور الأول من قصيدة الشاعر غريب على الخليج والسبب في هذا التشابه يرجع أ أساسا الى أن طريقة الشاعر في أداء هذين المحورين طريقة واحدة هي أنه يصف من الخارج أي دون أن يسمح لانفعاله الخاص بالمزيد من التسرب وهو يصف المكان هنا لا بد أن نشير أيضا الى أن المحور الأول الوصف من الخارج بدأه السياب بثلاثة أسطر تبدأ بتفعيلة تامة أي أن الغلبة في بدء السطور كان للتفعيلة التامة بينما ابتدأت عشر أبيات من أبيات المحور الثاني بتفعيلة زاحفة ولم يحظ البدء بالتفعيلة التامة بغير ثلاثة أبيات فقط وهذا يؤكد الافتراض الذي مر بنا سابقا أكثر من مرة المومس العمياء كثيرا ما يستمع القارئ الى صوت الشاعر معلقا على
الحدث فالسياب كان أقرب الى الرواية منه الى القاص المتمرس البارع ، وقليلة هي المرات التي يتعرف فيها قارئ القصيدة على صوت البطلة هواجسها أحزانها . وموقفها ان هناك صوتين اذن ، صوت الشاعر وهو الأكثر شيوعا وصوت البطلة الذي يوشك أن يكون غائبا ومع أن السياب يتدخل كثيرا في حياة أبطاله بل ويوشك - في أحيان عديدة ـ أن ينطقهم بلغته هو مع هذا فان لنا أن نجرب بين صوتين صوت الشاعر معلقا وصوت البطلة تتحدث عن أساها ومحنتها تقول بطلة القصيدة لا تتركوني يا سكارى للموت جوعا بعد موتى - ميتة الأحياء – عارا لا تقلقوا فعماي ليس مهابة لي أو وقارا ما زلت أعرف كيف أرعش ضحكتي خلل الرداء ابان خلعي للرداء - وكيف أرقص في ارتخاء وأمس أغطية السرير وأشرئب الى الوراء ما زلت أعرف كل ذلك فجربوني يا سكارى من ضاجع العربية السمراء لا يلقى خسارا وما ذكرنا للبيت ، من ضاجع العربية الا من قبيل اتمام الدفقة الشعرية لأنه لا يدخل في حساباتنا وذلك لسبب واحد هو أنه يشير الى صوت الشاعر بوضوح وهذا البيت قاد السياب الى حديث مسهب علاقته بالحدث القصصي واهية أو أنه طرح لبعض من أفكاره الشخصية التي لا تنسجم مع مجرى الحدث صوت البطلة يقدم لنا هذه النتائج عدد التفعيلات 26 التام منها 11 الزاحف 8 ، المعتل 7 والنسب على التوالي 42,31، 30,75 ، 26,92 ومنها يتضح أن نسبة الزحاف عالية أما التفعيلة المعتلة فقد قدمت نمطا ايقاعيا يعتمد على المزاوجة بين الصيغتين المعتلتين متفاعلاتن و متفاعلان بالتناوب وكانت مجموع حروف المد 15 حرفا نسبتها المئوية 7,77 لأن حروف هذا المحور كلها كانت
193 حرفا هذه النتائج المرتبطة بصوت البطلة المأساوي نقارنها بنتائج صوت الشاعر معلقا على الحدث، في أبياته التي تبدأ من قوله ذهب الشباب فشيعيه مع السنين الأربعين وتنتهي بـ ( كالمصباح والزيت الذي تستأجرين ) ونتائج هذا المحور محور الصوت المعلق هي أن نسبة التام بلغت 56,67 والزاحف 2333 والمعتل %20% ونسبة حروف المد %12٫5 لأن الحروف بلغت 27 من مجموع حروف المحور البالغة 216 ، وهذه النتائج تقدم لنا ارتفاع نسبة التام ارتفاعا كبيرا عما كانت عليه في محور صوت البطلة وانخفاض نسبة الزحاف انخفاضا كبيرا أيضا ، كما ارتفعت نسبة حروف المد من %7,77 الى 12,5 ولعل ارتفاع نسبة التام وحروف المد يرجع الى سبب واحد هو تباين شدة احساس أي صوت من الصوتين بالانفعال ولا شك أن صوت الشاعر وهو يعلق على الحدث أو يخاطب البطلة لا يحمل من الاحساس بالانفعال وشدته ما تحمله كلمات البطلة الجريحة وهي تتوسل الى الزناة أن لا يصدوا عنها ان الاختلاف في الحالة النفسية بين المحورين أدى الى تقديم ايقاعين مختلفين بشكل واضح الأول يميل الى السرعة المنسجمة مع ذروة الأسى والثاني يميل الى البطء الواضح بطء المعلق على الحدث ويوضح الملحق رقم (18) أن أبيات محور صوت البطلة بدأ أغلبها بتفعيلة زاحفة بينما ابتدأت أغلب أبيات محور صوت الشاعر بتفعيلة تامة ولم تحظ البدايات الزاحفة بغير بيتين من مجموع ثمانية أبيات ، مما يؤكد الافتراض بأن شدة انفعال الشاعر تلجؤه الى المزيد من الأبيات الزاحفة (19) مر بنا ان حسب الشيخ جعفر من أكثر الشعراء تكريسا للحوار في بناء قصيدته لقد غدا الحوار وسيلة تعبير لا تنفصل عن السرد في أشعاره منذ مجموعتيه زيارة السيدة السومرية وعبر الحائط في المرآه غير أن ما يهم الباحث وهو يدرس قضية الايقاع الداخلي تلمس الفروق الايقاعية بين أسلوبي التعبير اللذين يعمان القصيدة وهما السرد والحوار في قصيدته اوراسيا يبدأ الشاعر بأسلوب السرد أرى الحافلات الأخيرة تهجر موقفها ارتدي معطفي وأغادر غرفتي البهو منطفئ والحديقة تصغي (20)ويقدم هذا المقطع السردي الذي يصف فيه الشاعر المدينة الخارج وما حوله نتائج بلغت فيها نسبة التفعيلة التامة 55,55 والزاحفة 44,44 وليست هناك تفعيلة معتلة واحدة لأن القصيدة مدورة والتدوير لا يسمح بظهور القوافي الخارجية التي تفيد من تفعيلة المتقارب المعتلة فعل أو فعول أما حروف المد فكانت نسبتها 7,72 لأن مجموعها 19 حرفا من حروف المقطع كلها 246 بعد مقطع السرد مباشرة يبدأ الشاعر هذا الحوار القصير اذن جئت فلنتجول قليلا ولكنني في الحديقة منذ أسابيع أرقب مصباحك المتوهج دون المصابيح أم كنت تجهل موعدنا المتكرر ؟
أعرف موعدنا غير أني أخشى اختفاءك أكره أن يتبدد وجهك في الضوء
مهلك هذي يدي في أصابعك المستريبة تخفق دافئة دعك من شكك المتسائل وقبل أن نتبين نتائج هذا الجزء من الحوار نقول أن هناك افتراضا شائعا وهو أن ايقاع أسلوب السرد ووصف الأمكنة لا بد أن يكون أكثر ميلا الى الهدوء أو البطء من ايقاع أسلوب المحادثة أو الحوار الذي يميل الى السرعة في الايقاع لكونه يقوم على عنصر الحديث الذي يحمل أسئلة واجابات بعبارة أخرى أن ايقاع السرد ينبع من ذات الفرد الكاتب وهو يسترسل بالوصف أو الحدث تبعا لرغباته الخاصة ، بينما يتألف ايقاع الحوار من المشاركة مع الآخر أي أنه ليس ذاتيا محضا وثابتا بل متغير لأنه لا ينبع من ذات واحدة وهنا لا بد أن نشير الى أن الحوار أسرع من السرد اذا كان الاسلوبان على درجة واحدة من الحالة النفسية ، كأن يكون أسلوب السرد هادئا وكذلك الحوار ولا شك أن للسرعة الايقاعية التي يتطلبها الحوار درجات أيضا لأنها ترتبط أصلا بنوع المحاورة فاذا كان الحوار محتدما ثائرا مليئا بالانفعالات كان الايقاع السريع أكثر بروزا واذا كانت المحاورة هادئة غير ميالة الى العنف كما في المثال المتقدم من شعر حسب كانت أقرب الى الايقاع ذي السرعة غير الشديدة ولكن ايقاع الحوار في كافة أنماطه درجات الانفعال والحالة النفسية يظل بشكل عام أكثر سرعة من حديث الفرد الواحد وهو يصف أو يتحدث عن حكاية والحوار الذي تقدم يؤكد هذا الافتراض فاذا كانت نسبة التفعيلة التامة في السرد هي العليا %55,55 مقابل %44,44 للزحاف فان النسبة في أبيات الحوار تغيرت تماما لقد غدت تفعيلة الزحاف هي المتقدمة 55,81 تقابلها للتام %44,81٪ مما أكسب المقطع الحواري ايقاعا مميزا بالسرعة كما كان لنسبة حروف المد التي انخفضت في المقطع الحواري عما كانت عليه في مقطع السرد دور مهم ومؤثر في بروز هذه السرعة ذلك أن نسبة حروف المد بلغت 3,14 أي أقل من نصف نسبة حروف المد في مقطع السرد لعل قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد المصادرة وهي من القصائد المبنية بناء طويلا متناميا والتي تفيد من عنصر الحوار افادات مهمة جدا ستبين لنا التغيرات التي تحصل في ايقاع الحوار تبعا لتغير درجة الانفعال وتغيرات المواقف عنفا أو هدوءا بين بطل القصيدة الجندي وبين قضاته وسنختار من القصيدة ثلاثة نماذج من الحوار المرتبط بثلاثة أنماط من المواقف ذاكرين صفات المشهد ونوع اللهجة والانفعال تاركين الأبيات ورموزها لنوردها في الملحق وذلك توخيا للاختصار (21) يبدأ النموذج الأول من قول الشاعر على لسان القضاة في جوازك حين عبرت الحدود وينتهي بقول الجندي سأحاول رؤيته وفق أعينكم يمكن لنا أن نصف نمط الحوار الذي جاء على لسان القضاة بأنه هادئ اللهجة خال من العنف مشوب بالتهكم ميال الى الادانة ، ونصف لهجة الجندي بأنها غير عنيفة في الرد ولكنها مستريبة تشف عن خوف كامن وقبل أن نتحدث عن نتائج الحوار جدير بنا أن نشير الى أن التفعيلة الأصلية للقصيدة هي فاعلن الصيغة الأساسية لبحرالمتدارك و فاعلن عندما يصيبها التذييل وهو من علل الزيادة تتحول الى فاعلان فان أصابها الترفيل : علة زيادة أيضا صيرها ( فاعلاتن ) وان أصابها الخبن والترفيل فعلاتن وعلل الزيادة هذه لا تأتي الا في أواخر الأبيات ولـ فاعلن علة نقص واحدة هي القطع حذف آخر الوتد المجموع اسكان ما قبله الذي يصيرها فاعل أي فعلن ولها زحاف هو الخبن حذف الثاني الساكن وبه تتحول الى الصيغة فعلن هنا نجد أن علة النقص والزحاف القطع والخبن يشتركان معا في مهمة واحدة هي الحذف وكأن عمل العلة هنا عمل الزحاف بمعنى أنهما يؤديان الى الاختزال اختزال الصيغة فاعلن وهذا الاختزال يؤدي بشكل واضح الى السرعة في الأداء الصوتي النطق والسرعة في الزمن الموسيقي أيضا لأن فاعلى أقصر في الزمن من فعلن ومن فعلن لكن فعلن و فعلن هما صیغتان متساويتان بالزمن فلكل منهما درجة واحد بينما لـ فاعلن درجة وربع الدرجة غير أن الفرق بين فعلن وفعلن يكمن في التركيب ذلك أن فعلن تتكون من سببين متلاحقين نصفين بينما تتألف ( فعلن ) من ربعين ونصف أي فاصلة صغرى وما دامت علة النقص في المتدارك قد أخذت تؤدي وظيفة الزحاف أي تسهم بنمو الايقاع الأكثر سرعة فان علينا - في حساباتنا الرياضية - أن لا نفرق بين ما هو زحاف وما هو علة نقص ويتحتم علينا أن نجمعهما الى بعضهما لأنهما يؤديان وظيفة ايقاعية واحدة وما احتفاظنا برمزيهما أو اسميهما الا من قبيل الحفاظ على المصطلح العروضي واذا كانت علة النقص قد أسهمت مع الزحاف بتقديم الايقاع السريع فان قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد قد وظفت في أكثر من بيت الصيغة الايقاعية الجديدة فاعل وتبرز هذه الصيغة مع علة النقص والزحاف في قوله أطلب مـرأة أبصر فيها وجهي وفي مواضع عديدة أخرى من القصيدة لم يقل العروضيون - على حد علم الباحث - شيئا عن فاعل في سياق المتدارك ولا ندري على وجه التأكيد أهي علة أم زحاف غير أني أميل الى اعتبارها علة تمشيا مع القاعدة العروضية القديمة التي تقول ان الزحاف هو التغيير الحاصل بثواني الأسباب وما دام التغيير قد حصل في وتد فاعلن فهي أقرب الى كونها علة
ومهما يكن نوعها علة أو زحافا فانها من الناحية الايقاعية تسهم جنبا الى جنب مع الصيغتين فعلن و فعلن في اضفاء طابع السرعة على الايقاع الشعري لأنها اختزال لـ فاعلن الأطول في الزمن وفي النطق ونعود الى مقطع الحوار، بين الجندي وقضاته ، لنرى هذه النتائج بلغ عدد تفعيلات حوار الجندي 19 تفعيلة التام منها 7 ونسبته 36,84 والزاحف - مضافا اليه التفعيلة المعتلة علة نقص - 11 ونسبته 57,89 والمعتل - الذي هو علة زيادة ـ تفعيلة واحدة ونسبتها الى المجموع 5,26 أما مجموع حروف حوار الجندي فهو 85 حرفا منها ثلاثة حروف مد نسبتها 3,53 وتألف حديث القضاة من 61 تفعيلة ، التام منها 32 بنسبة 52,46 ، والزاحف 25 ونسبته 40,98 والمعتل - علة زيادة - 4 بنسبة 6,56 ، وجميع حروف حديث القضاة 284 منها تسعة حروف مد نسبتها 317 من هنا يتضح أن ايقاع حوار القضاة هو غير ايقاع حوار الجندي ولكن الفارق بين النمطين ليس كبيرا جدا حقا ان نسبة الزحاف في حديث الجندي تزيد عن مثيلها في حديث القضاة بفارق 16,91% وهذا هو السبب الوحيد الذي أكسب حديثه تلك السرعة الملموسة ولكن هذه السرعة لم تبلغ مدى واضحا وذلك لعدم اسهام حروف المد في مؤازرة الزحاف فنسبة هذه الحروف ظلت بين حديث بطلي المقطع متقاربة ( 3053 - 317 ) كما كان لغياب الفوارق الكبيرة في نسب التفعيلة المعتلة دوره في تضييع الاحساس بالتنوع الايقاعي الذي يمكن أن يخدم بطء الايقاع أو سرعته هنا يمكن للمرء أن يتساءل لماذا تباينت نسب الزحافات وتقاربت نسب العلل وحروف المد ؟ وأظن أن الاجابة تكمن في أن الزحاف هو أهم العوامل المتغيرة التي تقترن بالانفعال شدة أو ضعفا بروزا أو خفوتا والذي يؤدي بالتالي الى الايقاع الأسرع فان آزرته عوامل ايقاعية أخرى كتغيرات نسب شيوع حروف المد نحو القلة كان الايقاع أكثر سرعة وواضح أن الانفعالات التي تخفيها كلمات الجندي لا تتطلب ايقاعا هادئا لأنها تحمل دلالات المستريب المتوجس ، وتحمل شيئا من الخوف الشفيف وهذا كله ينأي بانفعاله عن حالة القضاة النفسية التي يمكن وصفها بأنها تحمل الثقة والثبات ولا يشوبها توجس أو خوف والثقة والثبات اذا أضفنا لهما التهكم لا تلجىء المرء الى الانفعال المباشر الذي يتطلب السرعة في الايقاع هذه الدلالات - كما يظن الباحث - هي التي خلقت هذا التباين في نسب الزحافات أما تقارب نسب حروف المد ونسب التفعيلة التامة فأظن أن هذه العوامل الايقاعية لم تكن موظفة توظيفا ايجابيا بحيث تتنامى شيوعا أو عدم شيوع مع تنامي الزحافات فلقد مر بنا وفي أكثر من مقطع أو قصيدة ان حروف المد تنخفض نسبتها كلما ازدادت نسبة الزحاف ، لأن الزحاف يعني السرعة وغياب حروف المد يسهم في ابراز المزيد من السرعة ولئلا نتعجل في اصدار الأحكام فان علينا أن نتريث قليلا لاختبار مقاطع حوارية أخرى في قصيدة الشاعر فنحن الآن أمام حوار متبادل لأول مرة في دراستنا للايقاع وقد يكون للحوار المستمر المتبادل دور في تقارب نسب حروف المد أو التفعيلة المعتلة وها نحن مرة أخرى أمام افتراضات جديدة نرجو لها كشفا تتطور المواقف الدرامية في هذه القصيدة وتنمو ، ونصل الى مشهد جديد يمكن أن يوصف بأنه يقدم لنا شدة المجابهة ، مجابهة القضاة للمتهم انهم هنا أكثر عنفا
هل سلمت المأمور المخزن خوذتك الحربية
صف رصاصك ، قمصانك ؟ جرحك
ضع جرحك فوق الأمتعة الأخرى وتسلم ايصالا
أما موقف المتهم فلم يتطور كثيرا كان فيما مضى مستريبا وهو الآن يدفع عن نفسه ، كما تسرب الى لغته شيء من الحدة ولكنها لا ترقى في درجة المجابهة والاحتدام الى موقف القضاة العنيف هذا الموقف الجديد يطرح هذه النتائج تكون حديث القضاة من 30 تفعيلة (22) التام منها 6 ونسبته %20 والزاحف 12 ونسبته 40% والمعتل علة نقص فعلن فاعل 12 بنسبة %40 أيضا وليس في حديث القضاة علة زيادة ، وحروف المد كانت نسبتها 3٫17 لأن مجموعها 4 وجميع الحروف المنطوقة126 أما حديث الجندي فقد تألف من 38 تفعيلة ، التام منها 21 ونسبته 55,26 والزاحف 15 بنسبة 3947 والمعتل علة زيادة فاعلاتن ، فاعلان 2 بنسبة 526 وجميع الحروف 178 وحروف المد 9 ونسبتها 5006 وليس في حديثه علة نقص واحدة في حديث القضاة ينبغي أن نضيف نسبة علة النقص الى الزحاف ، لأنها غدت من عوامل الايقاع السريع، أي أن نسبة هذه العوامل الزحاف وعلة النقص صارت 80٪ ، هنا يتضح لنا الفارق الهائل في النسبة بين حديث القضاة وحديث الجندي الذي حمل الينا من عوامل السرعة ما نسبته 39,47 ، وهي نسبة أقل من نصف مثيلها في حديث قضاته ، وما كان ارتفاع النسب الا لأن موقف القضاة كان أكثر صرامة وانفعالا وعنفا من موقف الجندي الذي ظل مدافعا يرد على الاتهام بلهجة لا ترقى الى عنف لهجة الذين يحاكمونه ان موقف القضاة كان يتطلب ايقاعا سريعا منسجها مع حالة الغضب ، وتأتى له ذلك عن طريق تلاحق العوامل الفاعلة المؤدية الى ابراز السرعة وسنرى أن نسبة حروف المد في حوار القضاة %03,17 هي أقل من مثيلها في حديث الجندي 5,06 ، وتلك النسبة الضيئلة كان لها دور فاعل ومؤازر للزحافات من أجل ابراز المزيد من السرعة في الايقاع هنا يتضح أ أن الحوار لا يفرض طابعا خاصا على حروف المد ، شيوعا أو غير شيوع أو تقارب ، وهذا ما يجعل الافتراض الذي مر بنا قبل قليل افتراضا غير صائب ، وسيبدو - نتيجة لتنوع نسب حروف المد ان هذه الحروف في المشهد الأول لم تكن موظفة توظيفا ايجابيا لخدمة المواقف الدرامية ما أن نصل الى المشهد الثالث وهو المشهد الذي يتحول فيه الجندي الى بطل ثائر محتدم بالغضب والعنف يشتم جلاديه ويهددهم ويكيل اليهم أقذع السباب حتى نفاجأ بحقيقة ايقاعية غريبة وهي أن ليس ثمة تفعيلة واحدة تامة في حديثه كله الذي بلغ مجموع تفعيلاته 100 تفعيلة هي اما زاحفة فعلن أو معتلة علة نقص فعلن أو هي فاعل ان تطور المواقف الدرامية في هذه القصيدة ونموها بدءا باتخاذ موقف الخوف إلى الدفاع المشوب بالخوف وانتهاء بتبني موقف المهاجم العنيف هذه المواقف تبعها تغير في الايقاع الداخلي للمقاطع تغير يميز هذا المقطع من الناحية الموسيقية عن المقطع الآخر الذي يطرح حالة أخرى أو موقفا جديدا أو تطورا في درجة الانفعال واذ نكتفي بتلك القصائد التي مرت فاننا نتوخى عدم التكرار الذي لا بد أن يرافق عملية احصائية كهذه ولأن النتائج ستكون دائما منسجمة مع ما توصلنا اليه من خلال قصائدنا التي درسناها ومع هذا فانا نود أن نحيل القارئ الى قصيدتين مهمتين أيضا تتضح فيهما ظاهرة التنوع الايقاعي بشكل جلي والقصيدتان هما من ليالي السهاد و حوار عبر الأبعاد لبلند الحيدري التي يتجلى فيها التغير الموسيقي الداخلي من خلال المواقف المتضادة التي يقدمها كورسا القصيدة كورس الرجال وكورس النساء ان ما تقدم كله انما هو افتراضات أدت الى نتائج يظن الباحث أنها على درجة كبيرة من الدقة وهو يأمل أن يتصدى باحثون آخرون لقصائد أخرى من أجل الكشف الحقيقي عن دور الايقاع الداخلي في خدمة المضمون الشعري ان دراسات كهذه ضرورية وحاجة ملحة لا غنى عنها لدراستنا في موسيقى الشعر العربي الحديث و دراسات من هذا النوع ستضع افتراضات هذا البحث ونتائجه في موقع الامتحان وستكشف عما فيها من خطأ أو صواب واذ يكتفي الباحث بدراسة جزء من عوامل الايقاع الزحافات والعلل وحروف المد فلأنه يظن أن هذه العوامل هي أبرز المؤثرات في الايقاع الشعري وتنوعه ولا شك أن هناك عوامل أخرى تؤثر تأثيرا ملحوظا أيضا في تنوع الايقاع ومن هذه العوامل الأصوات المتجانسة التي تشيع في مقطع دون الآخر ومنها القوافي الداخلية التي تتوافر في القصيدة اضافة الى القافية الخارجية وكاتب هذه الكلمات سيتحدث عن مثل هذه العوامل في مكان آخر من بحثه ولكنه يطمح الى أن يرى دراسات متخصصة وجادة شاملة تتصدى لهذه القضايا التي تشكل جزءا مهما من البناء الموسيقي للقصيدة العربية الحديثة تقارب ظاهرة التنوع في الأهمية والشيوع ظاهرة أخرى هي التدوير ولم يكن لجيل الرواد أو الجيل التالي له خبرة بهذا النمط من الكتابة الشعرية وتشير الاحصاءات التي بين يدي البحث الى أن هذه الظاهرة من انجازات الحقبة الشعرية الثالثة ومع أن بعض شعراء جيل الرواد - كالبياتي - أو الجيل الثاني - كسعدي يوسف قد قدم قصائد مدورة الا أن هذا لم يحدث قبل عام 1968 وأبرز الشعراء الذين أصلوا وكرسوا هذه الظاهرة هو حسب الشيخ جعفر الذي بلغ نتاجه فيها نصف مجموع القصائد التامة التدوير في الشعر العراقي كله وقد لا نكون بعيدين عن الصواب حين نقول أيضا ان الشيخ جعفر اضافة الى القيمة الكمية التي قدمها للقصيدة المدورة هو من أوائل الشعراء العراقيين ان لم يكن أولهم الذين التفتوا الى هذا النمط من الموسيقى الشعرية ولا شك أن للبياتي وسعدي وحميد سعيد وسامي مهدي دورهم أيضا في تكريس هذا النوع من القصائد بينما يظل الشعراء الآخرون أقل اهتماما بهذه الظاهرة، اذ نجد في نتاج بعضهم قصيدة أو قصيدتين بينما يكتفي بعض آخر بايراد مقاطع مدورة تعقبها مقاطع غير مدورة في القصيدة الواحدة وضروري أن نقول اننا في الجدول الاحصائي سجلنا القصائد التامة التدوير أما المقاطع داخل قصيدة غير تامة التدوير فقد أدرجت ضمن حسابات ظاهرة التنوع يرى بعض الدارسين ان التدوير عند حسب الشيخ جعفر يقوم على حاجة اقتضنها طبيعة القصيدة فالقصيدة عنده مونولوغ داخلي عميق (23) بينما يرى آخر ان التدوير عند الشيخ جعفر هو موقف من الزمن وتصور لحركة الكون اذ حاول به أن ينقل للشعر ايقاع الحركة الدائرية للكون وللزمن (24) عند هذا الحد ينبغي أن نشير الى أننا عندما نتحدث عن التدوير لا يخطر ببالنا نقل الدورة بمفهومها الرياضي أو الفيزيائي لأن التدوير في الشعر انما يعني الامتداد الذي لا علاقة له بالدورة ذات المعنى العلمي أعني أن تصورنا للتدوير في موسيقى القصيدة يجب أن تكون بعيدا عن الارتباط بحركة الكون الدائرية ، كما أننا لن نفهم الزمن بهذا المعنى أيضا لأن الزمن في الشعر لا يعني الاسترسال والعودة ثانية الى نقطة البداية والا لكان تصورنا قاصرا مرتبطا بالزمن الحسابي الذي تثيره في أذهاننا حركة عقارب الساعة أو طلوع النهار والليل مثلا واذا كان التدوير ينبع من ضرورات فنية أو موضوعية فان لنازك الملائكة رأيا في انتشار القصيدة المدورة وهو رأي غريب لم يقل به أحد من قبل فهي بعد أن منعت التدوير في الشعر الحر منعا باتا في كتابها قضايا الشعر المعاصر (25) عادت لترى ان ذيوع هذا النمط من القصائد يمتلك دلالات اجتماعية وسياسية فهو يشير الى أن الشاعر الحديث يحس بأنه مسلوب الارادة تحت ظل موقف تسيطر فيه الدول الكبرى التي تعترف باسرائيل وتؤمن بما تسميه حقها في البقاء ويتساءل هذا الشاعر العربي في شك حزين هل أستطيع أن أحارب الامبريالية ؟ لو أجاب الشاعر بنعم على هذا السؤال لربما تضاءل استعمال القصيدة المدورة تضاؤلا ملحوظا ان انتشار التدوير ليس الا وسيلة غير واعية يعبرون بها عن احساسهم بالذل السياسي أمام أميركا واسرائيل وعن شعورهم بالقهر والانكسار (26) وقد يكتفي المرء بالصمت حين يستمع لنازك الملائكة وهي تسمي القصيدة المدورة قصيدة ذات سطر واحد طويل كل الطول (27) ولكنه لا يستطيع الا أن يتساءل عن العلاقة الموضوعية التي تربط بين اسرائيل وأميركا وهذه الظاهرة الفنية الوليدة ان هذا القول لغرابته يذكرنا بتساؤل من يسأل أيهما أخطر شأنا الرومانتيكي أو الجاسوس اذ لا علاقة بين الرومانتيكية وعملية التجسس حقا ان الأحداث السياسية الكبري ومراحل القهر والذل السياسي قد تقود الى خلق أدب جديد ومدارس أدبية جديدة وظواهر لم تكن مألوفة وما حدث في أوربا بعد الحرب الكونية الثانية دليل على ذلك ، لكن التدوير في القصيدة العربية المعاصرة لم يكن نتيجة - لا مباشرة ولا غير مباشرة - لمثل تلك الهزات التي تدمر القيم بما فيها القيم الأدبية لأنه في رأينا ظاهرة فنية ما تزال في دور الامتحان وستبدي لنا الأيام القادمة مدى قيمة مثل هذه التجارب نهوضها أو موتها وهي ظاهرة ترتبط أساسا بمضامين الشعر وأحاسيس الشاعر ومحاولة واعية منه للتعبير عن تجاربه بشكل فني جديد وحين نتناسى ما سمعنا من أن التدوير هو نقل ايقاع الحركة الدائرية للكون والزمن الى القصيدة ، كما يرى محمد مبارك، أو علاقة التدوير بأميركا واسرائيل والقهر السياسي الذي يحسه الشاعر ونتجه الى تأمل التدوير الجزئي أو الكلي داخل القصيدة نفسها فسنكتشف أن هذه الظاهرة تنبثق عن علاقة خاصة بين المضمون الشعري وأسلوب التعبير وبين الموسيقى مر بنا في أكثر من موضع ، في الفقرة التي تقدمت فقرة الافتراضات والنتائج ان بدايات التدوير الجزئي لدى السياب والبياتي في عدد غير قليل من الأبيات كانت تصادفنا في المقاطع التي تتوافر فيها عناصر الحكاية وأسلوب السرد الممتد الذي يعني بتقديم الحدث سواء كان هذا الحدث جزءا من قصيدة قصصية أو قصيدة تحمل شيئا من فن القصة ويوضح الجدول العام للظواهر الموسيقية في الشعر العراقي الحديث ان مجموع القصائد المدورة قد بلغ خمسين قصيدة ، منها خمس وعشرون قصيدة لحسب الشيخ جعفر وحده وأربع عشرة للبياتي وست لسعدي يوسف واثنتان لحميد سعيد وواحدة لسامي مهدي وأخرى لخالد علي مصطفى وثالثة لصادق الصائغ وليس ضروريا أن نعيد ما قلناه سابقا عن مميزات شعر الشيخ جعفر أو سعدي يوسف ولكننا نستعيد مما مر بنا كله انهما من الشعراء الذين كرسوا القصة في أشعارهم تكريسا واضحا وتبنوها مجموعة اثر أخرى فاذا لم تكن القصيدة عندهما قصة فانها تحمل من ملامح فن القصة الشيء الكثير ولذا فان قصائدهما المدورة هي قصائد تنحو منحى قصصيا وكذلك القصائد المدورة التي هي للبياتي ولسامي مهدي وحميد سعيد فالتدوير اذن - كظاهرة موسيقية - ارتبط لدى أكثر من شاعر متمرس أو كبير باتجاه فني معين، وبأسلوب تعبيري معين أيضا أي أنه ظاهرة انبثقت عن ضرورات موضوعية وفنية ، وتوشك هذه العلاقة بين ظاهرة التدوير والأداء القصصي أنن تكون حقيقة لا يمكن التغافل عنها أبدا ـ في حدود الزمن والنتاج الشعري الحالي .كما ان لأسلوب السرد الذي يتصف بالتتابع والاسترسال دورا آخر يسهم في خلق أداء موسيقي له صفة التتابع المستمر وواضح أن التدوير هو الظاهرة الموسيقية التي تتصف بمثل هذه الصفات وتحمل - بتكوينها المتكرر – متطلبات التلاحق الايقاعي الذي ينسجم مع الأحداث المتلاحقة (4) وتعتبر القافية عنصرا بالغ الأهمية في قضية موسيقى الشعر ، ولقد كانت سمة مميزة للقصيدة العربية ولم تتخل عنها في أية مرحلة تاريخية ، وظلت ملازمة للبناء الشعري عبر عصور الأدب العربي ولم تلغ حركة الشعر الحر دور القافية أو تقلل من أهميتها - لإكمال الثراء الموسيقي للقصيدة كلها ولكن شعراء هذه الحركة كانوا يولون تنويع القوافي أهمية بالغة ، بينما اختفى في قصائدهم ذلك الحرص على ابراز القافية موحدة واتخاذ هذا التوحد منهجا دائما ومع هذا فان الشعراء يتفاوتون هنا ـ تبعا لأمزجتهم وضرورات فنهم الشعري - في مدى الالتزام بالقوافي أو التنويع الدائم لها وبكلمة أدق يمكن أن نقول انه اذا كانت القافية في القصيدة التقليدية نمطا واحدا فانها في الشعر الجديد غدت أنماطا ويلحظ قارئ الشعر العراقي حرص جيل الرواد عموما ، على التمسك بإيراد القافية ، فليس في نتاج جيل الرواد أو الجيل التالي لهم أيضا قصائد تخلو من القوافي ولعل هذا الحرص قد يبلغ مدى واسعا عند بعضهم بينما يجيء الاهتمام به ضعيفا عند بعض آخر ففي نتاج عبد الوهاب البياتي مثلا وفي قصائده التي سبقت عام 1970 أو ما يقرب من هذا التاريخ يجد القارئ أن اهتمامه بها يفوق اهتمام أي شاعر آخر كما أنه شديد الحفاظ على الأنماط التي يضعها لقوافيه فنحن اذ نقرأ مجموعته عشرون قصيدة من برلين سنفاجأ بأن لكل قصيدة من قصائد هذه المجموعة قافية واحدة تتكرر باستمرار بحيث نستطيع أن نقول عن القصيدة الى القتيل رقم 8 بأنها من الرجز وأنها نونية أو نقول عن قصيدة أخرى هي سلاما أثينا أنها رجزية دالية وهكذا لكل القصائد الأخرى تماما كما كان يقال قديما بائية فلان أو نونية فلان وسنقرأ من تلك المجموعة مقطعا صغيرا بين طرفا مهما امن منهج البياتي في صنع القوافي مدخنة تناطح السماء توزع الحلوى على للأطفال في المساء وتهب الضياء والثوب والكتاب والدواء من يزرعون الورد في بلادك الغناء فلنرفع الكأس على نخبك يا مدخنة السماء ففي غد يرتفع البناء (28) وليس البياتي وحده ممن يتصف بهذه الصفة في نتاجه من خلال مجموعته عشرون قصيدة انما يشاركه فيها حسين مردان وبلند الحيدري في أغاني المدينة الميتة ويستطيع القارئ أن يقول عن قصائد مردان كما كان يقول عن قصائد البياتي هذه سينية وتلك ميمة وأخرى رائية واقتربت خطوه كأنها غنوه عيونها مملوءة بالقند والقهوة وظهرها ربوه يحضنها القماش في قسوة فيصعد الهز الى الذروة كأنه رشوه لكل سن شرس النزوة يحفر في ثلوجها فجوه(29) ولعل هذا النمط من صناعة القافية كان سمة مرحلة لهؤلاء الشعراء فهو مع شيوعه الواضح ليس ملازما لنتاجهم كله ونحن اذ نقرأ أباريق مهشمة للبياتي سنجده يحافظ على القافية دون أن يلتزم بواحدة معينة متكررة بل ينوع في أشكالها
الشمس والحمر الهزيلة والذباب وحذاء جندي قديم يتداول الأيدي وفلاح يحدق في الفراغ في مطلع العام الجديد بداي تمتلئان حتما بالنقود وسأشتري هذا الحذاء وصياح ديك فر من قفص صغير ما حك جلدك مثل ظفرك والطريق الى الجحيم من جنة الفردوس أقرب والذباب(30)
وللقارئ أن يتساءل لماذا يعمد بعض الشعراء الى التمسك الشديد بالقافية وربما بالقافية الواحدة ما دامت حركة الشعر الحر قد أباحت لهم أو أرادوا هم لها أن تنوع في القوافي وأن تبتعد عن الصرامة في الحفاظ عليها والتمسك بها ؟ وللإجابة عن تساؤل كهذا فان الباحث يستطيع أن يقول ان هذا النمط من التقفية الشعرية انما يبرز في المراحل الأولى أو القريبة من سنوات نشأة حركة الشعر الحر أي أنه نتاج حقبة لم تكن بعيدة في الزمن عن الأيام التي كان فيها الشاعر الجديد كثير الممارسة لكتابة الشعر التقليدي واعتياده القافية الواحدة التي تحكم قصيدته فهي اذن نتاج غلبت عليه العادة القديمة التي لم تتعاقب عليها سنوات طويلة تؤدي بالتالي الى خفوتها واختفاء ملامحها تامة وربما كان هذا التمسك بالقافية هو رد فعل غير مدرك لتلك الهجمة الأدبية والنقدية التي كانت توجه الى شعر الشعراء الجدد وتتهمه بأنه خلو من الوزن وخلو من القافية أي أن مجيء القافية هنا انما هو محاولة دفاعية يلجأ اليها الشاعر الجديد ويتحصن بها ضد خصومة من يخاصمه ويؤكد هذا الرأي أنه كلما مرت سنوات أكثر وكلما تقدم عمر حركة الشعر الحر كلما نأى الشاعر عن القافية الواحدة وربما القافية عموما وبكل أنماطها فلو أننا قرأنا مجموعة شعرية لأي من جيل الرواد - ونستثني نازك الملائكة - تصدر هذه الأيام لأدركنا الفارق الكبير بين اهتمام الشاعر بالقافية قديما وبين اكتفائه باليسير والعابر منها
الآن وقد لا نستغرب اذ نجد أن دور القافية سيكون معدوما في حالات عديدة ونماذج لا عد لها وكمثال بسيط لهذا نود أن نشير الى مجموعتي البياتي كتاب البحر و قمر شیراز ومع هذه الاجابات فان ذاك النمط من الأداء بالقوافي يثير في موسيقى القصيدة من الرتابة والملل ما هو واضح ومستنكر وبخاصة اذا تكرر من قصيدة الى أخرى وشمل المجموعة الشعرية كلها كما حدث في حالة عشرون قصيدة من برلين وأغلب قصائد طراز خاص وربما كان التمسك والحرص على القافية سببا في وقوع الشاعر في دائرة الصنعة المتكلفة اذ يبدو بعض هذه القوافي متهدلا نابيا أو زائدا لا ضرورة له اطلاقا كان يغني كان في مدينتي يفعل ما يشاء يغوي الصبيات ويستجدي على قارعة الطريق في المساء صنعته تقبيل أيدي الناس - والغناء -وشتمهم لأنه حرباء يعرف من أين وكيف تؤكل الأكتاف والأثداء وسيرى القارئ أن قول البياتي يفعل ما يشاء و لأنه حرباء انما هو ضرورة لا غنى عنها للقصيدة وأن هذه الألفاظ نمط من الأداء لا تستقيم القصيدة بدونه وأن حذفها تخريب لموسيقى الأبيات وافساد لمعانيها لأن للقافية هنا - كما يقول أوستن وارين - معنى وانها بذلك عميقة التشابك مع السمة العامة للعمل الشعري وحين نصل الى بيت البياتي الثالث فاننا نتساءل عن الضرورة الموضوعية التي تتطلب أيراد كلمة في المساء ولماذا اختار الشاعر المساء دون غيره من أوقات النهار لا ندري ولو أننا عمدنا الى حذفها فما الذي سيحدث ؟ لا شيء وسيظل الانسياب الموسيقي سليما غير أن الذي قاد البياتي اليها هو الحرص الحرص الشديد على تلاحق القوافي وما كانت لتوجد لولا وجود ما يشاء قبلها ويأتي السطر الذي بعدها وفيه والغناء وهذه القافية تكرار غير مجد لأنها وردت في أول الأبيات التي نقلناها فما الضرورة التي تستوجب اعادتها مرة أخرى ويرد السطر الأخير من الأبيات يعرف كيف تؤكل الأكتاف والأثداء والبيت وصف موفق للرجل الحرباء المتلون وهو أيضا تضمين للمثل القديم يعرف كيف تؤكل الكتف ولكن ما هذه الأثداء التي ألصقها البياتي عنوة وجعل منها شيئا مأكولا ولفظا زائدا نابيا ان كل ما وضعناه بين أقواس انما هو مما لا ينفع ويسيء الى البناء الشعري موسيقى ومعنى وهو وليد الحرص غير المبرر على ايراد المزيد من القوافي ثمة كلمة جميلة ودقيقة قالها شوبنهور عن القافية هذه الكلمة ينبغي أن لا تغيب عن أذهان الشعراء وستجنبنا الافاضة في التفسيرات والاستطرادات في تقييم العديد من القصائد ضمن حديثنا عن القافية يقول يشترط أن تتوثق العلاقة بين الفكرة والقافية وأن ترتبطا باطنيا أما اذا بحثنا عن الأفكار من أجل القوافي فانه ينشأ عن ذلك شعر أجوف الرنين واذا بحثنا بعناء ومشقة عن القوافي من أجل الأفكار فانه ينشأ عن ذلك شعر متكلف مغتصب لا تطرب له الآذان أما اذا تتابعت الأفكار في تسلسل طبيعي مسترسل على ايقاع الكلمات وتناغم القوافي فانه يكون للغة الشعر تأثير السحر ومجيء القوافي بلا تكلف يكفل السلامة التامة والتوازن الباطني في الأفكار وهذا من شأنه أن يعطي القصيدة قدرة فائقة على التأثير في الخيال (31) وحين نتجاوز قضية الصنعة والتكلف الناتجة عن الحرص الشديد على ايراد القوافي فاننا سنرى في بعض من القصائد أن حرص الشاعر ذاك على قافيته قد يقوده الى توليد اشتقاقات لغوية جديدة وألفاظ قد تكون فصيحة سليمة ولكنها غير مألوفة ولا شائعة أو أن للشاعر عنها بديلا أكثر سلاسة وجمالا وألفة ولكنه يرفضه لأنه لا يصلح أن يكون قافية يا حبي المغامر ستعيش في قلبي وفي شعري الى أبد الأداهر
ستعيش جبارا مغامر(32) زماننا كان بلا شعر وكان الأحدب الأمير والأوثان والصحف الصفراء والأقزام والذوبان تعوي وتعوي كنت ياصغيرتي سأمان أمضغ قلبي ألعن الزمان لأنه مطية الأذناب والعبدان(33) ولم يقل البياتي الدهور لأنها تقابل في الوقع صيغة مغامر ولم يقل الذئاب لأنها موسيقيا لا تعادل الأوثان ولجأ الى العبدان ونأى عن البعيد وترك سئم ورضى بسأمان للسبب نفسه أي أن هذه الألفاظ لا تصلح أن تكون قوافي متلاحقة وواضح أن الشاعر لو لجأ الى هذه البدائل لما تغير الوزن وظل سليما ويقول حسين مردان في قصيدته نبوءة عن الشمر وكأي شحاذ لحوس أنا أسمع الأنغام في صمت الكؤوس فلن أثرثر كالمجوس فأقول في عينيك سوس والناس تعرف أنني رجل شموس لكنني أخشى الجلوس في غرفة صلعاء حارسها جسوس (34) لقد اضطر حسين مردان الى هذا النمط من القوافي الثقيلة المتكلفة لأنه كان يرى أن الحافظ على القافية الواحدة ضرورة والا فما معنى رجل شموس و سوس و جسوس وكم من القراء يعلم أن جسوس تعني في اللغة الرجل القميء المشوه كما يشرح في اشاراته الملحقة في آخر المجموعة
ولم يعرف عن نازك الملائكة تمسكها الشديد بالقافية الواحدة وللشاعرة رأي في القافية فهي تقول في مقدمة مجموعتها شظايا ورماد وليس هذا مكان الحديث عن الخسائر الفادحة التي أنزلتها القافية الموحدة بالشعر العربي طيلة العصور الماضية وانما المهم أن نلاحظ أن هذه القافية تضفي على القصيدة لونا رتيبا يكله السامع فضلا عما يثير في نفسه من شعور بتكلف الشاعر وتصيده للقافية (35). ولذا فهي تلجأ الى تعاقب القوافي وتشكيلها المتجدد ، فقد تكون على هذا النسق أب أب أ أ ب أ أ ب د د (36) أو أب أ ، ب ج ب ، ج دج، دهد، هـ و هـ وهـ ويبدو السياب أكثر شعراء جيله اهتماما بتنويع قوافيه وله في ايرادها أنماط عدة نحاول أن نشير اليها باختصار ، ومنها هذا النسق أ أ ، ب ب ، ج جـد أو ج ج ب (37) أو أ أ ، ب ، ج ، ب ، د هـ، و، ززز، أأ،ب هـ ، هـ هـ ، كما يمثله المقطع الأول من قصيدته مرحى غيلان (38) أو أ أ ، ب ب ب ، أ ، ج ، د ، ج ، د ، جـ وهذا النمط . من الأداء الموسيقي بالقوافي هو السمة الغالبة لمعظم أشعاره في مجموعته أنشودة المطر وفي مجموعته المعبد الغريق يكون النمط أ ، ب ب ، أ هو الغالب عبرت أوربا الى أسيه وما انطوى النهار كأنما الجبال والبحار ربى وأطراف من الساقية (39) أو أ ب ، أ ب أ أو أ أ أ ب أ (40) وهذه هي أكثر التشكيلات
شيوعا في شعر بدر شاكر السياب ولا يتشعب كثيرا ولا يبتعد شعر الحقبة الأولى وجزء كبير من شعر الحقبة الثانية عن مثل هذه التشكيلات في القوافي الشعرية ومع أن الكثير من هذه القوافي على اختلاف تشكيلاتها لا توحي : بالتكلف ولا تبدو وكأنها أتت ارغاما وبالجد والجهد الا أن أثر الصناعة فيها واضح والرغبة في الحرص عليها وعلى تأنيقها واختيارها بدقة يلفت انتباه القارئ بينما نلاحظ في قصائد أخرى أن القافية تجيء منسابة وعفوية ، وكأنها انبثقت من الجملة نفسها أو أن التعبير الشعري خلق مثل هذه القوافي خلقا طبيعيا جميلا أسائل كل ما طفل أأبصرت ابنتي أرأيتها ؟ أسمعت ممشاها وحين أسير في الزحمة أصغر كل وجه في خيالي كان جفناها كغمغمة الشروق على الحداول تشرب الظلمة وكان جبينها وأراك في أبد من الناس موزعة فأه لو أراك وأنت ملتمة (41) وللقارئ أن يتأمل هذه العفوية الساحرة التي صنعت ملتمة وأقفلت المقطع الشهري بضربة موسيقية محكمة الوقع ان هذه اللفظة مع أنها عودة الى ايقاع اللفظتين الرحمة والظلمة الا أنها منبثقة من التكوين اللغوي والتصوري والنفسي للشاعر فهي طموح نفسي للتكامل بالحصول على الشيء کكيان موجود وليس في الذاكرة وهي نقيض لغوي للفظة موزعة التي توحي بالضياع والقسوة واتمام للهاجس الذي يصنع الصورة العشرية ويقول البياتي خبات وجهي بيدي رأيت عائشة تطوف حول الحجر الأسود في أكفانها ناديتها هوت على الأرض رمادا وأنا هويت فنثرتنا الريح
وكتبت أسماءنا جنبا الى جنب على لافتة الضريح (42) ولعل قارئ هذه الأبيات سيدرك جمال تعاقب الفعلين هويت ورأيت وشدة التصاقها بكل الكلمات والمعاني التي سبقتها ، أي أن هذين الفعلين صارا ضرورة وتكوينا لا ينفصل عن مجمل معنى وتركيب الأبيات ولا تبدو لفظة الضريح موجودة لوجود اللفظة السابقة الريح وانما هي مما ينبثق عن الصورة كاملة وتنبع من المشهد كله ، وتضيف اليه - بما تحمل من معنى - اتماما لابراز المشهد القدسي لأن الصورة كلها انما هي تمثيل المرأى عائشة وهي تطوف حول الحجر الاسود بلباسها الأبيض وقد لا يكون ضارا أن نستطرد هنا فنلفت انتباه القارئ الى براعة الشاعر وهو يأتي بالمتضاد من الألوان الحجر الأسود والأكفان التي هي بيضاء عادة هذا التضاد الذي أحال الصورة الى لوحة ملونة وشديدة الحركة واذا كان جيل الرواد والجيل التابع لهم شديد الحرص على ايراد القافية وملاحقتها ووضع أنماط تشكيلية لها فان الجيل الجديد من الشعراء ونعني بهم شعراء الحقبة الثالثة والنتاج الشعري الصادر فيها لم يعد يلتفت كثيرا الى القافية ، ولم تعد هي هما من همومه الجمالية لقد صارت القصيدة بالنسبة للشعراء العراقيين الآن - كما يتضح من آخر نتاجاتهم الشعرية - تنمو بحرية أكبر وتستطيل تبعا لمتطلبات الجملة الشعرية التي غالبا ما تجيء مفتوحة النهاية أي سائبة لا يحدها قيد ولا قافية يرى الشاعر أنها ضرورية واذا استثنينا بعض الشعراء ممن يحرص أحيانا على ايراد بعض القوافي كبلند الحيدري وسامي مهدي وفوزي كريم وخالد علي مصطفى ، فان ما يرد من القوافي في عدد غير قليل من المجموعات انما يتأتى عن طريق الصدفة أو بشكل عفوي أو لضرورة يحتمها موقع ما من القصيدة وليس القصيدة كلها وبتعبير آخر لم تعد القافية منهجا ولعل الذي أسهم في غياب القوافي وعدم اهتمام الشعراء بها هو أنهم صاروا يرون أن الشعر قد لا يكون هو الوزن والقافية ، بمعنى أن الوزن والقافية ليستا ضرورتين ملازمتين لخلق القصيدة ، فاكتسب الشعراء بهذا المفهوم حرية أكبر مما
كان يباح لجيل الرواد منهم ولذا رأينا من خلال الجداول الاحصائية التي تحدثنا عنها شيوع ظواهر جديدة لم تكن معروفة قبل سنوات الحقبة الثالثة ومنها اختلاط الشعر بالنثر وظهور قصائد نثرية أما السبب الآخر فهو شيوع القصيدة المدورة أو المقاطع المدورة في القصائد فان لم يكن التدوير تاما أو على شكل مقاطع فان الجملة الشعرية بدأت تستطيل ويرتبط السطر منها بما يعقبه من سطور وبهذا يزداد عدد التفعيلات ويتجاوز ماكان مألوفا في عطاء جيل الرواد وكل هذا التدوير التام والجزئي والاستطالة في الجملة الشعرية جدير بأن يلغي القافية أو يعطلها أو يقلل من اهتمام الشعراء بها ونضيف الى هذين السببين سببا ثالثا هو اهتمام الشعراء بكتابة القصائد الطويلة ذات الاشخاص والأفكار المتضادة وافادتها من عناصر الفن الدرامي كوجود الحدث أو الحكاية وتوظيف عناصر السرد والحوار وكل هذه الامور تصرف الشاعر الى العناية بها والحرص عليها مما يؤثر بالتالي في تقليل الاهتمام بالعناصر الشكلية ومنها القوافي ومن يتأمل قصائد شفيق الكمالي ويوسف الصائغ وفاضل العزاوي وياسين طه حافظ وعبد الرزاق عبد الواحد وصلاح نيازي وغيرهم من الشعراء الذي يكتبون القصيدة الطويلة سيرى أن اهتمامهم بانتقاء القوافي وتجويدها والحرص عليها يوشك أن يكون معدوما أو عابرا يسيرا غير أن هذا الغياب الخارجي للقافية قاد الشاعر الى ابتكار محاور موسيقية داخلية تسهم الى حد بعيد في اغناء موسيقى القصيدة ولجأ بفعله هذا الى طريقتين الأولى هي خلق نمط من القوافي الداخلية التي تتوزع عفويا داخل الأبيات الشعرية فتضفي على القصيدة جوا موسيقيا داخليا وهذا الجو الموسيقي غالبا ما يكون خافتا هادئا أي ليس مجهورا وواضحا كما يحدث في ورد القوافي بالطريقة التقليدية يقول علي الحلي من أغراس الشمس المزروعة في رحم الصحراء الوحشية وتركت الليل المحفور المقرور على رمل الجرف(43) وكلمتا المحفور والمقرور متساويتان ايقاعيا ويصح أن تجيء احداهما قافية خارجية للأخرى ولكن الشاعر لم يلجأ الى ذلك بل جعل اللفظتين تتساوقان الواحدة تلو الأخرى فخلق بذلك نمطا من الايقاع الداخلي ويقول سعدي يوسف في قصيدته اشارة أيها المقبلون على أرض دارين أن لنا أخوة حينما يخطئونموت وحين نراهم يصيبون نشتم ياوطني صفقة نتبادل فيك المواقع كن مرة حكما لاتكن حاكما ها هم المقبلون على أرض دارين بين الحقائب والقبعات يديرون أعناقهم(44) وليس في هذا المقطع قوافي خارجية ولكنه غني بموسيقاه الداخلية التي تتكرر فيها هذه الألفاظ والصيغ بشكل أخاذ مقبلون يخطئون يصيبون مقبلون يديرون وتوزع هذه الصيغ الموسيقية وتجاوبها مع بعضها بشكل غير مباشر هو السبب الأكيد الذي يجعل القارئ يحس بهذا الدفق الموسيقي الأليف والخافت (45) أما الطريقة الثانية التي يحاول الشاعر فيها أن يغني موسيقى الداخل فهي لجوؤه الى تكوين تجمعات صوتيه متماثلة التجمعات انما هي تكرار لبعض الأحرف التي تتوزع في كلمات حروف تجانس أحرفا أخرى في كلمات وفق نسق خاص اهتماما بخلق هذه التجمعات الصوتية شاعران هما بدر شاكر الحيدري وهذا لا يعني أن الشعراء الآخرين يخلو نتاجهم من الموسيقية الصوتية ولكن وضوح هذه الظواهر في شعر السياب الغالب والمتكرر يقول بدر شاكر السياب يخوض بين ضفتيك يزرع الظلال ويملأ السلال بالماء والأسماك والزهر أودلو أخوض فيك أتبع القمر وأسمع الحصى يصل منك في القرار صليل آلاف العصافير على الشجر أغابة من الدموع أنت أم نهر؟ والسمك الساهر هل ينام في السحر وهذه النجوم هل تظل في انتظار (46) ولا بد أن يلتفت القارئ الى أن السياب كرر في البيت الأول الظاء ثلاث مرات وعاد اليه في البيت الرابع ثم تخلى عنه ولجأ ثانية التاسع من خلال لفظتي تظل انتظار وما بين الأول والبيت السين والأحرف التي تشبهه صوتيا كالصاد والزاي نموا عجيبا الاحرف اثنتي عشرة مرة وخلقت محورا موسيقيا صوتيا واضح التردد الاسهام في تطوير الموسيقية الداخلية وجعل القارئ يحس به مثيرة تنقل اليه الاحساس التام بالطبيعة وأصواتها كما أراد الشاعران يصورهم ولعل أدراكنا لطريقة السياب في خلق الصوتيات المتماثلة أو المتجانسة داخل لأبيات أضافة الى اهتمامه بالقوافي الخارجية المتعاقبة يفسر لنا سر غنى شعر السياب موسيقيا وتفرده عن الكثير من زملائه بهذا المجال ونقرأ لبلند الحيدري من مجموعته رحلة الحروف الصفر لن نسمح أن نذبح أن تربح من جلدي نعلا كلا واصنع من حقدك لي نصلا يتململ في نهدي حبلى سما لن يصبح موتي قمحا بل ملحا سيئز جراحك جرحا جرحا (47) ان بعض هذه الالفاظ قد تكون على شكل قوافي خارجية ولكن يجب أن نتأمل تكرار حرف الحاء في الألفاظ الداخلية ومدى اسهامه في خلق محور صوتي يثير فينا الاحساس بالذبح والحشرية والاختناق صليت يا أختاه صليت حتى صارت الذنوب في مجاهلي صلاة وصمت حتى جفت الشفاه وقلت في الشفاه في الخشب المعد للشتاء لي اله وانني سحابة جادت بها يداه وانني حلم الرمال السمر بالمياه وانني من يبس أفجر الحياة وكانت الحياة تسمر الصليب في الحياة وتصلب المسيح كل ساعة (48)ويعكس هذا المقطع اهتمام بلند الحيدري بخلق محاور صوتية هي غنى أكيد لموسيقى شعره الداخلية فلقد تكررت بعض الأحرف المتماثلة أو المتاجنسة بشكل واضح وصرنا نحس بورود السين والصاد والحاء والراء والشين أكثر من بقية الحروف الاخرى ولعل غنى موسيقى بلند الحيدري انما هو غنى داخلي في الغالب وطريقته في تكوين تجمعات صوتية هي ميزة شعره التي لا يضاهيه فيها الا السياب أما الشعراء الذين يهتمون بالتدوير فسيكون للقوافي الداخلية والتجمعات الصوتية نصيب واضح في أشعارهم بل ان هذه الاهتمامات ستكون البديل الأساسي لالغاء القافية الخارجية والتعويض عنها ما شاءت للشاعر قدراته أن يعوض وقبائل توقد نيرانا وكهوفا يكشف عنها البرق أرى الالق المتراكض فوق البحر وتخبو الشمس على الصلبان تولول في الساحات الريح وتغرق في النوم الثلجى تخوم الغابات وتصحو (49) في هذا المقطع يلمس القارئ حرص الشاعر على الافادة بشكل جلي من الألفاظ التي يتكرر فيها حرف القاف قبائل توقد برق الق تغرق والتأكيد على تكرار حروف القاف والحاء مما يجعل موسيقى القصيدة داخلية خافتة تنبع من أصوات متكررة هنا لابد أن نشير الى أن الشاعر لا يلجأ الى مثل هذا الابداع الموسيقي بتعمد وتصميم مسبق وانما هو مما ينبثق من الفعل الشعري ذاته وان شئنا الدقة فاننا نقول ان خلق هذه الانماط الموسيقية الداخلية ليس الا تعويضا في لاوعي الشاعر عن الموسيقى الخارجية التي تشكلها وتسهم في اغنائها تلك القافية المفتقدة التي ضيعها النسيج الجديد للقصيدة الجديدة.
_____________________
(1) في مجموعتيهما ثم مات الليل 1963 سفر الفقر والثورة ، 1965
2- أنشودة المطر 116
3- أنشودة المطر 121
4- ديوان البياتي 2/184المقطع الأول
5- ديوان البياتي 188 المقطع الثالث
6- نفسه 19 المقطع الرابع
7- نفسه 193 المقطع الخامس
(8) ديوان البياتي 186 المقطع الثاني
(9) الطائر الخشبي 80 - 81
(10) الأخضر بن يوسف ومشاغله 62 والعبارة لا علاقة لها بالقصيدة من ناحية المعنى
(11) منهاج البلغاء 266
12) مفهوم الشعر د جابر عصفور 403
13)الصناعتين 139 نقلا عن مفهوم الشعر
14) أسس النقد الأدبي الحديث 12
(15) التفسير النفسي للأدب عز الدين اسماعيل 59 وينظر أيضا الشعر
العربي المعاصر 54 والرمز والرمزية في الشعر المعاصر لمحمد فتوح أحمد 396
(16) موسيقى الشعر العربي د شكري عياد دار المعرفة القاهرة الطبعة الثانية 1978 ص27، 28
(17) ينظر الملحق رقم (2)
(18) أنشودة المطر 223 والملحن رقم (4)
(19) ولمزيد من الايضاح وتأكيد صحة النتائج نحيل القارىء الى الملحق رقم (5) الخاص بقصيدة سعدي يوسف القصصية الأخضر بن يوسف وذلك لتلمس الفرق في النتائج الحسابية التي تقترن بجزأين من القصيدة الأول هو وصف البطل من الخارج المتميز بالايقاع البطىء والثاني تقديم الحدث أو الفعل القصصي الذي اتصف بالسرعة الملحوظة في الايقاع
(20) عبر الحائط في المرآة 17 - 18 وينظر الملحق رقم (6)
(21) ينظر الملحق رقم (7)
(22) ينظر الملحق رقم (7)
(23) التدوير في القصيدة الحديثة طراد الكبيسي مجلة الأقلام العدد الخامس سنة 1978
(24) دراسات نقدية محمد مبارك 188
(25) قضايا الشعر المعاصر 93
(26) مقال القصيدة المدورة في الشعر العربي الحديث ، نازك الملائكة ، مجلة الأقلام العدد 7 لسنة 1978 ص 110
(27) نفسه ص 107
28- ديوان البياتي 1/461
29- طراز خاص 31 وتنظر أغاني المدينة الميتة 39، 33، 32
(30) ديوان البياتي1/191
(31) في الشعر الأوربي المعاصر د عبد الرحمن بدوي ، 138
32- ديوان البياتي 1/508
33- نفسه 1/571-572
34- طراز خاص 25 وتنظر 37، 57
(35) دیوان نازك الملائكة 1/16
(36) أنشودة المطر 19
(37) نفسه
(38) المعبد الغريق 71
(39) نفسه
(40) منزل الأقنان 53
(41) المعبد الغريق 63
(42) ديوان البياتي 3/94وتنظر المجموعات الشعرية الآتية بعيدا عن السماء الأولى 31 ، أسفار الملك العاشق 249 250 ، الطائر الخشبي 77 ، حيث تبدأ الأشياء 46 لغة الأبراج الطينية 51 سيدة التفاحات الأربع
43- شعلة البعث 54
44- الأخضر بن يوسف 59
45- وينظر انشودة المطر 168 رحلة الحروف الصفر 44
الطائر الخشبي 77
أسفار الملك العاشق 75
جبال الثلاثاء 75، 76
نشيد الكركدن 90، 110
46- أنشودة المطر 142 وينظر أيضا 11 13 33 65 68
47- رحلة الحروف الصفر 12، 13
48- نفسه 17، 18 وينظر 31، 40 ، 43، 49، 50
49- عبر الحائط في المرلاة 40 وينظر 28، 32، 46، 47 والمجموعات الاتية ديوان البياتي 3/ 372، 377، 379، 378، 451، 468وتنهدات الامير العربي 93 ، 79، 68، 69، والشجرة الشرقية 29 ، 33 ، 40 وديوان الاغاني الغجرية 16، 17، 54، 55
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
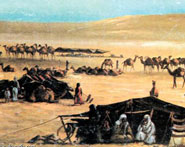 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|