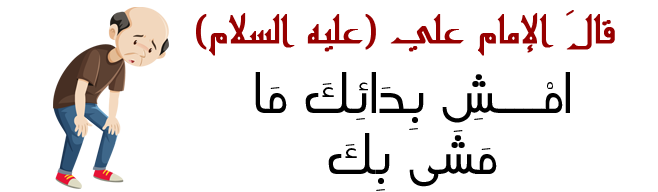
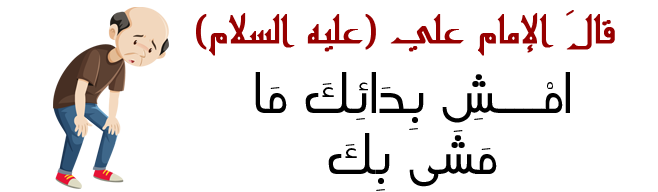
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-09-2015
التاريخ: 30-09-2015
التاريخ: 14-08-2015
التاريخ: 25-03-2015
|
العقاد: يرى أن الصورة الأدبية عند الشاعر تتجلى في "قدرته البالغة على نقل الأشكال الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخيال، أو هي قدرته على التصوير المطبوع؛ لأن هذا في الحقيقة هو من التصوير كما يتاح لأنبغ نوابغ المصورين"(1).
وعلى ذلك فالمنظر المراد تصويره له حالات: الحالة الأولى المنظر كما هو في الواقع لا تختلف ذاته أمام الأنظار، والحالة الثانية: انتقال المنظر إلى داخل النفس وامتزاجه بخواطر الشاعر وعواطفه، وأحاسيسه وصراعه مع المستودعات الذهنية والمخزونات الشعورية وهي مرحلة الاستحالة والحالة الثانية: وهي إخراج المنظر من معامل النفس في صورة جديدة، وهي ما تسمى بالصورة الأدبية، وهذا ما أراه في اتجاه العقاد لمفهوم الصورة، ويؤكد ما ذهبت إليه ما ذكره في موطن آخر حيث شبه ملكة الشاعر بالزجاجة المصورة الحساسة الواسعة، فلا يفلت مما يقابلها شيء إلا رسمته وصورته، وكذلك ملكة الشاعر الفذة الحساسة، تنقل إلينا صورة العالم كله من خلال مشاعره، التي تبرز في عمله الفني، وهذا بعكس الشاعر الذي يضيق إحساسه، فيصور قطعة من العالم، ويودعها صورته الفنية، والصورة الأولى تفوق الثانية في التظليل والتلوين"(2). وأروع أنواع التصوير، هو ما اجتمعت فيه الدعائم الآتية التي توضح مفهوم الصورة عنده:-
أ- الخيال في الصورة:
وحين أتناول الخيال عند أي ناقد، لن أذكره بالتفصيل والعمق الذي تقتضيه طبيعته، فليس هذا بحثًا مستقلًا فيه، ولكني أتناوله هنا في مجال المفهوم الصورة الشعرية، ومنزلة الخيال منها ودرجته فيها، وحقيقته ومعناه.
والعقاد من رواد الفكر في العصر الحديث، يثور -في خيال الصورة- على حماقة الوصف المحسوس، الذي هو أشبه بالطبل والطنين، ولا يخرج جمال الخيال فيه عن رسم الحركة الظاهرة التي لا صلة لها بالشعور، ولا يعرف غيرهما الأقدمون، وأدوها أجمل أداء كما في قول ابن حمديس الشاعر العربي:
أسد تخال سكونها متحركًا ... في النفس لو وجدت هناك منيرًا(3)
ويسمي العقاد الوصف المحسوس الذي لا يعدو الظاهر بالبهرج، وهو نقيض النشوة الروحية الممتزجة بالمحسوسات، وسمات الخيال العقيم البهرج. ومخاطبة الوظائف ودلائل الخيال الجميل هي الطلاقة ومخاطبة الملكات الروحية، والفرق بينهما هو الفرق بين قول أحد الشعراء البديعيين:
إذا ملك لم يكن ذا هبه ... فدعه فدولته ذاهبه
وقول أحد الشعراء المصورين مثل قول ابن الرومي:
أخاف على نفسي وأرجو مفازها ... وأستار غيب الله دون العواقب
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ... ومن أين والغايات قبل المذاهب(4)
فالألفاظ في البيت تحجب المعنى فهي "وهج في النظر، وقرقعة في الأذن، ولذع في الحس وتهييج في الشعور"، فقائلها مزور مبهرج لا حظ له من البلاغة.
والجمال، والألفاظ عند ابن الرومي، تجوز بالناظر إلى معناه من غير توقف ولا انتباه فهي تريك المعنى، ولا تريك نفسها فالتصوير هنا لا يستوقف الحسن، ولا يعطل التفكير والخيال، ولكنه يطلق النفس في هوادة ورفق، ويسلس في الطبع شعور السماحة والاسترسال(5).
لأن التصوير عنده ومقياس الإحساس فيه، إنما هو من عمل النفس المركبة، من خيال وتصور وشعور، وليس كالساعة الجامدة المركبة من حديد ونحاس(6)، فالشعر عند العقاد يعني بوصف الحركات النفسية، لا بوصف المشاهد المحسوسة، والشاعر حين يصف جمال المرأة، إنما يصف أثرها في النفس، ولا يشغل شعره بتصوير المحسوسات إلا إذا فاضت عن عواطفه ومشاعره(7). فملكة النثر غير ملكة الشعر، غير ملكة الوصف، وليست بشيء واحد، كما يفهم كثير من القراء فمن وصف وشبه، ولم يشعر. فليس بشاعر. ومن شعر وأبلغك ما في نفسه بغير وصف مشبه فلا حاجة به إذن إلى سرد الصفات لتتم له ملكة الشاعرية(8).
ويؤكد العقاد كلامه بأن الصناعة اللفظية والتصنع في الوصف أمات الشعور في الصورة وأضعف الخيال وجهل الشعر، ونقده كنه الصورة الشعرية، التي تنبني عليها حياة الشعر، وجماله ونضارته، ولا قيمة عنده في الصورة للمعاني اللطيفة فيها، والنظم الرائق ولا التوليد البكر، ما لم يكن ممزوجًا بالنفس مفعمًا بالإحساس، تنبض بالمشاعر القوية، وتفور بالعواطف الجياشة؛ لأن الشعراء البديعيين رأوا أن التصوير الشعري، لا يتم إلا بالألاعيب اللفظية والمعنوية، فالشاعر منهم هو الذي يصف النجوم ويشبهها بالجواهر والحلي. هو الشاعر غير مدافع وهو المثل الأعلى في هذه الصناعة، ثم يليه الشعراء، على حسب الأشعار في سوق المشبهات، وقصارى ما يطلبه الشاعر من التشبيه أن يثبت أنه رأى شيئين من لون واحد، وشكل واحد، كأنك في حاجة إلى مثل هذا. لإثبات الذي لا طائل تحته، فأما أنه أحس وتخيل، وصور إحساسه، وتخيله باللفظ المبين والخواطر الذهنية الواضحة، فليس ذلك من شأنه ولا هو مما يدخل عنده في باب البلاغة والشاعرية، ولذلك عاب العقاد مثل قول ابن المعتز في وصف الهلال:
انظر إليه كزورق من فضة ... قد أثقلته حمولة من عنبر
وقوله:
كأن آذريونها ... والشمس فيها كاليه
مداهن من ذهب ... فيها بقايا غاليه
ويرى العقاد أن لابن المعتز تشبيهات كثيرة أبلغ من هذه وأنقى في المعنى والديباجة، ولكنهم لا يختارون في مقام التحدي إلا هذه الأبيات وأمثالها، لظنهم أن نفاسة التشبيه، إنما بنفاسة المشبهات، ولا فضل فيه للشعور والتخيل، وهذا خطأ بعيد في فهم الوصف والشعر، فالمسافة عظيمة بين شاعر يصف لك ما رآه كما قد تراه المرآة، أو المصورة الشمسية، وشاعر يصف لك ما رآه وتخيله وشعر به، وأجاله في روعه وجعله جزءًا من حياته، وإنما يعنيك من الشعر أن يكون إنسانًا حيًّا يشعر بالدنيا، ويزيد حظك من الشعور بها(9).
ويتصدى لهذا الزعم ناقد حيث دفع الخطأ الذي وجهه العقاد إلى النقاد القدامى، وبين وجه الصواب في نظرة النقاد للصورتين السابقتين، وهي أن الشاعر ينقل في صوره الأدبية ما يمتزج بحسه ووجدانه وما يتصل بشعوره وخواطره حتى يتحقق الصدق الفني في التصوير، وهو أساس البراعة فيه، فابن المعتز يصور في صدق ما رآه، وما شعر به ولو فعل غير ذلك لما كان صادقًا في قوله دقيقًا في تصويره، وهذا هو توضيح ما أشار إليه النقاد القدامى، ولذلك تعجب ابن الرومي المصور من صور ابن المعتز، وحاد عنها في التصوير إلى صور أخرى، تمتزج بحسه وشعوره وخواطره، ويكمل الناقد حديثه في ذلك فيقول:
"ونحن مع العقاد في أن لابن المعتز تشبيهات كثيرة أبلغ مما ذكر في الرواية، ولكننا نخالفه في أن يكون النقاد قد أخطأوا مثل هذا الخطأ، أو خالوا ذلك الظن البعيد، إنما أرادوا أن ابن المعتز تفرد بهذا اللون خاصة من التشبيه، وهو ما استخدم فيه آلات حياته وترفه في تلوين أصباغ تشبيهاته ووصفه، على أن هذا اللون لا يخلو كله من تصوير لعاطفة الشاعر ووجدانه وإحساسه بالحياة، أما ما سوى ذلك اللون الذي انفرد به ابن المعتز، فقد يشاركه بعض الشعراء الموهوبين فيه فلا داعي للتحدي به(10)".
وليس الخيال وحده هو أهم ركيزة في الصورة الأدبية؛ لأن العقاد يقرر أن هناك ملكة ضرورية في الصورة تشمل الخيال وغيره من الوهم، واتساق المعنى واللفظ، وتداعي الخواطر، ويسميها، "ملكة تداعي الفكر" بها ينظم الخاطر بتصحيف يسير في اللفظ أو المعنى، وبمناسبة دقيقة من الخيال الصحيح أو الوهم الكاذب، فيصل بها الشاعر بين طرفين متناقضين عند عامة الناس، وتلتمس لها المشابه والمغازي، حيث لا شبه ولا مغزى لمن لم يوهبوا هذه السرعة في توارد الخواطر وتساوق المعنى والألفاظ(11).
ولا يخفى على الناظر مما سبق أن العقاد متأثر تمامًا بنظرية النظم عند الإمام عبد القاهر، وإن أخفى ذلك تحت المصطلح البراق الذي يدل على عبقريته وهو "ملكة تداعي الفكر" وما هي إلا القدرة على التآخي بين معاني النحو، وارتباط ثان منها بأول وهكذا، ولكن العقاد فر من التعبير "بالنحو" خشية أن يصيب الجمود فيه انطلاق الأدب وحيوية التصوير الشعري كما يدعي الجمود في نظرية النظم عند الإمام بعض المحدثين، وهل هناك جمود في التأخير والتقديم والتنكير والتعريف، وإفادة أن الاسم هنا فاعل أو هناك مفعول، ليتضح المعنى، إلى غير ذلك مما قرره الإمام، إلى أن نظروا إلى ذات الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم، وهذا ما لا يقصده عبد القاهر، ولكن الناقدين يختلفان من جهة أخرى وذلك في درجة الخيال من الصورة ومنزلته فيها، فيرى العقاد أن الخيال أقوى وسيلة من وسائل التصوير، وأعظمها حيوية فهو يفضل النظم والمزاوجة والإيقاع وبعض الحقائق، إذ يرى أن الخيال مناسبة دقيقة في تساوق بين المعنى واللفظ، يجمع بين المتناقضات، وتنضم الخاطرة إلى الخاطرة، بينما أقوى الصورة، بل أساسها عند الإمام عبد القاهر هي النظم أولًا ثم الخيال وغيره ويأتي تبعًا بعد ذلك.
وحين يربط الخيال بين الخواطر المتباعدة عند العقاد يكون ذلك في قول ابن الرومي:
قصرت أخادعه وطال قذاله ... فكأنه متربص أن يصفعا
وكأنما صفعت قفاه مرة ... وأحسن ثانية لها فتجمعا
لقد أعطى لها الشاعر النصيب الأوفر للعين والضحك والخيال، فصورة الرجل وهو يتهيأ لأن يصفع، ثم يتجمع ليتقي الصنعة الثانية هي صورة الأحدب بنصها وفصها، لا يعوزها الإتقان الحسي، ولا الحركة المهينة، ولا الهيئة الزرية، ولا التأمل الطويل في ضم أجزاء الصورة بعضها إلى بعض، حتى يتفق التشبيه هذا الاتفاق(12)".
وحين يربط الوهم الكاذب بين الخواطر كما في قول ابن الرومي يهجو أبا طالب الكاتب:-
أزيرق مشئوم أحيمر قاشر ... لأصحابه نحس على القوم ثاقب
وهل يتمارى الناس في شؤم كاتب ... لعينيه لون السيف والسيف قاضب
ويدعى أبوه طالبًا وكفاكم ... به طيرة إن المنية طالب(13)
ونستطيع أن نراقب ذهنه، وهو يعمل في حركته السريعة بين الأشكال والألوان والألفاظ والمعاني. كما تراقب البنية الحية، وهي تعمل من وراء المجاهر والكواشف، فانظر إلى لون الأحيمر القاشر، وإلى نذير السوء والبلاء. وأين هما؟ وماذا يجمع بينهما من الصلة والمناسبة؟ لا صلة ولا مناسبة، وقل مثل ذلك في لون العين ولون السيف القاضب. وفي الطالب الذي لا يقابله إلا الهارب، وفي الطالب الذي يفقد الشبه بين الموت، وذلك الكاتب، وفرق هذا كله فإذا هو أبعد المتفرقات. واجمعه كما جمعه ابن الرومي، فإذا هو أقرب المناسبات وألزم العلاقات(14) ".
ب- التشخيص في الصورة:
يرى العقاد أن التشخيص أقوى ألوان الخيال في الصورة، فهو يزيده حيوية وخلودًا، وملكة التشخيص لا تقل عن ملكة التصوير جلالًا وروعة في آيات الفن الرفيع. فهي الملكة المصورة التي تستمد قدرتها من سعة الشعور حينًا، أو من دقة الشعر حينًا آخر، فالشعور الراسخ هو الذي يستوعب كل ما في الأرضين والسماوات من الأجسام والمعاني، فإذا هي حية كلها ... وليست هي صلة لفظية تلجئنا إليها لوازم التعبير، ويوحيها إلينا تداعي الفكر وتسلسل الخواطر، ويمثل لذلك بأمثلة كثيرة منها هذا البيت لابن الرومي:-
أمت وديك عبطة فمه ... دعه على رسله يمت هرما
فالود كائن حي يعالجه القتل، أو يترك إلى الهرم فيموت(15).
والتشخيص هو أرقى أنواع الخيال، وصورته إنسانية من أقوى أنواع الصور فهو يجسد المعنى ويبعث الحياة في الصلب الجامد، ويوجد الرموز للمحسوسات، ويجسم الأفكار، التي تتخايل من وراء الصور، وتقوم الحيوية فيه مقام البرهان العقلي وهو الدليل الوجداني الناطق الذي لا يعرفه إلا الشعور، وغيرها من خصائص التشخيص الذي يقول فيه العقاد هو: "خلق الأشكال للمعاني المجردة أو خلق الرموز لبعض الأشكال المحسوسة"(16).
والتشخيص يعتمد على دعائم أساسية في حيويته، وفي اللون والشكل والحركة، مما يزيد الصورة الأدبية روعة وسحرًا.
ج- نفي المبالغة -لا البلاغة- من الصورة:
والمبالغة عند العقاد تفقد الصورة الشعرية. لما فيها من الزيف. وإرادة المستحيل. والبعد عن الحقيقة الشعرية، وهي الصدق الفني فيه، فهي تكشف على الكذب في النفس، لا عن الوضوح والتقرير، وما كانت في صورة إلا أخذت بجمالها، وتعطلت عنه، ولكنه تدارك الأمر خشية أن يظن بعض المعاصرين أن الحقيقة في المنشودة في التصوير فحسب أو اجتناب المبالغة هي الصحة العلمية، والنظم في العلم والتحقيق لا في الخيال والأوهام فقلنا: "القائل العقاد" لهم: ليس هذا بالشعر المقصود ولو كانه لكانت ألفية ابن مالك أبلغ الشعر القديم والحديث، وقدوة الصادقين في النظم والبيان؛ لأنها منظومة في علم النحو والعلوم كلها سواء في الصدق والتحقيق"(17).
بهذا وضح العقاد قصده من اجتناب المبالغة، وهي أن يكون الشاعر صادقًا مع نفسه حين يلعب الخيال في صوره، ويقصد في ذلك البلاغة لا المبالغة؛ لأنه يرى أن البلاغة إنسانية عامة لا عربية ولا فارسية فهي كما يقول: "وليست مزية لغوية ولكنها مزية نفسية"(18).
وعلى الشاعر أن يصدق مع نفسه في صورته الشعرية، من غير تجشم للمبالغات، وطلب ما لا يكون فقد يكون مبالغًا مخالفًا لظاهر العلم، وأنه مع هذا الصادق في المبالغة قدير في الوصف، والإبانة يقول لحبيبه: إنه أبهى من الشمس لا تسره كما يسره حبيبه ولا تغمر نفسه بالضياء كما تغمرها طلعة ذلك الحبيب(19).
فالمراد بالمبالغة -لا الكذب- هي التجلية والتقرير والتبيين، وهذا هو عين البلاغة في الشعر وصدق الخيال في التصوير الأدبي، وكشف العقاد بما تقدم عن أصالته في فهم الصورة الأدبية، وعمقه في معناها ودقته في معالمها ثم مناقشته الخيال والتشخيص والمبالغة في التصوير، مما جعله يكشف عن حقيقة الصورة الأدبية كما ينبغي أن تكون فنًّا نابضًا بالحياة زاخرًا بالعواطف والمشاعر وصدق الخيال.
__________
(1) ابن الرومي حياته من شعره: العقاد ص207.
(2) ساعات بين الكتب: العقاد 292.
(3) يسألونك: العقاد 43ط، القاهرة 1947.
(4) الديوان المخطوط ورقة 58، ج1.
(5) المرجع السابق: 309، ساعات بين الكتب: العقاد.
(6) المرجع السابق: 411.
(7) ابن الرومي: العقاد 315.
(8) المرجع السابق 314.
(9) ابن الرومي حياته من شعره. العقاد ص315.
(10) ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان: الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 238ط ثانية 1958.
(11) مراجعات في الآداب والفنون: العقاد 169 القاهرة: 1925م.
(12)المرجع السابق: العقاد ص141.
(13)الديوان المخطوط ورقة 94 ج1.
)14) المرجع السابق 212، 213- ابن الرومي: العقاد.
(15) المرجع السابق: 306.
(16) الديوان المخطوط ورقة ج4.
(17) ساعات بين الكتب: العقاد 123.
(18) المرجع السابق: 121.
(19) المرجع السابق 122.
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
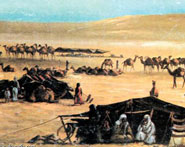 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|