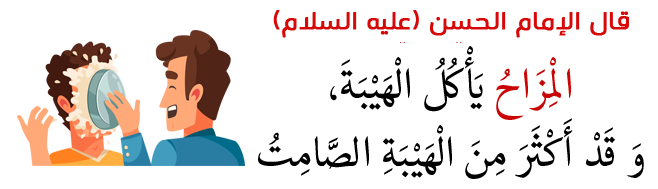
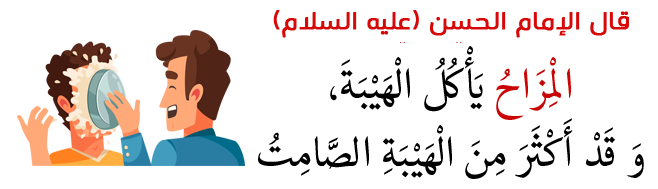

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2022
التاريخ: 8-8-2022
التاريخ: 3-10-2016
التاريخ: 3-10-2016
|
عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): "إنّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول الله عزّ وجل: اجعلوها في سجّين، إنّه ليس إياي أراد بها"[1].
معنى الرياء:
الرياء هو إظهار وإبراز شيء من الأعمال الصالحة أو الصفات الحميدة أو العقائد الحقّة، للناس لأجل الحصول على منزلة في قلوبهم والاشتهار بينهم بالصلاح والاستقامة والتديّن،
من دون أن تكون هناك نيّة إلهية صحيحة.
فالرياء بناء على هذا التعريف يكون في أمور ثلاثة: العقائد الحقّة، والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة.
ويكون الرياء في هذه الأمور الثلاثة من جهتين:
الأولى: إظهار العقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة من أجل الحصول على منزلة في القلوب.
الثانية: يُبعد عن نفسه العقائد الباطلة والأخلاق السيّئة والأعمال القبيحة لنفس الهدف.
وسنتعرّض لهذه الأمور بشيء من التفصيل:
أولاً: الرياء في أصول العقائد
إنّ الرياء في أصول العقائد والمعارف الإلهية أشدّ من جميع أنواع الرياء عذاباً وأسوأها عاقبة، وظلمته أشدّ من ظلمات جميع أنواع الرياء.
والمرائي إن كان في واقعه لا يعتقد بالأمر الّذي يظهره فهو من المنافقين، ونتيجة ذلك ستكون الخلود في النار والهلاك الأبدي والعذاب أشدّ العذاب.
وأمّا إن كان يعتقد بما يظهره، ولكنّه يظهره من أجل الحصول على منزلة في قلوب الناس، فهو وإن لم يكن منافقاً إلّا أنّ رياءه يؤدّي إلى زوال نور الإيمان من قلبه ودخول ظلمة الكفر، وفعله هذا من الشرك الخفي، لأنّ هذه المعارف الإلهية لم تكن خالصة لله بل حوّلها المرائي إلى الناس، وهكذا وبشكل تدريجي سيصبح قلبه مختصّاً بغير الله تعالى، فيخرج من هذه الدنيا بدون إيمان حقيقي، وقد جاء في الحديث الشريف: "كلّ رياء شرك"[2].
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): "قال الله عزّ وجل: أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلّا ما كان لي خالصاً"[3].
الفرق بين العلم والإيمان:
قد يحصل للإنسان علم بالله تعالى ووحدانيته وسائر صفاته الكمالية الثبوتية والجلالية السلبية، وكذلك يعلم بالملائكة والرسل والكتب ويوم القيامة. ولكنّه في نفس الوقت ليس بمؤمناً! وما أكثر هذا النوع من الناس.
ويمكننا أن نُمثّل بالشيطان، فهو رغم علمه بجميع هذه الأمور بقدر علمنا، ولكنّه كافر غير مؤمن.
والسبب في ذلك أنّ الإيمان عمل قلبي، يتضمّن التقبُّل والاستسلام والخضوع والاعتراف،
فقد يحصل للإنسان علم في العقل بكلّ هذه المعاني دون أن يخضع ويستسلم لها في قلبه.
ولنضرب مثالاً محسوساً لذلك:
أنتم قد أدركتم بعقولكم أنّ الميت لا يستطيع أن يضرّ أحداً، وأنّ جميع الأموات في العالَم ليس لهم حسّ ولا حركة بقدر ذبابة، وأنّ جميع القوى الجسمانية والنفسانية قد فارقته، ولكن حيث إنّ القلب لم يتقبّل هذا الأمر ولم يُسلِّم أمره
للعقل فإنّكم لا تقدرون على مبيت ليلة مظلمة واحدة مع ميت!
وأمّا إذا سلّم القلب أمره للعقل وتقبّل هذا الحكم منه، فلن يكون في هذا العمل أيّ المبيت مع الميت أيّ إشكال بالنسبة إليكم، كما أنّه وبعد عدّة مرّات من الإقدام يصبح القلب مسلّماً، فلن يبقى عنده بعدها خوف من الميت.
ومن الممكن أن يبرهن إنسان بالدليل العقلي على وجود الخالق تعالى والتوحيد والمعاد وباقي العقائد الحقّة، ولكن ذلك لا يسمّى إيماناً، ولا يجعل الإنسان مؤمناً، فلعلّه من جملة الكفّار أو المنافقين أو المشركين. فاليوم العيون مغشّاة، والبصيرة الملكوتية غير موجودة، والعين الملكية لا تدرك ولكن عند كشف السرائر وظهور السلطة الإلهية الحقّة، وخراب الطبيعة وانجلاء الحقيقة، سيعرف ويلتفت بأنّ الكثيرين لم يكونوا مؤمنين بالله حقّاً، وأنّ حكم العقل لم يكن مرتبطاً بالإيمان، فما لم تكتب عبارة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ بقلم العقل على لوح القلب الصافي لن يكون الإنسان مؤمناً بوحدانية الله تعالى.
وعندما ترد هذه العبارة النورانية إلى القلب، تصبح سلطة القلب لذات الحقّ تعالى، فيُسلِّم أن لا مؤثّر في الوجود إلّا الله تعالى ولا ملك سواه، ولا يتوقّع من شخص آخر جاهاً ولا تنزيهاً، ولا يبحث عن المنزلة والشهرة عند الآخرين. وبالتّالي فلن يكون القلب مرائياً ولا مخادعاً.
فإذا رأيتم رياء في قلوبكم فاعلموا أنّ قلوبكم لم تسلِّم للعقل وأنّ الإيمان لم يقذف نوره فيها، وأنّكم تحسبون في قلوبكم شخصاً آخر هو المؤثِّر في هذا العالَم غير الحقّ تعالى فتكونون في زمرة المنافقين أو المشركين أو الكفّار.
يبقى أن نشير إلى أنّ نور الإيمان إذا قوي حصل الاطمئنان في القلب، فالاطمئنان ليس هو العلم وإنما هو كمال الإيمان.
كيف نستأصل جذور الرياء:
نذكر هنا أمراً نأمل أن يكون مؤثِّراً في علاج هذا المرض القلبي، وهذا الأمر قد أشارت إليه آيات من القرآن الكريم والعديد من الروايات ودلّت عليه الأدلّة العقلية واكتشفته القلوب البصيرة العارفة بالله تعالى، وهو: إنّ قدرة الله تعالى محيطة بجميع الموجودات وسلطانه مبسوط على جميع الكائنات وقيمومته جارية على جميع المخلوقات، وقلوب الناس ليست مستثناة من ذلك، فالله تعالى هو القيّم والمسلّط والمحيط بقلوب الناس جميعاً.
ومادام تعالى هو القيّم على قلوب الناس فلا يمكن للإنسان التصرُّف بها والتأثير فيها إلّا بإذن الله تعالى، بل إنّ الإنسان غير قادر على التصرُّف حتّى بقلبه هو بدون إذاً من الله تعالى، وبهذا المعنى وردت كلمات إشارة وكناية وصراحة في القران الكريم وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام.
إذاً، فرياؤك وتملُّقك، إذا كانا لأجل جذب قلوب العباد ولفت نظرهم والحصول على المنزلة والتقدير في القلوب والاشتهار بالصلاح، فإنّ ذلك خارج عن تصرُّفك تماماً وهو تحت تصرُّف الله تعالى، فهو إله القلوب وصاحبها الّذي يوجّهها نحو من يشاء، بل من الممكن أن تحصل على نتيجة عكسية! وقد رأينا الكثير من الأشخاص المتملّقين والمنافقين كيف افتضح أمرهم وبان زيفهم وحصلوا على عكس ما أرادوا الحصول عليه في نهاية الأمر!
وفي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام يشرح قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾[4]، قال (عليه السلام): "الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنّما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس فهذا الّذي أشرك بعبادة ربّه. ثمّ قال: ما من عبد أسرّ خيراً فذهبت الأيّام أبداً حتّى يظهر الله له خيراً، وما من عبد أسرّ شرّاً فذهبت الأيّام أبداً حتّى يظهر الله له شرّاً"[5].
إذاً أيها العزيز، اطلب السمعة والذكر الحسن من الله، والتمس قلوب الناس من مالك القلوب، اعمل لله وحده وستجد أنّ الله تعالى بالإضافة إلى الكرامات والنعم الأخروية سيتفضّل عليك في هذا العالَم أيضاً بكرامات عديدة، فيجعلك محبوباً ويعظّم مكانتك في القلوب ويجعلك مرفوع الرأس وجيهاً في كلتا الدارين.
ثمّ لو فرضنا أنّك حصلت على قلوب الناس من خلال التملُّق والرياء، فماذا ستجني من حبّ الناس الضعاف لك، وما فائدة هذه الشهرة وهذا الصيت؟ وهم لا يملكون شيئاً من دون الله! ثمّ لو فرضنا أنّ هناك فائدة من ذلك، فما هو مقدار هذه الفائدة وما هي قيمتها؟ إنّما هي فائدة تافهة ولأيّام معدودة، ومن الممكن أن يوصل الإنسان إلى الشرك والنفاق والكفر لا سمح الله وإن لم يفتضح في هذا العالَم فسيفتضح في ذلك العالَم في محضر العدل الربّاني عند عباد الله الصالحين وأنبيائه العظام وملائكته المقرّبين ويهان ويصبح مسكيناً ذليلاً، إنّها فضيحة وأيّ فضيحة؟! إنّه اليوم الّذي يقول فيه الكافر ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾! فمقابل هذه المحبّة البسيطة وعديمة الفائدة بين العباد، خسرت تلك الكرامات وفقدت رضا الله وعرّضت نفسك لغضبه تعالى.
وقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): "إنّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول الله عزّ وجل: اجعلوها في سجّين، إنّه ليس إيّاي أراد بها"[6].
الله أعلم كيف ستكون صورة تلك الأعمال في سِجّين!



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|