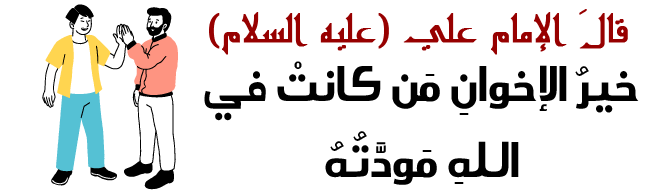
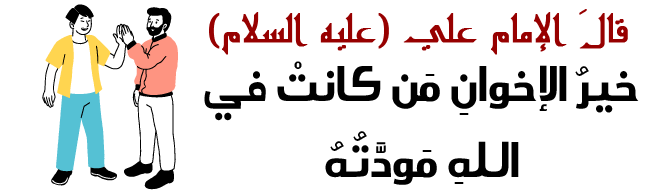

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-07-2015
التاريخ: 1-07-2015
التاريخ: 4-11-2017
التاريخ: 11-08-2015
|
الموضوع : القول في دفع ما طعن به المخالفون في
القرآن .
المؤلف : العلامة الشيخ سديد الدين الحمصيّ الرازيّ
.
الكتاب : المنقذ من التقليد والمرشد الى التوحيد
المسمى بالتعليق العراقي، ج1 - ص476- 489.
___________________________________________________
اعلم أنّهم قد طعنوا فيه بوجوه:
منها: أن قالوا: القرآن مغيّر مبدّل وليس الذي في أيديكم
ما وقع به التحدّي للعرب، فكيف يمكنكم الاستدلال به على صدقه عليه السلام. وأيضا
فلو كان معجزا دالا على صدقه لعصمه اللّه عن التغيير.
فيقال لهم أوّلا: لم زعمتم انّ القرآن مغيّر مبدّل،
بيّنوا ذلك ليمكنكم القدح فيه، ثمّ إن كان غرضهم بما ادّعوه من تغيير القرآن وتبديله
القدح في نبوته عليه السلام وصدقه في دعواه ودلالة صدقه، فانّه لا يحصل بما ادعوه
من ذلك غرضهم ولا يتمّ به بغيتهم. وذلك لأنّ العلم بصدقه عليه السلام في دعواه
النبوّة لا يحتاج إلى العلم بأنّ هذا الذي هو موجود في أيدينا، هو الذي ظهر عليه
بعينه، بل على الجملة كاف في هذا الباب، بأن يعلم في الجملة أنّه عليه السلام أظهر
كلاما وقرآنا بلغتهم، وادّعى أنّه كلام اللّه انزل عليه وخصّه به دونهم. فانهم لا
يمكنهم الإتيان بمثله وأنّهم لم يأتوا بمثله مع حرصهم على الإتيان بمثله وشدّة
دواعيهم وحاجتهم إليه، فكان انتفاء ذلك المثل من جهتهم لتعذّره عليهم، وإن كان ذلك
خارقا للعادة، سواء علم ذلك القرآن بعينه أو لم يعلم ولهذا يمكن الأميّين من
الأعاجم الاستدلال بالقرآن على نبوته وصدقه في دعواه وإن لم يعلموا القرآن على
التعيين ولا تعلموه على أنّا نبين أنّ القرآن ليس مغيّرا ولا مبدّلا، ليبطل بذلك
قولهم بأيّ غرض قالوه.
فنقول لهم أتزعمون أنّ جميع القرآن مغيّر مبدّل أم بعضه
دون بعض؟ إن قالوا كلّه، قلنا لهم: فجوّزوا أن يكون الفاتحة مغيّرة مبدّلة. إن قالوا
بجواز ذلك، قلنا لهم: كيف يجوز ويتمّ التغيير في الفاتحة مع أنّهم كانوا يسمعونها
منه عليه السلام كلّ يوم وليلة في صلاة الجهر ستّ مرّات، وكانوا يعلّمونها كلّ من
دخل في الإسلام، وكلّ مصلّ كان يقرؤها في الصلاة الواجبة والمسنونة، ثمّ وكانوا
يقرءونها خارج الصلاة، وكلّ من يتعلّمها كان يعرضها على معلّميها.
ثمّ وكيف يجوز مع كثرة المعظّمين لها والقارئين أن لا
ينكروا تغييرها ويقبلوها مغيّرة. بعد ما شاعت فيهم على غير النظم الذي حفظوها وتعوّدوا
قراءتها، ولو جاز تغيير مثلها في شهرتها وظهورها، لجاز تغيير كثير من الأخبار عن
البلدان والملوك والبقاع والوقائع حتّى يجوز أنّ الكعبة ومكّة والمدينة ليست هي ما
يتعارفونها بل أخرى، لكنّ الناس غيّروا الخبر عنها وكذا هذا في سائر البلدان والملوك،
وفي ذلك لزوم طريقة السّمنيّة وزوال الثقة بمخبر الأخبار.
و إن قالوا: إنّما نجوّز التغيير والتبديل في بعض القرآن
دون بعض وفيما عدا الفاتحة.
قلنا: الوجه الذي لم يجز التغيير في الفاتحة حاصل في
جميع القرآن وهي شهرة جميعه وقوّة الدواعي إلى نقله على وجهه، لأن القارئين للقرآن
والحافظين له والمتعلّمين له والعارضين له على الرسول عليه السلام والمعلّمين لهم
كانوا كثيرين، وكذا القارئون له في صلواتهم والخاتمون له في زمنه، عليه السلام وزمن
الصحابة بعده في غير الصلاة وفي كلّ شهر رمضان في التراويح كانوا جماعات كثيرين وكانوا
يزدادون عصرا بعد عصر، وكلّ هؤلاء كانوا معظّمين للقرآن ومنكرين لتغييره لو غيّر.
فكيف يجوز والحال هذه أن يغيّر ويبدّل؟ وكيف لا ينكر ذلك منكر، ولا يجري للإنكار
ذكر في عصر من الأعصار.
أوليس من المعلوم
أنّه لو غيّر كتاب معروف في فنّ من فنون العلم متداول بين أرباب ذلك العلم، ككتاب
سيبويه في النحو، او إصلاح المنطق في اللغة، أو القدوريّ في الفقه، أو المنصوريّ
في الطب، بإسقاط البعض منه أو زيادة شيء فيه أو تقديم مؤخّر أو تأخير مقدّم،
لعرفه العالمون بذلك الكتاب المدرّسون منه والمتعلّمون المتدرّسون منه، ولأنكروه ولردّوه
إلى الأصل المعلوم المقرّر عندهم فيه، ولخاصموا من نازعهم في ذلك. وكذا القول في
الدواوين المعروفة للشعراء، كديوان أبي تمّام والبحتريّ والمتنبّي.
ومن المعلوم أن دراسة هذه الكتب والدواوين ليس كدراسة
القرآن وتلاوته في الكثيرة، وانصراف الهمم إلى مراعاة هذه الكتب وحفظها لا يبلغ
حدّ انصراف الهمم والعنايات من عوام المسلمين وخواصّهم إلى مراعاة القرآن وحفظه ودراسته
وتلاوته والتمييز بين وجوه القراءات المختلفة فيه ووجوه العلل التي فيها الذي
يعرفه القرّاء ويعتنون به.
فإذا لم يتمّ التغيير والتبديل في شيء... مع انخفاض
رتبته عن القرآن بكثير في ماله ولأجله لا يتطرّق إليه التغيير كيف يتمّ ويتصوّر
ذلك في القرآن. هذا على أنّه قد وعد بحفظ القرآن من التغيير بقوله تعالى: {إِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] فصحّ وتحقّق
أنّ ما قالوه غير ممكن، ويلزم على ما قالوه وجوّزوه الجهالات التي ألزمناها من
جوّز تغيير الفاتحة.
فإن قيل: أليس قد روي عن الصحابة إنكار بعضهم على بعض في
الزيادة فيه والنقصان منه؟ كالرواية عن ابن مسعود في المعوذتين أنّهما ليستا من
القرآن وأنّ سورتي القنوت من القرآن. وعن أبيّ عكس ذلك، وهو أنّ المعوذتين من
القرآن وسورتي القنوت ليستا من القرآن، وإنكاره على ما قاله ابن مسعود، وكالرواية
المتضمّنة لاختلافهم في التسمية، وأنّها هل هي من الفاتحة أم ليست منها؟
قلنا: إنّه ما وقع بينهما خلاف في أنّ ذلك وحي منزل على
الرسول، وإنّما اختلفوا في أحكام هذه السور: فابن مسعود قال: إنّ المعوذتين أنزلتا
لتحفظا، لا لتكتبا، وإنّ حكمهما ليس كحكم سائر السور في التعظيم وحفظ الحرمة وان
حكم سورتي القنوت حكم القرآن في التعظيم ومراعاة الحرمة، وأبي كان يقول بخلاف ذلك.
ثمّ وهذا الاختلاف إنّما كان في بدو الأمر وأوّله، فبعد
ذلك كان للصحابة رضي اللّه عنهم اجتماع للبحث عن ذلك: فاتّفقوا على آخر العرض على
الرسول عليه السلام وانقطع ذلك الخلاف، وكتب المصحف المتّفق عليه، وسمّوه الإمام،
ليكتب منه النسخ وزال بذلك كلّ خلاف ظهر في بدو الأمر وبقي اختلاف القراءات التي
تتفق صورة المكتوب منها وتختلف حركاتها مع اتفاق المعنى في أكثرها.
وقد كانت تلك القراءات منزلة على ما ورد في الحديث
المعروف من قوله عليه السلام: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف كاف». شرع عليه
السلام القراءة بها بأمر اللّه وإذنه. فاختار قوم قراءة وآخرون قراءة اخرى وجماعة
غيرهما، ونصر كلّ قوم منهم ما اختاره ورجّحه على غيره. هذا مع اتفاقهم على تجويز
القراءة بغير ما اختاروه من القراءات.
ونحن إنّما ندّعي العلم بما انفقوا عليه بعد وقوع
الاختلاف وظهور بعضه ونقول: يستحيل تغييره وتبديله والزيادة والنقصان فيه، أي فيما
رجع أمرهم إليه واتفقوا عليه، فلا يضرّنا في ذلك الاختلاف الذي ظهر في ابتداء
الأمر إذ زال ذلك الخلاف بالإجماع على ما هو موجود في أيدينا.
فأمّا التسمية فلم يختلفوا في أنّها من القرآن وأنّها
بعض آية من سورة النمل، وإنّما اختلفوا في أنّها هل هي آية من الفاتحة أو آية من
كلّ سورة أو أنزلت ليبتدأ بها تبرّكا واستفتاحا في كلّ أمر ذي بال. وهذا الاختلاف
فيها بعد الاتفاق على أنّها آية من القرآن لا يقتضي ما رامه المخالف.
فإن قيل: أليس قد روي بعض الصحابة أنّه قال: كان يقرأ في
القرآن:
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة»(1)، وقوله: «لو
كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما واديا ثالثا»(2) ؟
قلنا: هذه أخبار آحاد لم تقم بها حجّة فلا يصحّ القدح
بها في الامور المعلومة. وعلى أنّ المروي في ذلك أنّه كان فيما أنزل اللّه: «الشيخ
والشيخة» و«لو كان لابن آدم واديان من ذهب»، وليس فيه أنّه أنزل قرآنا. ثمّ ولو
كان قرآنا أيضا لما ضرّنا، لأنّه كان قرآنا، ثمّ نسخه اللّه تعالى، أي تلاوته، على
ما قال تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106].
ومنها: أن طعنوا فيه بأن فيه خطاء من جهة العربيّة أو
فيه تكرارا، ثمّ وقع فيه ما لا يعلم له معنى، كالحروف المقطعة في أوائل السور، أو
فيه آيات متشابهات أو فيه تناقض ومن طعن فيه بأمثال هذا فقد أتى في غيه وضلاله من
قبل نفسه، لجهله بمخاطبات العرب وتعارفهم وتوسّعهم في كلامهم، أو علم ذلك ولكن
تعمّد الطعن لشكّه في نبوّة محمد صلى اللّه عليه وآله.
و الجواب عن هذا الطعن على الجملة، ما أورده الشيخ أبو
الهذيل على من سأله عن بعض ما يتشابه معناه من القرآن ويتوهم فيه التناقض. وهو
قوله له:
«أو ما علمت أنّ العرب كانوا أشدّ عداوة له منهم؟» قال:
«نعم». قال:
«و قد علمت أنّهم كانوا أعرف بما يتناقض من الكلام من
هؤلاء الجهّال الطاعنين في القرآن». فقال: «نعم». قال: «و قد علمت أنّهم كانوا
أحرص على إظهار التناقض في القرآن إن كان فيه تناقض»، قال: «نعم».
قال: «فلو كان فيه تناقض لأظهروه ولنقلوه، وكيف يعرضون
عنه بعد الظفر به، وقد كان عليه يقرأ عليهم. { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ
اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء: 82].
وهذا يكفي في دفع جميع المطاعن عن القرآن على الجملة على
أنّ علماء الإسلام قد بالغوا في دفع هذه المطاعن على التفصيل، فذكروا كلّ ما ذكره
الطاعن في القرآن من الآيات المعيّنة، وبيّنوا الموافقة بينها وبين غيرها، وذكروا
شواهدها من كلام العرب، وبينوا خطأ من ادّعى فيها أخطاء.
ومنها: قول الباطنيّة انّ لظواهر القرآن معاني باطنيّة
لا يعلمها إلّا إمامهم وأنّه ينبغي أن يتعلّم منه. وفي هذا إبطال كونه معجزا، لأنّ
البلاغة في الكلام إنّما تظهر بجزالة اللفظ وحسن المعنى، فإذا لم يعرف للكلام
معنى، كيف يبيّن ويظهر فيه الفصاحة والإعجاز، وكيف يصحّ التحدّي به، وهل يكون ذلك
عند من تحدّى به إلّا بمنزلة الهجر والهذيان.
يوضّح هذا أنّ في التحدّي لا بدّ من أن يعرف المتحدّي
معنى ما تحدّى به من الكلام، فيعلم مبلغه من الفصاحة، فإن تمكّن من مثله فيها أتى
بمثله، وهذا لا يصحّ فيما لا يعرف له معنى.
ولهؤلاء المبطلين غرضان اثنان فيما قالوه، أحدهما: إبطال
كون القرآن معجزا، وثانيهما: أن يدسّوا فيما يذكرونه من المعاني الباطنة الدعوة
إلى مذاهبهم ويضلّوا العوامّ ويستميلوهم إلى اعتقاد أنّ أئمتهم هم العلماء بمعاني
القرآن دون غيرهم من علماء المسلمين.
و الوجه في الردّ عليهم أن يقال لهم: هل يدلّ الظاهر على
المعنى الباطن الذي أراده اللّه تعالى أو يدلّ عليه المعنى الذي يدلّ عليه الظاهر؟
فإن قالوا: بلى، يدلّ عليه، إمّا الظاهر وإمّا المعنى
الذي يدلّ عليه الظاهر.
قلنا: إذا كان كذلك أمكن كلّ واحد أن يعرفه وصار ظاهرا وخرج
من كونه باطنا.
وإن قالوا: لا يدلّ عليه واحد منهما.
قلنا لهم: فكيف عرف إمامكم ذلك المعنى الباطن.
إن قالوا: بهما أو بواحد منهما.
قلنا: فعلى هذا يمكن لكلّ أحد أن يعرف ذلك المعنى بهما
أو بواحد منهما ...
وإن قالوا: إنما عرف ذلك المعنى إمامنا بإمام آخر قبله.
قلنا: نحن نلزمكم هذا في أوّل من سمع خطاب اللّه تعالى وأنّه
كيف علم ذلك المعنى الباطن.
فان قالوا: ألهمه اللّه تعالى ذلك المعنى.
قلنا: وهلّا ألهمه ذلك من دون خطاب؟ أو هلّا أسمعه صياحا
أو كلاما مهملا ثمّ ألهمه ذلك المعنى؟ وهذا يقتضي أن يكون إنزال اللّه تعالى
القرآن بلغة العرب عبثا.
ثمّ يقال لهم: إنّ ما يقولونه لا يعجز عن مثله كلّ مبطل،
بأن يدّعي دينا باطنا، ويدّعي، أنّ له فيه إماما، ويزعم أنّ إمامه هو العالم
بالمعاني الباطنة دون غيره، ويذكر ما يريده من المعاني التي لا دلالة عليها في
خطاب اللّه وينصر بها مذهبه الباطل. بل زائدا على ذلك يمكنه أن يذكر ما ينافي ما
تذكرونه من المعاني الباطنة.
فإن قالوا: إنّه تعالى خاطبه بلغة العرب، ثمّ أعلمه
المعنى الباطن بخطاب آخر يدلّ ظاهره على معناه.
قلنا لهم: إذا
جوّز المخاطب أن يخاطبه الحكيم بما لا يدلّ ظاهره ولا معناه وما يتعلّق به على
مراده، جوّز ذلك في كلّ خطاب يخاطبه به بأيّ لغة كان لا يستفيد من خطابه فائدة ولا
يفهم له معنى، وفي هذا سدّ الطريق إلى معرفة مراد اللّه تعالى بخطابه أصلا، وفيه
بطلان المعنى الظاهر والباطن جميعا.
فإن قيل: ما الفائدة في إنزال اللّه تعالى بعض القرآن
متشابها؟
قلنا: يجوز أن يكون فيه مصلحة لا يعلمها غير اللّه تعالى
هذا، مع أنّا نذكر فوائد في ذلك يرجع بعضها إلى الموافق وبعضها إلى المخالف.
أمّا ما يرجع الموافق فوجوه:
منها: أنّه لو كان القرآن كلّه محكما دالا بظاهره على
الحقّ من التوحيد والعدل لكانوا يقتصرون عليه في التوصّل إلى الحقّ، وأعرضوا عن
الاستدلال عليه بأدلّة العقل، لاستثقالهم الفكر والبحث وإتعاب الخاطر على ما هو
معهود من طباع أكثر الناس وكانوا متوصّلين إلى الشيء بغير طريقه، فبان الاستدلال
بالقرآن إنّما يصحّ بعد معرفة التوحيد والعدل. وليس كذلك إذا كان بعض القرآن ظاهره
يفيد التوحيد والعدل وظاهر بعضه يوهّم التشبيه والجبر، لأنّه إذا كان كذلك لم يكن
المكلّف بأن يتعلّق بأحدهما أولى من أن يتعلّق بالآخر، فيضطرّ عند ذلك إلى استعمال
العقل بالفكر في أدلّته، ولو كان كلّه محكما، لم يكن مدفوعا مضطرّا إلى ذلك.
ومنها: أنّ الموافق إذا اعتقد إعظام القرآن وتنزيهه عن
المناقضة ثم رأى فيه ما يتوّهم فيه مناقضة، راعه ذلك واستعظمه، وكلّ من راعه أمر
من الأمور فانّه يلتجئ إلى فكره وعقله. فإذا فكّر في طريق ما يجوز عليه من الأفعال
وما لا يجوز، وما يجوز أن يريده وما لا يجوز، عرف بفكره الصحيح في ذلك ما يجوز
عليه وما لا يجوز وعرف عند ذلك أنّه تعالى أراد بالمتشابه ما يوافق المحكم.
ومنها: أنّ في الفكر في استخراج معاني الآي المتشابهة
رياضة للأذهان وتخريجا للخواطر وتعريضا لزيادة الدرجات، فهذه فوائد ظاهرة راجعة
إلى الموافق.
وأمّا الفائدة الراجعة إلى المخالف فهي أنّ العرب كانت
تمنع من استماع القرآن خوفا من أن تعجب المستمع فصاحته، فتستميله إلى الإسلام، على
ما حكاه تعالى عنهم بقوله: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا
الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [فصلت: 26] ، فكان إنزاله
محكما ومتشابها يوهم مستمعه أنّه متناقض، فيطمعه في الظفر بمثله في التناقض، فيدعوه
ذلك إلى إطالة الإصغاء إليه، فإذا تأمّله وأطال استماعه له علم أنّه لا تناقض فيه،
واستماله ودعاه إلى الإسلام بما فيه من الفصاحة والإخبار عن الغيوب.
وفي الجملة غير لازم في الحكمة الاقتصار على الآيات
المحكمات دون المتشابهات، وإن كان غرض الحكيم تعالى أن يدلّنا على الحقّ دون
الباطل، والصحيح دون الفاسد، كما لم يجب الاقتصار على الأدلّة العقليّة ورفع
الشبهات التي قد ضلّ عندها الضالون، كإيلام الأطفال وخلق السباع والموذيات وغيرها
...
فان قيل: إنّما لم يجب في العقليّات ما ذكرتموه، لأنّه
يمكن الوصول إلى الحقّ معه هذه الشبهات، ومن ضلّ عندها فانّما أتى من قبل نفسه في
ذلك. ثمّ وغير ممتنع أن يكون في إيلام الأطفال وغيره ممّا ذكرتموه مصالح لا يطلع
عليها.
وبعد فانّ في وصول المكلّف إلى الحقّ مع اعتراض الشبهات
وإنعام النظر فيها تعريضا لدرجات زائدة في الثواب، وتشحيذا للخواطر، وتخريجا
للأفهام.
قلنا: مثل ذلك في
الآيات المتشابهة.
ثمّ إن كان الطعن بالمتشابهات في القرآن من قبل بعض أهل
الكتاب فأنا نقول لهم: ليس لكم أن تطعنوا في القرآن وتعيبوه بما فيه من الآي
المتشابهة مع انّ ما في كتبكم من ذلك أكثر ممّا في القرآن وأشدّ تصريحا بالتشبيه.
ففي القرآن: {وَجَاءَ رَبُّكَ} [الفجر: 22] ومعناه: جاء أمر ربّك ووعيده وعقوبته.
وهو نوع من المجاز مستعمل في اللغة ...
وفي التوراة ما ترجمته هذا: «و أقبل اللّه يمشي في
الفردوس مع الطهر وسمع آدم صوت وطئه، فعدا آدم من قدّامه فاختبى تحت الشّجرة
فناداه فقال: يا آدم أين أنت؟ فقال: ها أنا تحت الشجرة فقال: ولم اختبيت تحت
الشجرة؟ قال: لأني كنت عريانا».
وفي التوراة أيضا ما ترجمته: «إنّه دخل بيت إبراهيم وقال:
إنّ صريخ سدوم وعامورا صعدا إلي فنزلت إلى هذا المكان لأنظر. وإنّه كلّم يعقوب من
رأس سلم وإنّه كان ينزل على فترة من الزمان في الغمام وبأنّه صارع يعقوب، فاخذ
يعقوب بساقه، وقال: دعني، فقال: لا أدعك حتى تعرّفني من أنت، فقال: أنا ربّك،
فأرسله وسمّي إسرائيل، لأنّه أسر اللّه».
وكلّ ذلك متأوّل عندهم على أنّ المراد به ملك اللّه، وإن
كان في الكلام اسم اللّه. وفي القرآن قوله: {وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: 54] ومعناه
أنّه جازاهم على المكر، والعرب تسمّي الشيء باسم ما هو جزاء عليه، كما قال اللّه
تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } [الشورى: 40] ، وقال الشاعر:
ألا لا يجهلن أحد
علينا فنجهل فوق جهل
الجاهلينا
ولأنّ من مكر واستهزأ
وسخر بمن يعلم ذلك كان مكره واستهزاؤه وسخريّته عائدا بالمضرّة عليه، ويقال هو
المسخور منه، ويقال للعالم بما يفعله: الساخر الماكر الذي حلم عنه، هو الماكر به والساخر
منه والمستهزئ به.
وفي كتاب نبيّ من الاثني عشر قوله: «و أينما هربوا فثمّ
يمكر بهم الربّ، فيطرح مصيدته عليهم».
وقال داود في الزبور: «والباني الساكن في السماء يضحك
بهم ويسخر منهم».
وإن كان في القرآن: {فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا
مِنْهُمْ} [الزخرف: 55] ومعناه: أغضبونا.
ولهذا قال تعالى: { انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ} [الزخرف: 55].
ففي كتبهم أنّه ندم واستراح ومشى وتبرّم وانتقل. وفي
الفصل الرابع من أشعيا: «اسمعوا يا آل بيت داود، أحقر أن تتّبعوا الرجل حتّى
تريدوا أن تتعبوا اللّه ربّي أيضا كذلك سيعطكم ربّكم آية هذه العذراء تحبل وتلد
ابنا».
وإن كان في القرآن آيات متشابهة في الجبر، ففيه: { وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
وفي بعض كتبهم قال: «أخذ الأبناء بذنوب الآباء إلى سبعة
أعقاب».
فإن تعلّقوا بما في القرآن من الآيات المقتضية بظاهرها
أنّه يحول بين المرء وبين ما كلّفه ويمنعه دونه مثل قوله تعالى: {وَإِذَا قَرَأْتَ
الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا مَسْتُورًا } [الإسراء: 45] ، وقوله: {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا } [الأنعام: 25] ، {وَإِذَا
ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا
} [الإسراء: 46].
فقد ذكر أبو إسحاق
في كتاب المبعث «أن المشركين كانوا يقولون ذلك».
واللّه تعالى حكى عنهم ذلك في موضع آخر فقال: {وَقَالُوا
قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ
وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ } [فصلت: 5] فحكى اللّه تعالى ذلك عنهم رادّا
عليهم بقوله: {وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى
أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا} [الإسراء: 46] أي: إن كان الأمر كما يزعمون أنّ في آذانهم
وقرا وفي قلوبهم أكنّة فما يسمعون ولا يفهمون، فلم قال: إذا سمعوا ذكر اللّه في
القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفورا، وهذا تأويل ذكره الواقديّ وغيره.
وقيل: المراد بذلك المثل أي مثلهم في إعراضهم عن التأمّل
لما يسمعونه من كلام اللّه كأنّا جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا، وكأنا جعلنا على
قلوبهم أكنة، وكأنّ في أسماعهم وقرا، كما قال تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ
آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ
وَقْرًا } [لقمان: 7] ، وكما قال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ
أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِنْ
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا
يُبْصِرُونَ} [يس: 8، 9].
وهذا طريق التشبيه لحالهم بمن هذه سبيله، لا أنّهم كانوا
كذلك على الحقيقة، كما يقول أحدنا لمن هو معرض عن الحقّ الظاهر: هو أعمى وهو أصمّ،
وهو جماد، ونحن نعلم أنّ أيديهم لم تكن مغلولة ولا كانت أبصارهم مغشاة لا يبصرون.
فعلمنا أنّه على طريق ضرب المثل به، قال الشاعر.
كيف الرشاد وقد صرنا إلى نفر
هم عن الرشد أغلال وأقياد
وفي التوراة: «إنّ اللّه تعالى قال: وأنا أقسي قلب
فرعون، فلا يحبّك يا موسى».
وحكوا عن المسيح
عليه السلام في الإنجيل أنّه قال: «ما يقدر أحد أن يتّبعني إلّا من قاده ربي إليّ.
وعن نبيّ من الاثني عشر أنّه قال «و هل يكون في المدينة
شر الّا وأنا فاعله».
و حكي عن اشعيا عن اللّه عزّ وجلّ أنّه قال: «أنا فاعل
الخير والشرّ».
__________________________
( 1) كنز العمال: ج 2 ص 567 ح 4743 وح 4742.
( 2) كنز
العمال: ج 2 ص 567 ح 4743 وح 4742.



|
|
|
|
للحفاظ على صحة العين.. تناول هذا النوع من المكسرات
|
|
|
|
|
|
|
COP29.. رئيس الإمارات يؤكد أهمية تسريع العمل المناخي
|
|
|
|
|
|
|
الامين العام للعتبة الحسينية يؤكد على هيئة التعليم التقني بتحقيق التنمية المستدامة في البلاد
|
|
|