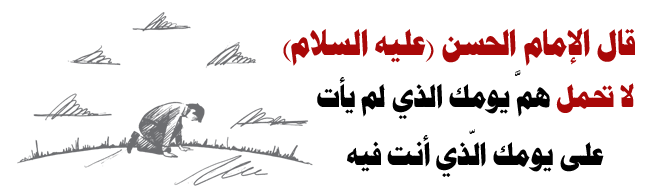
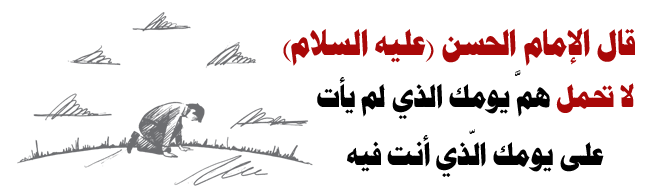

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-9-2016
التاريخ: 28-9-2016
التاريخ: 21-7-2021
التاريخ: 28-9-2016
|
{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء : 31]
الآية الشريفة على إيجازها البليغ وأسلوبها البديع تشتمل على الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والأمل والرجاء بالسعادة ، فهي تدل على وجوب الاجتناب عن المناهي ، التي يوجب ارتكابها الشقاوة والعذاب العظيم .
كما أنها تدل على أن الارتداع عن الكبائر المنهية يوجب الدخول في النعيم الأبدي ، ويستلزم العادة الحقيقية ، ولا يخفى ارتباطها بما قبلها من الآيات التي تضمنت جملة من الأحكام الشرعية والمناهي الإلهية التي شرعها الله تعالى لأجل مصالح الإنسان.
قال تعالى : { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ } [النساء : 31].
الاجتناب أبلغ من الترك ؛ لأنه ملحوظ فيه النفور والاشمئزاز ، وهو مـأخوذ من الجنب الذي هو الجارحة. وإنما بني عنه الفعل على سبيل الاستعارة ، فإن الأنسان إذا أعرض عن شيء تركه جانباً ، والاجتناب هو الابتعاد عن الشيء وملازمة تركه ، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في أربعة عشر موضعاً كلها تدل على أهمية المنهي عنه كالطاغوت ، قال تعالى : {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ} [النحل : 36].
والرجس ، قال تعالى : {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ} [الحج : 30].
وقول الزور، قال تعالى : {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج : 30]. وعبادة الأصنام ، قال تعالى : {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم : 35].
والنار ، قال تعالى : {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى} [الليل : 17].
وسوء الظن ، قال تعالى : { اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} [الحجرات : 12].
والتجنب تارة يحصل بالنسبة إلى الشيء قصداً وفعلا دائماً من أول التمييز إلى حين الموت.
وأخرى : بالنسبة إلى القصد فقط دون العمل ، بأن يقصد الاجتناب عن الكبائر مطلقاً ، ولكن يتفق صدور بعضها عنه غفلة.
وثالثة : يكون اجتناباً عرفياً ، بحيث يصدق على الشخص أنه مجتنب عرفاً ، فيكون له وللارتكاب مراتب متفاوتة.
ومقتضى القواعد الشرعية - وهو الموافق لسعة رحمته تبارك وتعالى - اعتبار الأخير ، ولكن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ هو الثاني.
والكبائر : جمع كبيرة ، وهي الصغيرة من الأمور الإضافية.
والآية الشريفة تدل على أن المعاصي قسمان كبيرة وصغيرة ، والأولى هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً ، العظيم أمرها كالقتل ، والزنا ، والفرار من الزحف ونظائرها.
وإن كانت المعاصي كلها تشترك في أصل المخالفة والعصيان على الله تعالى فهي كبيرة من هذه الجهة، فإن ذلك مقياس الذنب بين الإنسان المربوب المخلوق الضعيف ، وبين الله تعالى الذي لا منتهى لعظمته وسلطانه ، فلا فرق في أفراد المعاصي حينئذ.
وهنا لا ينافي كونها تتصف بالكبيرة والصغيرة إذا لوحظت فيما بينها كما هو الشأن في الأمور الإضافية ، فإن كبر المعصية يدل على أهمية النهي عنها وعظم المخالفة ، إذا قيس بالنسبة إلى النهي عن الآخر.
فهما وصفان للمعاصي والآثام والذنوب ، وفي المقام حذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه ، وان الصغر والكبر من المبينات العرفية ، وبهذا المعنى العرفي وقع في الكتاب والسنة واصطلاح العلماء في علمي الفقه والأخلاق ، فالنظر إلى الأجنبية مثلا صغيرة إذا قيس إلى سائر الاستمتاعات بها ، والمخالفة في الثاني أعظم وأكبر من المخالفة في الأول ؛ ويدل على ذلك قوله تعالى : {ما تنهون عنه} ، فإن المستفاد منه اختلاف المناهي في العظمة والأهمية ، ولا بد من استفادة الأهمية من الشرع أيضاً .
وقد ذكر العلماء (قدس الله أسرارهم) طرقاً كثيرة ، وأهمها ما ذكره في الفقه وهو : أن كل ذنب أوعد عليه بالنار ، أو تعدد الخطاب فيه ، والنهي عن الإصرار والتكرار.
وهذا هو المقياس في تحديد الكبائر في الإسلام ، وربما تكشف النصوص بعض الكبائر وتنص عليها بأنها كبيرة ، فتكون غيرها بالنسبة إليها صغيرة .
وقد ذكر العلماء في تعريف الكبائر والصغائر وتمييز كل واحدة منها عن الأخرى وجوها.
وربما يتوهم أن الإضافة في قوله تعالى : { كبائر ما تنهون عنه} بيانية ، فتدل الآية الكريمة على اجتناب جميع المعاصي ، وتكون معنى الآية المباركة حينئد : إن تجتنبوا المعاصي جميعاً نكفر عنكم سيئاتكم ، ولا سيئة مع اجتناب المعاصي ، فتكون من قبيل السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع.
ويرد عليه أنه خلاف ظاهر الآية الشريفة ، إلا أن يقال : إنه يرجع إلى تكفير سيئات المؤمنين قبل نزول الآية المباركة.
وفيه : أنه يلزم تخصيص الآية الشريفة بمن حضر عند النزول ، وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة أيضاً.
قال تعالى : { نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31].
مادة (كفر) تدل على الستر ، وكفر الشيء إذا غطاه ، ويقال للفلاح :
كافر ، لأنه يكفر البذر ، أي : يستره ، قال تعالى : { كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ} [الحديد : 20] ، ومنه كفر النعمة والإحسان إذا غطاها بترك الحمد والشكر عليها أو جحدها ، وفي الحديث: ارأيت أكثر أهل النار النساء لكفرهن ، قيل : أيكفرن بالله ؟
قال : لا ، ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير " ، أي : يجحدن إحسان أزواجهن ويسترنه.
ومنه سمي الكافر أيضاً ؛ لأنه كفر بالصانع والمبدأ ، وكفر الله عنه الذنب ، إذا ستره ومحاه عن العبد.
وقد وردت هذه المادة في القرآن الكريم في ما يزيد عن خمسمائة مورد ، أغلبها استعملت في مورد الكفر بالله والأنبياء واليوم الآخر.
ولكن ذكر التكفير عن السيئات في القرآن الكريم ورد في نحو ثلاثة عشر مورداً متعدياً بكلمة (عن).
والمستفاد من موارد استعماله في القرآن الكريم أن المراد منه العفو عن السيئات وحط وزرها عن المسيء ، والاحباط نقيضه التكفير ، وإنما يتحقق بفعل الطاعات وترك الكبائر ، فيكون تكفير السيئات حينئذ من الله جلت عظمته محو الذنب وإسقاطه بالمرة ، فلا يضر فعله بالعدالة إلا بالإصرار على الصغائر ، فيكون من الكبائر ، فلا يتحقق حينئذ شرط التكفير وهو الاجتناب عن الكبائر، وهذا من أحسن التدبيرات الإلهية في عباده ، حيث لا يبعدهم عن رحمته الواسعة بمجرد ارتكاب المخالفة.
نعم ، الإصرار إنما يتحقق بعدم تخلل التوبة بين ارتكاب صغيرة وصغيرة اخرى ، وإما مع تخللها ، فلا موضع حينئذ للإصرار.
ثم إن السيئات جميع السيئة ، وقد أطلقت في القرآن الكريم على معان ، منها كل ما يكرهه الإنسان ويسؤه ، قال تعالى : {وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} [النساء : 79].
وقال تعالى : {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ } [الرعد : 6]
ومنها : نتائج المعاصي والآثام ، سواء كانت دنيوية أم أخروية.
قال تعالى : {فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا} [النحل : 34] ، وقال تعالى : { سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا } [الزمر : 51].
ويمكن إرجاع هذا المعنى إلى الأزل أيضاً ، فإن تلك الآثار قد جلبها الإنسان على نفسه بسبب ارتكابه المحرمات والمعاصي ، وهي تسؤه في الدنيا أو الآخرة.
ومنها : مطلق المعصية ، قال تعالى : {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الجاثية : 21] ، والإطلاق فيه يشمل الكبائر والصغائر.
وأما السيئات في الآية الشريفة : { نكفر عنكم سيئاتكم} ، فإن لوحظت مقابلتها للكبائر، تنحصر لا محالة في الصغائر، وإن لوحظت سعة رحمته جل شأنه وسعة تكفيره وغفرانه، تعلم الكبائر أيضاً ، فيراد حينئذ بقوله تعالى : { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31] ، صرف وجود الكبيرة ، وإنما أتى عز وجل بالجمع باعتبار جميع أفراد الناس ، ومقتضى الجمود على ظاهر اللفظ هو الأول ، ولكن مقتضى ما ورد في سعة رحمته عز وجل غير المتناهية هو الثاني ، ويقتضيه ظاهر الامتنان في الآية المباركة ، خصوصاً مع ما ذكره الفقهاء وعلماء الأخلاق من إنهاء الكبائر إلى سبع وسبعين، ان لا يخلو عنها غالب الناس، وما ورد عن نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : " من الجمعة إلى الجمعة كفارة من الذنوب " ، وما ورد في غفران شهر رمضان ، وما ورد في الغفران في يوم عرفة ، قال (عليه السلام) : " ما وقف بهذه الجبال أحد إلا غفر الله تعالى له، من مؤمن الناس وفاسقهم " ، وغير ذلك مما ذكرناه في مبحث التوبة .
وكيف كان ، فالآية الكريمة تدل على انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر ، سواء أكان الانقسام بحسب ملاحظة نفس المعاصي بعضها مع بعض ، أم بحب ملاحظة صدورها من الفاعل ، فربما يكون بعض الصغائر بالنسبة إلى شخص كبيرة وبالنسبة إلى شخص آخر صغيرة ، كما ورد : " حسنات الأبرار سيئات المقربين ".
قال تعالى : {وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31].
المدخل - بضم الميم وفتح الخاء - والمعروف أنه اسم مكان ، والمراد به في الآية الشريفة الجنة ، فيكون منصوباً على الظرفية ، وقيل : إن مصدر منصوب ، فيكون مفعول { ندخلكم } الجنة ادخالا .
وقيل : إنه منصوب بفعل مقدر ، والأصح هو الوجه الأول.
وكيف كان ، فالمراد به الجنة التي وعدها الله تعالى للصالحين.
والكريم : هو الحسن الطيب ، ومن أسمائه جل شأنه " الكريم " ، أي : الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه، فهو الكريم المطلق ، والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل ، فلا حد لكرمه ولا يمكن عد نعمائه.
وقد وصف عز وجل ذلك المكان به أيضاً ، قال تعالى : { وَمَقَامٍ كَرِيمٍ } [الشعراء: 58] ، والمقام الكريم ذلك المقام الذي يعد الداخل فيه بحسن الثناء وعظيم النعمة ، ويتصف به الرزق أيضاً ، قال تعالى : { لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } [الحج : 50] ، كما يقصف به الرسول أيضا ، قال تعالى : { إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} [الحاقة : 40] ، ويتصف به غير ما ذكر كما ورد في الآيات الشريفة.
والمعنى : وندخلكم الجنة في الآخرة التي يكرم بها من يدخلها فيسعد فيها ، فإن الجنة لا يدخلها أحد الا بعد التطهير من الدنس ورذائل الصفات ، قال تعالى : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} [الأعراف : 43].
وفي إضافة الإدخال إلى ذاته المقدمة فيها غاية اللطف ونهاية العناية وكمال المحبة ، حيث انه تعالى بعد المخالفة وكفران السيئات باجتناب الكبائر يدخل العبد مدخلا كريما .



|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد 53 من مجلة عطاء الشباب
|
|
|