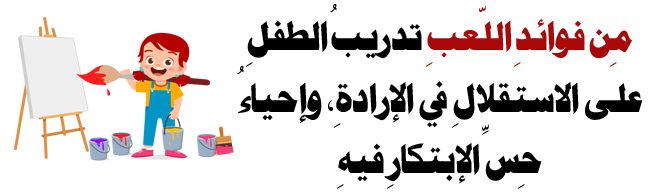
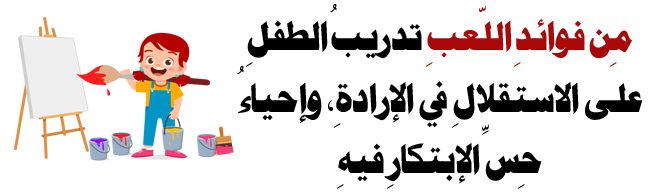

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2021
التاريخ: 7-10-2016
التاريخ: 16-3-2020
التاريخ: 2024-08-10
|
تدل الآيات الشريفة على امور :
الأول : يدل قوله تعالى : {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ } [المائدة: 78] على أن اللعن جائز شرعاً إذا تحقق موجبه وهو العصيان والاعتداء على حرمات الله تعالى المتحققان في الكفر بالله وآياته وتشريعاته المقدسة وإنما ذكر بني إسرائيل من باب المثال فيشمل غيرهم ولعل الإتيان بالفعل مبنيا للمفعول لأجل أن اللعن يتحقق من كل من يمكن أن يصدر منه اللعن سواء كان الله تعالى او الأنبياء أو اللاعنين من غيرهما على كل من كان من شأنه الاعتداء ويستفاد ذلك أيضاً من تعليق الحكم على الوصف وهو العصيان فيستفاد من العلية منه كما هو معروف من مثل هذا الأسلوب وإلا فإن السبب معلوم من الكفر السابق.
الثاني : يستفاد من قوله تعالى : {وَكَانُوا يَعْتَدُونَ } [المائدة: 78] ، إن اقتراف المعاصي والآثام والتمرد على الأحكام وعصيان الله عز وجل يوجب الاستهانة والاستهزاء بكل المقدسات فلا تبقى في النفس حرمة لها وينعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يتناهى عنه، فلو تحقق لا ينتهي عن المنكر وهنا هو السبب في ذم الله تعالى لأفعالهم التي أوجبت وقوعهم في هذا النوع من الذنب الذي له الأثر العظيم في فساد الفرد والمجتمع.
الثالث : يدل قوله تعالى : { لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة : 79] على أن ترك النهي عن المنكر وعدم الانتهاء عنه لو تحقق منهم من الفعل الشنيع الذي ذمه الله تعالى لعظيم أثره في الأفراد والمجتمعات وتأثيره الكبير في الجرأة على هتك الحرمات وعدم احترام النفوس للتكاليف ، وإذا تحقق ذلك في أي فرد أو مجتمع يوجب ضياع عن كل كمال ويستلزم فساده الذي له الأثر في النوع والنظام الكياني ، وقد قال تعالى : { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} [الروم : 41] وقد بين عز وجل بعض آثاره الفظيعة على النفوس والأعمال وما استوجب من الجزاء العظيم وهو سخط الله تعالى الذي كان السبب في دخولهم النار مأوى العاصين ومظهر الغضب الإلهي.
الرابع : يدل قوله تعالى : {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ } [المائدة : 81] على أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه من القرآن والمعارف والأحكام درع حصين من الدخول في زمرة الكافرين وموالاتهم وتعدد مصاديق الإيمان لأجل ثبوت أصل الإيمان في القلب ورسوخه في النفس، فيكون إيمانه خالصاً عن كل نفاق فيكون على طرف نقيض من الذين كفروا من عبدة الأوثان المعرضين عن كل كمال وتحدث البينونة بينهما فكيف يمكن والحال هذه أن يوالي الكافرين ؟ وموالاتهم دليل نفاقهم وعدم رسوخ الإيمان في قلوبهم وعلى هذا لا فرق بين إرجاع الضمير في { كانوا } إلى بني إسرائيل أو إلى المشركين فإن البينونة الحاصلة بين الطائفتين والفرقة الحادثة بينهما تنفي الموالاة فإذا تحققت لا بد أن يكون لأجل عدم الإيمان الموجب لاشتراكهما وإتيان النبي مجرداً عن الإضافة لبيان أن الأنبياء (عليه السلام) هم رسل الله تعالى لهداية الإنسان فلا فرق بينهم من هذه الجهة ، فإن الإيمان بالنبي محمد (صلى الله عليه واله) يدعو إلى الإيمان بموسى (عليه السلام) وكذلك الأمر معكوساً والجميع يدعون إلى الله تعالى والإيمان به وبهم يقطع كل صلة مع الكافرين، كما عرفت مكرراً.
الخامس : يستفاد من قوله تعالى : {وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } [المائدة: 81] ،
إن الإيمان الظاهري الذي يعم جميع من يعتقد به غير كاف في ثبوت الآثار الواقعية المترتبة عليه فيهم ، فإن الكثير الذين يوالون الكافرين ويعملون المعاصي والآثام هم الذين خرجوا عن ربقة المؤمنين وصاروا بذلك فاسقين فهم السبب في دفع الآثار الواقعية فتبقى القلة الذين آمنوا وأعرضوا عن موالاة الكافرين مسلوبوا التأثير ولكن مع ذلك ذكرهم الله وهو من نصفة القرآن حيث أثبت لهؤلاء القلة الحق ولم ينكره عليهم.
السادس : يستفاد من قوله تعالى : {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا } [المائدة: 82] ، أصناف العباد بالنسبة إلى المؤمنين من حيث القرب والبعد والعداوة والمحبة فطائفة منه يعادونهم وهذا هو المشاهد المحسوس منهم وذلك لأسباب معروفة ومعلومة ذكرها عز وجل في هذه الآيات وغيرها، منها موالاة الكافرين والعصيان المتكرر فيهم والاعتداء المستقر في النفوس وعدم احترام المقدسات والحرمات الإلهية، ففي أي قوم استقرت فيهم هذه الصفات وتمكن في النفوس النفاق كانوا على عداء مع القوم المؤمنين وتختلف مراتبه حب شدة الأسباب وضعفها ، ولذا كانت اليهود على الأشد لأنهم على أقصى درجات الاستكبار والنفاق والطائفة الأخرى على قرب من المؤمنين ومحبة لهم وذلك لأسباب معلومة أيضاً وهي وجود العلماء العارفين الذين يدعون أقرانهم إلى الإيمان والطاعة ، والزهاد الذين أعرضوا عما يوجب البعد عن الله تعالى والتواضع للحق وعدم الاستكبار عنه وهذه أمور عالية في غاية الكمال وإذا تحققت في أي قوم توجب الإذعان للحق وحب أهله ، وتختلف أيضاً المحبة شدة وضعفاً بحب زيادة الأفراد وقلتهم وضعف الاستكبار ؛ وكانت النصارى أقربهم مودة للذين آمنوا لكثرة مثل هؤلاء العلماء والزهاد وضعف الاستكبار منهم ، ولعل التعبير بالوجدان لأجل معلومية تلك في النفوس وأنسها بها في الأمور المادية.
وتدل الآية على أن الزهد عن ملاذ الدنيا ووجود الزاهدين في كل قوم له الأثر في نفوس الآخرين وكذلك وجود العلماء الداعين إلى الله تعالى فيهم ، فإن المؤانسة بين الأفراد لا محالة تؤثر وإن النفوس مجبولة على الرجع إلى العلماء الداعين والزاهدين فتتاثر بها ولعل انتفاء الاستكبار من بينهم لأجل وجود هاتين الطائفتين في المجتمع فإن العلم إذا اقترن بالعمل في الخارج زاد في المعرفة وهي تدعو إلى التواضع وإذا أخذ ذلك في الشريعة أيضاً تم المطلوب وانتفى كل عناد ولجاج ، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في التفسير فراجع.
السابع : يدل قوله تعالى : {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ} [المائدة : 83] ، على أن النفوس المستعدة والقابلة لتلقي الفيض تنهضها مجرد سماع الحق ولا تحتاج إلى أمر زائد عن ذلك فترى أن القوم سمعوا القرآن الكريم فتأثروا به وأول أثر خارجي شوهد فيهم هو فياض أعينهم من الدمع الكاشف عن رقة القلوب وابتهاجها بعرفان الحق ، ولعل ذكر الدمع الغزيرة من دون سائر الصفات لبيان الجانب الروحي المتغلب عليهم وانقطاع أنفسهم إلى عالم الغيب فإن الإنسان قد تبرق عليه بارقة فينقطع بها إلى تلك العوالم التي كانت الأرواح فيها ومحل أنسها وإذا استغلها بأحسن وجه وعرف عظيم أثرها لرأى العجب العجاب ولا تخلو لحظة يمر كل فرد فيها.
وأما طلبهم أن يجعلهم مع الشاهدين الذين عرفوا الحق وآمنوا به وأصبحوا شهوداً على قومهم بإيمانهم وصاروا شهداء على الحق بإيمانهم وأعمالهم فإذا كانوا كذلك فلم يؤمنوا بالله وما جاءهم من الحق الذي عرفوه ؟ وما هو السبب في إعراضهم وقد صاروا شهوداً عليه ؟ ولا مبرر لهم في ترك الحق حينئذ فهم صلحاء في عقائدهم وقد خلب الحق قلوبهم فلم لا يطمعون في الدخول مع القوم الصالحين الذين صلحت سرائرهم وأعمالهم وخلص إيمانهم ؟!
الثامن : يدل قوله تعالى : {وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ} [المائدة : 84] على أن الإيمان المستقر في القلوب الذي يكون باعثاً على العمل الصالح يكفي في أن يجعل الفرد من القوم الصالحين وذلك بلطفه العمي ومنه الكريم ، فإن النوايا الحسنة والإيمان الصادق الباعث للعمل الصالح هما الموجبان لتلقي الثواب والدخول مع زمرة الصالحين الذين أعد لهم الله تعالى الثواب العظيم والأجر الجميل ويستفاد منه مصبوبة الطمع من فضل الله العظيم إذا تحققت القابلية لتلقي الفيض وأن كان مذموماً في أمور الدنيا.
التاسع : يدل قوله تعالى : {ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ} [الزمر: 34]، على أن عرفان الحق والإيمان به إحسان محض والمعتقد به يكون من المحسنين ، وقد وصف هؤلاء بأوصاف ثلاثة تدل على عظيم منزلتهم وهما كونهم من الشاهدين والصالحين والمحسنين.
والأول : حصل من عرفان الحق والتواضع له وخلبه لمشاعرهم حتى فاضت دموعهم وانبهروا من شروق نوره على نفوسهم المستعدة.
والثاني : لأن الحق استقر في القلب وسيطر على المشاعر فصلحت نفوسهم ولم يصدر منهم إلا الصلاح فاستقاموا بالبقاء.
والثالث : حصل لهم بعد التجليات الباهرات.



|
|
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|