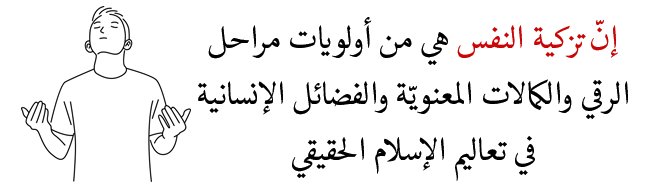
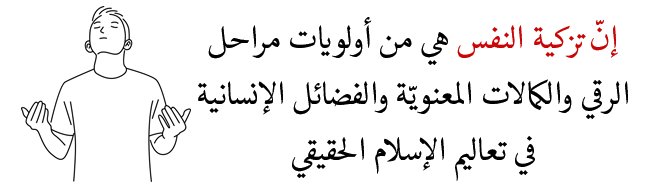

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2014
التاريخ: 5-2-2016
التاريخ: 10-10-2014
التاريخ: 10-10-2014
|
هذه هي القصة الرابعة في سورة أهل الكهف : بغض النظر عن تسلسلها في
السورة ، حيث جاءت ثالثة القصص منها.
ومما لا شك فيه أن التسلسل ـ كما سنرى ـ خاضع لهيكل السورة بأكملها.
لكننا الآن نعنى بهذه القصة من حيث صلتها بالقصص الأخرى من جانب ، وبمقدمة السورة
التي طرحت مفهوم [نبذ الحياة الدنيا وزينتها] من جانب آخر.
لقد لحظنا كيف ان القصص الثلاث التي سبقت التحدث عنها مفصلا... كيف
انها عالجت مفهوم (الزينة) وطرائق الاستجابة حيالها.
فقصة أهل الكهف ، تناولت نبذ الحياة وزينتها ، من خلال أبطال اهل
الكهف أنفسهم حيث نبذوا متاع الحياة ، واتجهوا نحو الكهف في سياق المناخ الاجتماعي
الذي فرض عليهم أن يختاروا (العزلة) بدلا من النشاط ، ما دام النشاط في المناخ
المذكور لم يسمح للأبطال أن يمارسوا وظيفتهم الخلافية على الأرض.
وهؤلاء على العكس تماما من ذي القرنين ، حيث تحرك في قلب الحياة
بأكملها ، حتى استولى على مشرق الأرض ومغربها : في حين لم تسع أصحاب الكهف حتى
الرقعة الصغيرة من مساحة الأرض.
هذا التقابل بين أبطال قصة الكهف وقصة ذي القرنين ، يكشف لنا بوضوح ،
عن ان السياق الاجتماعي هو الذي يفرض حينا تحركا في قلب الأحداث ، وحينا آخر :
سكونا حيالها ما دام الأمران محكومان بالطبع الخلافي أو العبادي بالرغم من تضاد
الموقفين.
والمهم ، ان الموقفين ـ على تضادهما ـ يعكسان دلالة واحدة عن نظرة
الأبطال ـ في القصتين ـ عن الحياة وزينتها.
فأبطال الكهف نبذوا زينة الحياة من خلال لجوئهم الى الكهف. وذو
القرنين نبذ زينة الحياة من خلال تحركه في قلب الأحداث ، مما لم تحتجزه سيطرته على
شرق الأرض وغربها من التعامل مع السماء ، والاحتفاظ بدلالة مفهوم الخلافة.
وهذا على العكس تماما من صاحب الجنين [القصة الثالثة من سورة الكهف]
حيث احتجزه التملك الضئيل لبعض أمتعة الحياة وزينتها... إحتجزه من التعامل مع
السماء بالنحو الذي يتطلبه مفهوم الخلافة أو العبادة على الأرض ، فيما أصبحت
نهايته آسفة على ضياع متاعه العابر : الجنتين.
إذن : القصص الثلاث ، حامت بأكملها على دلالة الحياة وزينتها ،
وطريقة الاستجابة حيالها : على النحو الذي فصلناه سابقا عند القصص الثلاث.
والآن : نواجه قصة جديدة ، هي : قصة موسى مع (العالم)... ترى : هل
تحوم هذه القصة على الحياة وزينتها ايضا؟؟ ثم ، طريقة الإستجابة حيال الزينة
المذكورة ؟؟
إن طبيعة البناء الفني أو الهندسي لمقدمة السورة : سورة أهل الكهف
تدلنا على ان هذه القصة [قصة موسى والعالم] لا مناص من ان تكون بدورها حائمة على
مفهوم (الزينة) وطريقة الاستجابة حيالها.
فما دامت مقدمة السورة { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ
أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا} [الكهف : 7 ، 8]. ما دامت هذه المقدمة حائمة على (الزينة) وطريقة
استجابتنا حيالها... وما دامت القصص الثلاث [أهل الكهف ، صاحب الجنتين ، ذو
القرنين] حائمة بأكملها على مفهوم (الزينة) أيضا ، حينئذ نتوقع ـ من خلال معايير
الفن الذي توفر النص القرآني عليه ـ أن تكون هذه القصة [قصة موسى مع العالم] حائمة
أيضا على مفهوم (الزينة) واستجابة الآدميين حيالها.
ولكن ، كيف نتبين ذلك؟
قد يبدو لأول وهلة أن قصة موسى مع العالم ، وهي قصة تحوم على واقعة
سفر نحو إحدى بقاع الأرض بصحبة أحدهم ، ثم مواجهته لأحدى الشخصيات التي قامت ببعض
الممارسات المتصلة ببناء جدار ، وإعطاب سفينة ، وقتل غلام... قد يبدو وكأن هذه
الوقائع وما رافقتها من مواقف متصلة بعلاقة موسى مع الشخصية المذكورة... تظل بمنأى
عن دلالة (الزينة) في الحياة وطريقة الاستجابة حيالها.
بيد ان التدقيق في وقائع هذه القصة ومواقفها وشخوصها وبيئتها التي
تحركت في النطاق المذكور... يدلنا على ان هذه القصة بدورها تحوم على دلالة
(الزينة) وطريقة استجابة الأبطال حيالها.
بيد أن الفارق ـ فنيا ـ بين هذه القصة والقصص الثلاث ، أن كل واحدة
من القصص الأربع ، تتناول نمطا خاصا من (الزينة) ، واستجابة خاصة حيالها : مع
ملاحظة ان كلا منها يطرح ـ في الآن ذاته ـ أكثر من مفهوم يستهدف النص القرآني
الكريم توصيله إلينا من خلال القصص الأربع.
ومن هنا ندرك قيمة (الفن) الذي نستجيب لصياغته على النحو المذكور ،
حينما نجد أن قصة موسى ـ عليه السلام ـ مع العالم ستفصح عن إبراز احدى دلالات
النبذ لزينة الحياة ، من خلال البطل (العالم). والى ان الوقائع التي رافقت سلوك
(العالم) ، تظل متجانسة ـ فنيا ـ مع الوقائع التي رافقت حياة ذي القرنين.. وإلى ان
(المواقف) الجديدة ستتلاقى مع مواقف سابقة طرحتها القصص الثلاث : توافقا أو
تضادا... وإلى أن طرحا جديدا تتوفر القصة الرابعة عليه : تماما كما توفرت القصص
الثلاث على طرح يتميز أحده عن الآخر...
كل ذلك ، من الممكن أن نلحظه بوضوح ، حين نبدأ الآن بدارسة هذه القصة
وصلتها بالقصص الثلاث, وصلة اولئك بمقدمة سورة أهل الكهف.
إن الرابطة الفنية التي تصل بين قصة [موسى مع العالم] وقصص سورة
الكهف ، تتمثل حتى موسى عليه السلام.
ان هذا (العالم) قد اخفى شخصيته ، على نحو لم يسمع به معاصروه ، وغير
معاصريه إلا في نطاق التعرف الذي يخص بعض الشخصيات التي اصطفتها السماء ، أو
التعرف الذي سمحت به السماء لغير معاصريه أو لغير المصطفين في نطاق التعرف العلمي
الصرف : من نحو ما نعرفه جميعا عن الشخصية المذكورة ، خلال رجوعنا لمصادر التفسير
أو التأريخ.
والمهم ، أن إبهام هذه الشخصية أو خفاءها عن الآخرين ، يدلنا على
أنها لم تعن بما تعنى به الشخصية الارضية عادة من البحث عن [تقدير اجتماعي] يشبع
حاجتها إليه ، بصفته أشد الدوافع البشرية لصوقا بـ(الذات).
وواضح ، ان التأكيد على الذات ، والتعريف بها أمام الآخرين ، ومنه :
التقدير أو الثناء أو المكانة الاجتماعية التي تتطلع الشخوص إليها ، يعد من أبرز
مظاهر (الزينة) الدنيوية التي يعني بها الآدميون. فإن ألغت الشخصية هذه الحاجة الى
معرفة الآخرين بها : وبخاصة إذا كانت الشخصية ذات كفاءة علمية تفوق حتى شخصية موسى
عليه السلام ،... حينئذ نستكشف بوضوح ، أن هذه الشخصية قد ألغت الحياة وزينتها من
الذاكرة تماما ، وتمحضت في نشاطها العبادي لله وحده.
وهذا كله من حيث صلة هذه الشخصية (العالم) بمقدمة سورة الكهف التي
تحوم حول مفهوم زينة الحياة الدنيا ، وطريقة الاستجابة حيالها.
* * *
أما من حيث صلتها بسائر الأبطال الذين انتظمتهم قصص سورة الكهف : ذي
القرنين ، وصاحب الجنتين ، وأصحاب الكهف ، فانها تتحدد بوضوح ، حين نوازن بين
(العالم) و(الشخوص) المذكورين من حيث طرائق استجابتهم لزينة الحياة.
فصاحب الجنتين ، يظل هو الشخصية الوحيدة التي استجابت لزينة الحياة
استجابة مريضة : على العكس من شخصية ذي القرنين التي وظفت نشاطها للسماء ، أو
شخصيات اصحاب الكهف الذين هربوا من (زينة) الحياة واتجهوا الى كهف منزو لم يتعرف
عليه الآخرون.
أما (العالم) ، فان استجابته لزينة الحياة : فواضحة تماما ، مادامت
قد (اختفت) من (الزينة) بكل أشكالها : بما في ذلك : الزينة المعنوية المتمثلة في
البحث عن [التقدير الاجتماعي] أو التعرف على (الذات).
وخارجا عن الصلة الفنية بين شخصية (العالم) ، وشخصيات القصص الثلاث
في سورة أهل الكهف ، أو صلة (العالم) بمقدمة السورة... خارجا عن ذلك ، فان هذه
الشخصية : مضافا إلى شخصيتين أخريين في قصة [موسى مع العالم] ، ونعني بهما : موسى
وصاحبه الذي رافقه في السفر ،... هذه الشخصيات الثلاث تظل ـ من جانب آخر- جزء من
المفهومات التي تطرحها القصة أمام المتلقي ، فيما تستهدف صياغة جملة من (الأفكار)
التي سنوضحها مفصلا.
لكننا قبل كل شيء ، ينبغي أن نقف على الشكل الفني للقصة ، وما تتضمنه
من عناصر جمالية في هذا الصدد.
بدأت قصة [موسى مع العالم] على النحو التالي :
{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ
الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} [الكهف : 60]
هذه البداية القصصية ، تنطوي على جملة من أسرار الجمال الفني المتصل
ببناء القصة ، ينبغي ان نقف عندها.
فأولا : بدأت القصة من عنصر (الحوار) وليس
من خلال (السرد) ، متمثلا في تلك الفقرة التي بدأت على هذا النحو : {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ } [الكهف : 60] الخ.
ثانيا : منذ اللحظة الاولى نتعرف على وجود
بطل آخر مع موسى هو : فتاه أو صاحبه.
ثالثا : نتعرف منذ البداية على (حادثة) سفر
يعتزمه موسى {لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ ..} الخ.
رابعا : نتعرف على (بيئة) قصصية معينة هي
(مجمع البحرين).
اذن : منذ البداية ، نتعرف على جملة من عناصر القص : أبطال وحوادث
وبيئات ، فضلا عن واحدة من ادوات القص : الحوار.
كل ذلك يتم من خلال فقرة حوارية واحدة بدأتها القصة.
ومما لا شك فيه ، أن المتلقي الذي يمتلك خبرة فنية في عملية التذوق
القصصي ، يدرك جمالية أو خطورة مثل هذه الفقرة الحوارية المكتنزة بعناصر القص.
ويعنينا الآن بعد التعريف بالعناصر المذكورة ، ان نتبين قيمة هذه
(البداية) القصصية ، وما ترهص به من احداث ومواقف وبيئات لاحقة ، يظل بعضها موشحا
بالإبهام الفني الجميل ، وبعضها الآخر : يأخذ (تفصيلات) محددة ، تكشف الاجزاء
اللاحقة من القصة عنها كما سنرى.
إن اول يواجه المتلقي في هذه (البداية)
القصصية هو : غموض الموقف حيال شخصية موسى. ترى : ماذا يستهدف موسى من اعتزامه
السفر نحو مجمع البحرين.
ثانيا : من هو هذا (الفتى) الذي وجه موسى
خطابه إليه ؟؟
ثالثا : ما دلالة هذا (الزمن) الذي يمتد
(حقبا) أي : أعواما من السفر ، بحيث يحرص موسى ـ عليه السلام ـ عليه بهذا النحو من
الحرص؟
هذه الأسئلة تواجه المتلقي منذ البداية.
ومع أن احداث القصة ، ستجيب على هذه الأسئلة ،... ومع ان نصوص
التفسير ستكشف جانبا من الغموض الفني الذي يحيط بهذه (البداية) القصصية... ألا ان
المتلقي يظل بطرحه الأسئلة المذكورة ، مساهما بشكل أو بآخر في عملية [الكشف النفي]
بما سيستخلصه ، بعيدا عن نصوص التفسير ، من دلالات متنوعة في نطاق التذوق الجمالي الصرف.
إن اهم ما يواجه المتلقي فيما يتصل بشخصية (الفتى) هو :
طبيعة الدور الثانوي لهذا البطل في القصة : هل انه صحب موسى ـ عليه
السلام ـ لمجرد ضرورة وجود الصاحب في الطريق؟ أم أنه صحبه : بغية ان يخدم موسى
عليه السلام؟ أم انه يجسد عنصرا ستكشف القصة عن انه كان ضروريا لتذكير موسى ـ عليه
السلام ـ ببعص ملابسات الموقف مما يعد ضرورة فنية؟ أم انه صحبه ليفيد من العالم
أيضا؟؟...
لاشك ، ان نصوص التفسير قد لا تجيب على الأسئلة المذكورة جميعا ،
بقدر ما تحوم على دلالة (الخدمة) ، أو افادة كليهما من العالم الذي سيواجهما. غير
ان المتلقي يستطيع ان يستكشف دلالات أخرى سنقف عليها مفصلا.
والأمر ذاته فيما يتصل بالبيئة التي أسماها النص بـ(مجمع البحرين) ،
وعلاقتها بطول السفر الذي حدده موسى عليه السلام ، أو أعلن عن اعتزامه لقطع
الأعوام الطوال من خلاله : بغية الوصول إلى (الهدف) الذي أعلنت القصة عنه فيما
بعد.
إن استكشاف الدلالات المتنوعة لهذه البيئة ، وتلك الشخصية ، فضلا عما
سنواجه من بيئات وأبطال آخرين ، متآزرة مع نصوص التفسير ، ستعمق ـ دون ادنى شك ـ
من جمالية التذوق لهذه القصة.
بدأت قصة [موسى والعالم] بالفقرة الحوارية {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا
أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} [الكهف : 60] .
ومثلما رأينا ، فإن هذا القسم من القصة ، دلنا على شخصيتين هما :
موسى والفتى. كما دلنا على عملية سفر نحو مجمع البحرين : دون ان ندرك دلالة هذا
السفر وهدفه ونتائجه.
ومع القسم الثاني من القصة ، فيما يشكل امتدادا للبداية ، أو التمهيد
الذي ترسم فيه ، ملامح عامة عن الابطال والبيئات والاحداث والمواقف التي تأخذ
تفصيلاتها فيما بعد... مع القسم الثاني من القصة نبدأ بمواجهة التفصيلات الجديدة
لعملية (السفر) ، كما نبدأ بالعثور على شخصية حيوانية ، سيكون لها تأثيرها الكبير
على سير الأحداث.
اذن ، لنقرأ هذا القسم :
{فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ
سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا} [الكهف : 61]
هذه الفقرة من (السرد) تحفل بتطوير للأحداث ، وبإرهاص جديد بها. فقد
كشفت لنا عن ان موسى ـ عليه السلام ـ وفتاه قد قاما بسفرتهما فعلا ، ووصلا الى
الموقع الذي يستهدفانه.
بيد أن القصة مع وصولها بالأحداث الى هذا الموقع ، تجابهنا بمفاجأة
هي : نسيان الحوت. وبرسمها لهذا العنصر المفاجئ ، ترتد بنا القصة الى الوراء ،...
أو بكلمة أخرى : برسمها لظاهرة (الحوت) تنهض القصة بمهمتين فنيتين مزدوجتين :
المهمة الاولى : هي ادخال عنصر جديد من عناصر القصة : يعد تكملة
للتمهيد الذي يتضمن ـ عادة ـ رسوما مجملة لعناصر القصة التي ستتحرك ظمنها ، ومنها
: عناصر الأبطال أو البيئات ، حيث تجيء شخصية (الحوت) بطلا ثالثا في القصة لا ندرك
مهمته الثانوية بقدر ما نتعرف في البداية على مجرد كونه عنصرا له دوره في القصة.
المهمة الثانية : هي إدخال عنصر جديد من عنصر القصة : ليس من حيث
كونه تكملة للتمهيد القصصي ، أو للفصل الاول الذي يتضمن عادة : التعريف بعناصر
القصة ، وجزء من حركة الأبطال فيها ، بل من حيث كونه تقطيعا للأحداث ، وعودة الى
بداياتها ، حتى تستكمل القصة من خلال التقطيع والعود ، صياغتها الكاملة في نهاية
المطاف.
ومن الواضح ، ان هذا المنحى في صياغة القصة, ينطوي على إمتاع جمالي
كبير يتحسس المتلقي بجماليته الفائقة ، حينما يجد ان النص قد وفر له إمكانات
التذوق بهذا النحو الذي يجمع بين إعطاء الملامح العامة لتحركات القصة وبين ارتداده
الى بداية القصة بعد أن يسرد طرفا منها. وهذا ما لحظناه عندما أعطت القصة ملامح
السفر ، وشخصيتي موسى ـ عليه السلام ـ والفتى : ثم ارتدت الى الوراء لتقدم لنا
ملمحا عن (الحوت) وصلته بعملية السفر : بعد ان أنهت عملية السفر ، ووصلت بموسى ـ
عليه السلام ـ وفتاه الى مجمع البحرين.
للمرة الجديدة ، ينبغي الا نمر عابرا على هذا المنحى القصصي ومعطياته
الجمالية بالنسبة للمتذوق الذي خبر طرائق الأدب القصصي في هذا الميدان.
ولنعد ، إلى ظاهرة (الحوت) ، وتحديد موقعها من القصة ، مستعينين
بنصوص التفسير التي لا مناص من التوكأ عليها لمعرفة البعد الفني للظاهرة المذكورة.
لكننا قبل ان نرتكن الى النصوص المفسرة ، نتساءل :
هل ثمة امكانات لاستخلاص الدلالة الفنية لظاهرة (الحوت) دون الارتكان
للنصوص المفسرة؟؟
ان المتلقي من الممكن أن يستخلص بعض الدلالات الغامضة لهذا الحدث :
حدث الحوت وانسرابه في البحر. لكنه ، يتعين عليه ان يتابع الجزء الثالث من القصة.
ولنقرأ :
{فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ
سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} [الكهف : 62 - 64]
إن هذا القسم من القصة [وهو قسمها الثالث] سنقف عليه مفصلا ،...
لكننا الآن لا نستهدف منه ، إلا ظاهرة (الحوت) وامكان استخلاص فنى صرف حيال مهمة
(الحوت) في القصة. ان القارئ أو السامع ، سيدرك بنحو غامض ، ان (الحوت) يشكل ـ على
الاقل ـ علامة أو دليلا على نمطين من التحركات داخل القصة...
فأولا : ثمة صلة بين (الحوت) وبين تناول الغذاء.
وثانيا : ثمة صلة بين الصخرة التي وقف عندها موسى ـ عليه السلام ـ
وفتاه ، وبين نسيان (الحوت) هناك ، وبين هدف الرحلة التي قام بها موسى ـ عليه
السلام ـ وفتاه.
وبكلمة جديدة : ان رسم (الحوت) ينهض بمهمتين مزدوجتين ، تتداخلان :
واحدة مع الاخرى ، هما : مهمة (الزاد) الذي لا مناص من تهيئته لموسى ـ عليه السلام
ـ وفتاه ، ومهمة انسراب (الزاد) وإفلاسهما منه ، وصلة هذا الانسراب مهمة الرحلة
الغامضة.
المتلقي ، لا يمتلك سوى هذا النمط من الاستخلاص ، مع ملاحظة انه سيقف
ذاهلا عن إدارك العلاقة بين الزاد وانسرابه عنهم.
والمهم ، ان (الرحلة) ما دامت محفوفة بضبابية تتكشف عنها الاحداث
لاحقا ، فإن لواحقها ستظل محفوفة بالضباب الفني ايضا فيما يستكشف بدوره مع متابعة
القصة حتى نهايتها كما سنرى.
إلا أن الصلة بين الانسراب وهدف الرحلة تظل على غموضها ، مما يتعين
علينا أن نتجه الى النصوص المفسرة : بغية تجليتها.
ومع ذلك ، فإن خطورة مثل هذه القصة الفنية الممتعة ، تظل مرتبطة بما
تتضمنه القصة من ضبابية ممتعة ، بمقدور المتلقي ان يتذوق جماليتها ، وأن يستكنه
أسرارها ، ويستخلص دلالاتها ولو على نحو مجمل ، وهو ـ دون ادنى شك ـ يعود على
المتلقي بفائدة فنية وفكرية لها أهميتها في ميدان التذوق.
ان المتلقي بمقدوره ان يستخلص من القصة بأكملها ، أن موسى ـ عليه
السلام ـ قد واجه (العالم) في رحلته التي استهدف منها ، تلك المواجهة. والى ان
(الحوت) كان بمثابة علامة لموقع المواجهة المذكورة. والى ان ذلك قد اقترن بظاهرة
اعجازية هي : انسراب الحوت في البحر ، بعد ان هيأ الحوت زادا لرحلة لا يعلم أمدها.
هذا الاستخلاص من الممكن ان يتم على النحو المذكور ،... ومن الممكن
ان يتم على أشكال أخرى ، يقترن فيها الحدث العادي مع الحدث المعجز ،... ويقترن
فيها الوضوح مع الضبابية ،... مثلما تقترن فيها البيئة العادية مع البيئة الجميلة
التي تمثل الصخر ، والحوت ، والماء ، والبحر الذي ينسرب الحوت فيه ، وما يواكب هذا
الانسراب من تخيل لما هو غير مألوف... الخ...
كل ذلك ، من الممكن ان يستخلصه المتلقي ، كما قلنا.
بيد ان الرجوع الى النصوص المفسرة ، سيلقي مزيدا من الإنارة على
الاستخلاصات المذكورة ، مما تثري عملية التذوق الفني كما سنرى ذلك.
تحتل ظاهرة (الحوت) في قصة [موسى والعالم] أهمية فنية ، في تأثيرها
على رحلة موسى عليه السلام ، وفي تطويرها للأحداث.
فلو عدنا الى النصوص المفسرة ، للحظنا ان (الحوت) كان بمثابة (دليل)
لموسى ـ عليه السلام ـ في رحلته نحو مجمع البحرين بحيث يدله على (العالم) الذي
استهدفته رحلة موسى عليه السلام.
بيد ان هذه النصوص لم تسرد لنا تفاصيل المهمة التي أوكلت الى (الحوت)
بقدر ما يمكننا ان سنتخلص بعضها في الأجزاء اللاحقة من القصة.
إن المهم ـ ونحن في القسم الثاني من القصة ـ ان نلحظ مع نمو القصة
وجود بطلين وحوت ورحلة ، وان الرحلة قد تمت بوصول البطلين موسى ـ عليه السلام ـ
وفتاه ، إلى مجمع البحرين.
لكن الذي حدث هو : ان البطلين قد (نسيا) حوتهما ، وإلى ان الحوت قد
اتخذ سبيله في البحر سربا.
وتقول النصوص المفسرة ان (الحوت) وثب في البحر ، والى انه ترك أثرا
في انسرابه ، متمثلا في جمود ذلك.
ومع متابعتنا للقسم الثالث من القصة ، تبدأ الاحداث بالتكشف ، ونبدأ
بمواجهة تفصيلات جديدة عن مهمة (الحوت) وصلتها برحلة موسى عليه السلام.
فلقد جاوز موسى ـ عليه السلام ـ وفتاه ، مجمع البحرين : الموقع الذي
يستهدفه موسى ـ عليه السلام ـ واحس عندها بالجوع والتعب :
{فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا}
فأجابه الفتى عندئذ :
{قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ
سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا} [الكهف : 62 ، 63] .
ان اجابة الفتى تكشف لنا عن ان البطلين قد وصلا الى موقع ما : عند
الصخرة. والى انهما قد نسيا (الحوت) هناك ، والى انه قد وثب الى البحر بنحو عجيب.
وعندها ، يخاطب موسى ـ عليه السلام ـ فتاه :
{ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا}.
هذه الاجابة ، توضح لنا أن موسى ـ عليه السلام ـ كان مستهدفا ـ في
رحلته ـ ذلك الموقع عند الصخرة ، وإلى ان ثمة صلة بين الموقع المذكور وبين انسراب
الحوت في البحر ، وإلى ان الانسراب هو (العلامة) التي ينبغي أن يقف عندها في تحقيق
هدفه من الرحلة ،... ولذلك رجع موسى وفتاه إلى نفس الموقع الذي انسرب الحوت منه ،
بعد أن جاوزاه.
بهذا القسم من القصة ، ينتهي شطرها الاول ، أو لنقل : ستنتهي مقدمات
(الهدف) الذي شدت الرحلة من أجله.
ثم يجيء شطرها الثاني : وقد التقى فيه موسى عليه السلام ، العالم ،
وتمت بينهما محاورات سنقف عندها ، مصحوبة بأحداث مدهشة ، ندرك من خلالها جميعا
(هدف) الرحلة التي قام بها موسى عليه السلام.
ان ما نعنى به الآن هو : ان نقف مع الشطر الاول من القصة : لنتعرف
على بناءها الفني ، وشخوصها وبيئتها وأفكارها. ثم نتجه الى شطرها الآخر بعدئذ.
ولعل معرفة (الأفكار) في القصة ، تظل متسمة بأهمية كبيرة ، ما دامت
الرحلة أساسا قائمة على بلوغ (هدف) فكري لموسى ـ عليه السلام ـ : آن لنا ان نتحدث
عنه ، قبل ان نتجه الى خصائص الشكل الفني للقصة.
تقول النصوص المفسرة ان السماء عندما منحت موسى ـ عليه السلام ـ عطاءات
كثيرة : بدء من ظواهر الاعجاز المتمثلة في : العصا ، واليد ، وفلق البحر ،...
مرورا بظواهر الطوافان والدم والجراد والضفادع والقمل ونحوها مما عوقب به قوم موسى
عليه السلام ، نتيجة لتمردهم عليه ،... وانتهاء بقضية تكليمه ونزول الألواح عليه :
تلك الألواح التي كتب فيها {مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ...}
عندها ، داخل موسى ـ عليه السلام ـ ـ كما تقول النصوص المفسرة ـ شيء
من الزهو أو العجب : حيث حاور نفسه قائلا بما مؤداه : (لم يخلق الله أحدا أعلم
مني).
ونتيجة لهذا الإحساس ، أرادت السماء أن تطلعه على حقيقة الأمر ،
فأوحت الى جبرئيل أن يتدارك موسى ـ عليه السلام ـ وأن يعلمه بان عند ملتقى البحرين
عند الصخرة (رجلا) هو أعلم من موسى عليه السلام ،... فليذهب إليه ، وليتعلم منه.
وعندها أحس موسى ـ عليه السلام ـ ـ كما تقول النصوص المفسرة ـ بخطأ
إحساسه المذكور ، ودخله الرعب من ذلك. وأخبر وصيه يوشع بن نون بالأمر ،... وعزما
على القيام بالرحلة نحو مجمع البحرين ، للافادة من (العالم) الذي أشارت السماء
إليه.
إذن : هدف (الرحلة) ، ـ ومن ثم ـ هدف القصة أساسا هو : تقرير حقيقة
مؤداها : ان الزهو العلمي مثلا ، ينبغي إلا يداخل اية شخصية عبادية ، بل ينبغي ان
تتحسس الشخصية ـ أيا كانت ـ بمشاعر الذي داخل الذات.
وهذا : في حالة انسياقنا مع النصوص المفسرة الذاهبة الى أن موسى ـ
عليه السلام ـ قد داخله الزهو المذكور.
اما في حالة انسياقنا مع عملية التذوق الفني الخالص ، فإنه يمكننا ـ
بعيدا عن نصوص التفسير ـ ان نستخلص حقيقة ذات خطورة ، هي : ان السماء ـ وفقا
لحكمتها ـ تمنح بعض الشخصيات العبادية عطاءات خاصة ، قد لا تمنحها للبعض الآخر :
سواء أكانت هذه الشخصيات متماثلة في الوظيفة الاجتماعية التي رسمتها السماء لهم ،
أم كانت متفاوته : كأن يكون بعضها على مستوى النبوة ، والآخر : غائبا عن أنظار
الناس لا يعرفه أحد منهم.
وهذه الحقيقة الفنية التي تنطق بها حوادث القصة نفسها ، عبر ملاحظتنا
لموسى [ في الشطر الثاني من القصة كما سنرى] أنه كان ينكر على (العالم) قتله لأحد
الاشخاص ، وخرقه للسفينة ، وابتناءه للجدار... هذه الحقيقة ، قد اشارت إليها بعض
النصوص المفسرة ايضا ، في ذهابها إلى ان موسى ـ عليه السلام ـ عندما التقى العالم
، وطلب ان يتبعه ليتعلم منه ، اجابة (العالم) حينئذ بما مؤداه : [أنك يا موسى قد
وكلت بعلم لا أطيقه ، ووكلت بعلم لا تطيقه]. وهذا يعني ان السماء تمنح هذه الشخصية
أو تلك ، عطاءات خاصة لا تمنحها لآخر ، وفقا لحكمة يتطلبها الموقف.
وأيا كان الأمر ، فإن استخلاص الحقيقة الفنية المذكورة ، مشفوعة
بالنصوص المفسرة ،... فضلا عن الحقيقة التي ذكرتها النصوص الذاهبة الى تفسير سبب
الرحلة نحو العالم ، متمثلا في الزهو العلمي ،... كل ذلك من الممكن ان يشكل
(أفكار) القصة ، و(هدفها) الفني : بحيث توظف عناصر القصة ، من شخصيات ، واحداث ،
ومواقف ، وبيئات : لإنارة (الهدف) المذكور ، تجليه أبعاده.
والآن : لنرى ، كيف وظفت العناصر الفنية المذكورة ، في صياغة
(الافكار) التي طرحتها القصة ؟ .
ونبدأ بالحديث عن (أبطال) القصة
في قصة [موسى والعالم] نواجه شخصيتي موسى ـ عليه السلام ـ وفتاه.
أما الفتى فقد سبق الوقوف عند ملامحة عابرا.
ونحن الآن حينما نحاول إلقاء الانارة على هذه الشخصية مفصلا ، فالنص
القصصي قد (أبهم) ملامحها تماما ، مكتفيا من ذلك [من حيث التعريف بها] بإطلاق سمة
(الفتى) عليها.
إن الرجوع الى النصوص المفسرة ، يدلنا على ان (الفتى) هو : يوشع بن
نون وصي موسى عليه السلام.
والسؤال هو : ما هو الدور الثانوي لهذه الشخصية في القصة ؟
مما لا شك فيه ، ان لهذه الشخصية دورا فنيا كبيرا في الاقصوصة. ومن
حيث البدء ، فإن القيام برحلة مجهولة المدى ، يتطلب وجود صاحب ، يمسح الوحشة ـ على
الاقل ـ عن موسى عليه السلام.
وهذا هو اول مسوغ لوجود هذه الشخصية في الأقصوصة.
ثانيا : إن وجود الصاحب من أجل خدمة (المسافر) ، يفرض وجود دور له في
الأقصوصة ، وبخاصة ان الأقصوصة رسمت له دورا محددا هو : تهيئة (الزاد).
ثالثا : ان مجرد كون الفتى (وصيا) لموسى عليه السلام ، يتطلب أن يصطحبه في
رحلة علمية عبادية هادفة ، لان ذلك في الصميم من متطلبات الوصاية.
ومن اجل ذلك نجد ، ان النصوص المفسرة تومئ إلى هذه الدلالة حينما
يقرر بعضها أن موسى ـ عليه السلام ـ قال لوصيه غداة عزمه على السفر بما مؤداه : يا
يوشع لقد (ابتليت) ، فلنصنع لنا زادا.
وبالرغم من ان هذا القول يحوم على دلالة [الخدمة : صنع الزاد] ، إلا
انه يتضمن ايضا دلالة أخرى هي قوله : (قد ابتليت). فالابتلاء هنا يعني ان موسى ـ
عليه السلام ـ قد أطلع وصيه على المهمة العبادية التي أوكلت إليه ، مما يتعين ان
يقف عليها يوشع ما دامت مرتبطة بشؤون العمل العبادي وما يواكبه من سلوك ينبغي ان
يتحلى به أبطال يضطلعون بمهمة الخلافة : من حيث تقدير ذواتهم ، والتحذير من خلع
سمات غامضة على (الذات) الشخصية.
وعندما يصطحب موسى ـ عليه السلام ـ فتاه ، حينئذ يكون (الوصي) قد
افاد من (التجربة) التي ستقدمها الرحلة لموسى عليه السلام.
إذن : ثمة مسوغات متنوعة تجعل لشخصية (الفتى) اكثر من دور قصصي في
الأقصوصة.
على ان أهم دور ثانوي لشخصية (الفتى) في الأقصوصة ، مما لم نشر إليه
، هو : الدور الفني الذي هيأه النص للفتى ، من حيث تأثيره على (حركة) القصة :
مواقف وأحداثا.
إن (حركة) القصة قد تأثرت ـ أساسا ـ بسلوك (الفتى) مما شكلت انعطافا
فنيا ملحوظا في الرحلة.
وملاحظة هذا الجانب في الأقصوصة ، له أهميته القصوى في تذوق الصياغة
الجمالية لها.
فمن الواضح ، ان موسى ـ عليه السلام ـ عندما اعتزم الرحلة ، انما وضع
في الاعتبار (مكانا) محددا هو : مجمع البحرين : بصريح النص القصصي.
كما أن النصوص المفسرة ، رسمت (علامة) لموسى ـ عليه السلام ـ هي. :
إنسراب الحوت إلى البحر ، مما يدله على (مكان) العالم الذي شد الرحيل من أجله.
ونحن قد لحظنا ، أن موسى ـ عليه السلام ـ وفتاه قد تجاوزا ذلك المكان
الذي قد اعتزما أن يصلا إليه ، ذلك : انهما وصلا ـ حسب النصوص المفسرة ـ إلى
(صخرة) في أحد الأمكنة ، حيث استراحا عندها ، وحيث غسل الفتى (الحوت) ووضعه هناك.
ثم تابع موسى ـ عليه السلام ـ وفتاه ، رحلتهما. لكنهما نسيا (الحوت)
عند الموضع المذكور.
ولذلك ، عندما أحس موسى ـ عليه السلام ـ بالجوع ـ كما تقول النصوص المفسرة
ـ طالب فتاه بتهيئة الطعام. لكن الفتى (تذكر) ان الحوت قد بقي في (المكان) الذي
استراحا عنده ، وتذكر أنه قد انسرب الحوت من يده.
وعندها قال موسى لفتاه : لنعد الى حيث استرحنا ، فإنه هو (المكان)
الذي نتوخاه.
إذن : عملية (النسيان) و(التذكر) تركا ـ في حركة القصة ـ انعطافا
كبيرا بالنسبة الى بلوغ (الهدف) لدى موسى ـ عليه السلام ـ.
وهذا [الانعطاف في حركة القصة] قد تأثر بسلوك (الفتى) كما رأينا. إذ
ان (الفتى) هو الذي (ذكر) موسى ـ عليه السلام ـ بالمكان الذي جاوزاه ، مما جعله
يعود الى حيث المكان الذي استراحا عنده.
وليس (التذكر) الذي أسهم في حركة القصة ، هو الذي اضطلع به (الفتى)
فحسب ، بل إن عملية (مشاهدته) لانسراب الحوت ، قد ساهم في الحركة المذكورة ايضا ،
ما دام الانسراب هو (المعلم) الذي سيدل موسى ـ عليه السلام ـ على (العالم).
وللمرة الجديدة ، ينبغي ألا نغفل عن هذا الدور الفني الذي فرض وجود
(الفتى) في صياغة الأقصوصة ، مما يجعلنا ـ عبر عملية التذوق الجمالي ـ في زخم
إمتاع كبير للصياغة القصصية المذكورة : في رسمها لأدوار البطل الثانوي : الفتى.
وحين نتجاوز شخصية (الفتى) إلى الأبطال الآخرين في القصة. نجد ان
(موسى) و(العالم) يحتلان مساحة كبيرة ورئيسة في القصة.
وبما اننا لا نزال مع الشطر الاول من القصة ، أي : مع (الرحلة) فقط ،
فسنؤجل الحديث عنهما إلى حيث وقوفنا على الشطر الآخر من القصة ، ونعني به : مواجهة
موسى ـ عليه السلام ـ للعالم ، وما واكبها من احداث ومواقف.
أما في نطاق (الرحلة) وما يواكبها من أبطال فان ظاهرة (الحوت) من
الممكن أن نعدها من جانب [عنصرا شخصيا] ، كما يمكن ان نعدها [عنصرا بيئيا] من جانب
آخر.
والمسوغ الفني يعد (الحوت) (شخصية) : كأي بطل آخر (يتحرك) من خلال
(الحياة) التي تدب فيه ، هو : عودته (حيا) وانسرابه إلى البحر.
ولكن ، بما ان الحوت لم يتحرك من خلال [علاقة متبادلة] مع الأبطال
الآخرين ، فحينئذ من الممكن ان نعده [عنصرا جامدا] مما يدخل في نطاق (البيئة) التي
تخصص لها حقلا آخر من المعالجة.
وأيا كان الأمر ، فإن هذا التأرجح بين امكانات الحوت (شخصيا)
وامكاناته (بيئيا)... هذا التأرجح ـ في تصورنا الفني ـ يعد واحدا من (جماليات) هذه
الأقصوصة المدهشة ،... الممتعة ،... المعجزة...
فالحوت تحرك كما يتحرك أي كائن حيواني ، منسربا إلى البحر على نحو ما
سنتحدث عنه لا حقا.
كما انه احتفظ بعنصر (السكون) الذي يغلف الحيوان المذكى.
لكنه ، بين الحركة والسكون ، اتخذ مظهرا مصحوبا بمشاعر الدهشة
والانبهار حيال (وجوده) في القصة.
من هنا ، سنفرد له حديثا خاصا يمتزج فيه عنصر (الأبطال) بعنصر
(البيئة) ، وبخاصة ان (وجوده) في الأقصوصة ، يشكل (المنعطف) الرئيسي فيها :
العلامة الوحيدة في رحلة موسى ـ عليه السلام ـ نحو العالم.
قلنا ، ان ظاهرة (الحوت) في قصة موسى ـ عليه السلام ـ مع العالم ،
تحتل حركة حية في الأقصوصة.
وبعض النظر عن كونها ظاهرة تتصل بشخصية حيوانية ساكنة ، ونقلابها الى
شخصية حيوانية متحركة ،... بغض النظر عن ذلك ، فإن (وجودها) في القصة ، يشكل عنصرا
له أهميته الموضوعية والفنية الكبيرة ، نظرا لمساهمته في تغيير مجرى الاحداث ، بل
في تحديد المنطلق إلى الرحلة أساسا.
والآن : لنتابع تفصيلات هذا العنصر من خلال النص ، والتفسير ،
والتذوق الفني الصرف.
إن النص القصصي لم يسرد لنا عن (الحوت) إلا ظاهرة (النسيان) الذي غلف
الفتى عندما ذكره موسى ـ عليه السلام ـ بالطعام. وإلا كونه قد انسرب في البحر ،
والا كونه قد اتخذ سبيله في البحر عجبا.
أما نصوص التفسير ، فتسرد لنا تفصيلات متنوعة قد يتوافق بعضها مع
الآخر ، وقد لا يتوافق : لكنها جميعا تحمل دلالات واضحة الاستخلاص حينا ، ودلالات
يصعب الركون الى استخلاص بعضها ، حينا آخر.
بيد ان الملاحظ أن (الصمت) يظل واضحا حيال تفسير الخطوة البادئة في
مهمة الحوت. أما مهمة الحوت في مراحلها الأخيرة ، فواضحة كما قلنا.
نصوص التفسير ، تذكر لنا أن موسى ـ عليه السلام ـ قد ألهم بأن يتزود
بحوت يدله على (العالم) الذي شد الرحيل من أجله.
وخارجا عن هذه الاشارة لا نظفر بتفصيلات عن الحوت إلا في قضية
انسرابه الى البحر.
والسؤال هو : هل ان التزود بالحوت كان يحمل مهمة مزدوجة هي : كونه
(زادا) من جانب ، وكونه (معلما) يرشد موسى ـ عليه السلام ـ الى (العالم) من جانب
آخر؟؟
إن الاجابة على هذا السؤال ، من الصعب أن تتسم باليقين إذا افترضنا
أن (الطعام) و(الارشاد) لا يمكن ان يتحققا في آن واحد. فاذا كان (الحوت) قد اعد
للطعام ، فحينئذ ينتفي وجوده المرشد الى الطريق ، لانه قد ازدرد أساسا.
أما إذا كان (الحوت) معدا إلى (الارشاد) ، ولا علاقة له بالطعام ،
فإن التداعي الذهني الذي اوضحته القصة ، يظل بلا دلالة : ذلك أن القصة أوضحت ان
موسى ـ عليه السلام ـ طالب بالطعام ،... واجابه يوشع (الفتى) بانه قد نسي الحوت.
وهذا يعني بما لا لبس فيه ان التداعي الذهني لدى الفتى يرتبط بالطعام ، أي يكون
(الحوت) هو الطعام الذي طالب به موسى ـ عليه السلام ـ عندما أحس بالجوع.
اذن : يتعين ان يكون الحوت قد أعد للطعام.
ومما يعزز هذا الذهاب أن بعض النصوص المفسرة ، تذكر لنا ان الحوت كان
(مشويا) ، مما تتعين مفروضية كونه (زادا).
ومع هذه المفروضية يثار السؤال على نحو آخر :
هل أن موسى ـ عليه السلام ـ قد ألهم بنحو مجمل بأن يتزود بحوت والى
أنه ـ بشكل أو بآخر ـ سيدله على الطريق؟؟ وبخاصة ان بعض النصوص تشير الى ان الصخرة
هي التي ستكون الدليل الى الهدف.
هذا الاحتمال غير بعيد ، دون ادنى شك ، ما دامت بعض النصوص تشير
إليه.
وقد يرد احتمال آخر هو : ان موسى ـ عليه السلام ـ نفسه قد أمر بأن
يصوغ طلبه الى فتاه بالنحو المتقدم : وهو على إحاطة بتفصيلات لم يدركها يوشع.
كل ذلك ، من الممكن أن نستخلصه من المهمة المزدوجة لظاهرة (الحوت)
،... لكننا في نهاية المطاف ، نظل ـ في عطش فني ـ لمعرفة التفصيلات المشفوعة
بالاطمئنان لهذا الاستخلاص أو ذاك.
وهذا العطش بذاته : رواء فني تثرى ـ من خلاله ـ احاسيسنا بعمليات
الاستخلاص والاستنتاج والتخيل والمحاكمة وسائر العمليات العقلية العليا ، فيما لا
يمكنها ان تغنى وتثرى وتنمو إلا اذا سمحنا لها بممارسة (الكشف) الذاتي في تفسير
الظواهر واستخلاص دلالاتها. هذا فضلا عما تنطوي العمليات المذكورة عليه من إمتاع
جمالي صرف كما هو واضح.
ولنتابع سائر التفصيلات المتصلة بظاهرة (الحوت).
ترسم النصوص المفسرة ، ملامح خارجية للحوت : من حيث مقدمات الرحلة.
فهي تصف الحوت حينا بأنه كان (مملحا) ، وترسمه حينا بانه كان (طريا) ، وترسمه حينا
ثالثا بانه كان (مشويا) ، وترسمه أخيرا بانه قد وضع في (مكتل) أي : الاداة
المصنوعة من الخوص ونحوه مما يحمل الطعام فيه.
هذه الملامح الخارجية للحوت ومكانه ، لم يسردها النص القصصي ، مما
يعني انها لا تشكل ضرورة فنية من حيث البناء العضوي للأقصوصة. اذ انه من الواضح ،
ان النص القرآني الكريم حينما يرسم لنا ملمحا خارجيا ، فان رسمه لهذه الملمح لا بد
ان يرتبط بدلالة (داخلية) ، أي : ان تكون هناك صلة بين الخارج والداخل. فاذا أهمل
الرسم الخارجي ، فهذا يعني ان الرسم المذكور ، لا ضرورة فنية له.
لكننا خارجا عن ذلك كله ، يمكننا ان نستخلص بعض الدلالات المتصلة
بالرسم الخارجي الذي ذكرته النصوص المفسرة ، وبخاصة إذا اخذنا بنظر الاعتبار ، ان
بعض التفصيلات التي يهملها القرآن الكريم ، انما يتركها لخبراتنا الخاصة في
استكشافها.
ومهما كان ، فانه من المحتمل ان تكون الاوصاف الخارجية المذكورة ،
على صلة بحفظ الحوت أو تطيبه ونحوهما مما هو مألوف في هذا الصدد.
هذا كله فيما يتصل بمقدمات الرحلة وصلتها بالحوت.
أما فيما يتصل بالرحلة ذاتها ، فان ظواهر الدهشة والطرافة والاعجاز
تظل مواكبة لحركة (الحوت) طوال الرحلة الممتعة في التذوق الفني ، أو الرحلة الشاقة
في تصورنا العبادي والفني في آن واحد.
ان أول خطوة لافتة للانتباه في ظاهرة الحوت : خلال الرحلة ، تتمثل في
وصول موسى ـ عليه السلام ـ وفتاه الى مجمع البحرين. وتعاملهما مع الحوت في الموقع
المذكور.
النصوص المفسرة تقدم لنا تفصيلات قد يختلف بعضها عن الآخر في هذا
الصدد.
بعضها يذهب الى ان موسى ـ عليه السلام ـ وفتاه عندما وصلا الى مجمع
البحرين ، استراحا عند صخرة على الساحل. وعندها أخرج الفتى الحوت وغسله بالماء
ووضعه على الصخرة المذكورة : ثم تابعا مسيرهما ، بعد أن نسي الفتى ، الحوت هناك.
بعضها الآخر يقول : ان الفتى غسل الحوت عند عين هناك ، لكن العين أو
الينبوع المذكور يتسم بكونه حاملا لخصيصة الإحياء ، ويسمى [عين الحياة]. ولذلك ،
انفلت الحوت من يد الفتى بمجرد غلسه ، فنسيه بعد ذلك ، وتابعا رحلتهما.
وهناك نصوص مفسرة ثالثة ، تذهب الى ان قطرت من الماء قطرة في
(المكتل) فاضطرب الحوت ، وانسرب الى البحر.
وأيا كان الأمر ، فان ما يعنينا من ذلك كله ، أن نتابع اول (حركة)
حيوية تواكب (الحوت) في رحلة موسى ـ عليه السلام ـ وفتاه ، وأن نتبين الملامح
الجمالية والفكرية للحركة المذكورة. تظل حركة الحوت في قصة موسى ـ عليه السلام ـ
والعالم متميزة بخصيصتين من الرسم ، هما :
(الجميل) و(المعجز).
ويتمثل كل من (الجميل) و(المعجز) في انسرابه الى البحر على نحو ما
رسمته القصة في موقعين ، احدهما :
{فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا} [الكهف : 61]
والآخر :
{وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا} [الكهف : 63]
وحين نتوكأ على النصوص المفسرة ، نجدها تقدم تفصيلات عن (الجميل)
و(المعجز) ، بالغة الاثارة.
فالنصوص ترسم كلا منهما في حركتين :
الاولى : حركة (الإحياء).
الثانية : حركة (لانسراب).
أما حركة (الاحياء) فقد قدمتها النصوص في ثلاثة أنماط :
1 ـ احياء الحوت بنحو مبهم بحيث لم يخضع للمشاهدة إلا بعد رجوع موسى
ـ عليه السلام ـ وفتاه إلى مجمع بينهما ، واتباعهما أثر الحوت : حيث اكتفت النصوص
برسم عملية غسل الحوت ونسيانه عند الصخرة ، دون ان تتحدث عن كيفية الأحياء.
2 ـ احياؤه داخل (المكتل) : وذلك بان قطرت من الساحل الذي وقفا عنده
او من وضوء الفتى ، قطرة داخل (المكتل) فاضطرب الحوت ، وانسرب الى البحر.
3 ـ احياؤه من خلال عملية الغسل : وذلك عندما غسله الفتى عند عين
هناك ، فانفلت الحوت من يده بعد أن مسه الماء.
ويلاحظ : ان (الجميل) و(المعجز) عبر العملية المذكورة : (الإحياء)
يتمثلان في : إضطراب (الحوت) وحركته ووثوبه ، بما يصاحب ذلك عنصر (الدهشة) أو
(المفاجأة) التي تغلف المشاهد [وهو يوشع] ، أو : تغلف المتلقي وهو على جهل تام
بأسرار الموقف : بخاصة أن النص القصصي نفسه لم يسرد تفصيلات عن ذلك.
وقد رسمت النصوص ـ مضافا الى عملية الإحياء ـ مصادر العملية المذكورة
، متمثلة في ما أسمته بـ[عين الحياة] ، حيث أكدت [خصيصة متميزة] للعين المذكورة ،
وهي :
تضمنها عنصرا (إحيائيا) سحب أثره على الحوت في العملية المذكورة.
هذا ، فيما يتصل بحركة (الإحياء).
أما فيما يتصل بحركة (الانسراب) ، فان (الجميل) و(المدهش) أو
(المعجز) ، يتمثل ـ كما سبق التلميح ـ في سمتين رسمهما النص القرآني ذاته (سربا)
و(عجبا).
وهاتان السمتان تفصلهما نصوص التفسير على النحو التالي :
ان الحوت كان يضرب الماء بذنبه ، ويشق طريقه في البحر ،... وقد تركت
هذه العملية آثارا [من خلال ضرب الماء بالذنب] تتفاوت نصوص التفسير في رسمها :
فبعضها يذهب الى ان الماء كان (يجمد) على الأثر. وبعضها يذهب الى انه كان يمسك عن
(الجريان). وبعضها يذهب الى انه اصبح مثل الطاق أو مثل الكوة ، وبعضها يكتفي برسم
(الماء) بأنه موسوم بمعلم هو : (الأثر) الذي تركته حركة الحوت ، دون أن ترسم هذه
النصوص تفصيلات الأثر المذكور.
وأيا كان الأمر ، فإن أهمية رسم (الأثر) ، لا تقف عند نطاق ما هو
(جميل) و(مدهش) ، بل تتجاوزهما إلى أهمية المبنى العضوي للقصة ، وتواشج الصلة بين
أجزائها ، بما يصاحب ذلك من تنمية وتطوير لأحداثها.
إن رسم (الاثر) له صلته العضوية الكبيرة ، بانعطاف الأحداث نفسها ،
ذلك : ان رجوع موسى ـ عليه السلام ـ وفتاه إلى الصخرة التي استراحا عندها ، مرتبط
ـ كما تذكر النصوص المفسرة ـ بان يقص (أثر) الحوت. وهذا يعني ان الرسم الخارجي
لظاهرة (الانسراب) ليست مجرد رسم لا براز (جمالية) البيئة التي تحرك الحوت من
خلالها ، وليست مجرد تبيين لما هو (معجز) فحسب ، بل يضاف الى ذلك [وهذا هو موضع
تشددنا في هذا الجزء من المعالجة] ان الرسم الخارجي المذكور مرتبط بتطوير الأحداث
اللاحقة ، الأحداث التي صيغت القصة من أجلها : بغية العثور على (العالم) ، ـ ومن
ثم ـ كانت الرحلة أساسا قد استهدفت ذلك.
ان المتلقي مطالب ـ من جديد ـ بأن يمارس عملية التذوق الفني للقصة من
خلال ملاحظته لهذه الظاهرة الفنية : ظاهرة التواشج العضوي بين رسم خارجي لبعض
ملامح البيئة [الاثر الذي تركه الحوت] ، وبين صلة هذا (الأثر) بمعالم الدرب الذي
سيسلكه موسى ـ عليه السلام ـ في الوصول الى (العالم).
خارجا ، عن المبنى العضوي لرسم ظاهرة (الاثر) الذي تركه الحوت في
انسرابه ، فإن (الجميل) و(المعجز) في عملية (الانسراب) ، يتمثلان في [جمود الماء]
أو في (انحساره) أو في (كواه).
(المدهش) في البيئة المائية المذكورة هو : الانسراب تميز بما هو خارج
عن [قوانين الحركة] الطبيعية.
وأما (الجميل) : فان مجرد ممارسة (التخيل) للمرائي أو ما تسميه لغة
القصص بـ(المشهد) أو (المنظر) ، كاف بتحسيسنا ضخامة الإمتاع الجمالي للمرائي
المذكورة : جمود الماء في خط متعرج أو مستقيم وسط امواج الماء. تشكله في هيئة
(كوة) أو (طاق) وسط الامواج المذكورة. انحساره أساسا على خط متعرج أو مستقيم وسط
تلك الامواج.
هذه المرائي أو المناظر تظل حافلة بالإثارة ، وبالدهشة وبالانبهار ،
ومن ثم : بالإمتاع الجمالي الضخم الذي يتزايد بقدر تزايد العملية التخيلية للمرأى.
وبعامة ، فان ظاهرة (الحوت) قد احتلت في قصة موسى ـ عليه السلام ـ
والعالم أهمية فنية كبيرة ، بما انطوت عليه من (حركة) داخل القصة : بدءا من حيث
كونها (زادا) للرحلة ، مرورا بكونها قد اقترنت بنسيان (الفتى) لها ، وانتهاء
بانسرابها داخل البحر : وصلة اولئك جميعا ، بهدف (الرحلة) التي كان لا مناص لها من
التزود بالحوت ، وصلة نسيانه بالهدف المذكور ، ثم صلة العودة إلى مجمع البحرين
بذلك ،… فضلا عن صلة (الانسراب) بذلك... وفضلا عما انطوت الظاهرة عليه من ملامح
جمالية واعجازية وقفنا عليها مفصلا.
ومع انسراب الحوت في البحر ، ينتهي الشطر الاول من قصة موسى مع
العالم ، ويبدأ شطرها الآخر في التقاء موسى ـ عليه السلام ـ العالم فيما كانت
ظاهرة (الحوت) موظفة لوصول البطل الى هدفه.
والآن : إلى الشطر الثاني من الأقصوصة.
نتجه الى الشطر الثاني من قصة موسى ـ عليه السلام ـ والعالم ، بعد أن
انتهينا من شطرها الأول الذي شكل مقدمة لالتقاء العالم ، ونعني بذلك : الرحلة التي
شدت من أجل اللقاء المذكور.
لقد كان القسم الاول من الأقصوصة يحفل باكثر من بطل ، وحدث ، وبيئة ،
وموقف : بدأ ينحسر ، أو ينتهي دوره مع الشطر الثاني من القصة.
فالبطل : يوشع أو الفتى الذي صاحب موسى ـ عليه السلام ـ في رحلته
العلمية ، قد انتهى دوره في القصة مع مجرد اللقاء بين موسى والعالم : بعد أن شكل
عنصرا مهما في ترتيب اللقاء المذكور.
و(الحوت) قد انتهت مهمته التي كانت (دليلا) أو (علامة) لترتيب اللقاء
المذكور.
كما أن بيئة البحر وما صاحبها من رسم (الجميل) و(المدهش) قد انتهت
وظيفتها التي كانت ـ في الواقع ـ مقدمة لكل ما هو (مدهش) و (معجز) من الاحداث
والمواقف اللاحقة التي ستواجه موسى ـ عليه السلام ـ مع العالم.
كل العناصر المتقدمة من : أبطال واحداث وبيئات ، سوف لن نجد لها
اسهاما في الشطر الجديد من القصة ، ما دامت قد (مهدت) لهذا القسم فنيا على النحو
الذي لحظناه مفصلا.
وهذا يعني أن القسم الجديد من القصة سيحوم ، فحسب ، على لقاء موسى ـ
عليه السلام ـ مع العالم.
ولنقف ـ اذن ـ مع هذه القسم من القصة.
بعد أن رجع موسى ـ عليه السلام ـ مع فتاه الى حيث استراحا عند الصخرة
، تم اللقاء بينه وبين العالم.
اما كيفية اللقاء ذاته ، فإن النص ساكت عن ذلك. وطبيعي ، ليس من
المهم ـ فنيا ـ ان ترسم التفصيلات حول اللقاء المذكور ، ما دام الهدف هو اللقاء
نفسه وليس كيفيته.
بيد أن نصوص التفسير ، تسرد لنا بعض التفصيلات التي تلقي شيئا من
الانارة على مقدمة اللقاء : نظرا لصلة ذلك بعض التساؤلات التي يثيرها لقاء موسى ـ
عليه السلام ـ بالعالم ، ومنها مثلا : طبيعة الفارق العلمي أو الشخصي بين موسى ـ
عليه السلام ـ وشخصية مجهولة اجتماعيا بحيث يفيد منها موسى ـ عليه السلام ـ وهو :
يمارس من حيث الوظيفة الاجتماعية ، أعلى منصب عبادي هو : النبوة والرسالة.
ان النصوص المفسرة تلقي إنارة على هذا الجانب حينما تنقل لنا أن
العالم قال لموسى : [وكلت بعلم لا تطيقه ، ووكلت بعلم لا أطيقه] ، وهذا يعني ان
موسى لا يظل في الحالات كلها مفضولا على زميله ، ولا زميله مفضولا عليه ، بقدر ما
يعني ان كلا منهما قد أوكلت له مهمة مختلفة عن الآخر.
على ان بعض النصوص المفسرة بالرغم من ذلك ، تصرح بوضوح بان موسى وان
تبع العالم إلا انه [أعلم منه] ، من نحو ما ورد عنهم ـ عليهم السلام ـ [كان موسى
أعلم من الذي تبعه].
المهم : ان الذي نستخلصه مما تقدم ، أن لقاء موسى ـ عليه السلام ـ
بالعالم تم نتيجة لإحساس خاص خامر موسى ـ عليه السلام ـ في تقديره لـ(ذاته) ، فيما
ارادت السماء أن تطلعه على الحقيقة الذاهبة من ان التقدير للذات ينبغي ألا يصاحبه
شعور بالفوقية : أيا كان الشعور.
والآن : وقد تم اللقاء بينهما ، ما الذي رسمته القصة في هذا النطاق؟
ان القصة تضمنت ثلاثة أحداث هي : خرق العالم للسفينة ، وقتله لأحد
الغلمان ، وابتناؤه للجدار.
كما تضمنت جملة من المواقف ، حائمة على سلوك كل من البطلين حيال
الآخر.
لكننا قبل ذلك ينبغي أن نتساءل من جديد :
ما الذي يجعل من البطلين وكأنهما يعايشان (صراعا) في سلوكهما حيال
الآخر؟
ويتمثل هذا الصراع في توجيه العالم خطابا الى موسى ـ عليه السلام ـ
على هذا النحو :
{إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف : 67]
واجابه موسى ـ عليه السلام ـ :
{سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا} [الكهف : 69]
ثم وفي تأكيد العالم لموسى من جديد :
{قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى
أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف : 70]
ثم : اعتراض موسى ـ عليه السلام ـ على العالم وإنكاره لكل مواقفه ،
وتأكيد العالم من جديد على موسى ـ عليه السلام ـ بانه لن يستطيع صبرا... الخ.
كل ذلك يجسد صراعا بين البطلين ، لم ينته إلا مع الحدث الثالث الذي
عقب العالم عليه وعلى سابقيه بنحو أنهى الصراع بينه وبين موسى عليه السلام.
إن الصراع ، يفرضه ـ كما هو واضح ـ نمط الشخصية لكل من البطلين.
فالعالم ـ وتقول النصوص المفسرة انه : الخضر ـ عليه السلام ـ ـ وأنه
(نبي) بدوره قد أودعت فيه السماء نمطا من المعرفة ، ونمطا من الحياة ، ونمطا من
السلوك : تسردها لنا نصوص التفسير بنحو يتعين من خلاله أن يمارس سلوكه الوظيفي على
شكله المعجز الذي اختارته السماء للشخصية المذكورة.
وموسى ـ عليه السلام ـ بدوره ما دام نبي زمانه لا مناص من رفضه لأي
سلوك يجده غير مؤتلف ـ ظاهرا ـ مع الحقائق التي يحيط بها علما : مما يجعله مناهضا
له ، متمثلا ذلك في : نقده الذي وجهه الى الخضر ـ عليه السلام ـ.
وهذا يعني ان كلا منهما مضطر الى أن يحيا صراعا مع الآخر ، بالرغم من
ان موسى ـ عليه السلام ـ قد طولب بأن يتبعه في المعرفة.
ومهما يكن ، فاننا نبدأ الآن بمحاولة التعرف على البناء الفني
للوقائع الثلاث وما رافقها من السلوك لدى البطلين ، وصلة اولئك بهدف القصة
الرئيسي.
لكننا ، قبل ذلك ينبغي ان نلفت انتباه المتلقي من جديد إلى ان
(إبهام) أو تنكير العالم ـ من حيث البعد الفني ـ يظل موسوما بأهمية كبيرة في غمار
هذا اللقاء العلمي أو المعرفي بين البطلين ، سواء أكان هذا الإبهام يتصل باستجابة
موسى ـ عليه السلام ـ حياله ، أو باستجابتنا ـ نحن المتلقين ـ حياله... إنه ـ
الابهام الفني ـ الذي يتساوق مع هدف القصة : الذاهب الى ضرورة التقدير السلبي لـ(الذات)
، وإلى ان (المعرفة) توزعها السماء وفقا لمتطلبات (الحكمة) التي تعلنها سمة عند
بعض الشخوص ، تخفيها ـ حتى عن الشخصيات المنتقاة ـ ، فضلا عن العاديين من البشر.
يبدأ لقاء موسى والخضر ـ عليهما السلام ـ بسؤال موسى :
{هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف : 66]
فيجيبه الخضر ـ عليه السلام ـ :
{إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا}
{وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ
تُحِطْ بِهِ خُبْرًا}
وواضح من الحوار المتقدم بينهما ، أن موسى ـ عليه السلام ـ
يعتزم الافادة من الخضر عليه السلام ، وان الخضر ـ عليه السلام ـ مطمئن الى ان
موسى لن يستطيع ان يصبر على ما يشاهده من ممارسات العالم.
ويلاحظ ان العالم أوضح لموسى ـ عليه السلام ـ سبب عدم اصطباره ،
متمثلا ذلك في عدم احاطته علما بأسرار الممارسات التي سيقدم العالم عليها.
وهنا ، مع أن موسى ـ عليه السلام ـ قد اطمأن إلى ان المصاحبة ستمضي
دون ان تعترضها اية صعوبة : من خلال إجابته التالية التي عقب بها على اجابة العالم
:
{سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا} [الكهف : 69]
مع ذلك كله ، فإن العالم يواصل تأكيداته واحدا تلو الآخر فيما يبدو
أنه مطمئن الى ان موسى ـ عليه السلام ـ سوف لن يستطيع معه صبرا. ولذلك اجابه للمرة
الثانية أو الثالثة :
{فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف : 70]
وطبيعي ـ فيما يتصل بالمتلقي ـ يستطيع ان يستخلص من الحوارات
المتقدمة ان [المصاحبة بين موسى والعالم] ستواجه بعض الصعوبات ، والى ان موسى ـ
عليه السلام ـ سوف لن يكف عن الاعتراض ، ما دام (الحوار) قد أرهص فنيا بهذا.
وتبعا لذلك ، ينبغي أن ندرك الدلالة الفنية لهذه الفقرة :
{وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا } [الكهف : 68]
فهذه الفقرة ، تحسم كل شيء ، لانها ربطت بين عدم المعرفة بالأسرار
وبين الاعتراض ، مما يتحتم ـ عبر المنطق العلمي ـ ان يثار الاعتراض حيال اية
ممارسة لا تتوافق مع مبادئ السماء ، أو مبادئ الأرض التي تعورف عليها : فخرق سفينة
تقل ركابا ابرياء لا يتساوق مع مبادئ السماء التي تطالب بالمساعدة بدلا من إلحاق
الأذى بالآخرين. وأما قتل النفس عمدا بلا مسوغ ، فيشكل قمة المفارقة لمبادئ
السماء. حتى ان بعض النصوص المفسرة ترسم النا طريقة استجابة موسى ـ عليه السلام ـ
لحادثة القتل من أنه جلد العالم بالأرض : إنكارا للمفارقة المذكورة.
وأيا كان : فان ظاهرة (الاعتراض) أو عدم الصبر ، تظل من حيث البناء
الهندسي للقصة أمرا (يتوقعه) قارئ القصة ، أو لنقل : وفق لغة الادب القصصي ، أن
عنصر (التنبؤ) بالأحداث اللاحقة ، سيظل قويا دون ادنى شك.
وهنا ، بالرغم من أن (التنبؤ) يظل محتفظا بفاعليته المذكورة ، إلا أن
استخلاص نتائج مضادة للتنبؤ المذكور ، من الممكن أيضا أن تثار عند المتلقي ، ما
دام الأمر متصلا بتأكيد موسى ـ عليه السلام ـ على انه سيصبر على ما يشاهده ، وبقناعته
بان السماء أرسلته ليتعلم رشدا من العالم.
هذا التوازن بين قناعة العالم من جانب ، وقناعة موسى ـ عليه السلام ـ
من جانب ثان ، ثم : التأرجح بين امكانات (التنبؤ) المتضاربة من جانب ثالث [فيما
يتصل بالمتلقي] ،... ترشح بقيم جمالية وفكرية ، ينبغي ألا نمر بها عابرا.
إننا حيال ذلك نواجه (عالما) يموج باستجابات متوازنة ، ومتضاربة ،
ومتصارعة في آن واحد.
وهذا (العالم) القصصي الموشح بالاستجابات المذكورة يزيد من الثراء
الفني للقصة : حينما نعثر على (بطلين) الأول (مطمئن) تماما الى ان البطل (الآخر)
سوف لن يصبر على اسرار كونية خافية عليه. والبطل الآخر مطمئن الى انه صابر على
ذلك. كما ان كلا من البطلين (مطمئن) الى ان الافادة العلمية ـ في نهاية المطاف ـ
ستتحقق دون ادنى شك ، ما دام الأمر متعلقا بإصدار أمر من السماء ، (يعيه) كل
منهما.
فإذا أضفنا الى ذلك ، ان استجابة (المتلقي) ستأخذ بدورها طابع
التضارب والاطمئنان في آن واحد أيضا : من حيث عدم إحاطته بطبيعة السلوك الذي
سيمارسه البطل ،... حينئذ ندرك طبيعة الثراء الفني للقصة في تموجاتها بهذا الزخم
المتضارب والمتوازن من الأحاسيس أو الاستجابات.
خارجا عما تقدم ، يعنينا من متابعتنا للقصة : ليس (موقف) موسى ـ عليه
السلام ـ من العالم في الوقائع الثلاث التي واجهها ،... فهذا الموقف واضح تماما ،
حينما نجد ان موسى ـ عليه السلام ـ قد أتخذ (النقد) أو (الاعتراض) خطا ثابتا في
المواقف الثلاثة بأكملها... انما يعنينا ان نشدد على ظاهرتين هما : نمو شخصية موسى
عليه السلام ، واستخلاص (الافكار) الكامنة وراء القصة. أما (الافكار) فقد تحددت
سابقا.
وأما (نمو) الشخصية ، فنعني بها ما يقابل ـ في لغة الادب القصصي ـ
بـ(انبساط) الشخصية. فهذه الأخيرة تعني ان الشخصية تحتفظ بخط سلوكي عام ، أو فكري
، أو أي شريحة من السلوك طوال القصة ، مقابلا للشخصية (النامية) التي تبدأ في
القصة بنحو مغاير لنهايتها في القصة.
وشخصية موسى ـ عليه السلام ـ تنتسب الى هذا النمط الذي (ينمو) مع
القصة.
فلقد بدأ موسى ـ عليه السلام ـ [إذا قدر لنا ان ننساق مع النصوص
المفسرة القائلة بأن موسى حاور نفسه ذات يوم ، بان السماء لم تخلق اعلم منه في
زمانه] بدأ موسى ـ عليه السلام ـ بهذا النسج من التقدير لذاته علميا ،... وانتهى
الى تقدير مغاير لتقديره الاول عن (الذات) العلمية له.
وخلال كل من البداية والنهاية ، تمر شخصية موسى ـ عليه السلام ـ
بمنعطفات (متنامية) جديرة بالانتباه ، نظرا لصلتها بطبيعة الاستجابة (المعرفية)
لدى الكائن الأدمي.
ويمكننا ملاحظة هذا التنامي في خطواته الاستجابية التالية مع العالم
:
1 ـ طلب موسى ـ عليه السلام ـ من العالم ان يعلمه رشدا.
وهذه هي الخطوة الاولى.
2 ـ اوضح العالم أنه لن يستطيع صبرا على ذلك ، موضحا السبب ، من انه
لم يحط خبرا بما سيواجه.
3 ـ اجاب موسى ـ عليه السلام ـ بانه سيصبر ، ولن يعصي له أمرا.
وهذه الاجابة تأكيد على الخطوة الاستجابية الاولى.
4 ـ اعترض موسى ـ عليه السلام ـ على سلوك العالم في خرقه للسفينة.
وهذه الخطوة نمو مضاد لخطوته الاولى التي أكد معها إصطباره على ما
يرى.
5 ـ اعترض ثانية على قتل الغلام.
وهذه الخطوة تأكيد للنمو السابق.
6 ـ اعترض ثالثة على ابتناء الجدار.
وهي خطوة مؤكدة للنمو السابق من جديد...
ومع هذه الخطوات كان ثمة (نمو) نحو الخطوة الاولى ، ونعني بها :
استعداده للصبر على ما يرى ، متمثلا في قوله للعالم بعد الاعتراض الاول : (لا
تؤاخذني) ، وفي قوله بعد الاعتراض الثاني : {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي} [الكهف : 76] .
إن مرور شخصية موسى ـ عليه السلام ـ بمنعطفات متنوعة من (النمو) :
استعداده لان يتعلم من العالم ، ثم اعتراضه على خرق السفينة ، ثم استدراكه (لا
تؤاخذني) ، ثم اعتراضه ـ بالرغم من الاستدراك السابق ـ على قتل الغلام ، ثم
استدراكه من جديد (لا تصاحبني)... هذه المنعطفات من (النمو) ، فضلا عن (النمو)
العام الذي بدأت القصة به نظرة خاصة من التقدير للذات ، وانتهت به نظرة مغايرة
للتقدير السابق.. تدلنا على ان المنعطفات المذكورة تظل حقيقة حية في حقل الاستجابة
، ما دام الكائن الآدمي ـ أيا كان ـ يتحرك من خلال جهازه الثقافي الذي لا يمكن ان
يتجاوز تخومه : نظرا للخصيصة الموضوعية التي تطبع الجهاز المذكور.
فقتل النفس مثلا ، أو خرق سفينة مثلا ، لا يمكن للجهاز العبادي الذي
تمتلكه الشخصية أن تتقبله ، ما لم يقترن بتفسير عبادي آخر يسوغ العلم المذكور.
من هنا لم تتم القناعة بمسوغات الأعمال الثلاث إلا بعد أن أوضحها
العالم لموسى ـ عليه السلام ـ في نهاية المطاف.
ويلاحظ ـ من حيث الرسم الفني لملامح الشخصية ـ أن النص ترك المتلقي
حائما على اكثر من استخلاص في تفسير (النمو) لدى شخصية موسى عليه السلام.
ونحن إذا وقفنا بعيدا عن إنارة النصوص المفسرة ، يمكننا ان نستخلص ان
موسى ـ عليه السلام ـ قد (نسي) العهد الذي اعطاه للعالم بعدم الاعتراض : وذلك
بصريح العبارة القصصية (لا تؤاخذني بما نسيت) ، مضافا الى انه ارهاق للطاقة
الثقافية التي لا تتحمل مواجهة (المفارقة) لحين توضيحها فيما بعد ،... وذلك بصريح
العبارة القصصية (لا ترهقني)...
وقد فسر بعضهم بان (النسيان) المذكور ، لا يعني النسيان بدلالته
اللغوية المعروفة ، بقدر ما يعني ترك العهد ، نظرا لضخامة المفارقة التي واجهها.
غير ان هذا الاستخلاص يتسق مع العبارة القصصية الثانية (لا ترهقني) ، وليس مع
العبارة التي سبقتها : (لا تؤاخذني بما نسيت).
ونحن إذا ادركنا ان القصة القرآنية بعامة تتميز بالانتقاء اللغوي ،
وبالاقتصاد اللغوي ، نستبعد حينئذ ان تكون العبارتان بدلالة واحدة ، بل لا مناص من
ان تكونا بدلالتين متغايرتين.
ومن الممكن ان يكون الأمر كذلك ، اذا افترضنا ان كلا من العبارتين
تأكيد أو توضيح للأخرى ، في حالة ما اذا ارتكن التفسير الى نص موثوق به عن آل
البيت عليه السلام...
ولكن ـ أيا كان الأمر ـ فإن المتلقي من الممكن أن يستخدم ذائقته
النفية ، فيستخلص مثلا : أن موسى ـ عليه السلام ـ من الممكن ان يكون قد توقع من
مصاحبته للعالم أن يمده بالمعرفة في مجالات أخرى عبر المصاحبة ، لم يحن وقتها بعد
، وأن مواجهته لخرق السفينة لم تكن إلا حدثا ، لا علاقة له بالمعرفة التي ينتظرها
من العالم.
غير ان هذا الاستخلاص يظل بمنأى عن الحقيقة ، حين ندرك بأن العالم قد
نبه موسى ـ عليه السلام ـ وألفت ذاكرته إلى العهد الذي أخذه عليه ، فيما يستتلي ،
الا يوجه إليه اعتراضا آخر في قتل الغلام. وهذا ما يقتادنا الى استخلاص آخر هو :
أن ضخامة (المفارقة) أنسته العهد ، وليس انها نابعة من افتراض كونها حدثا طارئا لا
علاقة له بمعرفة ينتظرها فيما بعد.
وأما اذا انسقنا مع بعض المفسرين الذين فسروا (النسيان) بدلالة أخرى
، فان الاستخلاص يعني : ان ضخامة المفارقة نفسها فرضت على موسى ـ عليه السلام ـ أن
(يعترض) بدلا من ان يلتزم بالعهد.
وفي الحالتين ، فان الأمر يظل متصلا بما سبق أن اوضحناه ، من ان
الجهاز الثقافي للشخصية ، يحتجزها من أن تتجاوز تخوم الجهاز المذكور.
وفي ضوء الحقيقة المتقدمة ، فإن بعض (الافكار) التي يمكننا ان
نستخلصها من القصة هو : ان الكائن الآدمي مسيج بحدود معينة من (المعرفة) لا يمكن
تجاوزها.
ويترتب على ذلك مبنى (فكري) آخر من (أفكار) القصة هو : ان التقدير
للذات
ينبغي ألا يحوم على المطلق ، بل لا مناص من التحفظ حيال أي تقدير
تنسجه الشخصية لـ(الذات).
وقد تحدد هذا بوضوح في (وجود) شخصية غائبة عن (المجتمع) الانساني ،
هي : (العالم) فيما سبب إلغاء أي تقدير مستقى من (الواقع) ، واقتياده الى ضرورة أن
ننسج تقديرا سلبيا عن (الذات) بدلا من التقدير الايجابي.
هذا إلى أن ثمة (افكارا) أخرى تضمنتها القصة ، فيما تتصل ببناء القصص
الأربع في سورة الكهف ، متمثلة بخاصة في الاستجابة الآدمية حيال زينة الحياة
الدنيا : حيث اوضحنا في حينه صلة (العالم) بالاستجابة المذكورة ، والى أنها نمط
آخر يضاف الى الأنماط التي جسد بعضها شخصية تملكت الأرض مشرقا ومغربا ، وثانية
تملكت جنتين منها فحسب ، وثالثة هربت منها تماما : مع ملاحظة ان كلا من الشخوص
المذكورين جسد : إما استجابة سلبية مثل صاحب الجنتين ، أو ايجابية مثل ذي القرنين
، وهكذا.
وبعامة ، فان سورة الكهف تضمنت ـ كما لحظنا ـ أربع قصص تواشجت فيما
بينها برابط فكري ، مهدت له مقدمة السورة التي تحدثت عن زينة الحياة الدنيا ، وإلى
أنها ـ في نهاية المطاف ـ ارض جرداء ، وإلى ان الكائن الآدمي وجد على الأرض بغية
(الاختبار).
وفعلا ، جاءت القصص الاربع ، لتجسد هذا المفهوم : ولكن في أبعاده
المتنوعة التي رسم بعضها إبادة الزينة حقا ، كما هي نهاية بستاني الشخصية التي
فشلت في (الاختبار) ، مثلما رسمت فشل الشخصية المذكورة في عملية (الاختبار) التي
خلق الانسان من أجلها. ورسمت ثالثا نجاح (الاختبار) لدى شخصيات ذات موقع اجتماعي
رائد كذي القرنين ، مقابلا لشخصية عادية مثل صاحب الجنتين. ورسمت رابعا نماذج
لشخصيات (هربت) حتى من [التقدير الاجتماعي] الذي يشكل احد مظاهر زينة الحياة مثل :
أصحاب الكهف ، والعالم.



|
|
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العبّاسيّة: البحوث الّتي نوقشت في أسبوع الإمامة استطاعت أن تثري المشهد الثّقافي
|
|
|