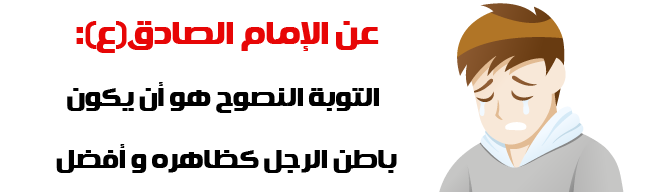
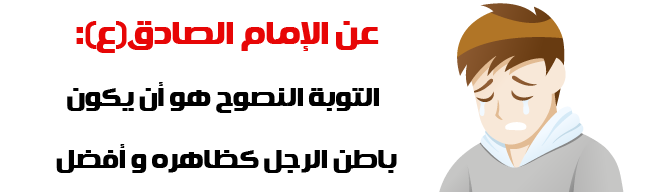

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2014
التاريخ: 10-10-2014
التاريخ: 10-10-2014
التاريخ: 30-04-2015
|
نلاحظ من خلال استقراء قراءات سورة البقرة في كتب القراءات المختلفة أنّ السياق يظهر عاملا حاسما في ترجيح قراءة على أخرى، أو ترك إحدى القراءات، ومن المسائل التي تنبهوا لها في هذا الإطار مراعاة السياق الصوتي للنص وعلاقته بالمعنى ، ومن أمثلته قراءة الآية {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ} [البقرة : 7]. فإنّها تقرأ بالإمالة والتفخيم،" وللعرب في إمالة الراء رغبة ليست في غيرها من الحروف ، للتكرير الذي فيها ... فإن قيل : فيلزم من أمال النار أن يميل الجار، فقل : لمّا كثر دور النار في القرآن أمالوها، ولما قلّ دور الجار في القرآن أبقوه على أصله" «1».
في هذا الاقتباس نلحظ دور التنبّه للسياق الصوتي، وهوأهميّة صفة (التكرير) في حرف الراء وأيضا دور كثرة الاستعمال كما في" الجار" و" النار" فهما عنصران سياقيّان : السياق الصوتي، وسياق الشيوع إذا جاز التعبير.
ومنها كذلك مراعاة العرف اللّغوي (السياق اللّغوي الثقافي)، وهوتوخّي ما جرت عليه العرب في سنن كلامها وعرفها اللّغوي، ومن أمثلة ذلك : ما قرئ في الآية {غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ} [البقرة : 7]. فإنّه" يقرأ بالرفع والنّصب، فالحجة لمن رفع أنّه أستأنف الكلام مبتدئا، ونوى به التقديم، وبالخبر التأخير، فكأنّه يقال : وغشاوة على أبصارهم، والحجّة لمن نصب أنه أضمر مع الواوفعلا عطفه على قوله : { خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ} وجعل على أبصارهم غشاوة، وإضمار الفعل إذا كان عليه دليل كثير مستعمل في كلام العرب" «2».
ومنه كذلك ما قرئ في قوله تعالى {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة : 222]. يقرأ بالتشديد والتخفيف ؛ ويهمّنا في هذا الموضع قراءتها بالتخفيف، وحجّة من خفّف" أنّه أراد حتى ينقطع الدم، لأنّ ذلك ليس من فعلهن، ثم قال" فإذا تطهرن يعني بالماء، ودليله على ذلك قول العرب طهرت المرأة من الحيض فهي طاهر" «3».
ففي المثال الأو ّل استعان موجّه القراءة بصنيع العرب في نحوها (قواعد كلامها في المستوى النحوي)، وفي المثال الثاني استعان بصنيع العرب في صرفها (قواعد كلامها في المستوى الصرفي)، وارتباط هذين المستويين مباشرة بالمستوى الدلالي من خلال الاستعمال.
ومما أو ردوه في هذا الشأن مسألة المشاكلة بين الألفاظ (اتّساق الألفاظ) ومثاله ما جاء في شرح الآية {وَمَا يَخْدَعُونَ } [البقرة : 9]." فإنّها تقرأ بضم الياء وإثبات الألف، وبفتح الياء، وطرح الألف، فالحجّة لمن أثبتها أنّه عطف لفظ الثاني على لفظ الأو ّل ليشاكل بين اللّفظين، والحجّة لمن طرحها أنّ (فاعل) لا يأتي في الكلام إلّا من فاعلين يتساويان في الفعل، كقولك قاتلت فلانا وضاربته، والمعنى بينهما قريب، ألا ترى إلى قوله تعالى :
{ قاتَلَهُمُ اللَّهُ} أي قتلهم ، فكذلك يخادعون بمعنى" يخدعون") «4». وهنا نلحظ أنّ أمام توجيه القراءة خيارين : الأو ّل الاتّكاء على عنصر" التشاكل" وهوعنصر صوتي معنوي داخلي له صلة بالاتّساق الصوتي الداخلي للنص، والثاني هوالاتّكاء على عنصر من" سياق الحال"، وهومسألة التكافؤ بين طرفي المخادعة، ويبقي موجّه القراءة الخيارات مفتوحة؛ إذ أنّه حتّى مع تبيّن انعدام التكافؤ بين اللّه عزّ وجل وبين المنافقين، وهومعنى ملتمس من خارج النصّ، فإنّ اللّغة تسمح بنوع من التبادل بين معاني أبنيتها فتأتي (يخادعون) بمعنى يخدعون، وهنا لا يكون تعارض بين اللّغة داخل النصّ والمقام الخارجي. وهوما يؤكد عليه علماء القرآن دائما من كون القرآن متّسقا داخليّا وخارجيّا.
ومن أمثلة هذا أيضا قراءة الآية {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة : 222]الآنف ذكرها بالتشديد، والحجّة لمن شدّد أنّه طابق بين اللفظين لقوله" فَإِذا تَطَهَّرْنَ" «5». وهذا من قبيل التشاكل اللفظي الذي
يؤدّي إلى اتّساق النصّ، ومن أمثلته كذلك قراءة الآية (282)" وكتبه" فإنه" يقرأ بالتوحيد والجمع، فالحجّة لمن جمع أنّه شاكل بين اللفظين وحقّق المعنى، لأنّ اللّه تعالى قد أنزل كتبا، وأرسل رسلا" «6». ف (كتبه) على زنة (رسله) و(ملائكته)، فجمع الألفاظ التي وقع الإيمان عليها في الآية جاءت بصيغة الجمع، فناسب مجيء (الكتب) كذلك. وهي مشاكلة صوتيّة معنويّة.
ويعد استحضار السياق المقامي لدى دارسي القراءات ملمحا آخر في هذا الشأن ومن أمثلته قوله تعالى : {بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } [البقرة : 10], يقرأ بتشديد الذال وبضمّ الياء وبفتح الياء، وتخفيف الذال ، فالحجّة لمن شدّد أنّ ذلك تردّد منهم إلى النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلم- مرّة بعد أخرى فيما جاء به، والحجّة لمن خفّف أنه أراد" بما كانوا يكذبون عليك بأنك ساحر، وأنّك مجنون"، فأضمر حرف الجر لأنّ (كذّب) بالتشديد يتعدّى بلفظه وكذب بالتخفيف لا يتعدّى إلّا بحرف جر، ومعنى القراءتين قريب لأنّ من كذب بما جاء به النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلم - فقد كذّب" «7».
إنّ صنيع المنافقين والكافرين مع الرسول عنصر مأخوذ من السياق الخارجي، ولكنّه وجد صداه في توجيه قراءة النصّ.
ومن ذلك أيضا قراءة الآية (37) من سورة البقرة { فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ} (تقرأ برفع آدم ونصب الكلمات، وبنصب آدم ورفع الكلمات، فالحجّة لمن رفع (آدم) أنّ اللّه تعالى لمّا علّم آدم الكلمات فأمره بهن تلقّاهنّ بالقبول عنه، والحجّة لمن نصب (آدم) أن يقول : (ما تلقّاك فقد تلقّيته وما نالك فقد نلته) وهذا ما يسمّيه النحويون المشاركة في الفعل" «8»، إنّ استجابة آدم وقبوله (وهي عنصر سياقي خارجي) تمثّلت رمزا لغويا في رفع (آدم)، وكذا الفهم الآخر للآية فإنّه يحيل إلى خارج النصّ. ومن أمثلته كذلك قراءة الآية " وكتبه" التي مرّ ذكرها فإنّه" يقرأ بالتوحيد والجمع، فالحجّة لمن وحّد أنّه أراد (القرآن) لأنّ أهل الأديان المتقدّمة قد اعترف بعضهم لبعض بكتبهم، وآمنوا بها إلّا القرآن فإنّهم أنكروه فلذلك أفرد، وجمع الرسل لأنّهم لم يجمعوا على الإيمان بهم" «9». فطبيعة الموقف الذي اتّخذته الأمم السابقة انعكس داخل النصّ وفي المستوى الصرفي ما بين إفراد وجمع، وهوما يؤكّد أنّ انعكاسات السياق الخارجي تتبدّى داخل مستويات النصّ اللّغوي جميعها، نحوها وصرفها، ودلالتها، وصوتها وبيانها. ومنه كذلك توجيه الآية الكريمة رقم (36) { فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ}" تقرأ بإثبات الألف والتخفيف، وبطرحها والتشديد. فالحجّة لمن أثبت الألف أن يجعله من الزوال والانتقال عن الجنة، والحجّة لمن طرحها أن يجعلها من الزلل وأصله (فأزللهما) فنقلت فتحة اللام إلى الزاي فسكنت اللام، فأدغمت للمماثلة" «10». فإذا كان الواقع الخارجي (السياق المقامي) زوالا أي انتقالا ترجّحت القراءة الأو لى، وإن كان التركيز على عنصر الزلل والخطأ في الواقع الخارجي ترجّحت القراءة الثانية.
وممّا يتّصل بهذا الموضوع ما يمكن أن نطلق عليه" المقامات الاجتماعيّة، أو أحوال المخاطب والمخاطب والمنزلة التي يحتلّها كلّ منهما، وكذلك مراعاة المكانة الدينيّة، وما يليق بحقّ الخالق وما لا يليق وأمثلته عديدة، مرّ معنا بعضها سابقا، ونضيف هنا قراءة الآية { وَ إِذْ واعَدْنا} فقد قال ابن خالويه فيها :" هاهنا وفي الأعراف وطه، يقرءان بإثبات ألف بين الواووالعين وبطرحها؛ فالحجّة لمن أثبت الألف أنّ اللّه تعالى وعد موسى عليه السلام وعدا فقبله، فصار شريكا فيه فجاء الفعل ب (فاعلت) لأنّه بنيّة فعل الاثنين، فإذا جاء للواحد فهوقليل، والحجة لمن طرح الألف أن يقول : اللّه هوالمنفرد بالوعد والوعيد، وإنّما تكون المواعدة بين المخلوقين، فلمّا انفرد اللّه تعالى بذلك كان (فعلت) فيه أو لى من (فاعلت) «11». إنّ هذه المراعاة لمقام اللّه عزّ وجل في قوله :" إنّما تكون المواعدة بين المخلوقين"، وتكييف الخطاب بحسب مقامات المخاطبين أو المخاطبين يعتبر من أبرز ملامح اللسانيّات الاجتماعيّة التي تقوم على مراعاة العرف الاجتماعي، والعرف العام للّغة.
ومن أمثلته كذلك قوله تعالى : {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة : 74]. وقوله : { إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } [البقرة : 85]. وقوله : {وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } [البقرة : 149]." يقرءان بالياء والتاء، فالتاء في الأو ل أكثر لقوله تعالى { ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ}.
والياء والتاء في الثاني معتدلتان، فالحجّة لمن قرأ بالتاء أنّه أراد" وما اللّه بغافل عما تعملون أنتم وهم" والاختيار في التاء لعلّتين : إحداهما أنّ ردّ اللفظ على اللفظ أحسن، والثانية أنّه لمّا ثبت أنّ اللّه ليس بغافل عما يعمل كل أحد اعتدلت التاء والياء فيهما، والحجّة لمن قرأ بالياء أنّ العرب ترجع من المخاطبة إلى الغيبة كقوله تعالى : {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس : 22] ولم يقل بكم، والياء والتاء في الثالث قريبتان، والاختيار الياء لقوله" من ربّهم" والياء والتاء في الرابع متساويتان؛ لأنّه لم يتقدّم في قوله { وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ} ما تكون إحداهما أو لى بالردّ عليه، إلّا أن يجعل قوله " من ربّك" إفرادا للنبيّ عليه السلام بالخطاب، والمعنى له ولأمّته، فيكون الاختيار على هذا الوجه التاء، كما قال اللّه تعالى :
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق : 1] «12» . فها هنا تحرّ لمقام النبي- صلّى اللّه عليه وآله وسلم- (إفرادا للنّبي بالخطاب) ونلحظ فيه كذلك توخيهم لعمليّة الاتّساق الداخلي في النصّ، وكذلك استحضارهم لسنن العرب في كلامها من حيث (إنّ العرب ترجع من المخاطبة إلى الغيبة).
ويستحضر دارسوالقراءات (عنصر المعنى) في توجيه الخطاب القرآني واختلاف هذا العنصر باختلاف القراءة أو العكس، أي اختلاف القراءة باختلاف توجيه المعنى.
وأمثلته عديدة، ومنها في قوله تعالى : {لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ } [البقرة : 83] تقرأ بالياء والتاء فالحجّة لمن قرأ بالتاء : مواجهة الخطاب فيكون أخذ الميثاق قولا لهم، والحجّة لمن قرأ بالياء معنى الغيبة" «13». ومنه كذلك الآية الكريمة {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة : 106]. فإنّه " يقرأ بضمّ النون وفتحها، فالحجّة لمن ضمّ أنّ المعنى" ما ننسخك يا محمّد من آية" كقولك أنسخت زيدا الكتاب، ويجوز أن يكون" ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ" أي تجعلها ذات نسخ كقوله تعالى (فأقبره)، أي جعله ذا قبر، والحجّة لمن فتح أنّه جعله من الأفعال اللازمة لمفعول واحد" «14». ومنه كذلك توجيه الخطاب بحسب المخاطب ومعنى الخطاب في قراءة الآية" أَمْ يَقُولُونَ". تقرأ بالتاء والياء؛" فالحجّة لمن قرأه بالياء أنّ الخطاب- للنبي- صلّى اللّه عليه وآله وسلم- والمعنى لمن قال ذلك- لا للنبيّ- فأخبر عنهم بما قالوه، والحجّة لمن قرأ بالتاء أنّه عطف باللّفظ على معنى الخطاب في قوله" أ تحاجّوننا"،" أم تقولون"،" قل أأنتم" فأتى بالكلام على سياقه" «15».
ومن أمثلة توجيه الخطاب بحسب المخاطب أو موضوع الخطاب قراءة الآية (165) من سورة البقرة" ولوترى الذين ظلموا" تقرأ بالتاء والياء فالحجّة لمن قرأ بالتاء أنه أراد : ولوترى يا محمد الذين ظلموا إذ عاينوا العذاب لرحمتهم، والحجّة لمن قرأ بالياء أنه جعل الفعل لهم، ومعناه، ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أنّ القوّة للّه" «16».
ويتحكّم بتوجيه الخطاب في القراءة أحيانا استحضار سياق الحال، كأن تأتي الآية جوابا على سؤال محدّد، فإذا ما تغيّر السؤال تغيّرت الإجابة، وفي حالتنا هذه تغيّرت القراءة، ومن أمثلته كذلك قراءة الآية" لا بيع فيه ولا خلّة- ولا شفاعة" (يقرأ ذلك بالرفع والتنوين، وبالنّصب وترك التنوين؛ فالحجّة لمن رفع أنّه جعله جوابا لقول قائل :
هل عندك رجل؟ فقال لا رجل، فلم يعمل (لا) لأنّ (هل) غير عاملة، والحجّة لمن نصب أنّه جعله جوابا لقول قائل : هل من رجل؟ فقال (لا رجل) لأنّ (من) لمّا كانت عامله في الاسم كان الجواب عاملا فيه النّصب، وسقط التنوين للبناء، كما سقط في" رام هرمز" «17».
ويدخل في هذا الإطار أيضا قراءة الآية الكريمة : {قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة : 219]. يقرأ بالرفع والنّصب" فمن رفع جعل (إذا) منفصلة من (ما) فيكون بمعنى (الذي) فكأنّه قال : ما الذين ينفقون؟ فقال : الذي ينفقون : العفو، فترفعه بخبر الابتداء لأنّه جعل الجواب من حيث سألوا والحجّة لمن نصب أنّه جعل (ما ذا) كلمة واحدة، ونصب العفوبقوله (ينفقون) كأنّه قال : ينفقون العفو" «18». فاستحضار موقف خطاب فيه حوار بين طرفين قد يوضح مجيء النصّ بهذه الصياغة اللّغويّة تلبية لمتطلّبات ذلك الخطاب الذي يحمل جوّا سياقيّا معيّنا، وهوأسلوب يلجأ إليه علماء القرآن والمفسّرون عادة في توضيح صيغ القرآن وأساليبه.
وتوجيه الخطاب يترتّب عليه توجيه الأحكام وتغييرها، ومن ذلك قراءة الآية (184) من سورة البقرة في قوله" فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ" يقرأ بالتنوين والتوحيد، وبالإضافة والجمع؛ فالحجّة لمن رفع ووحّد أنّ الفدية مبتدأ وطعام بدل منها ومسكين واحد، لأنّ عليه عن كل يوم يفطره إطعام مسكين، والحجّة لمن أضاف وجمع أنّه جعل الفدية عن أيام متتابعة لا عن يوم واحد" «19».
ومن العناصر السياقية التي يوليها دارسوالقراءات أهمية بالغة" مقصد الخطاب" فالخطاب يتشكّل بحسب مقصد واضع النصّ ، والهدف المقصود من أيّ خطاب يتحقّق إذا توافرت الآليّات اللّغويّة المناسبة لإيصاله إلى المخاطب. ومن ذلك قوله تعالى : "أو ننسأها " فإنّه يقرأ بفتح النون والهمز، وبضمّها وترك الهمز، فالحجّة لمن فتح النون وهمز أنّه جعله من التأخير أو من الزيادة ومنه قولهم : (نسأ اللّه أجلك، وأنسأ في أجلك، والحجّة لمن ضمّ وترك الهمز، أنّه أراد الترك، يريد أو نتركها فلا ننسخها، وقوله { نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها} قيل :
بأخفّ منها في العبادة، وقيل : نبدل آية العذاب بآية رحمة، فذلك خير، وقيل : بل بأشدّ منها لأنّه تخويف من اللّه لعباده، وترغيب فيما عنده وذلك خير، فإن قيل : ما معنى قوله :
" أو مثلها" فقل : المماثلة، موافقة الشيء من وجه من الوجوه، ولوماثله من جميع وجوهه لكان هو، ولم يكن له مثلا، والمعنى هنا أنّها قرآن مثلها، وهي في المعنى غيرها، لأنّ هذه آية رحمة، وهذه آية عذاب" «20». فاختلاف مقصد الخطاب ما بين الرحمة والعذاب جعل القراءة تختلف وهذا ما التمسه دارسوهذه القراءات.
ومن أمثلته كذلك اختلافهم في قراءة الآية (119) من سورة البقرة" وَ لا تُسْئَلُ" ما بين رفع وجزم وتوجيه الآية يتمّ بحسب مقصد الخطاب، فمن جعل مقصد الآية الإخبار فقد رفع، ومن جعل المقصد النهي فقد جزم، وفي قراءة الآية (125) من سورة البقرة" وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى" تقرأ بكسر الخاء وفتحها، فمن كسر فقد اعتبر أنّ مقصد الخطاب هوالأمر، ومن فتح اعتبر أنّ المقصد هوالإخبار" أخبر اللّه عنهم بذلك بعد أن فعلوه" «21».
وكذا في توجيه قراءة الآية" وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ" فقد قرئت بالإفراد والجمع، فمن جمعها ففي سياق الرحمة، ومن أفردها فقد جعلها في سياق العذاب، ومن أمثلة تحكّم مقصد الخطاب في توجيه القراءة أيضا قوله تعالى { وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة : 259]." يقرأ (أعلم) بقطع الألف والرفع، وبوصلها والوقف؛ فالحجّة لمن قطع أنّه جعله من إخبار المتكلّم عن نفسه، والحجّة لمن وصل أنّه جعله من أمر اللّه تعالى للمخاطب" «22». وإذن فتوجيه الخطاب تتداخل فيه عوامل عديدة ومنها استحضار المخاطب، أو المخاطب، أو طبيعة الخطاب، أو مقصد الخطاب، أو السياق المقامي المحيط بذلك الخطاب.
نخلص من هذا المبحث إلى أنّ علماء القرآن قد تتبعوا العلاقة بين النص والسياق في سورة البقرة في صورتيها : الاتساق المقامي، والاتساق الداخلي؛ فدرسوا في السياق المقامي : ظروف تنزيل سورة البقرة مكانا وزمانا وأسباب نزول ومخاطبين، كما أبانوا عن أثر هذه الظروف داخل سورة البقرة، ودرسوا في هذا الشأن كذلك مسألة النسخ، والآيات المنسوخة في السورة الكريمة، وكان توجيههم في القول بالنسخ أو عدمه محكوما في الغالب بظروف السياق المقامي للنص، وأما فيما يتعلق بالسياق الداخلي فدرسوا التناسب بين آيات سورة البقرة وفاتحتها وخاتمتها وترابط آياتها، كما درسوا السياق اللغوي في النص وعلاقته بالمقام، ونظروا في مفردات السورة، وشرحوا غريبها بالاستعانة بالسياق.
وأظهر علماء القراءات دور السياق في توجيه قراءات هذه السورة الكريمة من خلال مراعاة العرف اللغوي ، والسياق الصوتي ، ومقصد الخطاب ، والمشاكلة بين الألفاظ ، واستحضار السياق المقامي للنص الكريم .
_____________________
(1) الأصفهاني ، المفردات، ص 67.
(2) ابن خالويه ، الحجّة في القراءات السبع، ص 67.
(3) ابن خالويه ، الحجّة في القراءات السبع، ص 96.
(4) ابن خالويه ، الحجّة في القراءات ، ص 99.
(5) ابن خالويه ، الحجة في القراءات ، ص 96.
(6) ابن خالويه ، الحجة في القراءات ، ص 105.
(7) ابن خالويه ، الحجّة في القراءات ، ص (68-69).
(8) نفسه، ص (75).
(9) ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع ، ص (105).
(10) نفسه، ص : 74.
(11) ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع ، ص 77.
(12) ابن خالويه ، الحجّة في القراءات السبع ، ص (83).
(13) ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبع ، ص (83).
(14) ابن خالويه ، ص 26.
(15) ابن خالويه ، ص 89.
(16) نفسه، ص 91.
(17) ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبع ، ص 99.
(18) ابن خالويه ، الحجة في القراءات ، ص 96.
(19) نفسه، ص 93.
(20) ابن خالويه ، الحجة في القراءات ، ص 87.
(21) نفسه ، ص 87.
(22) ابن خالويه ، الحجة في القراءات ، ص 9.



|
|
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|