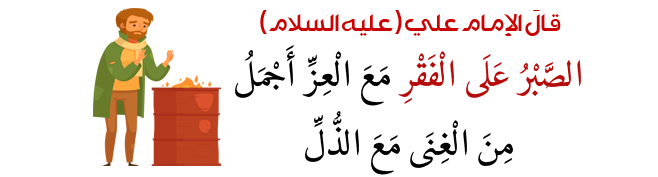
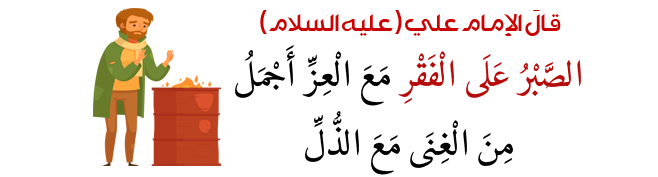

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-11-2017
التاريخ: 4-4-2021
التاريخ: 7-11-2017
التاريخ: 6-11-2017
|
قال تعالى : {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ} [الأنعام : 122 - 124] .
قال تعالى : {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ} [الأنعام : 122 - 123] .
ذكر سبحانه مثل الفريقين فقال {أو من كان ميتا فأحييناه} أي : كافرا فأحييناه ، بأن هديناه إلى الإيمان ، عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، شبه سبحانه الكفر بالموت ، والإيمان بالحياة ، وقيل : معناه من كان نطفة فأحييناه ، كقوله : {وكنتم أمواتا فأحياكم} {وجعلنا له نورا يمشي به في الناس} قيل فيه وجوه أحدها : إن المراد بالنور : العلم والحكمة ، سمى سبحانه ذلك نورا ، والجهل ظلمة ، لأن العلم يهتدى به إلى الرشاد ، كما يهتدى بالنور في الطرقات . وثانيها : إن المراد بالنور هنا القرآن ، عن مجاهد وثالثها : إن المراد به الإيمان ، عن ابن عباس .
{كمن مثله في الظلمات} لم يقل سبحانه كمن هو في الظلمات (2) تقديره كمن مثله مثل من هو في الظلمات ، يعني به الكافر الذي هو في ظلمة الكفر . وقيل : معناه كمن هو في ظلمات الكفر {ليس بخارج منها} لكنه ذكره بلفظ المثل ليبين أنه بلغ في الكفر والحيرة غاية يضرب به المثل فيها ، وإنما سمى الله تعالى الكافر ميتا ، لأنه لا ينتفع بحياته ، ولا ينتفع غيره بحياته ، فهو أسوأ حالا من الميت ، إذ لا يوجد من الميت ما يعاقب عليه ، ولا يتضرر غيره به ، وسمى المؤمن حيا ، لأن له ولغيره المصلحة والمنفعة في حياته ، وكذلك سمى الكافر ميتا والمؤمن حيا ، في عدة مواضع ، مثل قوله {إنك لا تسمع الموتى ولينذر من كان حيا} وقوله {وما يستوي الأحياء ولا الأموات} وسمى القرآن ، والإيمان ، والعلم : نورا ، لأن الناس يبصرون بذلك ، ويهتدون به من ظلمات الكفر ، وحيرة الضلالة ، كما يهتدى بسائر الأنوار ، وسمى الكفر ظلمة ، لأن الكافر لا يهتدي بهداه ، ولا يبصر أمر رشده ، وهذا كما سمى الكافر أعمى في قوله {أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى} وقوله {وما يستوي الأعمى والبصير} .
{كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون} وجه التشبيه بالكافر أن معناه زين لهؤلاء الكفر ، فعملوه ، مثل ما زين لأولئك الإيمان فعملوه ، فشبه حال هؤلاء في التزيين بحال أولئك فيه كما قال سبحانه : {كل حزب بما لديهم فرحون} . وروي عن الحسن أنه قال زينه . والله لهم الشيطان وأنفسهم ، واستدل بقوله {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} وقوله {زين} لا يقتضي مزينا غيرهم ، لأنه بمنزلة قوله تعالى : {أني يصرفون وأنى يؤفكون} وقول العرب أعجب فلان بنفسه ، وأولع بكذا ، ومثله كثير .
{وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر} أي : مثل ذلك الذي قصصنا عليك ، زين للكافرين عملهم ، ومثل ذلك جعلنا في كل قرية أكابر {مجرميها} وجعلنا ذا المكر من المجرمين ، كما جعلنا ذا النور من المؤمنين ، فكل ما فعلنا بهؤلاء ، فعلنا بأولئك ، إلا أن أولئك اهتدوا بحسن اختيارهم ، وهؤلاء ضلوا بسوء اختيارهم ، لأن في كل واحد منهم الجعل بمعنى الصيرورة ، إلا أن الأول باللطف ، والثاني بالتمكين من المكر .
وإنما خص أكابر المجرمين بذلك دون الأصاغر لأنه أليق بالاقتدار على الجميع ، لأن الأكابر إذا كانوا في قبضة القادر ، فالأصاغر بذلك أجدر ، واللام في قوله {ليمكروا فيها} لام العاقبة ويسمى لام الصيرورة ، كما في قوله سبحانه {ليكون لهم عدوا وحزنا} ، وكما قال الشاعر :
فأقسم لو قتلوا مالكا لكنت لهم حية راصدة
وأم سماك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالدة
{وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون} لأن عقاب ذلك يحل بهم ، ولا يصح أن يمكر الانسان بنفسه على الحقيقة ، لأنه لا يصح أن يخفى عن نفسه معنى ما يحتال به عليها ، ويصح أن يخفى ذلك عن غيره ، وفائدة الآية : إن أكابر مجرميها ، لم يمكروا بالمؤمنين على وجه المغالبة لله ، إذ هم كأنه سبحانه جعلهم ليمكروا ، وهذه مبالغة في انتفاء صفة المغالبة .
- {وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ} [الأنعام : 124] .
ثم حكى سبحانه عن الأكابر الذين تقدم ذكرهم واقتراحاتهم الباطلة ، فقال : {وإذا جاءتهم آية} أي : دلالة معجزة من عند الله تعالى ، تدل على توحيده ، وصدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم {قالوا لن نؤمن} أي : لن نصدق بها {حتى نؤتى} أي : نعطى آية معجزة {مثل ما أوتي} أي : أعطي {رسل الله} حسدا منهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم أخبر سبحانه على وجه الانكار عليهم بقوله : {الله أعلم حيث يجعل رسالته} أنه أعلم منهم ، ومن جميع الخلق بمن يصلح لرسالاته ، ويتعلق مصالح الخلق ببعثه ، وأنه يعلم من يقوم بأعباء الرسالة ، ومن لا يقوم بها ، فيجعلها عند من يقوم بأدائها ، ويحتمل ما يلحقه من المشقة والأذى على تبليغها .
ثم توعدهم سبحانه ، فقال : {سيصيب} أي : سينال {الذين أجرموا} أي : انقطعوا إلى الكفر ، وأقدموا عليه ، يعني بهم المشركين من أكابر القرى الذين سبق ذكرهم {صغار عند الله} أي : سيصيبهم عند الله ذل ، وهوان ، وإن كانوا أكابر في الدنيا ، عن الزجاج . ويجوز أن يكون المعنى سيصيبهم صغار معد لهم عند الله ، أو سيصيبهم أن يصغروا عند الله {وعذاب شديد بما كانوا يمكرون} في الدنيا أي : جزاء على مكرهم .
______________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 151-156 .
2 . [لان] .
{ أَومَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها } . هذا مثل ضربه اللَّه تعالى للمقارنة بين المؤمن والكافر ، وتوضيحه ان المقارنة بينهما تماما كالمقارنة بين الموت والحياة ، والنور والظلام ، فالكافر ميت ، فإذا آمن بعث من جديد وعادت إليه الحياة ، وإيمانه نور يمشي به في حياته على بصيرة من أمره ، ومن بقي على الكفر والشرك فهو كمن يتخبط في الظلمات ، يسير على غير هدى ، ولا يصل إلى خير مدى حياته كلها .
المسؤولية والسائل الأعلى :
قد يقول القائل : ان الآية شبهت الإيمان بالحياة ، والكفر بالموت ، مع أن الكافرين والملحدين في هذا العصر أكثر ثراء ورفاهية من المؤمنين والعابدين ؟ .
الجواب : ليس المراد بالحياة في هذه الآية أن يعيش الإنسان في النعيم والرفاهية ، فيأكل طيبا ، ويلبس ثمينا ، ويشرب سائغا . . ان الرفاهية لا تناط بالكفر ولا بالإيمان ، والا كان المؤمنون سواء في الشرق والغرب من حيث الحضارة والرفاهية ، وكذلك الملحدون والكافرون ، ان للرفاهية أسبابا وملابسات لا تمت إلى الإيمان والكفر بسبب . . وانما المراد بالحياة في الآية الايمان والشعور الديني الذي يدفع بصاحبه إلى القيام بالواجب كإنسان مسؤول عن سلوكه ، يحاسب عليه ويكافأ على إحسانه بالثواب ، وإساءته بالعقاب .
ولو كان الإنسان غير مسؤول عن شيء لكانت الشرائع والقوانين ألفاظا بلا معان . . ومتى سلمنا بأن الإنسان مسؤول ، ولا يترك سدى يلزمنا حتما أن نسلم بأنه مسؤول أمام من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . . ولو كان هذا السائل مسؤولا لوجب وجود سائل له ، وهكذا إلى ما لا نهاية .
ومن كفر بوجود السائل الأعلى الذي يسأل ولا يسأل فقد كفر بالمسؤولية ونفاها من الأساس ، لأنه لا مسؤولية من غير سائل ، ومن كفر بالمسؤولية فقد كفر بالحياة الاجتماعية .
وتقول : أجل ، ان الإنسان مسؤول ، ولكن ليس من الضروري أن يكون السائل هو اللَّه ، فللناس أن يختاروا هيئة منهم يكون الإنسان مسؤولا أمامها . .
ونسأل بدورنا : إذا أخطأت هذه الهيئة فمن يسألها ويحاسبها ، وان قيل :
الوجدان ، قلنا : أولا الوجدان أمر معنوي لا عيني . وثانيا : ان الوجدان مشاع يدعيه كل واحد ، فلما ذا يترك هذا لوجدانه دون ذاك ؟ إذن ، لا سائل غير مسؤول إلا اللَّه وحده ، فمن آمن باللَّه وألزم نفسه بشريعته وأحكامه فقد سار على بصيرة من أمره في عقيدته وسلوكه وإلا كان مثله كمن يمشي في الظلمات ليس بخارج منها .
{ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ } . أي مثل ما زيّن للمؤمنين أعمالهم أيضا زيّن للمشركين أعمالهم ، والفرق أن تزيين أولئك انعكاس عن الواقع ، وتزيين هؤلاء وهم وخيال .
{ وكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها } . المراد بالقرية كل مجتمع من الناس قلّ أو كثر ، والمعنى انه كما وجد في مجتمعك يا محمد رؤوس للإجرام تمكر وتنصب العداء لدين اللَّه كذلك وجد في المجتمعات السابقة ، ويوجد في اللاحقة أيضا رؤساء يمكرون بأمتهم ، ويقفون موقف العداء للحق وأهله .
وتسأل : ظاهر الآية يدل على ان اللَّه سبحانه هو الذي جعل أكابر المجرمين يجرمون ويمكرون بأهل الحق ، مع العلم بأنه تعالى ينهى عن المكر والإجرام ، ويعاقب عليهما ، فما هو التأويل ؟ .
الجواب : ان القصد من هذه النسبة إليه جل ثناؤه هو الإشارة إلى أن مشيئة اللَّه قضت بأن تقوم السنن الاجتماعية على أساس التناقض بين المحقين والمبطلين ، بين أرباب السلطان المعتدين ، وبين الناس المعتدى عليهم ، ولا مفر من هذا التناقض والصراع إلا بالقضاء على المجرمين ، ولا بد أن يتم ذلك ، وتعلو كلمة الحق على أيدي دعاة العدل والصلاح ، مهما تضخم الباطل واستطال ، وقد سجل سبحانه ذلك في كتابه ، حيث قال عز من قائل : {ولا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} [فاطر - 43] . ان هذا التكرار تأكيد قاطع بأن العاقبة للمتقين على المجرمين ، مهما طال الزمن ، وبهذا نجد تفسير قوله تعالى : { لِيَمْكُرُوا فِيها وما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وما يَشْعُرُونَ } .
{ وإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ } .
اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على قولين : الأول ان أكابر المجرمين من العرب اقترحوا على محمد ( صلى الله عليه وآله ) أن يأتيهم من المعجزات مثل ما أوتي موسى من فلق البحر ، وعيسى من إحياء الموتى . القول الثاني : انهم قالوا له : لن نؤمن حتى ينزل علينا الوحي كما نزل على الأنبياء . وقال الرازي : هذا القول مشهور بين المفسرين . ونحن نرجحه على الأول لأن سياق الآية يدل عليه ، حيث رد سبحانه على أكابر المجرمين بقوله : { اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ } .
بالإضافة إلى أن طلبهم أن ينزل اللَّه الوحي عليهم يتلاءم مع حسدهم لرسول اللَّه . قال تعالى في الآية 54 من سورة النساء : {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} . وفي مجمع البيان وغيره ، ان الوليد بن المغيرة قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك ، لأني أكبر منك سنا ، وأكثر منك مالا .
ومعنى قوله : { اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ } واضح ، وهو انه تعالى يختار لرسالته من يصلح لها من خلقه ، ومحمد أكرم خلق اللَّه وأشرفهم .
{ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ } لأنهم استعلوا وتعاظموا ، فاستحقوا الجزاء بالاحتقار والاذلال ، وفي بعض الروايات : ان المتكبرين يحشرون في صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء على تعاظمهم في الدنيا { وعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ } . فالصغار جزاء التكبر ، والعذاب جزاء المكر والخداع ، وبكلمة ان اللَّه سبحانه يعامل أرباب النوايا الخبيثة ، والأهداف الفاسدة بعكس ما يقصدون ويهدفون .
___________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 257-260 .
قوله تعالى : {أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها} الآية واضحة المعنى وهي بحسب ما يسبق إلى الفهم البسيط الساذج مثل مضروب لكل من المؤمن والكافر يظهر بالتدبر فيه حقيقة حاله في الهدى والضلال .
فالإنسان قبل أن يمسه الهدى الإلهي كالميت المحروم من نعمة الحياة الذي لا حس له ولا حركة فإن آمن بربه إيمانا يرتضيه كان كمن أحياه الله بعد موته ، وجعل له نورا يدور معه حيث دار يبصر في شعاعه خيره من شره ونفعه من ضره فيأخذ ما ينفعه ويدع ما يضره وهكذا يسير في مسير الحياة .
وأما الكافر فهو كمن وقع في ظلمات لا مخرج له منها ولا مناص له عنها ظلمة الموت وما بعد ذلك من ظلمات الجهل في مرحلة تمييز الخير من الشر والنافع من الضار ، ونظير هذه الآية في معناها بوجه قوله تعالى : {إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ} [الأنعام : 36] وقال تعالى : {مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً} [النحل : 97] .
ففي الكلام استعارة الموت للضلال واستعارة الحياة للإيمان أو الاهتداء والإحياء للهداية إلى الإيمان والنور للتبصر بالأعمال الصالحة ، والظلمة للجهل كل ذلك في مستوى التفهيم والتفهم العموميين لما أن أهل هذا الظرف لا يرون للإنسان بما هو إنسان حياة وراء الحياة الحيوانية التي هي المنشأ للشعور باللذائذ المادية والحركة الإرادية نحوها .
فهؤلاء يرون أن المؤمن والكافر لا يختلفان في هذه الموهبة وهي فيهما شرع سواء فلا محالة عد المؤمن حيا بحياة الإيمان ذا نور يمشي به في الناس ، وعد الكافر ميتا بميتة الضلال في ظلمات لا مخرج منها ليس إلا مبتنيا على عناية تخييلية واستعارة تمثيلية يمثل بها حقيقة المعنى المقصود .
لكن التدبر في أطراف الكلام والتأمل فيما يعرفه القرآن الكريم يعطي للآية معنى وراء هذا الذي يناله الفهم العامي فإن الله سبحانه ينسب للإنسان الإلهي في كلامه حياة خالدة أبدية لا تنقطع بالموت الدنيوي هو فيها تحت ولاية الله محفوظ بكلاءته مصون بصيانته لا يمسه نصب ولا لغوب ، ولا يذله شقاء ولا تعب ، مستغرب في حب ربه مبتهج ببهجة القرب لا يرى إلا خيرا ، ولا يواجه إلا سعادة وهو في أمن وسلام لا خوف معه ولا خطر ، وسعادة وبهجة ولذة لا نفاذ لها ولا نهاية لأمدها .
ومن كان هذا شأنه فإنه يرى ما لا يراه الناس ، ويسمع ما لا يسمعونه ، ويعقل ما لا يعقلونه ، ويريد ما لا يريدونه وإن كانت ظواهر أعماله وصور حركاته وسكناته تحاكي أعمال غيره وحركاتهم وسكناتهم وتشابهها فله شعور وإرادة فوق ما لغيره من الشعور والإرادة فعنده من الحياة التي هي منشأ الشعور والإرادة ما ليس عند غيره من الناس فللمؤمن مرتبة من الحياة ليست عند غيره .
فكما أن العامة من الإنسان في عين أنها تشارك سائر الحيوان في الشعور بواجبات الحياة والحركة الإرادية نحوها ، ويشاركها الحيوان لكنا مع ذلك لا نشك أن الإنسان نوع أرقى من سائر الأنواع الحيوانية وله حياة فوق الحياة التي فيها لما نرى في الإنسان آثاره العجيبة المترشحة من أفكار الكلية وتعقلاته المختصة به ، ولذلك نحكم في الحيوان إذا قسناه إلى النبات وفي النبات إذا قسناه إلى ما قبله من مراتب الكون أن لكل منهما كعبا أعلى وحياة هي أرقى من حياة ما قبله .
فلنقض في الإنسان الذي أوتي العلم والإيمان واستقر في دار الإيقان واشتغل بربه وفرغ واستراح من غيره وهو يشعر بما ليس في وسع غيره ويريد ما لا يناله سواه أن له حياة فوق حياة غيره ، ونورا يستمد به في شعوره ، وإرادة لا توجد إلا معه وفي ظرف حياته .
يقول الله سبحانه : {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً} [النحل : 97] فلهم الحياة لكنها بطبعها طيبة وراء مطلق الحياة {ويقول : {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ} [الأعراف : 179] فيثبت لهم أمثال القلوب والأعين والآذان التي في المؤمنين لكنه ينفي كمال آثارها التي في المؤمنين ، ولم يكتف بذلك حتى أثبت لهم روحا خاصا بهم فقال : {أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة : 22] .
فتبين بذلك أن للحياة وكذا للنور حقيقة في المؤمن واقعية وليس الكلام جاريا على ذاك التجوز الذي لا يتعدى مقام العناية اللفظية فما في خاصة الله من المؤمنين من الصفة الخاصة بهم أحق باسم الحياة مما عند عامة الناس من معنى الحياة كما أن حياة الإنسان كذلك بالنسبة إلى حياة الحيوان ، وحياة الحيوان كذلك بالنسبة إلى حياة النبات .
فقوله : {أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ} أي ضالا من حيث نفسه أو ضالا كافرا قبل أن يؤمن بربه وهو نوع من الموت فأحييناه بحياة الإيمان أو الهداية ـ والمال واحد ـ وجعلنا له نورا أي علما متولدا من إيمانه كما قال صلى الله عليه وآله فيما رواه الفريقان : {من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم ـ أو علمه الله ما لم يعلم} . فإن روح الإيمان إذا تمكنت من نفس الإنسان واستقرت فيها حولت الآراء والأعمال إلى صور تناسبها ولا تخالفها وكذلك سائر الملكات أعم من الفضائل والرذائل إذا استقرت في باطن الإنسان لم تلبث دون أن تحول آراءه وأعماله إلى أشكال تحاكيها .
وربما قيل : إن المراد بالنور هو الإيمان أو القرآن وهو بعيد من السياق .
وهذا النور أثره في المؤمن أنه {يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ} أي يتبصر به في مسير حياته الاجتماعية المظلمة ليأخذ من الأعمال ما ينفعه في سعادة حياته ، ويترك ما يضره .
فهذا هو حال المؤمن في حياته ونوره فهل هو {كَمَنْ مَثَلُهُ} ووصفه أنه { فِي الظُّلُماتِ} ظلمات الضلال وفقدان نور الإيمان {لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها} لأن الموت لا يستتبع آثار الحياة البتة فلا مطمع في أن يهتدي الكافر إلى أعمال تنفعه في أخراه وتسعده في عقباه .
وقد ظهر مما تقدم أن قوله : {كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ} إلخ ، في تقدير : هو في الظلمات ليس بخارج منها ، ففي الكلام مبتدأ محذوف هو الضمير العائد إلى الموصول ، وقيل : التقدير : كمن مثله مثل من هو في الظلمات ، ولا بأس به لو لا كثرة التقدير .
قوله تعالى : {كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ} ظاهر سياق صدر الآية أن يكون التشبيه في قوله : {كَذلِكَ} من قبيل تشبيه الفرع بالأصل بعناية إعطاء القاعدة الكلية كقوله تعالى : {كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ} وقوله : {كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ} [الرعد : 17] أي اتخذ ما ذكرناه من المثل أصلا وقس عليه كل ما عثرت به من مثل مضروب فمعنى قوله : {كَذلِكَ زُيِّنَ} إلخ ، على هذا المثال المذكور أن الكافر لا مخرج له من الظلمات ، زين للكافرين أعمالهم فقد زينت لهم أعمالهم زينة تجذبهم إليها وتحبسهم ولا تدعهم يخرجوا منها إلى فضاء السعادة وفسحة النور أبدا والله لا يهدي القوم الظالمين .
وقيل : إن وجه التشبيه في قوله : {كَذلِكَ زُيِّنَ} إلخ ، أنه زين لهؤلاء الكفر فعملوه مثل ما زين لأولئك الإيمان فعملوه . فشبه حال هؤلاء في التزيين بحال أولئك فيه (انتهى) وهو بعيد من سياق الصدر .
قوله تعالى : {وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها} إلى آخر الآية ، كأن المراد بالآية أنا أحيينا جمعا وجعلنا لهم نورا يمشون به في الناس ، وآخرين لم نحيهم فمكثوا في الظلمات فهم غير خارجين منها ولا أن أعمالهم المزينة تنفعهم وتخلصهم منها كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها بالدعوة الدينية والنبي والمؤمنين لكنه لا ينفعهم فإنهم في ظلمات لا يبصرون بل إنما يمكرون بأنفسهم ولا يشعرون .
وعلى هذا فقوله : {كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ} مسوق لبيان أن أعمالهم المزينة لهم لا تنفعهم في استخلاصهم من الظلمات التي هم فيها ، وقوله : {وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ} إلخ ، مسوق لبيان أن أعمالهم ومكرهم لا يضر غيرهم إنما وقع مكرهم على أنفسهم وما يشعرون لمكان ما غمرهم من الظلمة .
وقيل : معنى التشبيه في الآية أن مثل ذلك الذي قصصنا عليك زين للكافرين عملهم ، ومثل ذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ، وجعلنا ذا المكر من المجرمين كما جعلنا ذا النور من المؤمنين فكل ما فعلنا بهؤلاء فعلنا بهم إلا أن أولئك اهتدوا بحسن اختيارهم وهؤلاء ضلوا بسوء اختيارهم لأن في كل واحد منهما الجعل بمعنى الصيرورة إلا أن الأول باللطف والثاني بالتمكين من المكر [انتهى] . ولا يخلو من بعد من السياق .
والجعل في قوله : {جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها} كالجعل في قوله : {وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً} فالأنسب أنه بمعنى الخلق ، والمعنى : خلقنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكون مكرهم غاية للخلقة وغرضا للجعل نظير كون دخول النار غرضا إلهيا في قوله : {وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} [الأعراف : 179] وقد مر الكلام في معنى ذلك في مواضع من هذا الكتاب . وإنما خص بالذكر أكابر مجرميها لأن المطلوب بيان رجوع المكر إلى ما كره ، والمكر بالله وآياته إنما يصدر منهم ، وأما أصاغر المجرمين وهم العامة من الناس فإنما هم أتباع وأذناب .
وأما قوله : {وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ} فذلك أن المكر هو العمل الذي يستبطن شرا وضرا يعود إلى الممكور به فيفسد به غرضه المطلوب ويضل به سعيه ويبطل نجاح عمله ، ولا غرض لله سبحانه في دعوته الدينية ، ولا نفع فيها إلا ما يعود إلى نفس المدعوين فلو مكر الإنسان مكرا بالله وآياته ليفسد بذلك الغرض من الدعوة ويمنع عن نجاح السعي فيها فإنما مكر بنفسه من حيث لا يشعر : واستضر بذلك هو نفسه دون ربه .
قوله تعالى : {وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ ـ إلى قوله ـ رِسالَتَهُ} قولهم : {لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ} يريدون به أن يؤتوا نفس الرسالة بما لها من مواد الدعوة الدينية دون مجرد المعارف الدينية من أصول وفروع وإلا كان اللفظ المناسب له أن يقال : {مثل ما أوتي أنبياء الله} أو ما يشاكل ذلك كقولهم : {لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ} [البقرة : 118] وقولهم : {لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا} [الفرقان : 21] .
فمرادهم أنا لن نؤمن حتى نؤتى الرسالة كما أوتيها الرسل ، وفيه شيء من الاستهزاء فإنهم ما كانوا قائلين بالرسالة فهو بوجه نظير قولهم : {لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف : 31] كما أن جوابه نظير جوابه وهو قوله تعالى : {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} [الزخرف : 32] كقوله : {اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ} .
ومما تقدم يظهر أن الضمير في قوله : {وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا} إلخ ، عائد إلى {أَكابِرَ مُجْرِمِيها} في الآية السابقة ، إذ لو رجع إلى عامة المشركين لغا قولهم : {حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ} إذ لا معنى لرسالة جميع الناس حيث لا أحد يرسلون إليه ، ولم يقع قوله : {اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ} موقعه بل كان حق الجواب أنه لغو من القول كما عرفت .
ويؤيده الوعيد الذي في ذيل الآية : {سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ} حيث وصفهم بالإجرام وعلل الوعيد بمكرهم ، ولم ينسب المكر في الآية السابقة إلا إلى أكابر مجرميها ، والصغار الهوان والذلة .
___________________________
1. تفسير الميزان ، ج7 ، ص 286-290 .
قال تعالى : {أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ * وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ} [الأنعام : 122-123] .
الإيمان والرّؤية الواضحة :
ترتبط هذه الآية بالآيات السابقة من حيث كون الآيات السابقة أشارت إلى طائفتين من الناس : المؤمنين المخلصين ، والكافرين المعاندين الذين لا يكتفون بضلالهم ، بل يسعون حثيثا إلى تضليل الآخرين ، هنا أيضا يتجسد وضع هاتين الطائفتين من خلال ضرب مثل واضح .
يشير المثال إلى طائفة من الناس كانوا من الضّالين ، ثمّ غيروا مسيرتهم باعتناق الإسلام فهؤلاء أشبه بالميت الذي يحييه الله بإرادته : {أَوَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ} .
كثيرا ما يستعمل القرآن «الموت» و «الحياة» بالمدلول المعنوي لهما لتمثيل الكفر والإيمان ، وهذا يدل على أنّ الإيمان ليس مجرّد معتقدات جافة وأوراد وطقوس ، بل هو بمثابة الروح التي تحل في النفوس الميتة غير المؤمنة ، فتؤثر عليها في جميع شؤونها ، وتمنح العيون الرؤية ، والآذان قدرة السمع ، واللسان قوة البيان ، والأطراف العزم على أداء النشاطات البناءة . . . الإيمان يغير الأفراد ، ويشمل هذا التغيير كل جوانب الحياة ، وتبدو آثاره في كل الحركات والسكنات .
وتفيد جملة {فَأَحْيَيْناهُ} أنّ الإيمان ـ وإن استلزم سعي الإنسان لنيله ـ لا يتم إلّا بهداية من الله ! ثمّ تقول الآية عن أمثال هؤلاء : {وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ} .
على الرغم من وجود الاختلاف في تفسير هذا «النّور» فالظاهر أنّ المقصود ليس القرآن وتعاليم الشرع فحسب ، بل أكثر من ذلك ، حيث يمنح الإيمان بالله الإنسان رؤية وإدراكا جديدين . . . يمنحه رؤية واضحة ويوسع من آفاق نظرته لتتجاوز إطار حياته المادية وجدران عالم المادة الضيق إلى عالم أرحب وأوسع .
ولما كان الإيمان يدعو الإنسان إلى أن يبني نفسه ، فانه يزيح عن عينيه أغشية الأنانية والتعصب والمعاندة والأهواء ، ويريه حقائق ما كان قادرا على إدراكها من قبل .
إنّه في ضوء هذه النّور يستطيع أن يميز مسيرة حياته بين الناس ، وأنّ يصون نفسه ويحافظ عليها ويحصنها ضد ما يقع فيه الآخرون من أخطار الطمع والجشع والأفكار المادية المحدودة ، والوقوف بوجه أهوائه وكبح جماحها .
إنّ ما نقرأه في الأحاديث الإسلامية من أنّ «المؤمن ينظر بنور الله» إشارة إلى هذه الحقيقة ، إنّ مجرّد الوصف غير قادر على تبيان خصائص هذه الرؤية الإيمانية التي يمنحها الله للإنسان ، بل ينبغي أن يذوق الإنسان طعمها لكي يدرك بنفسه مغزى هذا القول ويحس به .
ثمّ تقارن الآية بين هذا الإنسان الحي ، الفعال ، النير ، والمؤثر ، بالإنسان العديم الإيمان والمعاند ، فتقول : {كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها} .
نلاحظ أنّ الآية لا تقول : «كمن في الظّلمات» بل تقول : {كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ} يقول بعضهم : إنّ الهدف من هذا التعبير هو إثبات أنّ هؤلاء الأفراد غارقون في الظّلمات والتعاسة إلى الحد الذي جعلهم مثلا يعرفه المدركون .
وقد يكون ذلك إشارة إلى معنى أدق هو : أنّه لم يبق من وجود هؤلاء الأفراد سوى شبح ، أو قالب ، أو مثال أو تمثال ، لهم هياكل خالية من الروح وأدمغة معطلة عن العمل .
لا بدّ من القول ـ أيضا ـ إنّ «النّور» الذي يهدي المؤمنين جاء بصيغة المفرد ، بينما «الظّلمات» التي يعيش فيها الكافرون جاءت بصيغة الجمع ، وذلك لأنّ الإيمان ليس سوى حقيقة واحدة ، وهو يرمز إلى الوحدة والتوحيد ، بينما الكفر وعدم الإيمان مدعاة للتشتت والتفرقة .
وفي الختام تشير الآية إلى سبب مصير هؤلاء المشؤوم فتقول : {كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ} .
سبق أن قلنا : إنّ من خصائص تكرار العمل القبيح أنّ قبحه يتضاءل في عين الفاعل حتى يبدو له أخيرا وكأنّه عمل جميل ، ويتحول إلى مثل القيد يشد أطرافه ، ويمنعه من الخروج من هذا الفخ ، إنّ مطالعة بسيطة لحال المجرمين تكشف لنا هذه الحقيقة بجلاء .
ولمّا كان بطل هذه المشاهد في جانبها السلبي هو «أبو جهل» الذي كان من كبار مشركي قريش ومكّة ، فالآية الثّانية تشير إلى حال هؤلاء الزعماء الضالين وقادة الكفر والفساد ، فتقول : {وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها} .
كررنا القول من قبل : أنّ سبب نسبة أمثال هذه الأفعال إلى الله ، لكونه تعالى هو علّة العلل ومسبب الأسباب ومصدر كل القدرات ، والإنسان يستخدم ما وهبه الله من إمكانات طالحا كان هذا الفعل أم صالحا .
جملة «ليمكروا» تشير إلى عاقبة أعمالهم ، ولا تعني الهدف من خلقهم (2) أي أنّه عاقبة عصيانهم وكثرة ذنوبهم أدت بهم إلى أن يصبحوا سدا على طريق الحق ، وعاملا على جر الناس نحو الانحراف والابتعاد عن طريق الحق ، فالمكر في الأصل هو اللف والدوران ، ثمّ أطلق على كل عمل منحرف مقرون بالإخفاء .
وفي الختام تقول الآية : {وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ} .
وأي مكر وخديعة أعظم من أن يقوم هؤلاء باستخدام كل رؤوس أموال وجودهم ، بما في ذلك فكرهم وذكاؤهم وابتكاراتهم وأعمارهم ووقتهم وأموالهم ، في صفقة لا تعود عليهم بأي ربح ، بل تثقل ظهورهم بأحمال الذنوب والآثام الثقيلة ، ظانين أنّهم قد أحرزوا الربح والانتصار !
كما يستفاد من هذه الآية أنّ النكبات والتعاسة التي تصيب المجتمع إنّما تنشأ من كباره وقادته ، إذ إنّهم هم الذين يتوسلون بالمكر والحيلة لتغيير معالم الطريق إلى الله ، ويخفون وجه الحق عن الناس .
{وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ} [الأنعام : 124] .
الله أعلم حيث يجعل رسالته :
تشير هذه الآية بإيجاز إلى طريقة تفكير هؤلاء الأكابر {أَكابِرَ مُجْرِمِيها} وإلى مزاعمهم المضحكة الباطلة ، فتقول : {وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ} كأنّ الوصول إلى مقام النبوة وهداية الناس يعتمد على سن الشخص وماله ، أو هو ميدان للمنافسة الصبيانية بين القبائل! وكأنّ على الله أن يراعي هذه الأمور المضحكة الباطلة التي لا تدل إلّا على منتهى الانحطاط الفكري وعدم إدراك معنى النبوة وقيادة الخليقة !
إنّ القرآن يرد على هؤلاء بوضوح قائلا : {اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ} .
بديهي أنّ الرسالة لا علاقة لها بالسن ولا بالمال ولا بمراكز القبائل ، لأنّ شرطها الأوّل هو الاستعداد الروحي ، وطهارة الضمير ، والسجايا الإنسانية الأصيلة ، والفكر السامي ، والرأي السديد ثمّ التقوى إلى درجة العصمة . . . إنّ هذه الصفات ، وخصوصا الاستعداد لمقام العصمة لا يعلم بها غير الله ، فما أبعد الفرق بين هذه الشروط وما كان يدور بخلد أولئك .
كما إنّ من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بدّ أن تكون له جميع تلك الصفات عدا الوحي والتشريع ، أي أنّه حامي الشرع والشريعة ، والحارس على قوانين الإسلام ، والقائد المادي والمعنوي للناس ، لذلك لا بدّ له أن يكون معصوما عن الخطأ والإثم ، لكي يكون قادرا على أن يوصل الرسالة إلى أهدافها ، وأن يكون قائدا مطاعا وقدوة يعتمد عليها .
وبناء على ذلك ، يكون إختياره من الله أيضا ، فهو وحده الذي يعلم أن يضع هذا المقام ، فلا يمكن أن يترك ذلك للناس ولا للانتخابات والشورى .
وفي النهاية تشير الآية إلى المصير الذي ينتظر أمثال هؤلاء المجرمين والزّعماء الذين يدعون الباطل ، فتقول : {سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ} (3) .
كان هؤلاء الأنانيون بمواقفهم العدائية يريدون أن يحافظوا على مراكبهم ، ولكنّ الله سينزلهم إلى أدنى درجات الصغار والحقارة بحيث إنّهم سيتعذبون بذلك عذابا روحيا شديدا ، مضافا إلى أنّهم سيلاقون العذاب الشديد في الآخرة لأنّ سعيهم على طريق الباطل كان شديدا أيضا .
___________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 206-211 .
2. «اللام» هنا هي لام «العاقبة» وليست اللام الغائية ، وقد وردت في القرآن كثيرا .
3. «الإجرام» من «جرم» وأصله القطع ، والمجرم هو الذي يقطع العهود وارتباطه بالله بعدم إطاعته ، ولذلك أطلقت كلمة
«الجرم» على الإثم والذنب ، في هذا إشارة لطيفة إلى أنّ هناك في ذات الإنسان اتفاق مع الحق والطهارة والعدالة ، والإجرام هو قطع هذه الاتفاق الفطري الإلهي .



|
|
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|