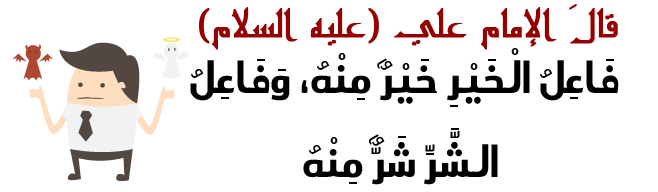
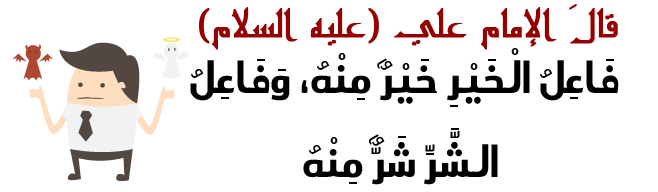

 القانون العام
القانون العام
 القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري و القضاء الاداري
 المجموعة الجنائية
المجموعة الجنائية
 قانون العقوبات
قانون العقوبات 
 القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية 
 القانون الخاص
القانون الخاص
 قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات و الاثبات
 المجموعة التجارية
المجموعة التجارية
 علوم قانونية أخرى
علوم قانونية أخرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2022
التاريخ: 2023-05-30
التاريخ: 1-2-2016
التاريخ: 2-2-2016
|
إن القيود التي يدفع المتهم بتخلّفها والتي ترد كقيد على تحريك الدعوى الجزائية هي ثلاثة وتتمثل في الشكوى والطلب والاذن ، وتمثل هذه القيود استثناء من الأصل العام الذي يجيز تحريك الدعوى الجزائية دون قيود (1).
ويجمع بين هذه القيود عنصر يتمثل بإرادة المجنى عليه أو غيره في تحريك الدعوى الجزائية وتعليق سلطة الادعاء العام على تلك الإرادة ، فحيث تتوافر هذه القيود لا يجوز تحريك الدعوى على الرغم من توافر جميع أركان الجريمة وشروط المسؤولية عنها . وقد حدد المشرع الحالات التي قيد فيها تحريك الدعوى بشكوى أو بطلب أو بإذن على سبيل الحصر، ومن ثم لا يجوز القياس عليها(2). وسنتناول في هذا الموضوع ذاتية هذه القيود في فرع أوّل ، ثم نتناول في الفرع الثاني الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى ، وفي الفرع الثالث سنتناول الدفوع المتفرعة عن قيد الطلب ، ثم سنتناول في الفرع الرابع والأخير الدفوع المتفرعة عن قيد الإذن
الفرع الأول
ذاتية قيود تحريك الدعوى الجزائية
سنبين في هذا الفرع خصائص قيود تحريك الدعوى الجزائية أولاً ، وأوجه الشبه والاختلاف بين هذه القيود ثانياً .
أولاً : خصائص قيود تحريك الدعوى الجزائية .
1- إنها ذات طبيعة إجرائية تتعلق بالدعوى الجزائية وحدها ، ويترتب على تخلفها الحكم بعدم قبول الدعوى لا ببراءة المتهم ، ومن ثم لا يكتسب هذا الحكم قوة تحول دون إعادة محاكمة المتهم مالم تكن الدعوى الجزائية قد انقضت لأسباب اخرى كسقوط الحق في تقديم الشكوى بوفاة المجنى عليه او مضي ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة (3).
2- إن هذه القيود تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم يجوز التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز الاتحادية ، بل وعلى المحكمة عند تخلّفها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى ولو لم يدفع بها المتهم ، كما يجوز لكل ذي مصلحة الدفع بها . وأي إجراء يتخذ قبل رفع القيد يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يصححه تقديم الشكوى او الطلب او صدور الإذن بعد ذلك . كما لا يجوز التنازل عنها، ويجب أن يتضمَّن حكم الإدانة ما يُشير بوضوح الى ارتفاع القيد ، وإلا كان الحكم قاصر التسبيب بما يبطله (4).
3- يترتب على ارتفاع القيد أن يرتد إلى المتضرر من الجريمة وإلى من علم بوقوعها وإلى الادعاء العام الحق في تحريك الدعوى والسير في إجراءاتها كما لو كان بصدد جريمة لا قيد على تحريكها (5).
4- الدفوع المترتبة على عدم الالتزام بالقيود ، من طبيعة أولية إذ تتولى المحكمة التي تفصل في الدعوى الفصل فيها .
5 - إنها ذات طبيعة استثنائية ، فالأصل أن تختص النيابة العامة الادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية كما في مصر وفرنسا ، أو أن تشترك مع جهات اخرى كما في العراق .
ثانياً : أوجه الشبه والاختلاف (6).
تتشابه القيود الثلاثة في الحكم المترتب على توافرها وهو عدم قبول تحريك الدعوى الجزائية ، مالم ترتفع تلك القيود ، ولكنها تختلف بعد ذلك من عدة نواح هي :
1- من حيث الشكل ، فبينما يجوز أن تكون الشكوى مكتوبة او شفوية ، فإن الطلب والاذن يتعيّن أن يكونا مكتوبين .
2- من حيث الجهة ، فالشكوى تصدر عن المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً وتحمي مصلحته الخاصة ، في حين يصدر الطلب من هيئة عامة ويحمي مصلحتها وهي مصلحة عامة ، ويصدر الإذن من هيئة عامة أيضاً ولكنه يحمي المتهم من الدعاوى الكيدية والحفاظ على عمل الجهة التي ينتمي لها .
3- من حيث المدة، فحيث لا يتقيد الطلب والإذن بمدة سقوط ، فإن الشكوى يشترط تقديمها خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه أو زوال عذره القهري
4 - من حيث جواز اتخاذ الإجراءات قبل رفع القيد ، ففي العراق ووفقاً للمادة (8) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز اتخاذ أي إجراء قبل تقديم الشكوى ، وفيما يخص الطلب والاذن فإننا نرى أن حكم المادة المذكورة ينسحب عليهما . أما في مصر ، فقبل تقديم الشكوى أو الطلب لا تملك النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق، أما قبل صدور الإذن فلها اتخاذ جميع الإجراءات التي لا تمس شخص المتهم او حصانة مسكنه .
5- من حيث التنازل ، فبينما يجوز التنازل عن الشكوى والرجوع عن الطلب ، لا يجوز الرجوع عن الإذن .
6- من حيث أحكام السقوط بالوفاة ، فهذه لا تسري على الطلب والاذن ، على خلاف الشكوى التي يسقط الحق في تقديمها بوفاة المجنى عليه (7).
7- من حيث نطاق القيد ، فبينما يكون الإذن شخصي بحت، أي لا يتعدّى الى غير من تم تعيينه فيه، فلا يمتد الى غيره من المتهمين الذين لهم ذات الحصانة . فإن تقديم أي من الشكوى أو الطلب ضد متهم معين يُعتبر أنه مُقدّم ضد الباقين .
الفرع الثاني
الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى
لم تضع التشريعات الإجرائية تعريفاً للشكوى ، ولكن الفقهاء تولوا ذلك ، فقد عرفت بأنها " عمل قانوني يصدر من المجنى عليه بقصد تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم التي يرى المشرع فيها إعطاء مصلحة المجنى عليه الأولوية والاعتبار (8) . ولتوضيح الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى فإن ذلك يقتضي التعرض الى الموضوعات الآتية :
أولاً : أثر الارتباط على الدفع بعدم مراعاة قيد الشكوى : لما كانت الشكوى استثناء من الأصل فإن الجرائم المعلقة على شكوى تكون على سبيل الحصر ، إلا أن الجرائم قد تتعدد تعدداً معنوياً (صورياً) أو تعدداً مادياً (حقيقياً) وتتطلب إحداها شكوى دون باقي الجرائم المرتبطة معها .
هنا ينبغي التفرقة بين التعدد المعنوي والمادي، ففي حالة التعدد المعنوي والذي يفترض خضوع السلوك الواحد لأكثر من وصف ونص قانوني ، إذا كان أحد الأوصاف يشترط لاتخاذ الإجراءات فيه تقديم شكوى بينما الوصف الآخر لا يستلزم تحريك الدعوى عنه تقديم شكوى . انقسم الفقه في ذلك إلى اتجاهين : يذهب الأوّل الى الاعتداد في هذه الحالة بالجريمة الأشد ، بحجة أنها وحدها التي توجد في نظر القانون ، ومن ثم إذا كانت الجريمة التي عقوبتها أشد هي التي يستلزم القانون الشكوى بالنسبة لها، فلا يجوز تحريك الدعوى الجزائية عن الوصف الأشد أو الوصف الأخف إلا إذا تقدم المجنى عليه بشكوى ، غير أنه يترتب على سقوط الحق في تقديم الشكوى عن الوصف الأشد جواز تحريك الدعوى عن الوصف الأخف(9). أما الاتجاه الثاني فيذهب الى أن قيد الشكوى يقتصر على الجريمة التي تطلب القانون فيها تقديم شكوى ، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الجريمة ذات الوصف الأشد أو الأخف، وحجتهم في ذلك أن الشكوى استثناء لا يجوز التوسع فيه ، فضلاً عن أن أحد أوصاف السلوك يفترض المساس بحق لا تتوافر بالنسبة للاعتداء عليه علة الشكوى(10). ونحن بدورنا نرجح الاتجاه الثاني ، منعاً لإفلات المجرم من العقاب .
وفي حالة التعدد المادي ، والفرض فيها أن تقع عدة جرائم ترتبط مع بعضها ارتباطا يقبل التجزئة أو ارتباطا لا يقبل التجزئة . فبالنسبة للارتباط القابل للتجزئة ، إتفق الفقه على حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى عن الجريمة غير المعلقة على شكوى ، وعدم جواز تحريكه لتلك المعلقة عليها (11).
أما بالنسبة للارتباط غير القابل للتجزئة ، فقد انقسم الفقه في ذلك الى اتجاهين : الأول يعتد بالجريمة ذات الوصف الأشد ، على اعتبار أنها وحدها التي تقوم في نظر المشرع ، عليه فإذا كانت الجريمة الأشد تستلزم الشكوى امتد قيد الشكوى عندئذ الى الجريمة ذات الوصف الأخف ومن ثم يمتنع - مالم تقدم الشكوى - تحريك الدعوى عن الجريمتين ، غير أنه إذا ما انقضى الحق في الشكوى ، فإن يجوز تحريك الدعوى عن الجريمة الأخف والتي لم تكن تستلزم التقدم بشكوى (12). أما الاتجاه الثاني - والذي نرجحه - فيذهب الى جواز تحريك الدعوى عن الجريمة التي لا تستلزم شكوى سواء أكانت هذه الجريمة هي ذات الوصف الأشد أو الأخف (13) ، ويدعم هذا الاتجاه رأيه بحجتين : أولهما، إن الارتباط غير القابل للتجزئة لا ينفي ذاتية كل جريمة، كما أن الاعتداد بالجريمة الأشد يفترض عرض الجريمتين على القضاء وهو ما لم يتحقق . ثانيهما إن الأخذ بالاتجاه الأول يؤدي الى إسباغ نوع من الحصانة على الجاني بغير سند من القانون ، وفي ذلك منافاة للعدالة إذ يصبح من يرتكب جريمتين أوفر حظاً ممن يرتكب إحداهما ، لمجرد أن المشرع يتطلب لتحريك الدعوى عن أشدهما تقديم الشكوى ، ولم تقدم (14).
ثانياً : صفة مُقدِّم الشكوى : نصت المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه : " لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً ... ". ونصت المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص" . وفي قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي استوجبت المادة (3/6) تقديم شكوى من المجنى عليه في جرائم معينة يتضح من ذلك أن صاحب الحق في تقديم الشكوى هو المجنى عليه ، وبذلك يخرج من هذا النطاق المضرور من الجريمة (15). والمجنى عليه قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً ، وعندئذ تقدّم الشكوى من الممثل القانوني لهذا الأخير. وفي حالة تعدد المجنى عليهم ، يكفي لتحريك الدعوى الجزائية أن تقدّم الشكوى من أحدهم ، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الآخرين ، عدا جريمة زنا الزوجية فلا تُحرَّك الدعوى ضد الشريك مالم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني أو الزوجة الزانية (16).
ثالثاً : انقضاء الحق في الشكوى (17): هنالك طريقان لانقضاء الحق في الشكوى هما :-
1- مضي المدة (التقادم).
هذه المدة هي (3) أشهر من تاريخ العلم بالجريمة (18)، والعلة من تحديد مدة تقديم الشكوى هي تحقيق الاستقرار القانوني وحتى لا يظل الجاني تحت رحمة المجنى عليه ، فمضي المدة قرينة على التنازل لا تقبل إثبات العكس ، وإذا كان للمجنى عليه وكيل فالعبرة بعلمه لا يعلم موكله ، أما إذا كان الأهلية فالعبرة بعلم ممثله القانوني (19). وتُعد مسألة ثبوت العِلم وتاريخه من المسائل الموضوعية التي ينظرها قاضي الموضوع في كل حالة على حدة (20).
2- الوفاة (21).
لما كانت الدعوى الجزائية - التي يُقيَّد تحريكها بشكوى - دعوى شخصية فإنه لا بد أن يكون المجنى عليه إنساناً على قيد الحياة ، فإذا توفي قبل تقديم الشكوى انقضى حقه في تقديمها (22)، ويُعتبر ذلك نتيجة منطقية لكون الحق في الشكوى حقاً شخصياً يتعلق بشخص صاحبه فلا ينتقل الى الورثة . غير أن الوفاة إذا وقعت بعد تقديم الشكوى فلا تأثير لذلك على الدعوى ، أي أن الشكوى تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجزائية (23)، باستثناء دعوى زنا الزوجية فإنها تنقضي بالوفاة .
الفرع الثالث
الدفوع المتفرعة عن قيد الطلب
يُعرف الطلب بأنه : " إجراء إداري يُفصح عن إرادة سلطة عامة في رفع القيد عن حرية الادعاء العام في إقامة الدعوى الجزائية عن جريمة ارتكبت إخلالاً بقانون تعمل هذه السلطة على تنفيذه (24). والحكمة من الطلب أن الجرائم التي يتعلق بها تمس مصالح أساسية للدولة ، فيترك من ثم للسلطة العامة تقدير ملائمة تحريك الدعوى الجزائية او عدم تحريكها (25).
ويُشترط لصحة الطلب أن يكون كتابياً ، وأن يصدر من المختص قانوناً بإصداره وأن يحمل ، فضلاً. توقيعه عن ذلك يجب أن يتضمَّن التاريخ الذي صدر فيه حتى يتم التأكد من أن الإجراءات اتخذت بعد تقديمه ، كما ويجب بيان الواقعة الجرمية في الطلب كي تتمكّن المحكم الأعلى درجة من التحقق من أن الجريمة من الجرائم التي يستلزم لتحريك الدعوى عنها تقديم طلب ، إذ أن تلك الجرائم وردت على سبيل الحصر (26) . هذا ويجوز لمن قدم الطلب أن يتنازل عنه ، فإذا صدر التنازل بعد تقديم الطلب فإنه يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية (27)
ويكون الطلب في جرائم محددة منها ما ورد في القانون الإجرائي ومنها ما ورد في قوانين خاصة، وكالاتي :-
أولاً : الجرائم المشار اليها في القانون الإجرائي .
فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، نصت المادة (3/ب) على عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج العراق إلا بإذن من وزير العدل (مجلس القضاء الأعلى حالياً)، وعلى الرغم من أن المشرع العراقي استعمل مصطلح " الإذن " إلا أنه قصد به الطلب، ذلك أن القيد المذكور انصب على الجريمة ذاتها ولم يتجه الى شخص مرتكبها (28).
أما قانون الإجراءات الجنائية المصري، فقد نص في المادة (8) على عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية في جرائم المادتين (181و182) من قانون العقوبات المصري، إلا بناءً على طلب . كما نصت المادة (9) من القانون ذاته على عدم جواز رفع الدعوى الجزائية في جريمة المادة (184) من قانون العقوبات المصري، إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها.
ثانياً : الجرائم المشار إليها في قوانين خاصة
في العراق ورد قيد الطلب في عدد من القوانين الخاصة ، ومنها المادة (241) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 النافذ إذ نصت على أنه : " لا تقام الدعوى الجزائية في الجرائم الكمركية إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو أحد معاونيه ". كذلك ما نصت عليه المادة (31) من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 النافذ من أنه : " يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل...". كذلك ما نصت عليه المادة (32) من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 على أن : " ... لا تقام أية دعوى عن جرم ارتكب ضد أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب من سلطات المكوس .. ونصت المادة (202) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 على أن : " تُحرّك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الأحوال بناءً على طلب من سلطات الطيران المدني ..... ونصت المادة (2/19) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 على أنه : " إذا لم يُظهر الولي تعاوناً مع المكتب أو أعرض عن تفهم مشكلة الحدث أو أمعن في إهماله لواجباته، فللمكتب أن يطلب من قاضي التحقيق أو الادعاء العام اتخاذ الإجراءات بحق الولي في أحكام هذا القانون " .
أما في مصر فقد ورد قيد الطلب في الكثير من القوانين الخاصة والتي لا يسعنا المجال لذكرها جميعاً، لذا سنقتصر على أهمها . فالمادة (137) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب من وزير المالية ". ونصت المادة (124) من قانون الكمارك رقم (66) لسنة 1963 على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي لوزير المالية أو من يفوضه .. كذلك ما نصت عليه المادة (65) من قانون البنوك والائتمان رقم (163) لسنة 1957 على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري ". أيضاً ما نصت عليه المادة (9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي رقم (38) لسنة 1994 من أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة لها او اتخاذ إجراء فيها إلا بناءً على طلب الوزير المختص أو من ينوبه ". وأخيراً نصت المادة (4) من القانون رقم (92) لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ إجراء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه ".
الفرع الرابع
الدفوع المتفرعة عن قيد الإذن
يُعرف الإذن بأنه إجراء يتضمّن رغبة أو موافقة جهة عامة محددة بالقانون على إقامة الدعوى الجزائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأفراد التابعين لها في جريمة علّق المشرع إقامة الدعوى فيها على موافقتها (29) . والعِلة من قيد الإذن هي توفير الاستقلال لبعض الهيئات ، ولتفادي أن يكون اتخاذ الإجراءات ضد الأعضاء المنتمين اليها سلاحاً لتهديدهم أو وسيلة للضغط عليهم ، وبذلك يتمكن العضو من ممارسة أعماله دون خوف او تردد (30). ويُشترط في الإذن أن يكون مكتوباً، ومتى صدر الإذن فإن الادعاء العام يتقيد بالواقعة التي صدر بشأنها ، ويقتصر الاذن على من عينه بالاسم دون غيره (31). كما أن الاذن ملزم لمن أصدره فلا يجوز العدول عنه (32).
وقد خلا كل من القانونين العراقي والمصري من بيان حالات الإذن فيما يخص تحريك الدعوى الجزائية . إلا إن الدستور وبعض القوانين الخاصة تضمنت أهم حالتين للإذن كقيد وحصانة إجرائية . وهاتان الحالتان هما الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية :
أولاً : الدفوع المتفرعة عن قيد الحصانة البرلمانية (33).
يتمتع أعضاء المجالس النيابية في جميع الدول بحصانة ضد الإجراءات الجزائية ، فقد نصت المادة (63) ثانياً (ب) من الدستور العراقي لعام 2005 على أنه : " لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي ، إلا إذا كان متهماً بجناية ، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية ". ونصت الفقرة (جـ) من المادة ذاتها على أنه : " لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي ، إلا إذا كان متهماً بجناية ، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية .
وفي مصر نصت المادة (113) من الدستور المصري لعام 2013 على أنه : " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة ، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس . وفي غير دور الانعقاد يتعيَّن أخذ إذن مكتب المجلس ، ويُخطر المجلس عند أوّل انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال ، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً وإلا عد الطلب مقبولاً ".
أما في فرنسا فقد نصت المادة (26) من دستور عام 1958 على أنه . لا يجوز أن يكون أي عضو في البرلمان - فيما يتعلق بالجنايات أو الجنح - محل توقيف أو أي إجراء آخر يسلبه حريته أو يقيدها إلا بإذن من مكتب المجلس الذي ينتمي إليه ، ولا يُشترط هذا الإذن في حالة التلبس بجناية أو جنحة أو في حالة الإدانة النهائية ...".
والحصانة البرلمانية كما هو واضح حصانة شخصية تقتصر على العضو دون غيره من أفراد أسرته، ذلك أن علة تقريرها تتمثل في حماية العضو أثناء أداء أعماله من الاضطهاد والتنكيل ، كما أن هذه الحصانة لا تمنع من رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية(34). وليس للمجلس أو رئيسه أن يقيم موضوع الدعوى ليرى ما إذا كان العضو قد ارتكب الجريمة أم لا، وإنما مهمته شكلية فحسب ، فهو يبحث في مدى جدية التهمة المنسوبة الى العضو وما إذا كان الباعث عليها سياسياً بقصد الكيد له أم أن الدافع هو تحقيق العدالة (35).
وتختلف جهة إصدار الإذن حسب الأحوال ، فإذا كان المجلس في دورة الانعقاد فيصدر الاذن منه ، أما إذا لم يكن في دورة الانعقاد فالإذن يصدر من رئيس المجلس وفقاً للدستور العراقي ، ومن مكتب المجلس وفقاً للدستور المصري . إلا أن الحصانة البرلمانية ليست دائمة بل تسقط عن العضو في ثلاث حالات : الأولى هي الجريمة المشهودة والتي تبيح تحريك الدعوى دون حاجة لموافقة المجلس أو رئيسه ، لانتفاء شبهة التعسف السياسي ، إذ الأدلة في هذه الحالة ترجح ارتكابه للجريمة (36)؛ والحالة الثانية هي موافقة أعضاء المجلس او رئيسه - حسب الأحوال - ؛ أما الحالة الثالثة فهي انتهاء مدة المجلس أو حله (37).
ثانياً : الدفوع المتفرعة عن قيد الحصانة القضائية .
يقرر المشرع للقضاة وأعضاء الادعاء العام حصانة تمنع من ملاحقتهم جزائياً ، وذلك حرصاً على تحقيق ما يجب أن يتوافر للسلطة القضائية من هيبة و إجلال باعتبارها السلطة القائمة على تحقيق العدالة ، كما أن من شأن ذلك منع باقي السلطات من التدخل في عملها.
وفي هذا الصدد نصت المادة (64) من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 النافذ على أنه : " لا يجوز توقيف القاضي أو اتخاذ الإجراءات الجزائية ضدّه ، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة ، إلا بعد استحصال إذن من رئيس مجلس القضاء الأعلى " . وفي السياق ذاته نصت المادة (96) من قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 النافذ على أنه : " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا ، إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94.... وتمتد هذه الحصانة لتشمل أعضاء النيابة العامة الادعاء العام بموجب المادة (68) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 النافذ(38)، والمادة (130) من القانون المصري المذكور . يتبيَّن من ذلك أن الحصانة القضائية تزول في حالتين، الأولى الجناية المشهودة بالنسبة للقانون العراقي، والتلبس بالجريمة - بصرف النظر عن نوعها - بالنسبة للقانون المصري . أما الحالة الثانية فهي صدور الإذن ، ففي هاتين الحالتين يرتفع القيد ومن ثم يجوز تحريك الدعوى الجزائية
وبالنسبة للوقت الذي يُلزم أن تتوافر فيه الصفة التي تمنع من تحريك الدعوى الجزائية فهو وقت ارتكاب الجريمة ، فطالما قد توافرت الصفة في هذا الوقت فإن المتهم يستفيد من القيد حتى لو تم تحريك الدعوى بعد زوال صفته (39).
وأخيراً فإن الأحكام الخاصة بالحصانة الإجرائية لأعضاء مجلس النواب أو القضاة ومن في حكمهم تتعلق بالنظام العام ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز التنازل عنها (40)، فضلاً عن بطلان الإجراءات المتخذة قبل صدور الإذن بطلاناً مطلقاً . ويجب أن يورد حكم الإدانة في أسبابه ما يشير الى ارتفاع القيد ، وإلا كان معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله (41) . ولكن يُشترط عند الدفع بعدم ارتفاع هذا القيد لأوّل مرة أمام محكمة التمييز أن تكون مقوماته واضحة ولا تحتاج الى تحقيق موضوعي ، وهو ما يخرج عن وظيفة محكمة التمييز بوصفها محكمة قانون
_____________
1- جدير بالذكر أن المشرعين المصري والفرنسي أناطا بالنيابة العامة حصراً الحق في تحريك الدعوى الجزائية مع بعض الاستثناءات على ذلك ، فقد نصت المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن : " تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون... ". ونصت المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن : " تحريك الدعوى العامة وإدارتها مناطة بموظفين يعينهم القانون ، ويجوز للطرف المتضرر أن يحركها وفق شروط منصوص عليها في هذا القانون ". أما المشرع العراقي وفي المادة (2) من قانون الادعاء العام منح للادعاء العام. - من بين جهات اخرى - الحق في تحريك الدعوى الجزائية ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تمتلك النيابة العامة في كل من مصر وفرنسا سلطة تقديرية في تحريك الدعوى الجزائية ، بخلاف الادعاء العام في العراق فهو ملزم بتحريك الدعوى إذا قدمت اليه الشكوى أو أحيلت اليه من الجهات المختصة وهذا ما ورد في المادة (7/ أولاً) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (159) لسنة 1979 النافذ والتي نصت على أنه : " على الادعاء العام ، القيام بما يأتي : أولاً – إرسال الشكاوى المقدمة اليه أو المحالة عليه الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان ملاحظاته بشأنها.....
2- انظر: د. سعد حماد صالح القبائلي ، المساهمة الإجرائية في بدائل الدعوى الجنائية ، مجلة اتحاد الجامعات العربية ، تصدرها الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية ، العدد (22) ، 2005، ص 465
3- انظر: د. محمود نجيب حسني, شرح قانون الإجراءات الجنائية, 3, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996 ، ص 116 ؛ د. ابراهيم حامد طنطاوي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص 12.
4- انظر: استاذنا د فخري عبد الرزاق الحديثي، اصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية ، بغداد ، 1987، ص12.
5- انظر: استاذنا د. فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع سابق ، ص 13.
6- انظر: عزت الدسوقي ، قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق – جامعة القاهرة ، 1986 ، ص 324 وما بعدها ؛ شاهر محمد علي المطيري ، الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائي الأردني والكويتي والمصري ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق – جامعة الشرق الأوسط ، 2010-2009، ص 34 وما بعدها ؛ الأستاذ سعيد حسب الله عبدالله ، مرجع سابق، ص 70.
7- انظر المادة (7) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
8- انظر: د. أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية ، مجلة القانون والاقتصاد ، تصدرها كلية الحقوق – جامعة القاهرة، السنة (53)، 1984، ص 213.
9- انظر : د. أحمد فتحي سرور، اصول قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969، ص 492-493 ؛ د. سامي النصراوي ، دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1974، ص 89 ؛ عبد السلام مقلد ، الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصة بها ، مطبعة رويال ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1989، ص 23؛ د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط12، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص 80 ؛ د. مأمون سلامة, قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض, دار الفكر العربي, القاهرة ، ص 73 ؛ د. محمد زكي ابو عامر، الإجراءات الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1984 ، ص444.
10- انظر: د. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، (بدون سنة طبع) ، ص 65 ؛ غازي خالد درويش ، شكوى المجنى عليه ، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1997، ص 135 ؛ استاذنا .د فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص 88 ؛ الأستاذ سعيد حسب الله عبدالله, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دار ابن الأثير للطباعة والنشر, جامعة الموصل, 2005 ، ص 57؛ د عدلي عبد الباقي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، ج 1، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1951، ص 78؛ د. آمال عبـد الرحيم عثمان, شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1975 ، ص 53؛ د. محمود نجيب حسني, شرح قانون الإجراءات الجنائية, 3, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996, ص 124 ؛ د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1972، ، ص 81 ؛ د. محمد عبد الغريب, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج 2, 2, النسر الذهبي للطباعة, القاهرة . 1997, ، ص 125 ؛
11- انظر: د ر: د. محمد زكي ابو عامر، الإجراءات الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1984 ، ص 445؛ د. محمد ابو العلا عقيدة ، ص149 والمراجع التي أشار إليها في هامش رقم 2 من الصفحة ذاتها .
12- انظر: د. حسنين ابراهيم صالح عبيد ، شكوى المجنى عليه ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975، ص 96 ؛ د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، مطبعة أطلس ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1984، ص 249؛ د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ، ص 80 ؛ د. مأمون سلامة, قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض, دار الفكر العربي, القاهرة ، ص74 ؛ د. محمد زكي ابو عامر، الإجراءات الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1984 ، ص 446 ؛ عبد السلام مقلد ، الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصة بها ، مطبعة رويال ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1989 ، ص 22 .
13- انظر: استاذنا د فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري ، بيروت 2015، ص 87 ؛ د. محمود نجيب حسني ، مرجع سابق، ص 124 د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, ط7 ، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة ، 1968 ، ص 69 ؛ د. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، (بدون سنة طبع) ، ص 65 ؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 624 ؛ غازي خالد درويش ، شكوى المجنى عليه ، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1997، ص 140.
14- انظر: د. فوزية عبدالستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص107. وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض المصرية ، انظر تطبيقاً لذلك أحكام النقض التي أشار إليها : د. ابراهيم حامد طنطاوي ، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ، ج 1 ، ط 1 ، بدون مكان (طبع ، 1994، ص 50-51 .
15- قد يشترط القانون توفر صفة خاصة في المجنى عليه حتى يتم قبول شكواه ، ففي جريمة زنا الزوجية يشترط أن يكون المجنى عليه زوجاً للجاني. وبهذا الخصوص يشترط المشرع العراقي توافر هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت بعد ذلك ، ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء أربعة أشهر بعد طلاقها . انظر المادة (2/378) من قانون العقوبات العراقي . بينما يذهب الفقه المصري مستنداً في ذلك الى نصي المادتين (273 274) من قانون العقوبات – ويؤيده في ذلك القضاء الى وجوب توافر صفة الزوجية وقت وقوع الجريمة وعند تقديم الشكوى . انظر: فايز اللمساوي و أشرف فايز اللمساوي ، الادعاء المدني أمام القضاء الجنائي ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للإصدارات القانونية . ، مصر، 2009 ص 27.
16- انظر المادة (4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (4) من قانون الإجراءات المصري .
17- يذهب أغلب الفقه الجزائي الى إدراج التنازل عن الشكوى ضمن حالات انقضاء الحق فيها ، إلا هنالك رأي يذهب إلى عدم صحة ذلك ، على اعتبار أن أسباب انقضاء الحق في الشكوى ترد بعد نشوء الحق وقبل استعماله ، أما التنازل فيتحقق بعد نشوء الحق وبعد استعماله ، هادفاً الى إزالة آثار هذا الاستعمال . انظر في هذا الرأي : فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 127 هامش رقم 2 ونحن نرجح هذا الرأي، وعليه سنبحث في التنازل عن الشكوى كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ، وذلك في موضع قادم من الرسالة.
18- انظر المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (2/3) من قانون الإجراءات الجنائية المصري . ولكن هناك إختلاف بين هاتين المادتين ، فالمشرع المصري يشترط لسريان مدة الثلاثة أشهر علم الجاني بالجريمة ومرتكبها معاً ، فإذا علم بالجريمة وظل جاهلاً أمر الجاني فإن ميعاد السقوط يتراخى ويظل الحق في تقديم الشكوى قائماً حتى تكتمل مدة التقادم المسقطة للدعوى ذاتها . أما المشرع العراقي فيكتفي بالعلم بالجريمة فقط دون العلم بمرتكبها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى جعل المشرع العراقي من العذر القهري مانعاً من سريان تلك المدة في حين أن المشرع المصري لم ينص على مثل هذا العذر.
19- انظر: استاذنا د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص 82 د. حسنين ابراهيم صالح عبيد ، شكوى المجنى عليه ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص 106 .
20- انظر : د. محمد زكي ابو عامر، الإجراءات الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1984 ، ص 461.
21- انظر المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (7) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
22- انظر المادة (7) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
23- انظر: د. حسنين ابراهيم صالح عبيد ، شكوى المجنى عليه ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975، ، ص 86 ؛ وانظر المادة (7) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (2/7) من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه : " وجد أن المشتكية توفت بعد تقديم الشكوى ، ولما كانت وفاة المشتكية بعد الشكوى لا تؤثر على سير الدعوى الجزائية ، فكان على المحكمة أن تجري المحاكمة حسب الأصول وتحكم في الدعوى حسبما تتبين لها النتيجة ". قرار رقم 1312 في 1973/2/6، النشرة القضائية ، يصدرها المكتب الفني بمحكمة التمييز، العدد (1)، السنة (4)، ص 247.
24- انظر: استاذنا د فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري ، بيروت 2015، ، ص 92.
25- انظر: : د. محمد أبو العلا عقيدة ، مرجع سابق ، ص 170.
26- انظر: عزت الدسوقي ، قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق – جامعة القاهرة ، 1986 ، ص 309 وما بعدها ؛ د. محمد أبو العلا عقيدة ، مرجع سابق ، ص172.
27- انظر: د. أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية ، مجلة القانون والاقتصاد ، تصدرها كلية الحقوق – جامعة القاهرة، السنة (53)، 1984 ، ص 219.
28- انظر: استاذنا د. فخري عبدالرزاق الحديثي ، اصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص14.
29- انظر: الأستاذ سعيد حسب الله عبدالله, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دار ابن الأثير للطباعة والنشر, جامعة الموصل, 2005 ، ص 63 .
30- انظر: د آمال عبـد الرحيم عثمان, شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1975 ، ص 67 ؛ فايز اللمساوي و أشرف فايز اللمساوي ، الادعاء المدني أمام القضاء الجنائي ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للإصدارات القانونية . ، مصر، 2009 ، ص32.
31- انظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص 241 ؛ شاهر محمد علي المطيري ، الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائي الأردني والكويتي والمصري ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق – جامعة الشرق الأوسط ، 2010-2009 ، ص 35.
32- تجدر الإشارة الى أنه في فرنسا يجوز سحب الإذن بعد صدوره إذ تنص المادة (26) من الدستور الفرنسي على أنه " ... يوقف حبس عضو البرلمان أو تنفيذ الإجراءات التي تسلبه حريته أو تقيدها أو متابعته قضائياً أثناء مدة انعقاد الدورة البرلمانية إذا طلب المجلس الذي ينتمي إليه ذلك .....
33- جدير بالذكر أن هذه الحصانة إجرائية فقط ، فليس من شأنها نزع الصفة الجرمية عن السلوك أو الإعفاء من المسؤولية أو من العقاب ، وإنما تمنع اتخاذ الإجراءات حتى صدور الإذن . أي أنها حصانة مؤقتة ، وبذلك يتضح الفرق بينها وبين الحصانة التي كفلها الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (63/ ثانياً/أ) والتي تنص على أنه : " يتمنع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك .
34- انظر د جلال ثروت, نظم الإجراءات الجنائية, دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2003 ، ص 126125؛ د. محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق ، ص 181.
35- انظر: : د. محمد عيد الغريب ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ج 1، مرجع سابق ، ص 184.
36- انظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ، جامعة بيروت العربية ، 1971، ص 272.
37- انظر المادة (64) من الدستور العراقي لعام 2005.
38- جدير بالذكر أن المشرع العراقي منح أعضاء مجلس شورى الدولة حصانة إجرائية ، فقد نصت المادة (27) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 النافذ على أنه : " لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار المنتدب والمستشار المساعد أو اتخاذ الإجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة إلا بعد استحصال إذن رئيس مجلس القضاء الأعلى .
39- انظر: د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص 104.
40- جدير بالذكر أنه وإن كان الأصل عدم جواز التنازل عن الحصانة الإجرائية لأعضاء مجلس النواب ، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق اتجهت في الفترة الأخيرة ، وبخصوص القضايا المتعلقة بالنزاهة ، الى أنه يجوز للعضو التنازل عن الحصانة المقررة له طوعاً .
41- انظر: د. آمال عبـد الرحيم عثمان, شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1975 ، ص 66 ؛ د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، مرجع سابق، ص 83؛ د جلال ثروت, نظم الإجراءات الجنائية, دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2003 ، ص 127



|
|
|
|
15 نوعا من الأطعمة تساعدك على ترطيب جسمك خلال موجة الحر
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تختار شركة "سبيس إكس" لـ"مهمة خاصة" في 2030
|
|
|
|
|
|
|
بالصور: بمناسبة عيد الغدير الاغر.. قراءة خطبة النبي الأكرم (ص وآله) بالمسلمين في يوم (غدير خم)
|
|
|