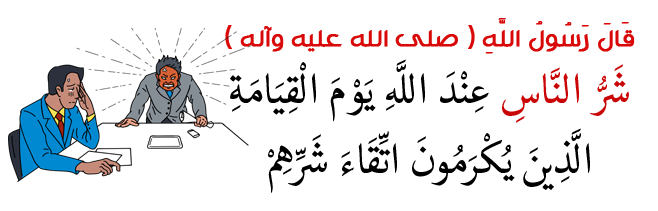
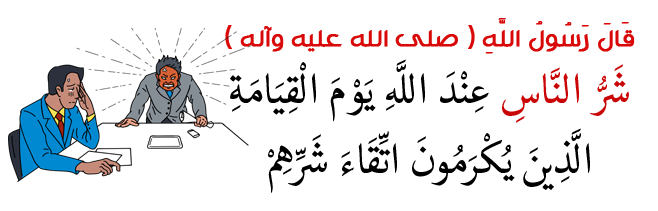

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2018
التاريخ: 28-3-2018
التاريخ: 12-4-2017
التاريخ: 29-11-2018
|
الجسم محدث لأنّه لا يخلو من حوادث لها أوّل، وما كان كذلك لا بدّ أن يكون محدثا ، هذه الجملة التي ذكرناها تحتاج إلى بيان أربعة أصول.
منها: إثبات أمور زائدة على الجسم.
ومنها: أنّ تلك الامور متجدّدة محدثة غير مستمرّة أزليّة.
ومنها: أنّ الجسم لم ينفك منها.
ومنها: أنّ لتلك الامور أوّلا تنتهي عنده. إذا ثبتت هذه الأصول، لم يبق في حدوث الجسم شك.
الأوّل: إثبات امور زائدة على الجسم :
أمّا الأوّل- وهو إثبات امور زائدة على الجسم- فظاهر وذلك أنّ الجسم متحرّك، وينتقل من جهة إلى جهة ويسكن ويجتمع مع غيره ويفارقه. فهذه امور زائدة، باعتبار أنّا عند تجدّدها نعلم، أمرا لم يكن معلوما لنا من قبل، والجسم كان معلوما لنا من قبل، وما تجدّد علمنا به غير ما لم يتجدّد علمنا به؛ ولأنّا نقدر على هذه الامور، ولا نقدر على نفس الجسم، وما نقدر عليه لا بدّ من أن يكون مغايرا لما لا نقدر عليه.
الثاني: أنّ هذه الامور متجدّدة محدثة :
وأمّا الثاني- وهو تجدّد هذه الامور وحدوثها- فالأمر ظاهر في حدوث ما يتجدّد على الأجسام التي نتصرّف نحن فيها، فإنّا نسكّنها بعد أن كانت متحرّكة، ونحرّكها بعد أن كانت ساكنة، ونجمع بين بعضها وبعض بعد أن كانت مفترقة، ونفرّق بين بعضها وبعض بعد أن كانت مجتمعة، فنعلم ضرورة نجدّد هذه الامور فيما نتصرّف نحن فيه وإنّما الاشتباه في الامور التي تثبت للأجسام الغائبة عنّا بأن يقول قائل: هلّا كانت تلك الأجسام ساكنة لم يزل فما تحرّكت، او مجتمعة فما افترقت، أو مفترقة فما اجتمعت، أو نقول فيما نتصرّف فيه: أنّها كانت ساكنة لم يزل فحرّكناها، أو مجتمعة ففرّقناها، أو مفترقة فجمعناها.
والذي يدلّ على حدوث جميع هذه الامور أنّ هذه الامور جائزة الوجود بذواتها، وإذا كانت جائزة الوجود بذواتها فلا توجد إلّا بمؤثّر، إمّا موجب أو مختار والموجب إمّا أن يكون قديما أو محدثا، وباطل أن يكون موجبا قديما، فلم يبق إلّا أن يكون إمّا مختارا أو موجبا محدثا وأيّهما ثبت ثبت حدوث هذه الامور لأنّ الحاصل بالمحدث لا يكون الّا محدثا. وكذلك الذي يوجده الفاعل لا يكون إلّا محدثا.
فإن قيل: لم قلتم إنّ هذه الأعراض جائزة الوجود بذواتها؟
قلنا: لأنّها لو لم تكن جائزة الوجود بذواتها لكانت واجبة الوجود بذواتها، ولا ثالث في حقّ هذه الأعراض، لأنّ الثالث إنّما هو الاستحالة والثابت لا يكون مستحيلا فتعيّن فيه أحد القسمين الجواز والوجوب، فإذا بطل الوجوب لم يبق إلّا الجواز.
فإن قيل: لم قلتم إنّه لا قسمة وراء الوجوب والجواز والاستحالة؟.
قلنا: لأنّ الأمر لا يخلو من أن يكون مستحيلا أو لا يكون مستحيلا، وما لا يستحيل إمّا أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا، وما لا يجب ولا يستحيل هو الجائز، والطرفان أحدهما الوجوب والآخر الاستحالة، فتعيّن انحصار هذا التقسيم، والاستحالة في حقّ الأعراض غير ثابتة، فليس فيها إلّا الوجوب أو الجواز فإذا أبطلنا الوجوب تعيّن الجواز.
والّذي يدلّ على أنّها ليست واجبة الوجود بذواتها وجهات اثنان:
أحدهما: أنّ هذه الأعراض تابعة في ثبوتها لثبوت موصوفاتها التي هي محالّها، وما يتبع في وجوده وجود غيره لا يكون واجبا بذاته.
والوجه الثاني: هو أنّ العدم جائز عليها، وواجب الوجود لذاته لا يجوز عليه العدم. وبيان أنّ العدم جائز على هذه الأعراض أنّه يمكننا تسكين المتحرّك من الأجسام وإبطال ما فيها من الحركة، وعلى العكس يمكننا تحريك الساكن وإبطال ما فيه من السكون.
ولئن خطر بالبال أنّه لا يمكننا تحريك الأجسام الثقال الساكنة في أماكنها، كالجبال الراسيات، فالمزيل لهذا الخاطر أنّه لا يمكننا تحريكها بأجزائها، بان نقلع منها قطعة قطعة فنزيل ما فيها من السّكون. وأيضا فإنّها تتحرّك عند الزلازل ويبطل بذلك التحرّك سكونها. فثبت أنّ العدم جائز عليها، وواجب الوجود بذاته لا يجوز عدمه.
فإن قيل: لم قلتم إنّ واجب الوجود بذاته لا يجوز عدمه؟
قلنا: لأنّ القول بوجوب وجود الشيء وبجواز عدمه متناقض، فدلّ ذلك على أنّ واجب الوجود بذاته يستحيل عدمه.
إن قال قائل: لم لا يكون واجب الوجود لم يزل يجوز عدمه فيما لا يزال، فيكون واجب الوجود فيما لم يزل، وجائز الوجود فيما لا يزال؟
قلنا: إذا جاز عدمه في تقدير وقت ما أو انعدم وكان هذا العدم أو جوازه متجدّدا استدعى بقضيّة العقل أمرا له عرض هذا العدم أو جوازه، وذلك الأمر إمّا أن يكون إثباتا أو نفيا. وأيّهما ثبت كشف عن أنّه كان محتاجا في وجوب وجوده إلى أمر. فإن كان نفيا كشف عن أنّه كان في وجوب وجوده محتاجا إلى ثبوت أمر لمّا انتفى ذلك الأمر انتفى واجب الوجود، هذا يقدح في وجوب الوجود بذاته. وكذا إن كان ذلك ثبوت أمر انكشف أنّه كان وجود مشروطا بأن لا يكون ذلك الأمر ثابتا، فلمّا ثبت انعدم، وهذا أيضا يقدح في كونه موجودا بذاته. فانكشف بذلك أنّ واجب الوجود بذاته لا يجوز أن ينعدم بوجه من الوجود.
فاذا ثبت أن هذه الأعراض جائزة الوجود بذواتها، وجائز الوجود بذاته لا يثبت إلّا لأمر، وهذا يعلم بأدنى تأمّل.
وذلك الأمر لا يخلو من أن يكون موجبا أو مختارا، والموجب إمّا أن يكون قديما أو محدثا...، لا يجوز أن يكون قديما، لأنّ القديم موجود بذاته فلا يجوز عدمه. وإذا لم يجز عدمه وهو يوجب شيئا من هذه الأعراض، وجب أن لا يتبدّل ذلك العرض، فلا يسكن المتحرّك إن كان ذلك العرض حركة ولا يتحرّك الساكن إن كان العرض سكونا، والمعلوم خلافه.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المؤثّر، في ثبوت العرض موجبا قديما موجودا بذاته غير جائز العدم؛ ومع ذلك لا يلزم أن لا يتبدّل العرض، بأن يتوقف إيجابه للعرض على شرط، فيتبدّل العرض وينعدم بتبدّل شرطه وانعدامه مع بقاء موجبه القديم الموجود بذاته؟.
قلنا: الشرط المقدّر لا يخلو من أن يكون أزليّا او متجدّدا، إن كان أزليّا استحال تبدّله وعدمه فيستحيل تبدّل العرض وعدمه، إذا الموجب له وما هو شرط في إيجابه دائمان أبدا، وإن كان متجدّدا تحقق حدوث العرض، لأنّ المشروط بالمتجدّد لا يكون إلّا متجدّدا.
إن قيل: لم قلتم إنّ القديم موجود لذاته؟
قلنا: إنّه لا يخلو إمّا أن يكون موجودا لذاته أو غيره. وغيره إمّا أن يكون مختارا أو موجبا، والموجب إمّا أن يكون قديما أو محدثا، ولا يجوز أن يكون مختارا، لأنّ المختار هو الفاعل ومن شأنه أن يخرج الشيء من العدم إلى الوجود، وهذا في القديم مستحيل. ولا يجوز أن يكون موجبا محدثا، لأنّ المحدث لا يوجب حكما متقدّما على ذاته، سيّما بتقدير أوقات لا نهاية لها. وإن كان موجبا قديما، احتاج ذلك الموجب القديم أيضا إلى موجب قديم آخر له يكون قديما، ثمّ الكلام في القديم الثالث كالكلام في القديمين، فيؤدّي إلى ما لا يتناهى، وهو باطل.
فإن قيل: ذلك القديم الثاني يكون قديما لنفسه.
قلنا: أيّ فرق بينه وبين القديم الأوّل، إن كان هو قديما لنفسه فكذلك القديم الأوّل، وإن كان القديم الأوّل لموجب كان قديما، فليكن القديم الثاني قديما لموجب قديم آخر، وإلا فلا فرق. فثبت بهذا أنّ هذه الأعراض إمّا أن تكون [حدوثها] ثابتة بموجب محدث أو بفاعل. وأيّهما ثبت، ثبت حدوثه، لأنّ الحاصل بالمحدث لا يكون إلّا محدثا، وكذلك الحاصل بالفاعل لا يكون الّا محدثا، لوجوب تقدّم الفاعل على فعله ...
الثالث: انّ الجسم لم ينفك من هذه الأعراض :
أمّا الكلام في الفصل الثّالث، وهو أنّ الجسم ما خلا من هذه الأعراض، فظاهر أيضا.
وذلك لأنّا نعلم ضرورة أنّ الجسم المتحيّز لا بدّ من أن يكون إمّا واقعا في فراغ أو مارّا فيه ولا يعقل إلّا كذلك، ولهذا إذا فرضنا جسمين علمنا ضرورة أنّهما إمّا أن يكونا متماسّين أو غير متماسّين، وإذا فرضناهما غير متماسّين فإمّا أن يكونا متقاربين أو يكونا متباعدين، وكلّ هذا يشعر باستحالة وجود لا في جهة، وهو المعني بخلوّه عن هذه الأعراض.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال كانت هذه الأجسام موجودة لم يزل ولم تكن متحيّزة فكانت خالية من هذه الأعراض، ثمّ لمّا تحيّزت، اختصّ بها هذه الأعراض ولم تنفك بعد تحيّزها عن هذه الأعراض؟
قلنا: هذا إنّما يتوجّه على من يجعل المتحيّز أمرين ذاتا وحالا، فيقال له: هلّا كانت الذات ثابتة ولم تكن متحيّزة ثمّ تحيّزت؟ فأمّا نحن إذا ذهبنا إلى أنّ المتحيّز أمر واحد لا يتوجّه علينا هذا السّؤال، لأنّ ذلك بمنزلة أن يقال:
هلّا كانت متحيّزة ولم تك متحيّزة، أو هلّا كانت ثابتة ولم تك ثابتة، وهذا خلف من الكلام.
فإن قيل: لم قلتم إنّ المتحيّز أمر واحد، وليس ذاتا وحالا؟
قلنا: بيان ذلك أنّه لو كان ذاتا وحالا لوجب فيما علم المتحيّز من طريق الإدراك على ضرب من التّفصيل ولم يذهل عن علمه به، أنّه يجد من نفسه أنّه يعلم أمرا مضافا إلى أمر كما إذا علم المتحيّز متحرّكا، فإنّه يجد من نفسه أنّه يعلم إضافة معقول هو المتحرّك إلى معقول آخر هو المتحيز. وكما إذا عرفه أسود، فانّه يجد من نفسه أنّه يعلم إضافة معقول هو الهيئة إلى معقول آخر هو المتحيّز، ومعلوم أنّه لا يجد في علمه بالمتحيّز مثل هذا.
الرابع: انّ للحوادث أولا تنتهي عنده :
أمّا الفصل الرابع: وهو بيان أنّ الحوادث تنتهي عند أوّل ليتمّ لنا القول بحدوث الجسم بسبب أنّه لم يسبقها. وإلّا فمتى جوّزنا أن يكون الأمر في الحوادث على ما تقوله الأوائل، من أنّه كان قبل كل حادث حادث لا إلى أوّل، لم نعلم حدوث الجسم، وإن علمنا أنّه لم يخل من الحوادث.
والذي يدلّ على أنّ الحوادث لها أوّل هو أنّا نقدّر الكلام في حوادث جسمين، فنقول: إذا كان حوادث جسمين كلّ واحد منهما لا إلى أوّل، فما نقول إذا نقصنا بأوهامنا عن حوادث أحدهما [جملة كثرة] شيئا عظيما، كمائة ألف ألف حادث، ولم ننقص من حوادث الجسم الآخر شيئا، ثمّ أخذنا من حوادث الجسم الّذي لم ننقص منه شيئا واحدا وواحدا من باقي حوادث الجسم الّذي نقصنا منه ما نقصنا، وهكذا نأخذ من تلك واحدا ومن هذه واحدا، فإمّا أنّ يمرّا لا إلى أوّل متساويين أو يقصر الحوادث الّتي نقصنا منها ما نقصنا عن الّتي لم ننقص عنها شيئا. فإن مرّا، لا إلى أوّل، كان باطلا، لأنّ فيه مساواة النّاقص للزائد، وهذا باطل، وإن قصر دونه تعيّن تناهيه، لانّ ما لا يتناهى لا يقصر عن عدد، فإذا تناهى هذا الذي نقصنا منه تبيّن تناهي حوادث الآخر، لأنها ما ازدادت على هذه إلا بهذا المقدار المتناهي الذي نقصنا من هذه الحوادث، وما زيادته على المتناهي بعدد متناه يكون متناهيا، فثبت بهذا أنّ القول بحوادث لا إلى أوّل باطل وإذا بطل ذلك ثبت أنّ لها أوّلا وعلمنا أنّ الجسم ما سبقها، قطعنا على انّ للجسم أوّلا، وهو المقصود، ولم يبق في المسألة شبهة.
ويدلّ أيضا، على بطلان القول بحوادث لا إلى أوّل، أنّه لو صحّ ذلك لأدّى إلى استحالة حدوث حوادث زماننا هذا، بل إلى استحالة حدوث كلّ حادث معيّن، لأنّ من شرط حدوث كلّ حادث معيّن أن يسبقه حوادث لا إلى أوّل، وتتقطّع وتتصرّم بواحد بعد واحد حتّى تنتهي النوبة إلى ذلك الحادث المعيّن.
ومعلوم أنّ ما لا يتناهى عددا يستحيل أن ينقطع ويتصرّم بواحد بعد واحد، الا ترى أنّه لا أوّل له حتّى تنتهي النّوبة من الأوّل إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث وكذلك إلى أن ينتهي إلى الحادث المعيّن. وإذا كان هذا محالا- وهو شرط في حدوث كلّ حادث معيّن على هذا القول- وجب أن يستحيل حدوث كلّ حادث معيّن، والمؤدّي إلى استحالة ما تحقق ثبوته محال.
ووجه آخر: وهو أن يقال: متى تصرّمت الحوادث التي نقول إنّها لا إلى أوّل، فتصرّمها في زماننا هذا، فينبغي لو فرضنا أنّه ما حدث حادث قبل زماننا هذا بمائة سنة أن لا تكون تلك الحوادث الّتي هي بلا نهاية متصرّمة تامّة، وهذا يشعر بتناهيها، لأنّها إنّما تتمّ بالحوادث الّتي هي حوادث مائة سنة.
فإن قال: إنّما تصرّم في وقت آخر قبل هذا.
قلنا لهم مثل ذلك، وهو أنّه ينبغي أن تكون قبل ذلك ما كانت متصرّمة، فيكون ذلك أيضا مشعرا بتناهيها، إذ يكون تصرّمها باعتبار هذه الحوادث التي فصلناها عنها، وكذلك القول في كلّ وقت أو تقدير وقت معيّن، وعند هذا نعلم أنّه لو كان هاهنا حوادث لا إلى نهاية لكان تصرّمها أيضا لا إلى نهاية. وهذا محال، لأنّ فيه أنّ حكم المتصرّم السابق على تصرّمه وحكم تصرّمه المتأخّر عنه سيان في مرور كل واحد منهما لا إلى نهاية. ويتبيّن بتقدير ثالث قديم، فيقال: ذلك القديم كما لم ينفك من هذه الحوادث لم ينفكّ من تصرّم هذه الحوادث وفي هذا أنّ حكم السابق والمسبوق حكم واحد في التقدّم والسّبق، وهذا محال. فثبت أن القول بحوادث لا إلى أوّل محال، واذا بطل ذلك تعيّن أنّ لها أوّلا، وإذا تعيّن أنّ لها أوّلا، تعيّن حدوث الجسم الذي لم يسبقها.
ووجه آخر: وهو أنّه إذا وصف كلّ واحد منها بأنّه حادث، فقد أثبت لكلّ واحد منها أوّل. فإن قيل بعد ذلك إنّه لا أوّل لها، كان ذلك نقضا لما سلّم وأثبت، لأنّ من ضرورة الوصف الثابت للآحاد إثباته للجملة. ألا ترى أنّه لمّا كان كلّ واحد من الزّنج أسود وجب في جميعهم أن يكونوا سودا، ولا يصحّ غير ذلك.
فإن قال: أ لستم تقولون إن كلّ جزء من الإنسان ليس بقادر؟ وجملته قادر؟ فلم لا يجوز نظيره فيما نحن بصدده وهو أن نقول: كلّ واحد من هذه الأعراض محدث وله أوّل، ولا أوّل لجميعها.
قلنا: النفي في هذا الباب بخلاف الإثبات، فيجوز نفي وصف معيّن عن كلّ جزء من أجزاء جملة معيّنة، ثمّ إثبات ذلك الوصف بعينه لذلك المجموع ولا يكون ذلك تناقضا؛ وعكسه وهو إثبات وصف لكلّ جزء ثمّ سلبه عن المجموع غير جائز أ لا ترى انّه يصحّ أن يقال في كلّ جزء من أجزاء السرير إنّه ليس بسرير، ثمّ يوصف المجموع بأنه سرير، ولا يجوز قياسا على ذلك أن يقال:
كلّ جزء من أجزائه خشب، ومجموعه ليس بخشب. إذا ثبت أنّ الحوادث تنتهي إلى أوّل وثبت أنّ الجسم لم يسبقها، ثبت حدوث الجسم وتعيّن.
إثبات محدث الجسم
إذا ثبت حدوث الجسم لم يخل من أن يكون حدث مع الوجوب أو مع الجواز. وباطل أن يكون حدث مع الوجوب، لأنّه لو كان حادثا مع الوجوب لوجب أن يكون حادثا قبل ذلك وقبله وقبله، ولا يتوقف على أمر لأنّ توقّفه على أمر يقدح في وجوبه على ما أشرنا إليه، في الدلالة على حدوث الأعراض.
ونزيد عليه فنقول: إمّا أن يكون لوجوب حدوثه مخصّص أو لا يكون له مخصّص. فإن كان له مخصّص قدح في وجوبه بنفسه، ثمّ وفي هذا اعتراف بأنّ لحدوث الجسم مؤثّرا فنبيّن أنّه ليس لموجب حتّى يحصل به مقصودنا؛ وإن كان من غير مخصّص نبيّن أنّه يجب أن يكون محدثا قبله وقبله وقبل كلّ وقت يشار إليه، وفي ذلك قدمه وإبطال حدوثه. وبعد، فإن المحدث يكون موجودا بعد أن سبقه عدم، لا عن ابتداء، ومعلوم ضرورة أنّ ما كان معدوما في تقدير أوقات لا نهاية لها، لا يستحيل أن يبقى لحظة أخرى معدوما على ما كان، وفي ذلك جواز حدوثه، إذا ثبت أنّه حدث مع جواز أن لا يحدث وجب أن يكون حدوثه بمؤثّر لقضاء العقل به.
ثم ذلك المؤثر لا يخلو من أن يكون موجبا أو مختارا: إن كان موجبا لم يخل من أن يكون قديما أو محدثا، إن كان قديما لزم منه قدم الأجسام وقد ثبت حدوثها ، وإن كان محدثا احتاج إلى محدث آخر وإن كان المحدث الثاني مختارا ثبت أنّ الجسم لا يحصل، إلّا بتأثير مختار، وإن كان بواسطة، يبقى علينا أن نبيّن أنّه أحدثه من غير واسطة موجب؛ وإن كان موجبا كان الكلام فيه كالكلام في غيره ويحتاج إلى محدث آخر وذاك إلى آخر. فإمّا أن ينتهي إلى موجب قديم، فيتّجه عليه قدم الأجسام والوسائط التي بينها وبين ذلك الموجب القديم، أو إلى مختار وهو المقصود. يبقى علينا ما قلناه وهو أن تسقط الوسائط من البين أو تمرّ لا إلى نهاية، وقد أبطلنا القول بحوادث لا إلى أوّل فثبت أن للأجسام محدثا أحدثها على طريق الصّحة، لا على طريق الإيجاب.
وهذا كما يدلّ على إثبات محدث الأجسام يدلّ على كونه قادرا، لأنّه لا معنى للقادر إلّا الذي يمكن أن يؤثّر على طريق الصحّة والاختيار دون الإيجاب.
ومن أراد أن يحدّ القادر فليقل إنّه الذي يمتاز عن غيره امتيازا لمكانه يصحّ أن يفعل ولا يفعل. وهذا الامتياز قد يكون بمجرّد الذات في بعض المواضع وقد يكون بزائد على الذات في موضع آخر على ما يدلّ عليه الدليل.
ثمّ القادر الذي يصحّ أن يفعل ويصحّ أن لا يفعل، إذا بعثه باعث على الفعل ودعاه داع إليه صار وقوع الفعل منه أولى من لا وقوعه. وإذا صرفه عن الفعل صارف، صار لا وقوعه أولى من وقوعه وبهذا يحصل الفرق بين القادر والموجب، ومن هذا الوجه يلزم تقدّمه على فعله، إذا الموجب يتحتّم حصول موجبه عنه ولا يتوقف وقوعه على داع ولا وجوب انتفاء أثره على صارف، إذ لا داعي له ولا صارف، كالثقل في إيجابه الهويّ إذا لم يصادف مانعا، والنار في الإحراق.
فإن قيل: لم قلتم إنّ المؤثّر الذي أثبتموه وقلتم إنّه قادر أحدث الجسم من غير واسطة موجب؟ بيّنوا ذلك، لأنّ هذا البيان باق عليكم على ما ذكرتموه.
قلنا: لو كان ثمّ واسطة موجبة لم يخل من أن يكون له اختصاص ببعض الجهات أو لم يكن فإن لم يكن له اختصاص ببعض الجهات دون بعض لم يكن الجسم الحاصل منه بأن يحصل في بعض الجهات أولى من بعض فكان يجب أن يحصل في سائر الجهات. وإن كان له اختصاص بجهة دون جهة كان اعتمادا ومدافعة وأجناس المدافعات والاعتمادات في مقدورنا ونحن نفعلها، ومعلوم أنّه لا يتولّد منه الجسم، فثبت أنّ المحدث للجسم أحدثه من دون واسطة موجب.



|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يحتفي بذكرى عيد الغدير في بغداد
|
|
|