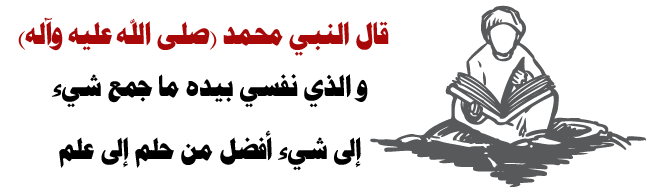
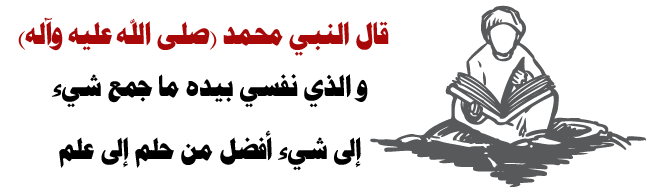

 التوحيد
التوحيد
 صفات الله تعالى
صفات الله تعالى
 الصفات الثبوتية
الصفات الثبوتية 
 العدل
العدل
 النبوة
النبوة
 الامامة
الامامة
 المعاد
المعاد
 فرق و أديان
فرق و أديان
 شبهات و ردود
شبهات و ردود
 أسئلة وأجوبة عقائدية
أسئلة وأجوبة عقائدية
 التوحيد
التوحيد
 القرآن الكريم
القرآن الكريم
 الأئمة الإثنا عشر
الأئمة الإثنا عشر
 أديان وفرق ومذاهب
أديان وفرق ومذاهب
 احاديث وروايات
احاديث وروايات
 أولياء وخلفاء وشخصيات
أولياء وخلفاء وشخصيات
 اسئلة عامة
اسئلة عامة
 الحوار العقائدي
الحوار العقائدي|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2017
التاريخ: 14-11-2016
التاريخ: 17-1-2019الإ
التاريخ: 18-1-2019
|
[نص الشبهة] تتركّز هذه الصياغة على مجموعة من الصفات الإلهيّة والأسماء والمصطلحات الخاصّة ، الواردة في القرآن الكريم ، منها :
ما قاله ( ماكدونالد D. B. Macdonald ) تحت مادّة ( الله ) ( ج ـ الله في ذاته ولذاته ): (وصَفة القدّوس وحدها من أسماء الله الحسنى ، ولكنّها لا ترد إلاّ مع كلمة ملك ، ولسنا نعرف على وجه التحقيق المعنى الذي يريده محمّد من كلمة قدّوس...) (1) .
ويقول أيضاً في المادّة نفسها : ( ومن أسمائه أيضاً السلام ( سورة الحشر، الآية 23 ) . وهذه الصفة لم ترد إلاّ في الآية 23 من سورة الحشر ، ومعناها شديد الغموض ، ونكاد نقطع بأنّها لا تعني ( السلم ) .
ويرى المفسّرون أنّ معناها ( السلامة ) أي البراءة من النقائص والعُيوب ، وهو تفسيرٌ محتمل ، وقد تكون هذه الصفة كلمةٌ بقيت في ذاكرة محمّد من العبارات التي تُتلى في صلوات النصارى ) (2) .
ويقول أيضاً : (... أمّا صفاته المعنويّة فقد وردت في قلّة يشوبها الغموض ، فإنّه يصعب علينا معرفة ما يَقصده محمّد من صفات ( القدّوس ) و( السلام ) و( النور ) . وهناك مجال للشكّ فيما إذا كان محمّد قد رأى من المناسب أنْ يطلق على الله صفة ( العدل ) (3) .
أمّا تحت مادّة ( الله ) ( د ـ صلة الخالق بخلقه ) فيقول : ( ومن الواضح أنّ صفة البارئ قد أخذها محمّد من العبريّة واستُعملت دون أنْ يُقصد منها معنىً خاص )(4) .
وتحت مادّة ( بسم الله ) يقول ( كارادي فو B. Carrde Vaux ) : ( وتساءل بعض المستشرقين عمّا إذا كانت صيغتا الرحمن والرحيم من أسماء آلهة الجاهليّة ، التي بقيَت إلى جانب اسم الله ، ثمّ أصبحتا مجرّد صفات )(5) .
وتحت مادّة ( الأنصار ) يقول ( ركندوف Reckendorf ) : ( ويظهر أنّ محمّداً استغلّ التشابه الموجود بين لفظ أنصار ونصارى فجعل عيسى يطلق على الحواريّين ( أنصار الله ) ( سورة آل عمران ، آية 52 ، سورة الصف ، آية 14)(6) .
وتحت مادّة ( بَعْل ) يقول ( ماكدونالد D. B. Macdonald ) : ( ولا يزال بين كلمة ( بَعْل ) التي تدلّ على إله وبين ( بَعِلَ ) معناها دهِش أو فَرِق ومشتقّاتها صلةٌ ضئيلة ، وليس لهذين الاشتقاقين الآن وجود... ودخلت [بَعل] إلى العربيّة تفسيراً لآيةٍ في القرآن ، وقد أشار القرآن ( سورة الصافّات ، الآيات 123 ـ 132 ) إلى قصّة إلياس ، وقال على لسانه : {أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ} [الصافات: 125] ، ومن المرجّح أنّ محمّداً قصَدَ بـ ( بَعْل ) ( بَعَل ) كما سمعها في قصّة من قصص التوراة ( سِفر الملوك الأوّل ، الإصحاح 18)(7).
أمّا ( بول F. Buhl ) فيقول تحت مادّة ( سورة ) : ( أمّا مِن أين أتى النبيّ بهذه الكلمة ؟ ، فأمرٌ لا يزال غيرُ ثابت على الرغم من المحاولات التي بُذلت لتتبّع أصلها . ويذهب ( نولدكه ) إلى أنّ ( سورة ) هي الكلمة العبريّة الحديثة ( شورا ) ومعناها الترتيب أو السلسلة ، ولو قد أمكن تفسيرها بأنّها ( السطر ) لِما قادنا ذلك إلى المعنى الأصلي للكلمة...)(8) .
[جواب الشبهة] : تهدف هذه الشبهة إلى تكوين دليل على نفي الوحي بالقرآن ، وأنّه إمّا من مخترعات النبيّ محمّد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أو أنّه اقتبسه من الغير ...
وإنَّ جميع مفردات هذه الشُبهة تعود في الحقيقة إلى جَهل المستشرقين ، أو تجاهلهم لمعاني ألفاظٍ عربيّة وردَت في القرآن الكريم ، فافترضوا ، بعد تشكيل مقدّمةٍ باطلة من معانٍ وهميّة ادّعوها لتلك الألفاظ ، أنّها استُعيرت من صلوات النصارى مرّة، أو أُخِذَت من العبريّة مرةً أُخرى ، أو أنّها من الأسماء الجاهليّة ثالثة ، أو استقيت من قصص التوراة رابعة ، أو أنّها ألفاظ شديدة الغموض ، أو لا معنى لها خامسة ، وهكذا... ويبقى الهدف الحقيقي وراء هذه التمحّلات هو إنكار الوحي الإلهي للرسول محمّد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، [وجوابه في الصفحة (313-346) من هذا الكتاب في موضوع ادّعاء النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وابتكاره واصطناعه وتأثره بمَن حوله].
أمّا أهمّ الألفاظ التي أنكروا الأصالة العربيّة لبعضها ، وجهلوا أو تجاهلوا استعمالها في معانيها العربيّة الأصيلة في آيات القرآن الكريم ، فهي كالآتي حسب تسلسل ورودها في الشبهة السالفة الذكر :
1 ـ قُدّوس : على وزن فُعُّول من القُدْس . وفي التهذيب : القُدْسُ تنزيه الله تعالى ، والقدّوس : من أسماء الله تعالى ، قال الأزهري : القدّوس هو الطاهر المُنزّه عن العيوب والنقائص ، وقال ابن الكلبي : القدّوس ، وحكى ابن الأعرابي : والمقدّس المبارك .
ويُقال أرضٌ مقدّسة أي مباركة ، وهو قول العجاج :
قد عَلِمَ القَدُّوس مولى القُدْس أَنَّ أبا العبّاس أولى نفسِ
بِمَعْدن المُلْك القديم الكرْسي
يعني بالقدّوس هنا الله سبحانه وتعالى وبالقُدْس الأرض المباركة(9) .
وقد طابق قول المفسّرين المعنى اللغوي في تفسير كلمة ( قُدّوس ) ، فذكر الطباطبائي في تفسير الميزان أنّ القدوس مبالغة في القُدس وهو النزاهة والطهارة(10) .
وقال الطوسي في تفسير التبيان : ( القُدّوس ) معناه المُطهَّر فتطهر صفاته عن أنْ يدخل فيها صفةُ نقص(11) .
فكيف يدّعي ( ماكدونالد ) عدم معرفة المعنى المراد من هذه الكلمة في القرآن الكريم ؟!.
2 ـ السَّلام : ورد في معنى السَّلام والسلامة : البراءة . وتسلّمَ منه : تبَرّأ. وقال ابن الأعرابي : السلامة العافية . والتسليم : مشتقٌّ من السلام اسم الله تعالى ، لسلامته من العيب والنقص . والسَّلامُ : البراءة من العيوب في قول أُميّة :
سَلامك رَبَّنا في كلّ فجرٍ***بريئاً ما تعنّتكَ الذُّمُومُ
والذُّموم : العيوب ، أي ما تَلزقُ بك ولا تُنسب اليك(12) .
وهنا أيضاً جاء قول المفسّرين مطابقاً للمعنى اللغوي ، مِن أنّ السلام هو الذي يسْلَم عباده من ظلمه(13) ، وأنّ السلام من يلاقيك بالسلامة والعافية من غير شرٍّ وضرّ(14) .
فأين شدّة الغموض الذي يدّعيه ( ماكدونالد ) في المعنى الواضح لهذه الكلمة القرآنيّة ؟!
3 ـ النُّور : جاء في قواميس اللغة أنّ مِن أسماء الله تعالى النور ؛ قال ابن الأثير : هو الذي يُبصِر بنوره ذو العَماية ، ويَرْشدُ بهُداه ذو الغَوايَةِ ، وقيل : هو الظاهر الذي به كلّ ظُهور ، والظاهر في نفسه المُظْهِر لغيره يُسمّى نوراً .
قال أبو منصور : والنور من صِفات الله عزّ وجل ، قال عزّ وجلّ : ( اللّهُ نُورُ السّماوَاتِ وَالأَرْضِ )(15) .
وقد ورد في تفسير هذه الآية الكريمة : إنّ النور معروف وهو ظاهرٌ مكشوف لنا بنفس ذاته ، فهو الظاهر بذاته المُظهِر لغيره من المحسوسات للبصر ، هذا أوّل ما وضع عليه لفظ النور ، ثمّ عُمّم لكلّ ما ينكشف به شيء من المحسوسات على نحو الاستعارة أو الحقيقة الثانية ، فعُدَّ كل من الحواسّ نوراً أو ذا نور يُظهِر به محسوساته كالسمع والشم والذوق واللمس ، ثمّ عُمِّم لغير المحسوس فعدّ العقل نوراً يظهر به المعقولات .
كلّ ذلك بتحليل معنى النور المُبصِر إلى الظاهر بذاته المُظهِر لغيره... فقد تحصّل أنّ المراد بالنور في الآية الكريمة ، الذي يستنير به كلُّ شيء وهو مساوٍ لوجود كلّ شيء وظهوره في نفسه ولغيره وهي الرحمة العامّة(16) .
بعد هذا البيان كيف يدّعي ( ماكدونالد ) صعوبة معرفة المقصود من وصف الله تعالى بالنور ؟!
4 ـ العدل : ما قام في النفوس أنّه مستقيم ، وهو ضدّ الجور . وفي أسماء الله سبحانه : العَدْل ، هو الذي لا يَميلُ به الهوى فيجور في الحكم ، وهو في الأصل صدر سُمِّي به فوُضِعَ موضع العادل ، وهو أبلغ منه لأنّه جُعِلَ المُسَمّى نفسه عَدلاً(17) .
وكلمة العدل وإنْ لم ترد كصفة أو اسم من أسماء الله سبحانه في القرآن الكريم ، إلاّ أنّها جاءت كذلك في حديث الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )(18) .
5 ـ البارئ : من برأ ، وهي من أسماء الله عز وجلّ ، والله البارئ : الذي خَلَقَ لا عن مثال(19) . وبهذا المعنى جاءت في الآية الكريمة : {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} [الحشر: 24] أي المُحدِث المُنشئ للأشياء ممتازاً بعضها عن بعض (20) .
فكلمة البارئ لفظٌ عربيٌّ أصيل استعمل في المعنى الخاص الذي أشرنا إليه ، خلافاً لما ادّعاه ( ماكدونالد ) من أنّها استقيت من العبريّة ولم يقصد من استعمالها معنىً خاصّاً .
6 ـ بَعْل : يُقال للرجل ، هو بَعْلُ المرأة ، ويُقال للمرأة ، هي بَعْلُه وبَعْلتُه . وباعَلت المرأةُ : اتّخذت بعلاً ، وباعل القوم قوماً آخرين مُباعَلة وبِعالاً : تزوّج بعضهم إلى بعض ، والأنثى بَعْل وبَعْلة مثل زوج وزوجة ؛ قال الراجز :
شَرُّ قرينٍ للكبير بَعلتُه تُولغ كلباً سُؤرَه أو تكْفِتُه
وبَعَل يَبْعَل بُعولة وهو بَعْل: صار بَعْلاً وقال: يا رُبَّ بَعْل ساء ما كان بَعَل.
وبَعْلُ الشيء : رَبُّه ومالكهُ . وفي حديث الإيمان : وإنْ تَلِدَ الأمة بَعْلَها ؛ المراد بالبعل ههنا المالك يعني كثرة السبي والتسرّي ، فإذا استولد المسلم جاريةً كان ولدها بمنزلة ربّها .
وبَعْلٌ والبَعْل جميعاً : صَنَم ، سُمّي بذلك لعبادتهم إيّاه كأنّه ربّهم . وقوله عز وجلّ : {أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ} [الصافات: 125] يُقال : أنا بَعْلُ هذا الشيء أي رَبُّه ومالكه ، كأنّه يقول : أتدعون ربّاً سِوى الله ؟
ورُوي عن ابن عبّاس : إنّ ضالَّةً أُنشدَت فجاء صاحبها فقال : أنا بعلُها ، يُريدُ ربّها ، فقال ابن عبّاس : هو من قوله أتدعون بعلاً أي رَبّاً . وورد أنّ ابن عبّاس مرَّ برجُلين يختصمان في ناقة وأحدهما يقول : أنا والله بعلُها ، أي مالِكُها وربّها . وقولهم : مَنْ بَعلُ هذه الناقة ؟ أي مَنْ رَبُّها وصاحبها(21) .
وجاء في كتب التفسير ما يُطابق المعاني اللغويّة التي ذكرناها ، منها في تفسير الآية ( أَتَدْعُونَ بَعْلاً...) ، قال الحسن والضحّاك وابن زيد : المراد بالبعل ـ ههنا ـ صنم كانوا يعبدونه ، والبعل في لغةِ أهل اليمن هو الربّ ، يقولون : مَنْ بَعْل هذا الثوب أي مَنْ ربّه ـ وهو قول عِكرمة ومجاهد وقتادة والسدّي ـ ويقولون : هو بَعل هذه الدابّة أي ربّها(22) .
وعليه فكيف يدّعي ( ما كدونالد ) أنّ هذه الكلمة دخلت إلى العربيّة تفسيراً لآيةٍ في القرآن الكريم ؟
7 ـ سورة . السورة : المَنْزِلَة ، والجمع سُوَرٌ ، والسُّوَرةُ من البناء : ما حَسُنَ وطال . قال الجوهري : والسُّوْرُ جمع سُورَة مثل بُسْرَة وبُسْرٍ ، وهي كل منزلة من البناء ؛ ومنه سُورَة القرآن لأنّها منزلةٌ بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى ، والجمع سُوَرٌ بفتح الواو ؛ قال الراعي :
هُنَّ الحرائرُ لا رَبّاتُ أَخْمِرَةٍ سُودُ المَحاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بالسُّوَرِ
وقال ابن سيّده : سُمّيت السُّورَةُ من القرآن سُورَةً لأنّها درجة إلى غيرها ، وروى الأزهري بسنده عن أبي الهيثم قال : أمّا سورة القرآن فإنّ الله جلَّ ثناؤه جعلها سُوَراً مثل غُرْفَةٍ وغُرَفٍ ورُتْبَةٍ ورُتَبٍ وزُلْفَةٍ وزُلَفٍ(23) .
بعد هذا البيان للمعنى اللغوي الأصل لكلمة ( سورة ) في اللغة العربيّة واستعمالها بهذا المعنى في القرآن الكريم ، كيف يوجّه ( بول ) استفهامه عن مصدر هذه الكلمة وأصالتها ؟ وكيف يدّعي ( نولدكه ) أنّها عبارة عن الكلمة العبريّة الحديثة ( شورا ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) دائرة المعارف الإسلاميّة 2 : 562 .
(2) المصدر السابق 2 : 563 .
(3) المصدر السابق .
(4) المصدر السابق : 564 .
(5) المصدر السابق 3 : 64 .
(6) المصدر السابق 3 : 53 .
(7) المصدر السابق 3 : 694 .
(8) المصدر السابق 12 : 358 .
(9) لسان العرب : مادّة ( قدس ) . والقاموس المحيط مادّة ( قدس ) .
(10) السيّد الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن 19 : 256.
(11) الطوسي ، التبيان 9 : 573 .
(12) لسان العرب : مادّة ( سلم ) . والقاموس المحيط : مادّة ( سلم ).
(13) الطوسي ، التبيان 9 : 573 .
(14) السيّد الطباطبائي في تفسير القرآن 19 : 256 .
(15) لسان العرب : مادّة ( نور ) .
(16) السيّد الطباطبائي ، الميزان 15 : 122 .
(17) لسان العرب : مادّة ( عدل ) . والقاموس المحيط : مادّة ( عدل ) .
(18) راجع : بحار الأنوار 2 : 238 ـ 239 .
(19) لسان العرب : مادّة ( برأ ) . والقاموس المحيط : مادّة ( برأ ) .
(20) السيّد الطباطبائي ، الميزان 19 : 257 . والطوسي ، التبيان 9 : 574 .
(21) لسان العرب مادّة ( بعل ) . والقاموس المحيط : مادّة ( بعل ) .
(22) الطوسي ، التبيان 8 : 524 ـ 525 .
(23) لسان العرب : مادّة ( سور ) . والقاموس المحيط : مادّة ( سور ) .



|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يحتفي بذكرى عيد الغدير في بغداد
|
|
|