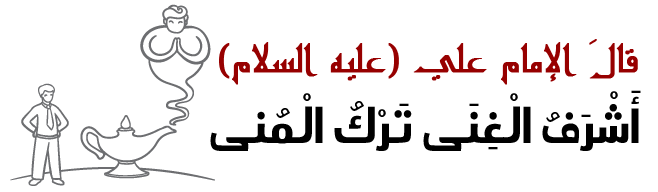
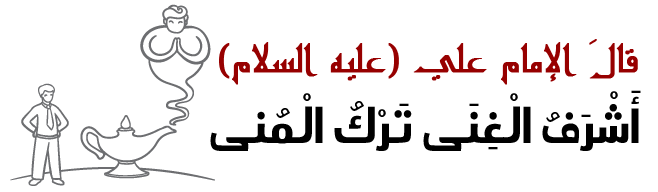

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015
التاريخ: 13-02-2015
التاريخ: 13-02-2015
التاريخ: 5-10-2014
|
قال اليعقوبي : وكانت العرب تقيم الشعر مقام الحكمة وكثير العلم، فإذا كان في القبيلة الشاعر الماهر، المصيب المعاني، المخير الكلام، أحضروه في أسواقهم الّتي كانت تقوم لهم في السنة ومواسمهم عند حجهم البيت، حتى تقف وتجتمع القبائل والعشائر، فتسمع شعره، ويجعلون ذلك فخراً من فخرهم، وشرفاً من شرفهم.
ولم يكن لهم شيء يرجعون إليه من أحكامهم وأفعالهم إلاّ الشعر، فبه كانوا يختصمون، وبه يتمثلون، وبه يتفاضلون، وبه يتقاسمون، وبه يتناضلون، وبه يمدحون ويعابون.
فكان ممن قدم شعره في جاهلية العرب على ما اجتمعت عليه الرواة وأهل العلم بالشعر، وجاءت به الاثار والاخبار من شعراء العرب في جاهليتها مع من أدركه الاسلام، فسمّي مخضرماً، فإنّهم دخلوا مع من تقدم، فسموا الفحول، وقدِّموا على تقدّم أشعارهم في الجودة، فإن كان بعضهم أقدم من بعض وهم على ما بيّنا من أسمائهم ومراتبهم على الولاء، فأوّلهم امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو آكل المرار بن معاوية بن ثور، وهو كندة.
ثم ذكر أسماء ثمانية وثمانين شاعراً بأنسابهم (1).
وفي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (2).
ورووا انّ المحلق كان ممن رفعه الشعر بعد الخمول، وذلك أن الاعشى قدم مكّة وتسامع الناس به، وكانت للمحلق امرأة عاقلة، وقيل بل أم، وكان المحلق فقيراً خامل الذكر، ذا بنات، فأشارت عليه، أن يكون أسبق الناس إليه في دعوته إلى الضيافة، ليمدحهم، ففعل . فلما أكل الاعشى وشرب، وأخذت منه الكأس، عرف منه أنّه فقير الحال، وأنّه ذا عيال، فلما ذهب الاعشى إلى عكاظ أنشد قصيدته :
أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشق
ثمّ مدح المحلق، فما أتم القصيدة إلاّ والناس ينسلون إلى المحلق يهنئونه، والاشراف من كل قبيلة يتسابقون إليه جرياً يخطبون بناته، لمكان شعر الاعشى.
ويذكر الرواة أنّ القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به، وفرحت بنبوغه، وأتت القبائل فهنأتها بذلك، وصنعت الاطعمة، واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهر، وتباشروا به لانّه حماية لهم، ولسانهم الذاب عنهم المدافع عن أعراضهم وأحسابهم وشرفهم بين الناس. وكانوا لا يهنأون إلاّ بغلام يولد أو فرس تُنتج أو شاعر ينبغ فيهم (3).
فالشاعر هو صحيفة القبيلة و(محطة إذاعتها)، وصوته، يحطّ ويرفع ويخلّد، لا سيما إذا كان مؤثراً، فيرويه الناس جيلاً بعد جيل.
وكان أثره في الناس أثر السيف في الحروب، بل استعمله المحاربون أوّل سلاح في المعارك. فيبدأ الفارس بالرجز، ثم يعمد إلى السيف أو الرمح أو آلات القتال الاخرى. ولأثره هذا، جاء في الحديث عن الرسول قوله : ((والذّي نفسي بيده، لكأنما تنضحونهم بالنبل بما تقولون لهم من الشعر))(4) مخاطباً بذلك شعراء المسلمين، الذين حاربوا الوثنيين بهذا السلاح الفتاك، سلاح الشعر.
وقد كان الوثنيون قد أشهروه أيضاً وحاربوا به المسلمين.
وطالما قام الشعراء بالسفارة والوساطة في النزاع الّذي كان يقع بين الملوك والقبائل، أو بين القبائل أنفسها، فلما أسر (الحارث بن أبي شمر) الغساني (شأس بن عبدة) في تسعين رجلاً من (بني تميم)، وبلغ ذلك أخاه (علقمة بن عبدة)، قصد (الحارث) فمدحه بقصيدته:
طحا بك قلبٌ بالحسان طروب بُعيد الشباب عصر حان مشيب
فلما بلغ طلبه بالعفو عن أخيه وعن بقية المأسورين، قال الحارث: نعم وأذنبه، وأطلق له شأساً أخاه، وجماعة أسرى بني تميم، ومن سأل فيه أو عرفه من غيرهم (5).
ولم يقلّ أثر الشاعر في السلم وفي الحرب عن أثر الفارس، الشاعر يدافع عن قومه بلسانه، يهاجم خصومهم، ويهجو سادتهم، ويحث المحاربين على الاستماتة في القتال، ويبعث فيهم الشهامة والنخوة للإقدام على الموت حتى النصر. والفارس يدافع عن قومه بسيفه، وكلاهما ذاب عنهم محارب في النتيجة. بل قد يقدم الشاعر على الفارس، لما يتركه الشعر من أثر دائم في نفوس العرب، يبقى محفوظاً في الذاكرة وفي اللسان، يرويه الخلف عن السلف، بينما يذهب أثر السيف، بذهاب فعله في المعركة، فلا يترك ما يتركه شعر المديح أو الهجاء من أثر في النفوس، يهيجها حين يذكر، وكان من أثره ان القبائل كانت إذا تحاربت جاءت بشعرائها، لتستعين بهم في القتال. فلما كان يوم (أُحد)، قال (صفوان بن أمية) لابي عزة عمرو بن عبداللّه الجمحي: ((يا أبا عزة انك امرؤ شاعر فأعنّا بلسانك، فاخرج معنا. فقال: إن محمداً قد منّ عليّ ولا أريد أن أظاهر عليه.
قال: فاعنا بنفسك، فلك اللّه عليّ إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر، فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة)) شعراً إلى السير مع قريش لمحاربة المسلمين (6).
وكان للرسول (صلى الله عليه واله وسلم) شاعره (حسان بن ثابت) يدافع عن الاسلام والمسلمين، وكان للمشركين من أهل مكّة شاعرهم (عبداللّه بن الزبعري) يرد عليه، ويهاجم المسلمين في السلم وفي المعارك.
وقد دوّنت كتب السير والاخبار والتواريخ أشعارهم وما قاله أحدهم في الاخر، وقد فات منه شيء كثير، نص رواة الشعر على أنهم تركوه لما كان فيه من سوء أدب وخروج على المروءة.
وكان إلى جانب الشاعرين شعراء آخرون، منهم من ناصر المسلمين، لانّه كان منهم، ومنهم من ناصر المشركين لانّه كان منهم . بل كان المحاربون إذا حاربوا، فلابد وأن يبدأوا حربهم بتنشيطها وبتصعيد نارها برجز أو بقريض.
ومن خوفهم من لسان الشاعر ما روي من فزع أبي سفيان، لما سُمع من عزم (الاعشى) على الذهاب إلى يثرب ومن اعداده شعراً في مدح الرسول، ومن رغبته في الدخول في الاسلام. فجمع قومه عندئذ، وتكلم فيما سيتركه شعر هذا الشاعر من أثر في الاسلام وفي قريش خاصة إن هو أسلم، ولهذا نصحهم أن يتعاونوا معه في شراء لسانه وفي منعه من الدخول في الاسلام بإعطائه مائة ناقة فوافقوا على رأيه، وجمعوا له ما طلبه، وتمكن أبو سفيان من التأثير فيه، فعاد إلى بلده (منفوحة) ومات بها دون أن يسلم (7).
قال (الجاحظ) يبلغ من خوفهم من الهجاء ومن شدة السبّ عليهم، وتخوفهم أن يبقى ذكر ذلك في الاعقاب، ويسبّ به الاحياء والاموات، انّهم اذا أسروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق، وربما شدوا لسانه بنسعة، كما صنعوا بعبد يغوث بن وقّاص الحارثي حين أسرته بنو تيم يوم الكلاب (8). و (عبد يغوث ابن وقاص) شاعر قحطاني، كان شاعراً من شعراء الجاهلية، فارساً سيد قومه من بني الحارث بن كعب، وهو الّذي قادهم يوم الكلاب الثاني، فأسرته بنو تيم وقتلته، وهو من أهل بيت شعر معروف في الجاهلية والاسلام، منهم اللجلاج الحارثي، وهو طفيل بن زيد بن عبد يغوث، وأخوه (مسهر) فارس شاعر، ومنهم من أدرك الاسلام: جعفر بن علبة بن ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث، وكان شاعراً صعلوكاً (9).
وفي جمهرة أنساب العرب:
(وهؤلاء بنو قُرَيْع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة ولدُ قُرَيع بن عوف: جعفر، وهو أنْف الناقة: لُقِّب بذلك لانَّ أباه نحر ناقةً، فقسمها في نسائه، وأعطى ابنه جعفراً رأسَ الناقة، فأخذ بأنْفها، فقيل له: ما هذا؟ فقال: ((أنف الناقة!)).
فلُقّب بذلك. فكان ولده يغضبون منه، إلى أن قال الحطيئة مادحاً لهم :
قومٌ همُ الانْفُ والاذْنابُ غيرُهُم ومَنْ يُساوي بأنْفِ النَّاقةِ الذَّنَبَا
فصار ذلك مدحاً لهم، يفتخرون به) (10).
وفي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 9 / 113:
ولما مدح الحطيئة (بغيض بن عامر بن لاي بن شماس بن لاي بن أنف الناقة)، واسمه (جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم)، وهجا (الزبرقان)، واسمه (الحصين بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن عوف ابن كعب)، صاروا يفخرون ويتباهون بأن يقال لهم (أنف الناقة)، وكانوا يعيرون به ويغضبون منه ويفرقون من هذا الاسم، حتى أنّ الرجل منهم كان يسأل ممن هو فيقول من (بني قريع) فيتجاوز جعفراً أنف الناقة، ويلغي ذكره فراراً من هذا اللقب، إلى أن قال (الحطيئة) هذا الشعر فصاروا يتطاولون بهذا النسب، ويمدون به أصواتهم في جهارة، إذ قال:
قوم هم الانف والاذناب غيرهم ومن يُسوّي بأنف الناقة الذنبا (11)
وقد تعزز الاعشى على قومه، وبين مكان فضله عليهم، إذ كان لسانهم الذاب عنهم المدافع عن أعراضهم، الهاجي لأعدائهم بشعر هو كالمقراض يقرض أعداء قومه قرضاً.
أدفع عن أعراضكم وأعيركم لساناً كمقراض الخفاجي ملحبا (12)
وذكر أن بني تغلب كانوا يعظمون معلّقة عمرو بن كلثوم ويروونها صغاراً وكباراً، حتى هجاهم شاعر من شعراء خصومهم ومنافسيهم بكر بن وائل، إذ قال:
الهي بني تغلب عن كلّ مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم
يروونها أبداً مُذْ كان أولهم يا للرجال لشعرٍ غير مسئومِ (13)
ولسلاطة ألسنة بعض الشعراء، ولعدم تورع بعضهم من شتم الناس ومن هتك الاعراض، ومن التكلم عنهم بالباطل، تجنب الناس قدر امكانهم الاحتكاك بهم، وملاحاتهم والتحرش في أمورهم، خوفاً من كلمة فاحشة قد تصدر عنهم، تجرح الشخص الشريف فتدميه، و ((جُرْح اللسان كجرح اليد))، كما عبر عن ذلك امرؤ القيس أحسن تعبير(14).
ولأمر ما قال طرفة:
رأيت القوافي تتلجن موالجاً تَضَايَقُ عنها أن تَوَلجها الابر
وفي هذا المعنى دوّن (الجاحظ) هذه الابيات:
وللشعراء ألسنةٌ حدادٌ على العوراتِ موفية دليله
ومن عقل الكريم إذا اتقاهم وداراهم مدارةً جميله
اذا وضعوا مكاويهم عليه - وإن كذبوا ـ فليس لهنّ حيله (15)
و ((كان عمر بن الخطاب عالماً بالشعر، قليل التعرض لأهله : استعداه رهط تميم بن أبي مقبل على النجاشي لما هجاهم، فأسلم النظر في أمرهم إلى حسان بن ثابت، فراراً من التعرض لاحدهما، فلما حكم حسان أنفذ عمر حكمه على النجاشي كالمقلد من جهة الصناعة، ولم يكن حسان ـ على علمه بالشعر ـ أبصر من عمر بوجه الحكم، وان اعتل فيه بما اعتل))(16).
________________________
1- تاريخ اليعقوبي 1 / 262 ـ 269.
2- المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 9 / 109 ـ 113.
3- بلوغ الارب 3 / 84، العمدة، 1 / 49، 65، المزهر 3 / 236، العقد الفريد 3 / 93.
4- الاغاني 15 / 26 و ط. بيروت 16 / 165.
5- العمدة 1 / 57، (أسر الحارث بن أبي شمر الغساني مع سبعين رجلا من بني تميم)، الشعر والشعراء (1 / 147 وما بعدها).
6- الروض الانف (2 / 126 وما بعدها)، (غزوة أحد).
7- الشعر والشعراء (136 وما بعدها)، زيدان، آداب 1 / 119.
8- البيان والتبيين 2 / 268.
9- الخزانة 1 / 317 (بولاق) و ط. القاهرة سنة 1387 ه 2 / 202 ـ 203.
10- جمهرة الانساب لابن حزم ص 209.
11- وفي البيان والتبيين 4 / 38، (هارون، الاشتقاق ص 156 و ط. مصر 1378 ه ص 255، زهر الآداب 1 / 19، الخزانة 1 / 567، العمدة 1 / 50).
12- ديوان الاعشى ص 117، القصيدة 14، البيت 31.
13- الاشتقاق ص 204، و ط. مصر 1378 ه ص 339، وقد روى هذه الشعر بأوجه مختلفة، البيان والتبيين 4 / 41.
14- العمدة 1 / 78.
15- العمدة 1 / 78.
16- العمدة 1 / 52، 76، (باب تعرض الشعراء). انتهى ما نقلناه من المفصّل 9 / 109 ـ 114.



|
|
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|