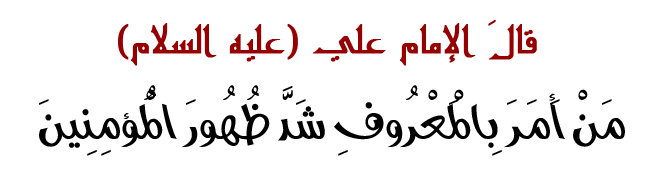
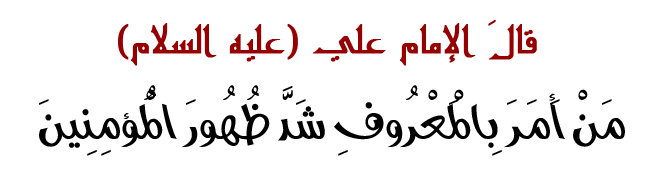

 القانون العام
القانون العام
 القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري و القضاء الاداري
 المجموعة الجنائية
المجموعة الجنائية
 قانون العقوبات
قانون العقوبات 
 القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية 
 القانون الخاص
القانون الخاص
 قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات و الاثبات
 المجموعة التجارية
المجموعة التجارية
 علوم قانونية أخرى
علوم قانونية أخرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
التاريخ: 16-5-2017
التاريخ: 2024-12-11
التاريخ: 2025-03-19
|
يقوم الإثبات في التشريعات الجنائية الإجرائية الحديثة على أساس (مبدأ القناعة الوجدانية), فهو مبدأ أساسي من مبادئ نظرية الإثبات الجنائي فيحكم القاضي حسب القناعة التي تكونت لديه من الأدلة التي قدمت في الدعوى ولا يتقيد بطريق معين من طرق الإثبات, فله أن يكّوَن عقيدته في الدعوى من جميع أدلتها, كما أن له سلطة واسعة في تحري الحقيقة حسبما يهدي إليه ضميره, فلا تصح مطالبته في الأخذ بدليل دون آخر, لأن الأمر مرجعه إلى اطمئنانه وحده(1).
فللقاضي الجنائي أن يزن الأدلة المقدمة في الدعوى وأن يكشف عن قوة كل دليل, فلا يتقيد بأدلة محددة سلفاً منحها القانون قوة ثبوتية لا يستطيع أن يتخطاها, لأن مبدأ الأدلة القانونية الذي كان سائداً فيما مضى قد اضمحل, حيث كان يفرض على القاضي قبول أدلة معينة لها قوة محددة في الإثبات لا يملك القاضي الحق في وزنها وتقديرها, كما أنه لم يكن للخصوم حرية تقديم أدلتهم بمختلف الوسائل(2). ولا يعني مبدأ القناعة الوجدانية أن القاضي الجنائي يحكم وفق مزاجه الشخصي, فإن الاقتناع الذي يفرضه القانون يجب أن يكون له سنده العقلي, فلا يجوز أن ينبني الاقتناع على التحكم ولا أن يجافي العقل والمنطق القانوني, فهو لا يستهدف إعطاء السلطة المطلقة للقاضي، وإنما غايته كشف الحقيقة من أي سبيل يجده القاضي مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك سوى ضميره(3), فالقانون لا يمنح القاضي قوة خلاقة بل يعتبر دوره تأكيداً لإرادة المشرع, إذ ليس من حقه مسايرة أفكاره الخاصة في تقدير الأدلة ومن ثم تقدير الحكم لأن ذلك لا يجوز أن يكون حقلاً للأفكار الشخصية(4), كما أن القانون قيد القاضي الجنائي من حيث القواعد التي تحدد كيفية حصوله على الدليل والشروط التي يتعين توافرها فيه ومخالفة هذه الشروط قد تهدر قيمة الدليل وتشوب القضاء بالاستناد إليه بالبطلان(5). ولا يخضع تقدير الأدلة من قبل القاضي الجنائي لرقابة محكمة التمييز, لأن محكمة التمييز لا تراقب تقدير القاضي واستخلاصه للدليل وإنما دورها ينحصر في مراقبة صحة الدليل, أي أنها تراقب صحة الأسباب التي استندت إليها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها, لهذا نجد أن القاضي الجنائي ليس مكلفاً ببيان أسباب اقتناعه غير أنه مكلف في بيان أسباب الحكم الذي انتهى إليه وذلك بذكر الأدلة التي اعتمدها في تكوين قناعته(6), فمحكمة التمييز في الإثبات الجنائي تراقب محكمة الموضوع بماذا اقتنعت وليس لماذا اقتنعت, فتقدير الأدلة مسألة واقع لا قانون لكي تخضع لرقابة محكمة التمييز. ومبدأ القناعة الوجدانية مبدأ قانوني نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية بمادته (213/أ) حيث نصت بأن: "تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة...", كما نصت على ذلك المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها بأن "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته", فأهمية النص على هذا المبدأ تنبع من التخلي عن كل قواعد الإثبات التحكمية التي كانت تقود إلى الاستبداد والتحكم, كما أن هذه القاعدة تستخدم كمنبه لتوخي احتياطات خاصة في الفحص المتوازن لوسائل الإثبات. وإذا كان مبدأ القناعة الوجدانية مقصوراً على القاضي في إطلاق حريته في الإثبات, فإن ذلك لا يعني عدم إعطاء الحرية للخصوم أو الادعاء العام في إثبات الوقائع المعروضة أمام القضاء, فحرية الإثبات يستفيد منها جميع الخصوم وهي تتعلق بإجراءات الدعوى, فلكل من هؤلاء أن يعرض أي طريق من طرق الإثبات للمناقشة بصرف النظر عما يسفر عنه تحقيق الدليل(7).
فحرية الإثبات هي إحدى مميزات الإثبات في المسائل الجنائية, وذلك على عكس الحال في المسائل المدنية حيث يحدد القانون وسائل الإثبات وقوتها, ومرجع الاختلاف هو أن الإثبات في المسائل المدنية ينصب على أعمال قانونية بينما يتعلق الإثبات الجنائي وقائع مادية ونفسية, فالادعاء العام يلجأ إلى كافة الوسائل لإثبات وقوع الجريمة من قبل المتهم, وهذا ما نصت عليه المادة (163) الأصولية بأن: "للمحكمة أن تأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو تكلف أي شخص بتقديم ما لديه من معلومات أو أوراق أو أشياء إذا رأت أن ذلك يفيد كشف الحقيقة...".
______________
1- ينظر: د. نائل عبد الرحمن صالح, محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, عمان 1997, ص173.
2- ينظر: د. محمد محي الدين عوض, الإثبات بين الازدواج والوحدة في الجنائي والمدني في السودان, مطبعة جامعة القاهرة بالخرطوم, 1974, ص85.
3- في عرض الأساس الذي تقوم عليه القناعة القضائية ينظر: د. فاضل زيدان محمد, سلطات القاضي الجنائي في تقدير الأدلة, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 1999, ص107-109, د. الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، المجلد الاول ، دار النهضة العربية، القاهرة 1981, ص349.
4- ينظر: د. أكرم نشأت إبراهيم, الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة
(دراسة مقارنة), مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 1998, ص59.
5- للتفصيل في بطلان الإجراء الجنائي ينظر: د. سليمان عبد المنعم, بطلان الإجراء الجنائي, دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع, الإسكندرية 1999, ص109 وما بعدها.
6- للتفصيل في ذلك ينظر: د. امين مصطفى محمد, التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض, دار النهضة العربية, القاهرة 2002, ص17 وما بعدها.
7- ينظر: محمد فالح حسن, مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي, رسالة ماجستير, كلية القانون/جامعة بغداد, 1978, ص31.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|