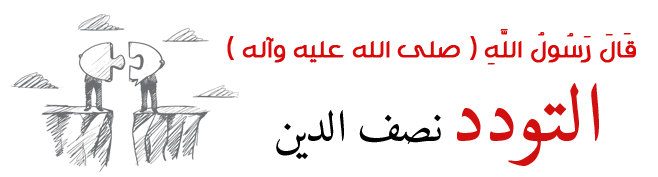
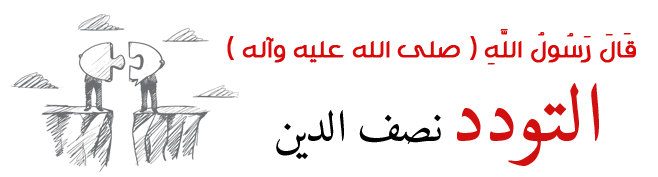

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
التاريخ: 9-12-2016
التاريخ: 1-3-2017
التاريخ: 20-2-2017
|
قال تعالى : {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَو نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ} [البقرة : 135 - 138].
{وقالوا} الضمير يرجع إلى اليهود والنصارى أي قالت اليهود {كونوا هودا} وقالت النصارى كونوا {نصارى} كل فريق منهم دعا إلى ما هو عليه ومعنى {تهتدوا} أي تصيبوا طريق الحق كأنهم قالوا تهتدوا إلى الحق أي إذا فعلتم ذلك كنتم قد اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة {قل} يا محمد {بل ملة إبراهيم} أي بل نتبع دين إبراهيم وعلى الوجه الآخر بل اتبعوا دين إبراهيم وقد عرفت الوجوه الثلاثة في الإعراب فلا معنى لإعادتها {حنيفا} مستقيما وقيل مائلا إلى دين الإسلام وفي الحنيفية أربعة أقوال (أحدها) أنها حج البيت عن ابن عباس والحسن ومجاهد (وثانيها) أنها اتباع الحق عن مجاهد (وثالثها) أنها اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما للناس بعده من الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام (والرابع) أنها الإخلاص لله وحده في الإقرار بالربوبية والإذعان للعبودية وكل هذه الأقوال ترجع إلى ما قلناه من معنى الاستقامة والميل إلى ما أتى به إبراهيم (عليه السلام) من الملة {وما كان من المشركين} أي وما كان إبراهيم من المشركين نفى الشرك عن ملته وأثبته في اليهود والنصارى حيث قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله وفي قوله سبحانه {بل ملة إبراهيم} حجة على وجوب اتباع ملة إبراهيم (عليه السلام) لسلامتها من التناقض ولوجود التناقض في اليهودية والنصرانية فلذلك صارت ملة إبراهيم أحرى بالإتباع من غيرها فمن التناقض في اليهودية منعهم من جواز النسخ مع ما في التوراة من الدلالة على جوازه وامتناعهم من العمل بما تقدمت به البشارة في التوراة من اتباع النبي الأمي مع إظهارهم التمسك بها وامتناعهم من الإذعان لما دلت عليه الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة من نبوة عيسى ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) مع إقرارهم بنبوة عيسى بدلالة المعجزات عليها إلى غير ذلك من أنواع التناقض ومن التناقض في قول النصارى قولهم الأب والابن وروح القدس إله واحد مع زعمهم أن الأب ليس هو الابن وأن الأب إله والابن إله وروح القدس إله وامتناعهم من أن يقولوا ثلاثة آلهة إلى غير ذلك من تناقضاتهم المذكورة في الكتب .
{قولوا آمنا بالله} خطاب للمسلمين وقيل خطاب للنبي والمؤمنين أمرهم الله تعالى بإظهار ما تدينوا به على الشرع فبدأ بالإيمان بالله لأنه أول الواجبات ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرائع {وما أنزل إلينا} يعني القرآن نؤمن بأنه حق وصدق وواجب اتباعه في الحال وإن تقدمته كتب {وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط} قال قتادة هم يوسف وإخوته بنو يعقوب ولد كل واحد منهم أمة من الناس فسموا الأسباط وبه قال السدي والربيع ومحمد بن إسحاق وذكروا أسماء الاثني عشر يوسف وبنيامين وزابالون وروبيل ويهوذا وشمعون ولاوي ودان وقهاب(2) ويشجر ونفتالي وجاد وأشرفهم ولد يعقوب لا خلاف بين المفسرين فيه.
وقال كثير من المفسرين أنهم كانوا أنبياء والذي يقتضيه مذهبنا أنهم لم يكونوا أنبياء بأجمعهم لأن ما وقع منهم من المعصية فيما فعلوه بيوسف (عليه السلام) لا خفاء به والنبي عندنا معصوم من القبائح صغيرها وكبيرها وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أنهم كانوا أنبياء وقوله {وما أنزل} إليهم لا يدل على أنهم كانوا أنبياء لأن الإنزال يجوز أن يكون كان على بعضهم ممن كان نبيا ولم يقع منه ما ذكرناه من الأفعال القبيحة ويحتمل أن يكون مثل قوله {وما أنزل إلينا} وأن المنزل على النبي خاصة لكن المسلمين لما كانوا مأمورين بما فيه أضيف الإنزال إليهم.
وقد روى العياشي في تفسيره عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر الباقر قال قلت له أ كان ولد يعقوب أنبياء قال لا ولكنهم كانوا أسباطا أولاد الأنبياء ولم يكونوا فارقوا الدنيا إلا سعداء تابوا وتذكروا ما صنعوا وقوله {وما أوتي موسى وعيسى} أي أعطيا وخصهما بالذكر لأنه احتجاج على اليهود والنصارى والمراد بما أوتي موسى التوراة وبما أوتي عيسى الإنجيل {وما أوتي النبيون} أي ما أعطيه النبيون {من ربهم لا نفرق بين أحد منهم} أي بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعله اليهود والنصارى فكفرت اليهود بعيسى ومحمد وكفرت النصارى بسليمان ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) .
{ونحن له مسلمون} أي نحن لما تقدم ذكره وقيل لله خاضعون بالطاعة مذعنون بالعبودية وقيل منقادون لأمره ونهيه وقد مضى هذا مستوفى فيما قبل وفائدة الآية الأمر بالإيمان بالله والإقرار بالنبيين وما أنزل إليهم من الكتب والشرائع والرد على من فرق بينهم فيما جمعهم الله عليه من النبوة وإن كانت شرائعهم غير لازمة لنا فإن الإيمان بهم لا يقتضي لزوم شرائعهم وروي عن الضحاك أنه قال علموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه حتى يؤمنوا بهم ويصدقوا بما جاءوا به فإن الله تعالى يقول {قولوا آمنا بالله} الآية .
{فإن آمنوا} أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الكفار متى آمنوا على حد ما آمن المؤمنون به {فقد اهتدوا} إلى طريق الجنة وقيل سلكوا طريق الاستقامة والهداية وقيل كان ابن عباس يقول اقرءوا بما آمنتم به فليس لله مثل وهذا محمول على أنه فسر الكلام لا أنه أنكر القراءة الظاهرة مع صحة المعنى وقوله {وإن تولوا} أي أعرضوا عن الإيمان وجحدوه ولم يعترفوا به {فإنما هم في شقاق} أي في خلاف قد فارقوا الحق وتمسكوا بالباطل فصاروا مخالفين لله سبحانه عن ابن عباس .
وقريب منه ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال يعني في كفر وقيل في ضلال عن أبي عبيدة وقيل في منازعة ومحاربة عن أبي زيد وقيل في عداوة عن الحسن {فسيكفيكهم الله} وعد الله سبحانه رسوله بالنصرة وكفاية من يعاديه من اليهود والنصارى الذين شاقوه وفي هذا دلالة بينة على نبوته وصدقه (صلى الله عليه وآله وسلّم) المعنى أن الله سبحانه يكفيك يا محمد أمرهم {وهو السميع} لأقوالهم {العليم} بأعمالهم في إبطال أمرك ولن يصلوا إليك .
{صبغة الله} أي اتبعوا دين الله عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد ويقرب منه ما روي عن الصادق (عليه السلام) قال يعني به الإسلام وقيل شريعة الله التي هي الختان الذي هو تطهير عن الفراء والبلخي وقيل فطرة الله التي فطر الناس عليها عن أبي العالية وغيره {ومن أحسن من الله صبغة} أي لا أحد أحسن من الله صبغة أي بينا لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الجحد عن الحسن وغيره {ونحن له عابدون} أي من نحن له عابدون يجب أن تتبع صبغته لا ما صبغنا عليه الآباء والأجداد وقيل ونحن له عابدون في اتباعنا ملة إبراهيم صبغة الله .
_____________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج1 ، ص403-408.
2- كذا في النسخ . وفي الطبري (قهات ) بالتاء المثناة.
{وقالُوا كُونُوا هُوداً أَو نَصارى تَهْتَدُوا} . الضمير في قالوا يعود إلى أهل الكتاب ، والمعنى قال اليهود ، كونوا يهودا تهتدوا ، لأن الهداية بزعمهم تنحصر بهم وحدهم ، وقال النصارى مثل قول اليهود . . وقال اللَّه لنبيه الأكرم محمد (صلى الله عليه واله وسلم) :
{قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ} ، أي لا نتبع اليهودية ، ولا النصرانية ، بل نتبع ملة إبراهيم . وقد ذكرنا في تفسير الآية 111 - 113 ما يلقي ضوءا على هذه الادعاءات وما إليها .
المنطق الجدلي :
وربّ قائل يقول : اليهود قالوا : نحن المحقون فقط ، والنصارى قالوا :
بل نحن فقط . . ومحمد (صلى الله عليه واله وسلم) قال : بل إبراهيم هو المحق لا اليهود ولا النصارى . وكل هذه الأقوال مصادرات وادعاءات بظاهرها ، وإذا صح لليهود
والنصارى أن يستعملوا هذا النحو من المنطق الباطل ، فإنه لا يصح نسبة مثله إلى اللَّه ورسوله ، فما هو الوجه ؟ .
الجواب : ان الغرض من قوله : (بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) هو النقض على اليهود و افحامهم ، لا اثبات الحقيقة بالذات ، ويجوز للإنسان أن ينقض على خصمه بشيء لم يكن حجة في نفسه ، بل حجة عند الخصم فقط ، أو ينقض عليه بمثل ما هو حجة عنده ، كالنقض على النصارى بآدم الذي لا أب له ، حيث قالوا :
المسيح رب ، لأنه من غير أب ، فينقض عليهم بأن آدم من غير أب ، فينبغي أن يكون ربا أيضا ، مع انكم تنفون عنه الربوبية . . ويسمى هذا النوع من المنطق بالمنطق الجدلي ، ووجه النقض على اليهود والنصارى ، و افحامهم فيما نحن فيه :
ان اليهود والنصارى مختلفون دينا وعقيدة ، وكل طائفة تكفّر الأخرى ، وهم في الوقت نفسه متفقون على صحة دين إبراهيم ، وبديهة ان إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، بل كان (حنيفا - أي موحدا - وما كان من المشركين) . أي لم يكن إبراهيم يهوديا ، لأنه لم يقل : عزير ابن اللَّه ، ولا جعل للَّه شبيها كما زعم اليهود بأن اللَّه شيخ أبيض الرأس واللحية ، ولم يكن نصرانيا ، لأنه لم يقل المسيح ابن اللَّه ، لأن ذلك هو الشرك واقعا . . وما دام كل من اليهود والنصارى يعترفون بدين إبراهيم فيلزمهم أن يكونوا موحدين ، بل ويحجوا أيضا إلى بيت اللَّه الحرام ، تماما كما كان يعتقد ويفعل إبراهيم ، وكما اعتقد وفعل محمد ، مع العلم بأنهم لم يوحدوا ولم يحجوا ، فإذن هم كاذبون بنسبتهم إلى دين إبراهيم ، ومحمد (صلى الله عليه واله وسلم) هو الصادق الأمين على دين اللَّه ، وملة إبراهيم .
وبتعبير ثان ان الأخذ بالمتفق عليه ، وهو دين التوحيد الذي كان عليه إبراهيم ، وعليه الآن محمد أولى من الأخذ بالمختلف فيه ، وهو اليهودية المشبهة ، والنصرانية المثلثة .
{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} . الخطاب للمسلمين .{وما أُنْزِلَ إِلَيْنا} . وهو القرآن .
{وما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ} . وهي صحف إبراهيم ، وقيل : انها عشر .{وإسماعيل وإسحاق} . هما ولدا إبراهيم ، وإسماعيل أكبر من اسحق ، وأمه هاجر ، وأم اسحق سارة . ويعقوب ، ابن اسحق ، والصحف لم تنزل إليهم جميعا ، وانما أنزلت إلى إبراهيم فقط ، ولكن صحّت نسبة الانزال إلى الجميع بالنظر إلى أنهم متعبدون بها ، وداعون إليها ، تماما كما يصح لنا نحن المسلمين أن نقول : انزل القرآن إلينا ، لأننا نؤمن ونعمل به ، وندعو إليه .
(والأسباط) . هم حفدة يعقوب من أبنائه الاثني عشر ، وهم بمنزلة القبائل العربية من ذرية إسماعيل ، وفي الأسباط أنبياء كثيرون كداود ، وسليمان ، ويحيى ، وزكريا ، وأيضا فيهم المؤمنون الذين تعبدوا بصحف إبراهيم (عليه السلام) .
{وما أُوتِيَ مُوسى وعِيسى} . التوراة والإنجيل ، {وما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ} .
كالزبور المنزلة على داود ، {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} . أي نؤمن بالجميع ، سواء من كان له كتاب يؤثر ، أولم يكن ، ولسنا كاليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض ، وكفروا ببعض ، بل الجميع عندنا سواء ، من حيث الاعتراف بنبوتهم . . وبديهة ان الايمان بجميع الأنبياء انما يجب بنحو الإجمال ، ولسنا مكلفين بالتفاصيل إلا بعد البيان من كتاب أوسنة .
{ونَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} . أي معترفون له بالوحدانية ، ومخلصون في العبودية .
{فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا} . أي فان آمنوا ايمانا صحيحا ، وهو التوحيد الخالص من شوائب الشرك ، واعترفوا بجميع الأنبياء بما فيهم محمد ، تماما كما آمن المسلمون بجميع الأنبياء دون استثناء فعندها يكونون مهتدين . . وليس المراد أن يؤمنوا بدين مثل دين الإسلام ، إذ لا مثيل للإسلام إطلاقا .
{وإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ} . كل من عاند الحق فقد شق العصا ، وبدد الشمل . (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ) إذ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله .
والكلمة الجامعة باختصار لكل ما قدمناه هي ان الإسلام يرفض التعصب ، ويدعو للتعاون على أساس الخير والعدل ، ويعترف بالحق أينما كان ويكون ، ويدعو أتباعه أن يفتحوا قلوبهم للناس ، كل الناس في مودة واخلاص .
{صبغة اللَّه} وهي دين الحق الذي يطهّر القلوب والعقول من الأقذار و الأكدار ، لا الغمس بالماء الأصفر ، كما تفعل النصارى ، ولا غير ذلك . قال محيي الدين ابن عربي في تفسيره :
(ان كل ذي اعتقاد ومذهب باطنه مصبوغ بصبغ اعتقاده ، ودينه ومذهبه ، فالمتعبدون بالملل المتفرقة مصبوغون بصبغ نيتهم ، والمتمذهبون بصبغ إمامهم وقائدهم ، والحكماء بصبغ عقولهم ، وأهل البدع والأهواء المتفرقة بصبغ أهوائهم ، والموحدون بصبغة اللَّه خاصة التي لا صبغ أحسن منها ، ولا صبغ بعدها) .
____________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص211-214.
قوله تعالى: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا}، لما بين تعالى أن الدين الحق الذي كان عليه أولاد إبراهيم من إسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده كان هو الإسلام الذي كان عليه إبراهيم حنيفا، استنتج من ذلك أن الاختلافات والانشعابات التي يدعو إليها فرق المنتحلين من اليهود والنصارى، أمور اخترعتها هوساتهم، ولعبت بها أيديهم لكونهم في شقاق، فتقطعوا بذلك طوائف وأحزابا دينية، وصبغوا دين الله سبحانه – وهو دين التوحيد ودين الوحدة، بصبغة الأهواء والأغراض والمطامع، مع أن الدين واحد كما أن الإله المعبود بالدين واحد وهو دين إبراهيم، وبه فليتمسك المسلمون وليتركوا شقاق أهل الكتاب.
فإن من طبيعة هذه الحياة الأرضية الدنيوية التغير والتحول في عين الجري والاستمرار كنفس الطبيعة التي هي كالمادة لها ويوجب ذلك أن تتغير الرسوم والآداب والشعائر القومية بين طوائف الملل وشعباتها، وربما يوجب ذلك تغييرا وانحرافا في المراسم الدينية، وربما يوجب دخول ما ليس من الدين في الدين، أو خروج ما هو منه والأغراض والغايات الدنيوية ربما تحل محل الأغراض الدينية الإلهية وهي بلية الدين، وعند ذلك ينصبغ الدين بصبغة القومية فيدعو إلى هدف دون هدفه الأصلي ويؤدب الناس غير أدبه الحقيقي، فلا يلبث حتى يعود المنكر وهوما ليس من الدين معروفا يتعصب له الناس لموافقته هوساتهم وشهواتهم والمعروف منكرا ليس له حام يحميه ولا واق يقيه ويئول الأمر إلى ما نشاهده اليوم من...
وبالجملة فقوله تعالى: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى}، إجمال تفصيل معناه وقالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، كل ذلك لتشعبهم وشقاقهم.
قوله تعالى: {قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين}، جواب عن قولهم أي قل، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا فإنها الملة الواحدة التي كان عليها جميع أنبيائكم، إبراهيم، فمن دونه، وما كان صاحب هذه الملة وهو إبراهيم من المشركين ولوكان في ملته هذه الانشعابات، وهي الضمائم التي ضمها إليها المبتدعون، من الاختلافات لكان مشركا بذلك، فإن ما ليس من دين الله لا يدعو إلى الله سبحانه، بل إلى غيره وهو الشرك، فهذا دين التوحيد الذي لا يشتمل على ما ليس من عند الله تعالى.
قوله تعالى: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا}، لما حكى ما يأمره به اليهود والنصارى من اتباع مذهبهم، ذكر ما هو عنده من الحق والحق يقول وهو الشهادة على الإيمان بالله، والإيمان بما عند الأنبياء، من غير فرق بينهم، وهو الإسلام وخص الإيمان بالله بالذكر وقدمه وأخرجه من بين ما أنزل على الأنبياء لأن الإيمان بالله فطري، لا يحتاج إلى بينة النبوة، ودليل الرسالة.
ثم ذكر سبحانه ما أنزل إلينا وهو القرآن أو المعارف القرآنية وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ثم ذكر ما أوتي موسى وعيسى وخصهما بالذكر لأن المخاطبة مع اليهود والنصارى وهم يدعون إليهما فقط ثم ذكر ما أوتي النبيون من ربهم، ليشمل الشهادة جميع الأنبياء فيستقيم قوله بعد ذلك: لا نفرق بين أحد منهم.
واختلاف التعبير في الكلام، حيث عبر عما عندنا وعند إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالإنزال وعما عند موسى وعيسى والنبيين بالإيتاء وهو الإعطاء، لعل الوجه فيه أن الأصل في التعبير هو الإيتاء، كما قال تعالى بعد ذكر إبراهيم، ومن بعده ومن قبله من الأنبياء في سورة الأنعام: {أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ } [الأنعام: 89] ، لكن لفظ الإيتاء ليس بصريح في الوحي والإنزال كما قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ } [لقمان: 12] ، وقال: {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ } [الجاثية: 16] ، ولما كان كل من اليهود والنصارى يعدون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من أهل ملتهم، فاليهود من اليهود، والنصارى من النصارى، واعتقادهم أن الملة الحق من النصرانية، أو اليهودية، هي ما أوتيه موسى وعيسى، فلوكان قيل: وما أوتي إبراهيم وإسماعيل لم يكن بصريح في كونهم بأشخاصهم صاحب ملة بالوحي والإنزال واحتمل أن يكون ما أوتوه، هو الذي أوتيه موسى وعيسى (عليهما السلام) نسب إليهم بحكم التبعية كما نسب إيتاؤه إلى بني إسرائيل فلذلك خص إبراهيم ومن عطف عليه باستعمال لفظ الإنزال، وأما النبيون قبل إبراهيم فليس لهم فيهم كلام حتى يوهم قوله: {وما أوتي النبيون شيئا} يجب دفعه.
قوله تعالى: {والأسباط}، الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل والسبط كالقبيلة الجماعة يجتمعون على أب واحد، وقد كانوا اثنتي عشرة أسباطا أمما وكل واحدة منهم تنتهي إلى واحد من أولاد يعقوب وكانوا اثني عشر، فخلف كل واحد منهم أمة من الناس(2).
فإن كان المراد بالأسباط الأمم والأقوام فنسبة الإنزال إليهم لاشتمالهم على أنبياء من سبطهم، وإن كان المراد بالأسباط الأشخاص كانوا أنبياء أنزل إليهم الوحي وليسوا بإخوة يوسف لعدم كونهم أنبياء، ونظير الآية قوله تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى} [النساء: 163] .
قوله تعالى: {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا}، الإتيان بلفظ المثل مع كون أصل المعنى، فإن آمنوا بما آمنتم به، لقطع عرق الخصام والجدال، فإنه لو قيل لهم أن آمنوا بما آمنا به أمكن أن يقولوا كما قالوا، بل نؤمن بما أنزل علينا ونكفر بما وراءه، لكن لو قيل لهم، إنا آمنا بما لا يشتمل إلا على الحق فآمنوا أنتم بما يشتمل على الحق مثله، لم يجدوا طريقا للمراء والمكابرة، فإن الذي بيدهم لا يشتمل على صفوة الحق.
قوله تعالى: {في شقاق}، الشقاق النفاق والمنازعة والمشاجرة والافتراق.
قوله تعالى: {فسيكفيكهم الله}، وعد لرسول الله بالنصرة عليهم، وقد أنجز وعده وسيتم هذه النعمة للأمة الإسلامية إذا شاء، واعلم: أن الآية معترضة بين الآيتين السابقة واللاحقة.
قوله تعالى: {صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة}، الصبغة بناء نوع من الصبغ أي هذا الإيمان المذكور صبغة إلهية لنا، وهي أحسن الصبغ لا صبغة اليهودية والنصرانية بالتفرق في الدين، وعدم إقامته.
قوله تعالى: {ونحن له عابدون}، في موضع الحال، وهو كبيان العلة لقوله: {صبغة الله ومن أحسن}.
____________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج1 ، ص259-261.
2- قال ابن فارس : السين والباء والطاء اصل يدل على امتداد شيء وقال الراغب في المفردات (ورجل سبط الكفين ممتدهما ويعبر به عن الجود والسبط : ولد الولد كأنه امتداد الفروع) وعن الازهري واخرين اشتقاقه الاسباط من السبط وهو ضرب من الشجر اغصانه كثيرة وأصله واحد وفي الحديث لحسين سبط من الاسباط اي امة من الامم . وفي سورة الاعراف وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا اي امة وجماعة وانما فسر العدد بالجمع لانه قصد الامم ولم يقصد السبط نفسه فهو منصوب على البدل لا على التمييز.
نحن على حقّ لا غيرنا!
التمحور والإِنغماس في الذاتية يؤدي إلى أن يحتكر الإِنسان الحقّ لنفسه، ويعتبر الآخرين على باطل، ويسعى إلى أن يجرهم إلى معتقداته.
الآية الاُولى تتحدث عن مجموعة من أهل الكتاب يحملون مثل هذه النظرة الضيقة، ونقلت عنهم القول: {وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارى تَهْتَدُوا}.
فيردّ عليهم القرآن مؤكداً أن الأديان المحرّفة لا تستطيع إطلاقاً أن تهدي الإِنسان {قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}.
التدين الخالص هو اتباع الخط التوحيدي الخالص غير المشوب بالشرك. ورعاية هذا الأساس أهم معيار للتمييز بين الأديان الصحيحة والأديان المنحرفة.
يعلمنا الإِسلام أن لا نفرق بين الرسل، وأن نحترم رسالاتهم، لأن المبادىء الأساسية للأديان الحقّة واحدة، موسى وعيسى كانا أيضاً من أتباع ملة إبراهيم ... أي من أتباع الدين التوحيدي الخالص من الشرك، وإن حرّف المغرضون من أتباعهما ما جاءا به، وجعلوه مشوباً بالشرك. و(كلامنا هذا لا يتنافى طبعاً مَعَ إيماننا بأن البشرية يجب أن تتبع آخر الاديان السماوية أي الإِسلام).
الآية التالية تأمر المسلمين أن {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالاْسَبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}.
لا يجوز أن ننطلق من محور الذاتية في الحكم على هذا النّبي أو ذاك، بل يجب أن ننظر إلى الأنبياء بمنظار رسالي، ونعتبرهم جميعاً رسل ربّ العالمين ومعلّمي البشرية، قد أدّى كلٌ منهم دوره في مرحلة تاريخية معينة، وكان هدفهم واحداً، وهو هداية النّاس في ظل التوحيد الخالص والحق والعدالة.
ثم يضيف القرآن قائلا: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوْا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق}.
ولو تخلى هؤلاء عن عنصريتهم و ذاتياتهم، وآمنوا بجميع أنبياء الله فقد اهتدوا أيضاً، وإلاّ فقد ضلوا سواء السبيل.
و «الشّقاق» النزاع والحرب، وفسرت في الآية بالكفر وبالضلال، وبالإِبتعاد عن الحق والإِتجاه نحو الباطل، وكل هذه المعاني تعود إلى حقيقة واحدة.
ذكر بعض المفسرين أن الآية السابقة التي ساوت بين عيسى وسائر الأنبياء. أثارت اعتراض جمع من النصارى وقالوا: إن عيسى ليس كسائر الأنبياء، بل هو ابن الله، فنزلت هذه الآية لتؤكد على انحراف هؤلاء وأنهم في شقاق.
ثم تثبت الآية على قلوب المؤمنين وتبعث فيهم الثقة والطمأنينة بالقول: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ} لأقوالهم (الْعَلِيمُ) بمؤامراتهم.
التّخلّي عن غير صبغة الله:
بعد الدّعوة التي وجهتها الآيات السابقة لإِتّباع الأديان بشأن إنتهاج طريق جميع الأنبياء، أول آية في بحثنا تأمرهم جميعاً بترك كل صبغة، أي دين، غير «صبغة الله»(2).
ثم تضيف الآية: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً}؟! أي لا أحسن من الله صبغة، {وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ} في اتباع ملّة إبراهيم التي هي صبغة الله، وقيل المعنى: من نحن له عابدون يجب أن تتبع صبغته، لا ما صَبَغَنا عليه الآباء والأجداد(3).
وبهذا أمر القرآن بالتخلي عن الصبغات العنصرية والطائفية والذاتية وعن كل الصّبغات المفرّقة، والإِتّجاه نحو صبغة الله.
ذكر المفسرون أن النصارى دأبوا على غسل أبنائهم بعد ولادتهم في ماء أصفر اللون، ويسمونه غسل التعميد، ويجعلون ذلك تطهيراً للمولود من الذنب الذاتي الموروث من آدم!
القرآن يرفض هذا المنطق الخاوي، ويقول: من الأفضل أن تتركوا هذه الصبغات الظاهرية الخرافية المفرقة، وتصطبغوا بصبغة الله، لتطهر روحكم.
ما أجمل تعبير «الصبغة» في هذه الآية! وما أروع هذه الدعوة إلى الإِصطباغ بصبغة الله!
لو حدث ذلك ... لو اختارت البشرية صبغة الله ... أي صبغة الطهر والتقوى والعدالة والمساواة والأُخوّة ... صبغة التوحيد والإِخلاص ... لاستطاعت أن تستأصل جذور الشرك والنفاق والتفرقة ... إنّها في الحقيقة الصبغة التي لا لون بها وتطهر الانسان من جميع الالوان.
وعن الإِمام الصادق(عليه السلام): أن «صِبْغَةَ اللهِ» هِيَ الاْسْلاَمُ(4)، وهذا إشارة إلى ما ذكرناه.
كان اليهود وغيرهم يحاجّون المسلمين بصور شتّى، كانوا يقولون: إنّ جميع الأنبياء مبعوثون منا، وإن ديننا أقدم الأديان، وكتابنا أعرق الكتب السماوية.
وكانوا يقولون: إن عنصرنا أسمى من عنصر العرب، ونحن المؤهلون لحمل الرسالة لا غيرنا، لأن العرب أهل أوثان.
وكانوا يدّعون أحياناً أنهم أبناء الله وأن الجنّة لهم لا لغيرهم.
______________________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج1 ، ص327و331.
2 ـ «صِبْغَةً» منصوبة على أنّها مفعول مطلق لفعل محذوف أي (اصطبغوا) صبغة الله، أو أنّها بدل من «ملة إبراهيم» في الآيات المتقدمة، أو مفعول به لفعل محذوف والتقدير (اتبعوا صبغة الله) والله أعلم!
3 ـ مجمع البيان، ذيل الاية مورد البحث.
4 ـ نور الثقلين، ج 1، ص 132. واصول الكافي ، ج2 ، ص14.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|