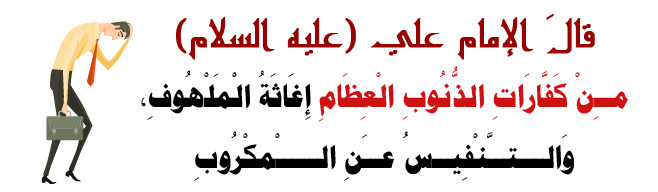
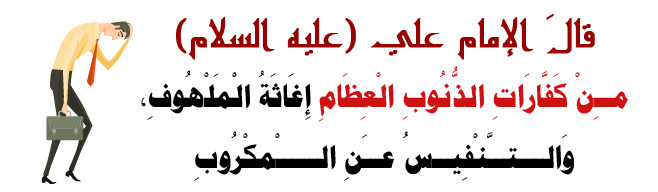

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-2-2017
التاريخ: 25-11-2016
التاريخ: 1-3-2017
التاريخ: 10-5-2017
|
قال تعالى : {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [البقرة: 127 - 129].
بين سبحانه كيف بنى إبراهيم البيت فقال {وإذ يرفع} وتقديره واذكر إذ يرفع {إبراهيم القواعد من البيت} أي أصول البيت التي كانت قبل ذلك عن ابن عباس وعطاء قالا قد كان آدم (عليه السلام) بناه ثم عفا أثره فجدده إبراهيم (عليه السلام) وهذا هو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) وقال مجاهد بل أنشأه إبراهيم (عليه السلام) بأمر الله عز وجل وكان الحسن يقول أول من حج البيت إبراهيم وفي روايات أصحابنا أن أول من حج البيت آدم (عليه السلام) وذلك يدل على أنه كان قبل إبراهيم وروي عن الباقر أنه قال أن الله تعالى وضع تحت العرش أربع أساطين وسماه الضراح وهو البيت المعمور وقال للملائكة طوفوا به ثم بعث ملائكة فقال ابنوا في الأرض بيتا بمثال وقدره وأمر من في الأرض أن يطوفوا بالبيت وفي كتاب العياشي بإسناده عن الصادق قال أن الله أنزل الحجر الأسود من الجنة لآدم وكان البيت درة بيضاء فرفعه الله تعالى إلى السماء وبقي أساسه فهو حيال هذا البيت وقال يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدا فأمر الله سبحانه إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على القواعد وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن أول شيء نزل من السماء إلى الأرض لهو البيت الذي بمكة أنزله الله ياقوتة حمراء ففسق قوم نوح في الأرض فرفعه وقوله {وإسماعيل} أي يرفع إبراهيم وإسماعيل أساس الكعبة يقولان ربنا تقبل منا وفي حرف عبد الله بن مسعود ويقولان ربنا تقبل منا ومثله قوله سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أي يقولون سلام عليكم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أي يقولون وقال بعضهم تقديره يقول ربنا برده إلى إبراهيم (عليه السلام) قال لأن إبراهيم وحده رفع القواعد من البيت وكان إسماعيل صغيرا في وقت رفعها وهو شاذ غير مقبول لشذوذه فإن الصحيح أن إبراهيم وإسماعيل كانا يبنيان الكعبة جميعا وقيل كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجر فوصفا بأنهما رفعا البيت عن ابن عباس وفي قوله {ربنا تقبل منا} دليل على أنهما بنيا الكعبة مسجدا لا مسكنا لأنهما التمسا الثواب عليه والثواب إنما يطلب على الطاعة ومعنى {تقبل منا} أثبنا على عمله وهو مشبه بقبول الهدية فإن الملك إذا قبل الهدية من إنسان أثابه على ذلك وقوله {إنك أنت السميع العليم} أي أنت السميع لدعائنا العليم بنا وبما يصلحنا وروي عن الباقر أن إسماعيل أول من شق لسانه بالعربية وكان أبوه يقول له وهما يبنيان البيت يا إسماعيل هات ابن(2) أي أعطني حجرا فيقول له إسماعيل بالعربية يا أبة هاك حجرا فإبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وفي هذه الآية دلالة على أن الدعاء عند الفراغ من العبادة مرغب فيه مندوب إليه كما فعله إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) .
ثم ذكر تمام دعائهما (عليهما السلام) فقال سبحانه : { ربنا واجعلنا مسلمين لك} أي قال ربنا واجعلنا مسلمين في مستقبل عمرنا كما جعلتنا مسلمين في ماضي عمرنا بأن توفقنا وتفعل بنا الألطاف التي تدعونا إلى الثبات على الإسلام ويجري ذلك مجرى أن يؤدب أحدنا ولده ويعرضه لذلك حتى صار أديبا فيجوز أن يقال جعل ولده أديبا وعكس ذلك إذا عرضه للبلاء والفساد جاز أن يقال جعله ظالما فاسدا وقيل أن معنى مسلمين موحدين مخلصين لك لا نعبد إلا إياك ولا ندعو ربا سواك وقيل قائمين بجميع شرائع الإسلام مطيعين لك لأن الإسلام هو الطاعة والانقياد والخضوع وترك الامتناع وقوله { ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} أي واجعل من ذريتنا أي من أولادنا ومن للتبعيض وإنما خصا بعضهم لأنه تعالى أعلم إبراهيم (عليه السلام) أن في ذريته من لا ينال عهده الظالمين لما يرتكبه من الظلم وقال السدي أراد بذلك العرب والصحيح الأول أمة مسلمة لك أي جماعة موحدة منقادة لك يعني أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) بدلالة قوله وابعث فيهم رسولا منهم وروي عن الصادق أن المراد بالأمة بنو هاشم خاصة وقوله { وأرنا مناسكنا} أي عرفنا هذه المواضع التي تتعلق النسك بها لنفعله عندها ونقضي عباداتنا فيها على حد ما يقتضيه توفيقنا عليها قال قتادة فاراهما الله مناسكهما الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإفاضة من عرفات ومن جمع ورمي الجمار حتى أكمل بها الدين وقال عطاء ومجاهد معنى مناسكنا مذابحنا والأول أقوى وقوله { وتب علينا} فيه وجوه ( أحدها ) أنهما قالا هذه الكلمة على وجه التسبيح والتعبد والانقطاع إلى الله سبحانه ليقتدي بهما الناس فيها وهذا هو الصحيح ( وثانيها ) أنهما سألا التوبة على ظلمة ذريتهما ( وثالثها ) أن معناه ارجع إلينا بالمغفرة والرحمة وليس فيه دلالة على جواز الصغيرة عليهم أو ارتكاب القبيح منهم لأن الدلائل القاهرة قد دلت على أن الأنبياء معصومون منزهون عن الكبائر والصغائر وليس هنا موضع بسط الكلام في ذلك.
{ إنك أنت التواب} أي القابل للتوبة من عظائم الذنوب وقيل الكثير القبول للتوبة مرة بعد أخرى { الرحيم} بعباده المنعم عليهم بالنعم العظام وتكفير السيئات والآثام وفي هذه الآية دلالة على أنه يحسن الدعاء بما يعلم الداعي أنه يكون لا محالة لأنهما كانا عالمين بأنهما لا يقارفان الذنوب(3) والآثام ولا يفارقان الدين والإسلام .
والضمير في قوله { فيهم} يرجع إلى الأمة المسلمة التي سأل الله إبراهيم أن يجعلهم من ذريته والمعني به بقوله { ربنا وابعث فيهم رسولا منهم} هو نبينا (صلى الله عليه وآله وسلّم) لما روي عنه أنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى (عليه السلام) يعني قوله مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وهو قول الحسن وقتادة وجماعة من العلماء ويدل على ذلك أنه دعا بذلك لذريته الذين يكونون بمكة وما حولها على ما تضمنه الآية في قوله { ربنا وابعث فيهم} أي في هذه الذرية { رسولا منهم} ولم يبعث الله من هذه صورته إلا محمدا (صلى الله عليه وآله وسلّم) وقوله { يتلو عليهم آياتك} أي يقرأ عليهم آياتك التي نوحي بها إليه { ويعلمهم الكتاب} أي القرآن وهذا لا يعد من التكرار لأنه خص الأول بالتلاوة ليعلموا بذلك أنه معجز دال على صدقه ونبوته وخص الثاني بالتعليم ليعرفوا ما يتضمنه من التوحيد وأدلته وما يشتمل عليه من أحكام شريعته وقوله { والحكمة} قيل هي هاهنا السنة عن قتادة وقيل المعرفة بالدين والفقه في التأويل عن مالك بن أنس وقيل العلم بالأحكام التي لا يدرك علمها إلا من قبل الرسل عن ابن زيد وقيل أنه صفة للكتاب كأنه وصفه بأنه كتاب وأنه حكمة وأنه آيات وقيل الحكمة شيء يجعله الله في القلب ينوره الله به كما ينور البصر فيدرك المبصر وقيل هي مواعظ القرآن وحرامه وحلاله عن مقاتل وكل حسن وقوله { ويزكيهم} أي يجعلهم مطيعين مخلصين والزكاء هو الطاعة والإخلاص لله سبحانه عن ابن عباس وقيل معناه يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه عن ابن جريج وقيل معناه يستدعيهم إلى فعل ما يزكون به من الإيمان والصلاح عن الجبائي وقيل يشهد لهم بأنهم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس بما كسبت عن الأصم وقوله { إنك أنت العزيز الحكيم} أي القوي في كمال قدرتك المنيع في جلال عظمتك المحكم لبدائع صنعتك وإنما ذكر هاتين الصفتين لاتصالهما بالدعاء فكأنه قال فزعنا إليك في دعائنا لأنك القادر على إجابتنا العالم بما في ضمائرنا وبما هو أصلح لنا مما لا يبلغه كنه علمنا وقصار بصائرنا وفي هذه الآية دلالة على أن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) دعوا لنبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) بجميع شرائط النبوة لأن تحت التلاوة الأداء وتحت التعليم البيان وتحت الحكمة السنة ودعوا لأمته باللطف الذي لأجله تمسكوا بكتابه وشرعه فصاروا أزكياء وهذا لأن الدعاء صدر من إسماعيل (عليه السلام) فعلم بذلك أن النبي المدعو به من ولده لا من ولد إسحاق ولم يكن في ولد إسماعيل نبي غير نبينا (صلى الله عليه وآله وسلّم) سيد الأنبياء .
_____________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج1 ، ص387-394.
2- وفي بعض النسخ ( هابي ابن) وفي العبرانية : اعطني حجرا (هانلي ابن) فليحرر.
3- قارف الذنب : داناه.
تاريخ الكعبة :
اختلف المفسرون والمؤرخون في تاريخ الكعبة : هل كانت قبل إبراهيم ( عليه الاسلام ) ثم عرض لها الخراب ، فجددها هو وولده إسماعيل بأمر اللَّه تعالى ، أوان
تاريخ بنائها وانشائها يبتدئ بإبراهيم ؟ .
ذهب أكثر أهل التفسير والتاريخ من المسلمين إلى انها أسبق بكثير من إبراهيم ، وقال البعض : بل ولدت الكعبة على يد إبراهيم ( عليه الاسلام ) ، وتوقف آخرون ، ولم يحكموا بشيء ، وقالوا : اللَّه أعلم . ونحن مع هؤلاء . . ذلك ان العقل لا مجال له في هذا الباب سلبا ولا إيجابا ، والطريق إلى معرفته ينحصر بالآثار والحفريات ، أو بآية قرآنية ، أوسنة قطعية .
ولم أطلع على أقوال الباحثين في الآثار والحفريات ، والقرآن لم يحدد صراحة تاريخ البناء ، وكل ما جاء فيه ان إبراهيم وولده إسماعيل قد باشرا بناء البيت ، وتعاونا معا على إقامته ، وهذا أعم من عدم وجوده إطلاقا من قبل ، أو كان موجودا ، ولكن عرض له الخراب والدمار ، ثم جدده إبراهيم وولده إسماعيل .
والسنة القطعية منتفية ، والأخبار الواردة في هذا الباب كلها آحاد ، والخبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية فقط (2) ، أوفيها وفي موضوعاتها على قول ، أما في العقائد ، والمسائل التاريخية ، والموضوعات الخارجية البحتة فليس بحجة الا مع قرينة توجب ركون النفس واطمئنانها ، وعندها يكون الخبر بحكم السنة القطعية .
ومهما يكن ، فنحن غير مسؤولين أمام اللَّه سبحانه ، ولا مكلفين بمعرفة تاريخ بناء الكعبة ، وزمن انشائها وولادتها ، وانها : هل هي جزء من الجنة ، أو قطعة من الأرض ؟ . وان آدم والأنبياء من بعده قد حجوا إليها ، أولا ؟ .
وانها عند الطوفان : هل ارتفعت إلى السماء ، ثم نزلت بعده إلى الأرض ؟ .
وان الحجر الأسود : هل جاء به جبريل من السماء ، أو صحبه آدم معه من الجنة ، أو تمخض عنه جبل أبي قبيس ؟ . وانه : هل اسودّ من ملامسة المذنبين ؟ .
إلى غير ذلك مما لا سند له الا خبر واحد ، أو قصّاص مخرف .
نحن غير مسؤولين عن شيء من هذه الأشياء ، ولا مكلفين بمعرفتها وجوبا ولا استحبابا ، ولا عقلا ولا شرعا . . ولا فائدة في بحثها دينية ولا دنيوية ، وقد عاشت هذه الأبحاث وما إليها حينا من الدهر ، ثم ذهبت مع الريح . . ومن أراد إحياءها فإنه تماما كمن يحاول إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء .
ان الشيء الذي نسأل عنه ، ونطالب به - فيما يعود إلى الكعبة – هو قصدها للحج والعمرة من استطاع إلى ذلك سبيلا ، واحترامها وتقديسها ، والمحافظة عليها ، والذب عنها بالنفس والنفيس اقتداء بالرسول الأعظم وأهل بيته (عليه الاسلام) ، وأصحابه والتابعين والعلماء وجميع المسلمين . . فإنهم يؤمنون ايمانا لا تشوبه شائبة بأن تعظيم بيت اللَّه تعظيم للَّه ، والحرص عليه حرص على حرمات اللَّه ، والذب عنه ذب عن دين اللَّه . . قال أمير المؤمنين (عليه الاسلام) :
(فرض اللَّه عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الانعام ، ويألهون - أي يفزعون - إليه ولوه الحمام ، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته ، وإذعانهم لعزته . . جعله سبحانه للإسلام علما ، وللعائذين حرما) .
( رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا ) . هذا دعاء من إبراهيم وإسماعيل أن يثيبهما اللَّه على هذا العمل ، لأن معنى القبول عند اللَّه هو الثواب على العمل الذي يقبله ، كما ان عدم الثواب على العمل معناه رده ورفضه ، ولا تفكيك بموجب كرم اللَّه وجوده ، وليس من شك ان اللَّه قد قبل دعاءهما ، وأجزل لهما الثواب على هذه الطاعة ، لأنه هو الذي فتح باب الدعاء ، وما كان ليفتح على عبد باب الدعاء ، بخاصة المتقي ، ويغلق عنه باب الإجابة ، كما قال أمير المؤمنين ( عليه الاسلام ).
{رَبَّنا واجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ} . المسلم ، والمسلَّم ، والمستسلم بمعنى واحد ، وهو الذي يذعن وينقاد ، والمراد به هنا من أخلص للَّه في عقيدته وأعماله ، وليس من شك ان السعيد الحميد هو الذي يسلم للَّه جل وعز جميع أموره وشؤونه .
{ومِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ} وقد استجاب اللَّه دعاءهما ، وجعل في ذريتهما ملايين الملايين من المسلمين .
الشيعة وأجداد النبي :
اختص الشيعة من دون جميع الطوائف الاسلامية ، اختصوا بالقول : ان آباء محمد وأجداده ، وأمهاته وجداته كانوا جميعا موحدين ، ما أشرك أحدهم باللَّه شيئا ، وان محمدا منذ الخليقة كان ينتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة حتى ساعة ولادته ( صلى الله عليه واله ) .
قال شيخ الشيعة الشهير بالمفيد في شرح عقائد الصدوق طبعة 1371 ه ص 67 :
(ان آباء النبي ( صلى الله عليه واله ) من أبيه إلى آدم كانوا موحدين على الإيمان باللَّه ، وعليه إجماعنا . قال اللَّه تعالى مخاطبا نبيه محمدا : {وتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} – (الشعراء 219) .
وقال الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله ) : ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات ، حتى أخرجني اللَّه تعالى في عالمكم هذا . . فدل قول النبي على ان آباءه كلهم كانوا مؤمنين ، إذ لوكان بعضهم كافرا لما استحق الوصف بالطهارة ، لقوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} ، فحكم على الكفار بالنجاسة ، فلما قضى رسول اللَّه ( صلى الله عليه واله ) بطهارة آبائه كلهم ووصفهم بذلك دل على انهم كانوا مؤمنين) .
{وأَرِنا مَناسِكَنا} . أي علمنا مناسك الحج ، وغيرها من العبادات .
{ وتُبْ عَلَيْنا}. وليس من الضروري أن يلازم طلب المغفرة وجود الذنب ، بخاصة إذا كان الطلب من الأنبياء والأوصياء ، لأن هؤلاء الكرام يرون أنفسهم مقصرين في حق اللَّه مهما اجتهدوا في العبادة للَّه ، وأخلصوا لجلاله ، لأنهم أدرى الناس بعظمته ، وبأن عبادة الإنسان بالغة ما بلغت فلن تفي ببعض الحق لتلك العظمة التي لا بداية لها ، ولا نهاية .
{ رَبَّنا وابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ} . واستجاب اللَّه هذه الدعوة بخاتم النبيين وسيد المرسلين ، فلقد جاء في أحاديث السنة والشيعة ان النبي قال : (انا دعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى) . . وفي سورة الجمعة : {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الجمعة: 2]. . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : {بعث اللَّه محمدا ( صلى الله عليه واله ) وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ، ولا يدعي نبوة ولا وحيا).
__________________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص202-205.
2- أغرب ما قرأت في هذا الباب قول السيد الطباطبائي في تفسير الميزان ج 1 ص 196 : « ان عدم صحة أسانيد الأخبار لا يوجب طرحها ما لم تخالف العقل أو النقل الصحيح » . . ومن المعلومات البديهية ان عدم مخالفة العقل والنقل الثابت شرط لما ثبت صحته من الاخبار سندا ، لا لما لم يثبت منها ، فان عدم ثبوت صحة السند كاف لطرح الخبر ، من غير إضافة شرط آخر . . والا لزم العمل بكل خبر غير صحيح إلا إذا خالف العقل أو النقل الثابت . . وفساده ظاهر بالبديهة.
قوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل}، القواعد جمع قاعدة وهي ما قعد من البناء على الأرض، واستقر عليه الباقي، ورفع القواعد من المجاز بعد ما يوضع عليها منها، ونسبة الرفع المتعلق بالمجموع إلى القواعد وحدها.
وفي قوله تعالى: {من البيت} تلميح إلى هذه العناية المجازية.
قوله تعالى: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم}، دعاء لإبراهيم وإسماعيل، وليس على تقدير القول، أو ما يشبهه، والمعنى يقولان: ربنا تقبل منا إلخ، بل هو في الحقيقة حكاية المقول نفسه، فإن قوله: {يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل} حكاية الحال الماضية، فهما يمثلان بذلك تمثيلا كأنهما يشاهدان وهما مشتغلان بالرفع، والسامع يراهما على حالهما ذلك ثم يسمع دعاءهما بألفاظهما من غير وساطة المتكلم المشير إلى موقفهما وعملهما، وهذا كثير في القرآن، وهومن أجمل السياقات القرآنية - وكلها جميل - وفيه من تمثيل القصة وتقريبه إلى الحس ما لا يوجد ولا شيء من نوع بداعته في التقبل بمثل القول ونحوه.
وفي عدم ذكر متعلق التقبل – وهو بناء البيت - تواضع في مقام العبودية، واستحقار لما عملا به والمعنى ربنا تقبل منا هذا العمل اليسير إنك أنت السميع لدعوتنا، العليم بما نويناه في قلوبنا.
قوله تعالى: {ربنا واجعلنا مسلمين لك} ، {ومن ذريتنا أمة مسلمة لك}، من البديهي أن الإسلام على ما تداول بيننا من لفظه، ويتبادر إلى أذهاننا من معناه أول مراتب العبودية، وبه يمتاز المنتحل من غيره، وهو الأخذ بظاهر الاعتقادات والأعمال الدينية، أعم من الإيمان والنفاق، وإبراهيم (عليه السلام) – وهو النبي الرسول أحد الخمسة أولي العزم، صاحب الملة الحنيفية - أجل من أن يتصور في حقه أن لا يكون قد ناله إلى هذا الحين، وكذا ابنه إسمعيل رسول الله وذبيحه، أو يكونا قد نالاه ولكن لم يعلما بذلك، أو يكونا علما بذلك وأرادا البقاء على ذلك، وهما في ما هما فيه من القربى والزلفى، والمقام مقام الدعوة عند بناء البيت المحرم، وهما أعلم بمن يسألانه، وأنه من هو، وما شأنه، على أن هذا الإسلام من الأمور الاختيارية التي يتعلق بها الأمر والنهي كما قال تعالى: {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [البقرة: 131] ، ولا معنى لنسبة ما هو كذلك إلى الله سبحانه أو مسألة ما هو فعل اختياري للإنسان من حيث هو كذلك من غير عناية يصح معها ذلك.
فهذا الإسلام المسئول غير ما هو المتداول المتبادر عندنا منه، فإن الإسلام مراتب والدليل على أنه ذو مراتب قوله تعالى: { إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ} [البقرة: 131] الآية حيث يأمرهم إبراهيم بالإسلام وقد كان مسلما، فالمراد بهذا الإسلام المطلوب غير ما كان عنده من الإسلام الموجود، ولهذا نظائر في القرآن.
فهذا الإسلام هو الذي سنفسره من معناه، وهو تمام العبودية وتسليم العبد كل ما له إلى ربه، وهو إن كان معنى اختياريا للإنسان من طريق مقدماته إلا أنه إذا أضيف إلى الإنسان العادي وحاله القلبي المتعارف كان غير اختياري بمعنى كونه غير ممكن النيل له - وحاله حاله - كسائر مقامات الولاية ومراحله العالية، وكسائر معارج الكمال البعيدة عن حال الإنسان المتعارف المتوسط الحال بواسطة مقدماته الشاقة، ولهذا يمكن أن يعد أمرا إلهيا خارجا عن اختيار الإنسان، ويسأل من الله سبحانه أن يفيض به، وأن يجعل الإنسان متصفا به.
على أن هنا نظرا أدق من ذلك، وهو أن الذي ينسب إلى الإنسان ويعد اختياريا له، هو الأفعال، وأما الصفات والملكات الحاصلة من تكرر صدورها فليست اختيارية بحسب الحقيقة، فمن الجائز أو الواجب أن ينسب إليه تعالى، وخاصة إذا كانت من الحسنات والخيرات التي نسبتها إليه تعالى، أولى من نسبتها إلى الإنسان، وعلى ذلك جرى ديدن القرآن، كما في قوله تعالى: { رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [إبراهيم: 40] ، وقوله تعالى: {وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [الشعراء: 83] ، وقوله تعالى: { رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ} [النمل: 19] ، وقوله تعالى: {ربنا واجعلنا مسلمين لك} الآية، فقد ظهر أن المراد بالإسلام غير المعنى الذي يشير إليه قوله تعالى: { قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14] ، بل معنى أرقى وأعلى منه سيجيء بيانه.
قوله تعالى: {وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم}، يدل على ما مر من معنى الإسلام أيضا، فإن المناسك جمع منسك بمعنى العبادة، كما في قوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكا}(الحج – 34)، أو بمعنى المتعبد، أعني الفعل المأتي به عبادة وإضافة المصدر يفيد التحقق، فالمراد بمناسكنا هي الأفعال العبادية الصادرة منهما والأعمال التي يعملانها دون الأفعال، والأعمال التي يراد صدورها منهما، فليس قوله: {أرنا} بمعنى علمنا أو وفقنا، بل التسديد بآرائه حقيقة الفعل الصادر منهما، كما أشرنا إليه في قوله تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ } [الأنبياء: 73] ، وسنبينه في محله: أن هذا الوحي تسديد في الفعل، لا تعليم للتكليف المطلوب، وكأنه إليه الإشارة بقوله تعالى: { وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ} [ص: 45، 46].
فقد تبين أن المراد بالإسلام والبصيرة في العبادة، غير المعنى الشائع المتعارف، وكذلك المراد بقوله تعالى: وتب علينا، لأن إبراهيم وإسماعيل كانا نبيين معصومين بعصمة الله تعالى، لا يصدر عنهما ذنب حتى يصح توبتهما منه، كتوبتنا من المعاصي الصادرة عنا.
فإن قلت: كل ما ذكر من معنى الإسلام وإراءة المناسك والتوبة مما يليق بشأن إبراهيم وإسمعيل (عليهما السلام)، لا يلزم أن يكون هو مراده في حق ذريته فإنه لم يشرك ذريته معه ومع ابنه إسماعيل إلا في دعوة الإسلام وقد سأل لهم الإسلام بلفظ آخر في جملة أخرى، فقال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ولم يقل: واجعلنا ومن ذريتنا مسلمين، أو ما يؤدي معناه فما المانع أن يكون مراده من الإسلام ما يعم جميع مراتبه حتى ظاهر الإسلام، فإن الظاهر من الإسلام أيضا له آثار جميلة، وغايات نفيسة في المجتمع الإنساني، يصح أن يكون بذلك بغية لإبراهيم (عليه السلام) يطلبها من ربه كما كان كذلك عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث اكتفى (صلى الله عليه وآله وسلم) من الإسلام بظاهر الشهادتين الذي به يحقن الدماء، ويجوز التزويج، ويملك الميراث، وعلى هذا يكون المراد بالإسلام في قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ما يليق بشأن إبراهيم وإسماعيل، وفي قوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ما هو اللائق بشأن الأمة التي فيها المنافق، وضعيف الإيمان وقويه والجميع مسلمون.
قلت مقام: التشريع ومقام السؤال من الله مقامان مختلفان، لهما حكمان متغايران لا ينبغي أن يقاس أحدهما على الآخر، فما اكتفى به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أمته بظاهر الشهادتين من الإسلام، إنما هو لحكمة توسعة الشوكة والحفظ لظاهر النظام الصالح، ليكون ذلك كالقشر يحفظ به اللب الذي هو حقيقة الإسلام، ويصان به عن مصادمة الآفات الطارئة.
وأما مقام الدعاء والسؤال من الله سبحانه فالسلطة فيها للحقائق، والغرض متعلق هناك بحق الأمر، وصريح القرب والزلفى ولا هوى للأنبياء في الظاهر من جهة ما هو ظاهر ولا هوى لإبراهيم (عليه السلام) في ذريته ولوكان له هوى لبدأ فيه لأبيه قبل ذريته ولم يتبرأ منه لما تبين أنه عدو لله، ولم يقل في ما حكى الله من دعائه {وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } [الشعراء: 87 - 89] ، ولم يقل {واجعل لي لسان صدق في الآخرين}( الشعراء – 84)، بل اكتفى بلسان ذكر في الآخرين إلى غير ذلك.
فليس الإسلام الذي سأله لذريته إلا حقيقة الإسلام، وفي قوله تعالى: {أمة مسلمة لك}، إشارة إلى ذلك فلوكان المراد مجرد صدق اسم الإسلام على الذرية لقيل: أمة مسلمة، وحذف قوله: لك، هذا.
قوله تعالى: {ربنا وابعث فيهم رسولا منهم} إلخ دعوة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: أنا دعوة إبراهيم.
_____________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج1 ، ص236-239.
إبراهيم يبني الكعبة
نفهم بوضوح من خلال آيات الذكر الحكيم أن بيت الكعبة كان موجوداً قبل إبراهيم، وكان قائماً منذ زمن آدم. تتحدث الآية 37 من سورة إبراهيم عن لسان إبراهيم تقول: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَاد غَيْرِ ذِي زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمحَرَّمِ}.
وهذه الآية تدل على أن بيت الكعبة كان له نوع من الوجود حين جاء إبراهيم مع زوجه وابنه الرضيع إلى مكة.
وتقول الآية 96 من سورة آل عمران: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً}. ومن المؤكد أن عبادة الله وإقامة أماكن العبادة لم تبدأ في زمن إبراهيم، بل كانتا منذ أن خلق الإنسان على ظهر هذه الأرض.
عبارة الآية الاُولى من الآيات محل البحث يؤكد هذا المعنى، إذ تقول: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.
فإبراهيم وإسماعيل قد رفعا قواعد البيت التي كانت موجودة.
وفي خطبة للإِمام أمير المؤمنين علي(عليه السلام) في نهج البلاغة، وهي المسماة بالقاصعة، يقول:
«أَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ إِخْتَبَرَ الاْوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الاْخَرِينَ مِنْ هذَا الْعَالَم بِأَحْجَار ... فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ ... ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ(عليه السلام) وَوَلَدَهُ أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ(2)...»(3).
القرائن القرآنية والروائية تؤيد أن الكعبة بنيت أوّلا بيد آدم، ثم انهدمت في طوفان نوح، ثم أُعيد بناؤها على يد إبراهيم وإسماعيل(4).
في الآيتين التاليتين يتضرع إبراهيم وإسماعيل إلى ربّ العالمين بخمسة طلبات هامّة. وهذه الطلبات المقدّسة حين الإِشتغال بإعادة بناء الكعبة جامعة ودقيقة بحيث تشمل كل احتياجات الإِنسان المادية والمعنوية، وتفصح عن عظمة هذين النبيين الكبيرين.
قالا أوّلا: {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ}.
ثم أضافا: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ}.
وطلبا تفهم طريق العبادة: {وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا}، اليعبد الله حقّ عبادته.
ثم طلبا التوبة: {وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}.
الآية الأخيرة تضمنت الطلب الخامس، وهو هداية الذرية {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم}.
________________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج1، ص319-320.
2 ـ أي أن يطوفوا حولَه.
3 ـ نهج البلاغة، صبحي صالح، ص 292 ـ (الخطبة القاصعة).
4 ـ صاحب المنار، ينكر هذا الموضوع بالمرة، ويرى أن إبراهيم وإسماعيل أول من بنى الكعبة، وهذا ما لا تؤيّده الروايات ولا عبارات القرآن الكريم.



|
|
|
|
هل يمكن للدماغ البشري التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم؟
|
|
|
|
|
|
|
علماء: طول الأيام على الأرض يزداد بسبب النواة الداخلية
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يشرك طلبة الدورات الصيفية بمحفلٍ قرآني في محافظة بابل
|
|
|