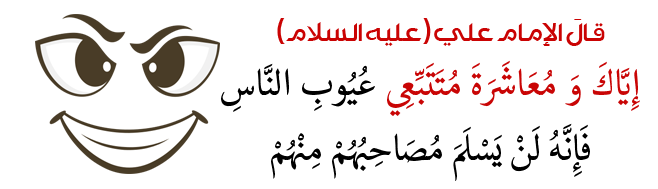
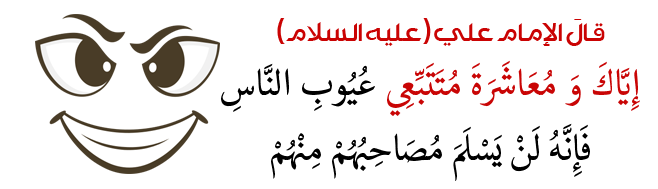

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-04-2015
التاريخ: 2023-12-13
التاريخ: 7-11-2014
التاريخ: 2024-04-28
|
هناك للعلماء ـ سلفاً وخلفاً ـ بحوث ودراسات وافية حول مسألة إعجاز القرآن ، مُنذ مطالع القرون الأُولى فإلى هذا الدور ، ولهم كلمات ومقالات ضافية عن وجه هذا الإعجاز المُتحدّي به من أَوّل يومه ، ولا يزال مُستمرّاً عِبر الخلود ولهذه الأبحاث والدراسات قيمتها ووزنها العلمي النظري في كلّ عصر وفي كلّ دور ، وأنّ الفضل يرجع إلى الأسبق ممّن فتح هذا الباب وأَسّس أساس هذا البنيان ، فكان مَن يأتي مِن بعد ، إنّما يجري على منواله ويضرب على ذات وتره ، مهما تغيّر اللون أو تنوّع الأُسلوب . ونحن نقدّم من آراء مَن سلف الأهمّ منها فالأهمّ ، ثُمّ نعقبها بطرف من آراء المتأخّرين ممّن قاربنا عصره ، وعلى أيّ تقدير ، فإنّ مساعيهم جميعاً مشكورة ، ومواقفهم في استنباط حقائق من الكتاب العزيز مقدّرة ، فلله درّهم وعليه أجرهم ، وإليك :
1 ـ رأي أبي سليمان البُستي :
يرى أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم الخطّابي البُستي (1) ( توفّي سنة 388هـ ) في رسالته الوجيزة التي وضعها في بيان إعجاز القرآن ـ ولعلّه أَسبق مِن توسّع في هذا البحث أفاد وأجاد ـ : أنّ الإعجاز قائم بنظمه ، ذلك المتّسق البديع ورصفه ، ذلك المؤتلف العجيب ، قد وُضعت كلّ كلمة في موضعها اللائق بدقّة فائقة ، ممّا يستدعي إحاطة شاملة تعوزها البشرية على الإطلاق ، الأمر الذي أبهر وأعجب .
قال : قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديماً وحديثاً ، وذهبوا فيه كلّ مذهب من القول وما وجدناهم بعدُ ، صَدَروا عن ريٍّ ؛ وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن ، ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيّته ، فأمّا أن يكون قد نقبت في النفوس نقبة (2) بكونه معجزاً للخلق ممتنعاً عليهم الإتيان بمِثله على حال ، فلا موضع لها ، والأمر في ذلك أَبين مِن أن نحتاج إلى أن نُدِلّ عليه بأكثر من الوجود القائم المستمرّ على وجه الدهر ، من لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن الذي نحن فيه ، وذلك أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قد تحدّى العرب قاطبةً بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه ، وقد بقيَ ( صلّى الله عليه وآله ) يُطالبهم به مدّة عشرين سنة ، مُظهِراً لهم النكير ، زارياً على أديانهم ، مُسفِّهاً آراءهم وأحلامهم ، حتى نابذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس ، وأُريقت المُهج ، وقُطعت الأرحام ، وذهبت الأموال .
ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلّفوا هذه الأُمور الخطيرة ، ولم يركبوا تلك الفواقر المبيرة ، ولم يكونوا تركوا السَهل الدَمِث من القول ، إلى الحَزِن الوعر من الفعل .
هذا مالا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لبّ ، وقد كان قومه قريش خاصّة موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول والألباب ، وقد كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلّقون ، وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل واللَّدَد ، فقال سبحانه : {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } [الزخرف : 58] ، وقال سبحانه : {وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا} [مريم : 97] ، فكيف كان جوز ـ على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة ـ أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيه وأن يضربوا عنه صَفحاً ، ولا يجوزوا الفلح والظفر فيه ، لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه .
قال : وهذا ـ من وجوه ما قيل فيه ـ أبينُها دلالةً وأَيسرها مؤونةً ، وهو مُقنع لمَن تُنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه .
2 ـ اختيار ابن عطيّة :
ولأبي محمّد عبد الحقّ بن غالب المحاربي الغرناطي ـ الفقيه المفسّر ( توفّي سنة 542هـ ) ـ اختيار يشبه اختيار أبي سليمان البُستي ، ولعلّه اختزال منه ، ذَكره في مقدّمة تفسيره ( المحرّر ) ونقله الإمام بدر الدين الزركشي ، مع تصرّف واختصار .
قال ابن عطيّة : إنّ الذي عليه الجمهور والحذّاق ـ وهو الصحيح في نفسه ـ أنّ التحدّي إنّما وقع بنظمه ، وصحّة معانيه ، وتوالي فصاحة ألفاظه ، ووجه إعجازه أنّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً ، وأحاط بالكلام كلّه علماً ، فإذا ترتّبت اللفظة من القرآن علم ـ بإحاطته ـ أيّ لفظة تصلح أن تلي الأُولى ، ويتبيّن المعنى دون المعنى ، ثُمّ كذلك من أَوّل القرآن إلى آخره .
والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول ، ومعلومٌ ضرورةً أنّ بشراً لم يكن قطّ مُحيطاً ، فبهذا جاء نظم القرآن ، في الغاية القصوى من الفصاحة ، وبهذا النظر يَبطل قول مَن قال : إنّ العرب كان في قدرتها الإتيان بمِثله ، فلمّا جاءهم محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) صُرفوا عن ذلك وعَجزوا عنه ! والصحيح أنّ الإتيان بمِثل القرآن لم يكن قطّ في قدرة أحد مِن المخلوقين ، ويظهر لك قصور البشر ، في أنّ الفصيح منهم يضع خطبةً أو قصيدةً يستفرغ فيها جهده ، ثُمّ لا يزال يُنقِّها حولاً كاملاً ، ثُمّ تُعطى لأحد نظيره فيأخذها بقريحة خاصّة فيُبدّل فيها ويُنقّح ، ثُمّ لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل .
وكتاب الله سبحانه لو نُزعت منه لفظة ، ثمّ أُدير لسان العرب على لفظة في أن يوجد أحسن منها لم توجد ، ونحن تتبيّن لنا البراعة في أكثره ، ويخفى علينا وجهها في مواضع ؛ لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذٍ في سلامة الذوق ، وجودة القريحة ، وميز الكلام .
قال : وقامت الحجّة على العالم بالعرب ؛ إذ كانوا أرباب الفصاحة وفطنة المعارضة كما قامت الحجّة في معجزة عيسى بالأطبّاء ، وفي معجزة موسى بالسَحَرة ، فإنّ الله تعالى إنّما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أَبرع ما يكون في زمن النبيّ الذي أراد إظهاره ، فكان السحر في مدّة موسى قد انتهى إلى غايته ، وكذلك الطبّ في زمن عيسى ، والفصاحة في مدّة محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) (3) .
3 ـ رأي عبد القاهر الجرجاني :
يرى الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني ( تُوفّي سنة 472هـ ) ـ وهو الواضع الأَوّل لأُسس عِلمَي المعاني والبيان ـ : أنّ إعجاز القرآن الذي تحدّى به العرب قائم بجانب فصاحته البالغة وبلاغته الخارقة ، وبأُسلوب بيانه ذلك البديع ، ممّا هو شأن نظم الكلام وتأليفه في ذلك التنافس والتلاؤم العجيب ، الأمر الذي لا يمسّ شيئاً من معاني القرآن وحِكَمِه وتشريعاته ، وهي كانت موجودةً من ذي قبل في كتب السالفين ، وقد أطلق لهم المعاني من أيّ نمط كانت .
وقد وضع كتابَيه ( أسرار البلاغة ) و( دلائل الإعجاز ) تمهيداً لبيان وجوه إعجاز القرآن لمن مارس أسرار هذا العلم . وثَلّثهما برسالته ( الشافية ) التي خصّصها بالكلام حول إعجاز القرآن والإجابة على أسئلة دارت حول الموضوع .
قال ـ في مقدّمة كتابه ( دلائل الإعجاز ) بعد أن أشاد بشأن النَظم في الكلام وتأليفه وتنسيقه ـ : وإذا كان ذلك كذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا : إذا كانت هذه الأُمور الوجوه من التعلّق التي هي محصول النظم موجودة على حقائقها وعلى الصحّة وكما ينبغي في منثور كلام العرب ومنظومه ، ورأيناهم قد استعملوها وتصرّفوا فيها وكملوا بمعرفتها ، وكانت حقائق لا تتبدّل ولا يختلف بها الحال ، إذ لا يكون للاسم بكونه خبراً لمبتدأ أو صفة لموصوف أو حالاً لذي حال أو فاعلاً أو مفعولاً لفعل في كلام حقيقة هي خلاف حقيقته في كلام آخر .
فما هذا الإعجاز الذي تجدّد بالقرآن من عظيم مزيّة ، وباهر الفضل ، والعجيب من الوصف ، حتّى أعجز الخلق قاطبةً ، وحتّى قهر من البلغاء والفصحاء القُوَى والقُدَر ، وقيّد الخواطر والفكر ، حتّى خرست الشقاشق (4) وعدم نطق الناطق ، وحتّى لم يجرِ لسان ، ولم يبنِ بيان ، ولم يساعد إمكان ، ولم ينقدح لأحد منهم زند ، ولم يمضِ له حدّ ، وحتّى أَسال الوادي عليهم عجزاً ، وأخذ منافذ القول عليهم أخذاً ؟!
أَيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله ، ونردّه عن ضلاله ، وأن نطبّ لدائه ، ونزيل الفساد عن رائه ؟ فإن كان ذلك يلزمنا فينبغي لكلّ ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه ( يريد نفس كتاب دلائل الإعجاز ) ويستقصي التأمّل لما أودعناه (5) .
وكرّ في الكتاب قائلاً : وإنّه كما يَفضل النظمُ النظمَ ، والتأليفُ التأليفَ ، والنسجُ النسجَ ، والصياغةُ الصياغةَ ، ثُمّ يعظُم الفضل ، وتكثر المزيّة ، حتّى يفوق الشيء نظيره ، والمجانس له درجات كثيرة ، وحتّى تتفاوت القيم التفاوت الشديد ، كذلك يفضل بعضُ الكلام بعضاً ، ويتقدّم منه الشيء الشيء ، ثُمّ يزداد من فضله ذلك ، ويترقّى منزلةً فوق منزلة ، ويعلو مرقباً بعد مَرْقب ، ويستأنف له غاية بعد غاية ، حتّى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع ، وتنحسر الظنون ، وتسقط القُوى ، وتستوي الأقدام في العجز (6) .
ثم قال : واعلم أنّه لا سبيل إلى أن تعرف صحّة هذه الجملة حتّى يبلغ القول غايته ، وينتهي إلى آخر ما أردت جمعه لك ، وتصويره في نفسك ، وتقريره عندك ، إلاّ أنّ هاهنا نكتة ، إن أنت تأمّلتها تأمّل المُتثبّت ، ونظرت فيها نظر المُتأنّي ، رجوت أن يحسن ظنّك ، وأن تنشط للإصغاء إلى ما أورده عليك ، وهي : إنّا إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا : لولا أنّهم حين سمعوا القرآن ، وحين تحدّوا إلى معارضته ، سمعوا كلاماً لم يسمعوا قطّ مِثله ، وأنّهم قد رازوا أنفسهم فأحسّوا بالعجز على أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه ، أو يقع قريباً منه ، لكان محالاً أن يدّعوا معارضته وقد تحدّوا إليه ، وقرعوا فيه ، وطولبوا به ، وأن يتعرّضوا لشبا الأسنّة ويقتحموا موارد الموت .
فقيل لنا : قد سمعنا ما قلتم ، فخبّرونا عنهم ، عمّاذا عجزوا ، أَعَن معانٍ من دقة معانيه وحسنها وصحّتها في العقول ؟ أم عن ألفاظ مِثل ألفاظه ؟ فإن قلتم : عن الألفاظ ، فماذا أَعجزهم من اللفظ ، أم بهرهم منه ؟
فقلنا : أَعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نَظمه ، وخصائص صادفوها في سياق لفظه ، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها ، ومجاري ألفاظها ومواقعها ، وفي مضرب كلّ مثل ، ومساق كلّ خبر ، وصورة كلّ عظة وتنبيه وإعلام وتذكير وترغيب وترهيب ، ومع كلّ حجّة وبرهان ، وصفة وتبيان ، وبهرهم أنّهم تأمّلوه سورة سورة ، وعشراً عشراً ، وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شأنها ، أو يَرى أنّ غيرها أصلح هناك أو أشبه ، أو أحرى وأخلق ، بل وجدوا اتّساقاً بَهر العقول ، وأَعجز الجمهور ، ونظاماً والتئاماً ، وإتقاناً وإحكاماً ، لم يدع في نفس بليغ منهم لو حكّ بيافوخه السماء موضع طمع حتّى خرست الألسن عن أن تدّعي وتقول ، وخلدت القُروم فلم تملك أن تصول (7) .
ويُعقّب ذلك بأنّ هذه كانت دلائل إعجاز القرآن ، ومزايا ظهرت في نَظمه وسياقه ، بَهرت العرب الأوائل ، فهل ينبغي للفتى الذكي العاقل أن يكون مُقلّداً في ذلك ؟ أم يكون باحثاً ومتتبّعاً كي يعلم ذلك بيقين ؟ ومِن ثَمّ وَضع كتابه الحاضر ( دلائل الإعجاز ) ليَدلّ الناشدينَ على ضالّتهم ، ويضع يدهم على مواقع الإعجاز من القرآن ، ويدعم مُدّعاه في ذلك بالحجّة والبرهان ، والرائد لا يُكذِّب أهله ، قال : وبذلك قد قطعتُ عذرَ المتهاون ، ودللت على ما أضاع من حظّه ، وهدايته لرشده (8) .
وقال ـ في رسالته ( الشافية ) : كيف يجوز أن يظهر في صميم العرب وفي مِثل قريش ذوي الأَنفس الأبيّة والهِمم العليّة والأَنفة والحميّة مَن يدّعي النبوّة ويقول : وحجّتي أنّ الله قد أنزل عليّ كتاباً تعرفون ألفاظه وتفهمون معانيه ، إلاّ أنّكم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله ولا بعشر سورٍ منه ولا بسورة واحدة ، ولو جَهدتم جهدَكم واجتمع معكم الجنّ والإنس ، ثُمّ لا تدعوهم نفوسهم إلى أن يعارضوه ويبيّنوا سَرَفه في دعواه ، لو كان ممكناً لهم ، وقد بلغ بهم الغيظ من مقالته حدّاً تركوا معه أحلامهم وخرجوا عن طاعة عقولهم ، حتّى واجهوه بكلّ قبيح وَلَقوه بكلّ أذىً ومكروه ووقفوا له بكلّ طريق .
وهل سُمع قطّ بذي عقل استطاع أن يخرس خصمه بكلمة يجيبه بها ، فيترك ذلك إلى أُمور ينسب معها إلى ضيق الذَرع ، وأنّه مغلوب قد أَعوزته الحيلة وعزّ عليه المَخلص ؟ وهل مِثل هذا إلاّ مِثل رجل عَرض له خصم فادّعى عليه دعوى خطيرة وأقام على دعواه بيّنةً ، وكان عند المدّعى عليه ما يُبطل تلك البيّنة أو يُعارضها ، فيترك إظهار ذلك ويضرب عنه الصفح جملةً ، ليصير الحال بينهما إلى جِدال عنيف وإخطار بالمُهج والنفوس ؟ قال : هذه شهادة الأحوال ، وأمّا شهادة الأقوال فكثيرة (9) .
ثمّ قال : في وجه التحدّي ـ : لم يكن التحدّي إلى أن يُعبّروا عن معاني القرآن أنفسها وبأعيانها بلفظ يُشبه لفظه ونَظم يوازي نظمه ، هذا تقدير باطل ، فإنّ التحدّي كان إلى أن يجيئوا ، في أيّ معنى شاءوا من المعاني ، بنَظم يبلغ نظم القرآن ، في الشرف أو يقرُب منه ، يدلّ على ذلك قوله تعالى : {قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} [هود : 13] أي مِثله في النظم ، وليكن المعنى مُفترى لِما قلتم ، فلا إلى المعنى دعيتم ، ولكن إلى النظم ... (10) .
قال : ويجزم القول بأنّهم تحدّوا إلى أن يجيئوا في أيّ معنى أرادوا مطلقاً غير مقيّد ، وموسّعاً عليهم غير مضيّق ، بما يشبه نظم القرآن أن يقرب من ذلك (11) .
4 ـ رأي السكّاكي :
يرى أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن علي السكّاكي ـ صاحب ( مفتاح العلوم ) ( توفّي سنة 567 هـ ) ـ أنّ الإعجاز في القرآن أمرٌ يُمكن دركه ولا يمكن وصفه ، والمَدرك هو الذوق ، الحاصل من ممارسة عِلمَي الفصاحة والبلاغة وطول خدمتهما لا غير ، فقد جعل للبلاغة طرفينِ ، أعلى وأسفل وبينهما مراتب لا تُحصى ، والدرجة السُفلى هي التي إذا هبط الكلام عنها شيئاً التَحق بأصوات الحيوانات ، ثُمّ تتزايد درجةً درجةً متصاعدة ، حتّى تبلغ قمّتها وهو حدّ الإعجاز ، وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه ، فقد جعل من الدرجة القصوى وما يقرب منها كليهما مِن حدّ الإعجاز .
ثُمّ قال بشأن الإعجاز : واعلم أنّ شأن الإعجاز عجيب ، يُدرك ولا يُمكن وصفه ، كاستقامة الوزن تُدرك ولا يُمكن وصفها ، وكالمَلاحة ، ومَدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلاّ ، وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذينِ العِلمَينِ ( المعاني والبيان ) .
ثمّ أخذ في تحديد البلاغة وإماطة اللثام عن وجوهها المُحتجبة ، وكذا الفصاحة بقسميها اللفظيّ والمعنويّ ، وضرب لذلك مثلاً بآية {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ} [هود : 44] وبيان جهاتها الأربع من جهتي المعاني والبيان ، وهما مَرجعا البلاغة ، ومِن جهتي الفصاحة المعنوية واللفظية ، وأسهب في الكلام عن ذلك ، وقال أخيراً : ولله دَرّ التنزيل ، لا يتأمّل العالم آية من آياته إلاّ أدرك لطائف لا تسع الحصر (12) .
وغرضه من ذلك : أنّ لحدّ الإعجاز ذروةً لا يبلغها الوصف ، ولكن يُمكن فهمها ودرك سَنامها ؛ بسبب الإحاطة بأسرار هذين العِلمَينِ ، فهي حقيقة تُدرك ولا توصف .
5 ـ رأي الراغب الأصفهاني :
لأبي القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني ( توفّي سنة 502 هـ ) ـ صاحب كتاب ( المفردات ) ـ رأي في إعجاز القرآن يخصّه ، إنّه يرى من الإعجاز قائماً بسبكه الخاصّ الذي لم يألفه العرب لحدّ ذاك ، فلا هو نثر كنثرهم المعهود ؛ لأنّ فيه الوزن والقافية وأجراس النغم ، ولا هو شعر ؛ لأنّه لم يجرِ مجرى سائر أشعار العرب ولا على أوزانها المعروفة وإن كانت له خاصّية الشعر من التأثير في النفس بلحنه الشعريّ النغميّ الغريب .
قال ـ بعد كلام له في وصف إعجاز القرآن قدّمناه آنفاً (13) ـ :
وهذه الجملة المذكورة ، وإن كانت دالّةً على كون القرآن مُعجزاً ، فليس بمقنع إلاّ بتبيين فصلَينِ :
أحدهما : أن يُبيّن ما الذي هو مُعجز : اللفظ أم المعنى أم النظم ؟ أم ثلاثتها ؟ فإنّ كلّ كلام منظوم مشتمل على هذه الثلاثة .
والثاني : أنّ المُعجز هو ما كان نوعه غير داخل تحت الإمكان ، كإحياء الموتى وإبداع الأجسام .
فأمّا ما كان نوعه مقدوراً ، فمحلّه محلّ الأفضل ، وما كان من باب الأفضل في النوع فإنّه لا يحسم نسبة ما دونه إليه ، وإن تباعدت النسبية حتّى صارت جزءً مِن ألف ، فإن النجّار الحاذق وإن لم يُبلغ شَأوُه لا يكون مُعجزاً إذا استطاع غيره جنسَ فِعْلِه ، فنقول وبالله التوفيق :
إنّ الإعجاز في القرآن على وجهين : أحدهما إعجاز متعلّق بفصاحته ، والثاني بصرف الناس عن معارضته .
فأمّا الإعجاز المتعلّق بالفصاحة : فليس يتعلّق ذلك بعنصريه الذي هو اللفظ والمعنى ؛ وذاك أنّ ألفاظه ألفاظهم ، ولذلك قال تعالى : {قُرْآنًا عَرَبِيًّا } [يوسف : 2] وقال : {الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ } [البقرة : 1، 2] تنبيهاً أن هذا الكتاب مُركّب من هذه الحروف التي هي مادّة الكلام .
ولا يتعلّق أيضاً بمعانيه ، فإن كثيراً منها موجود في ( الكتب المتقدّمة ) ولذلك قال تعالى : { وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} [الشعراء : 196] وقال : {أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى} [طه : 133] ، وما هو مُعجز فيه من جهة المعنى كالإخبار بالغيب فإعجازه ليس يرجع إلى القرآن بما هو قرآن ، بل هو لكونه خبراً بالغيب ، وذلك سواء كونه بهذا النظم أو بغيره ، وسواء كان مورداً بالفارسيّة أو بالعربيّة أو بلغة أُخرى ، أو بإشارة أو بعبارة .
فإذا بالنَظم المخصوص صار القرآن قرآناً ، كما أنّه بالنَظم المخصوص صار الشعر شعراً ، والخطبة خطبةً .
فالنظم صورة القرآن ، واللفظ والمعنى عنصراه ، وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره ، كالخاتم والقُرط والخَلخال اختلفت أحكامها وأسماؤها باختلاف صورها لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضّة ، فإذا ثَبت هذا ثبت أنّ الإعجاز المختصّ بالقرآن متعلّق بالنظم المخصوص .
وبيان كونه مُعجزاً هو أن نُبيّن نظم الكلام ، ثُمّ نُبيّن أنّ هذا النظم مخالف لنظم سائره ، فنقول : لتأليف الكلام خمس مراتب :
الأُولى : النظم : وهو ضمّ حروف التهجّي بعضها إلى بعض ، حتّى تتركّب منها الكلمات الثلاث : الاسم والفعل والحرف .
والثانية : أن يُؤلِّف بعض ذلك مع بعض حتّى تتركب منها الجمل المفيدة وهي النوع الذي يتداوله الناس جميعاً في مخاطباتهم ، وقضاء حوائجهم ، ويُقال له : المنثور من الكلام .
والثالثة : أن يضمّ بعض ذلك إلى بعض ضمّاً له مبادٍ ومقاطع ومداخل ومخارج ، ويُقال له : المنظوم .
والرابعة : أن يُجعل له في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ، ويقال له : المُسجّع .
والخامسة : أن يُجعل له مع ذلك وزن مخصوص ، ويُقال له : الشعر ، وقد انتهى .
وبالحقّ صار كذلك ، فإنّ الكلام إمّا منثور فقط ، أو مع النثر نظم ، أو مع النظم سجع ، أو مع السجع وزن .
والمنظوم : إمّا محاورة ويُقال له : الخطابة ، أو مكاتبة ويقال لها : الرسالة ، وأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الجملة ، ولكلّ من ذلك نظم مخصوص .
والقرآن حاوٍ لمحاسن جميعه بنَظم ليس هو نظم شيء منها ، بدلالة أنّه لا يصح أن يُقال : ( القرآن رسالة ، أو خطابة ، أو شعر ، كما يَصحّ أن يُقال : هو كلام ، ومَن قرع سمعه فصل بينه وبين سائر النَظم ، ولهذا قال تعالى : {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت : 41، 42] تنبيهاً أنّ تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر ، فيمكن أن يزاد فيه كحال الكتب الأخر .
فإن قيل : ولِمَ لمْ يُبلغ بنظم القرآن الوزن الذي هو الشعر ، وقد عُلم أنّ للموزون من الكلام مرتبةً أعلى مِن مرتبة المنظوم غير الموزون ؛ إذ كلّ موزون منظوم وليس كلّ منظوم موزوناً ؟
قيل : إنما جُنّب القرآن نظم الشعر ووزنه لخاصّية في الشعر منافية للحِكمة الإلهية ، فإنّ القرآن هو مقرّ الصدق ، ومعدن الحقّ ، وقصوى الشاعر : تصوير الباطل في صورة الحقّ ، وتجاوز الحدّ في المدح والذمّ دون استعمال الحقّ في تحرّي الصدق ، حتّى أنّ الشاعر لا يقول الصدق ولا يتحرّى الحقّ إلاّ بالعَرض ، ولهذا يُقال : مَن كان قوّته الخياليّة فيه أكثر كان على قَرض الشعر أقدر ، ومَن كانت قوّته العاقلة فيه أكثر كان في قرضه أقصر .
ولأجل كون الشعر مقرّ الكذب ، نزّه الله نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) عنه ؛ لِما كان مُرشّحاً لصدق المَقال ، وواسطة بين الله وبين العباد ، فقال تعالى : {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس : 69] فنفى ابتغاءه له ، وقال : {وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ} [الحاقة : 41] أي : ليس بقول كاذب ، ولم يعنِ أن ذلك ليس بشعر ، فإنّ وزن الشعر أَظهر مِن أن يشتبه عليهم حتّى يحتاج إلى أن ينفي عنه . ولأجل شهرة الشعر بالكذب سُميّ أصحاب البراهين الأقيسة المؤدّية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعريّة ، وما وقع في القرآن من ألفاظ مُتّزنة فذلك بحسب ما يقع في الكلام على سبيل العَرض بالاتّفاق ، وقد تكلّم الناس فيه .
وأمّا الإعجاز المتعلّق بصرف الناس عن معارضته فظاهر أيضاً إذا اعتُبر ؛ وذلك أنّه ما مِن صناعة ولا فِعلة من الأفعال محمودةً كانت أو مذمومةً إلاّ وبينها وبين قوم مناسبات خفية واتّفاقات إلهية ، بدلالة أنّ الواحد يُؤثر حِرفة من الحِرف فينشرح صدره بملابستها وتطيعه قُواه في مزاولتها ، فيقبلها باتّساع قلب ، ويتعاطاها بانشراح صدر ، وقد تَضمّن ذلك قوله تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة : 48] وقول النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : ( اعملوا فكلٌّ مُيسّر لِما خُلق له ) (14) . فلما رُئي أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كلّ وادٍ من المعاني بسلاطة ألسنتهم ، وقد دعا الله جماعتهم إلى معارضة القرآن ، وعجزهم عن الإتيان بمِثله ، وليس تهتزّ غرائزهم البتة للتصدّي لمعارضته ، لم يخفَ على ذي لبّ أنّ صارفاً إلهياً يَصرفهم عن ذلك ، وأيّ إعجاز أعظم مِن أن تكون كافّة البلغاء مُخيّرة في الظاهر أن يُعارضوه ، ومُجبرة في الباطن عن ذلك ، وما أليقهم بإنشاد ما قال أبو تمام :
فإنْ نكُ أُهمِلنا فَأَضعِف بِسَعينا وإنْ نَـكُ أُجـبِرنا فَفيمَ نُتَعتِعُ
والله وليّ التوفيق والعصمة (15) .
6 ـ رأي الإمام الرازي :
ولأبي عبد الله محمّد بن عمر بن حسين فخر الدين الرازي ( توفّي سنة 606هـ ) ـ المفسّر المتكلّم الأُصولي الكبير ـ رأي في إعجاز القرآن طريف ، وهو جَمْعه بين أُمور شتّى ، كانت تستدعي هبوطاً في فصاحة الكلام ، لو كان أحد مِن البشر حاول القيام بها أجمع ، لولا أنّ القرآن كلام الله الخارق لَمألوف الناس ، فقد جمع بين أفنان الكلام ، ومع ذلك فقد بلغ الغاية في الفصاحة ، وتسنّم الذروة من البلاغة ، وهذا أمرٌ عجيب !
قال : اعلم أنّ كونه ( القرآن ) معجزاً يُمكن بيانه من طريقينِ :
( الأوَّل ) أن يقال : إنّ هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة : إمّا أن يكون مساوياً لسائر كلام الفصحاء ، أو زائداً على سائر كلام الفصحاء بقدرٍ لا ينقض العادة ، أو زائداً عليه بقدرٍ ينقض ، والقسمان الأوّلان باطلان فتعيّن الثالث .
وإنّما قلنا : إنّهما باطلان ؛ لأنّه لو كان كذلك لكان من الواجب أن يأتوا بمِثل سورة منه إمّا مجتمعينَ أو منفردينَ ، فإن وقع التنازع وحصل الخوف من عدم القبول فالشهود والحُكّام يُزيلون الشبهة ، وذلك نهاية في الاحتجاج ؛ لأنّهم كانوا في معرفة اللغة والاطّلاع على قوانين الفصاحة في الغاية ، وكانوا في مَحبّة إبطال أمره في الغاية ، حتّى بذلوا النفوس والأموال ، وارتكبوا ضروب المَهالك والمِحن ، وكانوا في الحميّة والأَنَفة على حدّ لا يقبلون الحقّ فكيف الباطل ! ، وكلّ ذلك يُوجب الإتيان بما يقدح في قوله ، والمعارضة أقوى القوادح ، فلمّا لم يأتوا بها عِلمنا عَجزهم عنها ، فثبت أنّ القرآن لا يُماثل قولهم ، وأنّ التفاوت بينه وبين كلامهم ليس تفاوتاً معتاداً ، فهو إذاً تفاوت ناقض للعادة ، فوجب أن يكون معجزاً .
واعلم أنّه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة تقتضي نُقصان فصاحته ، ومع ذلك فإنّه في الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية لها وراءها ، فدلّ ذلك على كونه معجزاً .
أحدها : أنّ فصاحة العرب أكثرها في وصف مشاهدات ، مثل وصف بعير أو فرس أو جارية أو مَلِك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصف غارة ، وليس في القرآن من هذه الأشياء شيء ، فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتّفقت العرب عليها في كلامهم .
وثانيها : أنّه تعالى راعى فيه طريقةَ الصدق وتنزّه عن الكذب في جميعه ، وكلّ شاعر ترك الكذب والتزم الصدق نَزَل شعره ولم يكن جيّداً ، أَلا ترى أنّ لبيد بن ربيعة وحسّان بن ثابت لمّا أَسلما نَزَل شعرهما ولم يكن شعرهما الإسلامي في الجودة كشعرهما الجاهلي ، وأنّ الله تعالى مع ما تنزّه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحاً كما ترى .
وثالثها : أنّ الكلام الفصيح والشعر الفصيح إنّما يتّفق في القصيدة في البيت والبيتينِ والباقي لا يكون كذلك ، وليس كذلك القرآن ؛ لأنّه كلّه فصيح بحيث يعجز الخَلق عنه كما عجزوا عن جملته .
ورابعها : أنّ كلّ مَن قال شعراً فصيحاً في وصف شيء فإنّه إذا كرّره لم يكن كلامه الثاني في وصف ذلك الشيء بمنزلة كلامه الأَوّل ، وفي القرآن التَّكرار الكثير ، ومع ذلك كلّ واحد منها في نهاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت أصلاً .
وخامسها : أنّه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحثّ على مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة ، وأمثالُ هذه الكلمات تُوجب تقليل الفصاحة .
وسادسها : أنّهم قالوا في شعر امرئ القيس : يَحسن عند الطرب وذِكر النساء وصِفة الخَيل ، وشِعر النابغة عند الخوف ، وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخَمر ، وشعر زهير عند الرغبة والرجاء ، وبالجملة فكلّ شاعر يحسن كلامه في فنّ ، فإنّه يَضعف كلامه في غير ذلك الفنّ ، أمّا القرآن فإنّه جاء فصيحاً في كلّ الفنون على غاية الفصاحة .
أَلا ترى أنّه سبحانه وتعالى قال في الترغيب : {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة : 17] وقال تعالى : {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ} [الزخرف : 71].
وقال في الترهيب : {أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ } [الإسراء : 68] ، وقال : { أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ} [الملك : 16] ، وقال : {كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ} [إبراهيم : 15 - 17] .
وقال في الزجر مالا يبلغه وَهْم البشر ، وهو قوله : {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا} [العنكبوت : 40] .
وقال في الوعظ ما لا مَزيد عليه {أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ} [الشعراء : 205].
وقال في الإلهيّات : {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} [الرعد : 8] .
وسابعها : أنّ القرآن أصل العلوم كلّها ، فعِلم الكلام كلّه في القرآن ، وعِلم الفقه كلّه مأخوذ من القرآن ، وكذلك علم أُصول الفقه ، وعلم النحو واللغة ، وعلم الزهد في الدنيا ، وأخبار الآخرة ، واستعمال مكارم الأخلاق .
ومَن تأمّل كتابنا في دلائل الإعجاز (16) علم أنّ القرآن قد بلغ في جميع وجوه الفصاحة إلى النهاية القصوى .
( الطريق الثاني ) أن نقول : إنّ القرآن لا يخلو إمّا أن يُقال إنّه كان بالغاً في الفصاحة إلى حدّ الإعجاز ، أو لم يكن كذلك . فإن كان الأَوّل ثبت أنّه معجز ، وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا التقدير ممكنة ، فعدم إتيانهم بالمعارضة ، مع كون المعارضة ممكنةً ، ومع توفّر دواعيهم على الإتيان بها أَمر خارق للعادة ، فكان ذلك معجزاً ، فثبت أنّ القرآن معجز على جميع الوجوه ، وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الصواب (17) .
وكلامه هذا الأخير لعلّه ترجيح للقول بالصِّرفة !
7 ـ كلام الشيخ الطوسي :
وللشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ـ شيخ الطائفة ، ( توفّي سنة 460 ) ـ تحقيق مستوفٍ بشأن إعجاز القرآن ، أورده في كتابه ( الاقتصاد ) الذي وضعه على أُسس عِلم الكلام ، وحقّق فيه أُصول العقيدة على مباني الإسلام نذكر منه ما ملخّصه :
قال : الاستدلال على صدق النبوّة بالقرآن يتمّ بعد بيان خمسة أُمور :
1 ـ إنّه ظهر بمكّة وادّعى النبوّة .
2 ـ إنّه تحدّي العرب بهذا القرآن .
3 ـ إنّه لم يُعارضوه في وقت من الأوقات .
4 ـ وكان ذلك لعجزهم عن المعارضة .
5 ـ وإنّ هذا كان لتعذّر خَرق العادة .
فإذا ثبت ذلك أَجمع دلّ على أنّ القرآن معجز ، سواء كان لفصاحته البالغة أَم لأنّ الله صرفهم عن ذلك ، وأيّ الأمرينِ ثبت ثبتت نبوّته ( عليه السلام ) .
أَمّا ظهوره بمكّة وادّعاؤه النبوّة فضروري ، وكذا ظهور القرآن على يده وتحدّيه للعرب أن يأتوا بمِثله ؛ لأنّه صريح القرآن في مواضع عديدة .
وأمّا أنّه لم يُعارض ؛ فلأنّه لو كان عُورض لوجب أن يُنقل ، ولو نُقل لعُلم ؛ لأنّ الدواعي متوفرة إلى نقله ، ولأنّ المعارض لو كان لكان هو الحجّة دون القرآن ، ونَقل الحجّة أَولى من نقل الشبهة .
والذي يدعو إلى المعارضة ـ لو أَمكَنت ـ ونَقْلِها هو طلب التخليص ممّا أُلزموا به من ترك أديانهم ومفارقة عاداتهم وبطلان ما ألفوه من الرئاسات ؛ ولذلك نقلوا كلام مسيلمة والأسود العنسي وطليحة مع ركاكته وسخافته وبُعده عن دخول الشبهة فيه .
ولا يمكن دعوى الخوف من أنصاره وأتباعه ؛ إذ لا موجب للخوف مع ضعف المسلمين بمكّة وعلى فرضه فلا يمنع نقله استسراراً ، أو في سائر البلاد النائية كالروم والحبشة وغيرهما ، كما نُقل هجاؤهم وسبّهم ، وكان أفحش وكان أدعى للخوف إن كان .
وإذا ثبت أنّهم لم يُعارضوه فإنّما لم يُعارضوه للعجز ؛ لأنّ كلّ فعل لم يقع مع توفّر الدواعي لفاعله وشدّة تداعيه عليه قَطَعنا على أنّه لم يُفعل للتعذّر ، وقد توفّرت دواعي العرب إلى معارضته فلم يفعلوها ، وقد تكلّفوا المَشاقّ من أجله . فقد بذلوا النفوس والأموال وركبوا الحروب العِظام ودخلوا الفتن طلباً لإبطال أمره فلو كانت المعارضة ممكنةً لهم لما اختاروا الصعب على السهل ؛ لأنّ العاقل لا يَترك الطريق السهل ويَسلك الطريق الوعر الذي لا يبلغ معه الغرض إلاّ أن يختلّ عقله أو يُسفه رأيه ، والقوم لم يكونوا بهذه الصفة .
وليس لأحد أن يقول : إنّهم اعتقدوا أنّ الحرب أنجح من المعارضة فلذلك عدلوا إليها ، وذلك أنّ النبيّ ( عليه السلام ) لم يدّعِ النبوّة فيهم بالغَلَبة والقَهر ، وإنّما ادّعى معارضة مثل القرآن ، ولم يكن احتمال حرب إذ ذاك ، ثُمّ مع قيام الحرب كانوا في الأغلب مغلوبينَ مقهورينَ ، فكان يجب أن يقوموا بالمعارضة ، فإن أَنجَعت وإلاّ عدلوا إلى الحرب .
فإن قالوا : خافوا أن يلتبس الأمر فيَظنّ قوم أنّه ليس مثله ، قيل قد حصل المطلوب ؛ لأنّ الاختلاف حينذاك يُوجب الشبهة ، فكان أَولى من الترك الذي يَقوى معه شبهة العجز .
وليس لهم أن يقوموا : لم تتوفّر دواعيهم إلى ذلك ؛ لأنّهم تحمّلوا المَشّاق ، والعاقل لا يتكلّف ذلك إذا لم تتوفّر دواعيه إلى إبطال دعوى خصمه .
فإن قالوا : إنّما لم يُعارضوه ؛ لأنّ في كلامهم ما هو مِثله أو مُقاربه ، قلنا : هذا غير مُسلّم ، وعلى فرض التسليم فإنّ التحدّي وقع لعجزهم فيما يأتي ، فلو كان في كلامهم مِثله فهو أَبلغ لعجزهم في تحقّق التحدّي بالعجز عن الإتيان بمِثله في المستقبل .
فإن قيل : واطأه قوم من الفصحاء ، قيل : هذا باطل ؛ لأنّه كان ينبغي أن يُعارضه مَن لم يواطئه ، فإنّهم ـ وإن كانوا أَدون منهم في الفصاحة ـ كانوا يقدرون على ما يقاربه ـ على الفرض ـ لأنّ التفاوت بين الفصحاء لا ينتهي إلى حدّ يَخرق العادة . على أنّ الفصحاء المعروفينَ والبُلغاء المشهورينَ في وقته كلّهم كانوا منحرفينَ عنه ، كالأعشى الكبير الذي في الطبقة الأُولى ومَن أَشبهه مات على كفره ، وكعب ابن زهير أَسلَم في آخر الأمر وهو في الطبقة الثانية وكان من أعدى الناس له ( عليه السلام ) ، ولبيد بن ربيعة والنابغة الجعدي من الطبقة الثالثة أَسلما بعد زمان طويل ومع ذلك لم يَحظيا في الإسلام بطائل ، على أنّه لو كان لكان ينبغي أن يوافقوه على ذلك ويقولون له : الفصحاء المُبرزون واطأُوك ووافقوك ، فإنّ الفُصحاء في كلّ زمان لا يخفون على أهل الصناعة .
فإن قيل : لِمَ لا يكون النبيّ ( عليه السلام ) ـ وهو أفصح العرب ـ قد تأتّى منه القرآن ، وتَعذّر على غيره ، أو تعمله في زمان طويل فلمْ يتمكّنوا من معارضته في زمان قصير ؟
قيل : هذا لا يتوجّه على مَن يقول بالصِّرفة ؛ لأنّه يجعل صَرف هِممهم عن ذلك دليلاً على الإعجاز ، ولو فُرض تمكّنهم من المعارضة .
وأمّا مَن قال : إنّ جهة الإعجاز في الفصاحة والبيان ، فإنّ كون النبيّ ( عليه السلام ) أفصح لا يمنع من أن يُقارنوه أو يُدانوه ، كما هو المتعارف بينهم في المعارضة ومقارنة الشعر ، على أنّ العرب لم يتفوّهوا بذلك ولمْ يقولوا له : أنت أَفصحنا ، فلذلك يتعذّر علينا ما يتأتّى منك ، وأمّا احتمال التعمّل فباطل ؛ لأنّه ( عليه السلام ) عارضهم في مدّة طويلة أَكثير من عشرين عاماً يتحدّاهم طول المدّة .
قال : وإذ قد ثبت أنّ القرآن مُعجز لمْ يضرّنا أن لا نعلم من أيّ جهة كان إعجازه ، غير أنّا نُومئ إلى جملة من الكلام فيه :
كان المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي رحمة الله عليه يختار أنّ جهة إعجازه الصِّرفة ، وهي : أنّ الله تعالى سَلب العرب العلوم التي كانت تتأتّى منهم بها الفصاحة التي هي مِثل القرآن متى راموا المعارضة ، ولو لمْ يسلبهم ذلك لكان يتأتّى منهم . وبذلك قال النظّام وأبو إسحاق النصيبي أخيراً .
وقال قوم : جهة الإعجاز الفصاحة المُفرطة التي خَرقت العادة من غير اعتبار النَظم ، ومنهم مَن اعتبر النَظم والأُسلوب مع الفصاحة ، وهو الأقوى . وقال قوم : هو معجز لاختصاصه بأُسلوب مخصوص ليس في شيء من كلام العرب .
وقال قوم : تأليف القرآن ونَظمه مستحيل من العباد ، كاستحالة الجواهر والألوان .
وقال قوم : كان معجزاً لما فيه من العِلم بالغائبات .
وقال آخرون : كان مُعجزاً لارتفاع الخلاف والتناقض فيه ، مع جريان العادة بأنّه لا يخلو كلام طويل من ذلك .
وأقوى الأَقوال عندي قول مَن قال : إنّما كان معجزاً خارقاً للعادة لاختصاصه بالفصاحة المفرطة في هذا النَظم المخصوص ، دون الفصاحة بانفرادها ، ودون النَظم بانفراده ، ودون الصِّرفة .
وإن كنت نصرتُ في شرح الجمل (18) القول بالصِّرفة ، على ما كان يذهب إليه المرتضى ( رحمه الله ) من حيث شرحت كتابه ، فلم يَحسن خلاف مذهبه .
قال : والذي يدلّ على ما قلناه واخترناه : أنّ التحدّي معروف بين العرب بعضهم بعضاً ، ويعتبرون في التحدّي معارضة الكلام بمثله في نَظمه ووصفه ؛ لأنّهم لا يعارضون الخُطب بالشعر ولا الشعر بالخُطب ، والشعر لا يُعارضه أيضاً إلاّ بما كان يوافقه في الوزن والرويّ والقافية ، فلا يُعارضون الطويل بالرَّجَز ، ولا الرَّجَز بالكامل ، ولا السريع بالمتقارب ، وإنّما يُعارضون جميع أوصافه .
فإذا كان كذلك فقد ثبت أنّ القرآن جمع الفصاحة المُفرطة والنَظم الذي ليس في كلام العرب مثله ، فإذا عجزوا عن معارضته فيجب أن يكون الاعتبار بهما .
فأمّا الذي يدلّ على اختصاصها بالفصاحة المُفرطة فهو أنّ كلّ عاقل عرف شيئاً من الفصاحة يعلم ذلك ، وإنّما في القرآن من الفصاحة ما يزيد على كلّ فصيح ، وكيف لا يكون كذلك وقد وجدنا الطبقة الأُولى قد شهدوا بذلك وطربوا له ، كالوليد ابن المغيرة والأعشى الكبير وكعب بن زهير ولبيد بن ربيعة والنابغة الجعدي ، ودخل كثير منهم في الإسلام ، ككعب والنابغة ولبيد ، وهَمَّ الأعشى بالدخول في الإسلام فمنعه من ذلك أبو جهل وفزّعه ، وقال إنّه يُحرّم عليك الأطيبَينِ الزنا والخمر . فقال له : أمّا الزنا فلا حاجة لي فيه لأنّي كبرت ، وأمّا الخمر فلا صبرَ لي عنه ، واُنظر فَأَتته المنيّة واختُرم دون الإسلام .
والوليد بن المغيرة تحيّر حين سمعه ، فقال : سمعت الشعر ، والرَّجَز وليس برَجَز ، والخُطب وليس بخُطب ، وليس له اختلاج الكَهَنة ، فقالوا له : أنت شيخنا ، فإذا قلت هذا صَعفت قلوبنا ، ففكّر ، وقال : قولوا : هو سحر ، معاندةً وحسداً للنبيّ . فأنزل الله تعالى هذه الآية {إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ} [المدثر : 18 - 24] ، فمَن دفع فصاحة القرآن لم يكن في حيّز مَن يُكَلَّم .
وأمّا اختصاصه بالنظم فمعلوم ضرورةً ؛ لأنّه مَدرك مسموع ، وليس في شيء من كلام العرب ما يشبه نظمه ، مِن خطبة أو شعر على اختلاف أنواع وَصْفاته ، فاجتماع الأمرين منه لا يمكن دفعهما (19) .
_______________________________
1- نسبة إلى بُست مدينة من بلاد كابل كانت محلّ إقامته ، وينتهي نسبه إلى زيد بن الخطّاب أخي عمر بن الخطّاب ، أديب لغوي ومحدّث كبير ، قيل : هو أوّل من كتب في الإعجاز وطرق هذا الباب .
لكن ذَكَر ابن النديم لمحمّد بن زيد الواسطي ـ الذي هو من أجلّة المتكلّمين وكبارهم وصاحب كتاب ( الإمامة ) المُتوفّى سنة 307هـ ـ كتاباً أسماه ( إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه ) ، ( راجع الفهرست : ص63 و259، والذريعة : ج2 ، ص232 ، رقم 917 ) .
وقبله أبو عبيدة معمّر بن المثنّى ( توفيّ سنة 209هـ ) له كتاب ( إعجاز القرآن ) في جزءَين ، وهو مِن أَوّل الدراسات القرآنية التي ظهر فيها الاتجاه إلى الكشف عن أسرار أُسلوب القرآن ، وقد نشره الخانجي بمصر سنة 1955م ( راجع مقدّمة الطبعة الثانية لكتاب ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) : ص5 ، والتمهيد : ج1 ، ص8 ) .
2- أَي أُلقيت في النفوس إلقاءً ، وهو قول قريب من القول بالصرفة ، ومِن ثَمّ رفضه .
3- المحرّر الوجيز : المقدّمة ج1 ، ص71 ـ 72 ، وراجع الزركشي في البرهان : ج2 ، ص97 .
(4) الشقاشق : جمع شقشقة ـ بكسر الشين ـ وهي لهاة البعير أو شيء كالرئة يُخرجه البعير من فيه إذا هاج ، ويُقال للفصيح : هدرتْ شقاشقه ، يُريدون الانطلاق في القول وقوّة البيان ، ويُقال في مقابل ذلك : خرست شقاشقه .
(5) في مقدمة دلائل الإعجاز : ص ( ف ـ ص ) .
(6) دلائل الإعجاز : ص25 ـ 26 .
7المصدر نفسه : ص 27 ـ 28 .
8-المصدر نفسه : ص29.
9- الشافية ( المطبوعة ضمن ثلاث رسائل ) : ص120 ـ 122 .
10- الشافية : ص141 و144 .
11- المصدر نفسه : 141 و144 .
12-مفتاح العلوم : ص196 ـ 199 .
13- في ص 12 ـ 14 .
14- مسند أحمد : ج 4 ص 67 .
15- عن مقدّمته على التفسير : 104 ـ 109 .
16- المُسمّى بـ ( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ) طبع سنة 1985 بيروت .
17- التفسير الكبير : ج2 ، ص115 ـ 116 ذيل الآية 23 من سورة البقرة .
18- في كتابه ( تمهيد الأُصول ) شرحاً على القسم النظري من ( جُمَل العلم والعمل ) وقد طُبع أخيراً سنة 1362هـ . ش . في جامعة طهران ، وسننقل كلامه عند التعرّض للقول بالصِّرفة .
19- الاقتصاد في أُصول الاعتقاد : ص166 ـ 174 .



|
|
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|