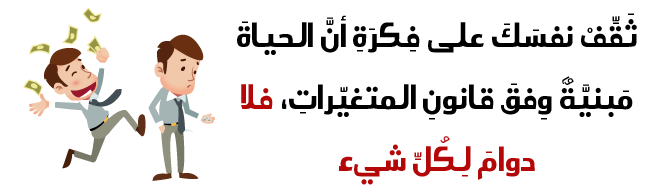
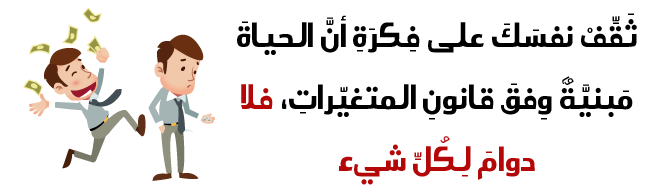

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
التاريخ: 26-8-2016
التاريخ: 26-8-2016
التاريخ: 25-8-2016
|
للوجوب ثلاث مراحل وهي: الملاك، والارادة، وجعل الحكم.
وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا. فاذا اخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد ان المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم اليه، ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض فان الانسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بانه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بانه شرط في اتصاف الفعل بالملاك وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر بان يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط ايضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، اذ من الواضح ان المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، وانما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة، وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها، فالطبيب بأمره المذكور يريد ان يوضح ان المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفي الا بحصة خاصة من الاستعمال، وهي استعماله بعد الطعام وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر، او مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط.
وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الارادة في المرحلة الثانية، خلافا لشروط الترتب فانها شروط للمراد، لا للإرادة من دون فرق في ذلك كله بين الارادة التكوينية، والتشريعية.
فالإنسان لا يريد ان يشرب الدواء الا اذا رأى نفسه مريضا، ولا يريد من مأموره ان يشرب الدواء الا اذا كان كذلك. ولكن ارادة شرب الدواء للمريض، او لمن يوجهه فعلية قبل ان يتناول الطعام.
ولهذا فان المريض قد يتناول الطعام لا لشيء الا حرصا منه على ان يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب، وهذا يوضح ان تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، بل هو قيد للمراد بمعنى ان الارادة فعلية، ومتعلقة بالحصة الخاصة، وهي شرب الدواء المقيد بالطعام، ومن اجل فعليتها كانت محركة نحو ايجاد القيد نفسه.
غير ان الارادة التي ذكرنا انها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، بل بوجودها التقديري اللحاظي لان الارادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. وما اكثر المصالح التي لا تؤثر في ارادة الانسان لعدم ادراكه، ولحاظه لها، فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الارادة فلا مصلحة في الدواء الا اذا كان الانسان مريضا حقا، ولا ارادة للدواء الا اذا لاحظ الانسان المرض وافترضه في نفسه، او فيمن يتولى توجيهه. ونفس الفارق بين شروط الاتصاف، وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة، وهي مرحلة جعل الحكم، فقد علمنا سابقا ان جعل الحكم عبارة عن انشائه على موضوعه الموجود، فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم وتعتبر مشروطا للوجوب المجعول، واما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب.
واذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة، وميزنا بين الجعل والمجعول، كما مر بنا في الحلقة السابقة، نجد ان الجعل باعتباره امرا نفسانيا منوطا، ومرتبطا بشروط الاتصاف بوجودها التقديري اللحاظي كالإرادة تماما لا
بوجودها الخارجي، ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل ان توجد شروط الاتصاف خارجا. واما فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي، فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا. واما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد. وبهذا نعرف ان الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف، لانه مشروط بها في عالم الجعل.
واما ما يقال من ان الوجوب المشروط غير معقول، لان المولى يجعل الحكم قبل ان تتحقق الشروط خارجا فكيف يكون مشروطا؟ فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول، والالتفات إلى ما ذكرناه من اناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط، واناطة المجعول بالوجود الخارجي له.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|