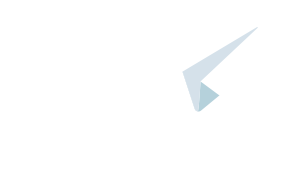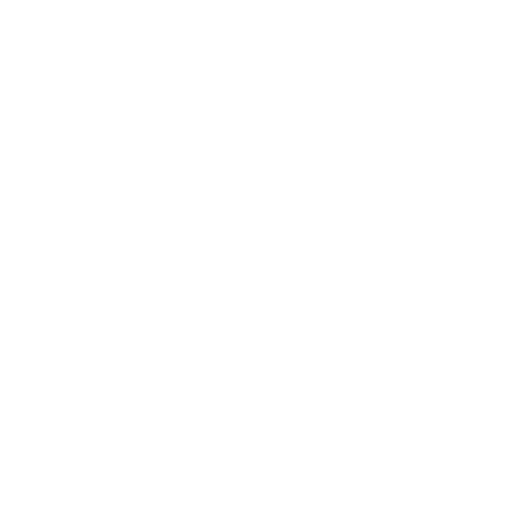المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
المستقلات العقلية
المؤلف:
الشيخ محمد رضا المظفر
المصدر:
أصول الفقه
الجزء والصفحة:
ج1 ص 195- 221.
25-8-2016
3918
تمهيد:
الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعليه يجب علينا إن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل لا سيما إنه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة فنقول: وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة:
1 - إنه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها أحكام عقلية من حسن وقبح؟ أو إن شئت فقل: هل للأفعال حسن وقبح بسحب ذواتها ولها قيم ذاتية في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها، أو ليس لها ذلك، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه، والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا؟ وهذا هو الخلاف الاصيل بين الأشاعرة والعدلية، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام، وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله وغيرها. وإنما سميت (العدلية) عدلية لقولهم بأنه تعالى عادل، بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليين. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية كا اشرنا إلى ذلك فيما سبق.
2 - إنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أولا؟ وعلى تقدير تمكنه هل للمكلف إن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك أما مطلقا أو في بعض الموارد؟ وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي. وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول، ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تحقق عندنا صغرى القياس التي تكلمنا عنها سابقا. ولا ينبغي إن يخفى عليكم إن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع. فأنتظر توضيح ذلك في محله القريب.
3 - إنه بعد فرض إن للأفعال حسنا وقبحا وإن العقل يدرك الحسن والقبح، يصح إن ننتقل إلى التساؤل: عما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع، بمعنى إن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا إن يحكم الشارع على طبق حكمه. وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع فأنكر الملازمة جملة من الإخباريين وبعض الأصوليين كصاحب الفصول.
4 - إنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لا بد إن يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجة شرعا؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث نواح:
(الأولى) - في أمكان إن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهي عن الأخذ به.
(الثانية) - بعد فرض أمكان نفي الشارع حجية القطع هل نهى عن الأخذ بحكم العقل وإن استلزم القطع كقول الأمام عليه السلام: (إن دين الله لا يصاب بالعقول) على تقدير تفسيره بذلك؟ والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الإخباريين جلهم أو كلهم.
(الثالثة) بعد فرض عدم أمكان نفي الشارع حجية القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه، أو إن حكمه معناه إدراكه وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه وهو شيء آخر غير أمره ونهيه فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العقل؟
وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجة (المقصد الثالث) وهو النزاع في حجية العقل. وعليه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة الأولى، ونترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث:
المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان:
اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها هل أنهما عقليان أو شرعيان، بمعنى إن الحاكم بهما العقل أو الشرع. فقالت (الأشاعرة): لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل إن ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لو يكن ممتنعا وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا، ومثلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة (1).
وقالت (العدلية): إن للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع فمنها ما هو حسن في نفسه، ومنها ما هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان. والشارع لا يأمر الا بما هو حسن ولا ينهى الا عما هو قبيح، فالصدق في نفسه حسن ولحسنه أمر الله تعالى به، لا إنه أمر الله تعالى به فصار حسنا، والكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى الله تعالى عنه، لا إنه نهى عنه فصار قبيحا.
هذه خلاصة الرأيين. واعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان، ولا تزال نقط غامضة في البحث إذا لم نبينها بوضوح لا نستطيع إن نحكم لأحد الطرفين. وهو أمر ضروري مقدمة للمسألة الأصولية، ولتوقف وجوب المعرفة عليه. فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب، لأهمية هذا الموضوع من جهة، ولعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى. وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق ص 17 - 23 عن القضايا المشهورات، لتستعينوا به على ما هنا.
والآن اعقد البحث هنا في أمور:
1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد، بل لهما ثلاثة معان، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع؟ فنقول: أولا - قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص. ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال. فيقال مثلا: العلم حسن، والتعلم حسن، ويضد ذلك يقال: الجهل قبيح وإهمال والتعلم قبيح. ويراد بذلك إن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها، وإن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى، فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار إنها كمال للنفس وقوة في وجودها. وكذلك أضدادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس وقوتها. ولا ينافي ذلك إنه يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين.
وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، لأن من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابقه، على ما سيأتي.
(ثانيا) - أنهما قد يطلقان ويراد الملائمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقاتها من أعيان وغيرها. فيقال في المتعلقات: هذا المنظر حسن جميل. هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن.. وهكذا. ويقال في الأفعال: نوم القيلولة حسن. الأكل عند الجوع حسن. والشرب بعد العطش حسن. وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها. وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال: هذا المنظر قبيح. ولولة النائحة قبيحة. النوم على الشبع قبيح.. وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك. فيرجع معنى الحسن والقبح - في الحقيقة - إلى معنى اللذة والألم، أو فقل إلى معنى الملائمة للنفس وعدمها، ما شئت فعبر فإن المقصود واحد. ثم إن هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألما، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتألم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا، بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتي يدخل فيما يستحسن. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحة، ولكن ما يعقبه من مرض أعظم من اللذة الوقتية يدخل فيما يستقبح.
والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع إن يصنف الأشياء والأفعال إلى ثلاثة أصناف: ما يستحسن، وما يستقبح، وما ليس له هاتان المزيتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ماله من الملائمة والمنافرة ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على ماله من لذة وقتية أو ألم وقتي، كمن يتحمل المشاق الكثيرة ويقاسي الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراها لشؤم عواقبها. وكل ذلك يدخل في الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم، قال القوشجي في شرحه للتجريد عن هذا المعنى : (وقد يعبر عنهما - أي الحسن والقبح - بالمصلحة والمفسدة فيقال: الحسن ما فيه مصلحة والقبح ما فيه مفسدة. وما خلا منهما لا يكون شيئا منهما). وهذا راجع إلى ما ذكرنا، وليس المقصود إن للحسن والقبح معنى آخر بمعنى ماله المصلحة أو المفسدة غير معنى الملاءمة والمنافرة، فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملائمة واستقباح المفسدة للمنافرة. وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. ومن توهم إن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلأمهم.
(ثالثا) إنهما يطلقان ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختبارية فقط. ومعنى ذلك: إن الحسن ما أستحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة. وبعبارة أخرى إن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي إن العقل الكل يدرك إنه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم، أي إن العقل عند الكل يدرك إنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه بالحسن والقبح، وسيأتي توضيح هذه النقطة، فإنها مهمة جدا في الباب. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، فالأشاعرة أنكروا إن يكون للعقل إدراك وذلك من دون الشرع، وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك.
(تنبيه) - ومما يجب إن يعلم هنا إن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة، كالتعلم والحلم والإحسان، فإنها كمال للنفس، وملائمة لها باعتبار مالها من نفع ومصلحة، ومما ينبغي إن يفعلها الإنسان عند العقلاء. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني، قبيحا أو ليس بحسن بالمعنى الآخر كالغناء - مثلا - فإنه حسن بمعنى الملائمة للنفس ولذا يقولون عنه إنه غذاء للروح (2)، وليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي إن يفعل وليس كمالا للنفس وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة، ومثله التدخين أو ما تعتاده النفس من المسكرات والمخدرات فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط، وليس كمالا للنفس ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء.
2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال وكذا مقابله أي القبح أمر واقعي خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق، ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله. بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين. وهذا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل، فنقول:
1 - أما (الحسن بمعنى الملائمة)، وكذا ما يقابله، فليس له في نفسه بإزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا، كاللون والرائحة والطعم وتناسق الإجزاء ونحو ذلك. بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص، فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه، فيكون حسنا عنده أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الاذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين. وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا، أو قبيحا كذلك.
والحاصل إن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة الا إدراك الإنسان وذوقه فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن الأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائمة. وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال إنها لا واقع لها بل هي تحصل من إنعكاسات اطياف الضوء على الأجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الاطياف عند وقوع الضوء عليها، وليس كل واحد من الألوان الا طيفا أو اطيافا فأكثر تركبت. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملاءمة، والشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة في الأشياء كالطعم والرائحة ونحوهما، الذي هو كالصفة في الجسم إذ تكون منشأ لانعكاس اطياف الضوء. كما إن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيإن ولكن هما الحسن والقبح اللذان ليسا هما من صفات الأشياء، واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن والقبح.
2 - وأما (الحسن بمعنى ما ينبغي إن يفعل عند العقل) فكذلك ليس له واقعية الا إدراك العقلاء، أو فقل تطابق اراء العقلاء. والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة. وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل للحسن والقبح. وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح. ولكن هذا بعيد عن أقوالهم لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع فإنه يعلم منه إنه ليس غرضهم ذلك لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية. كيف وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم فسيأتي تحقيق الحق فيه وإنهم ليسوا على صواب في ذلك.
3 - العقل العملي والنظري إن المراد من العقل - إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح - هو (العقل العملي) في مقابل (العقل النظري).
وليس الاختلاف بين العقلين الا بالاختلاف بين المدركات، فإن كان المدرك - بالفتح - مما ينبغي إن يفعل أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم فيسمى إدراكه (عقلا عمليا) وإن كان المدرك مما ينبغي إن يعلم مثل قولهم: (الكل اعظم من الجزء) الذي لا علاقة له بالعمل، فيسمى إدراكه (عقلا نظريا ). ومعنى حكم العقل - على هذا - ليس الا إدراك إن الشيء مما ينبغي إن يفعل أو يترك. وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي الا بمعنى إن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه. للعمل وفعل ما ينبغي. أذن - المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراؤه.
ومن هنا تعرف إن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول. إن المراد به هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص مما ينبغي إن يعلم، لا مما ينبغي إن يعمل. نعم إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه، فإنه يدرك معه إنه ينبغي فعله أو تركه فيستعين العقل العملي بالعقل النظري. أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي إن يعلم، ويستتبع ذلك إدراك إنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات ج 1 ص 59 المطبوع بالنجف سنة 1368 إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعة: (إن المطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري، فهو بمنزلة المشير الناصح والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته).
وهذا منه خروج عن الاصطلاح. وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري؟. وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته ، وللتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا وأخرى نظريا، وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل وتسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة.
4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح إن الإنسان إذ يدرك إن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا، وهذا شأن كل ممكن حادث بل لا بد له من سبب. وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فنقول:
(الأول) - إن يدرك إن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن أو فعله أو قبحه كما تقدم قريبا، تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص. (الثاني) - إن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها أما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص، فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. وكل من هذين الإدراكين - اعني إدراك الكمال أو النقض، وإدراك الملائمة أو عدمها - يكون على نحوين:
1 - إن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية. وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال، وإن كان هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي إن يسمى عقليا بل قد يسمى - بالتعبير الحديث - (عاطفيا) لأن سببه تحكيم العاطفة الشخصية ولا بأس بهذا التعبير.
2 - إن يكون الإدراك لأمر كلي، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس، كالعلم والشجاعة، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل، فيستتبع مدحا من جميع العقلاء. وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل، أو لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذما من جميع العقلاء. فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين، أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعين - فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضوع النزاع. وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات. وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة (الآراء المحمودة) و (التأديبات الصلاحية). وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات. فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات، كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليلهم. وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من (المنطق) في مبادئ القياسات، فراجع. ومن هنا يتضح لكم جيدا إن العدلية - إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين - يريدون إن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، أي إن واقعها ذلك. فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم إن فاعله ممدوح لدى العقلاء ومعنى قبح الظلم والجهل إن فاعله مذموم لديهم (3).
ويكفينا شاهدا على ما نقول - من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفية التي لا واقع لها الا الشهرة وإنها ليست من قسم الضروريات ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات: (ومنها الآراء المسماة بالمحمودة. وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لها الا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها.. لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح، وإن الكذب قبيح لا ينبغي إن يقدم عليه..). وهكذا وافقه شارحها العظيم الخواجا نصير الدين الطوسي.
(الثالث) ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح (الخلق الإنساني) الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه، نحو خلق الكرم والشجاعة. فإن وجود هذا الخلق يكون سببا لإدراك إن أفعال الكرم - مثلا - مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها. وهذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة ولا من جهة الكمال للنفس أو النقص، بل بدافع الخلق الموجود. وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح مشهورا بينهم تتطابق عليهم آراؤهم. ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للنفس أو مصلحة عامة نوعية فيدعو ذلك إلى المدح والذم. ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته عن (الخلقيات) في المنطق (ج 3 ص 20) لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنساني بهذه المشهورات .
(الرابع) ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح (الانفعال النفساني)، نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة.. إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان أتباعا لما في الغريزة من الرقة والعطف، والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعني برعاية الأيتام والمجانين بل الحيوانات لأنه مقتضى الرحمة والشفقة. ويحكم بقبح كشف العورة والكلام البذيء لأنه مقتضى الحياء. ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة لأنه مقتضى الغيرة والحمية.. إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامة بين الناس. ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا عقليين، بل ينبغي إن يسميا عاطفيين أو انفعاليين. وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين ب (الانفعاليات). ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة، ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذه الأحكام، لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات. بل يستحيل وجودها فيه لأنها من صفات الممكن. وإنما نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم العقل بالحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية - على ما سيأتي - فباعتبار إن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، بل خالق العقل، فلا بد إن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء ولكن لا يجب إن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون. ولا نقول إن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة.
(الخامس) - ومن الأسباب (العادة عند الناس)، كاعتيادهم احترام القادم - مثلا - بالقيام له، واحترام الضيف بالطعام، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم وإطعام الضيف. والعادات العامة كثيرة ومتنوعة، فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر. فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة، فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم. وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين بها، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية، أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي: فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها، وتراهم يذمون من يلبس غير الما لوف عندهم لمجرد إنهم لم يعتادوا لبسه، بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا. وهذا الحسن والقبح أيضا ليسا عقليين، بل ينبغي إن يسميا (عاديين) لأن منشأهما العادة. وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطقة (العاديات). ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع. ولا نقول نحن - أيضا - بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه، لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء بل بما هم معتادون، أي بدافع العادة. نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة، أي اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس. ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس، بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية والاشمئزاز فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا، وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه.
فتحصل من جميع ما ذكرنا - وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما - إنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الأشاعرة، بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو نقصه على نحو كلى، وما كان سببه إدراك ملائمته أو عدمها على نحو كلى أيضا من جهة ص 210 مصلحة نوعية أو مفسدة نوعية فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء وهي التي ندعي فيها إن الشارع لا بد إن يتابعهم في حكمهم. وبهذا تعرف ما وقع من الخلط في كلأم جملة من الباحثين عن هذا الموضوع.
5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام:
1 - ما هو (علة) للحسن والقبح، ويسمى الحسن والقبح فيه ب (الذاتيين)، مثل العدل والظلم، والعلم والجهل. فإن العدل بما هو عدل لا يكون الا حسنا أبدا أي إنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد إن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عندهم محسنا. وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون الا قبيحا، أي إنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم ويعد مسيئا.
2 - ما هو (مقتض) لهما، ويسمى الحسن والقبح فيه ب (العرضيين) مثل تعظيم الصديق وتحقيره، فإن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه فهو حسن ممدوح عليه، وتحقيره كذلك قبيح لو خلي ونفسه. ولكن تعظيم الصديق بعنوان إنه تعظيم الصديق يجوز إن يكون قبيحا مذموما كما إذا كان سببا لظلم ثالث، بخلاف العدل فإنه يستحيل إن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان العدل. كذلك تحقير الصديق بعنوان إنه تحقير له يجوز إن يكون حسنا ممدوحا عليه كما إذا كان سببا لنجاته، ولكن يستحيل إن يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم.
3 - ما لا عليه له ولا اقتضاء فيه في نفسه للحسن والقبح أصلا، وإنما قد يتصف بالحسن تارة إذا انطبق عليه عنوان حسن كالعدل، وقد يتصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالظلم. وقد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسنا ولا قبيحا، كالضرب مثلا فإنه حسن للتأديب وقبيح للتشفي، ولا حسن ولا قبيح كضرب غير ذي الروح. ومعنى كون الحسن أو القبح ذاتيا: إن العنوان المحكوم عليه بأحدهما بما هو في نفسه وفي حد ذاته يكون محكوما به، لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر. فلا يحتاج إلى واسطة في اتصافهم بأحدهما.
ومعنى كونه مقتضيا لأحدهما: إن العنوان ليس في حد ذاته متصفا به بل بتوسط عنوان آخر، ولكنه لو خلي وطبعه كان داخلا تحت العنوان الحسن أو القبيح ألا ترى إن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان العدل الذي هو حسن في ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون لهم مصلحة نوعية عامة. أما لو كان سببا لهلاك نفس محترمة كان قبيحا لأنه يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم ولا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للصديق. وكذلك يقال في تحقير الصديق، فإنه لو خلى ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعية عامة. فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق. وأما العناوين من القسم الثالث فليست في حد ذاتها لو خليت وأنفسها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح، فلذلك لا تكون لها علية ولا اقتضاء. وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا، فإن المراد من العلية إن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح.
والمراد من الاقتضاء إن العنوان لو خلي وطبعه يكون داخلا فيما هو موضوعا لحكم العقلاء بالحسن أو القبح. وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما إنه بمعنى التأثير والإيجاد فإنه من البديهي إنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء الا من باب علية الموضوع لمحموله.
6 - أدلة الطرفين بتقديم الأمور السابقة نستطيع إن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة، لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة.
ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد، فنقول:
1 - إنا ذكرنا إن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من إن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها. ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم إذ يقولون: (لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. ولكن الفرق موجود قطعا إذ الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف في الأول). وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. والجواب عنه: إن المقدمة الأولى، وهي الجملة الشرطية ممنوعة، ومنعها يعلم مما تقدم آنفا، لأن قضية الحسن والقبح - كما قلنا - من المشهورات وقضية إن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات، فلا ملازمة بينهما وليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل الا يكون فرق بينها وبين القضية الثانية. وينبغي إن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات، ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى. والفارق من وجوه ثلاثة:
(الأول) - إن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي، والحاكم في الأوليات العقل النظري. (الثاني) - إن القضية التأديبية لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء والأوليات لها واقع خارجي. (الثالث) - إن القضية التأديبية لا يجب إن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، فإنه لا بد ألا يشذ عاقل في الحكم بها لأول وهلة.
2 - ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين إن قالوا: إنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه، إذا كان فيه ضرر كبير. وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه، إذا كان فيه نفع كبير. كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من أحسن الأشياء وقبحها على إنحاء ثلاثة، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي إنه مادام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا. وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة. والخلاصة إن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد إن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا، حتى يلزم ما ذكر من الإشكال.
3 - وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلاصته: (إنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع). وأجيب عنه، بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملاءمة والمنافرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به. ونحن نقول: إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم. ولا شك في إن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس ومنكره مكابر. والذي يدفع العقلاء لهذا - كما قدمنا - شعورهم بأن العدل كمال للعادل وملاءمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه وشعورهم بنقص الظلم ومنافرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه.
4 - واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان الا من طريق الشرع، فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع. وقد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي : إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا الا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا الا إذا ذم الفاعل عليه. ومن أين تعرف إنه يجب إن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه، الا إذا كان ذلك واجبا عقلا، فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب.
ثم لو ثبت إن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض إن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، فمن أين نعرف إنه صادق في مدحه وذمه الا إذا ثبت إن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا، فلو لو يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير بأنه يكفي في كون الشيء حسنا إن يتعلق به الأمر وفي كونه قبيحا إن يتعلق به النهي، والأمر والنهي - حسب الفرض - ثابتان وجدانا. ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. وهذا الكلام - في الحقيقة - يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوى ومصادرة على المطلوب، لأن المستدل يرجع قوله إلى إنه يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح والمجيب يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن والقبح. والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول: إنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية وكذلك وجوب المعرفة. وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم، فنقول لهم: من أين يثبت هذا الوجوب؟
لا بد إن يثبت بأمر من الشارع. فننقل الكلام إلى هذا الأمر، فنقول لهم: من أين تجب طاعة هذا الأمر، فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة فننقل الكلام إليه.. وهكذا نمضي إلى غير النهاية.
ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف على أمر الشارع. وهو المطلوب. بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها، لأنا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية. والنتيجة: إن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا.
المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح
بعد ما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال، فقد نسب بعضهم إلى جماعة الإخباريين - على ما يظهر من كلمات بعضهم - إنكار إن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح. فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. والشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة (4) حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم:
1 - إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين. وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني.
2 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه وبين حكم الشرع وهذه هي المسألة الآتية في (المبحث الثالث).
3 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل...
وعليه، فإن أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلأم لا معنى له، لأنه قد تقدم إنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة وهو المعنى الثالث الا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على ما أوضحناه فيما سبق. وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف بإدراك العقل. ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل لهما الا إذا جاز تفكيك الشيء عن نفسه. نعم إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأولين جاز هذا التفكيك ولكنهما ليسا موضع النزاع عندهم. وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الأول.
المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع:
ومعنى الملازمة العقلية هنا - على ما تقدم - إنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلا إن يحكم الشرع على طبقه؟ وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علمنا، وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. وقد قلنا سابقا: إن الإخباريين فسر كلأمهم - في أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة الذي يظهر من كلأم بعضهم - بإنكار هذه الملازمة. وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا وسيأتي توجيه كلأمهم وكلأم الإخباريين. والحق إن الملازمة ثابتة عقلا، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه - أي إنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك - فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع فلا بد إن يحكم الشارع بحكمهم، لأنه منهم بل رئيسهم. فهو بما هو عاقل - بل خالق العقل - كسائر العقلاء لابد إن يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا إنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي رأي الجميع، وهذا خلاف الفرض. وبعد ثبوت ذلك ينبغي إن نبحث هنا عن مسألة أخرى، وهي إنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل كقوله تعالى: { أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ } [آل عمران: 32] فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي أي إنه أمر منه بما هو مولى، أو إنه أمر إرشادي أي إنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل، أي إنه أمر منه بما هو عاقل؟ وبعبارة أخرى إن النزاع هنا في إن مثل هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسيسي، وهذا معنى إنه مولوي أو إنه أمر تأكيدي وهو معنى إنه إرشادي؟ لقد وقع الخلاف في ذلك، والحق إنه للإرشاد حيث يفرض إن حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن واندفاع أرادته للقيام به، فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا، بل يكون عبثا ولغوا، بل هو مستحيل لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. وعليه، فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لا بد إن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا. نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، أو إنه يلزم منه ذلك بل هو عينه (5) ولكن لا يدرك ذلك كل أحد فيمكن الا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوة كل احد إلى الفعل الا للأفذاذ من الناس، فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل وانقياده، فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي، لا إذا استلزم منه محال التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة. بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويا، لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به، نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. توضيح وتعقيب: والحق إن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه، وفقا لحكم العقلاء لأنه من جملتهم، لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر، وإن توهم ذلك بعضهم.
ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنوا الا مسألة واحدة هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعليه، فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح. وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك. ومن العجيب ما عن صاحب الفصول - رحمه الله - من إنكاره للملازمة مع قوله بالتحسين والتقبيح العقليين، وكأنه ظن إن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد - ولو بطريق نظري أو من غير سبب عام من الأسباب المتقدم ذكرها - يدخل في مسألة التحسين والتقبيح، وإن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك. ولكن نحن قلنا: إن قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء وهي بادي رأي الجميع، وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو لم نتطابق عليه الآراء أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء يدخل في هذه المسألة. وقد ذكرنا نحن سابقا: إن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال ونحوهما، وما يدركه لا من سبب عام للجميع – لا يدخل في موضوع مسألتنا. ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا، فنقول: إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا، إذ لا يجب فيها إن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام وإبقاء النوع التي هي - أعني هذه المصالح العمومية - مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعلى هذا، فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه - اعني العقل - لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب إن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، إذ يحتمل إن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل، أو إن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل وإن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع. ولأجل هذا نقول: إنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب إن يحكم به العقل والى هذا يرمي قول أمامنا الصادق عليه السلام: (إن دين الله لا يصاب بالعقل) ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام.
وعلى هذا التقدير، فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والإخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء - فإن إنكارهم في محله وهم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه. ولكن هذا أمر أجنبي عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقلية. وإن كان ما انكروه هي مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم فهم ليسوا على حق فيما انكروا، ولا مستند لهم. وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلأم الإخباريين وصاحب الفصول بما يتفق وما أوضحناه، ولعله لا يأباه بعضهم كلامهم.
______________
(1) هذا التصوير لمذهب الأشاعرة منقول عن شرح القوشجي للتجريد.
(2) كان هذا التعبير يريد إن يحاول قائلوه به دعوى إن الغناء كمال للنفس في سماعه وهو مغالطة وأيهام منهم.
(3) ولا ينافي هذا إن العلم حسن من جهة أخرى وهي جهة كونه كمالا للنفس والجهل قبيح لكونه نقصانا.
(4) سيأتي إن هناك وجها رابعا لحمل كلأمهم عليه بما أولنا به رأي صاحب الفصول الآتي، وهو إنكار إدراك العقل لملاكات الأحكام الشرعية. وهو وجه وجيه سيأتي بيانه وتأييده وبه تحل عقدة النزاع ويقع التصالح بين الطرفين.
(5) الحق كما - صرح بذلك كثير من العلماء المحققين - إن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب ومعنى استحقاق الذم ليس الا استحقاق العقاب، بمعنى إن المراد من المدح ما يعم الثواب لأن المراد بالمدح المجازاة بالخير، والمراد من الذم ما يعم العقاب لأن المراد به المكافأة بالشر. ولذا قالوا: إن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، وأرادوا به هذا المعنى.
 الاكثر قراءة في المباحث العقلية
الاكثر قراءة في المباحث العقلية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











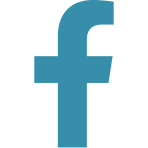

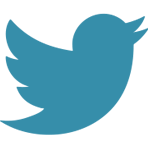

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)