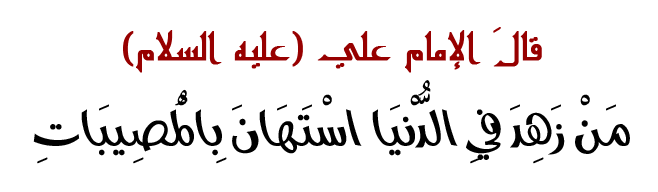
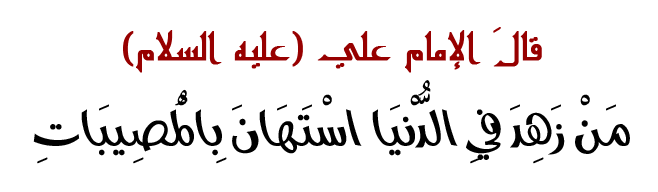

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
التاريخ: 18-8-2016
التاريخ: 18-8-2016
التاريخ: 18-8-2016
|
وقد وقعت معركة للآراء ، ولا محيص للفقيه عن الخوض فيها ; لأنّه يدور عليها رحى الاستنباط في هذه الأعصار .
استدلال النافين لحجّية الخبر الواحد بالكتاب:
فاستدلّ المنكرون بوجوه :
فمن الآيات : قوله تعالى : {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: 36].
ولكن المتدبّر في سياق الآيات يقف على أ نّها راجعة إلى الاُصول الاعتقادية .
ومنها : قوله تعالى : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36] وذيل الآيـة يوجب تعميمها للفروع ; لو لم نقل باختصاصها بها .
ولكن صحّة الاستدلال بها مستلزمة لعدم جواز الاستدلال بها ; وذلك لأ نّه يدلّ على نحو القضية الحقيقية على الزجر عن كلّ اتّباع بغير علم يوجد في الخارج ، مع أنّ الأخذ بظاهر الآية أيضاً اتّباع لغير علم ومصداق له ; لأنّ دلالتها على الردع عن غير العلم ظنّية لا قطعية ، فيلزم من الأخذ بمدلولها عدم جواز اتّباعها ; لكون دلالتها بالفرض ظنّية ، والآية شاملة لنفسها ; لكونها قضية حقيقية .
وربّما يقال : إنّ الآية غير شاملة لنفسها لأجل المحذور الذي ذكر . وبعبارة اُخرى : أنّ الآية مخصّصة عقلاً ; للزوم المحال لولا التخصيص .
أقول : إنّ الاستحالة مندفعة بأحد أمرين : الأوّل ما ذكره القائل من عمومها لكلّ غير علم إلاّ نفسه ، والثاني بتخصيصها بما قام الدليل على حجّيته .
ولا ترجيح ، بل الترجيح للثاني ; لأنّ الآية وردت للزجر عن اتّباع غير العلم ، ولا يتمّ الزجر إلاّ إذا كان ظاهرها حجّة عند المخاطبين ; حتّى يحصل لهم التزجّر عند الزجر ، ولا وجه لخروج ظاهر الآية عن هذا العموم إلاّ كون الظواهر حجّة عند العقلاء ، كسائر الظنون الخاصّة .
وحينئذ : فخروج ظاهر الآية أو مطلق الظواهر دون سائر الظنون تحكّم محض ; لوجود البناء من العقلاء في الموردين .
هذا ، مع أنّ هذه الآية قابلة للتخصيص ، وما لا تقبل له راجعة إلى الاُصول الاعتقادية .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ قد أجاب عن هذا الإشكال بما هذا حاصله : إنّ نسبة الأدلّة الدالّة على حجّية الخبر الواحد إلى الآيات نسبة الحكومة لا التخصيص ; لكي يقال إنّها آبية عنه ; فإنّ تلك الأدلّة تقتضي إلقاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزاً للواقع ; لكون حاله حال العلم في عالم التشريع . هذا في غير السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الواحد .
وأمّا السيرة فيمكن أن يقال : إنّ نسبتها إليها هي الورود ، بل التخصّص ; لأنّ عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظنّ ; لعدم التفاتهم إلى احتمال المخالفة للواقع . فالعمل به خارج بالتخصّص عن العمل بالظنّ .
فلا تصلح الآيات الناهية عن العمل به لأن تكون رادعة عنها ; فإنّه ـ مضافاً إلى خروج العمل به عن موضوع الآيات ـ يلزم منه الدور المحال ; لأنّ الردع عن السيرة بها يتوقّف على أن لا تكون السيرة مخصّصة لعمومها ، وعدم التخصيص يتوقّف على الرادعية .
وإن منعت عن ذلك فلا أقلّ من كون السيرة حاكمة على الآيات ، والمحكوم لا يصلح أن يكون رادعاً للحاكم(1) ، انتهى .
وفيه : أنّ ما هو آب من التخصيص إنّما هي الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ ، وأمّا قوله سبحانه : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء: 36] فقد عرفت أ نّه عامّ للأصول والفروع وقابل للتخصيص .
وأمّا حكومة الأدلّة الدالّة على حجّية الخبر الواحد على الآيات فلا أصل لها ; لأنّ الحكومة تتقوّم باللفظ ، وليس لسان تلك الأدلّة ـ من آياتها وأخبارها ـ لسان الحكومة ، كما لا يخفى .
وأمّا قوله ـ عليه السلام ـ : «العمري ثقة فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ; فإنّـه الثقـة المأمون»(2) فلا يصلح لإثبـات ما رامه ـ قدس سره ـ ; فإنّ مفاده هو وجوب اتّباع قوله لوثاقته ، وأمّا تنزيل ما يقوله منزلة العلم حتّى يكون حاكماً على ما دلّ على الزجر عن اتّباع غير العلم فلا يستفاد منه .
وأمّا السيرة : فالقول بأنّ نسبتها نسبة الورود أو التخصّص فلا يخلو عن ضعف ; لأنّ ذلك فرع كون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملاً بالعلم ، وهو ممنوع جدّاً ; لعدم حصول العلم من أخبار الآحاد ; حتّى لو فرضنا غفلتهم عن احتمال الخلاف فلا يصحّ أيضاً ; لأنّ الورود والتخصّص يدور مدار الخروج الواقعي ، لا على الخروج عند المخاطب ; فإنّ الورود ليس إلاّ خـروج موضوع أحـد الدليلين عن موضوع الدليل الآخـر حقيقـةً بعنايـة التشريع ، كما أنّ التخصّص هو الخروج حقيقةً وتكويناً ، ومع ذلك كلّه فهما يدور على الخروج الواقعي لا عند المخاطب .
والعجب عمّا أفاده أخيراً من حديث حكومة السيرة ; فإنّ السيرة عمل خارجي والحكومة من أوصاف دلالة الدليل اللفظي ، فكيف يصحّ حكومة العمل الخارجي على دليل آخر ، مع أ نّها قائمة بين لساني الدليلين اللفظيين ؟
نعم ، يمكن أن يقال بعدم صلاحية تلك الآيات للردع عن السيرة الدائرة بين العقلاء ; لعدم انتقالهم من التدبّر في هذه الآيات إلى كون الخبر الواحد مصداقاً له ; وإن كان مصداقاً واقعياً له .
نعم ، يمكن تقريب ورود السيرة على الآيات بوجهين :
الأوّل : أنّ المراد من قوله تعالى : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } أي لا تقف ما ليس لك به حجّة ; إذ لو اُريد منه العلم الوجداني ، واُريد منه الزجر عن التمسّك بغير العلم الوجداني لزم تعطيل أكثر الأحكام أو ورود التخصيص الأكثر المستهجن ، وهذا نظير حرمة القول بغير علم أو الإفتاء بغير علم ، وعليه كلّ ما يدلّ على حجّية الخبر الواحد يكون وارداً عليه .
الثاني : أنّ نفس الطريق وإن كان ظنّياً إلاّ أنّ ما يدلّ على حجّيته أمر قطعي ; لأنّ ما يدلّ من ظواهر الآيات على حجّية الخبر الواحد حجّة قطعية عند الخصم ، كسائر الظواهر ، فينسلك اتّباع الخبر الواحد في عداد اتّباع العلم ، فيتمّ ميزان الورود ، فتدبّر .
وأمّا مشكل الدور في رادعية الآيات عن السيرة ففيه ـ مضافاً إلى أ نّه ليس دوراً اصطلاحياً ; فإنّ الدور المصطلح ما يقتضي تقدّم الموقوف على الموقوف عليه ; ضرورة عدم تقدّم الرادعية على عدم المخصّصية ـ أنّ حجّية السيرة يتوقّف على عدم الرادعية ، وعدم الرادعية يتوقّف على عدم مخصّص واصل ، وهو ـ أي العدم ـ حاصل ; إذ لا مخصّص في البين .
وبالجملة : فإنّ الآيات بعمومها تدلّ على الزجر عن اتّباع كلّ ظنّ وما ليس بعلم ، ورادعية هذه الآيات تتوقّف على عدم مخصّص من الشارع ، والمفروض أ نّه لم يصل إلينا مخصّص .
وأمّا السيرة بما هي هي فلا تصلح أن يكون مخصّصة ; إذ لا حجّية للسيرة بلا إمضاء من الشارع ، فالرادع رادع فعلاً ، والسيرة حجّة لو ثبت الإمضاء ، وهو غير ثابت ; لاسيّما مع ورود تلك النواهي .
فإن قلت : إنّ العمل بالخبر الواحد كان سيرة جارية قبل نزول تلك الآيات ، وسكوت الشارع عنه إمضاء لها . وأمّا بعد نزول الآيات فالمقام من صغريات الخاصّ المتقدّم ـ السيرة ـ والعامّ المتأخّر ، فيدور الأمر بين تخصيصها بالسيرة المتقدّمة أو ردعها إيّاها .
وإن شئت قلت : الأمر يدور بين التخصيص والنسخ ، ومع عدم الترجيح يستصحب حجّية السيرة .
قلت : إنّ التمسّك بالاستصحاب من الغرائب ; إذ لم يثبت حجّيته إلاّ بأخبار الآحاد .
أضف إلى ذلك : أنّ السكوت في أوائل البعثة لا يكشف عن رضاه ; فإنّ أوائل البعثة والهجرة لم يكن المفزع والمرجع في أخذ الأحكام إلاّ نفس النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، فلم يكن أكثر الأحكام منقولة بآحاد الرواة حتّى تقع مورد الرضاء والردع .
وأمّا العمل بها في الاُمور العادية والعرفية فلا يجب للشارع تحديد العمل والتصرّف فيها ، بل من الممكن أنّ الآيات نزّلت في أوائل الأمر للردع عن العمل بها في العاديات ; لئلاّ يسري إلى الشرعيات .
استدلال النافين لحجّية الخبر الواحد بالسنّة
فهي مع كثرتها تنقسم إلى أقسام :
منها : ما يدلّ على عدم جـواز العمل بالخبر إلاّ إذا وجـد شاهـد أو شاهـدان مـن كتاب الله أو من قول رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يصدق مضمون الخبر(3) ، وهذا أيضاً مضمون ما دلّ على عدم جواز الأخذ إلاّ بما وافق كتاب الله(4) .
وغير خفي على الخبير : أ نّه إذا وجد شاهد أو شاهدان من الكتاب والسنّة على حكم مطابق لمضمون الخبر فلا حاجة عندئذ على الخبر الوارد في المقام .
فلا مناص حينئذ عن حملها على مورد التعارض والترجيح بموافقة الكتاب والسنّة ، فتقع تلك الطائفة في عداد الأخبار العلاجية ، ويكون من أدلّة حجّية الخبر الواحد في نفسه عند عدم المعارض .
ومنها : ما يدلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب(5) .
والتدبّر في هذه الطائفة يعطي كونها آبية عن التخصيص ، وعليه فلو قلنا بعمومها وشمولها لعامّة أقسام المخالفة ـ من الخصوص المطلق ومن وجه والتباين الكلّي ـ يلزم خلاف الضرورة ; فإنّ الأخبار المقيّدة أو المخصّصة للكتاب قد صدرت من النبي والخلفاء من بعده ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بلا شكّ ، فلابدّ من حملها على المخالف بالتباين الكلّي .
وتوهّم : أنّ الكذب على رسول الله والخلفاء من بعده على وجه التباين الكلّي لا يصدر من خصمائهم ; لظهور بطلان مزعمته ، مدفوع بأنّ الفرية إذا كان على وجه الدسّ في كتب أصحابنا يحصل لهم في هذا الجعل والبهتان كلّ مقاصدهم ; من تضعيف كتب أصحابنا بإدخال المخالف لقول الله ورسوله فيها ; حتّى يشوّهوا سمعة أئمّة الدين بين المسلمين ، وغيرهما من المقاصد الفاسدة التي لا تحصل إلاّ بجعل أكاذيب واضحة البطلان .
ومنها : ما دلّ على طرح غير الموافق(6) ، وهو يرجع إلى المخالف عرفاً .
ثمّ إنّ الاستدلال بهذه الروايات فرع كونها متواترة الوصول إلينا في تمام الطبقات ، فثبوت التواتر في بعض الطبقات لا يفيد .
ولكن التواتر على هذا الوصف غير ثابتة ; فإنّ عامّة الروايات منقولة عن عدّة كتب لم نقطع بعدم وقوع النسيان والاشتباه فيها .
ثمّ لو سلّم كونها متواترة الوصول من قرون الصادقين إلى عصر أصحاب الكتب فلا محالة يصير التواتر إجمالياً .
وعليه : لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن ; وهو الأخصّ من الجميع ، والمتيقّن من المخالفة ليس إلاّ التباين الكلّي أو العموم من وجه ـ على تأمّل ـ وأمّا المخالفة على النحو العموم المطلق فليست مخالفة في محيط التقنين ، على ما عرفت من صدور الأخبار المخصّصة والمقيّدة عنهم ـ عليهم السلام ـ بالضرورة ، فكيف يحمل عليها هذه الروايات ؟
حول استدلال القائلين بحجّية الخبر الواحد:
استدلّ المثبتون بوجوه من الآيات والأخبار والإجماع وغيرهما :
الاستدلال بآية النبأ:
أمّا الآيات : فمنها قوله تعالى في سورة الحجرات : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } [الحجرات: 6]
والعمدة في الاستدلال به هو مفهوم الشرط ، ودفع كون الشرط محقّقاً للموضوع ، وقد قيل في تقريبه وجوه :
منها : ما عن المحقّق الخراساني أنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفائه عند انتفائه ، وعلى ذلك لا يكون الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع(7) . ولا يخفى : أنّه مخالف لظاهر الآية .
ومنها : ما عن بعض محقّقي العصر من أنّ الظاهر أنّ الشرط هو المجيء مع متعلّقه ـ أي مجيء الفاسق ـ فيكون الموضوع نفس النبأ ولمفهومه مصداقان : عدم مجيء الفاسق ، ومجيء العادل ، فلا يكون الشرط محقّقاً للموضوع .
وأمّا إذا جعل الشرط نفس المجيء يكون الموضوع نبأ الفاسق ، فيصير الشرط محقّقاً للموضوع(8) .
وفيه : أنّ الظاهر بقاء الإشكال على حاله ; فإنّ مفهوم قولك : «إن جاءك الفاسق بنبأ» أنّه إذا لم يجئك الفاسق بنبأ ، وأمّا مجيء العادل مكانه فليس مذكوراً في المنطوق حتّى يعلم حكمه من المفهوم .
أضف إليه : أنّ تعدّد المصداق للمفهوم لا يتوقّف على ما ذكره من كون الشرط هو مجيء الفاسق ، بل يتمّ لو كان الشرط هو المجيء والموضوع هو نبأ الفاسق ، فلانتفائه في الخارج مصداقان : عدم مجيء النبأ أصلاً ومجيء العادل بالنبأ . ومع ذلك كلّه : فالمرجع هو العرف ، وهو لا يساعده .
ويمكن تقريب المقام بوجه آخر ; وهو أنّه لا فرق في شمول العامّ لأفراده بين كونها الأفراد الذاتية أو العرضية إذا كانت القضية شاملة لها على وجه الحقيقية ، فكما أنّ الأبيض صادق على نفس البياض لو فرض قيامه بذاته ، كذلك صادق على الجسم المعروض له ، مع أنّ صدقه عليه تبعي لدى العقل الدقيق ، لكنّه حقيقية لدى العرف .
وعليه : فلعدم مجيء الفاسق بالخبر فردان : عدم المجيء بالنبأ أصلاً ـ لا من الفاسق ولا من العادل ـ ومجيء العادل بالخبر . والأوّل فرد ذاتي له والآخر عرضي ، فيشمل العامّ لهما .
فمفهوم الآية : إن لم يجئ الفاسق بالخبر لا يجب التبيّن ; سواء جاء به العادل ; وهو الفرد العرضي أو لم يجئ أصلاً ; وهو الفرد الذاتي ، والعامّ يشملهما معاً .
أضف إلى ذلك : أنّ القضايا السالبة ظاهرة في سلب شيء عن شيء مع وجود الموضوع ، لا في السلب باعتبار عدم الموضوع . ولو حمل المفهوم على المصداق الذاتي ـ وهو عدم الإتيان بالخبر أصلاً ـ تصير السالبة صادقة باعتبار عدم الموضوع ، ولو حمل على إتيان العادل بالخبر تصير من السوالب المنتفي محمولها مع وجود الموضوع ، وهو أولى .
وفيه : أنّ الأمر في المثال والممثّل متعاكس ; وهو أنّ البياض مصداق للأبيض عند العقل دون العرف ، ولكن عدم إتيان الفاسق بالنبأ مصداق ذاتي للمفهوم عند العقل والعرف ، وأمّا مجيء العادل بالخبر فليس من مصاديق ذلك المفهوم عندهم ; وإن فرض أنّ أحد الضدّين ينطبق عليه عدم الضدّ الآخر ، ويكون مصدوقاً عليه لا مصداقاً حسب ما اصطلحه بعض الأكابر(9) ، لكنّه أمر خارج عن المتفاهم العرفي الذي هو المرجع في الباب .
وأمّا ما ذكر من ظهور القضايا السالبة في سلب المحمول فإنّه يصحّ لو كانت القضية لفظية ، لا مفهوماً من قضية منطوقة بالدلالة العقلية . على أنّه لو فرض صبّ هذا المفهوم في قالب اللفظ لما فهم منه أيضاً إلاّ كون الشرط محقّقاً للموضوع ، وانتفاء التبيّن باعتبار انتفاء موضوعه .
ثمّ إنّه لو فرض المفهوم للآية فلا دلالة فيه على حجّية قول العادل وكونه تمام الموضوع للحجّية; لأنّ جزاء الشرط ليس هو التبيّن ; فإنّ التبيّن إنّما هو بمعنى طلب بيان الحال ، وهو غير مترتّب على مجيء الفاسق بنبأ ; لا عقلاً ولا عرفاً ، والجزاء لابدّ أن يكون مترتّباً على الشرط ; ترتّب المعلول على العلّة أو نحوه .
فلابدّ من تقدير الجزاء بأن يقال : إن جاءكم فاسق بنبأ فأعرضوا عنه أو لا تقبلوه وأشباههما ، وإنّما حذف لقيامه مقامه .
وحينئذ : يصير المفهوم على الفرض : إن جاءكم عادل بنبأ فلا تعرضوا عنه واعتنوا به ، وهو أعمّ من كونه تمام الموضوع أو بعضه . ولعلّ للعمل به شرائط اُخر كضمّ آخر إليه أو حصول الظنّ بالواقع ونحوهما .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ قد أفاد في تقريب الآية ما هذا حاصله : يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ والشرط هو مجيء الفاسق به من مورد النزول ; فإنّ مورده إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق ، فقد اجتمع في إخباره عنوانان : كونه خبراً واحداً ، وكون المخبر فاسقاً ، والآية وردت لإفادة كبرى كلّية ليتميّز الإخبار التي يجب التبيّن عنها عن غيرها .
وقد علّق وجوب التبيّن فيها على كون المخبر فاسقاً ، فيكون هو الشرط ، لا كون الخبر واحداً . ولو كان الشرط ذلك لعلّق عليه ; ل أنّه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق . فعدم التعرّض لخبر الواحد وجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبيّن في خبر غير الفاسق .
ولا يتوهّم : أنّ ذلك يرجع إلى تنقيح المناط أو إلى دلالة الإيماء ; فإنّ ما بيّناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط .
وبالجملة : لا إشكال في أنّ الآية تكون بمنزلة الكبرى الكلّية ، ولابدّ أن يكون مورد النزول من صغرياتها ، وإلاّ يلزم خروج المورد عن العامّ ، وهو قبيح . فلابدّ من أخذ المورد مفروض التحقّق في موضوع القضية ، فيكون مفاد الآية بعد ضمّ المورد إليها : أنّ الخبر الواحد إن كان الجائي به فاسقاً فتبيّنوا ، فتصير ذات مفهوم(10) ، انتهى .
وفيه مواقع من النظر :
منها : أنّ كون مورد النزول هو إخبار وليد الفاسق لا يصحّح كون الموضوع هو النبأ ، وأنّ الشرط هو مجيء الفاسق ، و أنّه غير مسوق لتحقّق الموضوع ; إذ غاية ما يمكن أن يقال : إنّه مسوق لإعطاء القاعدة الكلّية في مورد الفاسق ، وأمّا بيان الضابطة لمطلق الخبر وظهورها في إفادة الكبرى الكلّية ليتميّز الإخبار التي يجب التبيّن عنها عن غيرها فلا يستفاد منها .
ومنها : أنّ ما أفاده من أنّه اجتمع في إخباره عنوانان : كونه خبر الواحد ، وكون المخبر فاسقاً بيان لمفهوم الوصف دون الشرط ، الذي هو بصدد بيانه ; ضرورة أنّه لم يعلّق وجوب التبيّن في الآية على كون المخبر فاسقاً حتّى يصحّ ما ادّعاه من كون الموضوع هو النبأ والشرط كون المخبر فاسقاً ، بل علّق على مجيء الفاسق بالخبر ، ومن المعلوم أنّ الشرط حينئذ محقّق للموضوع ، ولا مفهوم له .
وأمّا التمسّك بمفهوم الوصف : فمع أنّه خارج عن محلّ الكلام غير صحيح ; لبناء المفهوم على استفادة الانحصار من القيود ، وهي في جانب الوصف بعيد .
على أنّه يمكن أن يكون ذكر الوصف ـ الفاسق ـ قد سيق لغرض آخر غير المفهوم ; وهو التنبيه على فسق الوليد ، فكون مورد النزول إخبار الوليد مانع عن دلالة الآية على المفهوم ، لا موجبٌ له ، كما أفاد وأمّا ما أفاده من تأييد كون الآية بمنزلة الكلّية ـ من أنّ المورد مـن صغرياتها وإلاّ يلزم إخراج المورد ـ فلا يخلو عن خلط ; فإنّ كون المورد من صغرياتها لا يستلزم كونها بصدد إعطاء الضابطـة في مطلق الخبر ، بل يصحّ لـو كانت بصدد إعطاء القاعدة لخبر الفاسق ، ويصير المورد من مواردها ، من غير إخراج المورد ، ولا ثبوت مفهوم .
جولة في الإشكالات المختصّة بآية النبأ وأجوبتها:
منها : أنّ المفهوم على تقدير ثبوته معارض لعموم التعليل في ذيل الآية ; فإنّ الجهالة هي عدم العلم بالواقع ، وهو مشترك بين إخبار الفاسق والعادل ، فالتعليل بظاهره يقتضي التبيّن عن كلا القسمين ، فيقع التعارض بينهما ، والتعليل أقوى في مفاده ; خصوصاً في مثل هذا التعليل الآبي عن التخصيص ، فعموم التعليل لأقوائيته يمنع ظهور القضية في المفهوم ، فلا يصل النوبة إلى ملاحظة النسبة ; فإنّها فرع المفهوم(11) .
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر ـ قدس سره : أنّ الإنصاف أنّه لا وقع له :
أمّا أوّلاً : فلأنّ الجهالة بمعنى السفاهة والركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه ، ولا شبهة في جواز الركون إلى خبر العادل دون الفاسق ، فخبر العادل خارج عن العلّة موضوعاً .
وأمّا ثانياً : فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع يكون المفهوم حاكماً على عموم التعليل ; لأنّ أقصى ما يدلّ عليه التعليل هو عدم جواز العمل بما وراء العلم ، والمفهوم يقتضي إلغاء احتمال الخلاف ، وجعل خبر العادل محرزاً للواقع وعلماً في مقام التشريع ، فلا يعقل أن يقع التعارض بينهما ; لأنّ المحكوم لا يعارض الحاكم ; ولو كان ظهوره أقوى ; لأنّ الحاكم متعرّض لعقد وضع المحكوم إمّا بالتوسعة أو التضييق .
فإن قلت : إنّ ذلك فرع ثبوت المفهوم ، والمدّعى : أنّ عموم التعليل مانع عن ظهور القضية فيه.
قلت : المانع منه ليس إلاّ توهّم المعارضة بينهما ، وإلاّ فظهورها الأوّلي فيه ممّا لا سبيل لإنكاره ، وقد عرفت عدم المعارضة بينهما ; لأنّ المفهوم لا يقتضي تخصيص العموم ، بل هو على حاله من العموم ، بل إنّما يقتضي خروج خبر العادل عن موضوع القضية ، لا عن حكمها.
فلا معارضـة بينهما أصلاً ; لعدم تكفّل العامّ لبيان موضوعـه وضعـاً ورفعاً ، بل هـو متكفّل لحكم الموضوع على فرض وجـوده ، والمفهوم يمنع عـن وجوده(12) ، انتهى .
وفيه أمّا أوّلاً : فلأنّ التعليل مانع عن المفهوم في المقام بلا إشكال ، لا لما ذكره المستشكل من أقوائية التعليل ، بل السرّ : ما وافاك(13) من أنّ دلالة الشرطية على المفهوم واستفادة ذلك من تلك القضية مبنية على ظهور الشرط في القضية في كونه علّة منحصرة ; بحيث ينتفي الحكم بانتفائه ، وأمّا إذا صرّح المتكلّم بالعلّة الحقيقية ، وكان التعليل أعمّ من الشرط أو كان غير الشرط فلا معنى لاستفادة العلّية ; فضلاً عن انحصارها .
فلو قال : «إن جاءك زيد فأكرمه» ثمّ صرّح أنّ العلّة إنّما هو علمه فنستكشف أنّ المجيء ليس علّة ولا جزء منها ، وهذا واضح جدّاً . وهو أيضاً من الإشكالات التي لا يمكن الذبّ عنه ، وقد غفل عنه الأعلام ، وعليه فلا وقع لما أفادوه في دفعه .
وثانياً : أنّ جعل الجهالة بمعنى السفاهة أو ما لا ينبغي الركون إليه كما أوضحه ـ تبعاً للشيخ الأعظم(14) ـ غير وجيه ، بل المراد منها عدم العلم بالواقع .
ويدلّ عليه جعلها مقابلاً للتبيّن ; بمعنى تحصيل العلم وإحراز الواقع ، ومعلوم أنّ الجهالة بهذا المعنى مشترك بين خبري العادل والفاسق .
بل لا يبعد أن يقال : إنّ الآية ليست بصدد بيان أنّ خبر الفاسق لا يعتنى به ; لأنّ مناسبات صدرها وذيلها وتعليلها موجبة لظهورها في أنّ النبأ الذي له خطر عظيم وترتيب الأثر عليه موجب لمفاسد عظيمة والندامة ـ كإصابة قوم ومقاتلتهم ـ لابدّ من تبيّنه والعلم بمفاده ، ولا يجوز الإقدام على طبقه بلا تحصيل العلم ; لاسيّما إذا جاء به فاسق .
فحينئذ : لابدّ من إبقاء ظاهر الآية على حاله ; فإنّ الظاهر من التبيين طلب الوضوح وتحقيق صدق الخبر وكذبه ، كما أنّ المراد من الجهالة ضدّ التبيين ; أعني عدم العلم بالواقع لا السفاهة; ولو فرض أنّها إحدى معانيها ، مع إمكان منعه ; لعدم ذكرها في جملة معانيها في المعاجم ومصادر اللغة .
ويمكن أن يكون إطلاقها ـ كما في بعض كتب اللغة(15) ـ لكونها نحو جهالة ; فإنّ السفيه جاهل بعواقب الاُمور ، لا أنّها بعنوانها معناها .
ثمّ إنّه على ما ذكرناه في معنى الآية لا تلزم فيها التخصيصات الكثيرة ، على فرض حملها على العلم الوجداني ـ كما قيل بلزومها(16) ـ فتدبّر جيّداً .
وثالثاً : أنّ جعل المفهوم حاكماً على عمومه ـ مضافاً إلى عدم خلوّه من شبهة الدور ; فإنّ انعقاد ظهور القضية في المفهوم فرع كونه حاكماً على عموم التعليل ، وكون المفهوم حاكماً يتوقّف على وجوده ـ أنّ الحكومة أمر قائم بلسان الدليل ، ومعلوم أنّ غاية ما يستفاد من المفهوم هو جواز العمل بخبر العادل أو وجوبه ، وأمّا كونه بمنزلة العلم و أنّه محرز الواقع و أنّه علم في عالم التشريع فلا يدلّ عليه المفهوم .
نعم ، لو ادّعي أنّ مفهوم قوله : (إِنْ جَاءَكُمْ فاسِقٌ . . .) إلى آخره هو عدم وجوب التبيّن في خبر العادل ـ لكونه متبيّناً في عالم التشريع ـ لكان للحكومة وجه ، لكنّه غير متفاهم عرفاً .
ومن الإشكالات المختصّة : لزوم خروج المورد عن المفهوم ; فإنّه من الموضوعات الخارجية، وهي لا تثبت إلاّ بالبيّنة ، فلابدّ من رفع اليد عن المفهوم لئلاّ يلزم التخصيص البشيع(17) .
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ : بأنّ المورد داخل في عموم المنطوق ، وهـو غير مخصّص ; فإنّ خبـر الفاسق لا اعتبار بـه مطلقاً ـ لا في الموضوعات ولا في الأحكام ـ وأمّا المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود ; ل أنّه لم يرد في مورد إخبار العادل بالارتداد ، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية ، فلا مانع مـن تخصيصه . ولا فرق بين المفهوم والعام الابتدائي ; سوى أنّ المفهوم كان ممّا تقتضيه خصوصية في المنطوق ، ولا ملازمة بين المفهوم والمنطوق من حيث المورد ، بل القدر اللازم هو أن يكون الموضوع في المنطوق والمفهوم واحداً(18) ، انتهى .
وفيه : أنّ مبنى استفادة المفهوم من الآية هو القول بأنّ علّة التشنيع والاعتراض في العمل بقول الفاسق إنّما هو كون المخبر فاسقاً ; بحيث لولا فسقه أو كون المخبر غيره من العدول لما توجّه لوم ولا اعتراض .
مع أنّ الأمر على خلافه في المورد ; إذ لو كان الوليد غير فاسق أو كان المخبر غيره من العدول لتوجّه اللوم أيضاً على العاملين ; حيث اعتمدوا على قول العادل الواحد في الموضوعات ، مع عدم كفايته في المقام .
وبذلك يظهر : أنّ التخصيص في المفهوم بشيع ، فلابدّ من رفع اليد عن المفهوم والالتزام بأنّ الآية سيقت لبيان المنطوق دون المفهوم .
وبذلك يظهر : النظر فيما أفاده الشيخ الأعظم ـ قدس سره ـ ، فراجعه(19) .
حول إشكالات لا يختصّ بآية النبأ وأجوبتها
منها : أنّ النسبة بين الأدلّة الدالّة على حجّية قول العادل وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظنّ وما وراء العلم عموم من وجه ، والمرجع بعد التعارض إلى أصالة عدم الحجّية .
ولكن عرفت : أنّ من الآيات ما يختصّ بالاُصول الاعتقادية ، ولسانها آب من التخصيص ـ ولو كانت النسبة عموماً وخصوصاً مطلقاً ـ ومنها ما هو قابل للتخصيص ; لعموميتها للاُصول والفروع ، مثل قوله تعالى : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]
والنسبة بينه وبين أدلّة الباب هو العموم والخصوص المطلق ، فيخصّص عمومها أو يقيّد إطلاقها ، كما مرّ(20) .
وأجاب بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ بأنّ أدلّة الحجّية حاكمة على الآيات الناهية ; لأنّ أدلّة الحجّية تقتضي خروج العمل بخبر العادل عن كونه عملاً بالظنّ .
ثمّ قال : ولو لم نسلّم الحكومة فالنسبة بين أدلّة الباب مع الآيات الناهية هو العموم والخصوص المطلق ، والصناعة يقتضي تخصيص عمومها بما عدا خبر العادل(21) .
وقد عرفت الإشكال في حكومة أدلّة الحجّية ; لأنّ الحكومة قائمة باللسان ، وليس هنا ما يتكفّل تنزيل الخبر الواحد منزلة العلم(22) .
وأمّا ما أفاده من التخصيص ففيه : أنّه لو كان لسان العامّ آبياً عن التخصيص يقع المعارضة بينه وبين الخاصّ ، ولا يجري صناعة التخصيص في هذا المقام أصلاً ، والجواب ما عرفت .
ومنها : أنّ حجّية خبر الواحد تستلزم عدم حجّيته ; إذ لو كان حجّة لكان يعمّ قول السيّد وإخباره عن تحقّق الإجماع على عدم حجّيته(23) ، فيلزم من حجّية الخبر عدم حجّيته ، وهو باطل بالضرورة(24) .
وفيه ـ بعد الغضّ عن أنّه إجماع منقول وأدلّة حجّيته لا تشمله ، وعن أنّ الاستحالة إنّما هو ناش من إطلاق دليل الحجّية وشموله لخبر السيّد لا عن أصل الحجّية ـ أنّ الأمر دائر بين إبقاء عامّة الأفراد وإخراج قوله بالتخصيص أو العكس .
ولا يخفى أنّ الأوّل متعيّن ; إذ ـ مضافاً إلى بشاعة التخصيص الكثير المستهجن ـ أنّ التعبير عن عدم حجّية الخبر الواحد بلفظ يدلّ على حجّية عامّة أفراده ، ثمّ إخراج ما عدا الفرد الواحد الذي يؤول إلى القول بعدم الحجّية قبيح لا يصدر من الحكيم .
وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني : أنّ من الجائز أن يكون خبر العادل حجّة في زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيّد ، وبعده يكون هذا الخبر حجّة فقط ، فيكون شمول العامّ لخبر السيّد مفيداً لانتهاء الحكم في هذا الزمان ، وليس هذا بمستهجن(25) .
فيرد عليه : أنّ الإجماع المحكي بقول السيّد يدلّ على عدم حجّية قول العادل من أوّل البعثة ; إذ هو يحكي عن حكم إلهي عامّ لكلّ الأفراد في عامّة الأعصار والأدوار ، فلو كان قوله داخلاً تحت العموم لكشف عن عدم حجّية الخبر الواحد من زمن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، وأنّ عمل الناس عليه واستفادتهم حجّيتها بظاهر الآية إنّما هو لأجل جهلهم بالحكم الواقعي . وعلى ذلك فلا معنى لما أفاده من انتهاء زمن الحجّية .
ومن ذلك يظهر : أنّ ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ قدس سره ـ من أنّ بشاعة الكلام على تقدير شموله لخبر السيّد ليست من جهة خروج تمام الأفراد سوى فرد واحد حتّى يدفع بما أفاده ـ أي المحقّق الخراساني ـ بل من جهة التعبير بالحجّية في مقام إرادة عدمها ، وهذا لا يدفع بما أفاده(26) .
لا يخلو عن نظر ; لما عرفت من أنّ البشاعة الاُولى لا تندفع بما أفاده أيضاً ; لما عرفت أنّ مفاد الإجماع حكم إلهي كاشف عن عدم الحجّية من زمن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، فيكون تمام الأفراد خارجاً سوى فرد واحد .
ولو أغمضنا عمّا ذكرناه ، وسلّمنا أنّ شمول الأدلّة لخبر السيّد يدلّ على انتهاء أمد الحكم بعد شموله لهذه الأفراد طول مدّة قرون ، فالبشاعة الثانية مندفعة بما في كلام المحقّق الخراساني ; إذ لا مانع من شمول الإطلاق لفرد من الأفراد يفيد انتهاء أمد الحكم ، ويعلن بعدم حجّية قول العادل الواحد بعد هذا الإعلان والإخبار ، ولا إشكال فيه .
وأجاب بعض محقّقي العصر ـ قدس سره ـ عن الإشكال بما هذا حاصله : إنّ شمول إطلاق أدلّة الباب لمثل خبر السيّد الحاكي عن عدم الحجّية ممتنع ; لاستلزامه شمول الإطلاق لمرتبة الشكّ بمضمون نفسه ; لأنّ التعبّد بإخبار السيّد بعدم الحجّية إنّما كان في ظرف الشكّ في الحجّية واللاحجّية ، وهو عين الشكّ في مضمون أدلّة الحجّية التي منها المفهوم ، وإطلاقه لمثل هذه المراتب المتأخّرة غير ممكن(27) .
وفيه : أنّه مبني على امتناع شمول إطلاق الجعل للحالات المتأخّرة عنه ـ كالشكّ ونحوه ـ وقد عرفت بطلانه وأنّ إطلاق الحكم يشمل لبعض الحالات المتأخّرة من الشكّ والعلم .
وبالجملة : أنّ الآية وسائر الأدلّة وردت رافعة لعامّة الشكوك ، والشكّ في حجّية قول العادل وعدمها أمر ينقدح في ذهن الإنسان ; سواء جعل الحجّية له أو لا ، وسواء وقف عليها أو لا .
وحينئذ : فلو غضّ عن سائر الإشكالات فلا مانع لو قلنا بأنّ إطلاق الأدلّة شامل لقول السيّد ; حتّى يكون قول السيّد رافعة للشكّ ; إذ هو نبأ والحكم معلّق على مطلق النبأ ; ولكن بشرطين : أحدهما : عدم الإجماع على الفرق بين النبائين : نبأ السيّد وسائر الأنباء .
ثانيهما : عدم كون إجماع السيّد ناظراً إلى عدم الحجّية من أوّل البعثة.
وعند ذلك ; جاز الأخذ بالمفهوم وإدخال قول السيّد تحته ، فتكون النتيجة حجّية أخبار الآحاد من عصر الرسول إلى زمن السيّد ، وانتهاء أمد الحجّية في زمانه ، كما أفاده المحقّق الخراساني .
وربّما يجاب : بأنّ الأمر دائر بين التخصيص والتخصّص ; لأنّ شمول الآية لسائر الأخبار يجعلها مقطوع الحجّية ، فيعلم بكذب خبر السيّد . وأمّا شمولها لخبر السيّد وإخراج غيره يكون من قبيل التخصيص ; لعدم العلم بكذب مؤدّياتها ; ولو مع العلم بحجّية خبر السيّد ; لأنّ مؤدّياتها غير الحجّية واللاحجّية(28) .
وفيه أوّلاً : أنّ مفاد أدلّة الباب ليس هو الحجّية ، وإنّما لسانها ومفادها وجوب العمل ، وينتزع الحجّية من الوجوب الطريقي ، كما أنّ إجماع السيّد ليس مضمونه عدم الحجّية ، بل مفاده حرمة العمل بالأخبار ، وينتزع من الحرمة عدم الحجّية ; وذلك لأنّ الحجّية واللاحجّية ليستا من الاُمور القابلة للجعل .
فإجماع السيّد أيضاً يرجع إلى الإجماع على حرمة العمل المنتزع منها عدم الحجّية . وعليه يدور الأمر بين التخصيصين .
وثانياً : أنّ مضمون الآية لو كان جعل الحجّية للأخبار فلا إشكال في عدم شموله لما قطع بعدم حجّيته أو قطعت حجّيته . فحينئذ لو شملت الآية لخبر السيّد يصير خبره مقطوع الحجّية وخبر غيره مقطوع عدم الحجّية ـ وإن لم يكن مقطوع المخالفة للواقع ـ فيصير حال غيره كحاله في خروجه تخصّصاً ، فتدبّر .
إشكال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة:
والمهمّ هنا إشكال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة ; وقد قرّره الشيخ الأعظم بوجوه(29) ، ضرب على بعضها القلم في بعض النسخ ، وفصّلها وأوضحها بعض أعاظم العصر بوجوه خمسة(30) ، ونحن نذكر ما هو المهمّ .
وبما أنّ بعض تلك الوجوه ليس تقريراً لإشكال واحد ـ وإن كانت عامّة الوجوه راجعة إلى الإخبار بالواسطة ـ فلا جرم نفصّلها بما يلي :
الأوّل : انصراف الأدلّة عن الإخبار بالواسطة إذا كانت الوسائط كثيرة ـ كما في الأخبار الواصلة إلينا من مشائخنا ـ فإنّ الواسطة بيننا وبين المعصومين كثيرة جدّاً ، ومثل هذه الأخبار بعيد عن مصبّ الأدلّة اللفظية . وأمّا اللبّي منها ، كبناء العقلاء ـ الذي هو الدليل الوحيد عندنا ـ فلم يحرز بناء منهم في هذه الصورة .
ولم يكن الإخبار بالوسائط الكثيرة بمرأى ومسمع من الشارع حتّى نكشف من سكوته رضاه .
ولكنّه مدفوع بمنع الانصراف بالنسبة إلى الأخبار الدارجة بيننا ; فإنّه إنّما يصحّ لو كانت الوسائط كثيرة ; بحيث أسقطه كثرة الوسائط عن الاعتبار ، وأمّا الأخبار الدائرة بيننا فصدورها عن مؤلّفيها إمّا متواترة كالكتب الأربعة أو مستفيضة ، ولا نحتاج في إثبات صدورها عن هؤلاء الأعلام إلى أدلّة الحجّية .
وأمّا الوسائط بينهم وبين أئمّة الدين فليست على حدّ يخرجه عن الاعتبار أو يوجب انصراف الأدلّة .
وأمّا اللبّي من الأدلّة فلا وجه للتردّد في شموله لما نحن فيه ; ضرورة أنّ العقلاء يحتجّون بما وصل إليهم بوسائط كثيرة أكثر ممّا هو الموجود في أخبارنا ، فكيف بتلك الوسائط القليلة ؟
الثاني : أنّ الأدلّة منصرفة عن المصداق التعبّدي للخبر الذي اُحرز بدليل الحجّية ; فإنّ من نسمع كلامه ونشافهه فإخباره أمر وجداني لنا ، وأمّا من يحكى عنهم من الوسائط ، إلى أن يصل إلى أئمّة الدين فكلّها أخبار تعبّدية محرزة بدليل الحجّية .
ويدفعه : أنّ العرف لا يفرّق بين فاقد الواسطة وواجدها ; بحيث لو قلنا بقصور الإطلاق لحكم العرف بشمول مناط الحجّية لعامّة الأقسام بإلغاء الخصوصية أو بتنقيح المناط .
الثالث : أنّ حجّية الخبر الواصل إلينا بالوسائط تستلزم إثبات الحكم لموضوعه ; فإنّ الشيخ إذا أخبر عن المفيد ، وهو عن الصدوق فالمصداق الوجداني لنا هو قول الشيخ ، فيجب تصديقه ، وأمّا قول المفيد إلى أن ينتهي إلى الإمام فإنّما يصير مصداقاً لموضوع قولنا : «صدّق العادل» بعد تصديق الشيخ ـ قدس سره ـ ، فيلزم إثبات الموضوع بالحكم ، وهو محال .
واُجيب عنه تارة : بأنّ أدلّة الحجّية من قبيل القضايا الحقيقية الشاملة للموضوعات المحقّقة والمقدّرة ، فلا مانع من تحقّق الموضوع بها وشمولها لنفسها ، فيشمل قولنا «صدّق العادل» للموضوع المنكشف لنا إثباتاً بنفس التصديق ، كشمول قول القائل : «كلّ خبري صادق» لنفسه.
واُخرى : بانحلال قولنا «صدّق العادل» إلى قضايا كثيرة ; فإنّ الذي لا يعقل إنّما هو إثبات الحكم موضوع شخصه ، لا إثبات موضوع لحكم آخر ; فإنّ خبر الشيخ المحرز بالوجدان يجب تصديقه ، وبتصديقه يحصل لنا موضوع آخر ; وهو خبر المفيد ، وله وجوب تصديق آخر ، وهكذا . فكلّ حكم متقدّم ـ وجوب التصديق ـ يثبت موضوعاً مستقلاًّ لحكم آخر(31) .
الرابع : أنّه يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه ، من دون أن يكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه .
وإن شئت قلت : يلزم كون الحكم ناظراً إلى نفسه ; فإنّ وجوب التصديق الذي يتعلّق بالخبر مع الواسطة إنّما يكون بلحاظ الأثر الذي هو وجوب التصديق .
وتوضيحه : أنّ وجوب التعبّد بالشيء لابدّ وأن يكون بلحاظ ما يترتّب على الشيء من الآثار الشرعية ; فلو فرضنا خلوّ الموضوع عن الأثر الشرعي لما صحّ إيجاب التعبّد الشرعي به . فلزوم التعبّد بعدالة زيد التي قامت البيّنة على اتّصافه بها لأجل كونها ذات آثار ; من جواز الصلاة خلفه ، وإيقاع الطلاق عنده .
وعلى ذلك : فلو كان الراوي حاكياً قول الإمام فوجوب التصديق بلحاظ ما يترتّب على قول الإمام من الآثار ، كحرمة الشيء ووجوبه ; ولو كان المحكي قول غيره ، كحكاية الشيخ قول المفيد فالأثر المترتّب على قول المفيد ليس إلاّ وجوب تصديقه ، وحينئذ يجب تصديق الشيخ فيما يحكيه لأجل كون محكيه ـ قول المفيد ـ ذا أثر شرعي ; وهو وجوب التصديق ، ولا يعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه .
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر ـ قدس سره ـ : بأنّ المجعول عندنا في باب الأمارات نفس الكاشفية والوسطية في الإثبات ; لأنّ المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية إلى ما تؤدّي إليه ـ أيّ شيء كان المؤدّى ـ فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد ، وهو إلى قول الصدوق ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول الإمام ـ عليه السلام ـ . ولا نحتاج في جعل الطريق إلى أن يكون في نفس المؤدّى أثر شرعي ، بل يكفي الانتهاء إلى الأثر ، كما في المقام(32) .
وفيه : أنّ الإشكال غير مندفع أيضاً ـ حتّى على القول بجعل الطريقية ـ فإنّ محصّل الإشكال لزوم كون الدليل ناظراً إلى نفسه ، وكون دليل الجعل باعتبار الأثر الذي هو نفسه ، وهو وارد على مبناه أيضاً ; فإنّ خبر الشيخ المحرز بالوجدان طريق إلى خبر المفيد وكاشف عنه بدليل الاعتبار ، وهو كاشف عن خبر الصدوق بدليل الاعتبار أيضاً ، وهكذا . فدليل جعل الكاشفية ناظر إلى جعل كاشفية نفسه ، ويكون جعل الكاشفية بلحاظ جعل الكاشفية ، وهو محال .
وبعبارة اُخرى : أنّ الحاكم لابدّ له من لحاظ موضوع حكمه حين الحكم والموضوع لمّا لم يثبت إلاّ بهذا الحكم فلابدّ أن يكون دليل الجعل ناظراً إلى نفسه باعتبار ما عدا الخبر الذي في آخر السلسلة ، ولابدّ في الذبّ عنه ببعض الوجوه المتقدّمة أو الآتية .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر قرّر الإشكال المتقدّم بتقرير آخر ، وجعله خامس الوجوه ; حيث قال: ويمكن تقرير الإشكال بوجه آخر ، لعلّه يأتي حتّى بناءً على المختار وهو : أنّه لو عمّ دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة يلزم أن يكون الدليل حاكماً على نفسه ويتّحد الحاكم والمحكوم ; لأنّ أدلّة الاُصول والأمارات حاكمة على الأدلّة الأوّلية الواردة للأحكام الواقعية . ومعنى حكومتها هو أنّها مثبتة لتلك الأحكام . وفيما نحن فيه يكون الحكم الواقعي هو وجوب التصديق ، واُريد إثباته بدليل وجـوب التصديق ، فيكون دليل وجـوب التصديق حاكماً على نفسه ; أي مثبتاً لنفسه.
ونظير هذا الإشكال يأتي في الأصل السببي والمسبّبي ; فإنّ لازمه حكومة دليل لا تنقض على نفسه(33) .
والتحقيق في الجواب : أنّ دليل الاعتبار قضية حقيقية ينحلّ إلى قضايا ، فدليل التعبّد ينحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد آحاد السلسلة ، ويكون لكلّ منها أثر يخصّه غير الأثر المترتّب على الآخر ، فلا يلزم اتّحاد الحاكم والمحكوم ، بل يكون كلّ قضية حاكمة على غيرها .
فإنّ المخبر به بخبر الصفّار الحاكي لقول العسكري ـ عليه السلام ـ في مبدأ السلسلة لمّا
كان حكماً شرعياً من وجوب الشيء أو حرمته وجب تصديق الصفّار في إخباره عن العسكري بمقتضى أدلّة خبر الواحد ، والصدوق الحاكي لقول الصفّار حكى موضوعاً ذا أثر شرعي ، فيعمّه دليل الاعتبار ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان .
فلأجل الانحلال لا يلزم أن يكون الأثر المترتّب على التعبّد بالخبر بلحاظ نفسه ، ولا حكومة الدليل على نفسه ، فيرتفع الإشكال .
ومن ذلك يظهر دفع الإشكال في حكومة الأصل السببي على المسبّبي ; فإنّ انحلال قوله ـ عليه السلام ـ : «لا تنقض اليقين بالشكّ»(34) يقتضي حكومة أحد المصداقين على الآخر ، كما في ما نحن فيه .
وإنّما الفرق : أنّ الحكومة في باب الأصل السببي والمسبّبي تقتضي إخراج الأصل المسبّبي عن تحت قوله ـ عليه السلام ـ : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، وحكومة دليل الاعتبار فيما نحن فيه يقتضي إدخال فرد في دليل الاعتبار .
ثمّ أوضحه مقرّر بحثه ـ رحمه الله ـ في ذيل الصحيفة بما حاصله : أنّ طريق حلّ الإشكال الثالث مع طريق حلّ الإشكال الرابع ، الذي جعله خامس الوجوه ـ وإن كان أمراً واحداً ـ وهو انحلال القضية .
إلاّ أنّ حلّ الإشكال الأوّل يكون بلحاظ آخر السلسلة ; وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان ، فإنّ وجوب تصديقه يثبت موضوعاً آخر ، وحلّ الإشكال الثاني بلحاظ مبدأ السلسلة ; وهو الراوي عن الإمام ـ عليه السلام ـ ، فإنّ وجوب تصديقه بلحاظ الأثر الذي هو غير وجوب التصديق . ثمّ يكون وجوب تصديقه أثراً للإخبار الآخر ، وهكذا إلى آخر السلسلة(35) .
ولا يخفى : أنّ في كلامه مواقع للنظر ; نشير إلى مهمّاتها :
منها : أنّ جعل الأمارات حاكمة على الأحكام الواقعية ; بمعنى أنّها مثبتة لتلك الأحكام لا يخلو عن ضعف ; فإنّ مجرّد إثبات الأمارات الأحكام الواقعية لا يصحّح الحكومة ; لعدم انطباق ضابطتها على ذلك .
ومنها : أنّ أدلّة الاُصول ليست أيضاً حاكمة على الأحكام الواقعية ، بل هي متكفّلة لبيان الوظائف العملية في ظرف الشكّ ، من غير فرق بين المحرز منها وغير المحرز . وسيوافيك عدم صحّة ما زعمه ـ قدس سره ـ من وجود الأصل المحرز .
نعم ، بعض الاُصول ـ كأصالة الطهارة والاستصحاب ـ حاكمة على أدلّة الشرائط ، كما مرّ تفصيله في مبحث الإجزاء ، وهو أمر آخر أجنبي عمّا نحن فيه .
ومنها : أنّه يمكن أن يقرّر كون الدليل حاكماً على نفسه على وجه آخر ; بأن يقال : إنّ الدليل المتكفّل لبيان الموضوع حاكم على الدليل المتكفّل لبيان الحكم ، فقولنا : «زيد عالم» حاكم على قولنا : «أكرم العادل» ; فإنّ الحكومة قد يكون بإخراج فرد واُخرى بإدخاله . وعلى ذلك : فلو كان الدليل متكفّلاً لكلتا الحيثيتين ـ كما في المقام ـ لزم ما ذكرناه من المحذور ; فإنّ أدلّة اعتبار الخبر كما هي متكفّلة لبيان الحكم من وجوب التصديق فهكذا مثبتة لموضوعه على ما عرفت في الإشكال الثالث ، وهذا ما يقال من كون الدليل حاكماً لنفسه .
وعلى ذلك : فيكون هذا التقرير إمّا إشكالاً مستقلاًّ أو تقريراً آخر لثالث الإشكالات ، لا لرابعها كما ذكره مقرّر بحثه ـ رحمه الله ـ .
وأظنّ : أنّ المقرّر قد خلط الأمر ، والشاهد ما ذكره في إبداء الفرق بين حكومة السببي على المسبّبي وما نحن فيه : أنّ الحكومة في باب الأصل السببي والمسبّبي تقتضي إخراج الأصل المسبّبي عن تحت قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، وحكومة دليل الاعتبار فيما نحن فيه تقتضي إدخال فرد في دليل الاعتبار ; فإنّ وجوب تصديق الشيخ في إخباره عن المفيد يقتضي وجوب تصديق المفيد في إخباره عن الصدوق . فوجوب تصديق الشيخ يدخل فرداً تحت عموم وجوب التصديق ; بحيث لولاه لما كان داخلاً(36) ، انتهى . فإنّه صريح فيما ذكرناه .
ومنها : أنّ ما أفاده مقرّر بحثه من أنّ طريق حلّ الإشكالين وإن كان واحداً ـ وهو انحلال القضية إلى القضايا ـ إلاّ أنّ حلّ الإشكال الثالث بلحاظ آخر السلسلة ، وحلّ الرابع إنّما هو بلحاظ مبدأ السلسلة .
ضعيف جدّاً ; فإنّ الرابع لا ينحلّ بما ذكره ; فإنّ محكي قول الصفّار وإن كان هو قول الإمام ولـه أثر شرعي غير وجوب التصديق ، إلاّ أنّ وجوب التصديق يتوقّف على ثبوت موضوع ذي أثر ـ وهو قول الصفّار المنقول لنا تعبّداً ـ وثبوته يتوقّف على وجوب تصديقه ; فإنّ قول الصفّار لم يصل إلينا من الطرق العلمية حتّى يكون الموضوع محرزاً بالوجدان ، ولا نحتاج في تحصيل الموضوع إلى شيء .
وبذلك يظهر : أنّ الإشكال لا ينحلّ من طريق مبدأ السلسلة ; لعدم الموضوع لوجوب التصديق، فلابدّ من حلّ الإشكال باعتبار آخر السلسلة ; وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان ، ولا يتوقّف الموضوع فيه على الحكم .
جولة حول الأجوبة الماضية:
هذه جملة ما قيل أو يمكن أن يقال حول الإشكالات والأجوبة ، غير أنّ كلّ ذلك يتوقّف على أن يكون لسان الأدلّة لسان جعل الطريقية وأمثالها أو لسان التنزيل وجعل المصداق ; بأن يكون خبر الواحد من مصاديق العلم تشريعاً وتعبّداً ، أو يكون لسان الأدلّة ناظراً إلى تحقّق المخبر به في الخارج ; سواء كان المخبر به قول الإمام أو إخبار المفيد للشيخ مثلاً .
فلو صحّ واحد من هذه لصحّ ما تشبّثوا به ; من إحراز الموضوع بدليل «صدّق العادل» ; فإنّ العلم وما هو منزّل منزلته ـ أعني خبر الشيخ ـ يكشف كشفاً تامّاً تعبّدياً عن وجود موضوع كان مستوراً عنّا ، فيشمله وجوب التصديق ; لانحلاله إلى وجوبات حسب تعدّد موضوعه .
وأمّا إذا قلنا : إنّ لسانها على فرض دلالتها هو إيجاب العمل ولزوم التمسّك به فلا وجه لهذه الأجوبة ; لأنّ المحرز بالوجدان هو خبر الشيخ ، وما قبله ليس محرزاً ; لا بالوجدان ولا بالتعبّد; لأنّ المفروض أنّ لسان الأدلّة وجوب العمل بها حسب الوظيفة ، لا كون قول العادل نازلاً منزلة العلم ، أو دالاًّ على وقوع المخبر به تعبّداً . وعليه : فلا يشمل وجوب التصديق لغير المحرز بالوجدان .
وأمّا كون أدلّة حجّية الخبر كذلك فيظهر بالمراجعة إليها والتأمّل فيها .
هذا إذا قلنا بأنّ أدلّة الحجّية تأسيسية ، وإلاّ فلابدّ من ملاحظة بناء العقلاء ، ويأتي الكلام فيه(37) .
وأمّا حصول الظنّ النوعي منه أو الكشف الظنّي عن الواقع فكلّ ذلك يمكن أن يكون نكتة التشريع ليس مصبّاً للجعل ، كالقول بأنّ علّة التشريع عدم وقوع الناس في الكلفة وما أشبهه .
أضف إلى ذلك : أنّ إيجاب التصديق شرعاً يتوقّف على أثر عملي للمنكشف ، وليس لمحكي قول الشيخ ـ إخبار المفيد له عن الصدوق ـ أيّ أثر شرعي ; فإنّه لا يخبر عن وجوب صلاة الجمعة ، بل عن إخبار اُستاذه له ، كما ذكرناه . وعليه فلا أثر لقوله بما هو قوله .
وأمّا ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ من أنّه لو أخبر العادل بشيء يكون ملازماً لشيء له أثر شرعاً ; إمّا عادة أو عقلاً أو بحسب العلم نأخذ به ، ويكفي في حجّية خبر العادل انتهاؤه إلى أثر شرعي .
لا يقال : إنّ ذلك إنّما يصحّ إذا كانت الملازمة عادية أو عقلية ، وليس هنا بين المخبر به ـ حديث المفيد ـ وصدقه ملازمة ; لا عادية ولا عقلية .
لأنّا نقول : إنّ الملازمة وإن لم تكن عقلية ولا عادية ولكن يكفي ثبوت الملازمة الجعلية ; بمعنى أنّ الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية بين إخبار العادل وتحقّق المخبر به بمنزلة الملازمة القطعية(38) .
فلا يخلو عن إشكال ; فإنّ الملازمة ليست عقلية ولا عادية كما اعترف به ، والملازمة الشرعية تحتاج إلى الجعل ، وليس بين الأدلّة ما يتكفّل بذلك .
ودعوى دخالة كلّ واحد من السلسلة في موضوع الحكم غريبة ; فإنّ ما هو الموضوع للوجوب ليس إلاّ نفس الصلاة ، لا الصلاة المحكي وجوبها . على أنّ الانتهاء إلى الأثر إنّما هو بالتعبّد ، والتعبّد بالشيء فرع تحقّق الأثر الشرعي حتّى يكون التعبّد بلحاظ ذلك الأثر .
وإن شئت قلت : إنّ خبر الشيخ لا عمل له ولا أثر عملي له ، وليس جزء موضوع للعمل . نعم له أثر عملي بما هو موضوع من الموضوعات ، وهو جواز انتساب الخبر إلى المفيد ، وهو يتوقّف على تعدّد المخبر كسائر الموضوعات .
وأمّا وجوب صلاة الجمعة فليس مفاد خبر الشيخ حتّى يكون إقامة الصلاة ترتيباً عملياً له ; فإنّ الشيخ لم يخبر عن وجوبها ، وإنّما أخبر عن إخبار المفيد ، ولأجل ذلك يدور صدق قوله أو كذبه مدار إخبار المفيد له وعدم إخباره ; سواء كانت الصلاة واجبة أم لا .
ومن الغريب : أنّ الأساتذة أعرضوا عن مصبّ الإشكال ـ أعني آخر السلسلة ; وهو خبر الشيخ ـ وتشبّثوا بأوّل السلسلة ـ أعني خبر الصفّار عن العسكري ـ عليه السلام ـ ـ حيث قالوا : إنّ قول الصفّار له أثر غير وجوب التصديق ، فيجب تصديقه لأجل ذاك الأثر المغاير لوجوب تصديقه، فيصير قوله ذا أثر ، فإذا أخبر الكليني يكون إخباره موضوعاً ذا أثر ; حتّى ينتهي إلى آخر السلسلة .
وقد عرفت : أنّ ما هو المهمّ تصحيح الحجّية من جانب الشيخ ; حيث ليس لقوله وإخباره أثر عملي حتّى يجب التصديق بلحاظه ، وأمّا إخبار الصفّار فإنّ قوله وإن كان ذا أثر شرعي غير أنّ إخبار الصفّار للكليني ليس لنا وجدانياً ، بل لم يثبت لنا إلاّ بدليل التعبّد ، فلا يثبت إخباره له إلاّ أن يثبت قبله إخبار المفيد للشيخ ، وما بين المفيد والصفّار من الوسائط . فلا مناص إلاّ التشبّث بآخر السلسلة وإصلاح حاله . وقد مضى إشكاله .
التحقيق في دفع الإشكالات:
والذي يقتضيه النظر : أنّ الإشكالات تندفع بحـذافيرها بمراجعـة بناء العـرف والعقـلاء ; فإنّـهم لا يفـرّقـون فـي الأخبار بيـن ذي الـواسطـة وعـدمـه ، وسيمـرّ عليك : أنّ الدليل الوحيد هو البناء القطعي مـن العقلاء على العمل بخبر الثقة(39) .
وأمّا أنّ عدم كون محكي قول الشيخ ذا أثر فمدفوع بأنّه لا يلزم في صحّة التعبّد أن يكون له أثر عملي ، بل الملاك في صحّته عدم لزوم اللغوية في إعمال التعبّد أو إمضاء بناء العقلاء ، كما في المقام ; فإنّ جعل الحجّية لكلّ واحد من الوسائط أو إمضاء بناء العقلاء ليس أمراً لغواً .
ولعلّ السرّ في عدم تفريقهم بين ذي الواسطة وعدمه ، وعدّهم الخبر المعنعن المسلسل خبراً واحداً لا أخباراً لأنّ نظرهم إلى الوسائط طريقي لا موضوعي ، وليس هاهنا إخبارات عديدة ، ولكن لا يترتّب الأثر العملي إلاّ بواحد منها ـ أعني خبر الصفّار ـ بل إخبار واحد وعمل فارد .
ويشهد على ذلك : انصراف ما يدلّ على احتياج الموضوعات إلى البيّنة عن المقام ; أعني أقوال الوسائط مع كونها موضوعات .
نعم لو كان لبعض الوسائط أثر خاصّ لا يمكن إثباته إلاّ بالبيّنة ، كما لا يخفى .
الاستدلال بآية النفر:
وممّا استدلّ به قوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]
وقد ذكر بعض أعاظم العصر تقريباً ، زعم أنّه يندفع به عامّة الإشكالات المتوهّمة في دلالة الآية ، فقال : إنّ الاستدلال يتركّب من اُمور :
الأوّل : أنّ كلمة «لعلّ» مهما تستعمل تدلّ على أنّ ما يتلوها يكون من العلل الغائية لما قبلها ; سواء في ذلك التكوينيات والتشريعيات ، والأفعال الاختيارية وغيرها . فإذا كان ما يتلوها من الأفعال الاختيارية التي تصلح لأن يتعلّق بها الإرادة الآمرية كان لا محالة بحكم ما قبلها في الوجوب والاستحباب .
وبالجملة : لا إشكال في استفادة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب علّته الغائية . وفي الآية جعل التحذّر علّة غائية للإنذار ، ولمّا كان الإنذار واجباً كان التحذّر واجباً .
الثاني : أنّ المراد من الجموع في الآية هي الجموع الاستغراقية لا المجموعية ; لوضوح أنّ المكلّف بالتفقّه هو كلّ فرد فرد من النافرين أو المتخلّفين ـ على التفسيرين ـ فالمراد : أن يتفقّه كلّ فرد منهم ، وينذر كلّ واحد منهم ، ويتحذّر كلّ واحد منهم .
الثالث : المراد من التحذّر هو التحذّر العملي ، وهو يحصل بالعمل بقول المنذر ، بل مقتضى الإطلاق والعموم الاستغراقي في قوله (وَلِيُنْذِروُا) هو وجوب الحذر مطلقاً ـ حصل العلم من قول المنذر أو لم يحصل ـ غايته : أنّه يجب تقييد إطلاقه بما إذا كان المنذر عدلاً . وبعد العلم بهذه الاُمور لا أظنّ أن يشكّ أحد في دلالتها على حجّية الخبر الواحد . وبما ذكرنا من التقريب يمكن دفع جميع ما ذكر من الإشكالات على التمسّك بها(40) ، انتهى . ثمّ تصدّى لبيان الإشكالات ودفعها .
وفي كلامه مواقع للنظر :
منها : أنّ ما ادّعاه من أنّ ما يقع بعد كلمة «لعلّ» إنّما يكون دائماً علّة غائية لما قبلها منقوض بقوله تعالى : {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا} [الكهف: 6]; فإنّ الجملة الشرطية وإن كانت متأخّرة ظاهراً لكنّها متقدّمة على قوله تعالى : (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ . . .)إلى آخره حسب المعنى .
مع أنّ ما بعد «لعلّ» ليس علّة غائية لما قبلها ; أعني الجملة الشرطية ; فإنّ بخوع نفسه الشريفة ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ليس علّة غائية لعدم إيمانهم ; وإن كان مترتّباً عليه ، غير أنّ الترتّب والاستلزام غير العلّة الغائية .
لكن الأمر سهل بعد كون المقام من قبيل ما ذكره ـ رحمه الله ـ .
ومنها : أنّ ما ذكره من وجوب التحذّر لكونه غاية للإنذار الواجب غير صحيح ، بل الظاهر كونه غاية للنفر المستفاد وجوبه من «لولا» التحضيضية الظاهرة في الوجوب .
ومع ذلك أيضاً : ليس للآية ظهور تامّ في وجوب النفر حتّى يترتّب عليه وجوب التحذّر ; فإنّ صدر الآية ـ أعني قوله تعالى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) ـ يعطي : أنّ الغرض المسوق له الكلام هو النهي عن النفر العمومي ، و أنّه لا يسوغ للمؤمنين أن ينفروا كافّة ، وإبقاء رسول الله وحيداً فريداً .
وعلى ذلك فيصير المآل من الآية هو النهي عن النفر العمومي ، لا إيجاب النفر للبعض . فالحثّ إنّما هو على لزوم التجزئة وعدم النفر العمومي ، لا على نفر طائفة من كلّ فرقة للتفقّه .
ودعوى : أنّ ذلك خلاف ظاهر الآية ، بشهادة أنّه لو كان الغرض هو المنع عن النفر العمومي لكان الواجب الاكتفاء على قوله ـ عزّ شأنه ـ (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) ، من دون أن يعقّبه بما ذكره بعده من التفقّه والرجوع والإنذار والتحذّر ; فإنّ التعقيب بما ذكر شاهد على أنّ الغرض هو الحثّ على تحصيل هذه المطالب ; من بدوها إلى ختامها .
أضف إلى ذلك : أنّ قوله تعالى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ . . .) إلى آخره ليس نهياً ولا منعاً ، بل إخباراً عن أمر تكويني خارجي ; وهو امتناع النفر العمومي امتناعاً واضحاً يحكم به ضرورة العقول ; لاستلزامه اختلال النظام . ثمّ أردف ذلك ـ عزّ شأنه ـ بنفر البعض ; لعدم استلزامه هدم النظام وفساد المجتمع .
مدفوعة : بأنّ عدم الاكتفاء على الجملة الاُولى يمكن أن يكون لدفع ما ربّما ينقدح في الأذهان من بقاء سائر الطوائف على جهالتهم وعدم تفقّههم في الدين ، فقال ـ عزّ شأنه ـ يكفي لذلك تفقّه طائفة ، فليست الآية في مقام بيان وجوب النفر ، بل في مقام بيان لزوم التفرقة بين الطوائف .
وقوله : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ) إخبار في مقام الإنشاء ـ ولو بقرينة شأن نزولها ، كما قال المفسّرون(41) ـ وليس المراد بيان أمر واضح وهو امتناع نفر جميع الناس في جميع الأدوار إلى طلب العلم والتفقّه حتّى لزم التنبّه به ، إلاّ أن يحمل ذكره لصرف المقدّمة لما بعده ، وهو أيضاً بعيد مخالف لشأن نزول الآية وقول المفسّرين .
ومنها : أنّ ما ذكره ـ قدس سره ـ من أنّ المراد من الحذر هو الحذر العملي ، وهو يحصل بالعمل بقول المنذر لا يخلو عن ضعف ، بل الظاهر : أنّ المراد من الحذر هو الحذر القلبي بعد إنذار المنذر وإيعاده وتلاوته ما ورد في ذلك من الآيات والنصوص والسنن .
وعلى ذلك : فبعدما أنذر المنذر بما عنده من الآيات والروايات ، وحصل الحذر والخوف القلبيان يقوم المنذرون ـ بالفتح ـ بما لهم من الوظائف العملية التي تعلّموها من قبل ، أو يلزم تعلّمها من بعد ، فليست الآية ظاهرة في أخذ المنذر ـ بالفتح ـ شيئاً من الأحكام من المنذر ـ بالكسر ـ تعبّداً .
وبالجملة : غرض القائل سبحانه من الآية ليس تعلّم المنذَر شيئاً من المنذِر ولا عمله بقوله ، بل غرضه سبحانه أنّ المنذرين بعدما أوعدوا قومهم بتذكار الله وبيان عظمته ، وما اُعدّ للمتّقين من الجنّة وللكافرين والفاسقين من النار ، وذكروا ذلك كلّه على سبيل الموعظة والإنذار يحصل له حذر قلبي وخوف باطني يجبر ذلك الخوف على العمل بالوظائف الشرعية العملية .
وأمّا ما هو الوظائف و أنّها من أين يلزم تحصيلها والوقوف عليها فليس مورداً لغرض الآية ، كما أنّ أوصاف المنذِر من عدالته وتعدّده ليس مصبّاً للبيان . وعلى ذلك فبين معنى الآية وحجّية الخبر الواحد بون بعيد .
ومنها : ـ وذلك أهمّ ما في الباب من الإشكال ـ وملخّصه : إنكار إطلاق الآية بالنسبة إلى حصول العلم من قول المنذر وعدمه ; فإنّ الإطلاق فرع كون المتكلّم في مقام البيان ، وليس في الآية ما يشعر بكونه سبحانه في مقام بيان تلك الجهة بعامّة خصوصياتها .
فإنّ الآية ـ حسب بعض تفاسيرها(42) ـ في مقام بيان وجوب أصل النفر وقيام عدّة به ، ورجوعهم وإنذارهم وتحذيرهم ، وأمّا لزوم العمل بقول كلّ منذر ; سواء كان عادلاً أم فاسقاً ، واحداً أم متعدّداً ، حصل منه الظنّ أو العلم أم لا فليس في مقام بيانها حتّى يؤخذ بإطلاق الآية .
والعجب : أنّه ـ قدس سره ـ قد صار بصدد دفع الإشكال ، فقال : بعدما عرفت من أنّ المراد من الجمع هو العامّ الاستغراقي لا يبقى موقع لهذا الإشكال ; إذ أيّ إطلاق يكون أقوى من إطلاق الآية بالنسبة إلى حالتي حصول العلم من قول المنذر وعدمه(43) ؟ ! انتهى .
وأنت خبير : أنّ كون العامّ استغراقياً لا يثبت الإطلاق من ناحية الفرد ; إذ لا منافاة بين كون الحكم شاملاً لكلّ أحد وبين حجّية قول كلّ واحد منها في ظروف خاصّة وأوقات معيّنة .
ومنها : أنّ بعض الروايات الصادرة عنهم ـ عليهم السلام ـ يستفاد منها أنّ الأئمّة الهداة
قد استشهدوا بها على لزوم النفر إلى تحصيل العلم بالإمام المفترض طاعته بعد فوت إمام قبله(44) ، ومعلوم أنّ الاُصول الاعتقادية لا يعتمد فيها بخبر الثقة ، وهذا أيضاً يؤيّد عدم الإطلاق الفردي .
هذا ، وقد استدلّ القوم بآيات كثيرة ، غير أنّ المهمّ ما عرفت .
الاستدلال على حجّية قول الثقة بالأخبار:
قد استدلّ الأصحاب بالروايات الكثيرة الواردة التي جمعها الشيخ الجليل الحرّ العاملي في كتاب القضاء من «وسائله»(45) ، ولا حاجة لنا في نقلها وسردها في المقام . وعلى القارئ الكريم ملاحظة أبواب القضاء من ذاك الكتاب ، لعلّه يقف على أزيد ممّا وقف عليه غيره .
ولكن نعطف نظره إلى نكتة مرّت الإشارة إليه غير مرّة ; وهو أ نّا لاحظنا ما وقفنا عليه من الأخبار واحداً بعد واحد ، وأمعنا النظر في مفادها ، فلم نجد فيها ما يدلّ على التأسيس ، وأنّ الشارع قد جعل الخبر الواحد أو قول الثقة حجّة من عنده ، بل يظهر من كثيرها : أنّ حجّية خبر الثقة كان أمراً مسلّماً عندهم ، وكانت الغاية في هذه الأخبار تشخيص الثقة عن غيرها ، وأنّ فلاناً هل يجوز الأخذ منه لوثاقته أو لا يجوز .
وإن شئت قلت : إنّ الأخبار في مقام بيان الصغرى ; وهو تعيين الثقة ، وأنّ فلاناً ثقة أو غير ثقة ، وأمّا الكبرى ; وهو حجّية قول الثقة فقد كانت أمراً إرتكازياً لهم ، وكان بناء العقلاء على العمل به .
وبذلك يظهر : أنّ ما استدلّوا به من الكتاب والسنّة ما يدلّ بظاهرها على حجّية قول الثقة فهي محمولة على الأمر العقلائي الدائر بينهم ، وكان المرمي إمضاء عملهم ، لا تأسيس أمر لهم .
وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني(46) ، وتبعه شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ من أنّ لازم العلم إجمالاً بتواترها الإجمالي وإن كان هو الأخذ بأخصّ مضامين تلك الأخبار ـ وهو حجّية قول العدل الذي شهد اثنان من أهل الفنّ بعدالته ـ إلاّ أنّه يوجد في تلك الأخبار خبر يكون جامعاً لعامّة الشرائط الحجّية ، ويكون مفاده حجّية قول مطلق الثقة ، فيتعدّى منه إلى الأعمّ(47) .
فغير صحيح ; إذ لا أظنّ أن يكون بين الأخبار في الباب خبر يكون جامعاً لعامّة الشرائط الحجّية التي قد قلنا بها من باب الأخذ بالقدر المتيقّن ، ومع ذلك يكون من حيث المفاد أعمّ ; أي دالاًّ على حجّية قول مطلق الثقة ، فإنّه مجرّد فرض .
فإنّ القدر المتيقّن من تلك الأخبار هو الخبر الحاكي من الإمام بلا واسطة ، مع كون الراوي من الفقهاء نظراء زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، ومعلوم أنّه ليس بينها خبر جامع لتلك الشرائط دالّ على حجّية قول مطلق الثقة .
وأمّا ما أفاده بعض أعاظم العصر من أنّ أغلب الطوائف وإن لم يكن متواتراً إلاّ أنّه لا إشكال في أنّ مجموعها متواترة إجمالا ; للعلم بصدور بعضها عنهم ـ صلوات الله عليهم(48) ـ ففيه : أنّ العلم بصدور البعض لا يمكن الاستدلال به على
حجّية قول الثقة مطلقاً ; إذ من المحتمل أن يكون الصادر منهم ما يدلّ على حجّية قول الثقة إذا كان جامعاً لشرائط خاصّة .
وبالجملـة : العلم بصدور البعض لا يكفي في استنتاج الأعمّ . على أنّه يمكن منع التواتر ; ل أنّها مع كثرتها منقولة عـن عـدّة كتب خاصّـة لا تبلغ حـدّ التواتـر . واشترطـوا في تحقّق التواتر كـون الطبقات عامّتها متواترة ، والتواتر في جميعها ممنوع .
نعم ، هاهنا وجـه آخر لإثبات حجّيـة مطلق قول الثقة ، وحاصله : أنّه إن ثبت حال السيرة العقلائية ، وظهر أنّ بناء العقلاء على العمل بمطلق قول الثقة فهو ، وإلاّ فالقدر المتيقّن من السيرة هو بناؤهم على حجّيـة الخبر العالي السند الذي يكون رواته كلّهم ثقات عدول ، قد زكّاهم جمع من العدول ، ولا إشكال في أنّه يوجد بين تلك الروايات ما يكون جامعاً لتلك الشرائط ، مع كونه دالاًّ على حجّية قول الثقة مطلقاً .
فقد روى الكليني عن محمّد بن عبدالله الحميري ومحمّد بن يحيى جميعاً عن عبدالله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن ـ عليه السلام ـ قال : سألته وقلت : من اُعامل وعمّن آخذ ، وقول من أقبل ؟
فقال : «العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ; فإنّه الثقة المأمون»(49) . ونحـوها صحيحته الاُخـرى(50) .
وهذه الرواية مع علوّها رواته كلّهم من المشائخ العظام ممّن اتّفق الأصحاب على العمل برواياتهم ، فتلك الرواية لا إشكال في شمول السيرة العقلائية عليها ، فإذا شملتها نتعدّى حسب مضمونها إلى كلّ ثقة مأمون .
لا يقال : لا يمكن التعدّي منها إلاّ إلى نظراء العمري وابنه ، الذين هم من الأجلاّء الثقات ، ولا يمكن منه التعدّي إلى مطلق الثقة .
لأنّا نقول : إنّ التعليل بأنّه الثقة المأمون يرفع هذا الاحتمال ; فإنّ التعليل بمطلق الوثاقة والمأمونية ، لا الوثاقة المختصّة لأضراب العمري وابنه ، كما أنّ التعليل في قول القائل : «لا تشرب الخمر ; لأنّه مسكر» ظاهر في أنّ تمام العلّة ذات الإسكار ، لا الإسكار المختصّ بالخمر .
ثمّ هذه الرواية وأمثالها وإن كان لسانه عارياً عن جعل الحجّية أو تتميم الكشف أو جعل الطريقية إلاّ أنّه يظهر منه أنّ العمل بقول الثقة المأمون كان رائجاً بين الأصحاب ، بل بين العقلاء ; ولذا جاء أخذ الحديث من العمري وابنه معلّلاً بأنّه الثقة المأمون . وبذلك يظهر الفرق بين مقالنا وبين ما ذكره المحقّق الخراساني ، فراجع لما نقلناه عنه .
نعم ، لو قلنا بعدم استفادة إيجاب العمل أو جعل الحجّية وأمثالها منها يشكل التمسّك بها لكشف حال السيرة ; لعدم الكشف القطعي ـ وهو واضح ـ وعدم كونه حكماً عملياً ، فلا معنى للتعبّد به.
وكيف كان : فالخطب سهل بعد إحـراز بناء العقلاء على الاحتجاج بخبـر كلّ ثقـة .
ثمّ بناءً على إنكار بنائهم فالرواية ونحوها تدلّ على التشريع ولزوم العمل بقوله ، وما ذكرناه من عدم الدلالة على التأسيس لأجل إحراز بناء العقلاء ، فتدبّر .
الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجّية قول الثقة :
وقد عرفت أنّها العمدة في الباب ، بل لا دليل غيرها ، ويقف على وجودها كلّ من له إلمام بالمجتمعات البشرية منذ دوّن تأريخ البشر ، واستقرّ له التمدّن ، واتّخذ لنفسه مسلكاً اجتماعياً .
وما ورد من الآيات الناهية من العمل بغير العلم({وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } [الإسراء: 36]) أو العمل بالظنّ({وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} [يونس: 36]، {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28]) ليست رادعة عن السيرة ; إذ لو كانت رادعة لمطلق العمل بالظنّ أو بغير العلم شملت نفسها ; لأنّها بمنزلة القضايا الحقيقية ، الثابت فيها الحكم لموضوعاتها المحقّقة كلّ في موطنها ، ومن العمل بالظنّ نفس التمسّك بهذه الآيات والأخذ بمفادها ; فيلزم من جواز التمسّك عدم جوازه .
وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني من أنّ رادعية تلك الآيات تستلزم الدور المحال(51) فضعيف، وقد مرّ وجهه عند البحث عن استدلال النافين بالآيات(52) .
لا يقال : إنّ المحال إنّما يلزم من شمولها لنفسها ، فيندفع بعدم شمولها لنفسها ، وحينئذ يصلح للرادعية عن مطلق العمل بالظنّ .
لأنّا نقول : لا شكّ أنّ هذه الآية إنّما نزلت لأجل الإفادة والاستفادة حتّى يأخـذ الاُمّـة بمضمونها، كما لا شكّ في أنّ العمل بظاهـرها ليس إلاّ عملاً بالظـنّ وبغير العلم . وحينئذ فهل المتكلّم اتّكل في بيان مـراده على مفروغيـة حجّيـة الظواهـر الظنّية كما هـو المطلوب ، أو اتّكل على عـدم شمولها لنفسها ; لاستلزامـه المحال ؟
ولا أظـنّ أحـداً يتفوّه بالثاني ; فإنّه خارج عن المتفاهم العرفي والطريقة المألوفة بين العقلاء . فإذا كان الاتّكال في الإفهام على السيرة ـ أعني مفروغية حجّية الظواهر مع عدم إفادتها العلم ـ يعلم بعد إلغاء الخصوصية عدم رادعيتها للسيرة القطعية في العمل بالظواهر أو بقول الثقة المأمون أو غيرهما ممّا عليه عمل العقلاء .
وإن شئت قلت : إنّ المتكلّم قد اعتمد في إفادة المطلوب على السيرة العقلائية الدائرة بينهم من حجّية الظواهر ، لا على أنّ هذا الكلام لا يشمل لنفسها لأجل لزوم المحال ; فإنّه خارج عن المتفاهم العرفي .
فإذا كان الاعتماد على السيرة المستمرّة من حجّية الظواهر مع عدم إفادتها العلم يعلم بإلغاء الخصوصية أنّ الآية غير رادعة لما قامت عليه السيرة من العمل بالظنون في موارد خاصّة من الظواهر وحجّية قول الثقة وغيرهما .
ثمّ إنّ بعض الأعاظم أفاد في المقام : أنّه لا يحتاج في اعتبار الطريقية العقلائيـة إلى إمضاء صاحب الشرع لها والتصريح باعتبارهـا ، بل يكفي عـدم الردع عنها ; فإنّ عدم الردع عنها مع التمكّن منه يلازم الرضاء بها ; وإن لم يصرّح بالإمضاء .
نعم ، لا يبعد الحاجـة إلى الإمضاء في باب المعاملات ; لأنّها مـن الاُمـور الاعتباريـة التي يتوقّف صحّتها على اعتبارهـا ; ولو كـان المعتبر غير الشارع فلابـدّ مـن إمضاء ذلك ; ولو بالعموم والإطلاق .
وتظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة التي لم تكن في زمان الشارع ، كالمعاملات المعروفة في هذا الزمان ـ البيمة التأمين ـ فإنّها إذا لم يندرج في عموم {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] أو { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة: 1] ونحو ذلك فلا يجوز ترتيب آثار الصحّة عليها(53) ، انتهى .
وفيه : أنّ التفريق بين المعاملات وغيرها باحتياج الاُولى إلـى الإمضاء وعـدم كفاية الردع ، بخلاف الثاني غير صحيح ; لأنّ مجرّد كون المعاملات اُموراً اعتبارية لا يستلزم لزوم الإمضاء وعدم كفاية عدم الـردع ، فإذا كانت المعاملة بمرأى ومسمع من الشارع ، وكان متمكّناً عن الردع فسكوته كاشف عن رضاه ، وهذا كاف في نفوذ المعاملة .
ثمّ إنّه ـ قدس سره ـ أفاد ثانياً : أنّ سيرة المسلمين في الاُمور التوقيفية التي من شأنها أن تتلقّى من الشارع تكشف لا محالة عن الجعل الشرعي ، وأمّا في غير التوقيفية التي كانت تنالها يد العرف والعقلاء قبل الشرع فمن المحتمل قريباً رجوع سيرة المسلمين إلى طريقة العقلاء ، ولكن ذلك لا يضرّ جواز الاستدلال بها ; فإنّه كما أنّ استمرار طريقة العقلاء يكشف عن رضاء صاحب الشرع ، كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك ، غايته : أنّه في مورد اجتماع السيرة والطريقة يكونان من قبيل تعدّد الدليل على أمر واحد ، انتهى .
وفيه : أنّ عدّ مورد اجتماع السيرتين من باب قيام الدليلين على شيء واحد غير صحيح ; فإنّ سيرة المسلمين على جواز العمل بقول الثقة لو كانت قائمة عليه بما هم مسلمون فلا وجه لإرجاعها إلى طريقة العقلاء وسيرتهم كما ادّعاه .
وإن كانت قائمة عليه لا بما هم مسلمون فهي وإن كانت راجعة إلى سيرة العقلاء لكن لا تصير السيرة دليلاً مستقلاًّ بعد اتّحاد الحيثيتين في متعلّق السيرتين ، بل الدليل ينحصر في واحد ; وهو سيرة العقلاء(54) .
__________
1 ـ الكافي 1 : 330 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 138 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 4 .
2 ـ راجع وسائل الشيعة 27 : 110 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 11 و18 .
3 ـ راجع وسائل الشيعة 27 : 109 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 10 و12 و14 و15 و19 و35 .
4 ـ راجع وسائل الشيعة 27 : 109 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 10 و19 و37 .
5 ـ راجع وسائل الشيعة 27 : 110 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 12 و14 و37 .
6 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 160 ـ 162 .
7 ـ كفاية الاُصول : 340 .
8 ـ نهاية الأفكار 3 : 111 ـ 112 .
9 ـ الحكمة المتعالية 1 : 157 .
10ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 169 ـ 170 .
11 ـ الذريعة إلى اُصول الشريعة 2 : 535 ـ 536 ، العدّة في اُصول الفقه 1 : 130 .
12 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 171 ـ 173 .
13 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 99 .
14 ـ اُنظر فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 261 .
15 ـ اُنظر المصباح المنير : 113 .
16 ـ نهاية الأفكار 3 : 115 .
17 ـ اُنظر فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 271 .
18 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 174 .
19 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 271 .
20 ـ تقدّم في الصفحة 430 .
21 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 175 ـ 176 .
22 ـ تقدّم في الصفحة 431 .
23 ـ رسائل الشريف المرتضى 1 : 24 .
24 ـ اُنظر فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 264 .
25 ـ درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 110 .
26 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 387 .
27 ـ نهاية الأفكار 3 : 118 ـ 119 .
28 ـ نهاية الأفكار 3 : 119 .
29 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 265 .
30 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 177 .
31 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 179 .
32 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 180 ـ 181 .
33 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 181 ـ 182 .
34 ـ تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
35 فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 183 ، الهامش 1 .
36 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 184 .
37 ـ يأتي في الصفحة 472 .
38 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 388 .
39 ـ يأتي في الصفحة 472 .
40 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 185 ـ 187 .
41 ـ راجع مجمع البيان 5 : 126 .
42 ـ التبيان في تفسير القرآن 5 : 322 .
43 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 187 .
44 ـ الكافي 1 : 378 / 1 ـ 3 .
45 ـ وسائل الشيعة 27 : 77 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 8 والباب 11 .
46 ـ كفاية الاُصول : 347 .
47 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 392 .
48 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 191 .
49 ـ الكافي 1 : 330 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 138 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي، الباب 11 ، الحديث 4 .
50 ـ نفس المصدر .
51 ـ كفاية الاُصول : 348 .
52 ـ تقدّم في الصفحة 433 .
53 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 193 .
54 ـ ثمّ إنّ القوم ـ قدّس الله أسرارهم ـ استدلّوا على حجّية قول الثقة بالدليل العقلي الذي نقل الشيخ الأعظم تقريراته المختلفة في «فرائده» ، ومرجع الكلّ إلى الانسداد الصغير والكبير .
وقد بحث سيّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه الوارف ـ عنه في الدورة السابقة ، وغار في عامّة مباحثه ، وفند أكثر ما أفاده بعض أعاظم العصر في هاتيك المباحث . غير أنّه ـ دام ظلّه ـ رأى البحث عنه في هذه الدورة ضياعاً للوقت ، وصار بصدد تهذيب الاُصول وتنقيحه .
ومن أجمل ما أفاد في هذا المقام قوله : إنّ البحث عن أصل الانسداد وإن كان له شأن ; ليقف القارئ على حقيقة الحال ، غير أنّ البحث عن فروعه ; من كون النتيجة على فرض صحّة الانسداد مهملة أو كلّية ، وكون الظنّ حجّة على الكشف أو الحكومة و . . . ضار جدّاً ; إذ بعد إبطاله لا مصاغ للبحث عن فروعه ; إذ لا أساس حتّى يبحث عمّا يبنى عليه .[المؤ لّف]



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|