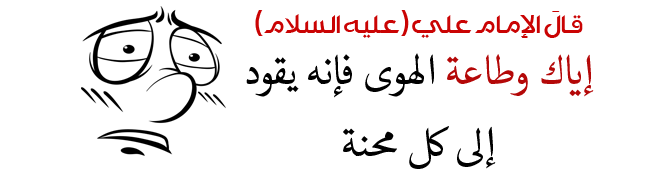
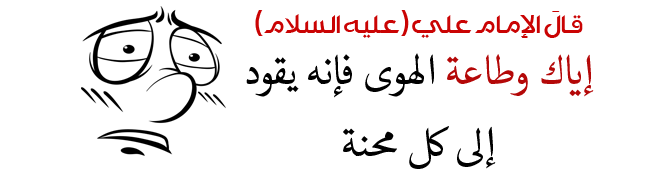

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-24
التاريخ: 2023-11-21
التاريخ: 8-11-2020
التاريخ: 3-12-2015
|
أسرار تقديم "إياك" على "نعبد"
إن حصر العبادة والاستعانة بالله، كان يمكن بيانها بعبارات مثل: "لا نعبد إلا إياك" أو "نعبدك ولا نعبد غيرك" لكنها بينت في هذه الآية الكريمة بتقديم المفعول (إياك). وهناك أسرار كامنة في انتخاب هذا السياق الخاص نشير إلى بعضها فيما يلي:
أ. إن الموحد الذي يعد الذات المقدسة الإلهية، منشأ وجامعا لكل صفات الكمال والجمال ويعتقد بربوبيته ومالكيته المطلقة، فإنه يراه في البداية وقبل كل شيء، وبتقديم (إياك) فإنه يعد العبادة حقا منحصر به.
والإنسان الذي مق حجاب الغفلة لا يرى سواه، ومن البداية بتكلم عنه، ولذلك فإن كلمة "شهيد" في الآية الكريمة: {أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [فصلت: 53] هي بمعنى (المشهود)، وليس (الشاهد)، يعني أن الإنسان عند النظر إلى كل شيء يرى الله أولا، ثم يرى الآخر ثانية كأية له. وحيث إن الله مشهود يتفوق على كل المشهودين لذلك استعملت مع كلمة (على).
ب. إن العابد الذي يرى المعبود أولا، ويعتقد بأنه جمال محض وكمال صرف تهون عليه صعوبة العبادة ومشقتها. فالعبادة بالنسبة لسالكي طريق الوصول إلى الحق شاقة في بدايتها، ومن هنا غد الصبر على الطاعة من أعظم الفضائل ورأس الإيمان: "فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد"(1).
والله سبحانه ذكر الصلاة بأنها أمر كبير وثقيل على الذين لم يصلوا بعد إلى مقام (الخشوع): {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45] فعلى الرغم من أن الصلاة لا تحتاج إلى وقت كثير، لكن الكثير من الناس يتهربون منها، لأن الأنانية لاتدع الإنسان يقر بالعبودية ويظهرها. وتمريغ الناصية بالتراب صعب على من يدعي الاستقلال عن الله، ولكن الخاشعين الذين يرون جمال وحسن المعبود يسهل عليهم إظهار العبودية ويتلذذون بحلاوة العبادة.
والذي يقيم الصلاة وهو يشعر بالصعوبة، فهو قد أدى تكليفه ولكنه لا يلتذ بالصلاة، أما المشاهدون لجمال المعبود فيتلذذون بها صدقا ويتألمون لأجل فراقها، ولذلك يقولون: "لو كان العمر كله ليلة واحدة لقضيناها في السجود أو الركوع"(2).
والرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) ما الذي كان دائما مستغرقا في شهود جمال الله سبحانه، وكان فراق الله مدعاة لألمه فهو لذلك كان يرى الصلاة قرة لعينه "جعلت قرة عيني في الصلاة"(3). وكان إذا حان وقت الصلاة يقول لمؤذنه بلال الحبشي: "أرحنا يا بلال"(4).
ج. وإن كان الشيطان يوسوس للإنسان في جميع الأحوال، لكنه في وقت الصلاة يعبئ جميع طاقاته ليمنع من حضور القلب لدى المصلي. ووسوسة الشيطان ومزاحمته له في الأعمال العادية ليست من الأهمية بشيء، ولا يكون الشيطان فيها جادا كثيرا، ولكن إذا أراد الإنسان أن يضع قدمه في طريق العبادة فإن الشيطان يجهز جميع جنده وذريته لأجل إغفال العبد السالك. ولأجل الحفظ من هذا الهجوم الشامل، يجب أولا تعيين المعبود ثم الحديث عن العبادة، كي لا يصطنع الشيطان للإنسان معبودا، فإن الإنسان إذا انبرى للعبادة قبل أن يشخص المعبود وسوس له الشيطان وألقي في روعه أفكاره ليصنع بها له معبودا كاذبا.
فالشيطان بإلقائه وسوسته للكفار وعبدة الأصنام يصور وينحت لهم صنمين. وبالنسبة للمؤمنين فإنه يجعل النجاة من النار والحصول على نعيم الجنة معبودا لهم(5).
د. إن للعبادة ثلاثة أركان: (المعبود) و(العابد) و(العمل العبادي). والركن الأساسي في هذه الأركان الثلاثة هو (المعبود). والعابد إذا رأى الدمع نفسه والعبادة والمعبود فهو مبتلى ب (التثليث)، ولا نصيب له من التوحيد الخالص الذي هو مقام الفناء المحض، وإذا رأى العبادة والمعبود ولم ير نفسه فهو مبتلى ب (الثنوية) ولم يصل إلى مرتبة الفناء ولم يكن موحدا خالصا، لكن إذا لم ير لأنفسه ولا العبادة ولم ينظر إلا إلى المعبود فهو فانٍ في الله وموحد خالص له(6).
وبتقديم "إياك" فإن المصلي لا يرى سوى المعبود ولا شأن له بالعابد والعبادة، لأن جميع همه منصب على لقاء المعبود وقد أنساه لقاء المعبود رؤية العابد والعبادة.
هـ. كل محادثة فيها ثلاثة أركان: المتكلم والمخاطب والخطاب. ومن بين هذه الأركان الثلاثة تارة يكون المتكلم هو الأصيل فيصبح الركنان الآخران فرعيين، وتارة يكون المخاطب هو الأصل، وتارة كما في المحادثة العادية بين اثنين متقاربين في المستوى حيث يكون المتكلم والمخاطب والخطاب كلهم في و عرض ومستوى واحد.
وفي الخطابات والمكاتبات الاعتبارية ولأجل رعاية الأدب يذكر المخاطب أولا. وما نقوم به في محاوراتنا العرفية من حفظ حرمة المخاطب بذكر اسمه في البداية، فهو أمر جعلي واعتباري، ولكنه فيما يتعلق بالخطاب مع الله سبحانه فحرمة وأصالة المخاطب له جذر تكويني فالمخاطب هو الأصل، وكل من الخطاب والمتكلم فرع. وهذا الخطاب الاعتباري، ثمرة للخطاب التكويني الذي يكون فيه المتكلم أصلا، ويكون فيه كل واحد من الخطاب والمخاطب فرعا.
وتوضيح ذلك هو: ما يحصل في الخطابات الاعتبارية هو أن المتكلم هو الأول وبعده يصدر الخطاب وفي المرحلة الثالثة يتصف الشخص الآخر بعنوان المخاطب بواسطة خطاب المتكلم، ولكن في الخطابات التكوينية، في البداية يكون المتكلم وخطابه، ومن ثم (يوجد) المخاطب بواسطة الخطاب، لأن الخطاب التكويني هو الذي يخلق المخاطب: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82] ، أي ان في الخطاب التكويني يكون خطاب المتكلم وأمره (كن) موجدأ وخالقة للمخاطب لا ان الله سبحانه يقول للمخاطب الموجود (كن): "انما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله"(7).
إذن بما أن خطاباتنا الاعتبارية في الصلاة ونظائرها مسبوقة بالخطاب الحقيقي فلها جذور تكوينية، يعني أننا في البداية خلقنا بالخطاب التكويني لله ثم أصبحنا نخاطب خالقنا، فهو الأصل، ونحن الفرع، ولهذا يجب أن نلتزم الأدب في كلامنا مع الله سبحانه فنذكر اسمه أولا، لا أن نبدأ بذكر أنفسنا فنقول (أنا أتكلم معك). بما أنه في التكوين (كن) أي الأمر بالإيجاد مقدم على (يكون)، ففي الخطاب الاعتباري أيضا يقتضي الأدب ان تقدم المخاطب الذي هو ذاته المتكلم والأمر الذي خلقنا بأمر (كن) الوجودية. ومثل هذا اللون من الكلام ثمرة ناتجة من التنسيق بين الأمور الاعتبارية والتكوينية.
وجميع النعم دون استثناء هي من قبل الله سبحانه: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53] وكل عمل خير يؤديه العبد ولأجله يكافأ بالجائزة، فهو محاط بنعمتين سابقة ولاحقة، لأن التوفيق لمعرفة التكليف وأدائه هو نعمة انعمها الله عليه، والجزاء والثواب الذي يحظى به بعد أداء التكليف هو نعمة أخرى من قبل الله. فالإنسان في كل عمل صالح بما في ذلك العبادة يكون بين نعمتين، وكلتاهما من الله ولا يبقى للعبد نصيب، وحسب هذا التحليل فالإنسان غير مستحق لشيء في مقابل نعمة الطاعة والانقياد لله.
وفي القرآن الكريم ورد تطبيق هذا الأصل الكلي على موارد خاصة فمثلا توبة العبد محفوفة ومحاطة بنعمتين: إحداهما: نعمة التوفيق للتوبة، والأخرى: نعمة قبولها، وكلتا النعمتين سميت بالتوبة، إذن فكل توبة من العبد محفوفة بتوبتين من الله.
يقول القرآن الكريم حول التوبة الأولى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} [البقرة: 37] أي أن النبي آدم (عليه السلام) تلقى من ربه كلمات فتاب الله عليه أي أن الله رجع إليه وشمله بلطفه. واللطف الإلهي يجذب العبد إلى الطريق، وبعد ذلك يوفق الإنسان للتوبة. وكذلك يقول تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 117] ، أي أن الله تاب على النبي والمهاجرين والأنصار في ساعة العسرة وضيق الشدة، وهذه التوبة اقترنت بـ (على) في الاستعمالات القرآنية، وهذا يعني أن لطف المولى فاض من الأعلى على العبد.
وحول التوبة الثانية يقول الله سبحانه: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ } [التوبة: 104]. من مجموع ثلاث توبات، وهي توبة من العبد وتوبتان من الله،
وقد ذكرت أيضا هذه التوبات الثلاث في الآية الكريمة: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } [التوبة: 118].
وخلاصة القول: إن الإنسان محفوف ومحاط دائما بالنعم الإلهية، وإذا لم يستطع أن يرى ترادف النعم واتصالها وترابطها فلأنه يرى نفسه وذاته، وإلا فإن السيل الهادر للنعم الإلهية ليس فيه وقفة وفاصلة وعقبة ومانع الا (نفس) الإنسان. كما أنه ليس بين الخالق والمخلوق أي حجاب سويا نفس الخلق: "ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور"(8). وإذا لم ينظر الإنسان إلى نفسه، فأينما اتجه فسوف لن يرى سوى وجه الله: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].
إذن بما أن العبادة توفيق من الله سبحانه، فأدب العبادة يقتضي أن لا نقدم اسمنا على اسم المعبود. فهو الذي يجعل الإنسان ظمآنا بفيض منه وبفيض آخر يسوق الإنسان الظمآن إلى عين الكوثر فيسقيه. ولا ينسب إلى الإنسان شيء سوى الظمأ، ولهذا جاء في الأدعية "منتك ابتداء"(9) ، "كل نعمك ابتداء"(10).
فنعم الله ابتداء منه، وليس لنا من عمل نستحق به شيئا من الجزاء والمكافأة.
وما ذكر من كلام في سر تقديم "إياك" على "نعبد" فهو الكلام ذاته يمكن أن يستنبط في سر تقديم "إياك" على "نستعين".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نهج البلاغة، الحكمة 82 المقطع 3.
2. راجع كتاب شرح أحوال اويس القرني.
3. البحار، ج 79، ص193.
4. البحار، ج 79، ص193.
5. العبادة بنية نيل الجنة والنجاة من النار، على الرغم من انها صحيحة من الناحية الفقهية ولكنها من شأن الإنسان ضعيف الهمة حيث يطلب من الله النجاة من النار أو دخول الجنة ولا يطلب لقاءه والذي يكون هدفه الأصلي ومعبوده الواقعي هو الخلاص من النار ودخول الجنة بحيث يجعل الله وسيلة لبلوغ مثل هذا المعبود وليس هدفا ومقصودا بالذات، فعبادته باطلة. وهذا هو مقصود من قال ببطلان عبادة من كان هدفه نيل الجنة والنجاة من النار، لأنه من كان حاله هكذا فهو ان تمكن من دخول الجنة بدون عبادة الله فإنه ما كان ليعبد الله (راجع كتاب (صهباي حج، ص363).
طبعا على الرغم من ان المعبود بالذات لأكثر الناس هو الله، ولهذا فإن عبادتهم صحيحة لكن لا يعلمون ان طلب غير الله من الله علامة على كسل الإنسان وفقدان همته: "... لا نريد منك غيرك ولا نعبدك بالعوض والبدل كما يعبدك الجاهلون بك، المغيبون عنك" (تفسير الصافي، ج 1، ص 72).
6. جاء في القرآن الكريم تعبيران في هذا المجال: فالأول عن النبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) حبيب الله حيث ذكر الله اولا ومن ثم ذكرت آيته وهو نبي الإسلام (صلى الله عليه واله وسلم) ، وذلك في قوله تعالى: {إن الله معنا}(سورة التوبة، الآية 40) وفي التعبير الثاني الذي ورد عن النبي كليم الله موسى(عليه السلام) وفيه ذكرت الآية والعلامة على الله أولا ثم ذكر اسم الله: {إن معي ربي} (سورة الشعراء، الآية 62) ومن هذين التعبيرين يظهر ان حبيب الله يرى الله أولا وبنوره يرى نفسه، لكن كليم الله يبدأ من نفسه بما هو آية الله ويجعل من نفسه مقدمة لرؤية الحق، فتعبير: {إن معي ربي} بالنسبة إلى النبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) الذي بلغ مقام شامخا يعد تعبيرا ذا درجة متوسطة.
7. نهج البلاغة، الخطبة 186، المقطع 17.
8. البحار، ج 3، ص 327.
9. الصحيفة السجادية، الدعاء 45.
10. نفس المصدر، الدعاء 12.



|
|
|
|
هل يمكن للدماغ البشري التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم؟
|
|
|
|
|
|
|
علماء: طول الأيام على الأرض يزداد بسبب النواة الداخلية
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يشرك طلبة الدورات الصيفية بمحفلٍ قرآني في محافظة بابل
|
|
|