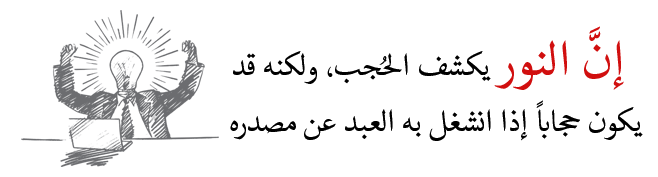
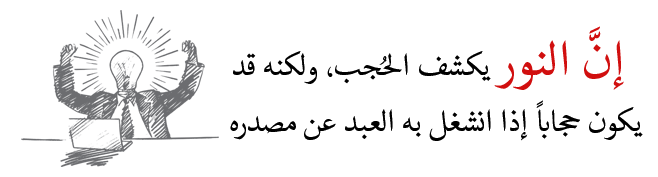

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-11
التاريخ: 8-10-2014
التاريخ: 2024-08-13
التاريخ: 8-10-2014
|
قال تعالى : {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى
قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ
لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى
حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [البقرة : 259]
لقد كشفت المناقشة الفكرية بين إبراهيم ـ
عليه السلام ـ وبين نمرود عن صمت هذا الأخير وكأن حجرا ألقي في فمه.
لقد زعم نمرود انه قادر على أن يحي ويميت.
ولما قال له إبراهيم ـ عليه السلام ـ : ان الله يأتي بالشمس من المشرق ، فأت بها
من المغرب... عندئذ بهت ، وتلفع بالصمت المطبق.
وعندما نعود إلى النصوص المفسرة ، نجدها قد
نقلت جانبا آخر سبق هذه المناقشة ، وهو : زعمه بأن اطلاق سراح سجين مثلا ، وعدم
اطلاق السجين الآخر يعد إحياء لحياة الأول ، واماتة لحياة الآخر.
لكن هذه المغالطة ، سرعان ما أسكتته ، عندما
قال له إبراهيم : أحيي القتيل ، أي : السجين الآخر.... وعندها سكت نمرود...
لكن إبراهيم ـ عليه السلام ـ أراد قطع كل
طريق للمغالطة ، بحيث لا يدع مجالا لأية مراوغة في هذا الصدد ،... لذلك ، قال
لنمرود : إت بالشمس من المغرب... وعندها سكت نمرود تماما ، ولفته الحيرة
والاضطراب. والحق ، ان أمثلة هذه المناقشة لا تكشف عن سخف وهزال المنكرين لحقيقة
السماء فحسب ، بل تنطوي على جملة من الحقائق ، منها :
أن الشخصيات التي تعنى بالملك الدنيوي ،
وسائر أمتعة الحياة ، يحجزها مثل هذا المتاع عن التفكير بحقيقة الانسان ومعنى
وجوده العبادي في الأرض.
ومنها : ان إنكار حقيقة السماء ، لا يستند
إلى أية حجة حتى لو كانت واهية ، لأن هذه الحقيقة واضحة كل الوضوح ، يضطر المنكر
لها إلى أن يصمت في نهاية المطاف.
ومنها : إن كلا من الإحياء والاماتة ، وسائر
الظواهر ، تظل مرتبطة بالسماء مهما دق تصورها في هذا الصدد.
ولعل هذه الظاهرة الأخيرة ، تكفلت بتحديدها
، أقصوصتان أعقبتا قضية إبراهيم ـ عليه السلام ـ مع نمرود ، وألقتا على الموقف
إنارة جديدة فيما يتصل ببعض أسرار التركيبة البشرية ، وطريقة معرفتها بحقائق
السماء ، ومنها : حقيقة الاحياء والاماتة بخاصة. وأولى هاتين الاقصوصتين ، أقصوصة
القرية الخاوية على عروشها.
فلنقف عندها ، مفصلا...
تقول الأقصوصة :
{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ
بَعَثَهُ
قال : كَمْ لَبِثْتَ ؟
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ
قَالَ
بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ
يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ
إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
إن هذه الأقصوصة الممتعة فكريا وفنيا ، تظل
حائمة على نفس ظاهرة الإماتة والاحياء ، لكنها تصب في رافد آخر.
انها تتحدث عن واقعة حدثت فعليا ، هي إماتة
القرية ، ثم إماتة شخصية ، وإحياءها من جديد...
الأقصوصة السابقة [إبراهيم مع نمرود] تحدثت
عن الإحياء والإماتة على نحو الإجمال ، وكانت (الواقعة) المستشهد بها حقيقة كونية
ثابتة هي طلوع الشمس من المشرق ،... وكان المنكر لحقيقة الاماتة ولأحياء ، شخصية
هزيلة ، اضطرت إلى الاقرار بحقيقة الامر عندما واجهت قضية الشمس.
أما هنا في أقصوصة القرية الخاوية ، فان
الأمر مختلف كل الاختلاف. فالشخصية [بطلة القصة] مؤمنة بالسماء ، وبالأحياء
وبالإماتة ، وبكل شيء... انها احدى الشخصيات (النبوية) قد تكون (إرميا) ، وقد تكون
(عزيرا) ،... لكنها ـ على أية حال ـ ذات سمة ليست مثل البشر العاديين ، بل من
الشخصيات المتميزة التي تتلقى تعاليمها من السماء وحيا.
والتجربة التي واجهت هذه الشخصية من نمط آخر
أيضا. انها تتصل بقرية ميتة باد اهلها وعمرانها ،... وتتصل بالشخصية المارة على
هذه القرية ، حيث أماتها الله ، وبعثها بعد مائة عام ، ... ومثل ذلك قضية الدابة
والطعام اللذين شكلا راحلة المسافر وزاده... إذن : الاحداث ، والمواقف ، والشخصيات
في الأقصوصتين تتمايز من واحدة لأخرى... كل ما في الأمر ان قضية واحدة هي :
[الاماتة والاحياء] تظل مادة مشتركة بينهما.
والسؤال : ما هي دلالة الأقصوصة [القرية
الخاوية] فكريا وفنيا ؟
من حيث (البيئة) ، فان القرية قد رسمت خاوية
على أبنيتها. وهذا المظهر الخارجي للمدينة ، يشيع الرهبة والوحشة في النفوس ، حيث
نتحسس أرضا خالية من دبيب البشر ، خالية من العمارة ، خالية من كل مظهر حضاري ،
إلا أنقاض الأبنية.
وتقول النصوص المفسرة ، أن (بختنصر) ، زحف
عيها وأبادها ، وكان أهلها ـ كما نتوقع دائما ـ من اليهود الذين عملوا بالمعاصي ،
فانتقم الله منهم ، بطاغية من طرازهم ابادهم من المدينة تماما. وتضيف النصوص
المفسرة : ان سباع البر والبحر والجو كانت تأكل من الجيف المتمزقة هنا وهناك.
المهم ، ان هذه المدينة ، خرج إليها ذات يوم
، أومر عليها (إرميا) ، ومعه دابته وزاده. ويعنينا من هذه (البئية) رد الفعل الذي
أحدثته في نفس [المسافر ـ إرميا] ، عندما وجدها بهذه الوحشة ، مما جعلته يتساءل :
{ أنى يحيي هذه الله بعد موتها ؟ }
طبيعي ، ان هذا التساؤل ، لا يحمل عنصر
(تشكيك) بالسماء وقدراتها اللامحدودة ، بقدر ما يحمل شحنة انفعالية فجرتها تلك
اللحظة التي تركت في نفس (إرميا) مشاعر الرهبة والوحشة والاختناق ، حتى جعلته
يتحاور مع نفسه قائلا بما معناه : لقد بادت هذه المدينة ، ومسحت من خارطة العمران
، ولا أمل بأن يحييها الله من جديد.
نقول هذا ونحن لا يخامرنا شك في ان الشخصيات
(النبوية) من الممتنع أن يصدر عنها أي تشكيك بقدرات السماء : كل ما في الأمر ، ان
موقف (إرميا) يشبه موقف من يشاهد احدى المدن التي أبادتها الحرب وحولتها إلى أنقاض
، مما يجعله ـ في مثل هذه الحالة ـ مستبعدا أي أمل بعودتها جديدا بعد هذا الخراب.
وبكلمة أخرى ، يمكننا أن نقول ، ان الشخصية
المذكورة ، نظرت إلى الأسباب التي جعلها الله موقوفة على هذه الظاهرة أو تلك ، دون
أن تتجاوزها الشخصية المذكورة إلى التماس ما هو خارج عن نطاق المألوف...
من هنا ، جاء رد السماء سريعا على التساؤل
المذكور ،... فعرض هذه الشخصية ذاتها إلى ظاهرة غير مألوفة فيما يتصل بالإحياء بعد
الموت... فأمات هذه الشخصية مائة عام ، ثم بعثها من جديد... حتى تطمئن تماما إلى
أن الله قادر على كل شيء.
وقد رافق إحياء هذه الشخصية ، أكثر من ظاهرة
، تشكل بمجموعها إجابة واضحة على التساؤل المذكور.
ويعنينا الآن ، أن نفصل الحديث [من الزاوية
الفنية] في ظاهرة الإماتة ولأحياء في نطاق هذه الشخصية ، وما عكسته من أثار في
استجابتها لهذه الظاهرة ، وما نفيد منه ـ نحن القراء ـ في هذا الصدد.
قلنا ، إن المار على المدينة الخاوية [وهو
إرميا] قد تساءل :
(أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟).
وقد أماته الله مائة عام منذ تلك اللحظة اتي
تساءل فيها ، ثم : بعثه من جديد..
هنا ، بعد الانبعاث ، ماذا نتوقع من ردود
الفعل لدى هذه الشخصية الميتة ، المنبعثة ؟ تقول القصة : انه سئل : كم لبثت في
نومك؟ فأجاب : لبثت يوما أو بعض يوم.
(قال : كم لبثت؟
قال : لبثت يوما ، أو بعض يوم).
المار على القرية ، كان ـ فيما يبدو ـ
مسافرا لوحده.
ونحن نتوقع أن يكون لوحده أيضا في لحظة
انبعاثه...
فمن الذي سأله وقال له : كم لبثت؟ ولمن وجه
المسافر جوابه حين قال : لبثت يوما أو بعض يوم ؟
القصة ساكتة عن كل هذا...
لكننا ـ ونحن حيال قصة فنية ـ يمكننا أن
نستكشف من خلال لغة الفن ، ان السائل لا بد ان يكون خارجا عن نطاق المألوف... فكما
أن إماتة شخص وإحياءه بعد مائة عام. ، خارج عن نطاق المألوف... فكذلك : يلوح لنا
أن السائل أيضا غير مألوف...
النصوص المفسرة تقول : ان السؤال كان نداء
من السماء ، أو شخصية ملائكية ، أو شخصية نبوية ، أو شخصية معمرة... وكل ذلك من
المكن أن يكون صحيحا...
فنحن أمام شخصية أحد الأنبياء... ونتوقع ـ
فنيا ـ أن تتعامل مثل هذه الشخصيات مع السماء من خلال شخوص الملائكة الذين هم رسل
السماء إلى الأرض...
كما انه من الممكن أن تكون السماء قد أحضرت
ـ في لحظة الانبعاث ـ احدى شخصيات الأرض ، ليطلع (إرميا) على حقيقة الأمر...
والمهم ـ من الزاوية الفنية ـ ان القصة لم
تكشف عن السائل ، بل تركتنا ـ نحن القراء ـ نستخلص بأنفسنا ذلك... ما دام الهدف هو
: إخبار (إرميا) بحقيقة الأمر...
والأهم من ذلك كله : ان عملية السؤال نفسه ،
ظاهرة (اعجازية) تضاف إلى الظاهرة الاعجازية التي سبقتها ، وهي : إماتة إرميا مائة
عام وإحياءه بعد ذلك : حتى لكأن القصة تريد أن تقول لنا : ها هو المسافر (إرميا)
يواجهه معجز بعد معجز حتى يطمئن إلى ان الله قادر على كل شيء ، وإلى أنه لا ينبغي
أن يخامرنا أدنى شك ، أو تأمل أو تساؤل عن كيفية إحياء المدينة بعد تحولها إلى
أنقاض.
هنا ، ينبغي أن نقف وقفة قصيرة عند عنصر
(الزمن) في هذه الاقصوصة.
فالزمن (المعجز) طابع هذه الأقصوصة : كما
لحظنا.
إن (إرميا) قد افتقد الإحساس بالزمن ، حتى
خيل إليه أن نومه كان يوما أو بعض يوم ، على نحو مانلحظه عند أصحاب الكهف الذين
لبثوا ثلاثمائة وتسعة أعوام ، فخيل إليهم أنهم لبثوا في الكهف يوما أو بعض يوم...
ونتساءل هنا : لماذا خيل للمار على القرية
انه لبث يوما أو بعض يوم؟
القصة ساكتة عن ذلك : لأسباب فنية لا تحتاج
إلى توضيح.
لكن النصوص المفسرة ، تلقي نورا على مصدر
الاحساس المذكور ، قائلة : ان هذه الشخصية نظرت إلى الشمس ، فوجدتها قد ارتفعت...
وحينئذ خامرها الإحساس بانه يوم أو بعض يوم.
بيد ان القصة وهي تستهدف ترسيخ اليقين
بقدرات السماء ، سرعان ما صححت الاحساس الواهم بالزمن لدى هذه الشخصية ، فاوضحت
لها على لسان الملك أو النداء أو النبي الآخر ، أو المعمر ، قائلة له :
(بل لبثت مائة عام...).
هنا ، لا بد أن تصيب الصعقة أو الدهشة شخصية
المنبعث حينما يصحح إحساسه بالزمن الحقيقي ، فيجد نفسه أمام مفاجأة إعجازية جاءت
جوابا على تساؤله :
{ أنى يحيي هذه الله بعد موتها ؟ }.
لكن السماء لم تكتف بهذا الملمح الاعجازي ،
بل تقدمت بملامح اخرى ، ألفتت إنتباه هذه الشخصية إليها ، حتى تعمق يقينه بقدرات
السماء...
فما هي هذه الملامح؟؟
لكل مسافر ، راحلة وزاد....
لقد قالت القصة عن شخصية (إرميا) ما يلي :
(كالذي مر على قرية).
وهذا يعني ان [المار على القرية] هو :
(مسافر) يتنقل من مكان إلى آخر.
والمسافر ـ عصرئذ ـ [وحتى الى عهد قريب] ،
كانت راحلته أو وسيلة ركوبه هي (الدابة).... وطبيعي ، فإن سير الدابة يظل بطيئا
بالقياس إلى سير الحافلة أو القاطرة أو الطائرة مثلا.... ونتيجة لهذا البطء ، فإن
قطع عشرات الكيلومترات أو المئات أو الآلاف ، يظل مستغرقا اياما أو أسابيع أو
شهورا.... وهذا ما يتطلب ان يهيئ المسافر (طعاما) بقدر ما تستغرقه رحلته...
وهكذا ، كان من أمر بطل الأقصوصة (إرميا).
القصة لم تقل لنا أن إرميا ركب حماره واصطحب
معه طعامه ، وسافر على هذه المدنية أو تلك. انما قالت لنا :
{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا}
إن هذه السمة [كالذي مر على قرية] ، تعني ان
(إرميا) كان (مسافرا) ، بدليل : انه [مر على قرية]... والمار على المدينة يحتاج
إلى زاد وراحلة...
ولكن كيف استخلصنا ذلك؟؟
الفن العظيم هو الذي يتكفل بتوضيح ذلك ، من
خلال لغة الفن القصصي.
فلنستمع ـ إذن ـ إلى الحوار الدائر بين
(إرميا) وبين (السائل) الذي قال له بانك قد لبثت مائة عام ، وليس يوما أو بعض يوم.
قال السائل ، وهو ينبه بطل الأقصوصة إلى خطأ
تصوره من أنه لبث يوما أو بعض يوم ،... قال له :
{فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ} [البقرة : 259]
قد يتساءل القارئ : ما هي علاقة الطعام
والشراب والدابة بالأقصوصة؟
ولماذا؟ تعرضت للطعام والشراب والدابة ، ولم
تتعرض لظواهر أخرى من البيئة؟؟
كان من الممكن أن تنبه الأقصوصة بطلها
(إرميا) إلى هيكله الجسمي مثلا من طول أظافره وشعره ، وبلى ملابسه : كما سبق أن
نبهت قصة اصحاب الكهف إلى ذلك عندما قالت لنا :
(لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت
منهم رعبا).
حيث كانت أشكالهم تثير الرعب والهول في نفوس
المشاهدين ، نظرا للبثهم عدة قرون في الكهف.
هنا ، تنبثق أهمية الفن في القصص القرآن
العظيم.
إن (إرميا) بطل الأقصوصة ، كان (مسافرا)...
والمسافر لابد له من زاد وراحلة... وبما انه كان (مسافرا) يركب (دابته) ، ويصطحب
معه (طعامه) و(شرابه) ،... فحينئذ ، تعرضت القصة لهذا الجانب دون سواه من الظواهر
المحيطة به... فالفتت انتباهه إلى طعامه وشرابه ودابته ، وقالت له :
(فانظر إلى طعامك وشرابك ، لم يتسنه. وانظر
إلى حمارك).
إذن : أدركنا السر الفني الممتع لهذه
الأوصاف المتصلة بيئة الطعام والشراب والدابة ، دون سواها من الأوصاف التي كان من
الممكن أن تنبه بطل الأقصوصة إلى ذلك.
ولكن : لا تزال هناك أسرار فنية جديدة في
هذا النطاق ، يتعين علينا متابعتها.
قلنا : إن القصة عندما تعرضت للطعام والشراب
والدابة ، وطالبت البطل (إرميا) بان ينتبه إليها ،... إنما كان ذلك ، بسبب فني
محكم هو : كون البطل كان (مسافرا) يصطحب معه طعاما وشرابا يقتات منه في رحلته ،
ويستخدم الدابة في ركوبه... حيث انتهى الأمر بالبطل إلى أن يميته الله مائة عام ،
ويبعثه بعد ذلك ، وينبهه إلي أنه لم يلبث يوما أو بعض يوم ، لم لبث مائة عام …. ثم
ينبهه إلى الطعام والشراب والدابة ، وإلى ما رافق هذه العناصر الثلاثة من مظاهر ،
سنتعرض لها بعد قليل...
لكننا قبل ذلك ، ينبغي أن نتعرف على سمة
فنية أخرى في هذا القسم من الاقصوصة..
الأقصوصة لم تقل لنا : أن بطلها (إرميا) كان
قد اصطحب معه طعاما وشرابا ، وانه ركب دابته عند مروره على المدينة الخاوية ،
واستفساره :
{أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا}
بل ، تعرضت لبيئة السفر (من طعام شراب
ودابة) من خلال تنبيه البطل إلى خطأ إحساسه بالزمن ، وإلى عدم إحساسه بأنه قد تعرض
لاختبار إلهي معجز هو : إماتته مائة عام ، وإحياؤه بعد ذلك... خلال هذا الاختبار ،
أو الحادثة الاعجازية فحسب ، نبهت الأقصوصة بطلها إلى أن ينظر إلى طعامه وشرابه
ودابته... وحنيئذ أدركنا ـ نحن القراء ـ من خلال هذه الوسيلة الفنية ، ان (إرميا)
قد صحب معه ما يصحبه المسافر عادة من (الزاد) ، وما يستخدمه عادة من (الراحلة) ،
وإلى أن كلا من [الزاد والراحلة] يفسران لنا أسرار الفن الذي جعلنا نتساءل عن تعرض
الاقصوصة لهما ، دون سواهما من عناصر (البيئة) التي أحاطت بالبطل ، وجعلته يفتقد
عنصر الاحساس بالزمن ، حتى خيل إليه انه لبث يوما أو بعض يوم.
والآن : بعد أن أدركنا ذلك كله ، يحسن بنا
أن نقف عند كل من الزاد والراحلة ، أي : الطعام والشراب والدابة ، ونتعرف أسباب
التنبيه إليها من حيث صلة ذلك بالاعجاز ، وبقدرات الله التي لا تحد ، وبسائر
الدلالات الفكرية التي تستهدفها السماء في هذه الاقصوصة ، وما يمكننا ـ نحن القراء
ـ من الافادة منه في تصويب سلوكنا وطريقة تعاملنا مع الله ـ عز وجل ـ وصلة ذلك
بدرجات اليقين ومستوياته التي ينبغي أن نكون عليها : خلال مهمتنا الخلافية في
الأرض.
قلنا : ان عنصر [الزمن المعجز] يمثل الملمح
الرئيسي في هذه الأقصوصة.
ان بطل الأقصوصة حينما فقد إحساسه بالزمن ،
وخيل إليه أنه لبث يوما أو بعض يوم... فلأن الأعوام لم تغير ـ في تصوره ـ شيئا من
ملامح البيئة التي واجهها.
وقد نبهت القصة بطلها إلى أن ينظر الى طعامه
وشرابه ودابته ، ثم طالبته بأن ينظر إلى العظام كيف تنشر ، وإلى اللحم كيف يكسوها…
.
والسؤال هو : لماذا طولب البطل بأن ينظر إلي
طعامه وشرابه ودابته قبل النظر إلي العظام واللحم؟؟ وهل العظام واللحم ، عائدان
إلى البطل أم إلى الدابة؟؟ وإذا كان البطل واعيا بان عظامه قد انتشرت ، فلماذا
إلتبس الأمر عليه ، فقال : بأنه لبث يوما أو بعض يوم؟؟
إن الاجابة على هذين السؤالين ، ينطويان على
جملة من أسرار الفن العظيم في القصص القرآني...
ولكي نتبين بوضوح أسرار الفن في هذا الصدد ،
يحسن بنا أن نتبسط في تحليل الظاهرة...
لقد بعث البطل بعد مرور مائة عام على
موته... قيل له : كم لبثت في النوم؟ قال : يوما أو أقل منه.
قيل له ، لا أنك قد اخطأت.. لقد لبثت مائة
عام في نومك.. هنا ، تعجب البطل... ولكن طولب بان ينظر الى طعامه وشرابه ، وقد كان
عصيرا وتينا وعنبا... قيل له : انظر الى العصير والتين والعنب... إنها لم تتغير
خلال المائة عام... ثم قيل له : انظر إلى العظام واللحم ، كيف يحييها الله وكيف
يكسوها.
إلى هنا ، نفهم : ان تنبيه البطل إلى عدم
تغير الطعام والشراب خلال مائة عام ، يعني : ان (الإعجاز) وراء هذه الظاهرة…
كما نفهم : إن مطالبته بالعظام المنتشرة
وكيفية إعادتها واكتسائها باللحم ، ينطوي على (الاعجاز) ذاته.
ولكن : هل ان هذه العظام عظامه هو ام عظام
دابته؟
إذا كانت العظام عظام دابته فلماذا شوهدت
متفسخة : ثم اعيدت الى الحياة؟ في حين ان العصير والتين والعنب : لم تخضع
للتغير...
اذن : لا بد هناك من سر فني ، في إبقاء بعض
الظواهر محتفظة بحيويتها كالطعام والشراب ، وفي اخضاع البعض الآخر الى التغير ثم
الى إعادتها كما هي مثل العظام واللحم.
واذا كانت العظام عظام البطل نفسه وليس عظام
الدابة!!
فيكف استطاع ان ينظر اليها (وهو نفسه متفسخ
العظام واللحم)؟؟... أيضا : لا بد هناك من سر فني وراء هذا ... ثم يثار سؤال آخر :
سواءا كانت العظام المتفسخة التي عادت إلى الحياة... ، عظامه هو أو عظام دابته!!
لماذا طولب بالنظر إليها بعد النظر الى الطعام والشراب؟؟
للمرة الجديدة : الاجابة على هذه الاسئلة ،
تكشف عن خطورة الفن القرآني العظيم ، وما يواكب ذلك من دلالات لها فاعليتها في
تصويب سلوكنا الفكري حيال قدرات الله عز وجل...
في تصورنا الفني الخالص : ان هدف القصة هو :
إراءة البطل بان الله قادر على كل شيء بما في ذلك : تغيير السنن الكونية التي
رسمها الله موسومة بطابع الثبات... ولكي يتم تحقيق ذلك ، كان لا بد ان تجعل القصة
بطلها غير منتبه الى تركيبته البدنية ، بل تصرفه الى قضية الطعام والشراب أولا...
والسبب في ذلك [من الزاوية الفنية] أن القصة
لو جعلت البطل ينتبه الى نفسه أولا : لما التبس الأمر عليه حينئذ ، ولما قدر له ان
يتخيل بان لبثه كان يوما أو بعض يوم.. إذ لو شاهد اجزاء جسمه أو دابته متقطعة ،
لتيقن حينئذ بانه مكث اعواما... في حين ان القصة تريد ان تنبهه الى خطأ تصوره ،
فكان لا بد من ان تنبهه اولا على الطعام والشراب [حتى يغفل عن حقيقة الامر, وبعد
ذلك تنبهه الى العظام واللحم ، وكيفية إعادته إليها.. وعندها تيقن تماما ، ويطمئن
الى (الاعجاز) الذي رافق هذه العملية.
بكلمة أخرى : كان لا بد من ان تجعل القصة
بطلها (على الاقل : في لحظة توجيه السؤال اليه ، او لحظة انبعاثه) ذا هيئة بدنية
طبيعية ، حتى يلتبس عليه الامر ، فيتصور بانه لبث يوما او بعض يوم... وبعد انتهاء
هذه المرحلة تنبهه إلى اشياء جديدة يبدأ معها في تعرف حقيقة الأمر...
وبهذه الوسيلة أو الطريقة النفسية ، يتحقق
هدف الاقصوصة في تحسيس بطلها بان الله قادر على كل شيء : قادر على إحياء القرية
الخاوية بمثل قدرته على احياء ميت مرت عليه مائة عام.
وهذا كله إذا تصورنا ان العظام واللحم عائدة
إلى البطل. والامر نفسه اذا تصورناها عائدة الى الدابة (لكننا نستبعد هذا التصور
الاخير لاسباب فنية نشرحها فيما بعد) ، وحتى مع افتراض صحة هذا التصور ، فان
مشاهدة اجزاء الدابة متفسخة ، تجعل البطل منتبها الى الحقيقة منذ البدء ، فلا يخيل
اليه انه لبث يوما أو بعض يوم... اذن : ادركنا أهمية السر الفني الذي جعل القصة
تنبه البطل أولا الى قضية الطعام والشراب ،... ثم تنبهه الى العظام واللحم بعد
ذلك...
لكن : هناك اسرار فنية عظيمة أخرى ، تتصل
بنفس الطعام والشراب والدابة ، ينبغي ان نقف عندها.
منذ اللحظة الاولى من إحياء البطل بعد موته
مائة عام... طالبته الاقصوصة بان ينظر الى طعامه وشرابه...
إن هدف هذه المطالبة بالنظر الى الطعام
والشراب ، هو : لفت انتباه بطلها إلى ان مائة عام من الزمن لم تغير شيئا من الزاد
الذي كان البطل قد اصطحابه في سفره.
تقول القصة :
{فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّهْ}
أي : لم تغيره الاعوام.
وتذهب النصوص المفسرة الى ان الطعام والشراب
، كان من النوع الذي يفسد سريعا مثل : العنب والتين والعصير.
وهذا يعني ، ان الاقصوصة قدمت للبطل دليلا
(اعجازيا) يتمثل في قدرة السماء على كل شيء ، ومنه : احتفاظ الطعام والشراب
بحيويتهما رغم مرور مائة عام عليهما ، مع انهما من النوع الذي يتغير ، ويفسد خلال
أيام معدودة... ولازم هذا (فنيا) : أن الله قادر على احياء القرية الخاوية ايضا...
هكذا سلكت القصة فنيا في حمل بطلها على
القناعة بقدرة الله عز وجل...
لكن السؤال هو : بعد ان نبهت القصة بطلها
بانه قد مرت عليه مائة عام ، وبان طعامه وشرابه لم يتغيرا خلال هذه المدة... هل
اكتفت بذلك؟ أم قدمت دليلا آخر؟
قد يخامر القارئ والسامع بعض التساؤل ، وهو
: ان مشاهدة البطل لطعامه وشرابه لم يتغيرا من الممكن ان يزيده قناعة بانه لبث
يوما أو بعض يوم ، وإلا تلف الطعام والشراب ، ولم يبق لهما أي أثر...
ان مثل هذا التساؤل ، يحل سريعا ، إذا اخذنا
بنظر الاعتبار ، ان مجرد انتباهه [عن طريق النداء أو الملك] الى انه لبث مائة عام
كاف في تعرفه على حقيقة الأمر...
لكن الملاحظ ، ان القصة لم تكتف بهذا الدليل
الاعجازي ، بل نبهت البطل الى دليلين إعجازيين آخرين ، هما : النظر الى الدابة ثم
النظر الى العظام واللحم قد التما من جديد وأعادا الحياة الى البطل او الدابة.
إن هذين الدليلين يقفان على العكس من الدليل
السابق.
الدليل السابق هو : أبقاء الشيء على ما هو
عليه طوال مائة عام ، وهو : الطعام والشراب... اما الدليلان الاخيران ، فهما على
العكس من ذلك... أنه : تلاشي الشيء ثم اعادته الى الحياة من جديد... والفرق كبيرـ
كما هو واضح ـ بينهما... فما هو السر الفني في ذلك؟
في تصورنا الفني لهذه الظاهرة : ان الاقصوصة
تستهدف تقديم كافة الوجوه المعبرة عن (قدرات الله) عز وجل ، ذات الصلة بالإماتة
والإحياء.
ان السماء : كما تستطيع أن تبقي الشيء
محتفظا بحيويته ، قادره أن تعيد حيوية الشيء أيضا بعد تلاشيه... الطعام بقي محتفظا
بحيويته رغم انه ينبغي ان يتلاشى... وها هي الدابة قد تلاشت حيويتها ، أو ها هو
البطل قد تلاشت حيويته ، ولكن : عادت الحيوية إليهما من جديد ، رغم انهما ينبغي
ألا يعودا...
اذن : هناك ظاهرتان تضاد احدهما الأخرى ،
لكنهما خاضعتان لطابع واحد هو : قدرات الله ـ عز وجل ـ بشكلها غير المحدود...
ومن البين ، ان تقديم دليلين لعمليتين
متضادتين ، يزيد من قناعة البطل بقدرات السماء...
لكننا ، خارجا عن ذلك ، نجد ان الاقصوصة
تلفع الموقف بضباب فني ممتع غاية الامتاع ، حينما تسرد لنا قضية الدابة ، وقضية
عودة العظام واللحم...
ففيما يتصل بالدابة ، قالت الاقصوصة موجهة
الخطاب الى بطلها (وانظر الى حمارك)... والسؤال هو : هل ان (الدابة) ظلت محتفظة
بحياتها طيلة مائة عام على نحو ما لحظناه في الطعام والشراب؟ أم ان الدابة قد
تلاشت وأعيدت الحياة اليها في لحظة انبعاث البطل؟؟
القصة ساكتة عن توضيح ذلك تماما... انها
طالبت البطل بان ينظر الى الدابة دون ان تشير الى استمرارية حياتها أو عودة الحياة
اليها... نعم... طالبت البطل بعد ذلك ، بما يلي :
{وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا }
ولكن : هل هذه العظام ، وهذا اللحم عائدان
الى البطل أم الى الدابة؟
القصة أيضا ، ساكتة عن ذلك... والقارئ لا
يستطيع أن يجزم بشيء... بل يبقى في نشاط ذهني متواصل لمعرفة الحقيقة... القارئ لا
يستطيع ان يجزم [قبل الرجوع الى النصوص المفسرة] بان العظام واللحم قد التمت من
جديد وعادت الى البطل ، لان البطل لو كان فاقدا لبدنه ، كيف يستطيع ان يشاهد عظامه
وقد التئمت واكتسيت باللحم؟... مضافا لذلك ، إذا كان البطل قد شاهد عظامه ولحمه قد
عادا إليه ، فلماذا التبس الامر عليه ، وقال : لبثت يوما أو بعض يوم ؟؟ وبكلمة
أخرى : ان البطل كان غير واع أبدا بحقيقة العظام واللحم ، وإلا لانتبه إلى حقية
(الاعجاز) ، وانتبه الى انه قد لبث مدة مجهولة لا يعرف مداها ، لا انها يوم أو بعض
يوم...
وبالمقابل... لا يستطيع القارىء ايضا أن
يجزم بأن العظام واللحم ، عائدان الى الدابة ، لانه لو شاهد مثل هذه الحادثة لما
التبس عليه الامر ، وتخيل انه لبث يوما أو بعض يوم ،... بل لانتبه الى ذلك...
وبكلمة اخرى ايضا... لو شاهد البطل عظام الدابة ولحمها قد أعيدا ، حينئذ لأجاب السائل
الذي سأله : كم لبثت؟ لأجابه بعدم العلم...
اذن : يظل القارئ والسامع في حيرة من أمره
قبال الجزم بهذا الشيء أو ذاك...
لكن الفن العظيم هو الذي يثري ذهن القارئ
ويعمقه بهذا النمط من الاستجابة حيال القصة : إذ ان كلا من الاحتمالين يعبر عن
(الاعجاز) ذاته : سواء اكانت العظام واللحم عائدة الى البطل ام الى الدابة...
المهم هو : لفت انتباهنا الى (الاعجاز)... وقد تحقق ذلك... أما التفصيلات فأمر آخر
يستطيع القارئ أن يتعرفها في نصوص التفسير ، أو يتعرفها من خلال لغة (الفن) اذا
كان القارئ خبيرا بفن القصة... وهذا ما نحاول الوقوف عليه : فنتقدم أولا إلى
النصوص المفسرة ، ثم نعرض وجهة نظرنا الفنية في هذا الصدد.
فيما يتصل بالنصوص المفسرة ، فانها مترددة
بين الذهاب الى ان العظام واللحم ، عائدان الى البطل ، وبين الذهاب الى انهما
عائدان الى الدابة.
لكن نصا مأثورا عن أهل البيت عليهم السلام ،
يؤكد بان العظام واللحم عائدان الى البطل ،... ويقول هذا النص : ان اول ما خلق من
تركيبة البطل ، عيناه ، حيث شاهد بهما بعد مطالبته بالنظر الى الطعام والشراب
والدابة ، شاهد بهما عظامه يلتئم بعضها بالآخر ، وعروقه تجري فيه.
وفي تصورنا الفني الخالص ، أن هذا التفسير
أقرب الى الواقع ، لا لأنه مأثور عن أهل البيت ـ عليهم السلام ـ فحسب ، بل لان
الادلة الفنية أيضا تسعفنا في ذلك.
وقبل ان نتقدم بوجهة نظرنا النفية مفصلا ،
ينبغي لفت الانتباه الى ان ادراك هذه الحقيقة الفنية أو تلك ، انما يكتسب اهميته
بقدر ما تنطوي عليه الحقيقة الفنية من دلالة (فكرية) تستهدفها القصة في تطبيع
سلوكنا حيال السماء وقدراتها التي ينبغي ألا يتسلل الشك إليها حتى في نطاق تغيير
القواعد التي طبعتها السماء بسمة (الثبات).



|
|
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
|
|
بالفيديو: لتعريفهم بالاجراءات الخاصة بتحقيق وترميم المخطوطات.. مركز الإمام الحسين (ع) يستقبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بابل
|
|
|