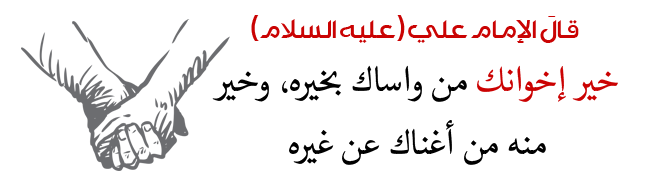
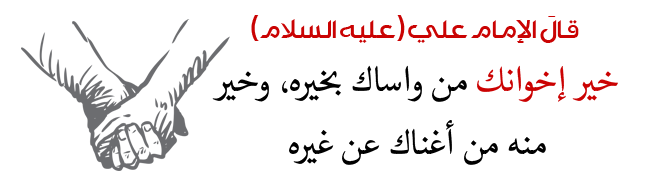

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-4-2019
التاريخ: 17-4-2019
التاريخ: 17-4-2019
التاريخ: 17-4-2019
|
مدخل:
يلاحظ أن جميع المعاجم التي سبق ذكرها قد رتبت بحسب الحروف الساكنة "أو ما يمكن أن يسمى بالصوامت أو السواكن Cansonants" دون اعتبار الحركات "أو ما يمكن أن يسمى بالصوائت أو العلل Vowels" سواء في ذلك ما قام بتجريد الكلمة من الزوائد -وهو النوع الغالب- أو ما وضع الكلمات تحت حرفها الأول دون تجريدها من الزوائد.
أما هذا النوع من المعاجم الذي سميناه بمعاجم الأبنية؛ فقد كان نوعًا فريدًا في بابه إذ راعى في ترتيب الكلمات الحركة إلى جانب الصوت الساكن. ولكنه -من سوء الحظ- لم يكتب له الشيوع والشهرة نظرًا لتعقد نظامه وتركبه من خطوات عدة.
وعلى الرغم من أن أول معجم كامل اتبع نظام الأبنية قد ظهر في القرن الرابع الهجري على يد مؤلف من تركستان، من إقليم فاراب اسمه أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي؛ فقد تمت محاولات كثيرة لدراسة أبنية اللغة العربية وترتيبها منذ بدأ التفكير اللغوي عند العرب. وقد مهدت هذه المحاولات الطريق، ويسرت السبيل أمام ظهور فكرة المعجم الكامل.
وربما كان من المفيد -من أجل هذا- أن نقسم البحث في معاجم الأبنية إلى نقطتين أساسيتين نتناول في أولاهما مرحلة التمهيد، أو وضع اللبنات الأولى، ونتناول في ثانيتهما مرحلة المعجم الكامل، وأشهر المعاجم التي اتبعت هذه الطريقة.
ص269
أولًا: حرية التمهيد
بدأ التأليف في الأبنية على أيدي النحاة، وقد كان "سيبويه أول من ذكرها وأوفى من سطرها"(1)، ولذلك أفرد لها في كتابه أبوابًا جمع فيها ما عرفه من أبنية اللغة العربية وقسمها تقسيما كميًّا، مع فصل أبنية الأسماء عن الأفعال، ومثل لكل نوع منها، وقد ذكر للأسماء 308 بناء بين ثلاثي مجرد ومزيد، ورباعي مجرد ومزيد، وخماسي مجرد ومزيد. وذكر للأفعال 34 بناء بين ثلاثي مجرد ومزيد ورباعي مجرد ومزيد.
ومهد سيبويه لكلامه عن الأبنية بمقدمة تحدث فيها عن أقل ما تكون عليه الكلمة وأكثر ما تصل إليه وحروفها أصلية أو مزيد فيها. ثم تحدث عن حروف الزوائد حرفًا حرفًا، وذكر مواضع زيادة كل منها(2). ولم يكن من غرض سيبويه في هذا البحث أن يحصر ألفاظ كل بناء، وإنما كان غرضه يتجه إلى حصر الأبنية والتمثيل فقط كل منها.
وجاء النحاة بعد سيبويه فبهرهم هذا العمل، وأثار إعجابهم. فلم يقدموا لنا في الموضوع شيئًا ذا بال، وانحصر بحثهم في ناحيتين:
الأولى: الاستدراك على سيبويه وإضافة بعض الأبنية التي تركها. وقد فعل ذلك ابن السراج الذي ذكر أبنية سيبويه وزاد عليها 22 مثالًا، كما زاد أبو عمر الجرمي عليها أمثلة يسيرة، ثم زاد ابن خالويه أمثلة يسيرة (3)، وزاد الزبيدي أكثر من ثمانين بناء(4).
والثانية: يمثلها المبرد الذي حول البحث في الأبنية إلى عمليات تدريبية وافتراضات عقلية بدلًا من أن يحاول القيام بعمل إيجابي. فهو
ص270
لم يبحث الأبنية بحثًا عمليًّا يقوم على الاستقراء والتتبع، وإنما أطلق لفكره العنان، وأكثر من الفروض العقلية. ومن ذلك أنه عقد بابا باسم "هذا باب معرفة الأبنية وتقطيعها بالأفاعيل ... " قال فيه: "فإذا قال لك: ابن مَن "ضرب" مثل "جعفر" فقد قال لك: زد على هذه الحروف الثلاثة حرفا، فحق هذا أن تكرر لامه فتقول: "ضريب".. ولو قال لك: ابن لي من "ضرب" على مثال "صمحمح" لقلت "ضربرب" (5).
ولكن من حسن حظنا أن اللغويين لم يدعوا النحاة وحدهم في هذا الميدان يصولون ويجولون، وإنما شاركوهم فيه. وحولوا البحث في الأبنية مرة أخرى إلى بحث استقرائي تتبعي، وإن اتجهوا في البحث اتجاهًا آخر، فلم يعد هدفهم حصر الأبنية فقط -فهذا أمر قام به السابقون- وإنما اتجه إلى محاولة حصر الألفاظ تحت كل بناء، واتخذ ذلك مظهرين اثنين: فاتجه فريق إلى أن يفردوا في كتبهم اللغوية بحوثًا خاصة بالأبنية، واتجه فريق آخر إلى التأليف في الأبنية مؤلفات مستقلة.
أما الفريق الأول فلم تتسم بحوثه بطابع خاص، وإنما اتخذت أشكالًا متعددة. فمنها ما اهتم بأن يذكر من ألفاظ البناء ما يقع الاشتباه فيه ويدع ما عداها، ومنها ما اهتم بذكر الأبنية التي تعد ضبطها، ومنها ما تعرض لبعض الأبنية -بدون ضابط وذكر ألفاظها، ومنها ما اهتم بذكر الأبنية النادرة، ومعظمها وجه عنايته لصيغتين من صيغ الأفعال هما "فعل أو فعل". وقد حظيت هاتان الصيغتان باهتمام اللغويين جميعًا حتى إن الكتب المبكرة التي ألفت في الأفعال كانت تحمل اسم "فعل وأفعل" أو "فعلت وأفعلت".
وأهم ما ألف في هذا الاتجاه "الغريب المصنف" لأبي عبيد، و"إصلاح المنطق" لابن السكيت، و"أدب الكاتب" لابن قتيبة،
ص271
و "المنتخب" لكراع النمل، و "الجمهرة" لابن دريد في أبوابها الأخيرة.
وأما الفريق الثاني فلم يصل بمؤلفاته -حتى القرن الرابع الهجري- إلى مرتبة المعجم الكامل الذي يحصر الأبنية "سواء كانت للأسماء أو الأفعال" ويوزع تحت كل بناء ما يخصه من ألفاظ، وإنما كانت مؤلفاته خاصة ببعض الأبنية دون بعض.
وانحصرت جهود اللغويين في هذه الناحية فيما يأتي:
"أ" التأليف في أبنية المصادر: وأول من ألف في ذلك الكسائي "ت سنة 182 هـ أو سنة 183 هـ"، ثم النضر بن شميل "ت سنة 203 هـ"، والفراء "ت سنة 207 هـ" وخص كتابه بمصادر القرآن، وأبو عبيدة "ت سنة 209 هـ"، والأصمعي "ت سنة 213 هـ" وأبو زيد "ت سنة 215 هـ" ونفطويه "ت سنة 323 هـ"(6).
"ب" التأليف في أبنية الأفعال: ولا نعرف مؤلفًا واحدًا منها تعرض للأفعال جملة، إذ لم يبدأ التأليف في ذلك إلا بعد الفارابي "قرن 4هـ" الذي سنخصه بحديث مفصل فيما بعد.
وإنما نجدها تناولت صيغًا خاصة من الأفعال، ونجد صيغتين اثنتين من بين هذه الصيغ تجتذبان اهتمام اللغويين فيؤلفون فيهما، وهما صيغتا "فعل وأفعل". ومن أول من ألف فيهما قطرب "ت سنة 206 هـ" والفراء، وأبو عبيدة، وأبو زيد، والزجاج "ت سنة 311هـ" وابن دريد "ت سنة 321 هـ". وأقدم كتاب وصلنا منها هو "فعلت
ص272
وأفعلت" لأبي حاتم السجستاني "ت سنة 255 هـ"(7)، وقد حققه ونشره مؤخرًا الدكتور خليل العطية.
"ج" التأليف في أبنية الأسماء: ولم أجد أحدًا من اللغويين قد أفرد أبنية الأسماء بتأليف مستقل يقصد استيعابها، ويعمد إلى تنظيمها ويجمع ما تفرق منها، ولكنني وجدتهم قد ألفوا في شيء خاص منها وهو "المقصور والممدود". وممن ألف في ذلك الفراء، والأصمعي، وأبو عبيدة، والزجاج(8) وأبو علي القالي "ت سنة 356هـ"، وقد وصلنا كتاب أبي على القالي وما يزال مخطوطًا.
ونخلص من كل هذا إلى أن التأليف في الأبنية في مرحلته الأولى لم يأخذ صورة المعجم الكامل، ولم يتجه إلى حصر المادة اللغوية وتوزيعها على الأبنية. وهو إلى جانب فقده عنصر الترتيب والنظام لم يصل إلى أكثر من:
أ- حصر الأبنية والتمثيل لكل منها.
ب- العناية ببعض الأبنية ومحاولة حصر ألفاظها.
أي أنه فقد أهم عنصرين من عناصر المعجم الكامل وهما الشمول والترتيب.
ص273
__________
(1) أبنية الأسماء لابن القطاع ورقة2.
(2)كتاب سيبويه، 2/ 315 وما بعدها "طبعة بولاق".
(3) أبنية الأسماء لابن القطاع ورقة 2.
(4) الاستدراك على سيبويه للزبيدي "ط روما سنة 1890"، ص1.
(5) المقتضب للمبرد "مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 1909 - نحو، ص 37.
(6) انظر الفهرست لابن النديم "ط مصر 1348" ص 77، 80، 81، 98- 100، 121 ومعجم الأدباء "ط الحلبي" 1/ 271، 272، 11/ 216، 217، 13/ 202، 203، 19/ 343، 20/ 13، 14.
(7) انظر الفهرست ص 79، 89، 91، 100، ومعجم الأدباء 1/ 151. 18/ 126، 136، 19/ 53، 160، 162، 20/ 13، 14.
(8) انظر كشف الظنون "ط استنبول 1360 - 62" 2/ 1461، 1462.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تستعد لإطلاق الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية
|
|
|