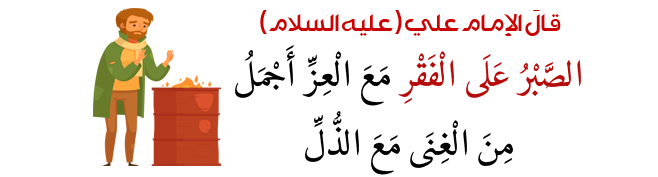
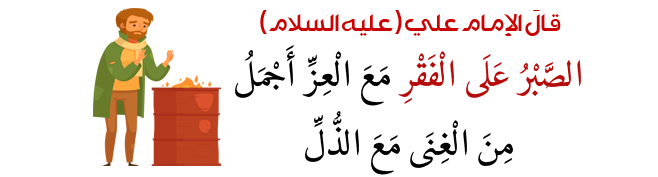

 القانون العام
القانون العام
 القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري و القضاء الاداري
 المجموعة الجنائية
المجموعة الجنائية
 قانون العقوبات
قانون العقوبات 
 القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية 
 القانون الخاص
القانون الخاص
 قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات و الاثبات
 المجموعة التجارية
المجموعة التجارية
 علوم قانونية أخرى
علوم قانونية أخرى| ضرورة الالتزام بالعقلنة في تطبيق مبدأ الحظر الدستوري (الضوابط الواردة على قيود التعديل الدستوري) |
|
|
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-10-2015
التاريخ: 9-1-2023
التاريخ: 2023-11-27
التاريخ: 25-4-2022
|
نحاول في هذا الصدد تعميق مسألة القيمة القانونية لقيود التعديل الدستوري، من خلال مناقشة إطارها القانوني، ومعرفة شروط نفاذ هذه القيود، أي النفاذ القانوني لهذه القيود بحد ذاتها. ترتبط ضوابط التعديل الدستوري مباشرة بنفاذها القانوني، فإذا كانت سارية فلها قوة ملزمة، فما هي شروط مشروعية قيود التعديل الدستوري؟، كيف نتمكن من فهم المجال الذي تطبق فيه هذه الشروط من طرف سلطة التعديل؟.
- إن فكرة المشروعية القانونية تنطوي على ثلاثة معايير (1) :
أولا: المعيار الغائي: المشروعية القانونية وفقا لهذا المعيار، تكمن في مدى توافقها مع القيم غير منصوص عليها في القانون الوضعي، والتي تجد لها مكان على ضوء القواعد الأخلاقية والدينية .... الخ
ثانيا: معيار الفاعلية: تتحدد فاعلية القاعدة القانونية بمدى الخضوع لها وتزول عند أحكامها، بمعنى تحديد الإطار القانوني وربطه بالواقع وهذا ما يعرف بمبدأ الواقعية القانونية أي النظر إلى نتائج القاعدة القانونية، وليس النظر إليها كقاعدة نظرية.
ثالثا: معيار الاطار القانوني: إن المشروعية القانونية تتحدد في ضوء انتمائها إلى نظام قانوني محدد وليس في ضوء أوصافها المجردة.
فالتعديل الدستوري الذي تجريه سلطة التعديل، يستمد مشروعيته من س نه باحترام الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الدستور في الجزء المخصص لتعديله، وبالتالي هذه المعايير أسمى من الناحية القانونية من أي معايير تحدثها سلطة التعديل من خلال تعديلات لاحقة، فالدستور هو نظام قانوني جوهري، تستمد منه باقي القواعد الأخرى صحتها لأنها أدنى منه. على ضوء ما سبق فإن معيار الغاية لم يسلم من النقد، لأنه يستند إلى مبادئ القانون الطبيعي التي تقوم على العدالة، وهي فكرة يصعب تحديدها بدقة على أساس موضوعي، لأن العدالة قيمتها متطورة وتختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص (2).
يبقى معيار الفاعلية والإطار القانوني هما المحددان لشروط المشروعية القانونية لقيود الدستور، ولكن حتى يتم الاعتراف لقيود التعديل بالقيمة القانونية، يجب توافر شرطين هما على التوالي:
أ. الشرط الشكلي: القيود الخاصة بحظر التعديل الدستوري يتضمنها الدستور نفسه، وتنبع من نظام قانوني محدد، هي جزء من الدستور يتضمنها هذا الأخير وفق اجراءات وضمانات منصوص عليها في متن الدستور، وهذا يصب في معنى الإطار القانوني.
ب . الشرط الوضوعي:
يجب أن تشتمل على شرط الفاعلية والنفاذ للنظام الذي يشمله النص، وشرط الحد الأدنى من الفاعلية لقيود تعديل الدستور ذاتها، وبذلك متى سقط الدستور بأي صورة تفقد قيود التعديل فاعليتها بسقوط ذلك الدستور، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن قيود تعديل الدستور ولا عن مشروعيتها القانونية لغياب النظام القانوني الذي تنتمي إليه(3) . ومن ناحية أخرى، فإنه يجب أن تحوز قيود التعديل حدا أدنى من الفاعلية، أي يجب تطبيقها عند الحاجة في بعض الحالات، ولو تم إهمال أحد قيود التعديل الدستوري وكان استعماله واجبا، فإنه يفقد مشروعيته القانونية، وطالما أن الدستور ظل مطبقا ولم يلغ أو يسقط بنجاح ثورة أو إنقلاب، فإن قيود تعديله المنصوص عليها تظل واجبة التطبيق والاحترام من قبل سلطة التعديل، وهي سلطة مشتقة وليس أصلية، تظل إرادتها قاصرة عن اختراق مثل هذه القيود نظرا لتمتع الدستور بأكمله بالنفاذ والفاعلية كنظام قانوني متكامل تستمد من خلاله العناصر المكونة له مشروعيتها القانونية وضوابط نفاذها . وفي في ختام هذا الجزء من الدراسة، فإننا نلاحظ أنه من العبث البحث عن استقرار المؤسسات السياسية في موانع قل اتساعها أو زاد، فليس منع تعديل هذه المادة أو تلك من الدستور، واعلان عدم مساسه خلال زمن محدد، هو الذي يضمن للدستور ثباته النسبي، وانما خاصيته كمنظم للحياة السياسية لشعب ما.
ثم إن هذا النوع من التقييدات ليس له أي قيمة، لان سلطة التعديل الدستوري تعود إلى القابضين على السلطة العليا، وكيف يمكن تقييدها بواسطة منع بسيط، هذا المنع له قيمة سياسية وليست قانونية. فمن الناحية القانونية لا يمكن إدراك الثبات الدستوري المطلق، فالسلطة المؤسسة نظرا لكونها السلطة العليا للدولة لا يمكن أن تقيد حتى من قبل نفسها، وبالتالي عمليا مؤسس اليوم لا يستطيع تقييد أمة الغد، ما لم يكن المنع إلا تأكيدا لقاعدة أخرى.
ولهذا لو نرجع إلى الواقع، فإن تقييد سلطة التعديل بموانع معينة تحظر التعديل الدستوري نابع من الاقتناع بوجود قواعد أخرى غير مكتوبة، وهو ما أكده الأستاذ (منذر الشاوي) (4) هذه القواعد هي "السمو دستورية" Super- Constitutionnelle (5) تفرض على المؤسس نفسه، غير مكثف بالتقييدات التقليدية المعروفة والمفروضة من قبل الدستور على السلطة المشتقة، وعليه فقد ذهب بعض الكتاب إلى حد التفتيش عن هذه القيود خارج الدستور الوضعي، فهم يعتقدون إيجادها في قواعد سمو دستورية، فهل هناك فعلا سمو دستور يفرض على السلطة المختصة بالتعديل الدستوري؟المقصود بهذه القواعد المصوغة في اعلانات حقوق الإنسان مثلا، فهي لا تلزم المشرع فقط، بل حتى المؤسس الدستوري، مثل إعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 الفرنسي. فالقواعد سمو دستورية هي الأساس لكل نظام قانوني نافذ المفعول ، وتباين وجهات النظر في مسألة حظر التعديل الدستوري ومشروعيته، نجد أنها ترمي في النهاية إلى عدم التعسف في استعمال حق التعديل من قبل السلطة المختصة، ولهذا فالسؤال المطروح في هذه الحالة، هل يمكن منع التعسف في استعمال حق التعديل الدستوري فقط باللجوء إلى القيود الإجرائية الموضوعية والزمنية للتعديل الدستوري، للحفاظ عل استقرار الوثيقة الدستورية وثباتها. يمكن معالجة هذه المسألة من زاوية أخرى بعيدا عن قيود عملية التعديل الدستوري وحدودها إلى مسألة أخرى غاية في الأهمية، لأن المشكل المطروح لا يتعلق بعملية المراجعة الدستورية بحد ذاتها، وانما بتحديد الأسباب والبواعث الحقيقية الدافعة إلى عملية التعديل، والتي أدت إلى افتقار الدساتير حاليا بالاستناد إلى هذه الدوافع إلى الاستقرار والثبات اللذان يميزان الدستور في معناه الحقيقي. فكيف تصبح الدوافع الرامية إلى حق التعديل الدستوري، وسيلة للتعسف في استعمال هذا الحق؟.
________________
1- عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، دراسة في بعض جوانبها النظرية والعملية، دارالنهضة العربية، الطبعة الاولى، 2006 ، ص 7 و ما بعدها
2- رجب محمود طاجن، قيود تعديل الدستور، دراسة في القانونين الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، الطبعة . الأولى، 2006 ، ص 119
3- قاشي علال، ضوابط التعديل الدستوري، مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية، الفترة من 5 إلى 7ماي 2008 ، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ص 96
4- منذر الشاوي، القانون الدستوري نظرية الدولة ، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1981، ص 188
5- cf, Mactar KAMARA, Supra-constitutionnalité et exercice du pouvoir constituant derivé, Revue de la recherche juridique, Presses universitaires d’Aix-Marsseille, n 3, 2008.



|
|
|
|
هل يمكن للدماغ البشري التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم؟
|
|
|
|
|
|
|
علماء: طول الأيام على الأرض يزداد بسبب النواة الداخلية
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يشرك طلبة الدورات الصيفية بمحفلٍ قرآني في محافظة بابل
|
|
|